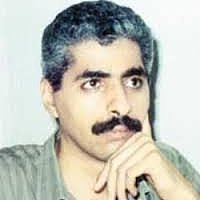عشق خيري عبد الجواد التراث الشفهي والمكتوب، فمثل نقلة نوعية في مسار الإبداع المصري، الذي التزم طوال الوقت بالواقعية ومرادفاتها الاجتماعية والنقدية وهو اتجاه أفضى إلى تجفيف الإبداع من طاقة التخييل، فأصبح ملتزما بقضايا الواقع فحسب.
أما تجربةخيري عبد الجواد في استعادت الخيال، وأكدت مكانته في الأدب المصري. ربما بدا هذا على استحياء مع أول قصة نشرت له عام 1981م، ثم تأكد مع مجموعته القصصية الأولى ( الديب رماح) التي استعانت بطرائق لعب الأطفال الموروثة عبر تاريخ يمتد إلى القدماء المصريين، ويتجلى في بعض المفردات الهيروغلفية كما في طقوس الاحتفال بمقدم هلال رمضان، أو في حالات سقوط الأمتار عندما ينشد الأطفال فرحا، يا مطرة رخي رخي.
كان خيري راغبًا في طي صفحة الماضي بكل نجاحاته وإخفاقاته. وكانت الحياة الثقافية شأن كل حياة المصريين، قد دخلت منعطفًا مظلمًا بعد نكسة 67. منعطف كثقب أسود، اتسم باهتزاز اليقين، ونظرة غاضبة إلى الوراء، ونزعة تشاؤمية عبر عنها الابنودي بأغنية «عدى النهار .. والمغربية جايه .. تتخفي ورا ضهر الشجر».
ربما هذه المعاناة هي التي دفعت تجربة هذا الجيل ( الثمانينيات) إلى نضج مبكر. بدأت معالمه تظهر بعد تحرير التراب المصري، برغبة ملحة في طي صفحة الماضي، والبحث عن معنى جديد للكتابة.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-9338910329340117&output=html&h=280&adk=2008785037&adf=2570672128&pi=t.aa~a.3987509640~i.5~rp.4&w=804&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1708424951&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=7328216920&ad_type=text_image&format=804×280&url=http%3A%2F%2Fwww.alkalimah.net%2FArticles%2FRead%2F23434&fwr=0&pra=3&rh=200&rw=804&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1708424951124&bpp=4&bdt=2257&idt=-M&shv=r20240215&mjsv=m202402120101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc2e7f4820ad1cc20%3AT%3D1708424901%3ART%3D1708424901%3AS%3DALNI_MYTy9_22RU0gLYbhFY1b8G47r0gww&gpic=UID%3D00000d5cdc287930%3AT%3D1708424901%3ART%3D1708424901%3AS%3DALNI_MYs5uCUTlX9IfB7fuWfmQI6fi3Kjw&eo_id_str=ID%3De9c22767ea289d73%3AT%3D1708424901%3ART%3D1708424901%3AS%3DAA-AfjaO52zR9sqd_Drr9n1ovSd-&prev_fmts=728×90%2C0x0&nras=2&correlator=3913590154259&frm=20&pv=1&ga_vid=1071211311.1708424902&ga_sid=1708424950&ga_hid=1576055265&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=1&u_h=768&u_w=1366&u_ah=720&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=1&adx=396&ady=1001&biw=1303&bih=646&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C44759837%2C44808397%2C31081222%2C44719338%2C44795921%2C95324580%2C95325066%2C31081135%2C95322195%2C95324154%2C95324160&oid=2&pvsid=3029581654190808&tmod=766905036&wsm=1&uas=0&nvt=1&fc=384&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C720%2C1318%2C646&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=23&bz=1.04&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&dtd=221
في الواقع، كانت الثمانينيات محطة للتجريب والبحث عن مذاق أدبي جديد. كنا قد انتهينا لتونا من حربين (67 -73) تركتا آثارًا فادحة على الواقع المصري. ندرك أن الشعارات الثورية لم تعد كافية لرأب الصدع الذي أصاب المجتمع، وشرخ نفوسنا من الداخل. فكان ثمة ضرورة لجيل بعضه ينظر إلى الوراء بغضب، وبعضه نجا من جبهات القتال بروح منطفئة غايتها الهجرة إلى دول الخليج، والبعض الآخر انهمك في اتجاهات الإسلام السياسي. باختصار لم تكن نكسة 67 مجرد هزيمة عسكرية، بل كانت هزيمة لحلم قومي أكبر منا. ومع ذلك فإن هذا الجيل لم يسلم من هجمات مرتدة مارسها بعض من كبار المثقفين العائدين من المنافي، ليعيدوا إنتاج مشروعهم اليساري وكأن لاشيء في الواقع تغير أثناء غيابهم.
هكذا جاء الحكم القاسي بإسقاط جيل كامل من تاريخ الأدب المعاصر. على أيه حال، لقد وضعت التسعينيات نهاية للعرض بإسدال الستار على كل ما مضى، برغبة في إنشاء حظيرة ثقافية تسع الجميع. حظيرة مشيدة على نحو طبقى، بنيتها التحتية الفقيرة تبدأ من نوادي الأدب بالأقاليم المهمشة أصلاً، وقمتها تحتمي ببيت أبيض كبير، نطلق عليه المجلس الأعلى للثقافة. إن هذا البناء الهيراركي للثقافة في تلك المرحلة، سمح بالكاد لكثير من المتميزين ثقافيًا وأدبيًا، أن ينتظروا على سلالم البيت الأبيض طويلاً، أملاً أن يسمح لهم بالصعود. وظني أن كثيرًا منهم مات، وهو ينتظر.
****
رغم عمره القصير، كان خيري عبد الجواد يطاول الكبار في غزارة إنتاجه وتنوعه وتفرده، وربما لو أطال الله في عمره حتى الآن، لبز بعضهم، ولكان يتربع على عرش السرد باستحقاق بعد رحلة النضج التي قطعها بدأب. غير أن المنايا كانت للفتي رصد؛ فقدناه في مطلع 2008م، وهو نفس العام الذي كنت فيه أمينًا عامًا لمؤتمر أدباء مصر في الأقاليم المنعقد بمدينة مرسى مطروح، ولم يكن لدينا ما نفعله غير أن نكرم اسمه بعد أن رحل عنا. في الواقع، قائمة الراحلين من جيله كانت كبيرة. فثمة سابقين عليه، وثمة لاحقين، وثمة من ينتظر على السلالم.
لا شك عندي أن التسعينيات شهدت صحوة ثقافية، لكن المؤكد أن طلائعها كانت من كتاب الثمانينات وعلى رأسهم خيري عبد الجواد. ولعل مراجعة متأنية لإنتاج النصف الأول من عقد التسعينيات، تشهد بنضج تجارب أدبية بدأت خطواتها الأولى في الثمانينيات، حيث اتسمت بالتنوع، والمغامرة، وروح التجريب. أسلمُ بأن شهادتي – كواحد من جيل الثمانينيات – عن خيري عبد الجواد قد تكون مجروحة نظرًا لصلة الصداقة القوية بيننا. ولكن هذه الصلة، جعلتني على يقين بهذا الاستحقاق، فقد قاربت توقده، وكنت شاهدًا على فيض الإلهامات التي تتفجر من مخياله السردي، وعمق اشتغاله الثقافي على مشروعه. الذي واكب شيوع واقعية ماركيز السحرية، فأسرت كثيرًا من كتاب هذه المرحلة، وما زالت تترك آثارًا شاحبة عند البعض من جيل التسعينيات.
هكذا كان خيري عبد الجواد رمزًا على تجربة ناجحة، ونادرة في مقاربة التراث، واستلهام مخياله الغرائبي. إذ نشأ في أشهر البيئات العشوائية التي تكونت على جوانب القاهرة في نهاية الستينيات، حي (بولاق الدكرور) هو نفسه يعترف بأن هذه النشأة، فضلاً عن تعليمه المتوسط، كانا دافعين قويين لينبهر بالمخيال الشعبي. يكتشف كم هو ثري وجدير باحترام النخب الثقافية. لكنه لم يتوقف عند حد الانبهار، والمحاكاة البسيطة للموروث كتلك التي نجدها في مجموعته الأولى (الديب رماح) بل راح ينهل بنهم من أعماق التراث الشفهي والمكتوب، يطور من أدواته، ويوسع من معارفه. كان أول ما لفت انتباهي في زيارتي الأولى له، هذا الكم الهائل من نفائس الكتب التراثية. في ذلك الوقت، وفي مناخ يلوح بسلفية مخيفة تتفشى في المجتمع، كان التراث موسومًا بالرجعية بين النخب الثقافية. ربما هذا ما دعا إدوار الخراط للتردد، متسائلاً في مقدمة الكتاب الأول لخيري عبد الجواد: هل هذه الكتابة حكايات شعبية أم قصص حداثية؟ وخلص في نهاية الدراسة إلى أنها قصصًا حداثية تمتح من بئر الخرافة الشعبية[2] إنه تساؤل عجيب وغير مبرر ولا يفضي إلى معنى، بقدر مايضمر احتجاجًا.
في فنون الأدب، ومجالات المعرفة المختلفة، نزع العرب إلى الأشكال الحرة أو المفتوحة، التي لا تلتزم بنية معيارية كما كان الحال في الدراما الإغريقية. هذه الرؤية الموسوعية للمعرفة سمحت للقدماء بالتنقل بين الفنون والموضوعات وطرائق التعبير المختلفة كما نجد في كتب الأغاني، والإمتاع والمؤانسة، وغير ذلك من كتب التجوال الحر في فضاء تخيلي كما في (ألف ليلة وليلة) التي تتضمن -داخل الحكاية الإطار- عدة حكايات صغرى لا ترتبط بمبررات فنية ومنطقية، وتتجاوز حدود الأمكنة والأزمنة. إذ يكفي اختلاق أي مبرر لينهمر المتخيل السردي مستفيدًا بالمعطيات الثقافية كافة، فالشعر والحكمة والتاريخ وفقه الدين، كما في حكاية الجارية تودد التي ألمت بكل علوم الدين والدنيا.
في أوروبا، نجد فن الرومانس الذي يتناول حكايات الفرسان ومغامراتهم، وفن والبكارسك الذي يتناول حكايات الشطار والمحتالين، اعتمادًا على بنية كلية، موزعة على حكايات صغرى. وظلت هذه البنية المرنة ملمحًا مميزًا للسرد حتى في أكثر الأعمال اكتمالاً ونضجًا مثل: ديكامرون بوكاتشيو، ودون كخوتة لسيرفانتس، ورحلة الحاج لجون بينان، التي تدور في عوالم النفوس والأرواح، وحكايات كانتربري لتشوسر وروبنسون كروزو لدانيال ديفو. كما أن الرواية الحديثة عند كبار الكتاب أمثال:ديكنز، ودويستيوفسكي وإميل زولا، الذين نشروا رواياتهم مسلسلات في الصحف اليومية، نزعوا إلى هذه البنيات البسيطة لتمرير الخيال، بغرض اجتذاب القراء، وتشويقهم إلى متابعة ما يكتبون. لكن هذه البنيات على بساطتها تحتاج ساردًا خصب الخيال واسع المعرفة.
ما نعنية، أن الخيال نفسه كان طريقًا للمعرفة. فالأساطير الأولى، كانت طريقة الإنسان الأول لتفسير وفهم واقعه المسكون بالغموض والخوف، ومنها خرجت كل المعارف الأولى والتي مازال بعضها راسخًا في الوجدان البشري، ويتجلى في خطابات مثل: الأحلام، والأديان، والفنون، والآداب. وبطبيعة الحال، فالثقافة العربية لها نصيبها في هذا التراث الإنساني المرتبط بعصور الشفاهة، وظلت آثاره ماثلة فيما بعد التدوين. ونجدها في فنون الأدب العربي بصور وأشكال مختلفة.
ربما نظرًا لاقتراب فن (المقامة) من أحوال البشر ومظاهر الواقع الإنساني، وتخلصها النسبي من الخوارق والعوالم الغيبية، اعتبرها البعض بدايات عربية لفن القصة القصيرة الذي نكتبه الآن. لكن مع سطوع الحداثة الأوربية، وغلبة التخصص العلمي، حرصت نظريات الأدب على وضع ضوابط إجرائية تحدد ماهيات الفنون. وفي هذا السياق يحذر هـ. ب.تشارلتن من الخلط بين الحكاية في صورتها التراثية والقصة القصيرة في معناها الحداثي، فيقول:”سيبدو لك ما زعمه مؤرخو الأدب أمرًا عجيبًا, لأنك في أغلب الظن ستخلط بين الحكاية والقصة, وسترجع بخيالك إلى أعمق أعماق الماضي السحيق لتري الناس يروون الحكايات كلما كان فراغ، ودار في حلقات السمر حديث, ثم تقول وهذه قصص العرب, وألف ليلة وليلة, وهي كلها أسبق من هذا التاريخ الذي زعمه مؤرخو الآداب بداية للقصة, لكنك أنسيت خصائص القصة بمعناها الصحيح, فليست كل تلك الحكايات الأولي قصصًا, لأنها تفقد أخص خصائص القصص, فما هي صادقة في تصوير الحياة, ولا هي تتعقب أجزاء الحادثة الواحدة تحليلاً حتى تبلغ أقصي مداها, وإنما هي حكايات ولا تنسى قط وأنت تطالعها أنك في عالم من الخيال”.[3]
نفهم من كلام (تشارلتن) حرصه على الوحدة الفنية لبناء القصة الحديثة. كما نفهم ضرورة التزام القصة الحديثة بتصوير جوانب الحياة الإنسانية، وخلوصها من موضوعات الخوارق والغيبيات التي كانت موضوعًا للحكايات القديمة. لكن (فرانك أكونورو) يضيف بعدًا آخر، فيقول:”يمكن أن نرى في القصة القصيرة اتجاهًا عقليًا يجتذب جماهير الجماعات المغمورة علي اختلاف الأزمنة وأن الرواية مازالت بالفكرة التقليدية عن المجتمع المتحضر”[4]. يضيف (اكونورو) شرطًا للسرد القصصي والروائي، وهو الالتزام بقضايا الجماعات المغمورة، وهذا التزام أيديولوجي وليس التزامًا فنيًا. وقد وجد في تشيكوف نموذجًا جيدًا للواقعية الاجتماعية ونزعتها النقدية. غير أن كلامه عن الاتجاه العقلي يفضي إلى تجفيف القصة من الخيال. وفي غمار الالتزام بالواقع وقضاياه، بالغت القصة في التخلص من التشكيل الخيالي سواء في موضوعاتها أو لغتها، حتى تحولت في كثير من الأحيان إلى مجرد رسائل تحمل فكرة، أو تحريض على موقف سياسي، وفي سبيل الرسالة نضحي بكل لمحات الخيال والجمال الفني. فيما ظلت الرواية بسبب بنيتها الأكثر اتساعًا فضاءً لمستويات عديدة من السرد، لكنها في عقيدة اكونورو فكرة تقليدية لا تواكب المجتمع المتحضر، مع ملاحظة أن صورة المجتمع المتحضر عنده، هي المجتمعات المغمورة!!
في تقديري أن استدعاء القصة لميدان الصراع الأيديولوجي في القرن العشرين هو الذي أفضى إلى تثبيت نموذجين متناقضين: نموذج تشيكوف الذي يركز على نقد الواقع وفضح تشوهاته، في وحدات قصيرة ومكثفة للحدث بتداعيات وحدتيه المكانية والزمنية. في مقابل (إدجار آلان بو) ونزعته الخيالية السوداء، حتى اشتهر بأنه مؤسس قصص الرعب والتحري، ففتح بابًا لأدب الإثارة والمغامرات الذي نُظر إليه من وجهة النظر الواقعية على أنه أدب تسلية، ولا يصب في تغيير الواقع الاجتماعي. لقد اكتسب المخيال الغرائبي سمعة سيئة تحت وطأة الحداثة. وظني أن هذا موقف أيديولوجي فحسب، فقصص (بو) لا تخلو من نماذج إنسانية متفردة، كما أن النزعة الإنسانية تسكن قصص تشيكوف بوضوح، حتى عندما تلتزم الواقعية النقدية تظل مطرزة بخيال ينبض بالحياة وتفاصيلها. لقد كان السرد طوال الوقت هو خطاب الإنسان إلى ذاته. وبين واقعية تشيكوف وغرائبية (بو) تأتي كتابات (جوجول-1809) ليس بين الواقع والخيال فحسب، بل بين القصة والرواية أيضًا، ففي الوقت الذي تحفل فيه بحياة البسطاء من الفلاحين وتصور معاناتهم تفيد من خيالهم الشعبي وحكاياتهم الغريبة بنبرة متعاطفة لا تخلو من طابع تهكمي على نحو ما عكسته (أمسيات قرب قرية ديكانا). وعلى الرغم من مأساوية حياة (أكاكي) بطل قصة (المعطف) بل ونهايتها، والتزامها بقضايا الواقع المعاش في روسيا، إلا أنها اتشحت بلمسات تخيّلية، بحيث بدت كأمثولة دالة على الواقع وليست محاكاة نقدية له. ولعل هذه الوضعية البينية عند (جوجول) سمحت بظهور أشكال وسيطة بين القصة والرواية، فظهرت كتاباته في شكل النوفيلا، ليس بوصفها رواية قصيرة، بل بوصفها فضاءً لقصص تتجاور وتتداخل وقعائها وشخصيايها بقدر من بالخيال، وطابع أمثولي أكثر اتساعا من الواقعية النقدية. حتى أطلق علي سرديات جوجول (الواقعية الخيالية) وهو مصطلح تتداخل أصداؤه مع الواقعية السحرية، وكان (بورخيس) من أبرز الذي رفعوا شعار الفن للفن، الذي يمثل نزعة احتجاجية ضد جر الأدب إلى غايات مُسيّسة.
وظني أن حركات المد الثوري التي شهدها القرن التاسع عشر، وما تبعها من حراك سياسي أفضى إلى حربين عالميين مع بداية القرن العشرين، فضلاً عن حرب باردة ومؤدلجة استمرت حتى التعسينيات، كل هذه ظواهر جعلت المعنى السياسي حاضرًا بقوة في الخطاب السردي، ولا سيما في المجتمعات التي عاشت حراكًا ثوريًا للتحرر من تراث الكولونيالية. إلا أن الثمانينات في مصر شهدت احتجًاجًا صامتًا ضد غلبة المعنى السياسي، ربما يكون متأثرًا بالواقعية السحرية بعد فوز جارسيا ماركيز بجائزة نوبل، مشفوعا بآلية دعائية واسعة. غير أن خيري عبد الجواد كان أسبق كتاب جيله، عندما التفت إلى أهمية توظيف التراث الشفهي والمكتوب لخدمة مشروعه الغرائبي. ليصبح – مع الوقت – تيارًا يعبر عن نفسه في موضوعات مختلفة مثل:
موضوع المكان: كثير من الروايات التي اتخذت من الأماكن الطرفية/ المهمشة، راهنت على توظيف التراث الشفهي/ الحكائي، والممارسات الممثلة في العادات والتقاليد والأعراف والمعتقدات.
موضوع التاريخ: ولاسيما التاريخ الاجتماعي، حيث يمكن الإفادة من التراث الشفهي والمكتوب لتضفي على الواقع الاجتماعي مسحة تخيلية تستهدف تأكيد الامتداد التراثي، ومن ثمّ تأكيد الهوية الثقافية، والتاريخية للمجتمعات.
الموضوع الميتافيزيقي: الذي يرصد عالم المتصوفة المتميز في معجمه اللغوي المجازي، ليجسد خيالاً مترعًا بحكايات الأولياء وكراماتهم، وتجلياتهم المكتنزة بالخوارق والمعجزات. لكن الفضاء الميتافيزيقي مرن، ويمتد لأبعد من الفضاء الصوفي، إذ نراه في روايات الخيال العلمي، وروايات والألغاز والمغامرات المترعة بعوالم باراسيكولوجية وطوابع غرائبية أصبحت في الآونة الأخيرة هي الأكثر مقروئية بين الأجيال الشابة.
جاءت حكايات الديب رماح في نهاية الثمانينيات بمثابة مانيفستو يعلن – بشكل مضمر – عن احتجاج كتّاب هذه المرحلة على مفهوم (الالتزام) وتحديدة لقيمة النص بقوة الرسالة وأثرها في المتلقي. وما أن جاءت التسعينيات، حتى أصبح الخيال عنصرًا رئيسًا ومستهدفًا في السرد.
***
الطبيعة الخاصة للحكاية الشفهية، تعمل على تفكيك بنيتها تلقائيًا عبر كل رواية لها، فنحن نعرف أن الضرورة الشفهية تجعل الحكاية مفتوحة على رواه متعددين، يمكنهم الحذف أو الإضافة أو التعديل، فينتج عن هذا التكرار والتشابه والتداخل بين الحكايات. كما تصبح الحكاية الواحدة قابلة لاستقبال خطابات متعددة وربما متناقضة، قد تكون تاريخية فتميل إلى الإخبار والتوثيق والاستشهاد والإسناد، وقد تكون دينية، فتتحلى بالأحاديث والمدائح النبوية والسير العطرة حتى لو خرجت عن مسارها الموضوعي، وقد تكون أمثولات تنزع إلى استلهام العبر من قصص السلف، وقد تقارب الإنسان في طبيعته وغرائزه وواقعه الحسي فتميل إلى الابتذال والمجون، أو تفارق الواقع إلى الخيال الغرائبي فتستدعي حكايات عن السحر والجان وكرامات الأولياء، وقد تجمع بين كل هذا في فضاء واحد.
ربما، لهذه الطبيعة الرجراجة والمتداخلة للحكاية الشعبية، ذهب الناقد اللبناني (جورج جحا) إلى أن رواية كيد النسا لخيري عبد الجواد:”تشكل في صورة عامة تراكم حالات متشابهة متكررة وتبدو أحيانًا أقرب إلى دراسة اجتماعية “قصصية” عن السحر و”الكتابة”[5] وطقوسهما وعن الجنس الذي يفيض منها ”وأغلب الظن أن (جورج جحا) يرى السرد عبر مفهوم معياري لا يطمئن إلى مغامرات التجريب، وفاعلية الأصوات المتعددة للموضوع الواحد، تلك التي تستدعي خطابات من حقول معرفية مختلفة لتدور كلها في فضاء واحد.
لخيري عبد الجواد رؤية واضحة في علاقته بالتراث، مفادها أن الماضي لا يموت، لأن الزمن طاقة، والطاقة لا تفنى، وإنما تجدد نفسها في صور مختلفة. وجزء من وظيفة الكتابة مطاردة الزمن في صوره ووقائعه المختلفة، وإمعان النظر فيه وبهذا الوعي لا ينفصل الكاتب عن واقعه مهما أوغل في الماضي وأخيلته:”أنا دائمًا ما أتمثل هذا التراث لحظة الكتابة، وتبقى المشكلة أو السؤال: كيف تنظر لهذا التراث؟ فإذا انبهرت به فسوف تقع في غوايته ولن تستطيع التخلص منه وسوف يقودك هو.. أما إذا نظرت إليه عن بعد نظرة محايدة فسوف تستطيع أن تتخذ موقفًا منه إما بالضد أو مع”[6]
يعكس الشاهد السابق إدراكه لخطورة التغيرات والتحريفات المدخلة على الحكاية الشعبية، فنتيجة لتعدد رواتها، تتعدد في دلالتها حد التناقض أحيانًا. وعلى الكاتب أن يمعن النظر في كل حكاية، لتكون مناسبة للنسق الثقافي العام للنص. وليس من قبيل الصدفة، أن خيري عبد الجواد، أول ما رأي الماضي، لم يكن في كتب التراث، بل في ألعاب الأطفال، مع مجموعته القصصية الأولى (حكايات الديب رماح). ولعل استخدامه لكلمة (حكايات) بدلاً من (قصص) تشير إلى وعيه المبكر بطبيعة مشروعه السردي الذي بدأه في العشرينات من عمره، وأنهاه في الأربعينيات، تاركًا رصيدًا ضخمًا من القصص والروايات والأبحاث والتحقيقات التي تضيء التراث العربي من المنظور السردي.
يبدأ خيري المرحلة الأولى في منتصف الثمانينيات، وتنتهي بمجموعتين قصصيتين هما: (حكايات الديب رماح 1987، حرب أطاليا 1988) وفيهما لا يذهب إلى عمق التراث الثقافي فقط، بل إلى بدايات التكوين للذات المصرية، فيتوقف طويلاً أمام مرحلة الطفولة، في محاولة للكشف عن عمليات التواصل الثقافي عبر الزمن، التي تقوم أساسًا على الشفهية وتعكسها العادات والتقاليد والألعاب و المفردات التي تتسلل إلى المعجم اللغوي للأطفال. إذ تكشف بعض الدراسات الفولكلورية، أن بعض مظاهرنا الثقافية، مازالت تحتفظ بصياغات تراثية قد تمتد إلى العصور الفرعونية مثل: احتفالات السبوع للمولود، وأربعينيات الموتى، وأغاني الأطفال وألعابهم ولغتهم ومصطلحاتهم الخاصة. فمثلا: ألعاب الأطفال تحت ضوء القمر في صعيد مصر، رافقتها أغان ترجع جذورها إلى طقوس فرعونية لـ (تحوت) إله القمر، سواء في تمامه أو استقباله ووداعه هلالاً صغيرًا. لكن الطقس الفرعوني يتحول إلى سياق مختلف تمامًا؛ ففي ألعاب الأطفال خلال شهر رمضان، تصبح الفوانيس في مخيلة الطفل بمثابة أقمار صغيرة (أهلة) ويصبح اسمها (إيوحا) وهي كلمة ترجع إلى (إيحي) الإله الذي كان يصور على هيئة طفل. وهكذا فإن (وحوي يا وحوي .. إيوحا) التي يستقبل الأطفال بها هلال رمضان، متصلة باستقبال القدماء المصريين لطلوع إله القمر.”أننا نستقبل رمضان بلغتنا المصرية القديمة بقولنا وحوي يا وحوي إيوحا، وكذلك حلّو يا حلّو.. رمضان كريم يا حلو. كما عرفت أن أغلب ألعاب الأطفال وأغانيهم تبدأ بكلمات مصرية قديمة: سح يا بدح يا خروف نطاح، و يا مطرة رخي رخي، وحلاقاتك برجلاتك”[7] إن الموروث الثقافي الحي لأي مجتمع هو تجسيد لسيرورة الزمن وتحولاته، فالاحتفالات بالآلهة المصرية القديمة، تحولت مع المسيحية إلى احتفالات بالقديسين، ومع الإسلام إلى احتفالات بأولياء االله الصالحين.. وهكذا .
وإذا كانت البدايات عند خيري عبد الجواد تسترشد بالتراث الشفهي، فإن المرحلة الوسطى تعوَل كثيرًا على التراث المكتوب، ولكننا في كثير من الأحيان لا نجد فصلاً حادًا بين المكتوب والشفهي في سرده. ويكشف هذا عن تصوره للطبيعة اللامركزية في الحكاية العربية، وقدرتها على التجلي في أكثر من سياق، فالحكاية العربية لم تلتزم فنًا واحدًا ولا نوعًا واحدًا من الحكي، ولكنها تتجلى في فنون وآداب كثيرة مثل: السير والمغازي والقصص والأخبار والمقامات والطرائف، والمديح النبوي، وحكايات المتصوفة والأولياء وكراماتهم، الحواديت والأمثال الشعبية والحكم والمواعظ، وحتى قصص التاريخ والحديث والفقه بثّت الحكايات في ثناياها. وكثيرًا ما تنسب الأشعار والحكايات إلى شخصيات أو رواة مجهولين أو بأسماء مختلقة. هذا فضلاً عن أن كثيرًا من الكتب والمخطوطات التراثية، كتبت بلغة تمازج بين الفصحى وعامية زمانها ومكانها، وأفادت من لهجات عربية مختلفة، وهي المعروفة بلغة المولدين.
لقد أفاد خيري عبد الجواد من هذه الطبيعة المرنة والمتعدية للحكاية الشعبية، مقتفيًا لغتها وأساليبها وموضوعاتها وعالمها الغرائبي. وظهر هذا في أعماله التي شملت عقد التسعينيات، وحملت عناوين دالة على انشغالها بالتراث مثل: (كتاب التوهمات 1992م، العاشق والمعشوق 1995م، حرب بلاد نمنم 1997، مسالك الأحبة 1998، الجني 1999م). وخلال هذه المرحلة اشتهر خيري عبد الجواد كاتبًا له مشروعه الخاص والمميز بين كتّاب جيله. ثم رأي أن المرحلتين الأوليين استنفذتا طاقتيهما فيما يتعلق بالتراث وعالمه الغرائبي، فالتفت إلى واقع الحياة اليومية، مطعّمًا إياه بإحالات تراثية وفولكلورية، ومن ثم جاءت مرحلته الأخيرة بمثابة نقلة موضوعية مثلتها أعمال: (يومية هروب، 1999م – قرن غزال،2003م – كيد النسا،2006م- حارة أبو أحمد،2009- سلك شائك، 2010م). ويمكن ملاحظة الرغبة في مقاربة الحياة اليومية من العناوين السابقة.
فيومية هروب تستدعى سيرة ذاتية للكاتب نفسه، وتستدعى معها لغة عصرية شديدة الاحتفاء باليومي والمعاش، وما يدور على ألسنة الناس من ابتذالات وممارسات مغرقة في عفويتها وشعبيتها. ووسط كل هذا تتكون ذات ترنو لأن تحظى بقدر من السمو والرفعة لمثقف مأزوم يعاني قهرًا اجتماعيًاً واقتصاديًا. والواقع أن هذه النقلة لم تفارق الحكاية الشعبية وآليات سردها، ولكن يمكن القول إنها فارقت المرجعيات والاستلهامات التراثية، سواء في لغتها وتعبيراتها، أو في موضوعاتها، فلغته وموضوعاته أصبحت أكثر انتماءً إلى قضايا وهموم الإنسان في واقعة المعاش داخل بيئات حديثة ومهجنة؛ ولكنها تتعايش مع ما تبقى في الواقع من ثقافة شعبية.
على أية حال، فهذه النقلة، تعكس نُضجًا في تجربة خيري عبد الجواد، التي كانت قد انهمكت في الأثر التراثي لغةً ومعنى على نحو ما نجد في: (نزهة المشتاق في حدائق الأوراق، كتاب التوهمات، مسالك الأحبة). العناوين الثلاثة تستند إلى محاكاة صريحة للعناوين التراثية، بخلاف العناوين التي تومئ إلى الواقع المُعاش. وانتمت إليه في موضوعاته ولغته، ولكنها ظلت محافظة على البنية السردية المفتوحة المتعددة الجوانب والآفاق كونها الملمح الأصيل في الحكاية التراثية. وكان عبد الجواد أدرك أن بعض التراث لم يبق سجين زمنه، فمنه الذي انساب في الزمن، وذاب في الوجدان الشعبي بطرائق وصور تناسب الوعي المعاصر في لغته وموضوعاته. هذه النظرة للتراث تمثل نضجا لوظيفة التراث في الموضوع السردي المعاصر، مثل ثيمة المثقف المأزوم في رواية (يومية هروب) وفي مجموعته القصصية (قرن غزال) التي أفادت من لغة الحياة اليومية، وإن كانت مفعمة هذه المرة بسخرية شديدة ورغبة في مشاغبة أبطال قصصه. إذ كان بعض قصص هذه المجموعة، مستوحى من شخصيات حقيقية، منها صديقه (سيد دعبس) كما كان يروي عن نفسه على نحو ما نجد في قصة (العشة). مع ملاحظة أن قرن الغزال في الثقافة الشعبية المهجنة (العشوائية) لا علاقة بصورة الغزال في التراث العربي، بل هي سلاح شعبي (مدية)، كما أن الأزمات التي يواجهها مثقف (قرن غزال) هي أزمات الحياة اليومية المألوفة، وليست من قبيل القضايا الكبرى كتلك التي نجدها في رواية (زهور سامة لصقر) لابن جيله أحمد زغلول الشيطي. وعليه فإن ملمح السخرية ينسحب على المثقف ذاته، وعجزه عن التوافق مع بيئته، وعدم القدرة على احترام ثقافتها. حتى أن المواجهات البسيطة مع واقعه تكشف عن هشاشة ذاته، ومثالية مفرطة مفارقة للواقع. وهكذا لا تبدو أن صورة المثقف في كتاباته تستدر التعاطف بوصفها ضحية للواقع المعاش وأنظمة الحكم على نحو ما نجد عند (الشيطي ) بل على العكس. إن مثقف خيري عبد الجواد صورة مرتبطة بمثالية نخبوية مفارقة لواقعها. وهو يكشفها في محيطها الاجتماعي بنبرة تهكمية ليسمح للهامش الشعبي أن يتمركز في المتن بدلاً المثقف النخبوي.
فبطل قصة (العشة) تستدرجه رومانسيته فتصوّر له أن بناء عشة من البوص على سطح بيته، هو الحل المناسب لمثقف ولد وعاش في بيئة شعبية. فوق سطح البيت، يمكنه أن يؤسس لنفسه مكانًا خاصًا، ليعكف فيه على كتبه وكتاباته. يمنحه فرصة ليطل على الحياة من علٍ، ليؤكد نخبويته وتميزه عن سكان الحارة؛ لكن عاصفة عابرة تطيح بعشته، وتطيح بحلمه الرومانسي.
وفي قصة (عفريت) نجد بطلها (سيد دعبس) مثقفًا فقيرًا، كل رأس ماله في الحياة مجموعة من المعارف تغذي سموقه وتمنحه حق التميز الذاتي على الرغم من جذوره الشعبية، وهو مثل كل المثقفين، مفعم بالأحلام الكبرى ومن ثم يخلق سيناريوهات داخلية لا ترقى إلى مستوى التحقق أبدًا، لقد رهن حياته على نص مسرحي: “استغرق في إعداده العمر كله، نص هو بطله ومنتجه ومؤلفه ومخرجه والمتفرج الوحيد عليه في خياله، إنه أحد نصوصه السرية التي دأب على تأليفها في الآونة الأخيرة”[8]
لقد تحولت نصوص سيد دعبس إلى صيغة بديلة للحياة، واقع افتراضي يلوذ به عوضًا عن فشله في الواقع المُعاش. لكنه وهو المثقف العلماني الذي لا يؤمن بالميتافيزيقا والغيبيات، يظهر له عفريت حقيقي من الجن، يواجهه بحقيقة أن وجوده رهن بهذه الأحلام وأن لا وجود حقيقي له في الواقع خارج أحلامه. إن الفكرة التي تطرحها القصة لا تبتعد كثيرًا عن الرؤية التي تحكم مشروع خيري عبد الجواد، حيث يكون للمجازى قدرة على اختراق الحقيقي، وللميتافيزيقى قدرة على اختراق الفيزيقى، تمامًا كما للماضي قدرة على اختراق الحاضر، ليشكل تداخل المتناقضات أهم ملمح في عالم خيري عبد الجواد الثري.
وفي هذه المجموعة نجد قصة: (نزهة المشتاق إلى فضائل بولاق) والتي يتناص عنوانها مع كتاب (نزهة المشتاق في حدائق الأوراق)، ونرى من جديد ذلك المثقف، لكنه هذه المرة يحلم بأن يصنع تاريخًا للحي الذي يسكنه (بولاق الدكرور) فيلجأ لكتب التاريخ ويستعير منها عالمًا وهميًا يضفيه على المكان، غير أن كل ما يحققه يظل مجرد خيال لا يرقى إلى الواقع. بما يؤكد أن العلاقة بين الخيال والواقع هي الهم المشترك في قصص المجموعة على اختلاف موضوعاتها. وإذا التفتنا إلى أن صورة المثقف الحالم -في هذه القصص – تحيل إلى خيري عبد الجواد نفسه، على نحو ما تجلى بوضوح أكثر في رواية (كيد النسا).. فهذا معناه أن خيري يضع ذاته المبدعة في مواجهة عاصفة مع كتاباته في تلك المرحلة التي اقترب فيها من الواقع. وهو تغير هام في علاقته بالتراث. وربما لهذا السبب انهمكت قصة (نزهة المشتاق) وبطلها في البحث بين كتب التراث عن هوية المكان (بولاق الدكرور) والتي تصبح معادلاً لهوية بطل القصة نفسه، فكلاهما مهمش في المكان ومن ثم فإن البحث في التاريخ بمثابة مواجهة فاضحة بين الزمان والمكان. في هذا السياق المفرط في البحث بين كتب التراث لبطل القصة، يشير الناقد شوقي عبد الحميد إلى خفوت البناء السردي فيها، فيقول:”القصة أقرب إلى المقال منها إلى القصة القصيرة، لا تحمل منها إلا خيط رفيع جدًا”[9] الحقيقة أن القصة مطعمة بكثير من الشروح والحواشي والتحقيقات، تلك هي التقنية التي اختارها الكاتب لتصوير ولع بطلها بالبحث عن ذاته وإدراك هويته المشوهة في مجتمع عشوائي. تلك هي أزمة (سيد دعبس) المثقف انتهي إلى حال من العزلة والاغتراب.
يرى (شوقي عبد الحميد) أن محاكاة الإجراء البحثي وتقنياته في القصة، أدى إلى تصدع البناء المحكم الذي رأيناه في قصة العشة من نفس المجموعة. وظني أن هذا صحيح، لكن الكاتب كان منذ البداية يستهدف تفكيك البنية المحكمة للسرد القصصي، ربما على سبيل المحاكاة للواقع الداخلي لسيد دعبس نفسه، وبيئته العشوائية. لكن هذه الطريقة في البناء السردي دعمت رغبة الكاتب في مقاربة أشكال غيرية عرفها السرد العربي، لم تنصت كثيرًا لمفهوم البنية المحكمة الذي عرفته القصة الحديثة بخضوعها لأنساق عقلانية أفضت إلى تنميطها. ولربما زادت جرعة التفكيك في هذا العمل، ليس لمناسبة موضوع البحث عن هوية بطلها فحسب، بل لحرص الكاتب على اعتماد الهوامش والشروح والحواشي بوصفها تقنيات بحثية، تضفي على السرد ملمحًا وثائقيًا، تعضد اعتقادنا بأن ما نقرأ هو وقائع حقيقية، إنها طريقة واعية، تستهدف اللعب بمشاعر القارئ وخلخلة يقينه، على نحو أشبه بما فعله بريخت في المسرح ليخرج المتفرج من حالة الاستسلام التام لسحر الحكاية إلى التفكر فيها وتأملها، بل ومحاكمتها.
فيما بعد، رأينا كيف استطاعت ثيمة البحث في التاريخ أن تقدم لنا نمطًا جديدًا لما تعارفنا عليه بالرواية المعرفية، على نحو ما نجد عند (أمبرتو إيكو) في رواية (اسم الوردة) حيث تحولت فيها ثيمة البحث عن (من القاتل) التي التزمت بها الرواية البوليسية، إلى بحث معرفي في التاريخ الكنسي، وهو ملمح أصبحنا نجده الآن في الرواية العالمية على نحو واسع عند (دان بروان وأورهان باموق) وليس لدي يقين أن (خيري عبد الجواد) كان يستهدف ثيمة البحث المعرفي، غير أن مغامرة التجريب التقني التي خلخلت البناء المحكم للقصة كما يقول الناقد (شوقي عبد الحميد) يمكنها أن تقود الكاتب إلى إدراك مبكر لرواية المعرفة. لهذا أعتقد أن رواية (كيد النسا) اقتربت كثيرًا من هذا المعنى، فهي في المجمل تنهض على ثيمة البحث في المكان والزمان/ التاريخ، من خلال اقتفاء الأثر التراثي لتاريخ (بولاق الدكرور) المنسوبة إلى أحد أولياء الله الصالحين.
وتأتي روايته (كيد النسا)[10] تأكيدًا على تنامي هذا الملمح البحثي في وعي خيري عبد الجواد، والجدير بالذكر أن خيري خاض تجارب مشهودة في جمع وتحقيق، وتحليل كتب تراثية مثل: (سيرة على الزيبق المصري، القصص الشعبي التي صدرت في ثلاثة أجزاء، الزير سالم) بما يومئ بأنه كان يعد نفسه لامتلاك أدوات البحث التراثي إلى جانب الإبداع ليكتمل مشروعه، فلا غرابة أن نجدهما معا في رواية أو مجموعة قصصية. بل نرى أن هذه بادرة كانت كفيلة بنقلة نوعية في الرواية التاريخية التي مازلت تمتثل لاستعارات متكررة من وقائع التاريخ. لكن أهم ما يميز رواية (كيد النسا) هو توازنها الدقيق بين معطيات تراثية ذات سمت بحثي، والواقع المعاش في صورته المعاصرة، فأفضت إلى سمات أسلوبية مميزة، تمزج بين الشفهي والكتابي، وبين التأليف الأدبي والسيرة الذاتية، وبين الواقع والخيال.
كيد النسا عنوان مستلهم من قصيدة تنسب للشاعر الشعبي ابن عروس: (كيد النسا يشبه الكي.. من مكرهم رحت هارب.. يتحزموا بالحنش حي.. ويتعصبوا بالعقارب) . وابن عروس نفسه، شخصية تراثية غير موثقة الزمان والمكان، والغالب أنه عاش بين مصر والمغرب وتونس. ويعتقد إنه كان قاطع طريق، وقع في العشق، فتاب على يدي معشوقته وأناب، وتغنى بالحب والحكمة حتى بلغ – في الضمير الشعبي- مرتبة الأولياء، ومازالت قصائده ملهمة للمبدع الشعبي ولا سيما فني الواو، والمربعات.
الشخصية الرئيسة (نور الدين) في رواية كيد النسا، مستلهمة من شخصية ابن عروس. فنور الدين بدأ حياته ضالًا و(قاطع طريق) لكنه انتهي وليًا، له مقام/ ضريح في حي بولاق الدكرور، ويُحتفل بمولده كل عام. وثمة احتمال آخر، أن اسم نور الدين نفسه، مستلهم من الولي المغاربي (نور الدين علي بن نور الدين محمد ابن البرنس) الذي بنى المسجد المعروف الآن بمسجد (أبو العلا) والكائن في حي بولاق أبو العلا على ضفة النيل المقابلة لبولاق الدكرور. غير أن الرواية الأقرب للدقة، أن بولاق الدكرور منسوبة إلى الشيخ (أبو محمد يوسف بن عبد الله الدكروري). وهذا يكشف لنا وعي خيري عبد الجواد بالفارق بين طبيعة البحث التاريخي على نحو ما استخدمه في تحقيق سيرة (الزير سالم ) وبين البحث السردي الذي تلتبس فيه الحقيقة بالخيال. إذ كانت معارفه التراثية الواسعة، تمكنه من التحرك في التاريخ والجغرافيا على نحو خلاق. فهذا الحراك والتلبيس والتشابه، من سمات الحكاية الشعبية، ولاسيّما حكايات الأولياء. فليس ثمة مراجع ولا مصادر يمكن الاحتكام إليها على نحو قاطع، وليس من مهمة المبدع تحقيق الحكايات. فكما نرى، فإن حكاية (ابن عروس) التي استلهمها لرسم صفات (نور الدين) هي نفسها محل خلاف كبير بين المصريين والمغاربة، لدرجة أن الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي، يعتبره شخصية خيالية لا أصل لها، اعتمادًا على فكرة التشابه مع غيرها من حكايات الأولياء، التي عادة ما تبدأ بالعصيان وتنتهي إلى التوبة. وغالبًا ما يكون الجنس هو مناط العصيان عند النساء في الثقافة الشعبية، فيما يكون عند الرجال بقطع الطريق.
ببعض الحيل الفنية، ينجح المؤلف في أن يجعل سيرة نور الدين معادلاً ثقافياً لسيرة المكان، الذي هو حي بولاق الدكرور؛ لكن المؤلف لا يكتفي بذلك، بل يجعل نفسه شاهدًا على هذه السيرة، أو جزءًا منها. والنتيجة أن الرواية تتحرك حول ثلاثة محاور رئيسة (سيرة المكان ـ سيرة نور الدين ـ سيرة خيري عبد الجواد نفسه ممثلاً في شخصية الباحث) وبالطبع يستطيع السرد أن يتحرك ببساطة بين المحاور الثلاثة، أي أنه ينتقل من مستوى الخطاب الشعبي إلى مستوى الخطاب الشخصي أو الذاتي، فيمزج بين واقع الحكاية الشعبية بطابعها الغرائبي وعمقها التراثي، والواقع المعاش في حيزه الزمني الآني.
والراوي في هذه الرواية، يتميز بحضور كثيف، سواء في صورته التقليدية كراوٍ ضمني في الرواية وشاهد على أحداثها، أو في صورة الباحث، وهي الصورة الأقرب لتجسيد شخصية خيري عبد الجواد الذي نعرفه، بوصفه باحثًا في الثقافة الشعبية. ينجح خيري عبد الجواد أن يجعل سيرته الشخصية جزءًا من السيرة الشعبية لولي الله نور الدين، الذي يصبح ضريحه – في الرواية- علامة على تاريخ المكان وشاهدًا عليه، بعد أن تغيرت معالمه بطغيان المدنية والتطور، ليعيش الناس أسطورة الحداثة، وينسون ـ تماماً ـ أساطيرهم التي صنعوها بأنفسهم .
وهنا يأتي دور الراوي الضمني منعشًا للذاكرة الشعبية، وحافظًا لتراثها وهويتها. يتجسد هذا الدور في ضخ الحكايات الشعبية التي ارتبطت بشخصيات الرواية، منها حكاية (بديعة) التي سحرت الشاب نور الدين حتى يقع في غرامها، ونجحت في أن تحيله من قاطع طريق إلى ولي صالح. وكانت قد رأت ما بداخله من قوة وسموّ فآمنت به وجعلت مهمتها جلاء بصيرته، ولا يعني هذا أن ترويض الرجال مهمة نسوية في الثقافة الشعبية بل العكس تماما. إذ كان (خيري) يدرك بوعي تنويري، أن جزءًا من مسئولية المبدع الذي يستلهم التراث، تفكيك الابنية والمعتقدات التي رسخت فيه عبر الزمن. لهذا فشخصية (بديعة) بطلة (كيد النسا) أقرب إلى شهرزاد ألف ليلة، إذ تمثل كيدها في أنها أحبت (نور الدين) فكان الحب هو سبيلها لترويضه. إن المفارقة التي تجسدها الرواية تنشأ بين عنوانها (كيد النسا) والدور الذي قامت به (بديعة) لهداية قاطع طريق. إنها مفارقة مقصودة لتلفت انتباهنا إلى أن خيري عبد الجواد، على قدر ما يستعير أو يستلهم، من التراث، فهو على درجة من الوعي بمخاطر هذه المغامرة عندما رد على المحاور الصحفي:”السؤال.. كيف تنظر لهذا التراث؟ فإذا انبهرت به فسوف تقع في غوايته ولن تستطيع التخلص منه وسوف يقودك هو.. أما إذا نظرت إليه عن بُعد نظرة محايدة فسوف تستطيع أن تتخذ موقفًا منه إما بالضد أو مع”[11]
وهنا يمكننا مراجعة سؤال إدوار الخراط في معرض تقديمه لمجموعة قصص الديب رماح: هل هذه الكتابة حكايات شعبية أم قصص حداثية؟ لنضع في المقابل سؤالاً آخر: هل يمكن لمبدع يستلهم الحكاية الشعبية، أن يتخلص من وعيه الحداثي؟ الكاتب ابن عصره بالضرورة. وهو عندما يستلهم الماضي لا يحاكيه، ولا يتماهي فيه، بقدر ما يعيد إنتاجه على نحو فني مكتنز بدلالات عصره.
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الروايات التي استلهمت الحكاية الشعبية، جعلت منها مجرد أداة يمكن توظيفها في النص السردي، ليكتنز بمزيد من الغرائبية والتشويق والإثارة. دونما التفات إلى المعنى البحثي والتحليلي لخطاب الحكاية الشعبية. لكن خيري عبد الجواد، لا يتعامل مع التراث بوصفه موضوعًا غنائيًا بديلا للنوستالجيا، ولا يقتات على التراث لمجرد الإفادة منه لتوسيع فضاء النص، أو إشعال خيال القارئ. صحيح هو يدرك أن الحاضر يحمل جينات من الماضي، لكن هذه الجينات تمر بتحورات وفقًا لمراحل التطور الحضاري لكل مجتمع. إن الماضي لا يسكن عاداتنا وتقاليدنا فحسب، بل يسكن طرائق تفكيرنا وهذا هو الخطر الأكبر، ومن ثم فعلى المثقف المتعامل مع التراث أن يكون على درجة من الوعي بالمسافة الحضارية بينه وبين الماضي.
كان خيري عبد الجواد سابقًا لعصره، ونحن الآن، نشهد تعاظم دور الخيال الغرائبي في الرواية بين الكتاب الشباب، غير أن الغالب عليها مستلهم من مخيلة السينما الأمريكية. من أفلام الرعب، والزومبي، والفامباير والمتحولين والكائنات الفضائية والألغاز البوليسية. إنه مجرد تقليد لخطاب ليس له أيه جذور في واقعنا المعاش، بما يضاعف من حجم اغترابنا عنه.
ــــــــــــــــــــــــــ
[1] – العاشق والمعشوق هو عنوان رواية لخيري عبد الجواد، صدرت (2009م) عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر، نتوارى خلف هذا العنوان، لنلمح إلى عشق خيري عبد الجواد للتراث.
[2] – إدوارالخراط: مقدمة المجموعة القصصية (حكايات الديب رماح) – الهيئة العامة للكتاب – القاهرة – 1987م
[3] – هـ. ب. تشارلس: فنون الأدب -ترجمة (زكي نجيب محمود) – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 2011م
[4] – فرانك أكونورو: الصوت المنفرد – ترحمة (محمود الربيعي) – مقالات في القصة القصيرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب -القاهرة -1993م.
[5] – جورج جحا: جديد خيري عبد الجواد -مقال نقدي – موقع إيلاف – الأحد 12 مارس 2006م جديد عبد الجواد: كيدالنساء
[6] – خيري عبد الجواد – حوار بجريد القبس الكويتية – بتاريخ 16/2/2006م
[7] – عصام استاتي: اللغة المصرية الحإلىة – الهقيئة المصرية العامة لقصور الثقافة – القاهرة- 2016م
[8] – خيري عبد الجواد: قرن غزال (قصص) – سلسلة الأعمال الكاملة -الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة -2014م.
[9] – شوقي عبد الحميد: الأحلام المحبطة في قرن غزال (مقال نقدي) – منتديات أزاهير الأدبية- 20/1/ 2008م
[10] – خيري عبد الجواد: كيد النسا (رواية) -دار الآداب – بيروت -2006م
[11] – خيري عبد الجواد: حوار بجريدة القبس – سابق

 sadazakera.wordpress.com
sadazakera.wordpress.com
أما تجربةخيري عبد الجواد في استعادت الخيال، وأكدت مكانته في الأدب المصري. ربما بدا هذا على استحياء مع أول قصة نشرت له عام 1981م، ثم تأكد مع مجموعته القصصية الأولى ( الديب رماح) التي استعانت بطرائق لعب الأطفال الموروثة عبر تاريخ يمتد إلى القدماء المصريين، ويتجلى في بعض المفردات الهيروغلفية كما في طقوس الاحتفال بمقدم هلال رمضان، أو في حالات سقوط الأمتار عندما ينشد الأطفال فرحا، يا مطرة رخي رخي.
كان خيري راغبًا في طي صفحة الماضي بكل نجاحاته وإخفاقاته. وكانت الحياة الثقافية شأن كل حياة المصريين، قد دخلت منعطفًا مظلمًا بعد نكسة 67. منعطف كثقب أسود، اتسم باهتزاز اليقين، ونظرة غاضبة إلى الوراء، ونزعة تشاؤمية عبر عنها الابنودي بأغنية «عدى النهار .. والمغربية جايه .. تتخفي ورا ضهر الشجر».
ربما هذه المعاناة هي التي دفعت تجربة هذا الجيل ( الثمانينيات) إلى نضج مبكر. بدأت معالمه تظهر بعد تحرير التراب المصري، برغبة ملحة في طي صفحة الماضي، والبحث عن معنى جديد للكتابة.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&client=ca-pub-9338910329340117&output=html&h=280&adk=2008785037&adf=2570672128&pi=t.aa~a.3987509640~i.5~rp.4&w=804&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1708424951&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=7328216920&ad_type=text_image&format=804×280&url=http%3A%2F%2Fwww.alkalimah.net%2FArticles%2FRead%2F23434&fwr=0&pra=3&rh=200&rw=804&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1708424951124&bpp=4&bdt=2257&idt=-M&shv=r20240215&mjsv=m202402120101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc2e7f4820ad1cc20%3AT%3D1708424901%3ART%3D1708424901%3AS%3DALNI_MYTy9_22RU0gLYbhFY1b8G47r0gww&gpic=UID%3D00000d5cdc287930%3AT%3D1708424901%3ART%3D1708424901%3AS%3DALNI_MYs5uCUTlX9IfB7fuWfmQI6fi3Kjw&eo_id_str=ID%3De9c22767ea289d73%3AT%3D1708424901%3ART%3D1708424901%3AS%3DAA-AfjaO52zR9sqd_Drr9n1ovSd-&prev_fmts=728×90%2C0x0&nras=2&correlator=3913590154259&frm=20&pv=1&ga_vid=1071211311.1708424902&ga_sid=1708424950&ga_hid=1576055265&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=1&u_h=768&u_w=1366&u_ah=720&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=1&adx=396&ady=1001&biw=1303&bih=646&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C44759837%2C44808397%2C31081222%2C44719338%2C44795921%2C95324580%2C95325066%2C31081135%2C95322195%2C95324154%2C95324160&oid=2&pvsid=3029581654190808&tmod=766905036&wsm=1&uas=0&nvt=1&fc=384&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C720%2C1318%2C646&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=23&bz=1.04&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&dtd=221
في الواقع، كانت الثمانينيات محطة للتجريب والبحث عن مذاق أدبي جديد. كنا قد انتهينا لتونا من حربين (67 -73) تركتا آثارًا فادحة على الواقع المصري. ندرك أن الشعارات الثورية لم تعد كافية لرأب الصدع الذي أصاب المجتمع، وشرخ نفوسنا من الداخل. فكان ثمة ضرورة لجيل بعضه ينظر إلى الوراء بغضب، وبعضه نجا من جبهات القتال بروح منطفئة غايتها الهجرة إلى دول الخليج، والبعض الآخر انهمك في اتجاهات الإسلام السياسي. باختصار لم تكن نكسة 67 مجرد هزيمة عسكرية، بل كانت هزيمة لحلم قومي أكبر منا. ومع ذلك فإن هذا الجيل لم يسلم من هجمات مرتدة مارسها بعض من كبار المثقفين العائدين من المنافي، ليعيدوا إنتاج مشروعهم اليساري وكأن لاشيء في الواقع تغير أثناء غيابهم.
هكذا جاء الحكم القاسي بإسقاط جيل كامل من تاريخ الأدب المعاصر. على أيه حال، لقد وضعت التسعينيات نهاية للعرض بإسدال الستار على كل ما مضى، برغبة في إنشاء حظيرة ثقافية تسع الجميع. حظيرة مشيدة على نحو طبقى، بنيتها التحتية الفقيرة تبدأ من نوادي الأدب بالأقاليم المهمشة أصلاً، وقمتها تحتمي ببيت أبيض كبير، نطلق عليه المجلس الأعلى للثقافة. إن هذا البناء الهيراركي للثقافة في تلك المرحلة، سمح بالكاد لكثير من المتميزين ثقافيًا وأدبيًا، أن ينتظروا على سلالم البيت الأبيض طويلاً، أملاً أن يسمح لهم بالصعود. وظني أن كثيرًا منهم مات، وهو ينتظر.
****
رغم عمره القصير، كان خيري عبد الجواد يطاول الكبار في غزارة إنتاجه وتنوعه وتفرده، وربما لو أطال الله في عمره حتى الآن، لبز بعضهم، ولكان يتربع على عرش السرد باستحقاق بعد رحلة النضج التي قطعها بدأب. غير أن المنايا كانت للفتي رصد؛ فقدناه في مطلع 2008م، وهو نفس العام الذي كنت فيه أمينًا عامًا لمؤتمر أدباء مصر في الأقاليم المنعقد بمدينة مرسى مطروح، ولم يكن لدينا ما نفعله غير أن نكرم اسمه بعد أن رحل عنا. في الواقع، قائمة الراحلين من جيله كانت كبيرة. فثمة سابقين عليه، وثمة لاحقين، وثمة من ينتظر على السلالم.
لا شك عندي أن التسعينيات شهدت صحوة ثقافية، لكن المؤكد أن طلائعها كانت من كتاب الثمانينات وعلى رأسهم خيري عبد الجواد. ولعل مراجعة متأنية لإنتاج النصف الأول من عقد التسعينيات، تشهد بنضج تجارب أدبية بدأت خطواتها الأولى في الثمانينيات، حيث اتسمت بالتنوع، والمغامرة، وروح التجريب. أسلمُ بأن شهادتي – كواحد من جيل الثمانينيات – عن خيري عبد الجواد قد تكون مجروحة نظرًا لصلة الصداقة القوية بيننا. ولكن هذه الصلة، جعلتني على يقين بهذا الاستحقاق، فقد قاربت توقده، وكنت شاهدًا على فيض الإلهامات التي تتفجر من مخياله السردي، وعمق اشتغاله الثقافي على مشروعه. الذي واكب شيوع واقعية ماركيز السحرية، فأسرت كثيرًا من كتاب هذه المرحلة، وما زالت تترك آثارًا شاحبة عند البعض من جيل التسعينيات.
هكذا كان خيري عبد الجواد رمزًا على تجربة ناجحة، ونادرة في مقاربة التراث، واستلهام مخياله الغرائبي. إذ نشأ في أشهر البيئات العشوائية التي تكونت على جوانب القاهرة في نهاية الستينيات، حي (بولاق الدكرور) هو نفسه يعترف بأن هذه النشأة، فضلاً عن تعليمه المتوسط، كانا دافعين قويين لينبهر بالمخيال الشعبي. يكتشف كم هو ثري وجدير باحترام النخب الثقافية. لكنه لم يتوقف عند حد الانبهار، والمحاكاة البسيطة للموروث كتلك التي نجدها في مجموعته الأولى (الديب رماح) بل راح ينهل بنهم من أعماق التراث الشفهي والمكتوب، يطور من أدواته، ويوسع من معارفه. كان أول ما لفت انتباهي في زيارتي الأولى له، هذا الكم الهائل من نفائس الكتب التراثية. في ذلك الوقت، وفي مناخ يلوح بسلفية مخيفة تتفشى في المجتمع، كان التراث موسومًا بالرجعية بين النخب الثقافية. ربما هذا ما دعا إدوار الخراط للتردد، متسائلاً في مقدمة الكتاب الأول لخيري عبد الجواد: هل هذه الكتابة حكايات شعبية أم قصص حداثية؟ وخلص في نهاية الدراسة إلى أنها قصصًا حداثية تمتح من بئر الخرافة الشعبية[2] إنه تساؤل عجيب وغير مبرر ولا يفضي إلى معنى، بقدر مايضمر احتجاجًا.
في فنون الأدب، ومجالات المعرفة المختلفة، نزع العرب إلى الأشكال الحرة أو المفتوحة، التي لا تلتزم بنية معيارية كما كان الحال في الدراما الإغريقية. هذه الرؤية الموسوعية للمعرفة سمحت للقدماء بالتنقل بين الفنون والموضوعات وطرائق التعبير المختلفة كما نجد في كتب الأغاني، والإمتاع والمؤانسة، وغير ذلك من كتب التجوال الحر في فضاء تخيلي كما في (ألف ليلة وليلة) التي تتضمن -داخل الحكاية الإطار- عدة حكايات صغرى لا ترتبط بمبررات فنية ومنطقية، وتتجاوز حدود الأمكنة والأزمنة. إذ يكفي اختلاق أي مبرر لينهمر المتخيل السردي مستفيدًا بالمعطيات الثقافية كافة، فالشعر والحكمة والتاريخ وفقه الدين، كما في حكاية الجارية تودد التي ألمت بكل علوم الدين والدنيا.
في أوروبا، نجد فن الرومانس الذي يتناول حكايات الفرسان ومغامراتهم، وفن والبكارسك الذي يتناول حكايات الشطار والمحتالين، اعتمادًا على بنية كلية، موزعة على حكايات صغرى. وظلت هذه البنية المرنة ملمحًا مميزًا للسرد حتى في أكثر الأعمال اكتمالاً ونضجًا مثل: ديكامرون بوكاتشيو، ودون كخوتة لسيرفانتس، ورحلة الحاج لجون بينان، التي تدور في عوالم النفوس والأرواح، وحكايات كانتربري لتشوسر وروبنسون كروزو لدانيال ديفو. كما أن الرواية الحديثة عند كبار الكتاب أمثال:ديكنز، ودويستيوفسكي وإميل زولا، الذين نشروا رواياتهم مسلسلات في الصحف اليومية، نزعوا إلى هذه البنيات البسيطة لتمرير الخيال، بغرض اجتذاب القراء، وتشويقهم إلى متابعة ما يكتبون. لكن هذه البنيات على بساطتها تحتاج ساردًا خصب الخيال واسع المعرفة.
ما نعنية، أن الخيال نفسه كان طريقًا للمعرفة. فالأساطير الأولى، كانت طريقة الإنسان الأول لتفسير وفهم واقعه المسكون بالغموض والخوف، ومنها خرجت كل المعارف الأولى والتي مازال بعضها راسخًا في الوجدان البشري، ويتجلى في خطابات مثل: الأحلام، والأديان، والفنون، والآداب. وبطبيعة الحال، فالثقافة العربية لها نصيبها في هذا التراث الإنساني المرتبط بعصور الشفاهة، وظلت آثاره ماثلة فيما بعد التدوين. ونجدها في فنون الأدب العربي بصور وأشكال مختلفة.
ربما نظرًا لاقتراب فن (المقامة) من أحوال البشر ومظاهر الواقع الإنساني، وتخلصها النسبي من الخوارق والعوالم الغيبية، اعتبرها البعض بدايات عربية لفن القصة القصيرة الذي نكتبه الآن. لكن مع سطوع الحداثة الأوربية، وغلبة التخصص العلمي، حرصت نظريات الأدب على وضع ضوابط إجرائية تحدد ماهيات الفنون. وفي هذا السياق يحذر هـ. ب.تشارلتن من الخلط بين الحكاية في صورتها التراثية والقصة القصيرة في معناها الحداثي، فيقول:”سيبدو لك ما زعمه مؤرخو الأدب أمرًا عجيبًا, لأنك في أغلب الظن ستخلط بين الحكاية والقصة, وسترجع بخيالك إلى أعمق أعماق الماضي السحيق لتري الناس يروون الحكايات كلما كان فراغ، ودار في حلقات السمر حديث, ثم تقول وهذه قصص العرب, وألف ليلة وليلة, وهي كلها أسبق من هذا التاريخ الذي زعمه مؤرخو الآداب بداية للقصة, لكنك أنسيت خصائص القصة بمعناها الصحيح, فليست كل تلك الحكايات الأولي قصصًا, لأنها تفقد أخص خصائص القصص, فما هي صادقة في تصوير الحياة, ولا هي تتعقب أجزاء الحادثة الواحدة تحليلاً حتى تبلغ أقصي مداها, وإنما هي حكايات ولا تنسى قط وأنت تطالعها أنك في عالم من الخيال”.[3]
نفهم من كلام (تشارلتن) حرصه على الوحدة الفنية لبناء القصة الحديثة. كما نفهم ضرورة التزام القصة الحديثة بتصوير جوانب الحياة الإنسانية، وخلوصها من موضوعات الخوارق والغيبيات التي كانت موضوعًا للحكايات القديمة. لكن (فرانك أكونورو) يضيف بعدًا آخر، فيقول:”يمكن أن نرى في القصة القصيرة اتجاهًا عقليًا يجتذب جماهير الجماعات المغمورة علي اختلاف الأزمنة وأن الرواية مازالت بالفكرة التقليدية عن المجتمع المتحضر”[4]. يضيف (اكونورو) شرطًا للسرد القصصي والروائي، وهو الالتزام بقضايا الجماعات المغمورة، وهذا التزام أيديولوجي وليس التزامًا فنيًا. وقد وجد في تشيكوف نموذجًا جيدًا للواقعية الاجتماعية ونزعتها النقدية. غير أن كلامه عن الاتجاه العقلي يفضي إلى تجفيف القصة من الخيال. وفي غمار الالتزام بالواقع وقضاياه، بالغت القصة في التخلص من التشكيل الخيالي سواء في موضوعاتها أو لغتها، حتى تحولت في كثير من الأحيان إلى مجرد رسائل تحمل فكرة، أو تحريض على موقف سياسي، وفي سبيل الرسالة نضحي بكل لمحات الخيال والجمال الفني. فيما ظلت الرواية بسبب بنيتها الأكثر اتساعًا فضاءً لمستويات عديدة من السرد، لكنها في عقيدة اكونورو فكرة تقليدية لا تواكب المجتمع المتحضر، مع ملاحظة أن صورة المجتمع المتحضر عنده، هي المجتمعات المغمورة!!
في تقديري أن استدعاء القصة لميدان الصراع الأيديولوجي في القرن العشرين هو الذي أفضى إلى تثبيت نموذجين متناقضين: نموذج تشيكوف الذي يركز على نقد الواقع وفضح تشوهاته، في وحدات قصيرة ومكثفة للحدث بتداعيات وحدتيه المكانية والزمنية. في مقابل (إدجار آلان بو) ونزعته الخيالية السوداء، حتى اشتهر بأنه مؤسس قصص الرعب والتحري، ففتح بابًا لأدب الإثارة والمغامرات الذي نُظر إليه من وجهة النظر الواقعية على أنه أدب تسلية، ولا يصب في تغيير الواقع الاجتماعي. لقد اكتسب المخيال الغرائبي سمعة سيئة تحت وطأة الحداثة. وظني أن هذا موقف أيديولوجي فحسب، فقصص (بو) لا تخلو من نماذج إنسانية متفردة، كما أن النزعة الإنسانية تسكن قصص تشيكوف بوضوح، حتى عندما تلتزم الواقعية النقدية تظل مطرزة بخيال ينبض بالحياة وتفاصيلها. لقد كان السرد طوال الوقت هو خطاب الإنسان إلى ذاته. وبين واقعية تشيكوف وغرائبية (بو) تأتي كتابات (جوجول-1809) ليس بين الواقع والخيال فحسب، بل بين القصة والرواية أيضًا، ففي الوقت الذي تحفل فيه بحياة البسطاء من الفلاحين وتصور معاناتهم تفيد من خيالهم الشعبي وحكاياتهم الغريبة بنبرة متعاطفة لا تخلو من طابع تهكمي على نحو ما عكسته (أمسيات قرب قرية ديكانا). وعلى الرغم من مأساوية حياة (أكاكي) بطل قصة (المعطف) بل ونهايتها، والتزامها بقضايا الواقع المعاش في روسيا، إلا أنها اتشحت بلمسات تخيّلية، بحيث بدت كأمثولة دالة على الواقع وليست محاكاة نقدية له. ولعل هذه الوضعية البينية عند (جوجول) سمحت بظهور أشكال وسيطة بين القصة والرواية، فظهرت كتاباته في شكل النوفيلا، ليس بوصفها رواية قصيرة، بل بوصفها فضاءً لقصص تتجاور وتتداخل وقعائها وشخصيايها بقدر من بالخيال، وطابع أمثولي أكثر اتساعا من الواقعية النقدية. حتى أطلق علي سرديات جوجول (الواقعية الخيالية) وهو مصطلح تتداخل أصداؤه مع الواقعية السحرية، وكان (بورخيس) من أبرز الذي رفعوا شعار الفن للفن، الذي يمثل نزعة احتجاجية ضد جر الأدب إلى غايات مُسيّسة.
وظني أن حركات المد الثوري التي شهدها القرن التاسع عشر، وما تبعها من حراك سياسي أفضى إلى حربين عالميين مع بداية القرن العشرين، فضلاً عن حرب باردة ومؤدلجة استمرت حتى التعسينيات، كل هذه ظواهر جعلت المعنى السياسي حاضرًا بقوة في الخطاب السردي، ولا سيما في المجتمعات التي عاشت حراكًا ثوريًا للتحرر من تراث الكولونيالية. إلا أن الثمانينات في مصر شهدت احتجًاجًا صامتًا ضد غلبة المعنى السياسي، ربما يكون متأثرًا بالواقعية السحرية بعد فوز جارسيا ماركيز بجائزة نوبل، مشفوعا بآلية دعائية واسعة. غير أن خيري عبد الجواد كان أسبق كتاب جيله، عندما التفت إلى أهمية توظيف التراث الشفهي والمكتوب لخدمة مشروعه الغرائبي. ليصبح – مع الوقت – تيارًا يعبر عن نفسه في موضوعات مختلفة مثل:
موضوع المكان: كثير من الروايات التي اتخذت من الأماكن الطرفية/ المهمشة، راهنت على توظيف التراث الشفهي/ الحكائي، والممارسات الممثلة في العادات والتقاليد والأعراف والمعتقدات.
موضوع التاريخ: ولاسيما التاريخ الاجتماعي، حيث يمكن الإفادة من التراث الشفهي والمكتوب لتضفي على الواقع الاجتماعي مسحة تخيلية تستهدف تأكيد الامتداد التراثي، ومن ثمّ تأكيد الهوية الثقافية، والتاريخية للمجتمعات.
الموضوع الميتافيزيقي: الذي يرصد عالم المتصوفة المتميز في معجمه اللغوي المجازي، ليجسد خيالاً مترعًا بحكايات الأولياء وكراماتهم، وتجلياتهم المكتنزة بالخوارق والمعجزات. لكن الفضاء الميتافيزيقي مرن، ويمتد لأبعد من الفضاء الصوفي، إذ نراه في روايات الخيال العلمي، وروايات والألغاز والمغامرات المترعة بعوالم باراسيكولوجية وطوابع غرائبية أصبحت في الآونة الأخيرة هي الأكثر مقروئية بين الأجيال الشابة.
جاءت حكايات الديب رماح في نهاية الثمانينيات بمثابة مانيفستو يعلن – بشكل مضمر – عن احتجاج كتّاب هذه المرحلة على مفهوم (الالتزام) وتحديدة لقيمة النص بقوة الرسالة وأثرها في المتلقي. وما أن جاءت التسعينيات، حتى أصبح الخيال عنصرًا رئيسًا ومستهدفًا في السرد.
***
الطبيعة الخاصة للحكاية الشفهية، تعمل على تفكيك بنيتها تلقائيًا عبر كل رواية لها، فنحن نعرف أن الضرورة الشفهية تجعل الحكاية مفتوحة على رواه متعددين، يمكنهم الحذف أو الإضافة أو التعديل، فينتج عن هذا التكرار والتشابه والتداخل بين الحكايات. كما تصبح الحكاية الواحدة قابلة لاستقبال خطابات متعددة وربما متناقضة، قد تكون تاريخية فتميل إلى الإخبار والتوثيق والاستشهاد والإسناد، وقد تكون دينية، فتتحلى بالأحاديث والمدائح النبوية والسير العطرة حتى لو خرجت عن مسارها الموضوعي، وقد تكون أمثولات تنزع إلى استلهام العبر من قصص السلف، وقد تقارب الإنسان في طبيعته وغرائزه وواقعه الحسي فتميل إلى الابتذال والمجون، أو تفارق الواقع إلى الخيال الغرائبي فتستدعي حكايات عن السحر والجان وكرامات الأولياء، وقد تجمع بين كل هذا في فضاء واحد.
ربما، لهذه الطبيعة الرجراجة والمتداخلة للحكاية الشعبية، ذهب الناقد اللبناني (جورج جحا) إلى أن رواية كيد النسا لخيري عبد الجواد:”تشكل في صورة عامة تراكم حالات متشابهة متكررة وتبدو أحيانًا أقرب إلى دراسة اجتماعية “قصصية” عن السحر و”الكتابة”[5] وطقوسهما وعن الجنس الذي يفيض منها ”وأغلب الظن أن (جورج جحا) يرى السرد عبر مفهوم معياري لا يطمئن إلى مغامرات التجريب، وفاعلية الأصوات المتعددة للموضوع الواحد، تلك التي تستدعي خطابات من حقول معرفية مختلفة لتدور كلها في فضاء واحد.
لخيري عبد الجواد رؤية واضحة في علاقته بالتراث، مفادها أن الماضي لا يموت، لأن الزمن طاقة، والطاقة لا تفنى، وإنما تجدد نفسها في صور مختلفة. وجزء من وظيفة الكتابة مطاردة الزمن في صوره ووقائعه المختلفة، وإمعان النظر فيه وبهذا الوعي لا ينفصل الكاتب عن واقعه مهما أوغل في الماضي وأخيلته:”أنا دائمًا ما أتمثل هذا التراث لحظة الكتابة، وتبقى المشكلة أو السؤال: كيف تنظر لهذا التراث؟ فإذا انبهرت به فسوف تقع في غوايته ولن تستطيع التخلص منه وسوف يقودك هو.. أما إذا نظرت إليه عن بعد نظرة محايدة فسوف تستطيع أن تتخذ موقفًا منه إما بالضد أو مع”[6]
يعكس الشاهد السابق إدراكه لخطورة التغيرات والتحريفات المدخلة على الحكاية الشعبية، فنتيجة لتعدد رواتها، تتعدد في دلالتها حد التناقض أحيانًا. وعلى الكاتب أن يمعن النظر في كل حكاية، لتكون مناسبة للنسق الثقافي العام للنص. وليس من قبيل الصدفة، أن خيري عبد الجواد، أول ما رأي الماضي، لم يكن في كتب التراث، بل في ألعاب الأطفال، مع مجموعته القصصية الأولى (حكايات الديب رماح). ولعل استخدامه لكلمة (حكايات) بدلاً من (قصص) تشير إلى وعيه المبكر بطبيعة مشروعه السردي الذي بدأه في العشرينات من عمره، وأنهاه في الأربعينيات، تاركًا رصيدًا ضخمًا من القصص والروايات والأبحاث والتحقيقات التي تضيء التراث العربي من المنظور السردي.
يبدأ خيري المرحلة الأولى في منتصف الثمانينيات، وتنتهي بمجموعتين قصصيتين هما: (حكايات الديب رماح 1987، حرب أطاليا 1988) وفيهما لا يذهب إلى عمق التراث الثقافي فقط، بل إلى بدايات التكوين للذات المصرية، فيتوقف طويلاً أمام مرحلة الطفولة، في محاولة للكشف عن عمليات التواصل الثقافي عبر الزمن، التي تقوم أساسًا على الشفهية وتعكسها العادات والتقاليد والألعاب و المفردات التي تتسلل إلى المعجم اللغوي للأطفال. إذ تكشف بعض الدراسات الفولكلورية، أن بعض مظاهرنا الثقافية، مازالت تحتفظ بصياغات تراثية قد تمتد إلى العصور الفرعونية مثل: احتفالات السبوع للمولود، وأربعينيات الموتى، وأغاني الأطفال وألعابهم ولغتهم ومصطلحاتهم الخاصة. فمثلا: ألعاب الأطفال تحت ضوء القمر في صعيد مصر، رافقتها أغان ترجع جذورها إلى طقوس فرعونية لـ (تحوت) إله القمر، سواء في تمامه أو استقباله ووداعه هلالاً صغيرًا. لكن الطقس الفرعوني يتحول إلى سياق مختلف تمامًا؛ ففي ألعاب الأطفال خلال شهر رمضان، تصبح الفوانيس في مخيلة الطفل بمثابة أقمار صغيرة (أهلة) ويصبح اسمها (إيوحا) وهي كلمة ترجع إلى (إيحي) الإله الذي كان يصور على هيئة طفل. وهكذا فإن (وحوي يا وحوي .. إيوحا) التي يستقبل الأطفال بها هلال رمضان، متصلة باستقبال القدماء المصريين لطلوع إله القمر.”أننا نستقبل رمضان بلغتنا المصرية القديمة بقولنا وحوي يا وحوي إيوحا، وكذلك حلّو يا حلّو.. رمضان كريم يا حلو. كما عرفت أن أغلب ألعاب الأطفال وأغانيهم تبدأ بكلمات مصرية قديمة: سح يا بدح يا خروف نطاح، و يا مطرة رخي رخي، وحلاقاتك برجلاتك”[7] إن الموروث الثقافي الحي لأي مجتمع هو تجسيد لسيرورة الزمن وتحولاته، فالاحتفالات بالآلهة المصرية القديمة، تحولت مع المسيحية إلى احتفالات بالقديسين، ومع الإسلام إلى احتفالات بأولياء االله الصالحين.. وهكذا .
وإذا كانت البدايات عند خيري عبد الجواد تسترشد بالتراث الشفهي، فإن المرحلة الوسطى تعوَل كثيرًا على التراث المكتوب، ولكننا في كثير من الأحيان لا نجد فصلاً حادًا بين المكتوب والشفهي في سرده. ويكشف هذا عن تصوره للطبيعة اللامركزية في الحكاية العربية، وقدرتها على التجلي في أكثر من سياق، فالحكاية العربية لم تلتزم فنًا واحدًا ولا نوعًا واحدًا من الحكي، ولكنها تتجلى في فنون وآداب كثيرة مثل: السير والمغازي والقصص والأخبار والمقامات والطرائف، والمديح النبوي، وحكايات المتصوفة والأولياء وكراماتهم، الحواديت والأمثال الشعبية والحكم والمواعظ، وحتى قصص التاريخ والحديث والفقه بثّت الحكايات في ثناياها. وكثيرًا ما تنسب الأشعار والحكايات إلى شخصيات أو رواة مجهولين أو بأسماء مختلقة. هذا فضلاً عن أن كثيرًا من الكتب والمخطوطات التراثية، كتبت بلغة تمازج بين الفصحى وعامية زمانها ومكانها، وأفادت من لهجات عربية مختلفة، وهي المعروفة بلغة المولدين.
لقد أفاد خيري عبد الجواد من هذه الطبيعة المرنة والمتعدية للحكاية الشعبية، مقتفيًا لغتها وأساليبها وموضوعاتها وعالمها الغرائبي. وظهر هذا في أعماله التي شملت عقد التسعينيات، وحملت عناوين دالة على انشغالها بالتراث مثل: (كتاب التوهمات 1992م، العاشق والمعشوق 1995م، حرب بلاد نمنم 1997، مسالك الأحبة 1998، الجني 1999م). وخلال هذه المرحلة اشتهر خيري عبد الجواد كاتبًا له مشروعه الخاص والمميز بين كتّاب جيله. ثم رأي أن المرحلتين الأوليين استنفذتا طاقتيهما فيما يتعلق بالتراث وعالمه الغرائبي، فالتفت إلى واقع الحياة اليومية، مطعّمًا إياه بإحالات تراثية وفولكلورية، ومن ثم جاءت مرحلته الأخيرة بمثابة نقلة موضوعية مثلتها أعمال: (يومية هروب، 1999م – قرن غزال،2003م – كيد النسا،2006م- حارة أبو أحمد،2009- سلك شائك، 2010م). ويمكن ملاحظة الرغبة في مقاربة الحياة اليومية من العناوين السابقة.
فيومية هروب تستدعى سيرة ذاتية للكاتب نفسه، وتستدعى معها لغة عصرية شديدة الاحتفاء باليومي والمعاش، وما يدور على ألسنة الناس من ابتذالات وممارسات مغرقة في عفويتها وشعبيتها. ووسط كل هذا تتكون ذات ترنو لأن تحظى بقدر من السمو والرفعة لمثقف مأزوم يعاني قهرًا اجتماعيًاً واقتصاديًا. والواقع أن هذه النقلة لم تفارق الحكاية الشعبية وآليات سردها، ولكن يمكن القول إنها فارقت المرجعيات والاستلهامات التراثية، سواء في لغتها وتعبيراتها، أو في موضوعاتها، فلغته وموضوعاته أصبحت أكثر انتماءً إلى قضايا وهموم الإنسان في واقعة المعاش داخل بيئات حديثة ومهجنة؛ ولكنها تتعايش مع ما تبقى في الواقع من ثقافة شعبية.
على أية حال، فهذه النقلة، تعكس نُضجًا في تجربة خيري عبد الجواد، التي كانت قد انهمكت في الأثر التراثي لغةً ومعنى على نحو ما نجد في: (نزهة المشتاق في حدائق الأوراق، كتاب التوهمات، مسالك الأحبة). العناوين الثلاثة تستند إلى محاكاة صريحة للعناوين التراثية، بخلاف العناوين التي تومئ إلى الواقع المُعاش. وانتمت إليه في موضوعاته ولغته، ولكنها ظلت محافظة على البنية السردية المفتوحة المتعددة الجوانب والآفاق كونها الملمح الأصيل في الحكاية التراثية. وكان عبد الجواد أدرك أن بعض التراث لم يبق سجين زمنه، فمنه الذي انساب في الزمن، وذاب في الوجدان الشعبي بطرائق وصور تناسب الوعي المعاصر في لغته وموضوعاته. هذه النظرة للتراث تمثل نضجا لوظيفة التراث في الموضوع السردي المعاصر، مثل ثيمة المثقف المأزوم في رواية (يومية هروب) وفي مجموعته القصصية (قرن غزال) التي أفادت من لغة الحياة اليومية، وإن كانت مفعمة هذه المرة بسخرية شديدة ورغبة في مشاغبة أبطال قصصه. إذ كان بعض قصص هذه المجموعة، مستوحى من شخصيات حقيقية، منها صديقه (سيد دعبس) كما كان يروي عن نفسه على نحو ما نجد في قصة (العشة). مع ملاحظة أن قرن الغزال في الثقافة الشعبية المهجنة (العشوائية) لا علاقة بصورة الغزال في التراث العربي، بل هي سلاح شعبي (مدية)، كما أن الأزمات التي يواجهها مثقف (قرن غزال) هي أزمات الحياة اليومية المألوفة، وليست من قبيل القضايا الكبرى كتلك التي نجدها في رواية (زهور سامة لصقر) لابن جيله أحمد زغلول الشيطي. وعليه فإن ملمح السخرية ينسحب على المثقف ذاته، وعجزه عن التوافق مع بيئته، وعدم القدرة على احترام ثقافتها. حتى أن المواجهات البسيطة مع واقعه تكشف عن هشاشة ذاته، ومثالية مفرطة مفارقة للواقع. وهكذا لا تبدو أن صورة المثقف في كتاباته تستدر التعاطف بوصفها ضحية للواقع المعاش وأنظمة الحكم على نحو ما نجد عند (الشيطي ) بل على العكس. إن مثقف خيري عبد الجواد صورة مرتبطة بمثالية نخبوية مفارقة لواقعها. وهو يكشفها في محيطها الاجتماعي بنبرة تهكمية ليسمح للهامش الشعبي أن يتمركز في المتن بدلاً المثقف النخبوي.
فبطل قصة (العشة) تستدرجه رومانسيته فتصوّر له أن بناء عشة من البوص على سطح بيته، هو الحل المناسب لمثقف ولد وعاش في بيئة شعبية. فوق سطح البيت، يمكنه أن يؤسس لنفسه مكانًا خاصًا، ليعكف فيه على كتبه وكتاباته. يمنحه فرصة ليطل على الحياة من علٍ، ليؤكد نخبويته وتميزه عن سكان الحارة؛ لكن عاصفة عابرة تطيح بعشته، وتطيح بحلمه الرومانسي.
وفي قصة (عفريت) نجد بطلها (سيد دعبس) مثقفًا فقيرًا، كل رأس ماله في الحياة مجموعة من المعارف تغذي سموقه وتمنحه حق التميز الذاتي على الرغم من جذوره الشعبية، وهو مثل كل المثقفين، مفعم بالأحلام الكبرى ومن ثم يخلق سيناريوهات داخلية لا ترقى إلى مستوى التحقق أبدًا، لقد رهن حياته على نص مسرحي: “استغرق في إعداده العمر كله، نص هو بطله ومنتجه ومؤلفه ومخرجه والمتفرج الوحيد عليه في خياله، إنه أحد نصوصه السرية التي دأب على تأليفها في الآونة الأخيرة”[8]
لقد تحولت نصوص سيد دعبس إلى صيغة بديلة للحياة، واقع افتراضي يلوذ به عوضًا عن فشله في الواقع المُعاش. لكنه وهو المثقف العلماني الذي لا يؤمن بالميتافيزيقا والغيبيات، يظهر له عفريت حقيقي من الجن، يواجهه بحقيقة أن وجوده رهن بهذه الأحلام وأن لا وجود حقيقي له في الواقع خارج أحلامه. إن الفكرة التي تطرحها القصة لا تبتعد كثيرًا عن الرؤية التي تحكم مشروع خيري عبد الجواد، حيث يكون للمجازى قدرة على اختراق الحقيقي، وللميتافيزيقى قدرة على اختراق الفيزيقى، تمامًا كما للماضي قدرة على اختراق الحاضر، ليشكل تداخل المتناقضات أهم ملمح في عالم خيري عبد الجواد الثري.
وفي هذه المجموعة نجد قصة: (نزهة المشتاق إلى فضائل بولاق) والتي يتناص عنوانها مع كتاب (نزهة المشتاق في حدائق الأوراق)، ونرى من جديد ذلك المثقف، لكنه هذه المرة يحلم بأن يصنع تاريخًا للحي الذي يسكنه (بولاق الدكرور) فيلجأ لكتب التاريخ ويستعير منها عالمًا وهميًا يضفيه على المكان، غير أن كل ما يحققه يظل مجرد خيال لا يرقى إلى الواقع. بما يؤكد أن العلاقة بين الخيال والواقع هي الهم المشترك في قصص المجموعة على اختلاف موضوعاتها. وإذا التفتنا إلى أن صورة المثقف الحالم -في هذه القصص – تحيل إلى خيري عبد الجواد نفسه، على نحو ما تجلى بوضوح أكثر في رواية (كيد النسا).. فهذا معناه أن خيري يضع ذاته المبدعة في مواجهة عاصفة مع كتاباته في تلك المرحلة التي اقترب فيها من الواقع. وهو تغير هام في علاقته بالتراث. وربما لهذا السبب انهمكت قصة (نزهة المشتاق) وبطلها في البحث بين كتب التراث عن هوية المكان (بولاق الدكرور) والتي تصبح معادلاً لهوية بطل القصة نفسه، فكلاهما مهمش في المكان ومن ثم فإن البحث في التاريخ بمثابة مواجهة فاضحة بين الزمان والمكان. في هذا السياق المفرط في البحث بين كتب التراث لبطل القصة، يشير الناقد شوقي عبد الحميد إلى خفوت البناء السردي فيها، فيقول:”القصة أقرب إلى المقال منها إلى القصة القصيرة، لا تحمل منها إلا خيط رفيع جدًا”[9] الحقيقة أن القصة مطعمة بكثير من الشروح والحواشي والتحقيقات، تلك هي التقنية التي اختارها الكاتب لتصوير ولع بطلها بالبحث عن ذاته وإدراك هويته المشوهة في مجتمع عشوائي. تلك هي أزمة (سيد دعبس) المثقف انتهي إلى حال من العزلة والاغتراب.
يرى (شوقي عبد الحميد) أن محاكاة الإجراء البحثي وتقنياته في القصة، أدى إلى تصدع البناء المحكم الذي رأيناه في قصة العشة من نفس المجموعة. وظني أن هذا صحيح، لكن الكاتب كان منذ البداية يستهدف تفكيك البنية المحكمة للسرد القصصي، ربما على سبيل المحاكاة للواقع الداخلي لسيد دعبس نفسه، وبيئته العشوائية. لكن هذه الطريقة في البناء السردي دعمت رغبة الكاتب في مقاربة أشكال غيرية عرفها السرد العربي، لم تنصت كثيرًا لمفهوم البنية المحكمة الذي عرفته القصة الحديثة بخضوعها لأنساق عقلانية أفضت إلى تنميطها. ولربما زادت جرعة التفكيك في هذا العمل، ليس لمناسبة موضوع البحث عن هوية بطلها فحسب، بل لحرص الكاتب على اعتماد الهوامش والشروح والحواشي بوصفها تقنيات بحثية، تضفي على السرد ملمحًا وثائقيًا، تعضد اعتقادنا بأن ما نقرأ هو وقائع حقيقية، إنها طريقة واعية، تستهدف اللعب بمشاعر القارئ وخلخلة يقينه، على نحو أشبه بما فعله بريخت في المسرح ليخرج المتفرج من حالة الاستسلام التام لسحر الحكاية إلى التفكر فيها وتأملها، بل ومحاكمتها.
فيما بعد، رأينا كيف استطاعت ثيمة البحث في التاريخ أن تقدم لنا نمطًا جديدًا لما تعارفنا عليه بالرواية المعرفية، على نحو ما نجد عند (أمبرتو إيكو) في رواية (اسم الوردة) حيث تحولت فيها ثيمة البحث عن (من القاتل) التي التزمت بها الرواية البوليسية، إلى بحث معرفي في التاريخ الكنسي، وهو ملمح أصبحنا نجده الآن في الرواية العالمية على نحو واسع عند (دان بروان وأورهان باموق) وليس لدي يقين أن (خيري عبد الجواد) كان يستهدف ثيمة البحث المعرفي، غير أن مغامرة التجريب التقني التي خلخلت البناء المحكم للقصة كما يقول الناقد (شوقي عبد الحميد) يمكنها أن تقود الكاتب إلى إدراك مبكر لرواية المعرفة. لهذا أعتقد أن رواية (كيد النسا) اقتربت كثيرًا من هذا المعنى، فهي في المجمل تنهض على ثيمة البحث في المكان والزمان/ التاريخ، من خلال اقتفاء الأثر التراثي لتاريخ (بولاق الدكرور) المنسوبة إلى أحد أولياء الله الصالحين.
وتأتي روايته (كيد النسا)[10] تأكيدًا على تنامي هذا الملمح البحثي في وعي خيري عبد الجواد، والجدير بالذكر أن خيري خاض تجارب مشهودة في جمع وتحقيق، وتحليل كتب تراثية مثل: (سيرة على الزيبق المصري، القصص الشعبي التي صدرت في ثلاثة أجزاء، الزير سالم) بما يومئ بأنه كان يعد نفسه لامتلاك أدوات البحث التراثي إلى جانب الإبداع ليكتمل مشروعه، فلا غرابة أن نجدهما معا في رواية أو مجموعة قصصية. بل نرى أن هذه بادرة كانت كفيلة بنقلة نوعية في الرواية التاريخية التي مازلت تمتثل لاستعارات متكررة من وقائع التاريخ. لكن أهم ما يميز رواية (كيد النسا) هو توازنها الدقيق بين معطيات تراثية ذات سمت بحثي، والواقع المعاش في صورته المعاصرة، فأفضت إلى سمات أسلوبية مميزة، تمزج بين الشفهي والكتابي، وبين التأليف الأدبي والسيرة الذاتية، وبين الواقع والخيال.
كيد النسا عنوان مستلهم من قصيدة تنسب للشاعر الشعبي ابن عروس: (كيد النسا يشبه الكي.. من مكرهم رحت هارب.. يتحزموا بالحنش حي.. ويتعصبوا بالعقارب) . وابن عروس نفسه، شخصية تراثية غير موثقة الزمان والمكان، والغالب أنه عاش بين مصر والمغرب وتونس. ويعتقد إنه كان قاطع طريق، وقع في العشق، فتاب على يدي معشوقته وأناب، وتغنى بالحب والحكمة حتى بلغ – في الضمير الشعبي- مرتبة الأولياء، ومازالت قصائده ملهمة للمبدع الشعبي ولا سيما فني الواو، والمربعات.
الشخصية الرئيسة (نور الدين) في رواية كيد النسا، مستلهمة من شخصية ابن عروس. فنور الدين بدأ حياته ضالًا و(قاطع طريق) لكنه انتهي وليًا، له مقام/ ضريح في حي بولاق الدكرور، ويُحتفل بمولده كل عام. وثمة احتمال آخر، أن اسم نور الدين نفسه، مستلهم من الولي المغاربي (نور الدين علي بن نور الدين محمد ابن البرنس) الذي بنى المسجد المعروف الآن بمسجد (أبو العلا) والكائن في حي بولاق أبو العلا على ضفة النيل المقابلة لبولاق الدكرور. غير أن الرواية الأقرب للدقة، أن بولاق الدكرور منسوبة إلى الشيخ (أبو محمد يوسف بن عبد الله الدكروري). وهذا يكشف لنا وعي خيري عبد الجواد بالفارق بين طبيعة البحث التاريخي على نحو ما استخدمه في تحقيق سيرة (الزير سالم ) وبين البحث السردي الذي تلتبس فيه الحقيقة بالخيال. إذ كانت معارفه التراثية الواسعة، تمكنه من التحرك في التاريخ والجغرافيا على نحو خلاق. فهذا الحراك والتلبيس والتشابه، من سمات الحكاية الشعبية، ولاسيّما حكايات الأولياء. فليس ثمة مراجع ولا مصادر يمكن الاحتكام إليها على نحو قاطع، وليس من مهمة المبدع تحقيق الحكايات. فكما نرى، فإن حكاية (ابن عروس) التي استلهمها لرسم صفات (نور الدين) هي نفسها محل خلاف كبير بين المصريين والمغاربة، لدرجة أن الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي، يعتبره شخصية خيالية لا أصل لها، اعتمادًا على فكرة التشابه مع غيرها من حكايات الأولياء، التي عادة ما تبدأ بالعصيان وتنتهي إلى التوبة. وغالبًا ما يكون الجنس هو مناط العصيان عند النساء في الثقافة الشعبية، فيما يكون عند الرجال بقطع الطريق.
ببعض الحيل الفنية، ينجح المؤلف في أن يجعل سيرة نور الدين معادلاً ثقافياً لسيرة المكان، الذي هو حي بولاق الدكرور؛ لكن المؤلف لا يكتفي بذلك، بل يجعل نفسه شاهدًا على هذه السيرة، أو جزءًا منها. والنتيجة أن الرواية تتحرك حول ثلاثة محاور رئيسة (سيرة المكان ـ سيرة نور الدين ـ سيرة خيري عبد الجواد نفسه ممثلاً في شخصية الباحث) وبالطبع يستطيع السرد أن يتحرك ببساطة بين المحاور الثلاثة، أي أنه ينتقل من مستوى الخطاب الشعبي إلى مستوى الخطاب الشخصي أو الذاتي، فيمزج بين واقع الحكاية الشعبية بطابعها الغرائبي وعمقها التراثي، والواقع المعاش في حيزه الزمني الآني.
والراوي في هذه الرواية، يتميز بحضور كثيف، سواء في صورته التقليدية كراوٍ ضمني في الرواية وشاهد على أحداثها، أو في صورة الباحث، وهي الصورة الأقرب لتجسيد شخصية خيري عبد الجواد الذي نعرفه، بوصفه باحثًا في الثقافة الشعبية. ينجح خيري عبد الجواد أن يجعل سيرته الشخصية جزءًا من السيرة الشعبية لولي الله نور الدين، الذي يصبح ضريحه – في الرواية- علامة على تاريخ المكان وشاهدًا عليه، بعد أن تغيرت معالمه بطغيان المدنية والتطور، ليعيش الناس أسطورة الحداثة، وينسون ـ تماماً ـ أساطيرهم التي صنعوها بأنفسهم .
وهنا يأتي دور الراوي الضمني منعشًا للذاكرة الشعبية، وحافظًا لتراثها وهويتها. يتجسد هذا الدور في ضخ الحكايات الشعبية التي ارتبطت بشخصيات الرواية، منها حكاية (بديعة) التي سحرت الشاب نور الدين حتى يقع في غرامها، ونجحت في أن تحيله من قاطع طريق إلى ولي صالح. وكانت قد رأت ما بداخله من قوة وسموّ فآمنت به وجعلت مهمتها جلاء بصيرته، ولا يعني هذا أن ترويض الرجال مهمة نسوية في الثقافة الشعبية بل العكس تماما. إذ كان (خيري) يدرك بوعي تنويري، أن جزءًا من مسئولية المبدع الذي يستلهم التراث، تفكيك الابنية والمعتقدات التي رسخت فيه عبر الزمن. لهذا فشخصية (بديعة) بطلة (كيد النسا) أقرب إلى شهرزاد ألف ليلة، إذ تمثل كيدها في أنها أحبت (نور الدين) فكان الحب هو سبيلها لترويضه. إن المفارقة التي تجسدها الرواية تنشأ بين عنوانها (كيد النسا) والدور الذي قامت به (بديعة) لهداية قاطع طريق. إنها مفارقة مقصودة لتلفت انتباهنا إلى أن خيري عبد الجواد، على قدر ما يستعير أو يستلهم، من التراث، فهو على درجة من الوعي بمخاطر هذه المغامرة عندما رد على المحاور الصحفي:”السؤال.. كيف تنظر لهذا التراث؟ فإذا انبهرت به فسوف تقع في غوايته ولن تستطيع التخلص منه وسوف يقودك هو.. أما إذا نظرت إليه عن بُعد نظرة محايدة فسوف تستطيع أن تتخذ موقفًا منه إما بالضد أو مع”[11]
وهنا يمكننا مراجعة سؤال إدوار الخراط في معرض تقديمه لمجموعة قصص الديب رماح: هل هذه الكتابة حكايات شعبية أم قصص حداثية؟ لنضع في المقابل سؤالاً آخر: هل يمكن لمبدع يستلهم الحكاية الشعبية، أن يتخلص من وعيه الحداثي؟ الكاتب ابن عصره بالضرورة. وهو عندما يستلهم الماضي لا يحاكيه، ولا يتماهي فيه، بقدر ما يعيد إنتاجه على نحو فني مكتنز بدلالات عصره.
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الروايات التي استلهمت الحكاية الشعبية، جعلت منها مجرد أداة يمكن توظيفها في النص السردي، ليكتنز بمزيد من الغرائبية والتشويق والإثارة. دونما التفات إلى المعنى البحثي والتحليلي لخطاب الحكاية الشعبية. لكن خيري عبد الجواد، لا يتعامل مع التراث بوصفه موضوعًا غنائيًا بديلا للنوستالجيا، ولا يقتات على التراث لمجرد الإفادة منه لتوسيع فضاء النص، أو إشعال خيال القارئ. صحيح هو يدرك أن الحاضر يحمل جينات من الماضي، لكن هذه الجينات تمر بتحورات وفقًا لمراحل التطور الحضاري لكل مجتمع. إن الماضي لا يسكن عاداتنا وتقاليدنا فحسب، بل يسكن طرائق تفكيرنا وهذا هو الخطر الأكبر، ومن ثم فعلى المثقف المتعامل مع التراث أن يكون على درجة من الوعي بالمسافة الحضارية بينه وبين الماضي.
كان خيري عبد الجواد سابقًا لعصره، ونحن الآن، نشهد تعاظم دور الخيال الغرائبي في الرواية بين الكتاب الشباب، غير أن الغالب عليها مستلهم من مخيلة السينما الأمريكية. من أفلام الرعب، والزومبي، والفامباير والمتحولين والكائنات الفضائية والألغاز البوليسية. إنه مجرد تقليد لخطاب ليس له أيه جذور في واقعنا المعاش، بما يضاعف من حجم اغترابنا عنه.
ــــــــــــــــــــــــــ
[1] – العاشق والمعشوق هو عنوان رواية لخيري عبد الجواد، صدرت (2009م) عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر، نتوارى خلف هذا العنوان، لنلمح إلى عشق خيري عبد الجواد للتراث.
[2] – إدوارالخراط: مقدمة المجموعة القصصية (حكايات الديب رماح) – الهيئة العامة للكتاب – القاهرة – 1987م
[3] – هـ. ب. تشارلس: فنون الأدب -ترجمة (زكي نجيب محمود) – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 2011م
[4] – فرانك أكونورو: الصوت المنفرد – ترحمة (محمود الربيعي) – مقالات في القصة القصيرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب -القاهرة -1993م.
[5] – جورج جحا: جديد خيري عبد الجواد -مقال نقدي – موقع إيلاف – الأحد 12 مارس 2006م جديد عبد الجواد: كيدالنساء
[6] – خيري عبد الجواد – حوار بجريد القبس الكويتية – بتاريخ 16/2/2006م
[7] – عصام استاتي: اللغة المصرية الحإلىة – الهقيئة المصرية العامة لقصور الثقافة – القاهرة- 2016م
[8] – خيري عبد الجواد: قرن غزال (قصص) – سلسلة الأعمال الكاملة -الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة -2014م.
[9] – شوقي عبد الحميد: الأحلام المحبطة في قرن غزال (مقال نقدي) – منتديات أزاهير الأدبية- 20/1/ 2008م
[10] – خيري عبد الجواد: كيد النسا (رواية) -دار الآداب – بيروت -2006م
[11] – خيري عبد الجواد: حوار بجريدة القبس – سابق

خيري عبد الجواد .. «العاشق والمعشوق»بقلم: سيد الوكيل
عشق خيري عبد الجواد التراث الشفهي والمكتوب، فمثل نقلة نوعية في مسار الإبداع المصري، الذي التزم طوال الوقت بالواقعية ومرادفاتها الاجتماعية والنقدية وهو اتجاه أفضى إلى تجفيف الإبداع من طاقة التخييل، …