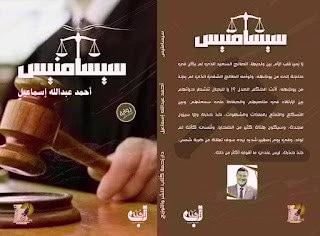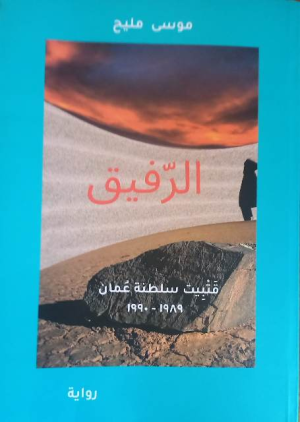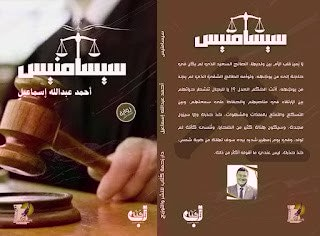قصة "خيتينيا" هي آخر قصة قصيرة من مجموعة "قصر النملة" للقاصة والروائية "هالة البدري" – الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2007- وهي من النصوص التي تنبغي مراجعتها والوقوف عندها طويلا وعميقا . إنها نص مقاوم من نوع جديد لم يُطرق من قبل حسب اطلاعي وملاحقتي للنصوص السردية التي كتبت في السنوات الأخيرة التي شهدت صعودا مخيفا للمد االمتخلف في الحياة العربية الاجتماعية، حيث نلاحظ وبكل أسى وقلق، بل حتى بخوف أن حركة الحياة تتراجع، وأن الجمال في ما حولنا ينحسر ويضمر ويموت، وأن مخالب القبح الباشطة صارت تمزق جسد الجمال الهش بطبيعته، وكأن هؤلاء المتخلفين يريدون تبليغنا رسالة من شقين : إن القبح أكثر جسارة من الجمال أولا، وأن علينا، إذا أردنا أن نتمتع بالجمال أن نهرب به ونستتر تحت أثقل الأستار، لأنه سيكون من الآن فصاعدا جريمة تدان بأحكام قد تصل حد الموت . سيكون حالنا مثل حال "ونستون سميث" بطل رواية "1984" لجورج أورويل الذي إذا أراد أن يقبل حبيبته عليه أن يقطع الفيافي ليظفر بفسحة منعزلة لا تراقب .. ومع ذلك كان معاونو "الأخ الكبير" – ديكتاتور أوقيانيا - يصوّرونه. لقد قدّم أورويل بطله كإنسان أخير وبلغة نيتشوية فريدة . ومن منظور آخر يمكننا أن ننظر إلى بطلي قصة هالة هذه كرمز للإنسان الأخير الباحث عن قيم الجمال والحب والنماء . زوجان يأتيان شتاء إلى شاطيء "ميامي" في الأسكندرية في شهر أكتوبر حيث يعتقدان أن بدأ العام الدراسي، وعودة المصطافين إلى مدنهم، سيجعلها خالية إلا من أهلها، خصوصا وأنهما وصلا إلى المكان بعد العصر (بحثا عن الهدوء والخصوصية، الذي افتقدته المدينة تحت الزحف الذي دبرته الشركات والمصالح الحكومية لاصطياف عمالها – ص 115) . لكنهما فوجئا بوجود ازدحام كبير وصعب حدّ أن الزوجة قررت تعديل برنامج رحلتهما بأن يستأجرا مركبا، ويكتفيان بالسباحة في بعيدا في عرض البحر، بدلا من السباحة من الشاطيء إلى الجزيرة لاصطياد القواقع، واستعادة ذكريات الطفولة والصبا المرحة في هذا المكان الذي شهد عنفوان صباهما، أو، وهذا الحل اليائس الثاني، الرجوع إلى مدينتهما ثم العودة في نوفمبر حيث ذروة الشتاء وخلو الشاطيء والجزيرة المؤكد . كانت الزوجة متشائمة وتشعر بأن المتعة التي خططا لها قد أُفسدت، لكن الزوج كان متفائلا بصورة أكبر نسبيا، رغم أنه ألمح إلى أنه يعد هذه الرحلة (نخبا في صحة عالمنا الذي يذوى- ص 116) . كان يراهن على أن الموجودين لا يستطيعون الوصول إلى المناطق، التي كانا يرتادانها من الجزيرة، والتي كانت خالية فعلا (إنه يبحث عن مكان منعزل وبعيد وخال كي يحصل، مثلا، على قبلة من زوجته) . خفّت حدة التوتر التي اجتاحت الزوجة، وبدأت بخلع ملابسها، فبدأت النظرات الفضولية تخز جسدها، وهي تكاد تلتهم لباس البحر (المايوه) بلونه البرتقالي المشبع بحمرة الغروب الأرجوانية (ص 117). لقد ولّى ذاك الزمن الجميل الذي كانت ترى فيه، وهي طفلة (العجائز اللاتي كن يسبحن في البحر مرتديات آخر صيحة في الموضة آنذاك، وأمها وصديقاتها وفساتينهن المزركشة بالورود فاقعة اللون، ذوات الحمالات الرفيعة . كن يسمينها ملابس البحر، ويرتدين معها قبعة من الخوص لتحمي وجوههن من الشمس . أين ذهبت هذه الصورة التي صاحبت طفولتها وصباها؟) . لقد حلت محل تلك الصور الجميلة الباهرة التي تشيع الصفاء والارتياح في النفس مناظر دخيلة غريبة وصادمة لأحاسيسها . تلتقط هالة، وهذه سمة محترفي القص، ما هو غريب وصادم دخيل عبر الإشارات والمشاهد والسلوكات، وليس عبر التصوير الوعظي . أول المشاهد التي التقطتها تحمل دلالات في غاية الخطورة . لقد كانت النظرات الفضولية تخز جسدها بلباس البحر كما قلت، وكأن شيئا غريبا يتحرك أمام النظارة . هي نظرات تعبر في جوهرها عن حرمان وجوع وحشي . إنه "المدنس" الأنثوي الذي انبثق في الفراغ من القمقم . كل النسوة الباقيات على الساحل يلعبن – وهذه آخر صيحة في الموضة النكوصية المظلمة – في الماء بجلباب طويل يرتدينه فوق البنطلون . ولعل في هذا المشهد تعبير عن لب الإنذعار العربي من موجة الحداثة الغربية خصوصا في مدها العولمي . إنذعار حافزه الحرب بين المدنس والمقدّس كما تراه العقول المعصوبة . وعلى المدنس الوافد أن "يُغطّى" . هو الحل العصابي تجاه مأزق الحداثة والتحديث . أمة تدرك أنه يجب عليها أن تتقدم، ولكنها لا تريد أن تتقدم، ولا تعرف السبيل الصحيح للتقدم . أمة تستحي من البنطلون لكنها تلبسه تحت ستر . وهو حل عصابي ينتصر فيه "المكبوت" وتعرش على خناقه القوة الكابتة عبر تصافقات منافقة توفر قدرا من الإشباع، قد يصل حدودا فاجرة بل شديدة الفجور . تلتقط هالة صورة لامرأة تلعب مع زوجها وابنها الذي كاد يصيب الزوجة بكرته، كانت هذه المرأة (مرتدية جلبابا التصق بجسدها الممتليء، فبدت عارية تماما، وقد حدد القماش ثنيات الشحم فوق ظهرها، وخطوط لباسها الداخلي، وخرجت ضفائر شعرها متمردة من تحت طرحتها تمرح فوق ظهرها – ص 118) . يتحدث المحلل النفسي "فتحي بن سلامه " في كتابه الهام " الإسلام والتحليل النفسي" عن حالة "سوق الهرج" التي نحياها في الحياة العربية، فيقول: (هذه المحاولة الرامية إلى شد وثاق الجماهير إلى الأصلي خلقت حالة ذهول ونكران لدى البعض، ولكنها خلقت حالة تنويمية استبدت بالكثير من أفراد الشعب والطبقات الوسطى . إنها كانت سبيلا إلى خلق حالة استعداد طفولي للذاكرة، وحالة خلط تاريخي يحل فيها العتيق مع المثالي في الساحة العمومية بكثير من الهرج والمرج . فالمنفّرات والمظاهر الكريهة تكاثرت في كل مكان، مرتسمة على الأجساد نفسها، عبر اللباس وعبر أسلوب العيش والتعايش، وكأن العفونة والرثاثة هما الضمان الوحيد للأصالة ... يمكن للإنسان أن يستلقي من الضحك جرّاء هذا "الريمايك" الواقعي، إلا أن الضاحك سرعان ما يتبادر إلى ذهنه الطابع الخطير لهذا الشغف بالأصل، لأنه يحمل في ثناياه مشاعر الضيم والإهانة والحقد، وموجات عارمة من الضغائن المتنامية . إن الرغبة المفرطة إلى هذا الحد في اللحاق بالأصل لا يمكن أن تخلو من الرغبة في الإنتقام المريع من الأزمنة الحاضرة) . إن الناس الذين لا يعرفون كيف يتعاملون مع مكبوتات لاشعورهم، تلعب بهم قوى الكبت كيف تشاء، فتنتج تصرفات غريبة غير منضبطة، فوضى حركية، واحتكاكات في باطنها رغبة إشباعية جنسية لائبة، وفي ظاهرها شكل من أشكال المتعة البريئة التي تعمي بصيرة أدق المحللين قدرة !! زعيق وألعاب تصارعية منفلتة تسحق حدود الآخر المحايد، ولا تقيم له أي اعتبار . هذا ما ترصده القاصة، من خلال عيني الزوجة المتسائلتين، في مشهد "مسرحي" آخر يجري على "منصة" الشاطيء من بين مشاهد أصابتها بالحيرة ولم تعد قادرة على فهمها واستيعابها: (انكشف المشهد أمام عينيها ؛ تفاصيل لم تعتدها في المكان من قبل : رجال يرتدون فانلات فوق شورتات طويلة، وصبية بلباس البحر، وسيّدات بجلابيب غامقة اللون . انتبهت لصيحة ضاحكة من رجل ملتح يرتدي فانلة سوداء، يحمل فتاة ترتدي كامل ملابسها، ويلقي بها إلى الماء بصخب، جرفتها الموجة فانكفأت على وجهها، فلما انحسرت عنه، حاولت الوقوف وهي تمسح الماء والرمل من عينيها . شدّت طرحتها، التي انزلقت من فوق رأسها إلى الخلف، لتعيدها إلى مكانها، لكنها قبل أن تتوازن تماما، فوجئت بدفعة من الرجل، ألقت بها مرة أخرى إلى الماء، قامت متوّعدة إياه، وهي تحمل قبضة من الرمل . قذفته بها . تعثرت فأحاطها بذراعيه القويتين، وعلا صراخهما، والموجة الجديدة تطيح بهما معا – ص 117) .
تصف " هاله " "زاوية" من الحال الذي صار إليه جسد الفتاة المحجبة التي تحاول ستر رأسها بالإيشارب حياء !!، والرجل الملتحي يرمي بها في لجة ماء الشاطيء : (لاحظت حين نهوضها التصاق البلوزة بصدر الفتاة، وتحديدها لتفاصيل وردات الدانتيل المصنوعة منه حمالات صدرها – ص 117) . ومع المشهد المكمل للأم التي تسبح مرتدية جلبابها بحيث ينكشف حزّ لباسها الداخلي، والآخر الذي تسبح فيه النسوة بالجلابيب "الشرقية" وتحتها البنطلونات " الغربية "، أستعيد مداخلة أخرى لفتحي بن سلامة استعان بها بشاهد من شعر "رينه ماريا – ريلكه " الذي كان من أكثر الشعراء الأوربيين إنصاتا إلى الجزع النابع من الطفرة الحديثة، يقول فيه: (كلّ انقلاب مبهم في العالم له محروموه من الميراث، بحيث أن ما كان لهم لم يعد ملكا لهم، وما يقترب منهم ليس لهم بعد) . ويعلق عليه ارتباطا بالفوضى العربية، ومنها فوضى قصة هاله البدري هذه، قائلا: (وجدت الجماهير نفسها محرومة من الميراث مضاعفة : بسقوطها في بؤس الفضاءات العمرانية الموحشة، وفي الفقر الذي يعتري تصوّرهم للمنزلة البشرية الجديدة التي فُرضت عليهم . وهكذا اندلعت على نطاق لا مثيل له مسارات عنيفة تتمثل في الإلغاء الذاتي . وما أقصده بمسارات الإلغاء الذاتي هو أشكال الخلع التي تحصل للناس عندما يُصبحون عاجزين عن فهم ظروف عالمهم بإحداثيات الحقيقة الخاصة بذاتيتهم . وعندما يصبحون مهددين في اهتمامهم بأنفسهم، وفي المواظبة على وجودهم، وفي متانة المشترك الذي يجمع بينهم . إذا كان البشر قادرين على تحمّل ظروف الفقر المادي القصوى، فإنهم إذا سقطوا في هذا الخلع لأنفسهم أصابهم اليأس وأصبحوا هاذين ومتمرّدين، وأدى بهم الأمر أحيانا إلى حالة من الفاقة التي تجعلهم يقبلون أي عملية ضخ للمعنى . خجل الإنسان من كونه ملغى ذاتيا يؤدي به إلى محاولة تفادي العالم في حاضره للبحث عن الأصل في ما وراءه، للنظر فيما إذا كان باب الأصل باعتباره الفردوس الأول للحقيقة لم يوصد بعد . هذه البنية الفعلية تفترض ولاشك حركة تراجعية أمام الانقطاع الذي أحدثته الطفرة الحضارية . فجملة ريلكه : "ما كان لهم لم يعد ملكا لهم، وما يقترب منهم ليس لهم بعد " تعني توقفا ورفعا لليد يذكّران بما سمّاه "هولدرلين" بـ "الوقف"، أي تلك اللحظة الخاوية الدقيقة للنقلة المأساوية التي يغيب منها كل ربط وكل مراوحة) . إنها مرحلة " الإله المكفهر" . وإذا كنت قد وضعت المشهدين السابقين ضمن إطار سلبي فلأنني الآن أقوم بتحليل رجوعي أو تراجعي أضع فيه الحوادث الابتدائية في ضوء "الصورة الكلية – GESTALT " التي تكوّنت لدي، فأنا ناقد أفسّر بعد جمع معطيات الإطار الشامل للقصة، ولست قارئا، أنتظر المفاجآت والمستجدات التي تكشفها القراءة الأولى . أما الزوجة فقد كان موقفها في بداية مسار الحوادث مغايرا تماما . لقد أعجبها المرح الذي تناثر حول الرجل الملتحي وفتاته في صخبهما العارم، مثلما أعجبها عدم انزعاج الآخرين من الرمل الذي يصيبهم مصادفة من تراشق اللاعبين (ص117). كانت تنظر إلى ما يجري، حتى الآن، بعين "ديمقراطية" إذا ساغ الوصف، رغم أن الكثير من الأفعال لا يناسب ثقافتها ومزاجها وتركيبتها النفسية وموروثها التربوي . ووفق نظرتها "الديمقراطية" المسالمة والمتصالحة مع الآخر والمحيط هذه، انتقلت إلى موقع "التبرير"، الذي كان يقف على سدته الزوج بحماسة . ففي البداية كانت هي التي تتذمر من الزحام الرعاعي، ومن تشوه ملامح مكان الطفولة، وتقترح إلغاء رحلتهما المنتظرة . وكان الزوج هو الذي يقدم لها الأعذار – وبعضها واه – فتقنع بها، وإن على مضض . أما الآن فالزوج هو الذي أصبح في موقع السخط والتذمر من هذه الفوضى الساحقة التي حوّلت الشاطيء الجميل إلى ما يشبه سوقا للسمك (ص 125)، ويعلن أنه قد ضيّع فرصة التراجع، التي كانت يجب أن تحصل منذ البداية، عندما شاهدا أن المكان قد أصبح شاطئا شعبيا . أما الزوجة فقد صارت هي التي تبرر و "تعقلن" أحيانا .. لم يكن لديها اعتراض على غزو الناس "الشعبيين" لشاطيء الحب والطفولة والجمال، فهي تتذكر أن النساء في الشواطيء الشعبية في "رأس التين" و "الأنفوشي" [كنّ] يسبحن في الصباح المبكر، وعند الغروب أيضا . وكانت جدتها تحرص على نزول البحر مع غروب الشمس حتى تبطل أفعال السحر الشرير كما كانت تقول لهم وهم صغار . ثم تقدم استنتاجا هو نواة برنامج تغييري حياتي ذي طبيعة متحضّرة ؛ برنامج يكفل للجميع حقوقهم الاجتماعية والنفسية : (المشكلة ليست الإزدحام، ولكن أن يقبلونا بعاداتنا، كما نقبلهم بعاداتهم . وألا نهرب، ونتقوقع أماكن خاصة بنا، والعالم كله لنا- ص 125) .
لقد قفزت شبه جملة طرحتها القاصة في المقطع الذي وصفت فيه أم الصبي التي كانت تلعب مع زوجها وابنها الكرة وترتدي الجلباب الذي التصق بجسدها الممتليء حتى بدت عارية تماما وهو : وخرجت ضفائر شعرها متمردة من تحت طرحتها (تمرح فوق ظهرها – ص 118) . إن الزوجة، ومن ورائها القاصة حتما، فالمؤلف بالنسبة لي لا يموت، وأنا أمسك بلحم أو عصب نصّه الحي الآن . منذورة للفرح والبهجة وتفتح الطاقات وحتى انفلاتها .. لم تكن لديها أية مشكلة تجاه هذا الصخب الأخاذ للطاقات البشرية الذي شاهدته، أبدا . كانت منذ طفولتها عرّابته بخلاف زوجها . فقد تعلمت، وهي طفلة، السباحة على يدي أبيها، الذي رفض أن ترتدي طوق النجاة الحامي في الحالات الطارئة، وألقى بها إلى الماء، حتى تقطعت أنفاسها . وبعد أسابيع تركها [= أبوها] للبحر، وهو مطمئن لعشقها له، وأمانها معه (ص 126) . أما زوجها، ومقابل هذه الطريقة " الغمرية – flooding " المباشرة و "الصادقة"، فقد كان تعلمه السباحة مراوغا، وفيه الكثير من اللاصدقية والمراوغة التي يبدو أنها انعكست على ملامح سلوكه الراشد . كان أبوه يخطط بقلم الكوبيا فوق ظهره كي يضمن عدم نزوله النهر، فكان يتفق مع زملائه أن يسبحوا، وأن يجففوا أجسادهم، ثم يعيدوا رسم الخطوط مرة أخرى، حتى لا ينكشف أمرهم (ص 126) . وبفعل التدريب الطفولي الغامر والطافح، بفعل هذا الترعرع المطمئن في أحضان الرحم المائي رغم قسوته النسبية، كانت، بوصف موجز وبليغ "كائنا مائيا " . وهذا ما تعلنه، باطمئنان، لزوجها الذي كان يخشى عليها كثيرا وهي تتنقل على صخور الجزيرة المسننة، فهو يعتقد أنهما لم يعودا صغارا، وأن طاقاتهما قد نضبت : (لا تخش شيئا . أنا كائن من كائنات البحر . حبي له كاف لكي يهبني الأمان حتى وإن غبت عنه طويلا – ص 122) . ونفسيا، وإبداعيا، فإن الأنثى كائن مائي، في حين أن الذكر كائن صخري، كائن من تراب .
وستثور تساؤلات مريرة ومحيرة في ذهن المتلقي : أين كانت تعيش هذه الزوجة "البريئة النوايا" – والنوايا البيضاء، كما هو معروف في التحليل النفسي، وفي الحياة العملية الجائرة على حد سواء، هي الطريق المستقيمة التي توصل إلى الكارثة - بحيث أنها قد تفاجأت بمظاهر الخراب هذه التي نبتت في كل مكان من حياتنا، ومن المحيط إلى الخليج؟ ألم تلاحق متغيرات السنوات الطويلة التي كان صدع التمزقات يمتد بهدوء مراوغ ليشرخ حياتنا كلها؟ . لكن السؤال المطرقة الذي سيدوي في أذهاننا هو : لماذا لم ينسحب الزوجان، قبل نزول قارعة الكارثة، وهما يشاهدان مظاهر الخراب الساحقة هذه؟ . لقد كان بإمكان الزوجين اتخاذ قرار العودة النهائي والحاسم، خصوصا وأنهما قد تأكدا تماما أنهما قد طردا إلى الأبد من شاطيء الفردوس المفقود . مظهر واحد بسيط ومباشر وشديد السمّية كان كافيا لأن يطوّح، وإلى الأبد، بكل آمالهما إلى هاوية اليأس الفاجعة، مظهرا شاهداه بأعينهما العضوية، وكان عليهما أن يحللاه بعيني بصيرتهما، وكان لزاما أن يدركا بوضوح قاس أن شبح الخراب قد أحكم قبضته على خناق الوجود العام بل خنقه إلى الأبد، هذا الشاهد الخرابي الصاعق أجلته إلى هذه اللحظة لأسباب نفستحليلية سأطرحها الآن، شاهد أمسكت به الزوجة في موقفين : الأول حين خلعت بلوزتها وبدأت العيون الجائعة تفترس جسدها، كل العيون مقبولة من وجهة نظر علم النفس إلا عيون الأطفال : (لم تسلم حتى من عيون الأطفال الذين تركوا قصور رمالهم، وحفرات الماء الواسعة التي ينزحون منها الماء ليبللوا الرمل، حتى يلين، ويطيع أياديهم، فتشكّله، وتركوا معها الدلاء، والرشاشات الملوّنة، ووقفوا يراقبون حركة الزوجين معا – ص 117) . هذه قرينة على "تعهير" الطفولة البريئة في ظل نظام تربوي محتشم .. لا تصدقوا هؤلاء الأوغاد الذين يزعمون تطهير الطفولة وهم يعهّرونها . عذرا يجب أن نتحدث بلسان تعرضي واقتحامي، فهؤلاء الذئاب لم يكتفوا بمحاصرة بيوتنا، بل دخلوا حتى إلى غرف نومنا، وطوّعونا على أن نسألهم عن الكيفية التي نضاجع بها نساءنا، وهم يلعبون بخواتمهم بتشف، ويردون بصبر مسموم .. سحبوا البساط من تحت أقدامنا نحن الذين نلقب أنفسنا بتنفج زائف بـ " الإنتلجنسيا " ! الإنتلجنسيا المهزومة التي تريد بائسة أن تجد لها موطأ قدم على هضبة التغيرات الجارفة !! إنتلجنسيا هشّة لا تستطيع سوى بناء يوتوبيات غير مسلحة .. هذا درس عظيم تقدمه هالة البدري، وليس شرطا أن تعرف هي تفصيلات مشروعها وأبعاده، فنحن نتحرك وفق حتمية لاشعورنا حسب الأطروحة "اللاكانية " – نسبة إلى "جاك لاكان" المحلل الفرنسي - .
... ثم يأتي سلوك مضاف ومحيّر من طفل آخر يجعلنا نعيد التساؤل: لماذا لم ينسحب الزوجان ويخلصا من النهاية المميتة؟ يأتي طفل صغير في التاسعة من عمره، أي أنه بدأ الآن بتعلم حروف الكتابة، ويلمس خصر الزوجة العاري ويبتعد !! ضع ألف علامة استفهام . حدس المرأة صادق في أغلب أحواله، وعقل الرجل كاذب في أغلب حالاته، هذه حقيقة نفسية ومعرفية ننكرها نحن الذكور، ذكور النحل والخواء، يعضدنا علماء النفس الذكور الذين يتصايحون حول حسد القضيب لدى الأنثى – penis envoy " ولا يلتفتون إلى حسد الذكر للأنثى لأنه لا "يخلق"، غير مخصّب، لا يُنجب . وعليه فإن المرأة هي مجس الإحساس بموجات الخراب حين تكون أداتها الطفولة : (جفلت حين شعرت بيد صغيرة تمتد نحوها . التفتت لترى صبيا في التاسعة من عمره، يلمس خصرها، فلما التقت عيونهما تراجع خطوتين إلى الوراء، دون أن تظهر عليه علامات دهشة أو خوف .
سألت زوجها :
-أتصدّق؟
- هو مجرد طفل فضولي لا أكثر . اعتاد أن يرى أمه تنزل إلى البحر بملابسها الرسمية "ضاحكا" – ص 118).
إن هذه الحادثة تحتمل المزيد من التأويل . فمن مخزونات اللاشعور الجمعي لمس جسد الأنثى كتعبير عن موقف "بدئي" مفاده أن شيئا من قدرة الخصوبة الغامرة التي يحفل بها الجسد الأنثوي الكريم سينتقل إلى الملامس، ويذكر "جيمس فريزر" صاحب "الغصن الذهبي" بأن هذا الفعل كان من الممارسات الطقسية لدى الكثير من الشعوب البدائية خصوصا لمس عجيزة المرأة . لكن هل ذهبنا بعيدا في طريق التأويل الأسطوري؟ ممكن . أليس هذا ما تريده ما بعد الحداثة الغربية؟ لكن هذا التأويل مسترخ ومترف في فضاء الكراهية والخذلان الذي أحاط ببطلة القاصة من كل جانب . إننا نعيش مرحلة "تتوحّش" فيها حتى الدوافع الطفولية البريئة . عن أي نماذج بدئية نتحدث؟ عالمنا العربي غير متوازن ويسير سريعا نحو العدائية والتكريه والتوحّش بسبب سياسات "إخفاء" المرأة من ناحية، وبسبب التنفير والتكريه الذي تتعرض له نوازع النفس البشرية الطبيعية من ناحية أخرى . حتى يمكننا القول أننا نخضع لثقافة لا ترى أن الإنسان حيوانا ناطقا واجتماعيا حسب بل، يا للغرابة، "حيوانا آثما" بالدرجة الأساس . الإنسان هو "حيوان خطّاء"، وحيث يوجد الإنسان يوجد خطر الخطيئة، والمصدر الأول والأخير لهذا الخطر هو المرأة ؛ جسدها تحديدا . وعليه يجب إخفاءه بأي طريقة، حتى صار أطفالنا يكبرون وهم لا يرون من الجسد الأنثوي سوى عتمته وظلمته وحضوره الشبحي . وقد جاءت الملامسة الفضولية من هذا الطفل وهي تحمل جانبا كبيرا من هذا الحافز . في كل المجتمعات تدور التابوات حول الأمور الأخلاقية والقيم السلوكية المعروفة، إلا في مجتمعاتنا فإنها تتمحور حول نواة واحدة تتفرع منها كل التحريمات وهو جسد الأنثى / الأم . إن الجفاف الجمالي الذي اكتسح حياتنا اليومية حتى أدخلنا في ما يشبه حالة من "الكآبة القومية"، سببه الرئيس هو "إخفاء" المكون الجمالي المركزي في الكون والحياة وهو المرأة، وتحديدا جسدها . وموقف هذا الطفل الذي لم يحمل أي علامة للدهشة أو الخوف وهو يتراجع يعكس كارثة مفادها التحرّش الطفولي النابع من "التوحّش" والجفاف الجمالي . وهذان العاملان يوصلان في النهاية إلى "تعهير" الطفولة البريئة التي نلاحظ الكثير من الأدلة عليها في البيت والمدرسة والشارع، وعلى امتدادها تمضي في طيات سلوك الراشدين من البشر لدينا .
وقفة : الشهوة تشتعل :
وفي أجواء التوتر هذه الذي كانت تبدو واضحة على الزوجة، والتي كان الزوج يحاول جاهدا ويكابر لإخفائها، تحصل حالة مدهشة، لم يكن أحد ليصدقها لو لم تثبتها البحوث والمصموت عنه في الحياة السرّية واليومية . فالقلق يشعل الغريزة الجنسية المباركة . إنه فعل دفاعي في وجه الموت والفناء . هذا ما كان يحصل لدينا كمقاتلين في الحروب الثلاث من انتعاضات، عندما كان يشتد القصف الرهيب، أو خلال مرحلة اليقظة والحذر إنتظارا لهجوم العدو . ويحصل لدى الطلبة أيضا، تقلصات وقذف في قاعات الإمتحان . وهناك انتعاضات المحتضر المعروفة . وقد اشتعلت رغبة الزوج في زوجته . وهنا تتجلى قدرة مضافة وتميّز أسلوبي لدى هالة البدري، حيث تعمد الكثير من القاصات إلى استثمار مثل هذه المواقف للإيغال في عرض الجسد الأنثوي – وجانب من ذلك يرتبط بالحفزات الإستعراضية والإستعرائية لديهن – وكأنهن يساهمن في "تسليع" الجسد الأنثوي الذي يعلنّ أنفسهنّ عادة إدانتهن له كسمة من سمات المجتمع الذكوري . تعرض هالة حالة الإلتحام الرائعة برشاقة تعبيرية وتختزل المواقعة الجنسية بلمحة سريعة حيية : (نزلا إلى القاع ليلمساه معا، وحين التفتا، لكي يصعدا، أمسك بخصرها بقوة، فتركت له حرية الشعور بامتلاكها حيث الألوان تتكسر بدلال، طوّقت عنقه بذراعيها، وهي تدفع الماء بساقيها اللتان تنفرجان وتنغلقان مثل مروحة. أتاحت لجسمه مباغتتها بسهولة . حاولت الإنفلات، وهي تشهق بدخول الهواء المفاجيء إلى رئتيها حين وصلت إلى السطح، لكنه لم يعطها الفرصة. كان قد أحكم قبضة ساقيه حول جسدها وأزاح القماشة بسهولة . جاءت موجة لا حواف لها. رفعت مستوى الماء، فارتفعا معا، وهبطت بهما في مكانهما، واستمر تأرجحهما حتى فاضا بعاطفة حارة انتقلت إلى كائنات البحر، فأطلقت بخورا ملوّنا ذا رائحة نفّاذة، وصل عبيرها إلى الأعماق المدهشة، التي كشفت لهما عن أسرارها منذ زمن طويل – ص 120 و121) . يا لروعة هذه المواقعة، وهي تجري في رحم البحر الأم . وأعتقد أن همنغواي – بسبب مكبوتاته وعنفه وميوله المثلية – كان مخطئا حين قال على لسان بطله في روايته "الشيخ والبحر" إن من المفروض أن نسمّي القمر "مونه" وليس "مون" – لا أعرف كيف أعبر عنها بالعربية وهذه هي الخيانات الحقيقية للترجمة - أي نؤنثه مادام البحر ينجذب إليه في حركة المد، وكأنه كائن ذكوري . إن الماء رمز مؤصل للرحم الأمومي المنعم . وفي الواقع الأسطوري والرمزي فإن القمر هو الذي يريد "العودة" إليه . والزوجان، وأمام ضغط الواقع الجائر، يبغيان، لاشعوريا طبعا، العودة إلى واحد من تمظهرات الرحم الأمومي الفردوسي الذي يوفر الحماية ضد تهديدات الواقع الجائر . صاغت هالة مقابلة مدهشة بين هذا العالم / الداخل المنعم، والعالم الخارجي المهدٍد، مقابلة رسمت فيها معالم صورة الفعل الخلاصي الباذخة من خلال الفعل الجنسي حيث يتجلى الله . ولا أعرف ما الذي حصل للحب في هذا العالم الجائر، فليست مجتمعاتنا حسب هي التي تعاني من هذا التوجّه ؛ في بحث إحصائي أجري على مجموعات من الشباب الغربيين، سئلوا فيه عن مفهومهم للرومانسية، فأجابوا بأنه الإتصال الجنسي بالحبيبة في البانيو أو تحت المطر في الحديقة .. حلوه؟! . إن فلسفة القاصة هنا تتجلى في رسالة مستترة ورمزية، وهي الرسائل الأكثر حكمة ورصانة وتأثيرا، مفادها أن علاج المحنة البشرية العاتية التي نعيشها تتمثل في هذا الإلتحام العزوم والحر الذي يتوفر تحت الخيمة الحمايوية الأمومية . إلتحام تحت أستار الطمأنينة على المجال الشخصي من الحرية . كسر العادة، حيث تميت الرتابة الدهشة وتخنقها بالصدأ . ومن المهم أن أشير هنا إلى دور القلق، ليس في إشعال نيران الرغبة المتوهجة وتصعيد ألسنتها حسب، كما قلت آنفا، ولكن في تجديد مفهوم المواقعة وأعادتها إلى سياقها الروحي، كتجل لروح الله .. كفعل انبعاثي يتحدى "المثكل" حسب الوصف الموفق لجدنا "جلجامش" ؛ كامتداد خلودي مؤصل يوفر للإنسان الإحساس الصلب بالديمومة، وبأنه عصي على الفناء . اشعت البهجة المحيية المنبعثة من الفعل الجنسي على الوجود الفردي والجمعي : (خرجا متسائلين في صمت : لماذا لم يقتربا من نشوتهما هذه طوال هذه المعرفة بالبحر؟ أجاب : -لا يهم ما فات . لكن المهم أنه يحدث الآن . أرادت أن تنام في حضنه، وألّا تعود إلى الشاطيء أو إلى الجزيرة . أن تنام فحسب . وضع يديه تحت خصرها، وتركها لحنوّ الموجة، كي تطفو بها . كان البحر لهما، رغم الخيالات البعيدة التي تظهر كنقاط سود فوق الجزيرة، والأبنية العالية التي تقف بصلابة خلف الشاطيء .. اختفى البشر من مرمى الرؤيا – ص 121) .
عودة إلى حلم الفناء :
وبمزاج رائق بعد التجربة "الإلهية" التي خاضاها، والتي منحتهما شعورا منعشا بالتجدد والإنبعاث، وبعد أن امتلكا الماضي الذي اختفى، وصارت كل البحار بحرهما كما يقول الزوج، قررا استعادة الحلم المركزي الذي افتقداه طويلا، وهو الاصطياد في جزيرة "ميامي" التي شهدت لقاءاتهما في الصبا . هذه العملية تهم الزوجة، ذات المهارة العالية في الغوص وصيد القواقع دون الحاجة إلى التنفّس، بدرجة أكبر . كان زوجها يخاف عليها، فهو يرى أنهما لم يعودا صغيرين، وأن الغوص في الجانب الثاني من الجزيرة المقابل للبحر يتطلب قوة جسدية كبيرة، ويتضمن مخاطر جسيمة حيث الأمواج العالية . أما الزوجة فهي واثقة مطمئنة ترى أنها "كائن من كائنات البحر" وأنها تريد جمع بعض محارات "الخيتينيا" التي أحبتها بشغف ملتهب منذ طفولتها . وفي لمحة سريعة، وهذه عادة هالة في تعرية الواقع المتردي، تشير الزوجة أن محارات الخيتينيا اختفت حتى من المحلات تماما لأنها (تذهب إلى الفنادق ذات الخمسة نجوم مباشرة – ص 122) . وليس عفويا اختيار محارة الخيتينيا أبدا كما سنرى في النهاية ؛ القاص المحترف لفن السرد لا يقع في مثل هذه المصيدة . إن هذه الترابطات التلقائية التي تمتد خفية بين المكونات والرموز والأشياء التي يتعرض إليها الكاتب والتي تظهر وكأنها تلقائية وبلا قصدية، وأحيانا حتى عشوائية في النظر المباشر، ثم تتضح جوهرية دورها السردي وإحكامه، قد برع فيها شارل فلوبير ومارسيل بروست في الأدب العالمي وليس هنا مجال التطرق إلى هذه العطايا لأنني قد تعرضت لها في دراسات سابقة . لا أستطيع إهمال دور الحركات الجزئية والمشاهد العابرة في إحكام صلة الحلقات السردية، والتمهيد لبناء المناخ النفسي العام، التوتري، للحدث . كل خطوة محسوبة في قصة هالة من حيث موضعها المناسب في تشكيل اللوحة النهائية . فحينما يقود الزوج زوجته نحو البحر، يعبر بها جسرا خشبيا متهالكا، ارتص عليه الصيادون . يشعر الزوج، وهو يحيط زوجته بذراعيه، بتوترها المربك، ويقودها عبر الجسر هذا : (أمسك أحدهم [= الصيادون] بسمكة. عم الفرح وجوه الصبية المتفرجين، الذين كانوا يتنقلون بعيونهم بينها وبين السمكة، التي تجاهد لتفر من الأسر . تحلقوا حول الصياد، وهو يخلصها من الصنارة، ويضعها في المقطف – ص 119) . وحين تستكمل الصورة الكلية، وتصل ذروة النهاية الفاجعة ستسترجع- إذا كنت "قرّاء- على وزن فعّال"، وليس "قارئا- على وزن فاعل"- وهذا ما يتطلبه الفهم والتأثر بالنصوص الكبيرة – الأحداث الصغيرة التي ستشعرك بفداحة الخسارة الرهيبة ؛ ستستعيد صورة السمكة التي اقتنصت مع مرور الزوج والزوجة المتوترة التي كان الجميع ينقّل بصره الحاد والمتلصص بين جسدها، وبين جسم السمكة - والسمكة رمز أنثوي ؛ رمز عشتاري - الذي يلبط يائسا قبل إخمادة الموت التي ستأتي قريبا . ويمكن للناقد والقاريء النظر، وفق المقترب الفني البنائي نفسه إلى اللمحة، التي قد تبدو عابرة وجزئية، وفي حركة تراجعية - RETROGRADE " مستعادة ستلتحم مع الاحتدام النفسي الأخير، التي تصور بها القاصة الكيفية التي يحكم بها الزوج يده على كتف زوجته، وهو يعبر بها خشبة ناقصة من جسم الجسر الخشبي . كان يزيد من قبضته وحرصه، كلما توغلا في طريقهما، وتناقصت الأخشاب . هو تدبير حركي درامي يحمل سمة سينمائية، وهي من سمات الحداثة في السرد، أي أن توازي تصويريا، وانفعاليا، كما سيترتب على ذلك، بين المفردات الحركية الجزئية، وإسقاطات الانفعالات الصاخبة، لكن المكتومة لشخوص القصة . نحن نُعد، عبر استقبال توتر الزوجين أمام نقصان خشبات الجسر التي قد تسبب أذى بليغا للعابر "البريء" مثل هذين الزوجين اللذين أتيا بعد غياب طويل، أوقعهما في ورطة واضحة تستحق ليس النقد، بل حتى الإدانة . إنهما، ومن جديد، لا يعرفان ماذا حصل لـ "الجسر" ! هل يُعقل ذلك ؛ هل يُعقل أن شخصين ترعرعا في مكان احتفظ بذكريات طفولتهما – وعلميا يحتفظ الطفل حتى بذكريات السنة الثانية – لا يعلمان ما الذي حصل من تطورات فيه، وكلها "تطورات " خرابية؟! . أين كانوا؟ وهل كانوا يعانون من حرمان حسّي لا يتيح لهم التعرف على المعلومات والمتغيرات؟ إنه لأمر عجيب، وهي قنبلة معرفية تفجرها هاله البدري . المثقفون العرب غائبون في ضبابية سراب آيديولوجي يحسبه الظمآن الثقافي ماء، أو محلقون على أجنحة غيمة رومانسية خدرة يتهاوون منها حين تحضر "الفكرة"، فكرة الخراب، وتذهب "السكرة"، سكرة الهوامات وأحلام اليقظة. لا أدري لمَ أشعر هنا بضرورة استعادة ما كتبه الروائي العراقي المبدع " علي بدر " عن الفارق الهائل بين سيكولوجية المثقف أو المتعلم الذي يحسب الاحتمالات المعرفية بانهمام مفرط، ويضيع عن الواقع وهو في غمرة حساب هذه الاحتمالات الشائكة، وبين البشر السوقة الذين يعرفون بدقة أن غاياتهم تكمن في "قضيبهم"، وفي ثأرهم المستدخل الذي لا يؤجل، هم السوقة السِفلة الجسراء والتعرضيون الذين لا يتمتعون بالقدرات المعرفية و"البلاغية" لنا نحن المثقفين كما نوصف. نحن الذين أزحنا أنفسنا عن الموقع التاريخي " المنتظر " و " الإنقاذي " الذي صممه التاريخ لنا كمثقفين . إن الخطيئة لصيقة بنا، والمثقف العربي هو "مثقف آثم " . يتحدث علي بدر عن واحدة من شخصياته في روايته (صخب ونساء وكاتب مغمور) وهو (عبّود) النائب العريف الذي لم يستطع أن يكون نائب ضابط، وإذا به – بعد انقلاب الرابع عشر من تموز في العراق – وإذبه بعد تدهور الأحوال، ودوام الحال كما هو معروف من المحال، حصل انقلاب الثامن من آذار، فأطاح بالمقدم " محمود الماوردي" وصار يشعر بأنه يضاجع عشيقته وهي تلبس رتبة المقدّم . لكن المقدم قتل في انقلاب الثامن من شباط الجديد، فبدأت امتيازات العشيقة تتناقص بصورة بالغة خصوصا وشعرت أنها لا تستطيع "ضبط" قدرتها على الصرف، فبدأت بالاستدانة من النائب العريف، سائق عشيقها المقدم الراحل، وتراكمت عليها الديون، فاضطرت إلى قبول الزواج منه : عبود الذي عاش حياته طبقا إلى مواهبه في العيش، وهذا ما يفسر سر هذه الافعال المركّبة التي كان يجيد فعلها ن هذه الحركة السريعة في الصعود والهبوط ترتبط بموقفه الفطري من الحياة، فثبات العالم وسكونه هما من خصائص المتعلمين لا من خصائص الناس البسطاء. المتعلمون يعيشون الحياة من خلال نسق بالكاد أن يتغير وإن أي تغيّر يدمر حياتهم، أما هؤلاء الناس فالأمر مختلف معهم . إنهم يعيشون التناقضات كلها دون أدنى شعور بعذاب الضمير، فعبود الذي كان شيوعيا، كان متدينا أيضا، غير أن دينه هامشي وفطري ويسمح له أن يتزوج امرأة سيئة السمعة، ويسمح له أن يسرق من المطحنة ويجمع المال، الشيء المهم في حياة هذه الشخصية ذات المعتقدات الخرافية هي الجرأة والانشباك في التجارب الطاحنة) .
ومن تلك الوقفات الجزئية والمشاهد العابرة ذات المهمة التحضيرية للخاتمة المدمرة، هي عودة الزوجة الظافرة وهي تحمل بيديها قوقعة خيتينيا حيث دار الحوار المناوب!! : الزوج: كانت قسمة عادلة . أنا اصطاد السمك، وأنت تصطادين القواقع . الزوجة : لا أحب اصطياد السمك لأني أحبه حيّا، ولا أريد أن أراه يموت . (ضاحكة) لكنني أنسى هذا عندما آكله ! الزوج : آكل ومأكول . غالب ومغلوب. ولأننا الآكلون في حالة السمك، ننسى هذا، ولا نفكر في صراع الحياة والموت، صراع الصياد والفريسة – ص 124) . إن القاصة توسّع الرؤيا هنا إلى طبيعة الصراع الأزلي الي تدور رحاه في ساحة النفس البشرية بين دوافع الموت ودوافع الحياة . فالإنسان "حيوان معادي" إذا ساغ الصوف . وهذا الاستنتاج : إن العالم عبارة عن آكل ومأكول جاء بين موقفين مهمين : الأول هو السؤال الذي وجهه للزوج واحد من روّاد الجزيرة الذين بدأو يتقاطرون ويراقبون حركات الزوجة :
- هل تعرفها؟
- زوجتي .
وليس التحسّب من طبيعة "الرومانسيين" الشفافين . أما الثاني فهو الاستنتاج الذي وصل إليه الزوج : لم تعد الأسكندرية وشواطؤها مناسبة لنا، وصار موضوعا للجدل بينه وبين زوجته التي ترى أن عليهما أن لا يهربا ويتقوقعا . أعود من جديد للقول أن الزوجين الجميلين لم يكونا يعرفان حجم الخراب الذي حصل في الواقع المحيط بهما، وقد صحيا صحوة متأخرة وهما على "حافة بعد فوات لأوان" إذا جاز التعبير، صحوة كلفتهما حياتيهما كاملتين، وإلى الابد . كان منشغلين في جمع القواقع بروح "شعرية" في حين كانت غرائز العدوان في نفوس من يحيطون بهم تشرع في إشهار مناجلها الباشطة . فكلما اقتربا من الشاطيء كانا يلاحظان كثافة السابحين عن بعد . كان بحر العالم المحيط بهما يهيج كلّه ويضيّق الخناق عليهما، وينذر بطوفان محتقن من الغرائز المهلكة، في الوقت الذي كانا فيه عائمين على موجة علاقتهما الحبية الناعمة، مغيبي الوعي عن الشر المستطير الوشيك، بسبب حسّهما الجمالي المفتن الخدر . تتضح هذه المقارنة الذكية من خلال وصف القاصة لآخر المشاهد "الرومانسية" في القصة قبل أن تنزل قبضة العدوان الشرسة ضربتها المدوّية : (كلما اقتربا من الشاطيء لاحظا كثافة السابحين عن بُعد . كان العدد أكبر بكثير مما توقعا . ضربا الماء بسواعدهما علة مهل . أمسك بالصدفة، ووجهها نحو الشمس التي بدأت رحلة غروبها، حتى عكس الضوء نحو عينيها . اقتربت منه، والمكر يطل من رعشة فمها المكبوحة، مغمضة العينين، حتى لم يعد يستطيع أن يسلط الشعاع على وجهها . خطفت منه القوقعة، وسلّطتها ناحية الماء . غاص وراء الشعاع الضعيف، وعاد فاتحا كفيه، قائلا:
أتيت لك بالشمس الأرجوانية – ص 126) .
ويبدو أن غريزة تدمير الذات حسب النزعات المازوخية التي ننكرها عادة تشتغل بخفاء وسرّانية مراوغة . لم يتنبه الزوجان إلى العلامات المّنذرة التي كانت تتزايد لحظة بعد أخرى . ظلا يسبحان إلى أن تعبا .. وإلى أن حلّ الظلام .. فوفّرا (من دون أن يعلما) الشرط الأخير ليس لاقتراف أية رجيمة حسب، بل لانفلات غرائز العدوان في ظلمة النفس البشرية الآثمة مستترة بظلام الخارج . والآن فقط، وبعد لاحظا أن رؤوسا كثيرة تسبح نحوهما، التقت عيناهما على الحقيقة الفظيعة، الآن فقط استشعرا الخطر الداهم المبهم فقررا أن يخرجا من البحر بسرعة : (دبّ الخوف في أعصابهما للمرة الأولى . لم تفهم لماذا أصبحا فجأة هدفا لكل هؤلاء الرجال والصبية . فكّرت: هل يكون السبب أنني امرأة؟ النساء في البحر كثيرات، لكنهن يلعبن في الماء بجلباب طويل يرتدينه فوق بنطلون، وأنا الوحيدة التي ترتدي (المايوه) – ص 127) . والآن فقط أيضا يركبهما الشعور الممض بالندم من الإنساق لرغبتهما العارمة في اصطياد الخيتينيا، فقد ظهر أنها خيتينيا الخراب والموت والدمار، ولكن ساعة مندم، فقد سبق سيف العدوان، العاشقين الأعزلين، ومن هنا، ستمضي القاصة في تصوير مشهد لمطاردة الختامي المرعب في غاية الروعة والتماسك، تصوّره بعين "سينمائية" خلاقة تجسد المشهد العريض النهائي الأسود أمامنا بقدرة فائقة، حيث تتابع الصراع المستميت الذي يبذله الزوجان من أجل الخلاص، والتقرب الخانق والمخيف الذي تقوم به حلقة الرجال السِفلة . تصوّر "هاله" التفصيلات الحركية وتقلصات الأجسام .. متسقة مع ديكور العمق البحري .. مهتمة حتى بالجانب اللوني التشكيلي .. وقليلة، حسب اطلاعي، هي المشاهد القصصية، التي عالجت، مثل هذا المشهد، التحام دوافع الموت – thanatos، بدوافع الحياة – erose ، وتشابكهما الآسر الذي هو في الحقيقة سرّ الحياة والحضارة وجوهر الإبداع، ورُسم بطريقة دينامية محكمة تفرض على الناقد نقل جزء منه (هو يمتد من الصفحة 128 إلى نهاية القصة على الصفحة 131) كدرس تعبيري مؤصّل : (.. أدركا أنهما هالكان لا محالة، والإخضرار من حولهما يزداد زرقة، كلما غاصا أكثر ناحية الظلمة . ازداد الضغط في صدريهما حتى شعرا أنهما يوشكان على الإنفجار كبالون هائل . مد كل منهما ذراعيه ليمسك بأصابع الآخر . جذبها نحوه، وهما يرتعشان معا وتركا جسميهما للتيار، وقد فتحا فميهما ليسري الماء الذي عرف طريقه على الفور، فظهرت الفقاعات مرة أخرى أمام وجهيهما، وراح الماء ينبّه الخلايا كي تتذكر ميلادها البدائي الأول كخياشيم لكائنات رائعة في نفس المكان حيث الكتلة الهائلة للماء الناعم ؛ مصدر الحياة الوحيد قبل أن تتحرر منه الكائنات وتكتشف في الجفاف حياة أخرى، أو تتحرر الكائنات من الجفاف لتكتشف في البحر عالما آخر . لا يهم . استقبلتها الخلايا بفرح العاشق لحظة أن يمس حبيبته في قبلة طويلة، ينفذ منها إلى عمق وجودها، وراحت وردات الرئة تتحوّر إلى دوائر لها أهداب تغيّر لونها الوردي الذي عاش طويلا داخل صدريهما حتى أصبح قرمزيا . تمدّدت الخياشيم التي نبتت بسرعة، وراحت تمتص رحيق الحياة من الماء الذي يندفع إليها، وتنشر راحة غير مسبوقة فوق وجهيهما، ثم انقبضت، لتكمل الدائرة، وهي تطرد الماء الزائد، قبل أن تستقبل ماءً جديدا محملا بأكسير الحياة، واهبا لهما طاقة وقوة على الإنفلات والهرب، وانفتح البحر اللانهائي أمامهما، مبشرا بعالم غير مستحيل – ص 131) .
للحفاظ على وجودهما الهش وسط عالم أصبح غابة، وللبقاء على سدّة الجمال، والتحصّن ضد القبح الذي لم يعرفا أي مدى بليغا ومهولا وصل، فقد اختار الزوجان حياة أخرى، تولد بين راحتي الموت ؛ اختارا العودة إلى الرحم الأمومي في أعلى ذروة خلودية تتسطر على موجة الإبداع . وأقول "موجة" لأنها تصعد ثم تهبط لتضمحل وتموت، الرومانسية تقتل الشجاعة مثلما كان الجنرال "فوش" يقول "إن الرفاه يقتل الشجاعة" . لقد حقق الزوجان "المساواة" التي كانا يبغيانها في فردوس الفناء المتشح بأردية الخلود الشاعرية . وهذا منفذ لا يقنع "عبود"، أو الرجل الملتحي ذا الشورت الطويل، أو الصبي الذي تجاسر ولمس جسد الزوجة، أو الصيادين الذين التهموا جسدها بأبصارهم، مثلا، هؤلاء ذوو الغرائز "العملية"، والنفس الضارية اليائسة التي ترى أن سر شقائها في هذا الكون هو الجمال لأنها لا تمتلك البنية العقلية المناسبة لفهمه والتعامل معه، والتنعم بنعمه .. إن محنة النفس العربية – المسلمة تحديدا – هي اليأس المرير من الحياة، ونفض اليد من ماء بحرها الذي تراه بحرا أسود، لا شعاع التماعة من الأمل تبرق على سطحه . ولن يكون البحث عن خيتينيا الجمال في هذا العالم الموحش الجائر إلا عبارة عن سلوك الطريق المستقيمة نحو الموت والهلاك .. إنها خيتينيا الخراب ..
فذلكة حول العنوان :
الآن يمكننا أن نعود لتناول موضوعة العنوان "خيتينيا" التي لن تكون "ثريا للنص " مطلقا مهما حاولنا من تأويلات واندفاعات متحمسة في الولاء للأطروحات البنيوية التي تسلمنا رايتها بعد أن غادرها منتجوها، ومن المؤسف أن يكون ماضي النقد الأوربي هو مستقبل النقد العربي . لا يمكن أن تتضح معاني العنوان "خيتينيا" إلا الآن حيث يمكننا وضع العنوان في موضعه الصحيح ضمن إطار الصورة الكلية (الجشطلت) كما أكدت أكثر من مرة سابقا . ومعنى (الخيتينيا) حسب هالة البدري هو قوقعة تعيش في شواطيء الأسكندرية ؛ تأكل الحيوان الذى بداخلها، وهى كبيرة الحجم بمقدار كف اليد، ولون الصدفة من الداخل براق جدا كما نرى الاصداف التى تُزيّن بها الموبيليا. ويقال إنها صدفة اللؤلؤ. وهذا معنى يختلف تماما عن التعريف ذي الطبيعة الشعرية الذي قدمته الزوجة متسقا مع بنيتها النفسية "الرومانسية" من ناحية، والدوافع المختزنة التي جاءت بها إلى مربض الطفولة من ناحية ثانية . الخيتينيا بالنسبة لها كائن "مؤنسن" ذو دموع ومشاعر . تقول الزوجة ردا على سؤال زوجها المستنكر بحثها عن "اللؤلؤ"! : (صدقني دموع الخيتينية أغلى عندي من اللؤلؤ . هي كائن ضعيف صغير يحتمي بالصدفة الخشنة، يبطنها باللون اللؤلؤي الأخضر المضيء بالبنفسج أحيانا، والأحمر أحيانا أخرى، ويشع دفئا، كما تشع حبة الرمل التي تدخل عشّه، ويلف عليها دموع الخوف، ويغلّفها لكي تصبح جوهرة رائعة، ويصبح هو في أمان – ص 122 و123) . ما هو الوضع الذي اشتُقت منه هذه الصورة المربكة؟ من أين استقت الزوجة هذا التصوّر "الشعري" لعمل الخيتينيا؟ وهل نشكل آليات فعل أي ظاهرة موضوعية بعيدا عن إسقاطاتنا الذاتية؟ إن معاني وتأويلات دور ما هو موضوعي – وأفضل من وضع أسس هذه النظرية، نظرية تحكم الفواعل الذاتية وانسرابها في مسارات التشكلات الموضوعية، هو المفكر الفرنسي "غاستون باشلار"- تتبلور نواه الدقيقة في نفوسنا، في غرائزنا ورغباتنا – المكبوت منها خصوصا – وترسم المخططات التشغيلية المستترة في مخيلتنا من خلال هجاساتها الإشباعية والتعويضية، وبعد ذلك حسب، تبدأ الإشادات الموضوعية الصلبة تنبني على هذه النوى، وظيفة وتأويلا . ولم تكن الزوجة فيلسوفة أو محللة نفسية حين لخّصت لب هذه النظرية بقولها : (الحياة كلها خيال حقيقي – ص 123) لكن الأديب هو أسبق المحللين التلقائيين الذين اكتشفوا قوانين النفس البشرية الفطرية المستعمية ثم جاء علماء النفس ليركبوا لها الأطر العلمية . لهذا قال معلم فيينا عن الأدباء : (إن الشعراء والروائيين حلفاء موثوقون وينبغي أن تثمن شهاداتهم عاليا، لأنهم يعرفون أشياء كثيرة ما بين السماء والأرض ليس بمقدور حكمتنا المدرسية بعد أن تحلم بها. إنهم أساتذتنا في معرفة النفس، نحن الناس العاديين، لأنهم ينهلون من ينابيع لم نجعلها في متناول العلم بعد- سجموند فرويد- الهذيان والأحلام في قصة "غراديفا" جنسن) . إن الوضع النفسي الذي تعيشه الزوجة هو الذي صاغ ملامح هذه الصورة للخيتينيا، الحيوان الذي لا يعرف معنى الدموع ولا الدفء ولا الإشعاع والعش بالمعاني "الإنسانية" التي أضفيناها على هذه المسميات عبر مسيرتنا البشرية المديدة . إن "اعتقاداتنا" الذاتية هي التي تبلور اصطلاحات الواقع الموضوعية ؛ كل ما يرسم على أرضية الواقع المادي القاسية يشتق من فضاء الواقع النفسي الصغير الهش المزحوم بالرغبات . الأصل في المعرفة أن "نتصور" فعل الظاهرة الموضوعية الذي تفرضه لحظة اللقاء المعرفية "الصوفية" المفعمة بالدهشة بين الظاهرة والعقل البدائي أبدا مادام يصدم بمستجدات الواقع والكون أبدا : (لا أعرف إن كانت الخيتينية هي بالفعل محارة اللؤلؤ أم لا .. لقد تصورتها كذلك لأنها من الداخل هي إضاءة اللؤلؤ . أنا أعتقد هذا وكفى . إعتقادي يضفي على القصة حقيقة، وإن كانت خيالا – ص 123) .
ملاحظة أخيرة: الزوجان بلا اسمين:
لقد تركت هالة بطليها بلا اسمين، صحيح أن هويتيهما كانتا واضحتين تماما، ولكن من دون الإسم تتشوش الهوية، ورغم أنها من سلالة حضارية كانت تستخدم اسمين للشخص الواحد معتقدة، أي الحضارة، أن معرفة الإسم الأصلي للإنسان تعرضه للمخاطر، إلا أنها حسنا فعلت حينما تركت بطليها غفلين من الأسماء . هذه الخطوة حققت درجة عالية من التماهي بين المتلقي و "بطليه" . إن الإسم، وهذه ليست قاعدة مطلقة بل تعتمد أيضا على الصورة الكلية، يخلق في بعض الأحايين "فاصلة" نفسية تعرقل الإقتداء والتعاطف . بهذا التصرف الإجرائي جعلت هالة بطليها بطلينا، أنموذجينا، رغم اندحارهما وهزيمتهما "الجمالية "، كانا، على أرض النص، نحن في اندحارنا وهزيمتنا الفعلية المتحققة على أرض الواقع .
د. حسين سرمك حسن
تصف " هاله " "زاوية" من الحال الذي صار إليه جسد الفتاة المحجبة التي تحاول ستر رأسها بالإيشارب حياء !!، والرجل الملتحي يرمي بها في لجة ماء الشاطيء : (لاحظت حين نهوضها التصاق البلوزة بصدر الفتاة، وتحديدها لتفاصيل وردات الدانتيل المصنوعة منه حمالات صدرها – ص 117) . ومع المشهد المكمل للأم التي تسبح مرتدية جلبابها بحيث ينكشف حزّ لباسها الداخلي، والآخر الذي تسبح فيه النسوة بالجلابيب "الشرقية" وتحتها البنطلونات " الغربية "، أستعيد مداخلة أخرى لفتحي بن سلامة استعان بها بشاهد من شعر "رينه ماريا – ريلكه " الذي كان من أكثر الشعراء الأوربيين إنصاتا إلى الجزع النابع من الطفرة الحديثة، يقول فيه: (كلّ انقلاب مبهم في العالم له محروموه من الميراث، بحيث أن ما كان لهم لم يعد ملكا لهم، وما يقترب منهم ليس لهم بعد) . ويعلق عليه ارتباطا بالفوضى العربية، ومنها فوضى قصة هاله البدري هذه، قائلا: (وجدت الجماهير نفسها محرومة من الميراث مضاعفة : بسقوطها في بؤس الفضاءات العمرانية الموحشة، وفي الفقر الذي يعتري تصوّرهم للمنزلة البشرية الجديدة التي فُرضت عليهم . وهكذا اندلعت على نطاق لا مثيل له مسارات عنيفة تتمثل في الإلغاء الذاتي . وما أقصده بمسارات الإلغاء الذاتي هو أشكال الخلع التي تحصل للناس عندما يُصبحون عاجزين عن فهم ظروف عالمهم بإحداثيات الحقيقة الخاصة بذاتيتهم . وعندما يصبحون مهددين في اهتمامهم بأنفسهم، وفي المواظبة على وجودهم، وفي متانة المشترك الذي يجمع بينهم . إذا كان البشر قادرين على تحمّل ظروف الفقر المادي القصوى، فإنهم إذا سقطوا في هذا الخلع لأنفسهم أصابهم اليأس وأصبحوا هاذين ومتمرّدين، وأدى بهم الأمر أحيانا إلى حالة من الفاقة التي تجعلهم يقبلون أي عملية ضخ للمعنى . خجل الإنسان من كونه ملغى ذاتيا يؤدي به إلى محاولة تفادي العالم في حاضره للبحث عن الأصل في ما وراءه، للنظر فيما إذا كان باب الأصل باعتباره الفردوس الأول للحقيقة لم يوصد بعد . هذه البنية الفعلية تفترض ولاشك حركة تراجعية أمام الانقطاع الذي أحدثته الطفرة الحضارية . فجملة ريلكه : "ما كان لهم لم يعد ملكا لهم، وما يقترب منهم ليس لهم بعد " تعني توقفا ورفعا لليد يذكّران بما سمّاه "هولدرلين" بـ "الوقف"، أي تلك اللحظة الخاوية الدقيقة للنقلة المأساوية التي يغيب منها كل ربط وكل مراوحة) . إنها مرحلة " الإله المكفهر" . وإذا كنت قد وضعت المشهدين السابقين ضمن إطار سلبي فلأنني الآن أقوم بتحليل رجوعي أو تراجعي أضع فيه الحوادث الابتدائية في ضوء "الصورة الكلية – GESTALT " التي تكوّنت لدي، فأنا ناقد أفسّر بعد جمع معطيات الإطار الشامل للقصة، ولست قارئا، أنتظر المفاجآت والمستجدات التي تكشفها القراءة الأولى . أما الزوجة فقد كان موقفها في بداية مسار الحوادث مغايرا تماما . لقد أعجبها المرح الذي تناثر حول الرجل الملتحي وفتاته في صخبهما العارم، مثلما أعجبها عدم انزعاج الآخرين من الرمل الذي يصيبهم مصادفة من تراشق اللاعبين (ص117). كانت تنظر إلى ما يجري، حتى الآن، بعين "ديمقراطية" إذا ساغ الوصف، رغم أن الكثير من الأفعال لا يناسب ثقافتها ومزاجها وتركيبتها النفسية وموروثها التربوي . ووفق نظرتها "الديمقراطية" المسالمة والمتصالحة مع الآخر والمحيط هذه، انتقلت إلى موقع "التبرير"، الذي كان يقف على سدته الزوج بحماسة . ففي البداية كانت هي التي تتذمر من الزحام الرعاعي، ومن تشوه ملامح مكان الطفولة، وتقترح إلغاء رحلتهما المنتظرة . وكان الزوج هو الذي يقدم لها الأعذار – وبعضها واه – فتقنع بها، وإن على مضض . أما الآن فالزوج هو الذي أصبح في موقع السخط والتذمر من هذه الفوضى الساحقة التي حوّلت الشاطيء الجميل إلى ما يشبه سوقا للسمك (ص 125)، ويعلن أنه قد ضيّع فرصة التراجع، التي كانت يجب أن تحصل منذ البداية، عندما شاهدا أن المكان قد أصبح شاطئا شعبيا . أما الزوجة فقد صارت هي التي تبرر و "تعقلن" أحيانا .. لم يكن لديها اعتراض على غزو الناس "الشعبيين" لشاطيء الحب والطفولة والجمال، فهي تتذكر أن النساء في الشواطيء الشعبية في "رأس التين" و "الأنفوشي" [كنّ] يسبحن في الصباح المبكر، وعند الغروب أيضا . وكانت جدتها تحرص على نزول البحر مع غروب الشمس حتى تبطل أفعال السحر الشرير كما كانت تقول لهم وهم صغار . ثم تقدم استنتاجا هو نواة برنامج تغييري حياتي ذي طبيعة متحضّرة ؛ برنامج يكفل للجميع حقوقهم الاجتماعية والنفسية : (المشكلة ليست الإزدحام، ولكن أن يقبلونا بعاداتنا، كما نقبلهم بعاداتهم . وألا نهرب، ونتقوقع أماكن خاصة بنا، والعالم كله لنا- ص 125) .
لقد قفزت شبه جملة طرحتها القاصة في المقطع الذي وصفت فيه أم الصبي التي كانت تلعب مع زوجها وابنها الكرة وترتدي الجلباب الذي التصق بجسدها الممتليء حتى بدت عارية تماما وهو : وخرجت ضفائر شعرها متمردة من تحت طرحتها (تمرح فوق ظهرها – ص 118) . إن الزوجة، ومن ورائها القاصة حتما، فالمؤلف بالنسبة لي لا يموت، وأنا أمسك بلحم أو عصب نصّه الحي الآن . منذورة للفرح والبهجة وتفتح الطاقات وحتى انفلاتها .. لم تكن لديها أية مشكلة تجاه هذا الصخب الأخاذ للطاقات البشرية الذي شاهدته، أبدا . كانت منذ طفولتها عرّابته بخلاف زوجها . فقد تعلمت، وهي طفلة، السباحة على يدي أبيها، الذي رفض أن ترتدي طوق النجاة الحامي في الحالات الطارئة، وألقى بها إلى الماء، حتى تقطعت أنفاسها . وبعد أسابيع تركها [= أبوها] للبحر، وهو مطمئن لعشقها له، وأمانها معه (ص 126) . أما زوجها، ومقابل هذه الطريقة " الغمرية – flooding " المباشرة و "الصادقة"، فقد كان تعلمه السباحة مراوغا، وفيه الكثير من اللاصدقية والمراوغة التي يبدو أنها انعكست على ملامح سلوكه الراشد . كان أبوه يخطط بقلم الكوبيا فوق ظهره كي يضمن عدم نزوله النهر، فكان يتفق مع زملائه أن يسبحوا، وأن يجففوا أجسادهم، ثم يعيدوا رسم الخطوط مرة أخرى، حتى لا ينكشف أمرهم (ص 126) . وبفعل التدريب الطفولي الغامر والطافح، بفعل هذا الترعرع المطمئن في أحضان الرحم المائي رغم قسوته النسبية، كانت، بوصف موجز وبليغ "كائنا مائيا " . وهذا ما تعلنه، باطمئنان، لزوجها الذي كان يخشى عليها كثيرا وهي تتنقل على صخور الجزيرة المسننة، فهو يعتقد أنهما لم يعودا صغارا، وأن طاقاتهما قد نضبت : (لا تخش شيئا . أنا كائن من كائنات البحر . حبي له كاف لكي يهبني الأمان حتى وإن غبت عنه طويلا – ص 122) . ونفسيا، وإبداعيا، فإن الأنثى كائن مائي، في حين أن الذكر كائن صخري، كائن من تراب .
وستثور تساؤلات مريرة ومحيرة في ذهن المتلقي : أين كانت تعيش هذه الزوجة "البريئة النوايا" – والنوايا البيضاء، كما هو معروف في التحليل النفسي، وفي الحياة العملية الجائرة على حد سواء، هي الطريق المستقيمة التي توصل إلى الكارثة - بحيث أنها قد تفاجأت بمظاهر الخراب هذه التي نبتت في كل مكان من حياتنا، ومن المحيط إلى الخليج؟ ألم تلاحق متغيرات السنوات الطويلة التي كان صدع التمزقات يمتد بهدوء مراوغ ليشرخ حياتنا كلها؟ . لكن السؤال المطرقة الذي سيدوي في أذهاننا هو : لماذا لم ينسحب الزوجان، قبل نزول قارعة الكارثة، وهما يشاهدان مظاهر الخراب الساحقة هذه؟ . لقد كان بإمكان الزوجين اتخاذ قرار العودة النهائي والحاسم، خصوصا وأنهما قد تأكدا تماما أنهما قد طردا إلى الأبد من شاطيء الفردوس المفقود . مظهر واحد بسيط ومباشر وشديد السمّية كان كافيا لأن يطوّح، وإلى الأبد، بكل آمالهما إلى هاوية اليأس الفاجعة، مظهرا شاهداه بأعينهما العضوية، وكان عليهما أن يحللاه بعيني بصيرتهما، وكان لزاما أن يدركا بوضوح قاس أن شبح الخراب قد أحكم قبضته على خناق الوجود العام بل خنقه إلى الأبد، هذا الشاهد الخرابي الصاعق أجلته إلى هذه اللحظة لأسباب نفستحليلية سأطرحها الآن، شاهد أمسكت به الزوجة في موقفين : الأول حين خلعت بلوزتها وبدأت العيون الجائعة تفترس جسدها، كل العيون مقبولة من وجهة نظر علم النفس إلا عيون الأطفال : (لم تسلم حتى من عيون الأطفال الذين تركوا قصور رمالهم، وحفرات الماء الواسعة التي ينزحون منها الماء ليبللوا الرمل، حتى يلين، ويطيع أياديهم، فتشكّله، وتركوا معها الدلاء، والرشاشات الملوّنة، ووقفوا يراقبون حركة الزوجين معا – ص 117) . هذه قرينة على "تعهير" الطفولة البريئة في ظل نظام تربوي محتشم .. لا تصدقوا هؤلاء الأوغاد الذين يزعمون تطهير الطفولة وهم يعهّرونها . عذرا يجب أن نتحدث بلسان تعرضي واقتحامي، فهؤلاء الذئاب لم يكتفوا بمحاصرة بيوتنا، بل دخلوا حتى إلى غرف نومنا، وطوّعونا على أن نسألهم عن الكيفية التي نضاجع بها نساءنا، وهم يلعبون بخواتمهم بتشف، ويردون بصبر مسموم .. سحبوا البساط من تحت أقدامنا نحن الذين نلقب أنفسنا بتنفج زائف بـ " الإنتلجنسيا " ! الإنتلجنسيا المهزومة التي تريد بائسة أن تجد لها موطأ قدم على هضبة التغيرات الجارفة !! إنتلجنسيا هشّة لا تستطيع سوى بناء يوتوبيات غير مسلحة .. هذا درس عظيم تقدمه هالة البدري، وليس شرطا أن تعرف هي تفصيلات مشروعها وأبعاده، فنحن نتحرك وفق حتمية لاشعورنا حسب الأطروحة "اللاكانية " – نسبة إلى "جاك لاكان" المحلل الفرنسي - .
... ثم يأتي سلوك مضاف ومحيّر من طفل آخر يجعلنا نعيد التساؤل: لماذا لم ينسحب الزوجان ويخلصا من النهاية المميتة؟ يأتي طفل صغير في التاسعة من عمره، أي أنه بدأ الآن بتعلم حروف الكتابة، ويلمس خصر الزوجة العاري ويبتعد !! ضع ألف علامة استفهام . حدس المرأة صادق في أغلب أحواله، وعقل الرجل كاذب في أغلب حالاته، هذه حقيقة نفسية ومعرفية ننكرها نحن الذكور، ذكور النحل والخواء، يعضدنا علماء النفس الذكور الذين يتصايحون حول حسد القضيب لدى الأنثى – penis envoy " ولا يلتفتون إلى حسد الذكر للأنثى لأنه لا "يخلق"، غير مخصّب، لا يُنجب . وعليه فإن المرأة هي مجس الإحساس بموجات الخراب حين تكون أداتها الطفولة : (جفلت حين شعرت بيد صغيرة تمتد نحوها . التفتت لترى صبيا في التاسعة من عمره، يلمس خصرها، فلما التقت عيونهما تراجع خطوتين إلى الوراء، دون أن تظهر عليه علامات دهشة أو خوف .
سألت زوجها :
-أتصدّق؟
- هو مجرد طفل فضولي لا أكثر . اعتاد أن يرى أمه تنزل إلى البحر بملابسها الرسمية "ضاحكا" – ص 118).
إن هذه الحادثة تحتمل المزيد من التأويل . فمن مخزونات اللاشعور الجمعي لمس جسد الأنثى كتعبير عن موقف "بدئي" مفاده أن شيئا من قدرة الخصوبة الغامرة التي يحفل بها الجسد الأنثوي الكريم سينتقل إلى الملامس، ويذكر "جيمس فريزر" صاحب "الغصن الذهبي" بأن هذا الفعل كان من الممارسات الطقسية لدى الكثير من الشعوب البدائية خصوصا لمس عجيزة المرأة . لكن هل ذهبنا بعيدا في طريق التأويل الأسطوري؟ ممكن . أليس هذا ما تريده ما بعد الحداثة الغربية؟ لكن هذا التأويل مسترخ ومترف في فضاء الكراهية والخذلان الذي أحاط ببطلة القاصة من كل جانب . إننا نعيش مرحلة "تتوحّش" فيها حتى الدوافع الطفولية البريئة . عن أي نماذج بدئية نتحدث؟ عالمنا العربي غير متوازن ويسير سريعا نحو العدائية والتكريه والتوحّش بسبب سياسات "إخفاء" المرأة من ناحية، وبسبب التنفير والتكريه الذي تتعرض له نوازع النفس البشرية الطبيعية من ناحية أخرى . حتى يمكننا القول أننا نخضع لثقافة لا ترى أن الإنسان حيوانا ناطقا واجتماعيا حسب بل، يا للغرابة، "حيوانا آثما" بالدرجة الأساس . الإنسان هو "حيوان خطّاء"، وحيث يوجد الإنسان يوجد خطر الخطيئة، والمصدر الأول والأخير لهذا الخطر هو المرأة ؛ جسدها تحديدا . وعليه يجب إخفاءه بأي طريقة، حتى صار أطفالنا يكبرون وهم لا يرون من الجسد الأنثوي سوى عتمته وظلمته وحضوره الشبحي . وقد جاءت الملامسة الفضولية من هذا الطفل وهي تحمل جانبا كبيرا من هذا الحافز . في كل المجتمعات تدور التابوات حول الأمور الأخلاقية والقيم السلوكية المعروفة، إلا في مجتمعاتنا فإنها تتمحور حول نواة واحدة تتفرع منها كل التحريمات وهو جسد الأنثى / الأم . إن الجفاف الجمالي الذي اكتسح حياتنا اليومية حتى أدخلنا في ما يشبه حالة من "الكآبة القومية"، سببه الرئيس هو "إخفاء" المكون الجمالي المركزي في الكون والحياة وهو المرأة، وتحديدا جسدها . وموقف هذا الطفل الذي لم يحمل أي علامة للدهشة أو الخوف وهو يتراجع يعكس كارثة مفادها التحرّش الطفولي النابع من "التوحّش" والجفاف الجمالي . وهذان العاملان يوصلان في النهاية إلى "تعهير" الطفولة البريئة التي نلاحظ الكثير من الأدلة عليها في البيت والمدرسة والشارع، وعلى امتدادها تمضي في طيات سلوك الراشدين من البشر لدينا .
وقفة : الشهوة تشتعل :
وفي أجواء التوتر هذه الذي كانت تبدو واضحة على الزوجة، والتي كان الزوج يحاول جاهدا ويكابر لإخفائها، تحصل حالة مدهشة، لم يكن أحد ليصدقها لو لم تثبتها البحوث والمصموت عنه في الحياة السرّية واليومية . فالقلق يشعل الغريزة الجنسية المباركة . إنه فعل دفاعي في وجه الموت والفناء . هذا ما كان يحصل لدينا كمقاتلين في الحروب الثلاث من انتعاضات، عندما كان يشتد القصف الرهيب، أو خلال مرحلة اليقظة والحذر إنتظارا لهجوم العدو . ويحصل لدى الطلبة أيضا، تقلصات وقذف في قاعات الإمتحان . وهناك انتعاضات المحتضر المعروفة . وقد اشتعلت رغبة الزوج في زوجته . وهنا تتجلى قدرة مضافة وتميّز أسلوبي لدى هالة البدري، حيث تعمد الكثير من القاصات إلى استثمار مثل هذه المواقف للإيغال في عرض الجسد الأنثوي – وجانب من ذلك يرتبط بالحفزات الإستعراضية والإستعرائية لديهن – وكأنهن يساهمن في "تسليع" الجسد الأنثوي الذي يعلنّ أنفسهنّ عادة إدانتهن له كسمة من سمات المجتمع الذكوري . تعرض هالة حالة الإلتحام الرائعة برشاقة تعبيرية وتختزل المواقعة الجنسية بلمحة سريعة حيية : (نزلا إلى القاع ليلمساه معا، وحين التفتا، لكي يصعدا، أمسك بخصرها بقوة، فتركت له حرية الشعور بامتلاكها حيث الألوان تتكسر بدلال، طوّقت عنقه بذراعيها، وهي تدفع الماء بساقيها اللتان تنفرجان وتنغلقان مثل مروحة. أتاحت لجسمه مباغتتها بسهولة . حاولت الإنفلات، وهي تشهق بدخول الهواء المفاجيء إلى رئتيها حين وصلت إلى السطح، لكنه لم يعطها الفرصة. كان قد أحكم قبضة ساقيه حول جسدها وأزاح القماشة بسهولة . جاءت موجة لا حواف لها. رفعت مستوى الماء، فارتفعا معا، وهبطت بهما في مكانهما، واستمر تأرجحهما حتى فاضا بعاطفة حارة انتقلت إلى كائنات البحر، فأطلقت بخورا ملوّنا ذا رائحة نفّاذة، وصل عبيرها إلى الأعماق المدهشة، التي كشفت لهما عن أسرارها منذ زمن طويل – ص 120 و121) . يا لروعة هذه المواقعة، وهي تجري في رحم البحر الأم . وأعتقد أن همنغواي – بسبب مكبوتاته وعنفه وميوله المثلية – كان مخطئا حين قال على لسان بطله في روايته "الشيخ والبحر" إن من المفروض أن نسمّي القمر "مونه" وليس "مون" – لا أعرف كيف أعبر عنها بالعربية وهذه هي الخيانات الحقيقية للترجمة - أي نؤنثه مادام البحر ينجذب إليه في حركة المد، وكأنه كائن ذكوري . إن الماء رمز مؤصل للرحم الأمومي المنعم . وفي الواقع الأسطوري والرمزي فإن القمر هو الذي يريد "العودة" إليه . والزوجان، وأمام ضغط الواقع الجائر، يبغيان، لاشعوريا طبعا، العودة إلى واحد من تمظهرات الرحم الأمومي الفردوسي الذي يوفر الحماية ضد تهديدات الواقع الجائر . صاغت هالة مقابلة مدهشة بين هذا العالم / الداخل المنعم، والعالم الخارجي المهدٍد، مقابلة رسمت فيها معالم صورة الفعل الخلاصي الباذخة من خلال الفعل الجنسي حيث يتجلى الله . ولا أعرف ما الذي حصل للحب في هذا العالم الجائر، فليست مجتمعاتنا حسب هي التي تعاني من هذا التوجّه ؛ في بحث إحصائي أجري على مجموعات من الشباب الغربيين، سئلوا فيه عن مفهومهم للرومانسية، فأجابوا بأنه الإتصال الجنسي بالحبيبة في البانيو أو تحت المطر في الحديقة .. حلوه؟! . إن فلسفة القاصة هنا تتجلى في رسالة مستترة ورمزية، وهي الرسائل الأكثر حكمة ورصانة وتأثيرا، مفادها أن علاج المحنة البشرية العاتية التي نعيشها تتمثل في هذا الإلتحام العزوم والحر الذي يتوفر تحت الخيمة الحمايوية الأمومية . إلتحام تحت أستار الطمأنينة على المجال الشخصي من الحرية . كسر العادة، حيث تميت الرتابة الدهشة وتخنقها بالصدأ . ومن المهم أن أشير هنا إلى دور القلق، ليس في إشعال نيران الرغبة المتوهجة وتصعيد ألسنتها حسب، كما قلت آنفا، ولكن في تجديد مفهوم المواقعة وأعادتها إلى سياقها الروحي، كتجل لروح الله .. كفعل انبعاثي يتحدى "المثكل" حسب الوصف الموفق لجدنا "جلجامش" ؛ كامتداد خلودي مؤصل يوفر للإنسان الإحساس الصلب بالديمومة، وبأنه عصي على الفناء . اشعت البهجة المحيية المنبعثة من الفعل الجنسي على الوجود الفردي والجمعي : (خرجا متسائلين في صمت : لماذا لم يقتربا من نشوتهما هذه طوال هذه المعرفة بالبحر؟ أجاب : -لا يهم ما فات . لكن المهم أنه يحدث الآن . أرادت أن تنام في حضنه، وألّا تعود إلى الشاطيء أو إلى الجزيرة . أن تنام فحسب . وضع يديه تحت خصرها، وتركها لحنوّ الموجة، كي تطفو بها . كان البحر لهما، رغم الخيالات البعيدة التي تظهر كنقاط سود فوق الجزيرة، والأبنية العالية التي تقف بصلابة خلف الشاطيء .. اختفى البشر من مرمى الرؤيا – ص 121) .
عودة إلى حلم الفناء :
وبمزاج رائق بعد التجربة "الإلهية" التي خاضاها، والتي منحتهما شعورا منعشا بالتجدد والإنبعاث، وبعد أن امتلكا الماضي الذي اختفى، وصارت كل البحار بحرهما كما يقول الزوج، قررا استعادة الحلم المركزي الذي افتقداه طويلا، وهو الاصطياد في جزيرة "ميامي" التي شهدت لقاءاتهما في الصبا . هذه العملية تهم الزوجة، ذات المهارة العالية في الغوص وصيد القواقع دون الحاجة إلى التنفّس، بدرجة أكبر . كان زوجها يخاف عليها، فهو يرى أنهما لم يعودا صغيرين، وأن الغوص في الجانب الثاني من الجزيرة المقابل للبحر يتطلب قوة جسدية كبيرة، ويتضمن مخاطر جسيمة حيث الأمواج العالية . أما الزوجة فهي واثقة مطمئنة ترى أنها "كائن من كائنات البحر" وأنها تريد جمع بعض محارات "الخيتينيا" التي أحبتها بشغف ملتهب منذ طفولتها . وفي لمحة سريعة، وهذه عادة هالة في تعرية الواقع المتردي، تشير الزوجة أن محارات الخيتينيا اختفت حتى من المحلات تماما لأنها (تذهب إلى الفنادق ذات الخمسة نجوم مباشرة – ص 122) . وليس عفويا اختيار محارة الخيتينيا أبدا كما سنرى في النهاية ؛ القاص المحترف لفن السرد لا يقع في مثل هذه المصيدة . إن هذه الترابطات التلقائية التي تمتد خفية بين المكونات والرموز والأشياء التي يتعرض إليها الكاتب والتي تظهر وكأنها تلقائية وبلا قصدية، وأحيانا حتى عشوائية في النظر المباشر، ثم تتضح جوهرية دورها السردي وإحكامه، قد برع فيها شارل فلوبير ومارسيل بروست في الأدب العالمي وليس هنا مجال التطرق إلى هذه العطايا لأنني قد تعرضت لها في دراسات سابقة . لا أستطيع إهمال دور الحركات الجزئية والمشاهد العابرة في إحكام صلة الحلقات السردية، والتمهيد لبناء المناخ النفسي العام، التوتري، للحدث . كل خطوة محسوبة في قصة هالة من حيث موضعها المناسب في تشكيل اللوحة النهائية . فحينما يقود الزوج زوجته نحو البحر، يعبر بها جسرا خشبيا متهالكا، ارتص عليه الصيادون . يشعر الزوج، وهو يحيط زوجته بذراعيه، بتوترها المربك، ويقودها عبر الجسر هذا : (أمسك أحدهم [= الصيادون] بسمكة. عم الفرح وجوه الصبية المتفرجين، الذين كانوا يتنقلون بعيونهم بينها وبين السمكة، التي تجاهد لتفر من الأسر . تحلقوا حول الصياد، وهو يخلصها من الصنارة، ويضعها في المقطف – ص 119) . وحين تستكمل الصورة الكلية، وتصل ذروة النهاية الفاجعة ستسترجع- إذا كنت "قرّاء- على وزن فعّال"، وليس "قارئا- على وزن فاعل"- وهذا ما يتطلبه الفهم والتأثر بالنصوص الكبيرة – الأحداث الصغيرة التي ستشعرك بفداحة الخسارة الرهيبة ؛ ستستعيد صورة السمكة التي اقتنصت مع مرور الزوج والزوجة المتوترة التي كان الجميع ينقّل بصره الحاد والمتلصص بين جسدها، وبين جسم السمكة - والسمكة رمز أنثوي ؛ رمز عشتاري - الذي يلبط يائسا قبل إخمادة الموت التي ستأتي قريبا . ويمكن للناقد والقاريء النظر، وفق المقترب الفني البنائي نفسه إلى اللمحة، التي قد تبدو عابرة وجزئية، وفي حركة تراجعية - RETROGRADE " مستعادة ستلتحم مع الاحتدام النفسي الأخير، التي تصور بها القاصة الكيفية التي يحكم بها الزوج يده على كتف زوجته، وهو يعبر بها خشبة ناقصة من جسم الجسر الخشبي . كان يزيد من قبضته وحرصه، كلما توغلا في طريقهما، وتناقصت الأخشاب . هو تدبير حركي درامي يحمل سمة سينمائية، وهي من سمات الحداثة في السرد، أي أن توازي تصويريا، وانفعاليا، كما سيترتب على ذلك، بين المفردات الحركية الجزئية، وإسقاطات الانفعالات الصاخبة، لكن المكتومة لشخوص القصة . نحن نُعد، عبر استقبال توتر الزوجين أمام نقصان خشبات الجسر التي قد تسبب أذى بليغا للعابر "البريء" مثل هذين الزوجين اللذين أتيا بعد غياب طويل، أوقعهما في ورطة واضحة تستحق ليس النقد، بل حتى الإدانة . إنهما، ومن جديد، لا يعرفان ماذا حصل لـ "الجسر" ! هل يُعقل ذلك ؛ هل يُعقل أن شخصين ترعرعا في مكان احتفظ بذكريات طفولتهما – وعلميا يحتفظ الطفل حتى بذكريات السنة الثانية – لا يعلمان ما الذي حصل من تطورات فيه، وكلها "تطورات " خرابية؟! . أين كانوا؟ وهل كانوا يعانون من حرمان حسّي لا يتيح لهم التعرف على المعلومات والمتغيرات؟ إنه لأمر عجيب، وهي قنبلة معرفية تفجرها هاله البدري . المثقفون العرب غائبون في ضبابية سراب آيديولوجي يحسبه الظمآن الثقافي ماء، أو محلقون على أجنحة غيمة رومانسية خدرة يتهاوون منها حين تحضر "الفكرة"، فكرة الخراب، وتذهب "السكرة"، سكرة الهوامات وأحلام اليقظة. لا أدري لمَ أشعر هنا بضرورة استعادة ما كتبه الروائي العراقي المبدع " علي بدر " عن الفارق الهائل بين سيكولوجية المثقف أو المتعلم الذي يحسب الاحتمالات المعرفية بانهمام مفرط، ويضيع عن الواقع وهو في غمرة حساب هذه الاحتمالات الشائكة، وبين البشر السوقة الذين يعرفون بدقة أن غاياتهم تكمن في "قضيبهم"، وفي ثأرهم المستدخل الذي لا يؤجل، هم السوقة السِفلة الجسراء والتعرضيون الذين لا يتمتعون بالقدرات المعرفية و"البلاغية" لنا نحن المثقفين كما نوصف. نحن الذين أزحنا أنفسنا عن الموقع التاريخي " المنتظر " و " الإنقاذي " الذي صممه التاريخ لنا كمثقفين . إن الخطيئة لصيقة بنا، والمثقف العربي هو "مثقف آثم " . يتحدث علي بدر عن واحدة من شخصياته في روايته (صخب ونساء وكاتب مغمور) وهو (عبّود) النائب العريف الذي لم يستطع أن يكون نائب ضابط، وإذا به – بعد انقلاب الرابع عشر من تموز في العراق – وإذبه بعد تدهور الأحوال، ودوام الحال كما هو معروف من المحال، حصل انقلاب الثامن من آذار، فأطاح بالمقدم " محمود الماوردي" وصار يشعر بأنه يضاجع عشيقته وهي تلبس رتبة المقدّم . لكن المقدم قتل في انقلاب الثامن من شباط الجديد، فبدأت امتيازات العشيقة تتناقص بصورة بالغة خصوصا وشعرت أنها لا تستطيع "ضبط" قدرتها على الصرف، فبدأت بالاستدانة من النائب العريف، سائق عشيقها المقدم الراحل، وتراكمت عليها الديون، فاضطرت إلى قبول الزواج منه : عبود الذي عاش حياته طبقا إلى مواهبه في العيش، وهذا ما يفسر سر هذه الافعال المركّبة التي كان يجيد فعلها ن هذه الحركة السريعة في الصعود والهبوط ترتبط بموقفه الفطري من الحياة، فثبات العالم وسكونه هما من خصائص المتعلمين لا من خصائص الناس البسطاء. المتعلمون يعيشون الحياة من خلال نسق بالكاد أن يتغير وإن أي تغيّر يدمر حياتهم، أما هؤلاء الناس فالأمر مختلف معهم . إنهم يعيشون التناقضات كلها دون أدنى شعور بعذاب الضمير، فعبود الذي كان شيوعيا، كان متدينا أيضا، غير أن دينه هامشي وفطري ويسمح له أن يتزوج امرأة سيئة السمعة، ويسمح له أن يسرق من المطحنة ويجمع المال، الشيء المهم في حياة هذه الشخصية ذات المعتقدات الخرافية هي الجرأة والانشباك في التجارب الطاحنة) .
ومن تلك الوقفات الجزئية والمشاهد العابرة ذات المهمة التحضيرية للخاتمة المدمرة، هي عودة الزوجة الظافرة وهي تحمل بيديها قوقعة خيتينيا حيث دار الحوار المناوب!! : الزوج: كانت قسمة عادلة . أنا اصطاد السمك، وأنت تصطادين القواقع . الزوجة : لا أحب اصطياد السمك لأني أحبه حيّا، ولا أريد أن أراه يموت . (ضاحكة) لكنني أنسى هذا عندما آكله ! الزوج : آكل ومأكول . غالب ومغلوب. ولأننا الآكلون في حالة السمك، ننسى هذا، ولا نفكر في صراع الحياة والموت، صراع الصياد والفريسة – ص 124) . إن القاصة توسّع الرؤيا هنا إلى طبيعة الصراع الأزلي الي تدور رحاه في ساحة النفس البشرية بين دوافع الموت ودوافع الحياة . فالإنسان "حيوان معادي" إذا ساغ الصوف . وهذا الاستنتاج : إن العالم عبارة عن آكل ومأكول جاء بين موقفين مهمين : الأول هو السؤال الذي وجهه للزوج واحد من روّاد الجزيرة الذين بدأو يتقاطرون ويراقبون حركات الزوجة :
- هل تعرفها؟
- زوجتي .
وليس التحسّب من طبيعة "الرومانسيين" الشفافين . أما الثاني فهو الاستنتاج الذي وصل إليه الزوج : لم تعد الأسكندرية وشواطؤها مناسبة لنا، وصار موضوعا للجدل بينه وبين زوجته التي ترى أن عليهما أن لا يهربا ويتقوقعا . أعود من جديد للقول أن الزوجين الجميلين لم يكونا يعرفان حجم الخراب الذي حصل في الواقع المحيط بهما، وقد صحيا صحوة متأخرة وهما على "حافة بعد فوات لأوان" إذا جاز التعبير، صحوة كلفتهما حياتيهما كاملتين، وإلى الابد . كان منشغلين في جمع القواقع بروح "شعرية" في حين كانت غرائز العدوان في نفوس من يحيطون بهم تشرع في إشهار مناجلها الباشطة . فكلما اقتربا من الشاطيء كانا يلاحظان كثافة السابحين عن بعد . كان بحر العالم المحيط بهما يهيج كلّه ويضيّق الخناق عليهما، وينذر بطوفان محتقن من الغرائز المهلكة، في الوقت الذي كانا فيه عائمين على موجة علاقتهما الحبية الناعمة، مغيبي الوعي عن الشر المستطير الوشيك، بسبب حسّهما الجمالي المفتن الخدر . تتضح هذه المقارنة الذكية من خلال وصف القاصة لآخر المشاهد "الرومانسية" في القصة قبل أن تنزل قبضة العدوان الشرسة ضربتها المدوّية : (كلما اقتربا من الشاطيء لاحظا كثافة السابحين عن بُعد . كان العدد أكبر بكثير مما توقعا . ضربا الماء بسواعدهما علة مهل . أمسك بالصدفة، ووجهها نحو الشمس التي بدأت رحلة غروبها، حتى عكس الضوء نحو عينيها . اقتربت منه، والمكر يطل من رعشة فمها المكبوحة، مغمضة العينين، حتى لم يعد يستطيع أن يسلط الشعاع على وجهها . خطفت منه القوقعة، وسلّطتها ناحية الماء . غاص وراء الشعاع الضعيف، وعاد فاتحا كفيه، قائلا:
أتيت لك بالشمس الأرجوانية – ص 126) .
ويبدو أن غريزة تدمير الذات حسب النزعات المازوخية التي ننكرها عادة تشتغل بخفاء وسرّانية مراوغة . لم يتنبه الزوجان إلى العلامات المّنذرة التي كانت تتزايد لحظة بعد أخرى . ظلا يسبحان إلى أن تعبا .. وإلى أن حلّ الظلام .. فوفّرا (من دون أن يعلما) الشرط الأخير ليس لاقتراف أية رجيمة حسب، بل لانفلات غرائز العدوان في ظلمة النفس البشرية الآثمة مستترة بظلام الخارج . والآن فقط، وبعد لاحظا أن رؤوسا كثيرة تسبح نحوهما، التقت عيناهما على الحقيقة الفظيعة، الآن فقط استشعرا الخطر الداهم المبهم فقررا أن يخرجا من البحر بسرعة : (دبّ الخوف في أعصابهما للمرة الأولى . لم تفهم لماذا أصبحا فجأة هدفا لكل هؤلاء الرجال والصبية . فكّرت: هل يكون السبب أنني امرأة؟ النساء في البحر كثيرات، لكنهن يلعبن في الماء بجلباب طويل يرتدينه فوق بنطلون، وأنا الوحيدة التي ترتدي (المايوه) – ص 127) . والآن فقط أيضا يركبهما الشعور الممض بالندم من الإنساق لرغبتهما العارمة في اصطياد الخيتينيا، فقد ظهر أنها خيتينيا الخراب والموت والدمار، ولكن ساعة مندم، فقد سبق سيف العدوان، العاشقين الأعزلين، ومن هنا، ستمضي القاصة في تصوير مشهد لمطاردة الختامي المرعب في غاية الروعة والتماسك، تصوّره بعين "سينمائية" خلاقة تجسد المشهد العريض النهائي الأسود أمامنا بقدرة فائقة، حيث تتابع الصراع المستميت الذي يبذله الزوجان من أجل الخلاص، والتقرب الخانق والمخيف الذي تقوم به حلقة الرجال السِفلة . تصوّر "هاله" التفصيلات الحركية وتقلصات الأجسام .. متسقة مع ديكور العمق البحري .. مهتمة حتى بالجانب اللوني التشكيلي .. وقليلة، حسب اطلاعي، هي المشاهد القصصية، التي عالجت، مثل هذا المشهد، التحام دوافع الموت – thanatos، بدوافع الحياة – erose ، وتشابكهما الآسر الذي هو في الحقيقة سرّ الحياة والحضارة وجوهر الإبداع، ورُسم بطريقة دينامية محكمة تفرض على الناقد نقل جزء منه (هو يمتد من الصفحة 128 إلى نهاية القصة على الصفحة 131) كدرس تعبيري مؤصّل : (.. أدركا أنهما هالكان لا محالة، والإخضرار من حولهما يزداد زرقة، كلما غاصا أكثر ناحية الظلمة . ازداد الضغط في صدريهما حتى شعرا أنهما يوشكان على الإنفجار كبالون هائل . مد كل منهما ذراعيه ليمسك بأصابع الآخر . جذبها نحوه، وهما يرتعشان معا وتركا جسميهما للتيار، وقد فتحا فميهما ليسري الماء الذي عرف طريقه على الفور، فظهرت الفقاعات مرة أخرى أمام وجهيهما، وراح الماء ينبّه الخلايا كي تتذكر ميلادها البدائي الأول كخياشيم لكائنات رائعة في نفس المكان حيث الكتلة الهائلة للماء الناعم ؛ مصدر الحياة الوحيد قبل أن تتحرر منه الكائنات وتكتشف في الجفاف حياة أخرى، أو تتحرر الكائنات من الجفاف لتكتشف في البحر عالما آخر . لا يهم . استقبلتها الخلايا بفرح العاشق لحظة أن يمس حبيبته في قبلة طويلة، ينفذ منها إلى عمق وجودها، وراحت وردات الرئة تتحوّر إلى دوائر لها أهداب تغيّر لونها الوردي الذي عاش طويلا داخل صدريهما حتى أصبح قرمزيا . تمدّدت الخياشيم التي نبتت بسرعة، وراحت تمتص رحيق الحياة من الماء الذي يندفع إليها، وتنشر راحة غير مسبوقة فوق وجهيهما، ثم انقبضت، لتكمل الدائرة، وهي تطرد الماء الزائد، قبل أن تستقبل ماءً جديدا محملا بأكسير الحياة، واهبا لهما طاقة وقوة على الإنفلات والهرب، وانفتح البحر اللانهائي أمامهما، مبشرا بعالم غير مستحيل – ص 131) .
للحفاظ على وجودهما الهش وسط عالم أصبح غابة، وللبقاء على سدّة الجمال، والتحصّن ضد القبح الذي لم يعرفا أي مدى بليغا ومهولا وصل، فقد اختار الزوجان حياة أخرى، تولد بين راحتي الموت ؛ اختارا العودة إلى الرحم الأمومي في أعلى ذروة خلودية تتسطر على موجة الإبداع . وأقول "موجة" لأنها تصعد ثم تهبط لتضمحل وتموت، الرومانسية تقتل الشجاعة مثلما كان الجنرال "فوش" يقول "إن الرفاه يقتل الشجاعة" . لقد حقق الزوجان "المساواة" التي كانا يبغيانها في فردوس الفناء المتشح بأردية الخلود الشاعرية . وهذا منفذ لا يقنع "عبود"، أو الرجل الملتحي ذا الشورت الطويل، أو الصبي الذي تجاسر ولمس جسد الزوجة، أو الصيادين الذين التهموا جسدها بأبصارهم، مثلا، هؤلاء ذوو الغرائز "العملية"، والنفس الضارية اليائسة التي ترى أن سر شقائها في هذا الكون هو الجمال لأنها لا تمتلك البنية العقلية المناسبة لفهمه والتعامل معه، والتنعم بنعمه .. إن محنة النفس العربية – المسلمة تحديدا – هي اليأس المرير من الحياة، ونفض اليد من ماء بحرها الذي تراه بحرا أسود، لا شعاع التماعة من الأمل تبرق على سطحه . ولن يكون البحث عن خيتينيا الجمال في هذا العالم الموحش الجائر إلا عبارة عن سلوك الطريق المستقيمة نحو الموت والهلاك .. إنها خيتينيا الخراب ..
فذلكة حول العنوان :
الآن يمكننا أن نعود لتناول موضوعة العنوان "خيتينيا" التي لن تكون "ثريا للنص " مطلقا مهما حاولنا من تأويلات واندفاعات متحمسة في الولاء للأطروحات البنيوية التي تسلمنا رايتها بعد أن غادرها منتجوها، ومن المؤسف أن يكون ماضي النقد الأوربي هو مستقبل النقد العربي . لا يمكن أن تتضح معاني العنوان "خيتينيا" إلا الآن حيث يمكننا وضع العنوان في موضعه الصحيح ضمن إطار الصورة الكلية (الجشطلت) كما أكدت أكثر من مرة سابقا . ومعنى (الخيتينيا) حسب هالة البدري هو قوقعة تعيش في شواطيء الأسكندرية ؛ تأكل الحيوان الذى بداخلها، وهى كبيرة الحجم بمقدار كف اليد، ولون الصدفة من الداخل براق جدا كما نرى الاصداف التى تُزيّن بها الموبيليا. ويقال إنها صدفة اللؤلؤ. وهذا معنى يختلف تماما عن التعريف ذي الطبيعة الشعرية الذي قدمته الزوجة متسقا مع بنيتها النفسية "الرومانسية" من ناحية، والدوافع المختزنة التي جاءت بها إلى مربض الطفولة من ناحية ثانية . الخيتينيا بالنسبة لها كائن "مؤنسن" ذو دموع ومشاعر . تقول الزوجة ردا على سؤال زوجها المستنكر بحثها عن "اللؤلؤ"! : (صدقني دموع الخيتينية أغلى عندي من اللؤلؤ . هي كائن ضعيف صغير يحتمي بالصدفة الخشنة، يبطنها باللون اللؤلؤي الأخضر المضيء بالبنفسج أحيانا، والأحمر أحيانا أخرى، ويشع دفئا، كما تشع حبة الرمل التي تدخل عشّه، ويلف عليها دموع الخوف، ويغلّفها لكي تصبح جوهرة رائعة، ويصبح هو في أمان – ص 122 و123) . ما هو الوضع الذي اشتُقت منه هذه الصورة المربكة؟ من أين استقت الزوجة هذا التصوّر "الشعري" لعمل الخيتينيا؟ وهل نشكل آليات فعل أي ظاهرة موضوعية بعيدا عن إسقاطاتنا الذاتية؟ إن معاني وتأويلات دور ما هو موضوعي – وأفضل من وضع أسس هذه النظرية، نظرية تحكم الفواعل الذاتية وانسرابها في مسارات التشكلات الموضوعية، هو المفكر الفرنسي "غاستون باشلار"- تتبلور نواه الدقيقة في نفوسنا، في غرائزنا ورغباتنا – المكبوت منها خصوصا – وترسم المخططات التشغيلية المستترة في مخيلتنا من خلال هجاساتها الإشباعية والتعويضية، وبعد ذلك حسب، تبدأ الإشادات الموضوعية الصلبة تنبني على هذه النوى، وظيفة وتأويلا . ولم تكن الزوجة فيلسوفة أو محللة نفسية حين لخّصت لب هذه النظرية بقولها : (الحياة كلها خيال حقيقي – ص 123) لكن الأديب هو أسبق المحللين التلقائيين الذين اكتشفوا قوانين النفس البشرية الفطرية المستعمية ثم جاء علماء النفس ليركبوا لها الأطر العلمية . لهذا قال معلم فيينا عن الأدباء : (إن الشعراء والروائيين حلفاء موثوقون وينبغي أن تثمن شهاداتهم عاليا، لأنهم يعرفون أشياء كثيرة ما بين السماء والأرض ليس بمقدور حكمتنا المدرسية بعد أن تحلم بها. إنهم أساتذتنا في معرفة النفس، نحن الناس العاديين، لأنهم ينهلون من ينابيع لم نجعلها في متناول العلم بعد- سجموند فرويد- الهذيان والأحلام في قصة "غراديفا" جنسن) . إن الوضع النفسي الذي تعيشه الزوجة هو الذي صاغ ملامح هذه الصورة للخيتينيا، الحيوان الذي لا يعرف معنى الدموع ولا الدفء ولا الإشعاع والعش بالمعاني "الإنسانية" التي أضفيناها على هذه المسميات عبر مسيرتنا البشرية المديدة . إن "اعتقاداتنا" الذاتية هي التي تبلور اصطلاحات الواقع الموضوعية ؛ كل ما يرسم على أرضية الواقع المادي القاسية يشتق من فضاء الواقع النفسي الصغير الهش المزحوم بالرغبات . الأصل في المعرفة أن "نتصور" فعل الظاهرة الموضوعية الذي تفرضه لحظة اللقاء المعرفية "الصوفية" المفعمة بالدهشة بين الظاهرة والعقل البدائي أبدا مادام يصدم بمستجدات الواقع والكون أبدا : (لا أعرف إن كانت الخيتينية هي بالفعل محارة اللؤلؤ أم لا .. لقد تصورتها كذلك لأنها من الداخل هي إضاءة اللؤلؤ . أنا أعتقد هذا وكفى . إعتقادي يضفي على القصة حقيقة، وإن كانت خيالا – ص 123) .
ملاحظة أخيرة: الزوجان بلا اسمين:
لقد تركت هالة بطليها بلا اسمين، صحيح أن هويتيهما كانتا واضحتين تماما، ولكن من دون الإسم تتشوش الهوية، ورغم أنها من سلالة حضارية كانت تستخدم اسمين للشخص الواحد معتقدة، أي الحضارة، أن معرفة الإسم الأصلي للإنسان تعرضه للمخاطر، إلا أنها حسنا فعلت حينما تركت بطليها غفلين من الأسماء . هذه الخطوة حققت درجة عالية من التماهي بين المتلقي و "بطليه" . إن الإسم، وهذه ليست قاعدة مطلقة بل تعتمد أيضا على الصورة الكلية، يخلق في بعض الأحايين "فاصلة" نفسية تعرقل الإقتداء والتعاطف . بهذا التصرف الإجرائي جعلت هالة بطليها بطلينا، أنموذجينا، رغم اندحارهما وهزيمتهما "الجمالية "، كانا، على أرض النص، نحن في اندحارنا وهزيمتنا الفعلية المتحققة على أرض الواقع .
د. حسين سرمك حسن