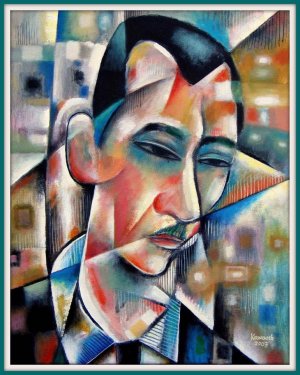خبر قديم كانت صحيفة عراقية قد نشرته في عام 1964 أعادني إلى بدر شاكر السياب. ليس إلى شعره الذي مع انقضاء السنوات نسيتُ أكثره، بل إليه هو، «بدر»، كما كنا نسميه لدوام حضوره بيننا. هذا ولم يكن أحد منا قد رآه. حسن خليل رأى شخصا يشبهه في بوسطة كانت تقلّ ركابها إلى الشياح. وهذا كان أخاه على الأغلب وليس هو نفسه، طالما أننا كنا في سنة 1968 وكان بدر قد مات قبل ذلك بسنتين.
لكن لماذا لم تكلّمه يا حسن، لماذا لم تسأله؟ أجاب أنه ظلّ يحمّس نفسه ليقوم بذلك إلى حين فاجأه ذاك الرجل بالنزول بعد أمتار من مستديرة الطيونة. كنا نحبّ أن نعرف عن بدر شاكر السياب. هو مَن حفّزنا إلى ذلك، أقصد شعره، وها إنني من بين ما لم تنسني إياه السنوات، ابنه غيلان واعتذار بدر له بسبب ابتعاده عنه متنقّلا بين المشافي؛ وكذلك زوجته إقبال التي كتب لها «الملتقى بك والعراق على يديّ هو اللقاء» لكن من منفاه هذه المرّة. كما لم أنسَ «جيكور» قريته التي اكتفيتُ من تخيّلها ببيوت طين وشجرات نخيل وأشياء قليلة أخرى، بينها تلك الشناشيل الملونة على نافذة ابنة الجلبي، ثم «بويب» ذلك النهر الذي فوجئت حين قال لي صديق عاد من رحلة إلى العراق أنه ساقية بالكاد. كان شعر السياب قد أحيا مخيلاتنا وملأها بماء «بويب»، دفّاقا صافيا. كنا نقول لبعضنا بعضا إن السياب ليس شاعرا فحسب، بل هو ناقل لعالم عايشه إلى فضاء الشعر. ولا يعود ذلك إلى أخذه لنا إلى ذلك القرب من ماء بلاده وترابها ونخيلها ونسائها، سواء كنّ معشوقاتٍ أولئك الأخيرات، أو جدّات «يوشوشن عن حزام وكيف شقّ القبر عنه أمام عفراء الجميلة».
كنا نتقفى أثر بدر شاكر السياب، كأن من أجل أن نجمع من الأخبار الصغيرة لتكون معرفتنا بحياته كاملة. ولم ننس شيئا مما كنا نسمع من تلك النتف القليلة. مثلا لم ننسَ ما كتبه أنسي الحاج، هو الذي عرفه هنا في بيروت، عن مشية السياب التي يثقلها وجع ظهره. كما أننا بقينا سنوات نتساءل عمّا حل بابنه وبزوجته بعد رحيله. وفي يوم ما من أيام الثمانينيات المنقضية ذهبت لحضور أمسية أحيتها آنذاك لميعة عباس عمارة. ما ذهبت لأسمعه، أو لأراه، هو السياب طالما أنه كان مولعا بلميعة، كما كان قد تناهى إلى أسماعنا آنذاك.
على الدوام كنا نبحث عن السياب، الشخص، بل الشاعر، كأن شعره أظهر لنا عن روحه ولم يبق إلا أن نعرف في أي إهاب كانت تسكن هذه الروح. وما زال ذلك الفضول القديم مقيما فينا. من ذلك مثلا صورة تلك القصاصة على الفيسبوك. «تعال انظر» سمعت زوجتي تقول عن الشرفة. كان خبرا صغيرا في صفحة تعنى بالإخطارات التي تعلن عنها إدارات الدولة في جريدة صدرت بتاريخ 12ـ 8 ـ 1964. أما مضمونه فكان إخطارا لبدر شاكر السياب بأن إجازته المرضية قد انتهت وأن عليه أن يعود إلى العمل في خلال ثلاثين يوما وإلا يُعتبر مستقيلا من الخدمة. وقّع الإخطار يومذاك المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية. أما العودة إليه، إلى نشره على الفيسبوك بعد أربعة وخمسين عاما فكانت من طلال طعمة الذي أراد، بعد انقضاء كل هذه المدة، أن يُطلع عليه أصدقاءه الافتراضيين.
هناك آخرون أيضا يعملون مثلي على اقتفاء كل ما يتعلّق بالسياب. أحد المعلّقين على ما ورد في تلك القصاصة كتب، متذكرا السياب، «مطرٌ مطرٌ مطر»، غير مكترث بما يمكن أن يحمله الخبر من سجال حول أن يكون السياب مرؤوسا للعميد المدير العام، أو إن كان هذا الرئيس متقيدا بالقانون إلى حدّ عدم الاكتراث بأن الرجل مريض فعلا، وهو على شفير الموت، وقد مات فعلا بعد نحو أربعة أشهر من ذلك التاريخ.
لم أجد تعليقا أفضل من ذاك: «مطرٌ مطرٌ مطر»، على الرغم من أنني ما زلت ساعيا لأن أعرف أي شيء عن حياة السياب. ذاك أن من كتب ذاك التعليق بقي هناك بين اسم السياب وشعره. كأنه يعلن عن استمتاعه الباقي بتلك القصيدة الرائعة، وبعد ذلك لا شيء يهم.
السياب، وحده من بين مَن عرفنا شعرهم، يعيدنا شعره بهذا القدر إلى حياة كاتبه. هل هو شعره الذي يدعونا إلى ذلك؟ هل هي مأساته، مرضه الذي أودى به وهو في السادسة والثلاثين من عمره؟ هل هو حنيننا إلى جنته الأليفة التي صنعها لنا لنقيم فيها، والتي لم نغادر فيئها بعد؟ إلخ. لكن المهم هو قبولي في وقت ما بتلك النظرية التي تقول إن علينا أن نقرأ النص، الأدبي أو الشعري، بعد فصله عن كاتبه وقطْعه عنه. كنت قابلا بذلك ومصدقا له، على الرغم من تعلّقي بالسياب على النحو الموصوف أعلاه.
٭ روائي لبناني
لكن لماذا لم تكلّمه يا حسن، لماذا لم تسأله؟ أجاب أنه ظلّ يحمّس نفسه ليقوم بذلك إلى حين فاجأه ذاك الرجل بالنزول بعد أمتار من مستديرة الطيونة. كنا نحبّ أن نعرف عن بدر شاكر السياب. هو مَن حفّزنا إلى ذلك، أقصد شعره، وها إنني من بين ما لم تنسني إياه السنوات، ابنه غيلان واعتذار بدر له بسبب ابتعاده عنه متنقّلا بين المشافي؛ وكذلك زوجته إقبال التي كتب لها «الملتقى بك والعراق على يديّ هو اللقاء» لكن من منفاه هذه المرّة. كما لم أنسَ «جيكور» قريته التي اكتفيتُ من تخيّلها ببيوت طين وشجرات نخيل وأشياء قليلة أخرى، بينها تلك الشناشيل الملونة على نافذة ابنة الجلبي، ثم «بويب» ذلك النهر الذي فوجئت حين قال لي صديق عاد من رحلة إلى العراق أنه ساقية بالكاد. كان شعر السياب قد أحيا مخيلاتنا وملأها بماء «بويب»، دفّاقا صافيا. كنا نقول لبعضنا بعضا إن السياب ليس شاعرا فحسب، بل هو ناقل لعالم عايشه إلى فضاء الشعر. ولا يعود ذلك إلى أخذه لنا إلى ذلك القرب من ماء بلاده وترابها ونخيلها ونسائها، سواء كنّ معشوقاتٍ أولئك الأخيرات، أو جدّات «يوشوشن عن حزام وكيف شقّ القبر عنه أمام عفراء الجميلة».
كنا نتقفى أثر بدر شاكر السياب، كأن من أجل أن نجمع من الأخبار الصغيرة لتكون معرفتنا بحياته كاملة. ولم ننس شيئا مما كنا نسمع من تلك النتف القليلة. مثلا لم ننسَ ما كتبه أنسي الحاج، هو الذي عرفه هنا في بيروت، عن مشية السياب التي يثقلها وجع ظهره. كما أننا بقينا سنوات نتساءل عمّا حل بابنه وبزوجته بعد رحيله. وفي يوم ما من أيام الثمانينيات المنقضية ذهبت لحضور أمسية أحيتها آنذاك لميعة عباس عمارة. ما ذهبت لأسمعه، أو لأراه، هو السياب طالما أنه كان مولعا بلميعة، كما كان قد تناهى إلى أسماعنا آنذاك.
على الدوام كنا نبحث عن السياب، الشخص، بل الشاعر، كأن شعره أظهر لنا عن روحه ولم يبق إلا أن نعرف في أي إهاب كانت تسكن هذه الروح. وما زال ذلك الفضول القديم مقيما فينا. من ذلك مثلا صورة تلك القصاصة على الفيسبوك. «تعال انظر» سمعت زوجتي تقول عن الشرفة. كان خبرا صغيرا في صفحة تعنى بالإخطارات التي تعلن عنها إدارات الدولة في جريدة صدرت بتاريخ 12ـ 8 ـ 1964. أما مضمونه فكان إخطارا لبدر شاكر السياب بأن إجازته المرضية قد انتهت وأن عليه أن يعود إلى العمل في خلال ثلاثين يوما وإلا يُعتبر مستقيلا من الخدمة. وقّع الإخطار يومذاك المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية. أما العودة إليه، إلى نشره على الفيسبوك بعد أربعة وخمسين عاما فكانت من طلال طعمة الذي أراد، بعد انقضاء كل هذه المدة، أن يُطلع عليه أصدقاءه الافتراضيين.
هناك آخرون أيضا يعملون مثلي على اقتفاء كل ما يتعلّق بالسياب. أحد المعلّقين على ما ورد في تلك القصاصة كتب، متذكرا السياب، «مطرٌ مطرٌ مطر»، غير مكترث بما يمكن أن يحمله الخبر من سجال حول أن يكون السياب مرؤوسا للعميد المدير العام، أو إن كان هذا الرئيس متقيدا بالقانون إلى حدّ عدم الاكتراث بأن الرجل مريض فعلا، وهو على شفير الموت، وقد مات فعلا بعد نحو أربعة أشهر من ذلك التاريخ.
لم أجد تعليقا أفضل من ذاك: «مطرٌ مطرٌ مطر»، على الرغم من أنني ما زلت ساعيا لأن أعرف أي شيء عن حياة السياب. ذاك أن من كتب ذاك التعليق بقي هناك بين اسم السياب وشعره. كأنه يعلن عن استمتاعه الباقي بتلك القصيدة الرائعة، وبعد ذلك لا شيء يهم.
السياب، وحده من بين مَن عرفنا شعرهم، يعيدنا شعره بهذا القدر إلى حياة كاتبه. هل هو شعره الذي يدعونا إلى ذلك؟ هل هي مأساته، مرضه الذي أودى به وهو في السادسة والثلاثين من عمره؟ هل هو حنيننا إلى جنته الأليفة التي صنعها لنا لنقيم فيها، والتي لم نغادر فيئها بعد؟ إلخ. لكن المهم هو قبولي في وقت ما بتلك النظرية التي تقول إن علينا أن نقرأ النص، الأدبي أو الشعري، بعد فصله عن كاتبه وقطْعه عنه. كنت قابلا بذلك ومصدقا له، على الرغم من تعلّقي بالسياب على النحو الموصوف أعلاه.
٭ روائي لبناني