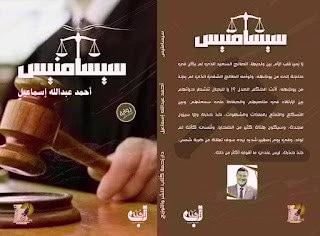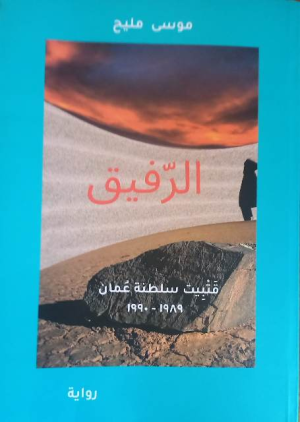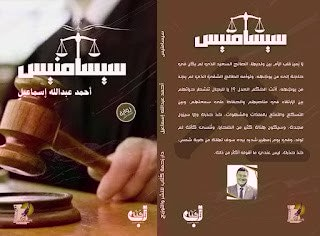علي محمود طه من أهم الأصوات المنسية في ثقافتنا الشعرية الحديثة. كان شاعراً بالأساس، لم يترك لنا مصنّفاً حول رؤيته للقصيدة، وتجربته في الشعر والحياة، غير أنّ أعماله الشعرية تصدع بالحقيقة، وتسمح لنا بالتعرُّف على أبعاد تجربته، ومفهوماته للشعر ووظيفته ومقصديّته. وهذا ما كانت تحاوله قراءات شوقي ضيف، طه حسين، محمود أحمد فتوح، محمد مندور، أنور المعداوي، سهيل أيوب، نازك الملائكة، يسري العزب وسواهم، لشعر الشاعر. لكنّ المتمعن فيها لا يلمس فهماً عميقاً محايثا له إلا لماماً، وربما أرجعنا ذلك إلى احتكام هؤلاء إلى نظريات الظروف الخارجية التي كانت تتمحّل في تعاملها مع القصيدة كشكل، وتغفل عن فِعْل الذّات في الخطاب، وتنظيمها للمعنى والإيقاع، فيما هي كانت تُركِّز، أساساً، على مستويات الخطاب الشعري منفصلة ومتجاوزة. من هنا، يحقُّ لنا تغيير مكان القراءة، يكون مُنشدّاً إلى دوالّ القصيدة، ومُحتفياً بالذات كمتعدِّد، والمعنى بوصفه لا نهائيّاً يستعصي على الاختزال إلى ثنائية الدليل؛ وهو ما تتيحه لنا، اليوم، مقاربات الشعر وفق الاعتبار بابستيمولوجيا الكتابة. وبقدرما يفيدنا ذلك في قراءة الذات وتنظُّراتها وأوفاق تجربتها وأطياف متخيَّلها في الكتابة والحياة، من هذا الشاعر إلى ذاك، بقدرما يسعفنا على رجّ شجرة النسب الشعري، وإعادة بناء السلالات الشعرية، بحثاً عن أصولٍ أخرى لحقائق أخرى في زمن القصيدة الحديث وإبدالاته.
2.
من الصدف العجيبة أن يختصر عمر الشاعر علي محمود طه عمر القصيدة الرومانسية نفسه، ففي سنة ميلاده كانت الرومانسية العربية قد خرجت إلى الوجود بصدور كتاب: "الموسيقى" لجبران خليل جبران الصادر عام 1902، وفي سنة رحيله 1949 كان الشاعر العربي قد ودّع فضاء الرومانسية، وشقّ فضاءً آخر لا يقلُّ خطورة في دروب المغامرة الشعرية، صحبة السياب ورفقته الهائلين. بين الشاعر والرومانسية عقْدُ قرانٍ روحيّ، رمزيّ وصُدْفويّ. والمثير أنّه كان أكثر حداثةً مما كان يكتبه، وقتئذٍ، نفرٌ غير قليل من شعراء جيله، حتى أن فعل الحداثة الجوهري لم يستعلن منابته إلا على ما تأسس من أجروميّات الذات الشاعرة كأثر محايث لها، التي كان يتكلمها شاعرنا بعمق وصفاء لافتين. وليس من المراء أن نشير إلى أن إسهامات طه كانت ترهص إرهاصاً أكيداً بأزمة البيت الشعري، التي فاضت عن ثخونة المعنى وممكنات الخطاب الشعري، وبالنتيجة، بالحداثة التالية التي كانت تُسفح على مذابحها القرابين، ويُهدر فيها دم الشاعر من قبل النقاد وأشباههم. ومن الدالّ، هنا، أن يطلب السياب من طه أن يكتب له مقدمة باكورته «أزهار ذابلة» باعتبار ذلك يمثّل دفعة رمزية له، إلا أن مرض طه حال دون ذلك، ومن الدالّ أيضاً أن تفرد نازك الملائكة كتابا نقديا للشاعر كتحيّةٍ لتجربته وإشادةٍ بخطّه الشعري.
كان الاختلاف الحقيقي بين الرومانسية العربية، وطه أحد أصوليّيها اللافتين، وسواها قائماً على الإحساس الفادح والمتهجّج بالتصدع الذاتي لدى الشاعر الرومانسي. ذلك ما تهدينا إليه كتابات طه، وفيها يصير هذا التصدع رحماً لسؤال الشعر والشعريّة، وسؤالاً أنطلوجيّاً يتورّط فيه الشعري بعلاقاته الراسخة مع الإنسان والعالم، بقدرما يحتضن الإبدال النصي. لا شيء، هنا، يوحي بالتئام الذات وامتلائها، من القصيدة إلى القصيدة. وفي سياق خاص يحفّز الذات على التراقص الرهيب بين مرايا عالمها المتشظية، والترحل المستمر، بغير وصول، إلى المجهول الذي يغذّيه انقداح اللاشعور الشخصي للذات وميثاتها، في النص، على نار خسارات الشاعر، وحكمته الممضّة التي خبرها على هامش العالم والكتابة.
3.
يبقى علي محمود طه استراتيجيّاً، كما، في محور آخر، جبران والسياب وأدونيس، في ثقافتنا الشعرية الحديثة. راهنيّة مُفارقة بالنسبة إلى ما بعد جبران وما قبل السياب، وإلى الميثات التي تحكم الكتابة راهناً وتؤدلجها. إستراتيجيّ هو، بصدد الغنائية الخاصة بقصيدته المتجددة باستمرار. إنه شاعر حديث. لماذا وكيف؟ لأنّ كتابته تتجاوز الاختزالات الإيديولوجية المتعاقبة. ومن المهمّ، هنا، أن نستند إلى الكتابة التي تخلق نداء طه وتكوينه ونسقيّته: الذّات والإيقاع والحقول الاستعارية، لا كمستويات بل كصيغة واحدة لفعل "دلّ" ليس بالمعنى اللساني المعتاد لـ "الصورة السمعية" كما يقول سوسير، بل بالمعنى الذي يكون فيه بالنسبة للشعرية باثّاً للدلاليّة التي تتجاوز الدليل المعجمي للكلمات، عبر آثار تداعيها مع دوالّ أخرى: ما يصنع الكتابة، هذه الفعالية للذات والتاريخ، التي تظل سؤالا بلا جواب، وهو ما يشعّ، على الأقل، في "الملاح التائه"، العمل الذي يظهر ذروة المغامرة الذاتية عند علي محمود طه.
أوجد الشاعر، باقتدار، وسائل أدائية وفنية مهمة لخطاب الذات تكاد تصير نواة لمذهب وازن في شعرنا الحديث، يعكس الغنائية الخاصة بالقصيدة، وفعاليتها في اللغة والتاريخ، في سياق رمزية التعبير من صفاء اللغة وتوتر الإيقاع وحركة المعنى، يمكن أن ندعوها "الرمزية الشرقية" التي من طبيعتها التأمل الذاتي، والتحليق الحسي، والاستغراق الجوّاني، التي ذهب في أثرها الشاعر مذهباً جليّاً، عكس ما اعتقده محمد مندور في "محاضراته".
كان طه تحت ضغط الإحساس بضيق أفق اللغة، يجنح، بشرط المبدع، إلى خلق لغة في اللغة ليفتح أمامه إمكاناتٍ من البوح باختلاجات الذات وعوالمها الضاجّة بما انغلقت عليه من وعي حاد بتصدُّعها. ولهذا كان جهده يتركّز، أساساً، على استغلال القيم اللغوية والصوتية في سياق يشفُّ عن شفافية في التعبير بقدرما ثخونة المعنى، حتى وهو يستنبت علاقات فيها توحي بالتجريد، فإن ذلك لم يصل إلى درجة تكون فيها الدلالة معطلة. إن ما توحي به الكلمة الشعرية لا يقف فقط عند إيحائها الصوتي بالموسيقى، وإنما يتعدّاه إلى تفجير ما يحويه كوْنُها الدلالي من كوكبات وصور ورموز نتاج ذكرى ما صائرة في راهنها، ومن تداعيات تفضُّ الحدود عن منطق الفكر وجاهزية العبارة، مما يراكم، في النهاية، مسعىً كتابيّاً ينشط في رحم متخيل الغزو الذي ينفذ، بنزعة بوهيمية، إلى الأسرار، بقدرما يتمح من التراجيديا الشخصية مفردات الألم والقلق. لذلك، وجدناه يستحدث قاموساً شعريّاً خاصّاً بهذا المتخيل، من قبيل: الطبيعة العذراء –الشاطئ المجهول –خمر الخيال – أنشودة الوادي – عوالم السدم – حرب البقاء – وادي الحمام – شواطئ الأبد – ليل المقادر…..الخ، وهي، في أغلبها، تقوم على تشبيه اللامحسوس بالمحسوس، واستعارة المادي للمعنوي، والكناية بالمنظور عن اللامنظور أو العكس؛ بل ابتدع، في خضم ذلك، بعض الرموز الرئيسية التي كثُر تردُّدها في شعره، فتخرج بها عن حدودها الدلالية العادية، كالانتظار بما في معناه من إثارة الذكريات وبعث الإستيهامات المحبطة والضاغطة، والبحر باعتباره مهدا للميلاد والموت ومثوى الهموم والأوصاب، والشاطئ المجهول وما يمثل فيه من رؤى تعكس أسس الشاعر الغابر وقد صار أثراً بعد حين، والصخرة وما ترمز إليه من مشاهد الصراع بين الإنسان والطبيعة على خلفية الزمن الضائع، والملاح التائه وما يومئ إليه من سيرة الشاعر الباحث عن نفسه في رؤيا الغياب..إلخ.
وقد يتعدى ذلك الكلمة أو العبارة أو البيت ليشمل فضاء القصيدة بأكملها باعتبارها كلّاً متناغماً. يهمّ هذا أساساً قصائد ذات الطابع التأملي والرمزي، بما في ذلك مطوّلته "الشاعر والله" التي تضمّنت أبعاداً من بحث الشاعر المضني عن أجوبة لأسئلة الذات المقلقة بخصوص الحياة والموت، والخير والشر، الطبيعة والوجود، على خلفية فهم حقيقة العالم. فلا تخلو هذه القصيدة من نفس روحاني غامر في سياق العلاقة التي يقيمها الشاعر مع الله من أجل رفع المحنة عنه مادام هو "يد الرحمة من ربه، ومعزي العالم في حزنه، وحامل الآلام عن قلبه". هكذا، يغمرنا داخل القصيدة فيضٌ من الألفاظ والتراكيب ذات المحتوى المتقاطب بين الحسّي التجريدي، والمرئي واللامرئي، حتى أنّه ـ أحياناً ـ تفقد الصورة تخومها وأبعادها المرسومة لها.
في هذا السياق، يبدو تأثُّر الشاعر بالمذهب الرمزي جليّاً، فعناصر صوره وعلاقاتها العابرة في اللغة تنحو منحى رمزيّاً، حيث لم يكتف بربط الطبيعة بالذات، بل تجاوز ذلك إلى تراسل الحواس وامتزاجها مما يظهر العالم بكراً، خارج مألوفيّته. كل ما في العالم يصير، في نظره الشعري، رمزاً لغنى التجربة وجروحها الشخصية، مما أكسب العمل قدراً مهمّاً من مشاريع القدرة على الحلم الذي يصور مغامرات روحه التي تترحل باستمرار باتجاه المجهول، أو نحو نداء البدايات، على نحْوٍ ما يشفّ عن قلق الذات، ويخلق مفردات الحلم في سياق تذويت التجربة المعطاة من وحي الذكرى أو المشاهدة أو الاستيهام. مثلما كانت لغة القصيدة تتشعب في حقول استعارية وأطياف تخييلية، كان إيقاعها مشروطا بمدى كثافته وحساسيته وقدرته على نقل كل اهتزازات الحياة الباطنية ورعشاتها الغامضة، وليس بمدى موافقته لقواعد العروض التقليدي، فالإيقاع ـ كما يفهم وقتئذ من لدن الطليعة ـ صورة نفسية قبل أن يكون نظاماً وزنيّاً ونغميّاً.
وإذا كان التجديد في الإيقاع قد بلغ شأواً مهمّاً لدى طائفة من شعراء الرومانسية إلى حدّ كسر نظام الشطرين والمزج بين البحور، كما لدى أحمد زكي أبي شادي تحديداً، فإن تجديد علي محمود طه للإيقاع كان ينطلق من تجربته ويتنفَّس داخلها، مُوافقاً لغنائيته وخطاب ذاته. كان يُنوِّع في نسق القصيدة عبر توالي مقاطعها، وكان يخلق داخلها أنماطاً من التشكيل الوزني كالرباعية والمزدوج والمخمس، ويتخفّف من تواتر القافية الواحدة، عدا استغلاله الواضح للقيم الصوتية وموازناتها، وبالتّالي كان يسيطر على الوزن الشعري، ويُريده قوّةً للشكل التي تتأتّى من خلال الجهد الفني والصياغة العالية.
إن الإيقاع لا تكمن أهميته في وجود الوزن من عدمه، إنما في القوة التي بها يحتفظ داخل القصيدة، ويتكلمها في تجلّيات ناظمة تفصح عن حمل الشكل لمعناه، دون أن يعني ذلك الفصل بينهما. ذلك ما يُنبِّهنا إليه إيقاع ذات الشاعر بوصفه نداءً على الأعماق، وهو مل يدفعنا إلى الإقرار بمعادلة لافتة: كلّما كان هناك ضغط من المعنى على الذّات في اللغة الّتي تنكتب بها، كلما كانت يد الشاعر تفاجئ البيت النمطي بهذا الخروج أو ذاك، وهذا ما يشي بحقيقة أنّ ذلك كان إرهاصاً حقيقيّاً بأزمة البيت الشعري، ليس من حيث هو شكل بل شكل-معنى، وإلا عددنا التجديدات الوزنية السابقة على الشاعر أدخل في الأزمة.
4.
إلى ذلك، يكشف شعر طه عن علاقات قرابة روحية ومادية، قديمة وحديثة، نفسية وحسية، أقامها شاعرنا مع شعراء آخرين من سلالة النسب الشعري الذي أخلص له؛ ففضلاً عن شعراء العربية من أمثال أبي نواس، وديك الجن، والعباس بن الأحنف، وابن الفارض وغيرهم – وهو ما يحتاج حقّاً إلى دراسة مستقلة- إختبر صاحب "الملاح التائه" حواراً مع الآخر، في سياق البحث عن أجوبة لأسئلة جديدة، بصدد: كيف تصبح القصيدة العربية حديثة؟ وكان هذا الحوار كفيلاً باختراق إجماع التقليديّين، وهدم السائد الشعري، واستشراف أفق الشعر كسيرورة، بما يسمح برج شجرة النسب، وإعادة ترتيب السلالات الشعرية وفق أصول أخرى تحترثها لغةٌ نبوئيّة حديثة لا تفارق الخيال الشعري.
كان علي محمود طه أكثر شعراء عصره تعاطياً مع الشعر الأوربي في روحه وموضوعاته، حتى أنّه اتُّهم بـ "تغريب الشعر" من قبل شوقي ضيف، فقد عكف من جهة على ترجمة الشعر الفرنسي والإنجليزي في صفحات مجلة "المقتطف" بداية الثلاثينيات، التي ساهمت في توسيع أفق التلقي لدى القارئ العربي، وعمل من جهة ثانية على الحوار معه والتأثر به كتابيّاً من غير أن يكون أسيراً له، بحيث أعاد إنتاجها وتضفيرها بتجربته الشخصية، ولا أدلّ على ذلك قصيدتا "الخريف" و "البحيرة" لكل من فرلين و لامارتين، التي صاغهما شعراً عربيّاً. وأهم ممّن تأثر بهم نجد شعراء الرمزية أمثال بودلير، ألفريد دي فيني، شيللي، جون ماسفيلد، ويظهر ذلك في تأثره بموسيقى الكلمة الشعرية، ورمزية التعبير، وتظليل الصورة وتراسل الحواس، التي أدمجها في رمزيّته التي تجاري طبعه الانبساطي السمح، الذي يفتتن بالحياة من أيسر أسرارها، ويستمتع بلذاتها، ويتنفّس مجازها، بروح أبيقورية تمزج التحليق الشعري بالوصف الحسي والأداء النفسي المرهفين، داخل شِعْرٍ له تسميةُ الغنائيَّة بمعناها الخاصّ.
2.
من الصدف العجيبة أن يختصر عمر الشاعر علي محمود طه عمر القصيدة الرومانسية نفسه، ففي سنة ميلاده كانت الرومانسية العربية قد خرجت إلى الوجود بصدور كتاب: "الموسيقى" لجبران خليل جبران الصادر عام 1902، وفي سنة رحيله 1949 كان الشاعر العربي قد ودّع فضاء الرومانسية، وشقّ فضاءً آخر لا يقلُّ خطورة في دروب المغامرة الشعرية، صحبة السياب ورفقته الهائلين. بين الشاعر والرومانسية عقْدُ قرانٍ روحيّ، رمزيّ وصُدْفويّ. والمثير أنّه كان أكثر حداثةً مما كان يكتبه، وقتئذٍ، نفرٌ غير قليل من شعراء جيله، حتى أن فعل الحداثة الجوهري لم يستعلن منابته إلا على ما تأسس من أجروميّات الذات الشاعرة كأثر محايث لها، التي كان يتكلمها شاعرنا بعمق وصفاء لافتين. وليس من المراء أن نشير إلى أن إسهامات طه كانت ترهص إرهاصاً أكيداً بأزمة البيت الشعري، التي فاضت عن ثخونة المعنى وممكنات الخطاب الشعري، وبالنتيجة، بالحداثة التالية التي كانت تُسفح على مذابحها القرابين، ويُهدر فيها دم الشاعر من قبل النقاد وأشباههم. ومن الدالّ، هنا، أن يطلب السياب من طه أن يكتب له مقدمة باكورته «أزهار ذابلة» باعتبار ذلك يمثّل دفعة رمزية له، إلا أن مرض طه حال دون ذلك، ومن الدالّ أيضاً أن تفرد نازك الملائكة كتابا نقديا للشاعر كتحيّةٍ لتجربته وإشادةٍ بخطّه الشعري.
كان الاختلاف الحقيقي بين الرومانسية العربية، وطه أحد أصوليّيها اللافتين، وسواها قائماً على الإحساس الفادح والمتهجّج بالتصدع الذاتي لدى الشاعر الرومانسي. ذلك ما تهدينا إليه كتابات طه، وفيها يصير هذا التصدع رحماً لسؤال الشعر والشعريّة، وسؤالاً أنطلوجيّاً يتورّط فيه الشعري بعلاقاته الراسخة مع الإنسان والعالم، بقدرما يحتضن الإبدال النصي. لا شيء، هنا، يوحي بالتئام الذات وامتلائها، من القصيدة إلى القصيدة. وفي سياق خاص يحفّز الذات على التراقص الرهيب بين مرايا عالمها المتشظية، والترحل المستمر، بغير وصول، إلى المجهول الذي يغذّيه انقداح اللاشعور الشخصي للذات وميثاتها، في النص، على نار خسارات الشاعر، وحكمته الممضّة التي خبرها على هامش العالم والكتابة.
3.
يبقى علي محمود طه استراتيجيّاً، كما، في محور آخر، جبران والسياب وأدونيس، في ثقافتنا الشعرية الحديثة. راهنيّة مُفارقة بالنسبة إلى ما بعد جبران وما قبل السياب، وإلى الميثات التي تحكم الكتابة راهناً وتؤدلجها. إستراتيجيّ هو، بصدد الغنائية الخاصة بقصيدته المتجددة باستمرار. إنه شاعر حديث. لماذا وكيف؟ لأنّ كتابته تتجاوز الاختزالات الإيديولوجية المتعاقبة. ومن المهمّ، هنا، أن نستند إلى الكتابة التي تخلق نداء طه وتكوينه ونسقيّته: الذّات والإيقاع والحقول الاستعارية، لا كمستويات بل كصيغة واحدة لفعل "دلّ" ليس بالمعنى اللساني المعتاد لـ "الصورة السمعية" كما يقول سوسير، بل بالمعنى الذي يكون فيه بالنسبة للشعرية باثّاً للدلاليّة التي تتجاوز الدليل المعجمي للكلمات، عبر آثار تداعيها مع دوالّ أخرى: ما يصنع الكتابة، هذه الفعالية للذات والتاريخ، التي تظل سؤالا بلا جواب، وهو ما يشعّ، على الأقل، في "الملاح التائه"، العمل الذي يظهر ذروة المغامرة الذاتية عند علي محمود طه.
أوجد الشاعر، باقتدار، وسائل أدائية وفنية مهمة لخطاب الذات تكاد تصير نواة لمذهب وازن في شعرنا الحديث، يعكس الغنائية الخاصة بالقصيدة، وفعاليتها في اللغة والتاريخ، في سياق رمزية التعبير من صفاء اللغة وتوتر الإيقاع وحركة المعنى، يمكن أن ندعوها "الرمزية الشرقية" التي من طبيعتها التأمل الذاتي، والتحليق الحسي، والاستغراق الجوّاني، التي ذهب في أثرها الشاعر مذهباً جليّاً، عكس ما اعتقده محمد مندور في "محاضراته".
كان طه تحت ضغط الإحساس بضيق أفق اللغة، يجنح، بشرط المبدع، إلى خلق لغة في اللغة ليفتح أمامه إمكاناتٍ من البوح باختلاجات الذات وعوالمها الضاجّة بما انغلقت عليه من وعي حاد بتصدُّعها. ولهذا كان جهده يتركّز، أساساً، على استغلال القيم اللغوية والصوتية في سياق يشفُّ عن شفافية في التعبير بقدرما ثخونة المعنى، حتى وهو يستنبت علاقات فيها توحي بالتجريد، فإن ذلك لم يصل إلى درجة تكون فيها الدلالة معطلة. إن ما توحي به الكلمة الشعرية لا يقف فقط عند إيحائها الصوتي بالموسيقى، وإنما يتعدّاه إلى تفجير ما يحويه كوْنُها الدلالي من كوكبات وصور ورموز نتاج ذكرى ما صائرة في راهنها، ومن تداعيات تفضُّ الحدود عن منطق الفكر وجاهزية العبارة، مما يراكم، في النهاية، مسعىً كتابيّاً ينشط في رحم متخيل الغزو الذي ينفذ، بنزعة بوهيمية، إلى الأسرار، بقدرما يتمح من التراجيديا الشخصية مفردات الألم والقلق. لذلك، وجدناه يستحدث قاموساً شعريّاً خاصّاً بهذا المتخيل، من قبيل: الطبيعة العذراء –الشاطئ المجهول –خمر الخيال – أنشودة الوادي – عوالم السدم – حرب البقاء – وادي الحمام – شواطئ الأبد – ليل المقادر…..الخ، وهي، في أغلبها، تقوم على تشبيه اللامحسوس بالمحسوس، واستعارة المادي للمعنوي، والكناية بالمنظور عن اللامنظور أو العكس؛ بل ابتدع، في خضم ذلك، بعض الرموز الرئيسية التي كثُر تردُّدها في شعره، فتخرج بها عن حدودها الدلالية العادية، كالانتظار بما في معناه من إثارة الذكريات وبعث الإستيهامات المحبطة والضاغطة، والبحر باعتباره مهدا للميلاد والموت ومثوى الهموم والأوصاب، والشاطئ المجهول وما يمثل فيه من رؤى تعكس أسس الشاعر الغابر وقد صار أثراً بعد حين، والصخرة وما ترمز إليه من مشاهد الصراع بين الإنسان والطبيعة على خلفية الزمن الضائع، والملاح التائه وما يومئ إليه من سيرة الشاعر الباحث عن نفسه في رؤيا الغياب..إلخ.
وقد يتعدى ذلك الكلمة أو العبارة أو البيت ليشمل فضاء القصيدة بأكملها باعتبارها كلّاً متناغماً. يهمّ هذا أساساً قصائد ذات الطابع التأملي والرمزي، بما في ذلك مطوّلته "الشاعر والله" التي تضمّنت أبعاداً من بحث الشاعر المضني عن أجوبة لأسئلة الذات المقلقة بخصوص الحياة والموت، والخير والشر، الطبيعة والوجود، على خلفية فهم حقيقة العالم. فلا تخلو هذه القصيدة من نفس روحاني غامر في سياق العلاقة التي يقيمها الشاعر مع الله من أجل رفع المحنة عنه مادام هو "يد الرحمة من ربه، ومعزي العالم في حزنه، وحامل الآلام عن قلبه". هكذا، يغمرنا داخل القصيدة فيضٌ من الألفاظ والتراكيب ذات المحتوى المتقاطب بين الحسّي التجريدي، والمرئي واللامرئي، حتى أنّه ـ أحياناً ـ تفقد الصورة تخومها وأبعادها المرسومة لها.
في هذا السياق، يبدو تأثُّر الشاعر بالمذهب الرمزي جليّاً، فعناصر صوره وعلاقاتها العابرة في اللغة تنحو منحى رمزيّاً، حيث لم يكتف بربط الطبيعة بالذات، بل تجاوز ذلك إلى تراسل الحواس وامتزاجها مما يظهر العالم بكراً، خارج مألوفيّته. كل ما في العالم يصير، في نظره الشعري، رمزاً لغنى التجربة وجروحها الشخصية، مما أكسب العمل قدراً مهمّاً من مشاريع القدرة على الحلم الذي يصور مغامرات روحه التي تترحل باستمرار باتجاه المجهول، أو نحو نداء البدايات، على نحْوٍ ما يشفّ عن قلق الذات، ويخلق مفردات الحلم في سياق تذويت التجربة المعطاة من وحي الذكرى أو المشاهدة أو الاستيهام. مثلما كانت لغة القصيدة تتشعب في حقول استعارية وأطياف تخييلية، كان إيقاعها مشروطا بمدى كثافته وحساسيته وقدرته على نقل كل اهتزازات الحياة الباطنية ورعشاتها الغامضة، وليس بمدى موافقته لقواعد العروض التقليدي، فالإيقاع ـ كما يفهم وقتئذ من لدن الطليعة ـ صورة نفسية قبل أن يكون نظاماً وزنيّاً ونغميّاً.
وإذا كان التجديد في الإيقاع قد بلغ شأواً مهمّاً لدى طائفة من شعراء الرومانسية إلى حدّ كسر نظام الشطرين والمزج بين البحور، كما لدى أحمد زكي أبي شادي تحديداً، فإن تجديد علي محمود طه للإيقاع كان ينطلق من تجربته ويتنفَّس داخلها، مُوافقاً لغنائيته وخطاب ذاته. كان يُنوِّع في نسق القصيدة عبر توالي مقاطعها، وكان يخلق داخلها أنماطاً من التشكيل الوزني كالرباعية والمزدوج والمخمس، ويتخفّف من تواتر القافية الواحدة، عدا استغلاله الواضح للقيم الصوتية وموازناتها، وبالتّالي كان يسيطر على الوزن الشعري، ويُريده قوّةً للشكل التي تتأتّى من خلال الجهد الفني والصياغة العالية.
إن الإيقاع لا تكمن أهميته في وجود الوزن من عدمه، إنما في القوة التي بها يحتفظ داخل القصيدة، ويتكلمها في تجلّيات ناظمة تفصح عن حمل الشكل لمعناه، دون أن يعني ذلك الفصل بينهما. ذلك ما يُنبِّهنا إليه إيقاع ذات الشاعر بوصفه نداءً على الأعماق، وهو مل يدفعنا إلى الإقرار بمعادلة لافتة: كلّما كان هناك ضغط من المعنى على الذّات في اللغة الّتي تنكتب بها، كلما كانت يد الشاعر تفاجئ البيت النمطي بهذا الخروج أو ذاك، وهذا ما يشي بحقيقة أنّ ذلك كان إرهاصاً حقيقيّاً بأزمة البيت الشعري، ليس من حيث هو شكل بل شكل-معنى، وإلا عددنا التجديدات الوزنية السابقة على الشاعر أدخل في الأزمة.
4.
إلى ذلك، يكشف شعر طه عن علاقات قرابة روحية ومادية، قديمة وحديثة، نفسية وحسية، أقامها شاعرنا مع شعراء آخرين من سلالة النسب الشعري الذي أخلص له؛ ففضلاً عن شعراء العربية من أمثال أبي نواس، وديك الجن، والعباس بن الأحنف، وابن الفارض وغيرهم – وهو ما يحتاج حقّاً إلى دراسة مستقلة- إختبر صاحب "الملاح التائه" حواراً مع الآخر، في سياق البحث عن أجوبة لأسئلة جديدة، بصدد: كيف تصبح القصيدة العربية حديثة؟ وكان هذا الحوار كفيلاً باختراق إجماع التقليديّين، وهدم السائد الشعري، واستشراف أفق الشعر كسيرورة، بما يسمح برج شجرة النسب، وإعادة ترتيب السلالات الشعرية وفق أصول أخرى تحترثها لغةٌ نبوئيّة حديثة لا تفارق الخيال الشعري.
كان علي محمود طه أكثر شعراء عصره تعاطياً مع الشعر الأوربي في روحه وموضوعاته، حتى أنّه اتُّهم بـ "تغريب الشعر" من قبل شوقي ضيف، فقد عكف من جهة على ترجمة الشعر الفرنسي والإنجليزي في صفحات مجلة "المقتطف" بداية الثلاثينيات، التي ساهمت في توسيع أفق التلقي لدى القارئ العربي، وعمل من جهة ثانية على الحوار معه والتأثر به كتابيّاً من غير أن يكون أسيراً له، بحيث أعاد إنتاجها وتضفيرها بتجربته الشخصية، ولا أدلّ على ذلك قصيدتا "الخريف" و "البحيرة" لكل من فرلين و لامارتين، التي صاغهما شعراً عربيّاً. وأهم ممّن تأثر بهم نجد شعراء الرمزية أمثال بودلير، ألفريد دي فيني، شيللي، جون ماسفيلد، ويظهر ذلك في تأثره بموسيقى الكلمة الشعرية، ورمزية التعبير، وتظليل الصورة وتراسل الحواس، التي أدمجها في رمزيّته التي تجاري طبعه الانبساطي السمح، الذي يفتتن بالحياة من أيسر أسرارها، ويستمتع بلذاتها، ويتنفّس مجازها، بروح أبيقورية تمزج التحليق الشعري بالوصف الحسي والأداء النفسي المرهفين، داخل شِعْرٍ له تسميةُ الغنائيَّة بمعناها الخاصّ.