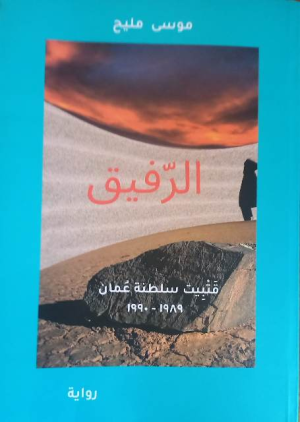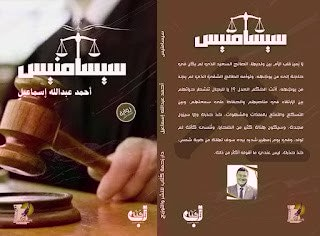إن يكتب القاصّ عن نفسه، وكيف يكتب؟ و كيف يتعامل مع اللّغة؟ و كيف تنقاد له أحيانا؟ وكيف تستعصى عليه أحياناً أخرى؟ وكيف تهجره الكلمات المراد توظيفها؟ وكيف لا تستقيم له التراكيب المعبّرة؟ و كيف يتزاوج الأسلوب واللّغة فينسكبان بيُسر مع مداد قلمه؟ وكيف يتنافران أحياناً فتحضر اللّغة ويغيب الأسلوب المُناسب… كلّ هذا ما كان ليشكلَ موضوعاً للكتابة السّردية قبل مَطلع القرن العشرين، ولكن في ستينياته، ظهرت هذه التقنية: الميتا سرد ( Métarécit) بشكل واضح، تنظيراً في العديد من الدّراسات والأبحاث التي تشكّل انشغالات علم السّرد ( Narratologie). والسيميوطيقا (Sémiotique) وتطبيقاً في العديد من الرّوايات، وكان الرّوائي الانجليزي (جون فاولز John Fowles ) من أبرز روادها .ثمّ تأثرت بذلك القصّة القصيرة. وبعد ذلك بثلاث عقود أي في التّسعينيات، وصل التّأثيرُ التّقنيُّ إلى القصّة القصيرة جداً المغربية، بشكل مُحتشم في البداية، غير أنّ صعوبة كتابة هذا الجنس، وما يطرحهُ من تحدٍّ في الانجاز .. حفّزت البعض عن قصدٍ، أو عن غير قصدٍ، لتوضيح نوع المعاناة الكتابية، ومُكابدات إعداد نصٍّ قصصي متناهي في القصر.
إذن، فإنّ الميتا سرد كتابة تجمعُ بين الواقع/ معاناة الكتابة، والخيال /أنسنة أدوات السّرد، لتصبح شخصيات في النّص، محققة أدباً تخييليا يُعنى بهمِّ الكتابة أساساً و ببصْمة ما بعد الحَداثة، كما يرى ذلك النّقد الحديث، في مجال السّرديات. ما يشكّل تداخلاً بيّناً لدَرجة التّماهي، إذ يبدو الميتا سرد و كأنّه يُجاري السّرد اللأتوبيوغرافي (autobiographie) ـ السّير ذاتي،لأنّه سرد حول السّرد الحقيقي، و الافتراضي، و التّخييلي، مستعيناً و مستفيداً بما هو ذاتي، أو تاريخي، أو تدويني، أو تحقيق صحفي، أو يوميات، أو مخطوطات ….ما يحقق سردية مختلفة ذات طابع بوليفوني / متعدّد الأصوات.
و من بين القصاصين المغاربة في هذا الجنس الذين وظفوا هذه التقنية بشكل مختلف ومتفاوت : إسماعيل البويحياوي ، وحسن برطال، و سن البقالي، وجمال الدين الخضري، وميمون حيرش والقاص محمد فرّي الذي تكرّرت ملامح هذه التّقنية، بأشكال مختلفة ومتنوعة، في العديد من نصوصه القصصية سواء في القصّة القصيرة، أو القصّة القصيرة جداً. فمن القصّة القصيرة نذكر له قصّة: (أنا و الورقة ) نقتطف منها ما يلي:
وضعت الورقة أمامي.. وقررت أن أكتب قصة..نعم..ولم لا؟..الكل يكتب الآن..فلم لا أدلي بدلوي..وأخوض المعمعة مع الخائضين؟..فلأتحرك إذن..مادامت الحركة بركة كما يقولون. فكرت أن أمارس طقوسا عند الكتابة كما سمعت كبار الكتاب يفعلون، فقد يساعد ذلك على تدفق الأفكار، وفتح شهية القلم، واسترضاء ربات الإلهام. حملقت في الورقة البيضاء حتى كادت عيناي تنزلقان من محجريهما، ركزت كثيرا مستجمعا كل حواسي وعناصر إدراكي، محاولا استرضاء بنات أفكاري، لكن الورقة ظلت فارغة تتحداني ببياضها، واستعصى القلم وأضرب عن إسعافي..وكأن بينهما عصيانا اتفقا عليه، فأكبرا علي أن أحشر في مصاف الأدباء. غير أنني استنجدت بعنادي، ولم أرضخ لنزوتهما، وصممت على أن أكتب شيئا كيفما كان شكله وجنسه، فالكتابة هي القصد والغاية، وتبا للموضوع،ولأستعن على ذلك بأي شيء، حتى ولو كان تعاويذ وتمائم، فالأسباب كثيرة والغاية واحدة…”.
قصّة تترجم صعوبة الكتابة القصصية، إذ ليست المسألة في إيجاد فكرة، وإنّما في كيفية التّعامل معها: صياغة وأسلوباً. فالبطل قاصّ هاوي، وقد يكون مبتدئاً استعرض عدّة أفكار ليكتب عنها: الشيخ/الفقيه المشعوذ الذي تقصده النّسوة العانسات من أجل الزّواج و أغراض أخرى، و الجنس و بائعات الهوى/ المومسات و عالمهن المحموم، والكاتب النحرير .. ورجل الأعمال/ المقاول العقاري، و زعيم الحزب اللّعوب، و رجل البرلمان…و هكذا.. إذ ليس الأفكار ما ينقص، لأنّها أصبحت تطارده و تلحّ في ذلك. فذعر و تهرّب منها لتبقى الورقة بيضاء. كرمزٍ دالٍّ أنّ الأفكار رغم تنوعها و اختلافها..لا يمكن أن تنتج قصّة، في غياب التّمكن اللّغوي، و أدوات الكتابة..
وفي مجال القصة القصيرة جداً، سنقف عند ثلاثة نصوص للقاص محمد فرّي:
1 ــ نص: حروف
“أغازل الكلمات،أراودها.أبحث عن حرف هنا،عن حرف هناك، تستعصي متمنعة.أشيح بوجهي مستسلما.فجأة، أنتبه على همسات ساخرة.أحملق في البياض.
أكتشف النص يتحداني ..مكتوبا”.
إنّ عملية الكتابة الإبداعية، تخييل فنّي لا يخلو من موَدة وعواطف، لأنّها المحفز الدّاعم للكتابة والابتكار. فنص “حروف” يضع القارئ في لحظة الكتابة، وكأنّه يُعايش مخاض ولادة النّص. ويأتي الخيال السّرديّ، ليجعل من الكلمات تلك الغادة الحسناء التي تستوجب الغزل، والمراودة، والإغراء، والاحتيال لكي تطيب وتلين وتخضع.. ومن أجل ذلك لابدّ من التّرضية، وإنْ تطلب الأمر البحث هنا وهناك، ولكن ترضيتها صعبة، لأنّها تسْتعصي وتتمنّع كطبع كلّ الإناث. حتّى إذا ما تعبَ العاشق الولهان، وأشاحَ بوجهه مُستسلماً، وجدها تستجيبُ. وكذلك حالُ كلمات النّص السّردي تستعصي، وتتمنّع حتّى لا سبيل إليها.. ولكن في لحظة صَفاء ذِهني، وارتياح نفسي .. تنسكبُ في لَينٍ و يُسر، مشكّلة حجم النّص في دلالته وفنّيته… إنّها عملية مَخاض ذِهني، لا تمرُّ دائماً بيسر، وفي كلّ ذلك متعة للمُبدع، لأنّه أوّل قارئ، وناقد، ومتلقٍ للنّص.
لذلك نجدُ النّص متضمناً ما ذهبنا إليه: المودة: [أغازل الكلمات،أراودها ] التّرضية و الإغراء:[أبحث عن حرف هنا،عن حرف هناك]،الاستعصاء والتّمنّع:[ تستعصي مُتمنعة ]،
الشّعور بالإحباط ، و اليأس، و الملل: [أشيح بوجهي مُستسلماً ] ، لحظة الإٌبداع الحقيقية : [فجأة، أنتبه على همسات ساخرة.أحملق في البياض ]، لحظة الاكتمال و متعة الانجاز : [أكتشف النص يتحداني ..مكتوبا ]. و تلك حقيقة الإبداع، فأول مَنْ يُعجب بالنّص صاحبه، بل يكاد من شدّة إعجابه لا يصدق أنّه مبدعه، و كأنّه أمْلي عليه…أو نزل عليه وجياً تماماً كالعاشق الذي يصل درجة اليأس من ممانعة خليلته، و في لحظة ، تميل إليه، وكأنّها لم تستعص قط من قبل. فيكاد العاشق لا يصدق أنّ منْ كانت تمْعنُ في التّمنّعِ والدَّلال هي الآن راضية مَرضية.
وفي النّص الثّاني: فصام
وضع كلّ الأفعال أمامه.فكر في تصريفها إلى أزمنة مختلفة.عندما استعصى عليه المضارع استنجد بالزّمن الماضي .عندئذ ..لم تطاوعه إلا الأفعال الناقصة.”
النّص يركز على عامل الزّمن في العملية الإبداعية.[ أزمنة مُختلفة ، المضارع ، الزّمن الماضي ، الأفعال النّاقصة.] فهل اختيارُ الزّمن له دور؟
إنّ الزّمن له دور و أهمية بالغة في العملية السّردية، فتشكيل البنية الزّمنية يتحكّم في بنية النّص ، و أدوات الإنتاج الإبداعي: من صرف، و نحو، و بلاغة …فالسّرد لصيق بالزّمن كدعامة بنيوية. لذا اهتمّ به النّقد الأدبي ، و بخاصّة الشّكلانيين الرّوس ورواد الرواية الجديدة في فرنسا، انتهاء بالاتّجاهات الشّعرية وبعض النّقاد العرب، و ذلك في علاقته بالشّخصية، والمكان، والزّمن التّاريخي ، و الزّمن السّردي في النّص، و مدى الرّبط بين زمن الحِكاية و زَمن السّرد ، و مدى التّرابط الجَدلي بينَ الإنسان و الزّمن فضلا عن أنواعه و أبْعاده …كما اهتمتْ به دراسات و أبحاث فلسفية، و فزيائية.. تعْنى بأهمية الزّمن سواء في واقع الحال المَعيش، ما يعرف بالزّمن الطّبيعي/الموضوعي، أو في التّخييل الفنّيّ الإبداعيّ، أو الزّمن النّفسيّ ..و ما ينتج عنه من صيرورة و تغيير و تحول ..باعتبار العملية السّردية إبداعٌ زمنيٌّ خالص، يحدّد رؤية خاصّة للإنسان، و الحياة، و الكون، و في جميع الحالات يبقى الزّمن القصصي زمناً داخلياً، تخييلياً، في إطار زَمن الحكي والخِطاب. وذلك في إطار تشكّلٍ ثلاثي كما عرفته الرّواية: زمن تتابعي، وأخر جدليّ تداخليّ، وزَمن مُتعدد أو مُتشظي.
فالقاص محمد فرّي، لحُسن ثقافته السّردية، مُدرك لكلّ هذا تمامَ الإدراك . لذا جعلَ بطلَ النّص في حيرةٍ من أمرهِ ، منْ حيث توظيف الأفعال، و حُسن تصريفها، فتجاوزَ المضارع / الحال و الاستقبال. و قد استعصى عليه، واسْتنجد بالماضي فوجد نفسه رهينَ الأفعال النّاقصة. و التي هي:[كان أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، ما برح، ما انفك، ما زال، ما فتئ، ما دام، صار و ليس. ] و قد سميت بالناقصىة لأنّها هي الوحيدة، التي لا تحتاج إلى فاعل أو مفعول به ، ولأنّ كلّ فعل منهم يوضح أمرين، وهما : الزّمان والفعل.
و المراد أبعد من هذا التّصور الأفقي للنّص، والتّوقع المُعجميّ (Prévisibilité lexicale) بل أبعد حتّى من تقتية الميتا سرد، التي وظفت كوسيلة لغاية. إنّ تركيز النّص على الزّمن
وملفوظ الفعل، و تصريفه، و اسْتعصاء المضارع، واستجابة الماضي فيما يخصّ ملفوظات الفعل الناقص. كلّ ذلك يشكّلُ كناية عن وضع انعدم فيه فعل (الحال و الاستقبال) و لم يبق إلا ما اسْتهلك من أفعال ناقصة لا تلبي حاجيات الحال، و لا تفيد في متطلبات و مستلزمات المستقبل . فالنّص رغم بساطته، مرّر خطاباً عميقَ الدّلالة. يكشف العجز و الإحباط، وعدم الاستعداد، والقدرة، لمعايشة الحال/الآن .فما بالك بالتّطلّع و استشراف المستقبل بأيّ فعل من الأفعال؟! الشيء الذي جعل بطل النص يعيش حائراً منفصماً بين ما ينبغي فعلهُ و هو مُسْتعصٍ . و بينَ ما تجاوزه الزّمن/ التّصريف، و هو كلّ ما تبقى ( كان ، وظل ، و بات ، و أمسى…) التي لا تملك الفاعل و المفعول به / المُنتج و الإنتاج/ المبدع و الإبداع.. و تلك حقيقة وضع عربي متأزم، إقتصاديا ، واجتماعيا و سياسيا.. يعيش على اجترار الماضي/ التاريخ. و لا يستطيع بناء حاضر زاهر. أو يَستشرف مُستقبلا باهرا …
.أمّا النّص الثالث في إطار تقنية الميتا سرد، فهو قصير جداُ تحت عنوان : مصادفة
“لضيق مساحة الصفحة، كتبها قصيرة جدا؛ بعد أن كان في نيته أن يكتبها. قصيرة فقط.”
النّصّ في إطار الميتا سرد، يطرح مسألة الحجم . و يَجعلُ الكاتبُ بطلَه القاص في حالة اختيار اضطراري، يخالف ما كان في نيته. فبدل كتابة قصة قصيرة، يكتب قصّة قصيرة جداً، نظراً لضيق مساحة الصّفحة. و النّص بطرح، يثير جدلا تيماتيا ((Thmatique
ــ هل نكتب نصاً قصيراً جداً لاعتبارٍ اضْطراري، سببه ضيق مجال الكتابة ؟
ــ أم سببُ اختيار كتابة النّص القصير جداً هو سبب ذاتي ؟
ــ و هلْ يُمكن العدول عن جنسٍ نريدهُ لجنسٍ نرغم عليه ؟
ــ أم الغاية من النّص أبعدُ من كلّ هذا؟
أعتقد أنّه رغم الكتابة الواضحة، و السّلطة التّبليغية القصدية، و تّقنية الميتا سرد..التي تكشف وصف ظروف اختيار جنس الكتابة اضْطراراً .. إلاّ أنّ النّص يحتمل قراءة ما بين الكلمات :ــ الضيق ← ← قصيرة جدا
ــ النية ← ← قصيرة
ــ العنوان ← ← مصادفة
إنّ كلمة (ضيق) تنسحب على ضيق المجال بأبعاده المادية و المعنوية. فلا الكاتب أصبح يجدُ مُتّسعاً من الوقت ليكتبَ عملاً يتّسع لصفحات ، كما كان الأمر متاحاً في الماضي ، و لا القارئ ــ الذي أصبحَ في عُجالة منْ أمره و كأنّه في سباق دائم مع الزّمن والمَهام ــ .. يجد مُتّسعاً ليقرأ كومة من الصّفحات. إذن، مَسألة الضّيق أصبحت تطاردُ المرسلَ و المرسل إليه.و استحكمت السّرعة في كلّ شيء، الأمر الذي جعلَ المُبتغى و القصدَ يتجانس وفعل الواقع، رغم النّية، و القصد الذي كان خِلاف ذلك. و بمَعنى آخر، إنّ ظروف الواقع أقوى من أيّ احْتمالٍ أساسُه النّية و الرّغبة.
نَخلصُ في النّهاية أنّ القاص محمد فرّي، لم يعمد إلى الميتا سرد ليكشف بعضاً من هموم الكتابة فقط ــ وإنْ كان هذا هو الأساس ــ بل فضلاً عن ذلك وظّف الميتا سرد كمُؤشر عن دَلالات تسْتَقى كاسْتنباطٍ، أو مُعادل لتَأويلٍ فنّي. والمُلاحَظ أنَّ النَّص يَبدو بَسيطاً، ولكنّه ليسَ بِالبَسيط أبداً، ما دامَ يَتضمَّنُ عمقاً دلالياً.
كما أنَّ النّص المتاسردي كتابة نرجسية، قائمة على التّمركز الذّاتي وهذا ما لاحظناه في النّصين الأوليين “أنا و الورقة” و”حروف”، إذ كانت الصيغة بضمير المُتكلم، وهذا هو الشائع بمفهوم رومان جاكوبسون( Roman Jakobson) ولكن القاص لم يكتف بالذّات، (الأنا) بل حولَ الصّيغة من (الأنا) إلى (الهو)، أي صيغة الغائب، في النّصين المواليين: “فصام ” و”مُصادفة” وعموماً، هنيئاً للقاص محمد فرّي على هذه النّصوص بتقنية الميتا سرد، فقد أبدع في سبر بعض أغوار الكتابة القصصية الذّاتية، وما تتطلبه من عناء ومكابدة. و افتنّ في جعل النّص القصير جداً، يمتلك دَلالات مختلفة ، وتنوعا مَوضوعاتيا، وتلميحات فكرية تأمّلية، من خلال تقنية الميتا سرد.
مسلك ميمون
إذن، فإنّ الميتا سرد كتابة تجمعُ بين الواقع/ معاناة الكتابة، والخيال /أنسنة أدوات السّرد، لتصبح شخصيات في النّص، محققة أدباً تخييليا يُعنى بهمِّ الكتابة أساساً و ببصْمة ما بعد الحَداثة، كما يرى ذلك النّقد الحديث، في مجال السّرديات. ما يشكّل تداخلاً بيّناً لدَرجة التّماهي، إذ يبدو الميتا سرد و كأنّه يُجاري السّرد اللأتوبيوغرافي (autobiographie) ـ السّير ذاتي،لأنّه سرد حول السّرد الحقيقي، و الافتراضي، و التّخييلي، مستعيناً و مستفيداً بما هو ذاتي، أو تاريخي، أو تدويني، أو تحقيق صحفي، أو يوميات، أو مخطوطات ….ما يحقق سردية مختلفة ذات طابع بوليفوني / متعدّد الأصوات.
و من بين القصاصين المغاربة في هذا الجنس الذين وظفوا هذه التقنية بشكل مختلف ومتفاوت : إسماعيل البويحياوي ، وحسن برطال، و سن البقالي، وجمال الدين الخضري، وميمون حيرش والقاص محمد فرّي الذي تكرّرت ملامح هذه التّقنية، بأشكال مختلفة ومتنوعة، في العديد من نصوصه القصصية سواء في القصّة القصيرة، أو القصّة القصيرة جداً. فمن القصّة القصيرة نذكر له قصّة: (أنا و الورقة ) نقتطف منها ما يلي:
وضعت الورقة أمامي.. وقررت أن أكتب قصة..نعم..ولم لا؟..الكل يكتب الآن..فلم لا أدلي بدلوي..وأخوض المعمعة مع الخائضين؟..فلأتحرك إذن..مادامت الحركة بركة كما يقولون. فكرت أن أمارس طقوسا عند الكتابة كما سمعت كبار الكتاب يفعلون، فقد يساعد ذلك على تدفق الأفكار، وفتح شهية القلم، واسترضاء ربات الإلهام. حملقت في الورقة البيضاء حتى كادت عيناي تنزلقان من محجريهما، ركزت كثيرا مستجمعا كل حواسي وعناصر إدراكي، محاولا استرضاء بنات أفكاري، لكن الورقة ظلت فارغة تتحداني ببياضها، واستعصى القلم وأضرب عن إسعافي..وكأن بينهما عصيانا اتفقا عليه، فأكبرا علي أن أحشر في مصاف الأدباء. غير أنني استنجدت بعنادي، ولم أرضخ لنزوتهما، وصممت على أن أكتب شيئا كيفما كان شكله وجنسه، فالكتابة هي القصد والغاية، وتبا للموضوع،ولأستعن على ذلك بأي شيء، حتى ولو كان تعاويذ وتمائم، فالأسباب كثيرة والغاية واحدة…”.
قصّة تترجم صعوبة الكتابة القصصية، إذ ليست المسألة في إيجاد فكرة، وإنّما في كيفية التّعامل معها: صياغة وأسلوباً. فالبطل قاصّ هاوي، وقد يكون مبتدئاً استعرض عدّة أفكار ليكتب عنها: الشيخ/الفقيه المشعوذ الذي تقصده النّسوة العانسات من أجل الزّواج و أغراض أخرى، و الجنس و بائعات الهوى/ المومسات و عالمهن المحموم، والكاتب النحرير .. ورجل الأعمال/ المقاول العقاري، و زعيم الحزب اللّعوب، و رجل البرلمان…و هكذا.. إذ ليس الأفكار ما ينقص، لأنّها أصبحت تطارده و تلحّ في ذلك. فذعر و تهرّب منها لتبقى الورقة بيضاء. كرمزٍ دالٍّ أنّ الأفكار رغم تنوعها و اختلافها..لا يمكن أن تنتج قصّة، في غياب التّمكن اللّغوي، و أدوات الكتابة..
وفي مجال القصة القصيرة جداً، سنقف عند ثلاثة نصوص للقاص محمد فرّي:
1 ــ نص: حروف
“أغازل الكلمات،أراودها.أبحث عن حرف هنا،عن حرف هناك، تستعصي متمنعة.أشيح بوجهي مستسلما.فجأة، أنتبه على همسات ساخرة.أحملق في البياض.
أكتشف النص يتحداني ..مكتوبا”.
إنّ عملية الكتابة الإبداعية، تخييل فنّي لا يخلو من موَدة وعواطف، لأنّها المحفز الدّاعم للكتابة والابتكار. فنص “حروف” يضع القارئ في لحظة الكتابة، وكأنّه يُعايش مخاض ولادة النّص. ويأتي الخيال السّرديّ، ليجعل من الكلمات تلك الغادة الحسناء التي تستوجب الغزل، والمراودة، والإغراء، والاحتيال لكي تطيب وتلين وتخضع.. ومن أجل ذلك لابدّ من التّرضية، وإنْ تطلب الأمر البحث هنا وهناك، ولكن ترضيتها صعبة، لأنّها تسْتعصي وتتمنّع كطبع كلّ الإناث. حتّى إذا ما تعبَ العاشق الولهان، وأشاحَ بوجهه مُستسلماً، وجدها تستجيبُ. وكذلك حالُ كلمات النّص السّردي تستعصي، وتتمنّع حتّى لا سبيل إليها.. ولكن في لحظة صَفاء ذِهني، وارتياح نفسي .. تنسكبُ في لَينٍ و يُسر، مشكّلة حجم النّص في دلالته وفنّيته… إنّها عملية مَخاض ذِهني، لا تمرُّ دائماً بيسر، وفي كلّ ذلك متعة للمُبدع، لأنّه أوّل قارئ، وناقد، ومتلقٍ للنّص.
لذلك نجدُ النّص متضمناً ما ذهبنا إليه: المودة: [أغازل الكلمات،أراودها ] التّرضية و الإغراء:[أبحث عن حرف هنا،عن حرف هناك]،الاستعصاء والتّمنّع:[ تستعصي مُتمنعة ]،
الشّعور بالإحباط ، و اليأس، و الملل: [أشيح بوجهي مُستسلماً ] ، لحظة الإٌبداع الحقيقية : [فجأة، أنتبه على همسات ساخرة.أحملق في البياض ]، لحظة الاكتمال و متعة الانجاز : [أكتشف النص يتحداني ..مكتوبا ]. و تلك حقيقة الإبداع، فأول مَنْ يُعجب بالنّص صاحبه، بل يكاد من شدّة إعجابه لا يصدق أنّه مبدعه، و كأنّه أمْلي عليه…أو نزل عليه وجياً تماماً كالعاشق الذي يصل درجة اليأس من ممانعة خليلته، و في لحظة ، تميل إليه، وكأنّها لم تستعص قط من قبل. فيكاد العاشق لا يصدق أنّ منْ كانت تمْعنُ في التّمنّعِ والدَّلال هي الآن راضية مَرضية.
وفي النّص الثّاني: فصام
وضع كلّ الأفعال أمامه.فكر في تصريفها إلى أزمنة مختلفة.عندما استعصى عليه المضارع استنجد بالزّمن الماضي .عندئذ ..لم تطاوعه إلا الأفعال الناقصة.”
النّص يركز على عامل الزّمن في العملية الإبداعية.[ أزمنة مُختلفة ، المضارع ، الزّمن الماضي ، الأفعال النّاقصة.] فهل اختيارُ الزّمن له دور؟
إنّ الزّمن له دور و أهمية بالغة في العملية السّردية، فتشكيل البنية الزّمنية يتحكّم في بنية النّص ، و أدوات الإنتاج الإبداعي: من صرف، و نحو، و بلاغة …فالسّرد لصيق بالزّمن كدعامة بنيوية. لذا اهتمّ به النّقد الأدبي ، و بخاصّة الشّكلانيين الرّوس ورواد الرواية الجديدة في فرنسا، انتهاء بالاتّجاهات الشّعرية وبعض النّقاد العرب، و ذلك في علاقته بالشّخصية، والمكان، والزّمن التّاريخي ، و الزّمن السّردي في النّص، و مدى الرّبط بين زمن الحِكاية و زَمن السّرد ، و مدى التّرابط الجَدلي بينَ الإنسان و الزّمن فضلا عن أنواعه و أبْعاده …كما اهتمتْ به دراسات و أبحاث فلسفية، و فزيائية.. تعْنى بأهمية الزّمن سواء في واقع الحال المَعيش، ما يعرف بالزّمن الطّبيعي/الموضوعي، أو في التّخييل الفنّيّ الإبداعيّ، أو الزّمن النّفسيّ ..و ما ينتج عنه من صيرورة و تغيير و تحول ..باعتبار العملية السّردية إبداعٌ زمنيٌّ خالص، يحدّد رؤية خاصّة للإنسان، و الحياة، و الكون، و في جميع الحالات يبقى الزّمن القصصي زمناً داخلياً، تخييلياً، في إطار زَمن الحكي والخِطاب. وذلك في إطار تشكّلٍ ثلاثي كما عرفته الرّواية: زمن تتابعي، وأخر جدليّ تداخليّ، وزَمن مُتعدد أو مُتشظي.
فالقاص محمد فرّي، لحُسن ثقافته السّردية، مُدرك لكلّ هذا تمامَ الإدراك . لذا جعلَ بطلَ النّص في حيرةٍ من أمرهِ ، منْ حيث توظيف الأفعال، و حُسن تصريفها، فتجاوزَ المضارع / الحال و الاستقبال. و قد استعصى عليه، واسْتنجد بالماضي فوجد نفسه رهينَ الأفعال النّاقصة. و التي هي:[كان أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، ما برح، ما انفك، ما زال، ما فتئ، ما دام، صار و ليس. ] و قد سميت بالناقصىة لأنّها هي الوحيدة، التي لا تحتاج إلى فاعل أو مفعول به ، ولأنّ كلّ فعل منهم يوضح أمرين، وهما : الزّمان والفعل.
و المراد أبعد من هذا التّصور الأفقي للنّص، والتّوقع المُعجميّ (Prévisibilité lexicale) بل أبعد حتّى من تقتية الميتا سرد، التي وظفت كوسيلة لغاية. إنّ تركيز النّص على الزّمن
وملفوظ الفعل، و تصريفه، و اسْتعصاء المضارع، واستجابة الماضي فيما يخصّ ملفوظات الفعل الناقص. كلّ ذلك يشكّلُ كناية عن وضع انعدم فيه فعل (الحال و الاستقبال) و لم يبق إلا ما اسْتهلك من أفعال ناقصة لا تلبي حاجيات الحال، و لا تفيد في متطلبات و مستلزمات المستقبل . فالنّص رغم بساطته، مرّر خطاباً عميقَ الدّلالة. يكشف العجز و الإحباط، وعدم الاستعداد، والقدرة، لمعايشة الحال/الآن .فما بالك بالتّطلّع و استشراف المستقبل بأيّ فعل من الأفعال؟! الشيء الذي جعل بطل النص يعيش حائراً منفصماً بين ما ينبغي فعلهُ و هو مُسْتعصٍ . و بينَ ما تجاوزه الزّمن/ التّصريف، و هو كلّ ما تبقى ( كان ، وظل ، و بات ، و أمسى…) التي لا تملك الفاعل و المفعول به / المُنتج و الإنتاج/ المبدع و الإبداع.. و تلك حقيقة وضع عربي متأزم، إقتصاديا ، واجتماعيا و سياسيا.. يعيش على اجترار الماضي/ التاريخ. و لا يستطيع بناء حاضر زاهر. أو يَستشرف مُستقبلا باهرا …
.أمّا النّص الثالث في إطار تقنية الميتا سرد، فهو قصير جداُ تحت عنوان : مصادفة
“لضيق مساحة الصفحة، كتبها قصيرة جدا؛ بعد أن كان في نيته أن يكتبها. قصيرة فقط.”
النّصّ في إطار الميتا سرد، يطرح مسألة الحجم . و يَجعلُ الكاتبُ بطلَه القاص في حالة اختيار اضطراري، يخالف ما كان في نيته. فبدل كتابة قصة قصيرة، يكتب قصّة قصيرة جداً، نظراً لضيق مساحة الصّفحة. و النّص بطرح، يثير جدلا تيماتيا ((Thmatique
ــ هل نكتب نصاً قصيراً جداً لاعتبارٍ اضْطراري، سببه ضيق مجال الكتابة ؟
ــ أم سببُ اختيار كتابة النّص القصير جداً هو سبب ذاتي ؟
ــ و هلْ يُمكن العدول عن جنسٍ نريدهُ لجنسٍ نرغم عليه ؟
ــ أم الغاية من النّص أبعدُ من كلّ هذا؟
أعتقد أنّه رغم الكتابة الواضحة، و السّلطة التّبليغية القصدية، و تّقنية الميتا سرد..التي تكشف وصف ظروف اختيار جنس الكتابة اضْطراراً .. إلاّ أنّ النّص يحتمل قراءة ما بين الكلمات :ــ الضيق ← ← قصيرة جدا
ــ النية ← ← قصيرة
ــ العنوان ← ← مصادفة
إنّ كلمة (ضيق) تنسحب على ضيق المجال بأبعاده المادية و المعنوية. فلا الكاتب أصبح يجدُ مُتّسعاً من الوقت ليكتبَ عملاً يتّسع لصفحات ، كما كان الأمر متاحاً في الماضي ، و لا القارئ ــ الذي أصبحَ في عُجالة منْ أمره و كأنّه في سباق دائم مع الزّمن والمَهام ــ .. يجد مُتّسعاً ليقرأ كومة من الصّفحات. إذن، مَسألة الضّيق أصبحت تطاردُ المرسلَ و المرسل إليه.و استحكمت السّرعة في كلّ شيء، الأمر الذي جعلَ المُبتغى و القصدَ يتجانس وفعل الواقع، رغم النّية، و القصد الذي كان خِلاف ذلك. و بمَعنى آخر، إنّ ظروف الواقع أقوى من أيّ احْتمالٍ أساسُه النّية و الرّغبة.
نَخلصُ في النّهاية أنّ القاص محمد فرّي، لم يعمد إلى الميتا سرد ليكشف بعضاً من هموم الكتابة فقط ــ وإنْ كان هذا هو الأساس ــ بل فضلاً عن ذلك وظّف الميتا سرد كمُؤشر عن دَلالات تسْتَقى كاسْتنباطٍ، أو مُعادل لتَأويلٍ فنّي. والمُلاحَظ أنَّ النَّص يَبدو بَسيطاً، ولكنّه ليسَ بِالبَسيط أبداً، ما دامَ يَتضمَّنُ عمقاً دلالياً.
كما أنَّ النّص المتاسردي كتابة نرجسية، قائمة على التّمركز الذّاتي وهذا ما لاحظناه في النّصين الأوليين “أنا و الورقة” و”حروف”، إذ كانت الصيغة بضمير المُتكلم، وهذا هو الشائع بمفهوم رومان جاكوبسون( Roman Jakobson) ولكن القاص لم يكتف بالذّات، (الأنا) بل حولَ الصّيغة من (الأنا) إلى (الهو)، أي صيغة الغائب، في النّصين المواليين: “فصام ” و”مُصادفة” وعموماً، هنيئاً للقاص محمد فرّي على هذه النّصوص بتقنية الميتا سرد، فقد أبدع في سبر بعض أغوار الكتابة القصصية الذّاتية، وما تتطلبه من عناء ومكابدة. و افتنّ في جعل النّص القصير جداً، يمتلك دَلالات مختلفة ، وتنوعا مَوضوعاتيا، وتلميحات فكرية تأمّلية، من خلال تقنية الميتا سرد.
مسلك ميمون