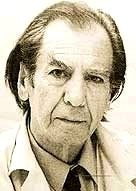رفيق خمس سنوات من عمري، منذ فكرتُ في إعداد ملف عنه لأول مرة عام 2015، وكان بالنسبة لي اسمًا مبهمًا، لا أعرف عنه شيئًا تقريبًا، سوى ما يقوله أدباء الستينيات والسبعينيات أثناء حديث كل منهم عن بداياته.
كانت معرفتي الأولى به من أستاذي الكاتب الراحل صلاح عيسى، الذي أخذ يحكي عنه بمحبة غامرة، واصفًا إياه بأنه «رجل لا يرد الموهبة»، وبعض مما قاله لي عن لقائهما الأول وجدته مرة أخرى بقلمه في كتاب «شخصيات لها العجب» الذي خصص واحدًا من فصوله لعبد الفتاح الجمل تحت عنوان «مسئول شؤون الهمزات»، وفيه يقول: «في ركن قصي من جريدة المساء وجدته يجلس إلى مكتبه، وأمامه إحدى صفحات الملحق يقوم بتصميمها، وبعض تجارب الطبع يراجعها، وكان منهمكًا في ذلك تمامًا حين دخلنا عليه، فصافحنا ببساطة بدت لي يومها عدم اكتراث، وتركنا نتخذ لأنفسنا مقاعد لنجلس عليها، واستمع بذهن شارد إلى الكلمات التي قدمني له بها صديقي، ولم يعقب بشيء بل مد يده إليَّ فسلمته المقال، وألقى نظرة عابرة على عنوانه، ثم ألقى به في درج على يساره، كان مليئًا حتى حافته بالورق، بطريقة أيقنت معها أنه سينزلق منه إلى سلة المهملات التي تقبع تحته، عند أول فرصة، ثم عاد إلى ما كان مشغولًا به، ليستغرق فيه، ودون أن يقول شيئًا أو يتبادل معنا كلامًا، وحين مرّ عامل البوفيه – أشار له علينا، دون أن يتكلم، وعندما أستأذناه في الانصراف لم يلح في بقائنا، وصافحنا بنفس الطريقة البسيطة. ومضينا وقد تحول شعوري بالندم لأنني أوقعت نفسي في هذا المأزق إلى غضب عارم على صديقي الذي ورطني في موقف محرج، بل ومهين.. وأدهشني أنه لم يجد فيما حدث شيئًا يدعو للغضب، بل أخذ يضحك وكأن شيئًا لم يحدث وهو يقول ببساطة: هذا هو عبد الفتاح الجمل».
نعم، هذا هو عبد الفتاح الجمل، قدرٌ كبيرٌ من التناقضات؛ بين ما يبدو عليه للوهلة الأولى من جهامة وعدم مبالاة وقسوة ثم «طولة لسان» وحدّة في المواقف، وبين ما تكتسي به روحه من رهافة وخجل وطفولة ورومانسية. رجلٌ لا تملك خيارًا إلا أن تحبه في النهاية، وتحترمه، وتقدِّر كل إنتاج أو فعل يصدر عنه، حتى وإن كانت ورقة بيضاء طواها ووضعها داخل كتاب يقرأه.
يكمل صلاح عيسى: «بعد أربعة أيام فقط، كان إحساسي خلالها بالإهانة قد تحوَّل إلى مرارة، صدر العدد الجديد من ملحق «المساء» فإذا بي أجد مقالي يتصدر صفحته الثالثة، وأجد اسمي منشورًا بنفس الطريقة التي تُنشر بها أسماء الكتاب الراسخين، ومع أنني ذهلت لتلك النتيجة التي بدت لي متناقضة تمامًا مع الانطباع الذي خرجت به من لقائنا، بل وكتبت مقالًا آخر لكي أقدمه له، إلا أنني قررت أن أتجنب لقاءه، فذهبت إلى «المساء» في يوم إجازته، وألقيت بالمقال في الدرج نفسه الذي علمت أنه يخصصه لما يتلقاه من مقالات وقصص وأشعار، ويأخذ محتوياته معه عند انصرافه، ليعكف في بيته على قراءتها ويختار ما يستحق النشر، وصدر العدد التالي من الملحق لأجد المقال منشورًا بالاحتفاء نفسه، ومع ذلك فقد ظللت لشهور طويلة أتعمد أن أترك له المقال في الدرج، وأتجاهل الرسائل التي كان يرسلها لي مع صديقي بأن أمُرَّ في يوم غير يوم إجازته، إلى أن كنت أهم يومًا بالانصراف بعد أن دسست المقال في الدرج، حين سمعت صوتًا يصيح بي من الطرف الآخر للصالة: ظبطتك يابن الـ (.......) يا (.......) ثم وصلة من الشتائم المنتقاة التي تعودنا نحن المصريين أن نعبر بها عن إعجابنا كما نعبر بها عن نفورنا، وعن حبنا كما نعبر عن كرهنا، وكان الصائح هو عبد الفتاح الجمل، الذي قطع الصالة عدوًا وهو يواصل شتائمه لي، لأجد نفسي بين أحضانه الدافئة، وليضع ذراعه في ذراعي ويقول لي إنه جاء في يوم إجازته خصيصًا لكي يقبض عليّ ويدعوني للغداء».
***
المرة الثانية لي مع سيرة الجمل كانت في نفس العام، بعد شهور قليلة من لقائي بصلاح عيسى، في احتفالية «أخبار الأدب» بسبعينية الكاتب الراحل جمال الغيطاني، والتي نُشرت بتاريخ 10 مايو 2015، وبنفس القدر من المحّبة قال الغيطاني حينها: «رَزقنا الله بشخص اسمه عبد الفتاح الجمل، أتذكر بعد عام 1967 كتبتُ قصة باسم «هداية أهل الورى لبعض ما جرى في المقشرة» وأخذتها له في جريدة المساء، وكان من النوع الذي إذا أحب أحدًا جدًا يسبّه، فطلب مني الجلوس، وبعد قراءته للقصة فوجئت به يعتلي الكرسي ويقف فوق المكتب ويرقص ويقول «حاجة جديدة يا ولاد..... حاجة جديدة»، والجالسون كانوا محمد البساطي ومحمد كامل القليوبي ورسامًا اسمه محمد عثمان هاجر فيما بعد للدنمارك، جلس يقرأ لهم القصة بصوت عال، فأخذت أقول لنفسي إنه يجاملني، ما الجديد الذي فعلته؟!».
واستطرد الغيطاني: «استخدمتُ اللغة في القصة كقناع، لدرجة أن عبد الفتاح الجمل عندما ذهب بها للرقيب قال له «شوف الراجل المجنون ده اللي لقى مخطوط وجايبه»، فنشرها الرقيب بالفعل على أنها كذلك».
***
في مستهل رحلتي، أول ما فعلت كان البحث عن معلومات حول عبد الفتاح الجمل عبر شبكة الإنترنت، لكني لم أجد إلا القليل، وروابط تشير إلى ندوات متفرقة أقيمت في ذكرى وفاته خلال السنوات العشرة الأخيرة. حتى عناوين كتبه كانت متداخلة مع كتب أديب وباحث آخر يحمل نفس الاسم، لدرجة أن موقع القراء الشهير «جودريدز» نسب له كتابا لا يخصّه.
صِرت في كل لقاء لي مع أديب من معاصريه، أحرص على سؤاله عنه، فأسمع ما يزيد حماسي للاقتراب من عالم هذا الرجل. لكن عند السؤال عن أعماله وإن كانت متوفرة منها نُسخ يمكنني الاطلاع عليها، تكون الإجابة «تائهة بين كتب كثيرة ومن الصعب العثور عليها حاليًا، لكنني سأحاول».
نزلتُ إلى سور الأزبكية لأبحث عن أعماله القليلة، بعدما توصلتُ فقط إلى نسخة إلكترونية من رواية «محب». وجدتُ الباعة يضعون صفًا لكل كاتب ممن اكتشفهم الجمل وأتاح لهم الفرصة حتى أصبحوا نجومًا في عالم الأدب، لكني لم أجد أحدًا يعرفه بينهم، حتى وإن ادعى البعض ذلك.
كثيرون منهم اختصروا الطريق من البداية بإجابة قاطعة تفيد عدم وجود كتب لعبد الفتاح الجمل، فهو غير معروف لديهم، إلا أن هناك من أخذوا يسألونني عن أسماء أعماله، فيومئ واحد برأسه ويؤكد أنه يعرفه لكنه لا يملك كتبه، بينما يثني آخر على معلوماتي قائلًا «فعلا؛ دي روايته» قبل أن يسأل عن اسم عمل آخر ليعيد عليَّ الرد «ودي كمان روايته أيوَه» ثم بأسف وتأثر يخبرني بأنه لا يملك أي منها في دكانه. وثالث نظر لي وبكل ثقة قال «أيوَه عارفه، ده أستاذ قانون» فاعتذرت منه لخطأ المعلومة وأكملتُ طريقي.
***
ذات يوم، وقع بين يدي العدد 712 من مجلة العربي، ويعود تاريخه إلى مارس 2018، متضمنًا حوارًا للدكتور محمد زكريا عناني، يقول في جزء منه «لقد تنبه مدرس اللغة العربية في المدرسة الابتدائية إلى هذه النزعة الأدبية، وإذا به يهدي إليَّ من مكتبة المدرسة ما رأى أنه يفيد وأن منه نسخًا مكررة.... هذا المدرس كان يحمل اسم عبد الفتاح الجمل؛ المشرف – فيما بعد – على الملحق الثقافي لجريدة المساء، والذي كان الأب الروحي لجيل الستينيات».
هاتفتُ الدكتور عناني على الفور لأتفق معه على موعد للقائه في الإسكندرية، وتحديدًا عند المدرسة الابتدائية، فرحّب بشدة. استغرقت جولتنا ما يقرب من خمس ساعات، شاهدنا خلالها ما طرأ على المدينة من تغيرات، واجتررنا ذكريات تعود إلى أكثر من سبعين عامًا مضت، حول مدرسته، وأستاذه الذي «قَلَب دِماغه».
***
بمرور الوقت أصبح عبد الفتاح الجمل «هوسًا» بالنسبة لي، أتتبع أثر أي قصاصة تحمل اسمه، إلى أن عثرتُ على الباب الصحيح الذي حوّل الفكرة لواقع ثري يمكن التعامل معه.
تواصلتُ مع الأصدقاء في محافظة دمياط؛ الكاتب الشاب إسلام عشري الذي ساعدني في الوصول لعنوان العائلة الصحيح في «أرض الجمل»، ثم الكاتب الخبير سمير الفيل، الذي يندر ألا تجد عنده معلومة عن شخص يعرفه أو تعامل معه.
بعد أسابيع قليلة وجدتُ أمامي عددًا من أرقام التليفونات التي تخص أفراد من عائلة عبد الفتاح الجمل، أخوته وأبناء عمومته، مع رسالة تحذيرية بأن أهالي دمياط لا يأمنون للغرباء وبالتالي - غالبًا - لن يكن مُرحبًا بي هناك.
لا أعرف أيًا منهم، لكني توّسمتُ في أن الأصغر سنًا ربما يكون أكثر تفهمًا لما أريد، وربما تكون طِباع دمياط أقل أثرًا في تعامله، وبين اثنين من شباب العائلة اتصلتُ بـ «علي الجمل» الذي يحمل اسم جدّه، وهو الابن الأصغر للأخ «أسامة الجمل»، فكان متعاونًا لدرجة كبيرة، بدءًا من تحديد موعد مناسب لسفري إليهم، ثم إخبار كبار العائلة ممن عاصروا عبد الفتاح؛ أخيه أسامة، وابن عمه طه، وابن أخيه عوض أحمد الجمل، ثم مرافقتي إلى البيت القديم الذي شهد نشأته في قرية «محِّب»، وإلى مقابر العائلة بعد ذلك.
***
وجدتُ لدى العائلة في دمياط بعضًا من مؤلفات عبد الفتاح الجمل وصوره والكتابات القديمة عنه، والبعض الآخر كان في انتظاري عند أخته الصغرى «تحية» وزوجها «محمد سناء السعيد» اللذين عاش معهما في نفس البيت خلال العشرين عامًا الأخيرة من حياته بمدينة نصر.
خرجتُ من بيتها إلى عالم أكثر ثراءً، حيث مكتبته في «مكتبة القاهرة الكبرى» بالزمالك، التي لا يعلم أحد بوجودها هناك، فالكتب تبدو وكأنها لم تُفتَح منذ قدومها. رحلة موازية، غير هيّنة، استغرقت شهورًا أخرى لأتمكن من الاطلاع على ما يوازي عشرين بالمائة فقط من كتبه، بعدما اضطررتُ إلى تفنيدها كتابًا تلو الآخر، إذ لم تعد المكتبة مستقلة باسم عبد الفتاح الجمل، وإنما فقط كتب مفرَّقة بين الأرفف وسط آلاف الكتب، كلٌ حسب مجال تخصصه!
***
الآن، بعد خمس سنوات – تقريبًا – من التفكير وتحسس الطريق، وستة شهور من العمل المتواصل، أشعر بأن عبد الفتاح الجمل رفيق حياة، وليس رفيق تلك المُدة فقط. أراه في مخيلتي وهو يخطو بكل مرحلة من حياته. أجدني واقفة إلى جانبه وهو يقرأ و«يحمِّض» الصور داخل غرفته بدمياط، وهو واقفٌ في الفصل يدرِّس لتلاميذ الابتدائية، وهو يرسم صفحات الملحق الأدبي والفني بجريدة المساء، وهو يلعب «الطاولة» على مقهى «فينيكس» بشارع عماد الدين، وهو يروي نباتاته في شقته بمدينة نصر، وأخيرًا وهو ساندٌ يديه على سور «بلكونته» يتلمس ضوء ودفء الشمس وعلى وجهه ابتسامة طفولية تنّم عن رضائه باختياراته في الحياة وفخره بمقدرته على تطويعها وعدم الانحناء أمام عقباتها.
كانت معرفتي الأولى به من أستاذي الكاتب الراحل صلاح عيسى، الذي أخذ يحكي عنه بمحبة غامرة، واصفًا إياه بأنه «رجل لا يرد الموهبة»، وبعض مما قاله لي عن لقائهما الأول وجدته مرة أخرى بقلمه في كتاب «شخصيات لها العجب» الذي خصص واحدًا من فصوله لعبد الفتاح الجمل تحت عنوان «مسئول شؤون الهمزات»، وفيه يقول: «في ركن قصي من جريدة المساء وجدته يجلس إلى مكتبه، وأمامه إحدى صفحات الملحق يقوم بتصميمها، وبعض تجارب الطبع يراجعها، وكان منهمكًا في ذلك تمامًا حين دخلنا عليه، فصافحنا ببساطة بدت لي يومها عدم اكتراث، وتركنا نتخذ لأنفسنا مقاعد لنجلس عليها، واستمع بذهن شارد إلى الكلمات التي قدمني له بها صديقي، ولم يعقب بشيء بل مد يده إليَّ فسلمته المقال، وألقى نظرة عابرة على عنوانه، ثم ألقى به في درج على يساره، كان مليئًا حتى حافته بالورق، بطريقة أيقنت معها أنه سينزلق منه إلى سلة المهملات التي تقبع تحته، عند أول فرصة، ثم عاد إلى ما كان مشغولًا به، ليستغرق فيه، ودون أن يقول شيئًا أو يتبادل معنا كلامًا، وحين مرّ عامل البوفيه – أشار له علينا، دون أن يتكلم، وعندما أستأذناه في الانصراف لم يلح في بقائنا، وصافحنا بنفس الطريقة البسيطة. ومضينا وقد تحول شعوري بالندم لأنني أوقعت نفسي في هذا المأزق إلى غضب عارم على صديقي الذي ورطني في موقف محرج، بل ومهين.. وأدهشني أنه لم يجد فيما حدث شيئًا يدعو للغضب، بل أخذ يضحك وكأن شيئًا لم يحدث وهو يقول ببساطة: هذا هو عبد الفتاح الجمل».
نعم، هذا هو عبد الفتاح الجمل، قدرٌ كبيرٌ من التناقضات؛ بين ما يبدو عليه للوهلة الأولى من جهامة وعدم مبالاة وقسوة ثم «طولة لسان» وحدّة في المواقف، وبين ما تكتسي به روحه من رهافة وخجل وطفولة ورومانسية. رجلٌ لا تملك خيارًا إلا أن تحبه في النهاية، وتحترمه، وتقدِّر كل إنتاج أو فعل يصدر عنه، حتى وإن كانت ورقة بيضاء طواها ووضعها داخل كتاب يقرأه.
يكمل صلاح عيسى: «بعد أربعة أيام فقط، كان إحساسي خلالها بالإهانة قد تحوَّل إلى مرارة، صدر العدد الجديد من ملحق «المساء» فإذا بي أجد مقالي يتصدر صفحته الثالثة، وأجد اسمي منشورًا بنفس الطريقة التي تُنشر بها أسماء الكتاب الراسخين، ومع أنني ذهلت لتلك النتيجة التي بدت لي متناقضة تمامًا مع الانطباع الذي خرجت به من لقائنا، بل وكتبت مقالًا آخر لكي أقدمه له، إلا أنني قررت أن أتجنب لقاءه، فذهبت إلى «المساء» في يوم إجازته، وألقيت بالمقال في الدرج نفسه الذي علمت أنه يخصصه لما يتلقاه من مقالات وقصص وأشعار، ويأخذ محتوياته معه عند انصرافه، ليعكف في بيته على قراءتها ويختار ما يستحق النشر، وصدر العدد التالي من الملحق لأجد المقال منشورًا بالاحتفاء نفسه، ومع ذلك فقد ظللت لشهور طويلة أتعمد أن أترك له المقال في الدرج، وأتجاهل الرسائل التي كان يرسلها لي مع صديقي بأن أمُرَّ في يوم غير يوم إجازته، إلى أن كنت أهم يومًا بالانصراف بعد أن دسست المقال في الدرج، حين سمعت صوتًا يصيح بي من الطرف الآخر للصالة: ظبطتك يابن الـ (.......) يا (.......) ثم وصلة من الشتائم المنتقاة التي تعودنا نحن المصريين أن نعبر بها عن إعجابنا كما نعبر بها عن نفورنا، وعن حبنا كما نعبر عن كرهنا، وكان الصائح هو عبد الفتاح الجمل، الذي قطع الصالة عدوًا وهو يواصل شتائمه لي، لأجد نفسي بين أحضانه الدافئة، وليضع ذراعه في ذراعي ويقول لي إنه جاء في يوم إجازته خصيصًا لكي يقبض عليّ ويدعوني للغداء».
***
المرة الثانية لي مع سيرة الجمل كانت في نفس العام، بعد شهور قليلة من لقائي بصلاح عيسى، في احتفالية «أخبار الأدب» بسبعينية الكاتب الراحل جمال الغيطاني، والتي نُشرت بتاريخ 10 مايو 2015، وبنفس القدر من المحّبة قال الغيطاني حينها: «رَزقنا الله بشخص اسمه عبد الفتاح الجمل، أتذكر بعد عام 1967 كتبتُ قصة باسم «هداية أهل الورى لبعض ما جرى في المقشرة» وأخذتها له في جريدة المساء، وكان من النوع الذي إذا أحب أحدًا جدًا يسبّه، فطلب مني الجلوس، وبعد قراءته للقصة فوجئت به يعتلي الكرسي ويقف فوق المكتب ويرقص ويقول «حاجة جديدة يا ولاد..... حاجة جديدة»، والجالسون كانوا محمد البساطي ومحمد كامل القليوبي ورسامًا اسمه محمد عثمان هاجر فيما بعد للدنمارك، جلس يقرأ لهم القصة بصوت عال، فأخذت أقول لنفسي إنه يجاملني، ما الجديد الذي فعلته؟!».
واستطرد الغيطاني: «استخدمتُ اللغة في القصة كقناع، لدرجة أن عبد الفتاح الجمل عندما ذهب بها للرقيب قال له «شوف الراجل المجنون ده اللي لقى مخطوط وجايبه»، فنشرها الرقيب بالفعل على أنها كذلك».
***
في مستهل رحلتي، أول ما فعلت كان البحث عن معلومات حول عبد الفتاح الجمل عبر شبكة الإنترنت، لكني لم أجد إلا القليل، وروابط تشير إلى ندوات متفرقة أقيمت في ذكرى وفاته خلال السنوات العشرة الأخيرة. حتى عناوين كتبه كانت متداخلة مع كتب أديب وباحث آخر يحمل نفس الاسم، لدرجة أن موقع القراء الشهير «جودريدز» نسب له كتابا لا يخصّه.
صِرت في كل لقاء لي مع أديب من معاصريه، أحرص على سؤاله عنه، فأسمع ما يزيد حماسي للاقتراب من عالم هذا الرجل. لكن عند السؤال عن أعماله وإن كانت متوفرة منها نُسخ يمكنني الاطلاع عليها، تكون الإجابة «تائهة بين كتب كثيرة ومن الصعب العثور عليها حاليًا، لكنني سأحاول».
نزلتُ إلى سور الأزبكية لأبحث عن أعماله القليلة، بعدما توصلتُ فقط إلى نسخة إلكترونية من رواية «محب». وجدتُ الباعة يضعون صفًا لكل كاتب ممن اكتشفهم الجمل وأتاح لهم الفرصة حتى أصبحوا نجومًا في عالم الأدب، لكني لم أجد أحدًا يعرفه بينهم، حتى وإن ادعى البعض ذلك.
كثيرون منهم اختصروا الطريق من البداية بإجابة قاطعة تفيد عدم وجود كتب لعبد الفتاح الجمل، فهو غير معروف لديهم، إلا أن هناك من أخذوا يسألونني عن أسماء أعماله، فيومئ واحد برأسه ويؤكد أنه يعرفه لكنه لا يملك كتبه، بينما يثني آخر على معلوماتي قائلًا «فعلا؛ دي روايته» قبل أن يسأل عن اسم عمل آخر ليعيد عليَّ الرد «ودي كمان روايته أيوَه» ثم بأسف وتأثر يخبرني بأنه لا يملك أي منها في دكانه. وثالث نظر لي وبكل ثقة قال «أيوَه عارفه، ده أستاذ قانون» فاعتذرت منه لخطأ المعلومة وأكملتُ طريقي.
***
ذات يوم، وقع بين يدي العدد 712 من مجلة العربي، ويعود تاريخه إلى مارس 2018، متضمنًا حوارًا للدكتور محمد زكريا عناني، يقول في جزء منه «لقد تنبه مدرس اللغة العربية في المدرسة الابتدائية إلى هذه النزعة الأدبية، وإذا به يهدي إليَّ من مكتبة المدرسة ما رأى أنه يفيد وأن منه نسخًا مكررة.... هذا المدرس كان يحمل اسم عبد الفتاح الجمل؛ المشرف – فيما بعد – على الملحق الثقافي لجريدة المساء، والذي كان الأب الروحي لجيل الستينيات».
هاتفتُ الدكتور عناني على الفور لأتفق معه على موعد للقائه في الإسكندرية، وتحديدًا عند المدرسة الابتدائية، فرحّب بشدة. استغرقت جولتنا ما يقرب من خمس ساعات، شاهدنا خلالها ما طرأ على المدينة من تغيرات، واجتررنا ذكريات تعود إلى أكثر من سبعين عامًا مضت، حول مدرسته، وأستاذه الذي «قَلَب دِماغه».
***
بمرور الوقت أصبح عبد الفتاح الجمل «هوسًا» بالنسبة لي، أتتبع أثر أي قصاصة تحمل اسمه، إلى أن عثرتُ على الباب الصحيح الذي حوّل الفكرة لواقع ثري يمكن التعامل معه.
تواصلتُ مع الأصدقاء في محافظة دمياط؛ الكاتب الشاب إسلام عشري الذي ساعدني في الوصول لعنوان العائلة الصحيح في «أرض الجمل»، ثم الكاتب الخبير سمير الفيل، الذي يندر ألا تجد عنده معلومة عن شخص يعرفه أو تعامل معه.
بعد أسابيع قليلة وجدتُ أمامي عددًا من أرقام التليفونات التي تخص أفراد من عائلة عبد الفتاح الجمل، أخوته وأبناء عمومته، مع رسالة تحذيرية بأن أهالي دمياط لا يأمنون للغرباء وبالتالي - غالبًا - لن يكن مُرحبًا بي هناك.
لا أعرف أيًا منهم، لكني توّسمتُ في أن الأصغر سنًا ربما يكون أكثر تفهمًا لما أريد، وربما تكون طِباع دمياط أقل أثرًا في تعامله، وبين اثنين من شباب العائلة اتصلتُ بـ «علي الجمل» الذي يحمل اسم جدّه، وهو الابن الأصغر للأخ «أسامة الجمل»، فكان متعاونًا لدرجة كبيرة، بدءًا من تحديد موعد مناسب لسفري إليهم، ثم إخبار كبار العائلة ممن عاصروا عبد الفتاح؛ أخيه أسامة، وابن عمه طه، وابن أخيه عوض أحمد الجمل، ثم مرافقتي إلى البيت القديم الذي شهد نشأته في قرية «محِّب»، وإلى مقابر العائلة بعد ذلك.
***
وجدتُ لدى العائلة في دمياط بعضًا من مؤلفات عبد الفتاح الجمل وصوره والكتابات القديمة عنه، والبعض الآخر كان في انتظاري عند أخته الصغرى «تحية» وزوجها «محمد سناء السعيد» اللذين عاش معهما في نفس البيت خلال العشرين عامًا الأخيرة من حياته بمدينة نصر.
خرجتُ من بيتها إلى عالم أكثر ثراءً، حيث مكتبته في «مكتبة القاهرة الكبرى» بالزمالك، التي لا يعلم أحد بوجودها هناك، فالكتب تبدو وكأنها لم تُفتَح منذ قدومها. رحلة موازية، غير هيّنة، استغرقت شهورًا أخرى لأتمكن من الاطلاع على ما يوازي عشرين بالمائة فقط من كتبه، بعدما اضطررتُ إلى تفنيدها كتابًا تلو الآخر، إذ لم تعد المكتبة مستقلة باسم عبد الفتاح الجمل، وإنما فقط كتب مفرَّقة بين الأرفف وسط آلاف الكتب، كلٌ حسب مجال تخصصه!
***
الآن، بعد خمس سنوات – تقريبًا – من التفكير وتحسس الطريق، وستة شهور من العمل المتواصل، أشعر بأن عبد الفتاح الجمل رفيق حياة، وليس رفيق تلك المُدة فقط. أراه في مخيلتي وهو يخطو بكل مرحلة من حياته. أجدني واقفة إلى جانبه وهو يقرأ و«يحمِّض» الصور داخل غرفته بدمياط، وهو واقفٌ في الفصل يدرِّس لتلاميذ الابتدائية، وهو يرسم صفحات الملحق الأدبي والفني بجريدة المساء، وهو يلعب «الطاولة» على مقهى «فينيكس» بشارع عماد الدين، وهو يروي نباتاته في شقته بمدينة نصر، وأخيرًا وهو ساندٌ يديه على سور «بلكونته» يتلمس ضوء ودفء الشمس وعلى وجهه ابتسامة طفولية تنّم عن رضائه باختياراته في الحياة وفخره بمقدرته على تطويعها وعدم الانحناء أمام عقباتها.