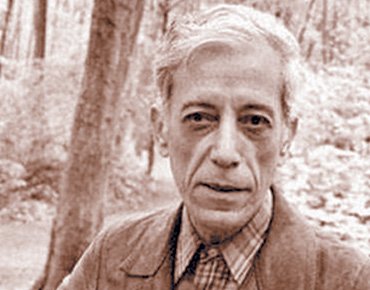أقدّر أن كل مَن أَجاءتهم أقدارهم إلى الكتابة الأدبية غَووْا، في مراهقتهم خاصة، بأكثر من كتاب قرأوه في مكتبة المتوسطة أو الثانوية. أو أعارتهم إياه مكتبة عمومية ـ وتلك كانت حالي مع "البؤساء" بترجمة منير البعلبكي؛ قبل أن أشتريه بعد سنين من ذلك ـ. أو حصلوا عليه من صديق أو من أستاذ. أو سرقوه من مكتبة تجارية. أو اقتنوه من على رصيف أو من عند بائع كتب مستعملة. أو أشير عليهم به من جهة تنظيمية أو من شخص تابع لها ـ كما كان الشأن بالنسبة إلي يوم قدم لي أحد الأساتذة العراقيين من المتعاونين التقنيين، وكان شيوعيا، ما أعُده أهم كتاب نقلني إلى قلب الثورة البلشفية؛ إنه "عشرة أيام هزت العالم".
فَلِطريقة كتابته المتأرجحة بين السرد الصحفي وبين السرد الروائي، إلى حد التماهي بينهما فيتحولان في ذهني شريطا أشاهد وقائعه كما على الشاشة، بلغتُ درجةَ أن أتمثل نفسي جون ريد نفسه الذي لم يكن فحسب يحكي، وعن بعد، وقائع تلك الأيام التي حولت العالم إلى قطبين، ولكنه يعيشها في تفاصيلها لينقلها بكلمات الكاتب وكاميرا السينمائي وريشة الفنان.
ذلك ما أدهشني؛ إنه أسلوب التداخل بين سرد الوثيقة (مقالات الصحف والمنشورات والمراسلات والصور) وبين سرد الشاهد اليومياتي الذي ينتهي إلى الأدبية.
وبرغم أن الكتاب ظل خارج التجنيس الروائي فإنه يكفي أن تُحذف منه المقدمات والمؤخَّرات ليظهر متْنه نصا أدبيا، بامتياز!
الآن، وعلى بعد مسافة تقدر بحوالي قرن من ذلك، وفي ظل هذا الحراك الذي يعرفه العالم العربي من الماء إلى الماء، أتساءل بأملٍ: أيمكن للعبقرية العربية أن تبرهن أن لها من الأفذاذ من يحفرون في رخامة تاريخنا المعاصر هذا التحول بكلمات ستقرأها الأجيال القادمة بانبهار وإكبار؟
لعل "عشرة أيام هزت العالم" وفيلم المدمرة "بوتامكين" لمخرحه سيرغاي أنشتاين؛ ولاحقا رواية "الأم" لمكسيم غوركي، هي مجتمعةً، كانت القبسات الأولى التي ستزرع في داخلي الحلم بأن أكتب يوما عن فلاحي الجزائر وعمالها ـ وكان مشروع الخيار الاشتراكي قد بدأ تنفيذه في سبعينيات القرن الماضي ـ. ونظرا إلى العلاقة الوثيقة جدا بين الرواية وبين السينما فإنه لا بد من القول إن تأثير السينما على جيلي (الجيل الثاني من كتاب الرواية بالعربية في الجزائر) كان له وقع لا يختلف عن الرواية؛ بل كان أحد روافد ذلك التأثير في مسار التجربة كله.
خَصَصت بالذكر كتاب جون ريد وفيلم "بوتامكين" لتأثير خطابهما الفكري والجمالي، الذي سيتبلور عندي لاحقا خياراً أيديولوجيا، ستدعمه الأدبيات الماركسية وكتابات الواقعية الاشتراكية. وستصبح "البؤساء"، التي كانت من قبل أحد اكتشافاتي لواقع الفقر والظلم الاجتماعي والقمع والرذيلة والفضيلة في فرنسا القرن التاسع عشر خاصة، روايةً متجاوَزة إذ أقرأ، من مكتبة جامعة وهران، "الدار الكبيرة" في نسختها الأصلية.
كانت، بحق، أول مفصل وأهمه، بالنسبة إلي في ثلاثية محمد ديب؛ قبل أن أقرأها في ترجمة رائعة للأستاذ الكبير سامي الدروبي. فقد اكتشفت فيها، أدبياً وفنياً، واقع التفقير والتجويع والظلم والحرمان الاجتماعي والثقافي وكل أنواع الميز والفصل التي كانت المؤسسة الاستعمارية الفرنسية تمارسه ضد الجزائريين في المنتصف الأول من القرن العشرين.
فهي، "الدار الكبيرة"، التي كان لها علي التأثير السحري لعبقرية لغتها ـ الفرنسية ـ كيف تصور، خلافاً للفرنسية الأخرى، مقاومة الجزائريين الصامتة على بعد خمسة عشر عاما من اندلاع حرب التحرير!
فشخصيات مثل الطفل عمر، الذي يكون شاهدا على ذلك الواقع المأسَوي فيعبّر لأمه في نهاية الرواية ببسمته عن أمل الخلاص الذي سيكون جيله هو من يحمل السلاح لتحقيقه. ومثل حميد السراج المعلم المثقف المناضل، أحد رمز الوعي الوطني. ومثل الأم للا عيني ـ في خوض تجربة نضالها الشاقة المختلفة عن تجربة "أم" غوركي ـ باعتبارها رمز الحفاظ على الهوية والنسيج الأسري؛ برغم حالات اليأس التي كانت تبلغها تحت وطأة الفقر.
"الدار الكبيرة" هي التي ستسكنني أجواؤها أكثر من غيرها في الثلاثية نفسها أو في ما قرأته من حولها. وسيكون لتلك الأجواء انبعاثات في قصصي القصيرة، وفي بعض رواياتي امتداداتٌ رفيعة الخيوط من بناء مكانها المغلق الفضاء المفتوح الدلالات.
وكانت هي إذاً بؤرة هاجسي في القيم التاريخية التي صار يمكن لكتابتي أن تحمل بعضها. ومن ثمة، حدث الإغواء الذي تكون قد مارسته علي؛ دون أن أكون أدرك فعلا أني مُغْوى بها
.
لذلك، أعتبر أن هناك تضافرا تم، بفعل تقاطعات "البؤساء" و"عشرة أيام هزت العالم" و"الأم" مع "الدار الكبيرة"، لأجد نفسي يوما دخلت، تحت تأثير ذلك كله بالتأكيد، في تجربة الكتابة الأدبية التي سيوجهها في البدء الوعي والالتزام السياسيان.
ثم، وبنضوج التجربة نفسها وتطورها وبتتالي الانكسارات النفسية والانهيارات الأيديولوجية؛ وعليه هدم بناء القناعات المكرسة، مع الحفاظ على ما يغذي الروح بالسخاء تجاه الإنسان والإنسانية، سيصبح بحثي عن الفضاء الخاص واللغة الجديدة والأسلوب المميز ومغامرة التجريب من بين أهم انشغالاتي لإضافة لمسة خاصة إلى شكل الرواية التي يوماً ما أغوتني. فصرت كأنما أنا ملزم بأن أقول ما كانت ستقوله "الدار الكبيرة" في زمني هذا؛ بعد أكثر من سبعين عاما.
ذلك مني أهم تعبير عن الوفاء لعهد تلك الكتابة. وذلك ما يحاول بعضٌ من كتابتي اليوم أن يحاور به "الدار الكبيرة"؛ لأنها الرواية التي يوماً ما أغوتني.

فَلِطريقة كتابته المتأرجحة بين السرد الصحفي وبين السرد الروائي، إلى حد التماهي بينهما فيتحولان في ذهني شريطا أشاهد وقائعه كما على الشاشة، بلغتُ درجةَ أن أتمثل نفسي جون ريد نفسه الذي لم يكن فحسب يحكي، وعن بعد، وقائع تلك الأيام التي حولت العالم إلى قطبين، ولكنه يعيشها في تفاصيلها لينقلها بكلمات الكاتب وكاميرا السينمائي وريشة الفنان.
ذلك ما أدهشني؛ إنه أسلوب التداخل بين سرد الوثيقة (مقالات الصحف والمنشورات والمراسلات والصور) وبين سرد الشاهد اليومياتي الذي ينتهي إلى الأدبية.
وبرغم أن الكتاب ظل خارج التجنيس الروائي فإنه يكفي أن تُحذف منه المقدمات والمؤخَّرات ليظهر متْنه نصا أدبيا، بامتياز!
الآن، وعلى بعد مسافة تقدر بحوالي قرن من ذلك، وفي ظل هذا الحراك الذي يعرفه العالم العربي من الماء إلى الماء، أتساءل بأملٍ: أيمكن للعبقرية العربية أن تبرهن أن لها من الأفذاذ من يحفرون في رخامة تاريخنا المعاصر هذا التحول بكلمات ستقرأها الأجيال القادمة بانبهار وإكبار؟
لعل "عشرة أيام هزت العالم" وفيلم المدمرة "بوتامكين" لمخرحه سيرغاي أنشتاين؛ ولاحقا رواية "الأم" لمكسيم غوركي، هي مجتمعةً، كانت القبسات الأولى التي ستزرع في داخلي الحلم بأن أكتب يوما عن فلاحي الجزائر وعمالها ـ وكان مشروع الخيار الاشتراكي قد بدأ تنفيذه في سبعينيات القرن الماضي ـ. ونظرا إلى العلاقة الوثيقة جدا بين الرواية وبين السينما فإنه لا بد من القول إن تأثير السينما على جيلي (الجيل الثاني من كتاب الرواية بالعربية في الجزائر) كان له وقع لا يختلف عن الرواية؛ بل كان أحد روافد ذلك التأثير في مسار التجربة كله.
خَصَصت بالذكر كتاب جون ريد وفيلم "بوتامكين" لتأثير خطابهما الفكري والجمالي، الذي سيتبلور عندي لاحقا خياراً أيديولوجيا، ستدعمه الأدبيات الماركسية وكتابات الواقعية الاشتراكية. وستصبح "البؤساء"، التي كانت من قبل أحد اكتشافاتي لواقع الفقر والظلم الاجتماعي والقمع والرذيلة والفضيلة في فرنسا القرن التاسع عشر خاصة، روايةً متجاوَزة إذ أقرأ، من مكتبة جامعة وهران، "الدار الكبيرة" في نسختها الأصلية.
كانت، بحق، أول مفصل وأهمه، بالنسبة إلي في ثلاثية محمد ديب؛ قبل أن أقرأها في ترجمة رائعة للأستاذ الكبير سامي الدروبي. فقد اكتشفت فيها، أدبياً وفنياً، واقع التفقير والتجويع والظلم والحرمان الاجتماعي والثقافي وكل أنواع الميز والفصل التي كانت المؤسسة الاستعمارية الفرنسية تمارسه ضد الجزائريين في المنتصف الأول من القرن العشرين.
فهي، "الدار الكبيرة"، التي كان لها علي التأثير السحري لعبقرية لغتها ـ الفرنسية ـ كيف تصور، خلافاً للفرنسية الأخرى، مقاومة الجزائريين الصامتة على بعد خمسة عشر عاما من اندلاع حرب التحرير!
فشخصيات مثل الطفل عمر، الذي يكون شاهدا على ذلك الواقع المأسَوي فيعبّر لأمه في نهاية الرواية ببسمته عن أمل الخلاص الذي سيكون جيله هو من يحمل السلاح لتحقيقه. ومثل حميد السراج المعلم المثقف المناضل، أحد رمز الوعي الوطني. ومثل الأم للا عيني ـ في خوض تجربة نضالها الشاقة المختلفة عن تجربة "أم" غوركي ـ باعتبارها رمز الحفاظ على الهوية والنسيج الأسري؛ برغم حالات اليأس التي كانت تبلغها تحت وطأة الفقر.
"الدار الكبيرة" هي التي ستسكنني أجواؤها أكثر من غيرها في الثلاثية نفسها أو في ما قرأته من حولها. وسيكون لتلك الأجواء انبعاثات في قصصي القصيرة، وفي بعض رواياتي امتداداتٌ رفيعة الخيوط من بناء مكانها المغلق الفضاء المفتوح الدلالات.
وكانت هي إذاً بؤرة هاجسي في القيم التاريخية التي صار يمكن لكتابتي أن تحمل بعضها. ومن ثمة، حدث الإغواء الذي تكون قد مارسته علي؛ دون أن أكون أدرك فعلا أني مُغْوى بها
.
لذلك، أعتبر أن هناك تضافرا تم، بفعل تقاطعات "البؤساء" و"عشرة أيام هزت العالم" و"الأم" مع "الدار الكبيرة"، لأجد نفسي يوما دخلت، تحت تأثير ذلك كله بالتأكيد، في تجربة الكتابة الأدبية التي سيوجهها في البدء الوعي والالتزام السياسيان.
ثم، وبنضوج التجربة نفسها وتطورها وبتتالي الانكسارات النفسية والانهيارات الأيديولوجية؛ وعليه هدم بناء القناعات المكرسة، مع الحفاظ على ما يغذي الروح بالسخاء تجاه الإنسان والإنسانية، سيصبح بحثي عن الفضاء الخاص واللغة الجديدة والأسلوب المميز ومغامرة التجريب من بين أهم انشغالاتي لإضافة لمسة خاصة إلى شكل الرواية التي يوماً ما أغوتني. فصرت كأنما أنا ملزم بأن أقول ما كانت ستقوله "الدار الكبيرة" في زمني هذا؛ بعد أكثر من سبعين عاما.
ذلك مني أهم تعبير عن الوفاء لعهد تلك الكتابة. وذلك ما يحاول بعضٌ من كتابتي اليوم أن يحاور به "الدار الكبيرة"؛ لأنها الرواية التي يوماً ما أغوتني.