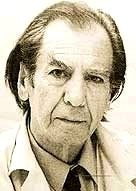فضائل «شعب النهار»... والدسائس
غداء في منزل فيروز وغسان تويني يطرده
والآن إلى شعب جريدة «النهار»، وإلى غسان تويني، وإلى الشاعرة ناديا تويني التي كانت ليّنة القوة وصلبة الشكيمة، حين هي كانت مريضة، وكانت تعي أنها تصير كذلك، ومع ذلك كانت صباح الخير ومساء الخير، وكانت شاعرة بدأت متردّدة النبرة، ثم تحولت إلى متمكنة من الكلمة باللغة الفرنسية.
وغسان تويني زوجها، لم يكن كلّ الوقت عابسًا، وإنما يضحك ضحكة تعبير نصفية، لا يرتوي ولا يشبع منها، وكان مع ناديا تويني يفتح لنا بيته العالي والفاخر في رأس كفرا، وبيت مري، في المتن الشمالي، ونحن نسهر ونتكلم في الطالع والنازل، ومرة كان يوسف الخال ونزار قباني من الضيوف وبعض المثقفين والشعراء، وكان الصفاء في الأحاديث. وما زلت أسمع تويني ينتقد يوسف الخال، ويأبى أن يطيقه في دور الشاعر الذي يحضن الموهوبين ويتهكم قليلاً. وإلى الطاولة فيما نتناول العشاء كانت ناديا، ولم تدافع عن يوسف الخال، بل أنا فعلت وعاتبته، لأنه ينكر عليه حضوره، وكونه قائمًا بنهضة أو محاولة نهضة في الشعر العربي الحديث، وليس وحده بل نحن معه، وصمت تويني وهو مقتنع بما عنده وليس العكس بتاتًا.
وكان تويني أيضًا قريبًا طبعًا من ناديا تويني في شِعرها، ولم يكن قريبًا من الحركة الثقافية عامة، مثلما فعل فيما بعد، فلا يحدب على أي موضوع ثقافي أمامنا نحن، إذ كنا في «النهار»، ونحمل معنا قلمنا الذي شحذناه في حركة مجلة «شعر» وحملناه إلى المهنة، إلى الصحافة. وكان بنا روح يحفزنا، وبه نتفهم أي تجربة في النثر أو الشعر ولا يستطيع غيرنا، لأنه في السبات، أن يكون في محلّنا في مرصادنا المتين والمشرف على الشاردة وعكسها، على ما يهزّنا هزّة ولو خفيفة، فنعلم أن في هذا الباب صدى واندفاعًا إلى الأشياء، إلى أول المغامرة التي لم نتنازل عنها حتى في الكهولة.
وتويني جزء من جو «النهار»، وكان حقًا لطيفًا وممتلئًا بالأحاسيس الجدية والبسمات والأحلام، وفي مدى هذا الجو ترعرعنا ثانية وصرفنا سنوات ولم نأسف، وكانت الوجوه رضيّة وأليفة منذ الستينات إلى أواخر التسعينات من القرن الماضي. وكنا أوفياء فلا ما يعطّل المسيرة الناعمة، وكان فرنسوا عقل في السلم وفي الحرب هو الأشدّ والأطول باعًا في الصمود وفي دفع الجريدة إلى مصيرها الأوحد، وهي أن تستمرّ، وهكذا استمرّت في الحرب اللبنانية، وتحدّت المخالب من كلّ نوع وقياس، وتويني أحيانًا في موقع المتفرج وموقع غير المصدق، وكأنه ينتظر أن تحدث الخيبة في أول فرصة، وأي زمان.
وشعب «النهار» ما أحلاه كان، فنحن إخوة، ونحن كتاب ونحن سطور وكلمات، ونحن خبر أو قصيدة أو نص مرتفع فوق العادة، ونحن مؤلفون وبنا الأقدام على الثمار وعلى ما يتوافق ويهتدي إلى الغاية الأخيرة، إلى النجاح الثمين والأكيد...
وإلى ميشال أبو جودة الذي تابعناه في عموده على الصفحة الأولى، وفي المضمون الذي له والذي كان الوحيد في وهجه، قبل أن نأتي نحن وأن نعمد نحن إلى التنويع وإلى بسط الوهج على صفحات الملحق، ثم صفحات «النهار». وإلى أن نكون في عزّ المضي إلى الأمام، وإلى أن نحرز قارئًا آخر ليس السياسي، وليس الذي اعتاد اسمًا واحدًا أو لونًا واحدًا مما في الجريدة.
أنسي الحاج والمثالية
وسبق لنا، سنة 1967، حين الهزيمة العربية، أن عمدنا إلى المخاطبة الثنائية أنا وصديقي أنسي الحاج الذي كان يهرب من الارتجال والعفوية الآنية والكتابة المباشرة، ويأخذ نصي أنا وعباراتي أنا، يأخذهما مني ونحن في مقهى «الهورس شو»، ويذهب إلى وحدته، إلى مكتبه، ويردّ على ما كتبت بعبارات تفقد أهميتها اللحظوية، لتكون شغل العقل والتأني. وليس ذلك بالعجيب، بل إنه عمد إلى الطريقة ذاتها مع ناديا تويني، وأظنه فعل كما معي، وأظن ناديا أيضًا ردّت بتأن وهو فعل بتأن، وانتفى الغرض من هذه الطريقة، أي أن تكون بنت الساعة، بنت العمق الإبداعي، لا أن تكون في صنف التأليف المعتاد والاصطناع الزائف، والموهبة هنا في حداد على هذا الموقف الخارج عن البراءة الأولى، وعن الزبد السريع إلى ملاقاة الأرجل على الرمل، ولفّ الأجساد بالأمنيات وبالعطر اليودي.
وحين تركت «النهار» لم يفكّر أنسي الحاج أنه سيصيبه ما أصابني، وأن غسان تويني استعمل كلمات الرثاء وإن في ستار التقييم والكلمات المرسلة بتأن ورحمة.
وأين المثالية فيما يفعل، وأين جلال الكلمة حين يقولها، لتكون هي الرادع له والحاجز دون أن يشطّ وأن ينحرف عن الخلقية وعن الصراط الحقيقي.
وتخلى عني غسان تويني
إذ تخلّى عني غسان تويني بسهولة، وأنبأني أنني مصروف، وأنه يستغني عن خدماتي. قالها لي في مكتبه وأنا قبالته. ثم سألني من ترى أنه صالح ليكون مطرحي، وما أجبت بل بقيت صامتًا، ورغبتي أن أنصرف وأنتهي من هذه اللعبة بين القط والفأرة، بل إن طبعه كما ظهر لي أنه يهوى الفعل الكاسر ولا حاجز دونه ليردعه عن الاستهتار واستعمال المزاج المنقلب. وكان هذا الحاجز يدعى فرنسوا عقل، إذ كان مدير التحرير الساهر على موقفه وعلى كرامة المحرّرين، وكنت أنا كذلك في هذا الفيء المتين، وكنت أعطي نفسي وموهبتي مسرورًا أبدًا. ما عدا الزمن الأخير حيث بلغ انزعاجي من الجو الوقح والدسائس إلى ذروته، وتكسّرت أغصان المحبة والطيبة على حضيض الانفعال والبراهين الصغيرة.
في منزل فيروز وعاصي
وخرجنا من الغداء عند الأخوين الرحباني والسيدة نهاد كما يناديها عاصي، خروجًا كان له الصدى في ملحق «النهار» وكان يوميًا، وتردّد الصدى أيضًا في بعض الإعلام، وحيث الأمر دائم الطرح، لأن العائلة الرحبانية في صدد أعمال وأغان وغيرهما من النشاط الذي يتصاعد إلى عرش العزّ والتجاوب المنداح إلى أقصاه، ولن أرجع إلى تفاصيل، بل أدلّ على سلوك أنسي الحاج رحبانيًا، من قبل في تلك الآونة ومن بعد في آونة المسرحيات والإطلال على الجمهور، بل على الجماهير، وعلى الآذان في وضع إصغاء ونجوى وطرب. وكان الحاج يغالي في إعجابه وتستخفه فيروز بما عندها من امتدادية في الهالة. بل إنها تبثّ النشوة نحوها، بحيث الكثيرون يقعون في هذه البئر العميقة من الجاذبية، وفي هذه الفجوة من الحرير، ويمكن القول ما أحيلى هذا الفخ وما أحيلى أن يسقط فيه الإنسان وأن تلفّه خيوط الشبكة الجميلة، ولا بطولة هنا ألا تتجاوب، وألا تنفعل، بل عليك الإقبال على هذه المساحة العذبة.
وكان أنسي، وهو حرّ وعلى حق، ذاتيا وانفعاليا، منذ «هالة والملك» على مسرح «البيكاديللي» يجلس في الصالة، ولا يفتأ أن يجهر ما يجيش في داخله من الآهات، وأخبرني المرحوم سمير نصري، وكان المقرب من الرحابنة آنئذ، أن عاصي كان ينزعج.
والحاج نفسه في القاعة حيث كنت أحرّر، وكان مكتبي في «النهار»، لا أدري لماذا احتدّ، وكانت الحرب صرفته عن العمل الدؤوب، أما نحن فكنا المحرّرين والمنكبين على أوراقنا، إذ هو أحاط بفيروز إحاطة الشغف والانجراف إلى موجاتها وبحرها الهائج والمنبعثة منه روائح السحر وتلاعب الرياح بالأشجار.
وعندما بلغت «هالة والملك»، خاتمتها سألني أنسي ماذا نفعل احتفاء بالنهاية؟ وماذا تستحق فيروز منا؟ وكان اقتراحي باقة وإرسالها إلى السيّدة العذبة الكهرباء، وبعثنا إليها بباقتين، ولم أدر أي شيء من التأثير، فيما تلا ذلك.
وعاصي، يخبرني سمير نصري، كان شديد الاحتضان لفيروز، وقسّى بكلماتها عليها، وكان يريدها طيّعة، وأن تكون كما يشاء من النظام، نظامه هو، وألا تخرج من أساره، من النهج الذي يخطّه. وكان يثأر من التصرّفات الفيروزية، بالكلمات يناديها، إن تباطأت على المسرح ولم تنسحب من التصفيق والتحيات والأزهار، حين يتطلب ذلك منها.
وعاصي ولو قسّى الكلام نجم رحباني مديد النور، تصل سرعته إلى الأجمل وإلى الأعمق، وهو من نضج التراث اللبناني، متعاونًا أو غير متعاون، بمساحة من الإبداع وبمساحة من اللغة الغنائية، إذ استقى من بلاده ومن هذه الليونة في العبارات والقصائد، بحيث كتب لها أن تكون الخميرة وأن تكون الصاج، وأن تكون المصهر، وأن تكون الرغيف الذي مهما تناولت منه يزداد اتساعًا ويتهادى خصبًا كبيرًا ولا تنتهي الموعظة، بل إن الجموع لن تجوع، ولن يأتيها القحط، ولن ينفد الطعام أبدًا.
زياد الرحباني... يخرمش الناس
ذات مرّة كان زياد الرحباني قبالة وجهي وهو على الكرسي في مكتبي في الحمراء. وكان من اللطف ومن الحديث الذي يقارب الهمس بحيث يسكب منه الكلمة العابرة أو الرقيقة. كما هي خفة الشراريب في طيارة الورق. وكان الذي أدركته الموسيقى والتراث المتراكم من الوالد عاصي الذي بنى باللمح والسرّ المضاء، مع منصور قصيدة النعومة والذكاء وتلك الخيوط بين حالة وحالة في لغة هي العامية وفي أقصى التجليات ومعالم الدعابة الكلامية. كما من عمّه منصور المنتشر جهده وعبيره. وزياد من الوالدة التي في صفاء النجوم والسفيرة... هو يرث ولا يرث ما سبق من الثروة القائمة على مجدها وعلى بيانها المديد.
لكنه مشرقي فيما هو أيضًا لبناني، وفي ألحانه وفي مسرحه ابتكار فيما تحتوي اللغة المحكية من انعكاس عميق ينزل في النفوس وفي العقول وفي مداها الخفي ويزرع الصدمة الحيّة والسريعة إلى التأثيرات مثلما هو النسر حين يفلش جناحيه ويخرمش الفضاء ويبعث المهابة.
وزياد يخرمش الناس، ويجلب مثلما يفعل الرحابنة، ذلك الإمتاع وتلك العاطفة وتلك الضحكة. وكلها في قالب الفكاهة التي تحتمل التأويل وتلك العبثية في الحركة كما يشتهي الفن الأصيل.
وفي الغناء وفي الأغنية عند زياد، ذلك الحنين الذي في المنطقة المشرقية، وذلك الطرب المختبئ ولا يظهر ولا ينجلي من ناحية التقييم سوى للعارفين، لكنه على سوية فنية ويكسر النسق الآخر ويبقى الطرب والدوخة كما عند الدراويش.
سمير عطا الله يجسّ الأنفاس
كنا معًا في جريدة «النهار» هو في ناحية وأنا في أخرى مفتوح الباب الزجاجي، وفي مكتب من الأوراق والأقلام. وسمير صحافي متذوق ودقيق، وهو على قوامه وعلى سمته المعروف وعلى الموهبة تدربت على الصواب وعلى قول ماذا في الباطن من شعلة ومن غضبة ومن التباس محكم الحلقات...
وهو، نحوي، وفي اتجاهي كلما حانت المناسبة الشعرية. وكما في السياسة هو طويل الروح وطويل الباع ورنان الجملة والتعبير المتصل والمتراكم حجّة وراء حجّة، وهمسة وراء همسة، كذلك هو في الأدب تنفجر النخوة لديه، وتضطرم المعاني خطوة وراء خطوة وجمرة وراء جمرة.
وهكذا الأسلوب عنده ينظر من عقله ومن وجدانه، ويسطع دم التجاوب وعصارة البلاغة. وهو يراني في قطعة كثيفة السطور، نشرت له في جريدة «النهار»، عنوانها «ذو الرنّة». أنني البهجة الشعرية لديه، ولا يدري السبب، وأنني له اللذة والرنّة، ولا يريد أن يدري لماذا. وها أنا ذا عنده «سنجاب يقع من البرج» كما فعل وانتقى عنواني لمقاله في أحد الأربعاء. وممكن القول إنه ذكاء وخيال ومتعة.
... وكيف لا يكون سمير عطا الله ذلك الأحادي الذي من طاولة الخبريات إلى الأوسع والأرحب، ومن التعب ثم التعب إلى النضج وإلى معالم الإحاطة والعبور في مهنة الصحافة وأشواكها وأزهارها. ومن فكرية إلى وقفة إطار يطلطل على لبنان وعلى العرب والعروبة وعلى المشاق والمهام والألوان. وما فتئ يلعب اللعبة بذكاء العبارة الممشوقة والليّنة بغية التأثير، وأن يشرب القارئ عذوبة الأسلوب نوطة ثم نوطة ورقصة ثم رقصة. وتلك، من سمير عطا الله، لمعة خاصة به تزيّن مقاله وتبعث الضوء حتى رؤية الشحوب ورؤية العافية معًا.
والأوفر في خضمّ ذلك، ثقافة الكاتب وكونه في ربيع الكلمة، وكونه في حاضرنا وفي سياقنا وفي النبوءات المتسارعة وليست في الغفلة أو في الطعن، وإنما هي الواقع، حيث الأزمات وحيث الصعاب، وتصوّره كما يفعل أي أديب أو أي روائي، أو أي صحافي مثل سمير عطا الله، وكأنه لا يبحث عن علاج وإنما ينبض ويجسّ الأنفاس، فضلاً عن القلب ونقله إلى الطوارئ المثالية وإلى سرير الحياة المثالي.
حنان الشيخ كأنها الركوة والقهوة
الصديقة والرفيقة والزميلة لي في جريدة «النهار» هي حنان الشيخ، وهي التي فازت ونجحت أمامي قبالة البصر والمنظار في مسح مجتمعها الأنثوي، وفي أنها داومت وغلبت الجفاف.
وتحمل حنان الشيخ الروائية اللبنانية، حيث تكون صورًا من بلادها، مقاطع من حياة ناسها، فسيفساءها، أحوالها، نساءها، رجالها. تحمل معها الشعب في أموره الصغيرة والأوسع في شجونه الكبيرة والأوسع، وكلما صدرت رواية لها تراءت المرأة العربية خصوصا في وهجها المتألق وفي رونقها وفي جفافها، ولعلّها أشد ظهورًا في هذا الذبول وهذا التناقض الذي يقوم بينها وبين العالم حولها...
إذن عالم أقصاه الغرب وأدناه الشرق، وفي هذا الشرق هي المرأة التي تفكر قليلاً... إن كان لها متسع من الحرية، فإنها تتمادى وتعصف بها العاصفة، وتدفعها إلى مواقع ضجر وخيبة، مواقع من أنس هو الأقل الأقل، ومواقع من التهافت الكياني، وتكثر عليها الأسئلة والأخطاء والتردّدات... وهكذا دائمًا لا ترتوي، لا تشعر بالثقة والأمان وتعكس مجتمعًا لها غارقًا في التحولات المتباطئة، ولا ما يوقفها في أرض صالحة...
حنان الشيخ منتجة، ولا يفوتها مجتمع في هلوساته وامتدادها كلما انوجد في مجتمع كالمجتمع اللندني. وهي، في حياتها العادية، لا تفعل سوى الكتابة، وسوى تناول الشوكولا، لذة عابرة من لذائذها، وسوى أن تسرّنا في العمق وفي الصباح كما في أي ساعة. وإنتاجها صادق اللسان والوتيرة يهجم على الطريدة، وينتصر دائمًا في صيد الحميم ولو تصاعد إلى مشارف العنف.
ولا تبخل حنان، بل إنها في علاقاتها الثقافية إنما تنجب، ويكون الجميل هو الذي يبزغ من أصابعها، من قلمها حين تكتب أو تحقق أو تقابل إحداهن. لا سيما هاتيك النسوة المرتفعات عن الواقع، عن العادي، واللواتي من ألوانهن، من أفكارهن، وهن في حركتهن والسلام لديهن. وهن في أدوار ملكة النحل، إنما يطربن للعمل، ولأن يضفن العسل المشتهى إلى طاولة المشتهيات. وحنان الصحافية لا تقلّ شأنًا عن الروائية، بل كانت الحميمة والجريئة والتي تنشد الحق وتنشد المثال حيث يكون مقامها، وحيث تتوسّع ليشمل الكحل عيون جميع السيّدات، ولا عمى البتة، وما تتراجع عنه، ولا تخبّئ الحقيقة بل ترسلها صراخًا وصورة دسمة ومرآة تعكس المطلق...
هي الآنسة، وهي السيّدة، وهي الصبيّة تبقى كذلك وهي الصحافية ذات مرّة وذات أوان. وهي، في الأحوال كلّها، وفي القريب وفي البعيد من الحياة التي عاشت وذاقت والتي كانت طوال الأيام والساعات كأنها على جمرة وعلى نار. وكأنها القهوة والركوة. وهي تحاذر أن تفور وأن يسيل من الفنجان، من الركوة أي شلال أي نقطة على الأرض أو على ثوبها أو على مريولها أو على الورقة البيضاء، لأن هذه الورقة هي التي تكتب عليها مناظر من الشرق، من النسوة من النساء اللواتي يغرقن في التناقضات وفي أصناف من الأسر وفي ركام من القيود...
وحنان لبثت على نقاء في الطوية وفي السيرة. وارتدت بغية الأمانة، ثوبها الحقيقي من الشرق ومن الغرب. وثوب الحقيقة في كلّ مكان وفي كلّ النصوص والروايات والأوراق التي شبعت من الاعتراف ومن الصور الجذابة إلى حدّ الحصول على بطاقة الدخول إلى عمق الدار، أي دار، وعلى الأخصّ هي التي لا تفارق الصبا ولا ذلك الجنون الناعم.
عصام محفوظ «الهمشري» المتمرد
وهذا وجه عصام محفوظ الذي كانت له معرفة بي منذ «أكياس الفقراء»، إذ شاهدته في مكتبة المر، على ذلك المدخل إلى جنب سينما دنيا، يقلب ديواني الأوّل، صادرًا عن حلقة الثريا، في دار مجلة «شعر»، عام 1959. ومن كلمة إلى كلمة، إلى أنس ناعم، ونشأت صحبة، إذ هو المثقف والبارع في النقد وفي القراءة وفي الحدس التام، وفي الوصول إلى هيبة النص ومعناه الدفين. وكانت له رحلة متأخرًا إلى مجلة «شعر» وإلى يوسف الخال عينه إذ بشّ في قدومه وكان يرافقنا في العمر الأخير من المجلّة، وله ديوان، ثم كانت تجربة المسرح التي فسحت له في تبيان الهدف وما هو منشود ومقصود. وكنت ربما الأول الذي رآه مسرحيًا حين طرحت قصيدته «زليخة» في خميس مجلة «شعر»، وأفصحت عن رأيي حينئذ أن في القصيدة مسرحًا.
وعصام همشري في الواقع، وابن التمرد على الوضع العائلي، إذ لطالما تسكع وعاش منفردًا في عالمه الخاص، وما كان أبدا في خطوة ثابتة أو دائمة، وإنما ينفلت من القاعدة من التقليد إلى الحريّة وشم نسيمها اللذيذ، ولكن ليظهر دائمًا أنه الصحيح، وعندي أنه الصحيح مظهرًا والغريب والشارد باطنًا.
وما كان إلا الغريب حقًا، والمال عنده ليس سوى ورقات وسوى غيمة يطردها الهواء. وتارة هو الغني وتارة هو الفقير، ويظل إياه متماسكًا في السرّاء والضرّاء، على عكس بعض مجايليه الذين تساقطوا وتباينوا، وهو كالزرافة لا يحني هامته ولو قسا عليه الدهر، ولو احتال هو عليه وعلى الآخرين، إذ ضاقت به الحاجة، وكان الهروب أجلّ علامة فيه.
وعصام حين يقود سيارته، إنما يكون في حال الخطر تمامًا، إذ يشرد وإذ يحيد عن الطريق، ولولا العناية ولولا العفوية ولولا الشجاعة لما اكتمل ولما بقي له عمر.
وكم مرّة طرأ عليه حادث؟ ذلك مرارًا في الليل أو في النهار، وكم مرّة ضيّع نظارته، ولا يسأل ولا يحفل بالمصيبة، بل كما هو وعقله يشتغل ونفسه عابرة الحروف، وهو أقرب إلى الأصالة وإلى بعض الأسماء في تاريخ الأدب، مما إلى أن يكون خارجًا عن المألوف وعن الأحكام التي تتراكم عليه وينفضها عن جلده مثلما يفعل أهل الغابة، أو يفعل الفيل وذلك الأبيض والأسود الوحشي.
سعيد عقل إمبراطور الأوزان
وهذا سعيد عقل، والملهم حتى النهاية، ولو قيل إنه رمزي، إنشائي ولغوي، والدليل هنا أنك إن فككت الوزن حيث هو مبدع به، تتسارع الحبات إلى الحضيض، والنضيد الذي كان إنما يبدو ليكون في هباء، وهنا العقدة، عقدة سعيد عقل، وكونه ينتمي إلى التراث أكثر مما ينتمي إلى الحداثة، هذه الحداثة التي تتطلب المعنى الهيولي، المعنى الأسطوري، والنغمة المطلقة، وليس الاكتفاء بالنضيد، لأنه المقصود، ولأنه كما عند المتنبي، هو كذلك وهو الجمال. ويبدو عقل أبدي الإقامة في حضارتنا اللبنانية والعربية مثالاً لهما.
يوسف حبشي الأشقر
وهذا يوسف حبشي الأشقر الذي غاب باكرًا عن الرفقة وعن الأصحاب وعن الأدب الروائي... وكان قادرًا على العبث وعلى الإحاطة بما بين يديه من المادة، وكان يلتفت نحوه جريئًا ومتجرئًا على القول وعلى الوصف، وعلى صيد الأشخاص في أحزانهم وأتراحهم وفي التناقضات المتقاطعة والمختلفة. وطالما نشرت له قصصًا وما يشبه التقدم إلى المجهول، إلى حيث الانطفاء أو الانبعاث وإلى غاية لا تظنها واحدة، بل هي أكثر وتذهب في الاتجاهات حتى الاصطدام بما هو شؤم أو نحس أو بين بين.
كاشف وناقد ومتذوق، وكان في المبتدأ وفي الخبر، ينصرف إلى القصيدة الحرّة، ولكن تعوزه في هذه الناحية، مساحة الوعي الكامل واليقظة الكاملة، ولذلك انتقل من هذه المهنة الأولى إلى الثانية إلى حياة القصة والرواية، وإلى اختطاف الصفات والطباع من نحوه، أي من ثقافته ومن واقعه القائم والمتعدّد الرحابة والأنس...
ولعلّ يوسف مثل بعض الذين وقفوا حيارى ماذا يفعلون وماذا يتذوقون من الشعر الحديث وكيف هو وماذا عليه أن يكون وأي وجه هو وجهه ومحياه الأصيل...
هؤلاء الكبار أنسبائي
وترامت الحقبة على وسعها، وأنا أصفر لها في ملعب المغامرة، وفي حلقة التواصل والانطلاق إلى أي بعيد، ونترك ما ليس يحوي المقدرة ويحوي الحيوية المطلقة، وينبغي الاعتراف بأن الحقبة كانت حقبة ولادة بل الأحرى ولادات، وكان الكبار المتعبون ما زالوا أحياء. وهذا تارّة الأخطل الصغير على إيقاعه الخفيف... وهذا أمين نخلة وخطواته الرقيقة، وظلّه الأخفّ من النملة، وهذه فيروز ونحن عندها ذات مرّة وعند عاصي ومنصور الرحباني، والسفرة متاحة وفيروز في بيتها ذاك وزوجها يناديها نهاد، أي ينادي المرأة، وتهيئ لنا الغداء، والزاد الثاني يموج مع عاصي ولا ينساه، ويسمعنا أغنية بيّاع الخواتم، ونشعر بالرطوبة، بالغيث يسيل علينا ويمدّنا بالجمال الفيروزي والرحباني. وهذا ميخائيل نعيمة في قوامه ولا يتزحزح عن الذكاء في النظرات، في المتابعة، وفي القول الطيب الذي لازمه. والمعاصرون كثر، هؤلاء قومي وأنسبائي، ولا أحد إلا شاركني وألا شاركته، وهكذا حسين مروه ومحمد دكروب.
وهكذا كنت المهر والحصان المجلّي معًا، وأركض على كلّ الرمال، ولا أدع فسحة من أهل القلم إلا أمشي على أصدافها وعلى حصاها وعلى حجرها الأملس، وأرمي من أصادفه، أيًا كان بالتحية وأنزل في ظهرانيه، لأكون الأكول والنهم في صحنه الفكري، وفي أفقه المفتوح، وفي نفسه الحرّى التي تذوب في النخوة وفي الإحاطة، وفي معرفة كنه الوطن، وأعبّ من كبرياء المهنة وإضافة الجديد الذي لا مفر منه...

 aawsat.com
aawsat.com
غداء في منزل فيروز وغسان تويني يطرده
والآن إلى شعب جريدة «النهار»، وإلى غسان تويني، وإلى الشاعرة ناديا تويني التي كانت ليّنة القوة وصلبة الشكيمة، حين هي كانت مريضة، وكانت تعي أنها تصير كذلك، ومع ذلك كانت صباح الخير ومساء الخير، وكانت شاعرة بدأت متردّدة النبرة، ثم تحولت إلى متمكنة من الكلمة باللغة الفرنسية.
وغسان تويني زوجها، لم يكن كلّ الوقت عابسًا، وإنما يضحك ضحكة تعبير نصفية، لا يرتوي ولا يشبع منها، وكان مع ناديا تويني يفتح لنا بيته العالي والفاخر في رأس كفرا، وبيت مري، في المتن الشمالي، ونحن نسهر ونتكلم في الطالع والنازل، ومرة كان يوسف الخال ونزار قباني من الضيوف وبعض المثقفين والشعراء، وكان الصفاء في الأحاديث. وما زلت أسمع تويني ينتقد يوسف الخال، ويأبى أن يطيقه في دور الشاعر الذي يحضن الموهوبين ويتهكم قليلاً. وإلى الطاولة فيما نتناول العشاء كانت ناديا، ولم تدافع عن يوسف الخال، بل أنا فعلت وعاتبته، لأنه ينكر عليه حضوره، وكونه قائمًا بنهضة أو محاولة نهضة في الشعر العربي الحديث، وليس وحده بل نحن معه، وصمت تويني وهو مقتنع بما عنده وليس العكس بتاتًا.
وكان تويني أيضًا قريبًا طبعًا من ناديا تويني في شِعرها، ولم يكن قريبًا من الحركة الثقافية عامة، مثلما فعل فيما بعد، فلا يحدب على أي موضوع ثقافي أمامنا نحن، إذ كنا في «النهار»، ونحمل معنا قلمنا الذي شحذناه في حركة مجلة «شعر» وحملناه إلى المهنة، إلى الصحافة. وكان بنا روح يحفزنا، وبه نتفهم أي تجربة في النثر أو الشعر ولا يستطيع غيرنا، لأنه في السبات، أن يكون في محلّنا في مرصادنا المتين والمشرف على الشاردة وعكسها، على ما يهزّنا هزّة ولو خفيفة، فنعلم أن في هذا الباب صدى واندفاعًا إلى الأشياء، إلى أول المغامرة التي لم نتنازل عنها حتى في الكهولة.
وتويني جزء من جو «النهار»، وكان حقًا لطيفًا وممتلئًا بالأحاسيس الجدية والبسمات والأحلام، وفي مدى هذا الجو ترعرعنا ثانية وصرفنا سنوات ولم نأسف، وكانت الوجوه رضيّة وأليفة منذ الستينات إلى أواخر التسعينات من القرن الماضي. وكنا أوفياء فلا ما يعطّل المسيرة الناعمة، وكان فرنسوا عقل في السلم وفي الحرب هو الأشدّ والأطول باعًا في الصمود وفي دفع الجريدة إلى مصيرها الأوحد، وهي أن تستمرّ، وهكذا استمرّت في الحرب اللبنانية، وتحدّت المخالب من كلّ نوع وقياس، وتويني أحيانًا في موقع المتفرج وموقع غير المصدق، وكأنه ينتظر أن تحدث الخيبة في أول فرصة، وأي زمان.
وشعب «النهار» ما أحلاه كان، فنحن إخوة، ونحن كتاب ونحن سطور وكلمات، ونحن خبر أو قصيدة أو نص مرتفع فوق العادة، ونحن مؤلفون وبنا الأقدام على الثمار وعلى ما يتوافق ويهتدي إلى الغاية الأخيرة، إلى النجاح الثمين والأكيد...
وإلى ميشال أبو جودة الذي تابعناه في عموده على الصفحة الأولى، وفي المضمون الذي له والذي كان الوحيد في وهجه، قبل أن نأتي نحن وأن نعمد نحن إلى التنويع وإلى بسط الوهج على صفحات الملحق، ثم صفحات «النهار». وإلى أن نكون في عزّ المضي إلى الأمام، وإلى أن نحرز قارئًا آخر ليس السياسي، وليس الذي اعتاد اسمًا واحدًا أو لونًا واحدًا مما في الجريدة.
أنسي الحاج والمثالية
وسبق لنا، سنة 1967، حين الهزيمة العربية، أن عمدنا إلى المخاطبة الثنائية أنا وصديقي أنسي الحاج الذي كان يهرب من الارتجال والعفوية الآنية والكتابة المباشرة، ويأخذ نصي أنا وعباراتي أنا، يأخذهما مني ونحن في مقهى «الهورس شو»، ويذهب إلى وحدته، إلى مكتبه، ويردّ على ما كتبت بعبارات تفقد أهميتها اللحظوية، لتكون شغل العقل والتأني. وليس ذلك بالعجيب، بل إنه عمد إلى الطريقة ذاتها مع ناديا تويني، وأظنه فعل كما معي، وأظن ناديا أيضًا ردّت بتأن وهو فعل بتأن، وانتفى الغرض من هذه الطريقة، أي أن تكون بنت الساعة، بنت العمق الإبداعي، لا أن تكون في صنف التأليف المعتاد والاصطناع الزائف، والموهبة هنا في حداد على هذا الموقف الخارج عن البراءة الأولى، وعن الزبد السريع إلى ملاقاة الأرجل على الرمل، ولفّ الأجساد بالأمنيات وبالعطر اليودي.
وحين تركت «النهار» لم يفكّر أنسي الحاج أنه سيصيبه ما أصابني، وأن غسان تويني استعمل كلمات الرثاء وإن في ستار التقييم والكلمات المرسلة بتأن ورحمة.
وأين المثالية فيما يفعل، وأين جلال الكلمة حين يقولها، لتكون هي الرادع له والحاجز دون أن يشطّ وأن ينحرف عن الخلقية وعن الصراط الحقيقي.
وتخلى عني غسان تويني
إذ تخلّى عني غسان تويني بسهولة، وأنبأني أنني مصروف، وأنه يستغني عن خدماتي. قالها لي في مكتبه وأنا قبالته. ثم سألني من ترى أنه صالح ليكون مطرحي، وما أجبت بل بقيت صامتًا، ورغبتي أن أنصرف وأنتهي من هذه اللعبة بين القط والفأرة، بل إن طبعه كما ظهر لي أنه يهوى الفعل الكاسر ولا حاجز دونه ليردعه عن الاستهتار واستعمال المزاج المنقلب. وكان هذا الحاجز يدعى فرنسوا عقل، إذ كان مدير التحرير الساهر على موقفه وعلى كرامة المحرّرين، وكنت أنا كذلك في هذا الفيء المتين، وكنت أعطي نفسي وموهبتي مسرورًا أبدًا. ما عدا الزمن الأخير حيث بلغ انزعاجي من الجو الوقح والدسائس إلى ذروته، وتكسّرت أغصان المحبة والطيبة على حضيض الانفعال والبراهين الصغيرة.
في منزل فيروز وعاصي
وخرجنا من الغداء عند الأخوين الرحباني والسيدة نهاد كما يناديها عاصي، خروجًا كان له الصدى في ملحق «النهار» وكان يوميًا، وتردّد الصدى أيضًا في بعض الإعلام، وحيث الأمر دائم الطرح، لأن العائلة الرحبانية في صدد أعمال وأغان وغيرهما من النشاط الذي يتصاعد إلى عرش العزّ والتجاوب المنداح إلى أقصاه، ولن أرجع إلى تفاصيل، بل أدلّ على سلوك أنسي الحاج رحبانيًا، من قبل في تلك الآونة ومن بعد في آونة المسرحيات والإطلال على الجمهور، بل على الجماهير، وعلى الآذان في وضع إصغاء ونجوى وطرب. وكان الحاج يغالي في إعجابه وتستخفه فيروز بما عندها من امتدادية في الهالة. بل إنها تبثّ النشوة نحوها، بحيث الكثيرون يقعون في هذه البئر العميقة من الجاذبية، وفي هذه الفجوة من الحرير، ويمكن القول ما أحيلى هذا الفخ وما أحيلى أن يسقط فيه الإنسان وأن تلفّه خيوط الشبكة الجميلة، ولا بطولة هنا ألا تتجاوب، وألا تنفعل، بل عليك الإقبال على هذه المساحة العذبة.
وكان أنسي، وهو حرّ وعلى حق، ذاتيا وانفعاليا، منذ «هالة والملك» على مسرح «البيكاديللي» يجلس في الصالة، ولا يفتأ أن يجهر ما يجيش في داخله من الآهات، وأخبرني المرحوم سمير نصري، وكان المقرب من الرحابنة آنئذ، أن عاصي كان ينزعج.
والحاج نفسه في القاعة حيث كنت أحرّر، وكان مكتبي في «النهار»، لا أدري لماذا احتدّ، وكانت الحرب صرفته عن العمل الدؤوب، أما نحن فكنا المحرّرين والمنكبين على أوراقنا، إذ هو أحاط بفيروز إحاطة الشغف والانجراف إلى موجاتها وبحرها الهائج والمنبعثة منه روائح السحر وتلاعب الرياح بالأشجار.
وعندما بلغت «هالة والملك»، خاتمتها سألني أنسي ماذا نفعل احتفاء بالنهاية؟ وماذا تستحق فيروز منا؟ وكان اقتراحي باقة وإرسالها إلى السيّدة العذبة الكهرباء، وبعثنا إليها بباقتين، ولم أدر أي شيء من التأثير، فيما تلا ذلك.
وعاصي، يخبرني سمير نصري، كان شديد الاحتضان لفيروز، وقسّى بكلماتها عليها، وكان يريدها طيّعة، وأن تكون كما يشاء من النظام، نظامه هو، وألا تخرج من أساره، من النهج الذي يخطّه. وكان يثأر من التصرّفات الفيروزية، بالكلمات يناديها، إن تباطأت على المسرح ولم تنسحب من التصفيق والتحيات والأزهار، حين يتطلب ذلك منها.
وعاصي ولو قسّى الكلام نجم رحباني مديد النور، تصل سرعته إلى الأجمل وإلى الأعمق، وهو من نضج التراث اللبناني، متعاونًا أو غير متعاون، بمساحة من الإبداع وبمساحة من اللغة الغنائية، إذ استقى من بلاده ومن هذه الليونة في العبارات والقصائد، بحيث كتب لها أن تكون الخميرة وأن تكون الصاج، وأن تكون المصهر، وأن تكون الرغيف الذي مهما تناولت منه يزداد اتساعًا ويتهادى خصبًا كبيرًا ولا تنتهي الموعظة، بل إن الجموع لن تجوع، ولن يأتيها القحط، ولن ينفد الطعام أبدًا.
زياد الرحباني... يخرمش الناس
ذات مرّة كان زياد الرحباني قبالة وجهي وهو على الكرسي في مكتبي في الحمراء. وكان من اللطف ومن الحديث الذي يقارب الهمس بحيث يسكب منه الكلمة العابرة أو الرقيقة. كما هي خفة الشراريب في طيارة الورق. وكان الذي أدركته الموسيقى والتراث المتراكم من الوالد عاصي الذي بنى باللمح والسرّ المضاء، مع منصور قصيدة النعومة والذكاء وتلك الخيوط بين حالة وحالة في لغة هي العامية وفي أقصى التجليات ومعالم الدعابة الكلامية. كما من عمّه منصور المنتشر جهده وعبيره. وزياد من الوالدة التي في صفاء النجوم والسفيرة... هو يرث ولا يرث ما سبق من الثروة القائمة على مجدها وعلى بيانها المديد.
لكنه مشرقي فيما هو أيضًا لبناني، وفي ألحانه وفي مسرحه ابتكار فيما تحتوي اللغة المحكية من انعكاس عميق ينزل في النفوس وفي العقول وفي مداها الخفي ويزرع الصدمة الحيّة والسريعة إلى التأثيرات مثلما هو النسر حين يفلش جناحيه ويخرمش الفضاء ويبعث المهابة.
وزياد يخرمش الناس، ويجلب مثلما يفعل الرحابنة، ذلك الإمتاع وتلك العاطفة وتلك الضحكة. وكلها في قالب الفكاهة التي تحتمل التأويل وتلك العبثية في الحركة كما يشتهي الفن الأصيل.
وفي الغناء وفي الأغنية عند زياد، ذلك الحنين الذي في المنطقة المشرقية، وذلك الطرب المختبئ ولا يظهر ولا ينجلي من ناحية التقييم سوى للعارفين، لكنه على سوية فنية ويكسر النسق الآخر ويبقى الطرب والدوخة كما عند الدراويش.
سمير عطا الله يجسّ الأنفاس
كنا معًا في جريدة «النهار» هو في ناحية وأنا في أخرى مفتوح الباب الزجاجي، وفي مكتب من الأوراق والأقلام. وسمير صحافي متذوق ودقيق، وهو على قوامه وعلى سمته المعروف وعلى الموهبة تدربت على الصواب وعلى قول ماذا في الباطن من شعلة ومن غضبة ومن التباس محكم الحلقات...
وهو، نحوي، وفي اتجاهي كلما حانت المناسبة الشعرية. وكما في السياسة هو طويل الروح وطويل الباع ورنان الجملة والتعبير المتصل والمتراكم حجّة وراء حجّة، وهمسة وراء همسة، كذلك هو في الأدب تنفجر النخوة لديه، وتضطرم المعاني خطوة وراء خطوة وجمرة وراء جمرة.
وهكذا الأسلوب عنده ينظر من عقله ومن وجدانه، ويسطع دم التجاوب وعصارة البلاغة. وهو يراني في قطعة كثيفة السطور، نشرت له في جريدة «النهار»، عنوانها «ذو الرنّة». أنني البهجة الشعرية لديه، ولا يدري السبب، وأنني له اللذة والرنّة، ولا يريد أن يدري لماذا. وها أنا ذا عنده «سنجاب يقع من البرج» كما فعل وانتقى عنواني لمقاله في أحد الأربعاء. وممكن القول إنه ذكاء وخيال ومتعة.
... وكيف لا يكون سمير عطا الله ذلك الأحادي الذي من طاولة الخبريات إلى الأوسع والأرحب، ومن التعب ثم التعب إلى النضج وإلى معالم الإحاطة والعبور في مهنة الصحافة وأشواكها وأزهارها. ومن فكرية إلى وقفة إطار يطلطل على لبنان وعلى العرب والعروبة وعلى المشاق والمهام والألوان. وما فتئ يلعب اللعبة بذكاء العبارة الممشوقة والليّنة بغية التأثير، وأن يشرب القارئ عذوبة الأسلوب نوطة ثم نوطة ورقصة ثم رقصة. وتلك، من سمير عطا الله، لمعة خاصة به تزيّن مقاله وتبعث الضوء حتى رؤية الشحوب ورؤية العافية معًا.
والأوفر في خضمّ ذلك، ثقافة الكاتب وكونه في ربيع الكلمة، وكونه في حاضرنا وفي سياقنا وفي النبوءات المتسارعة وليست في الغفلة أو في الطعن، وإنما هي الواقع، حيث الأزمات وحيث الصعاب، وتصوّره كما يفعل أي أديب أو أي روائي، أو أي صحافي مثل سمير عطا الله، وكأنه لا يبحث عن علاج وإنما ينبض ويجسّ الأنفاس، فضلاً عن القلب ونقله إلى الطوارئ المثالية وإلى سرير الحياة المثالي.
حنان الشيخ كأنها الركوة والقهوة
الصديقة والرفيقة والزميلة لي في جريدة «النهار» هي حنان الشيخ، وهي التي فازت ونجحت أمامي قبالة البصر والمنظار في مسح مجتمعها الأنثوي، وفي أنها داومت وغلبت الجفاف.
وتحمل حنان الشيخ الروائية اللبنانية، حيث تكون صورًا من بلادها، مقاطع من حياة ناسها، فسيفساءها، أحوالها، نساءها، رجالها. تحمل معها الشعب في أموره الصغيرة والأوسع في شجونه الكبيرة والأوسع، وكلما صدرت رواية لها تراءت المرأة العربية خصوصا في وهجها المتألق وفي رونقها وفي جفافها، ولعلّها أشد ظهورًا في هذا الذبول وهذا التناقض الذي يقوم بينها وبين العالم حولها...
إذن عالم أقصاه الغرب وأدناه الشرق، وفي هذا الشرق هي المرأة التي تفكر قليلاً... إن كان لها متسع من الحرية، فإنها تتمادى وتعصف بها العاصفة، وتدفعها إلى مواقع ضجر وخيبة، مواقع من أنس هو الأقل الأقل، ومواقع من التهافت الكياني، وتكثر عليها الأسئلة والأخطاء والتردّدات... وهكذا دائمًا لا ترتوي، لا تشعر بالثقة والأمان وتعكس مجتمعًا لها غارقًا في التحولات المتباطئة، ولا ما يوقفها في أرض صالحة...
حنان الشيخ منتجة، ولا يفوتها مجتمع في هلوساته وامتدادها كلما انوجد في مجتمع كالمجتمع اللندني. وهي، في حياتها العادية، لا تفعل سوى الكتابة، وسوى تناول الشوكولا، لذة عابرة من لذائذها، وسوى أن تسرّنا في العمق وفي الصباح كما في أي ساعة. وإنتاجها صادق اللسان والوتيرة يهجم على الطريدة، وينتصر دائمًا في صيد الحميم ولو تصاعد إلى مشارف العنف.
ولا تبخل حنان، بل إنها في علاقاتها الثقافية إنما تنجب، ويكون الجميل هو الذي يبزغ من أصابعها، من قلمها حين تكتب أو تحقق أو تقابل إحداهن. لا سيما هاتيك النسوة المرتفعات عن الواقع، عن العادي، واللواتي من ألوانهن، من أفكارهن، وهن في حركتهن والسلام لديهن. وهن في أدوار ملكة النحل، إنما يطربن للعمل، ولأن يضفن العسل المشتهى إلى طاولة المشتهيات. وحنان الصحافية لا تقلّ شأنًا عن الروائية، بل كانت الحميمة والجريئة والتي تنشد الحق وتنشد المثال حيث يكون مقامها، وحيث تتوسّع ليشمل الكحل عيون جميع السيّدات، ولا عمى البتة، وما تتراجع عنه، ولا تخبّئ الحقيقة بل ترسلها صراخًا وصورة دسمة ومرآة تعكس المطلق...
هي الآنسة، وهي السيّدة، وهي الصبيّة تبقى كذلك وهي الصحافية ذات مرّة وذات أوان. وهي، في الأحوال كلّها، وفي القريب وفي البعيد من الحياة التي عاشت وذاقت والتي كانت طوال الأيام والساعات كأنها على جمرة وعلى نار. وكأنها القهوة والركوة. وهي تحاذر أن تفور وأن يسيل من الفنجان، من الركوة أي شلال أي نقطة على الأرض أو على ثوبها أو على مريولها أو على الورقة البيضاء، لأن هذه الورقة هي التي تكتب عليها مناظر من الشرق، من النسوة من النساء اللواتي يغرقن في التناقضات وفي أصناف من الأسر وفي ركام من القيود...
وحنان لبثت على نقاء في الطوية وفي السيرة. وارتدت بغية الأمانة، ثوبها الحقيقي من الشرق ومن الغرب. وثوب الحقيقة في كلّ مكان وفي كلّ النصوص والروايات والأوراق التي شبعت من الاعتراف ومن الصور الجذابة إلى حدّ الحصول على بطاقة الدخول إلى عمق الدار، أي دار، وعلى الأخصّ هي التي لا تفارق الصبا ولا ذلك الجنون الناعم.
عصام محفوظ «الهمشري» المتمرد
وهذا وجه عصام محفوظ الذي كانت له معرفة بي منذ «أكياس الفقراء»، إذ شاهدته في مكتبة المر، على ذلك المدخل إلى جنب سينما دنيا، يقلب ديواني الأوّل، صادرًا عن حلقة الثريا، في دار مجلة «شعر»، عام 1959. ومن كلمة إلى كلمة، إلى أنس ناعم، ونشأت صحبة، إذ هو المثقف والبارع في النقد وفي القراءة وفي الحدس التام، وفي الوصول إلى هيبة النص ومعناه الدفين. وكانت له رحلة متأخرًا إلى مجلة «شعر» وإلى يوسف الخال عينه إذ بشّ في قدومه وكان يرافقنا في العمر الأخير من المجلّة، وله ديوان، ثم كانت تجربة المسرح التي فسحت له في تبيان الهدف وما هو منشود ومقصود. وكنت ربما الأول الذي رآه مسرحيًا حين طرحت قصيدته «زليخة» في خميس مجلة «شعر»، وأفصحت عن رأيي حينئذ أن في القصيدة مسرحًا.
وعصام همشري في الواقع، وابن التمرد على الوضع العائلي، إذ لطالما تسكع وعاش منفردًا في عالمه الخاص، وما كان أبدا في خطوة ثابتة أو دائمة، وإنما ينفلت من القاعدة من التقليد إلى الحريّة وشم نسيمها اللذيذ، ولكن ليظهر دائمًا أنه الصحيح، وعندي أنه الصحيح مظهرًا والغريب والشارد باطنًا.
وما كان إلا الغريب حقًا، والمال عنده ليس سوى ورقات وسوى غيمة يطردها الهواء. وتارة هو الغني وتارة هو الفقير، ويظل إياه متماسكًا في السرّاء والضرّاء، على عكس بعض مجايليه الذين تساقطوا وتباينوا، وهو كالزرافة لا يحني هامته ولو قسا عليه الدهر، ولو احتال هو عليه وعلى الآخرين، إذ ضاقت به الحاجة، وكان الهروب أجلّ علامة فيه.
وعصام حين يقود سيارته، إنما يكون في حال الخطر تمامًا، إذ يشرد وإذ يحيد عن الطريق، ولولا العناية ولولا العفوية ولولا الشجاعة لما اكتمل ولما بقي له عمر.
وكم مرّة طرأ عليه حادث؟ ذلك مرارًا في الليل أو في النهار، وكم مرّة ضيّع نظارته، ولا يسأل ولا يحفل بالمصيبة، بل كما هو وعقله يشتغل ونفسه عابرة الحروف، وهو أقرب إلى الأصالة وإلى بعض الأسماء في تاريخ الأدب، مما إلى أن يكون خارجًا عن المألوف وعن الأحكام التي تتراكم عليه وينفضها عن جلده مثلما يفعل أهل الغابة، أو يفعل الفيل وذلك الأبيض والأسود الوحشي.
سعيد عقل إمبراطور الأوزان
وهذا سعيد عقل، والملهم حتى النهاية، ولو قيل إنه رمزي، إنشائي ولغوي، والدليل هنا أنك إن فككت الوزن حيث هو مبدع به، تتسارع الحبات إلى الحضيض، والنضيد الذي كان إنما يبدو ليكون في هباء، وهنا العقدة، عقدة سعيد عقل، وكونه ينتمي إلى التراث أكثر مما ينتمي إلى الحداثة، هذه الحداثة التي تتطلب المعنى الهيولي، المعنى الأسطوري، والنغمة المطلقة، وليس الاكتفاء بالنضيد، لأنه المقصود، ولأنه كما عند المتنبي، هو كذلك وهو الجمال. ويبدو عقل أبدي الإقامة في حضارتنا اللبنانية والعربية مثالاً لهما.
يوسف حبشي الأشقر
وهذا يوسف حبشي الأشقر الذي غاب باكرًا عن الرفقة وعن الأصحاب وعن الأدب الروائي... وكان قادرًا على العبث وعلى الإحاطة بما بين يديه من المادة، وكان يلتفت نحوه جريئًا ومتجرئًا على القول وعلى الوصف، وعلى صيد الأشخاص في أحزانهم وأتراحهم وفي التناقضات المتقاطعة والمختلفة. وطالما نشرت له قصصًا وما يشبه التقدم إلى المجهول، إلى حيث الانطفاء أو الانبعاث وإلى غاية لا تظنها واحدة، بل هي أكثر وتذهب في الاتجاهات حتى الاصطدام بما هو شؤم أو نحس أو بين بين.
كاشف وناقد ومتذوق، وكان في المبتدأ وفي الخبر، ينصرف إلى القصيدة الحرّة، ولكن تعوزه في هذه الناحية، مساحة الوعي الكامل واليقظة الكاملة، ولذلك انتقل من هذه المهنة الأولى إلى الثانية إلى حياة القصة والرواية، وإلى اختطاف الصفات والطباع من نحوه، أي من ثقافته ومن واقعه القائم والمتعدّد الرحابة والأنس...
ولعلّ يوسف مثل بعض الذين وقفوا حيارى ماذا يفعلون وماذا يتذوقون من الشعر الحديث وكيف هو وماذا عليه أن يكون وأي وجه هو وجهه ومحياه الأصيل...
هؤلاء الكبار أنسبائي
وترامت الحقبة على وسعها، وأنا أصفر لها في ملعب المغامرة، وفي حلقة التواصل والانطلاق إلى أي بعيد، ونترك ما ليس يحوي المقدرة ويحوي الحيوية المطلقة، وينبغي الاعتراف بأن الحقبة كانت حقبة ولادة بل الأحرى ولادات، وكان الكبار المتعبون ما زالوا أحياء. وهذا تارّة الأخطل الصغير على إيقاعه الخفيف... وهذا أمين نخلة وخطواته الرقيقة، وظلّه الأخفّ من النملة، وهذه فيروز ونحن عندها ذات مرّة وعند عاصي ومنصور الرحباني، والسفرة متاحة وفيروز في بيتها ذاك وزوجها يناديها نهاد، أي ينادي المرأة، وتهيئ لنا الغداء، والزاد الثاني يموج مع عاصي ولا ينساه، ويسمعنا أغنية بيّاع الخواتم، ونشعر بالرطوبة، بالغيث يسيل علينا ويمدّنا بالجمال الفيروزي والرحباني. وهذا ميخائيل نعيمة في قوامه ولا يتزحزح عن الذكاء في النظرات، في المتابعة، وفي القول الطيب الذي لازمه. والمعاصرون كثر، هؤلاء قومي وأنسبائي، ولا أحد إلا شاركني وألا شاركته، وهكذا حسين مروه ومحمد دكروب.
وهكذا كنت المهر والحصان المجلّي معًا، وأركض على كلّ الرمال، ولا أدع فسحة من أهل القلم إلا أمشي على أصدافها وعلى حصاها وعلى حجرها الأملس، وأرمي من أصادفه، أيًا كان بالتحية وأنزل في ظهرانيه، لأكون الأكول والنهم في صحنه الفكري، وفي أفقه المفتوح، وفي نفسه الحرّى التي تذوب في النخوة وفي الإحاطة، وفي معرفة كنه الوطن، وأعبّ من كبرياء المهنة وإضافة الجديد الذي لا مفر منه...

«شوقي أبي شقرا يتذكر» (3 - 3): فضائل «شعب النهار»... والدسائس
في الحلقة الثالثة والأخيرة من كتاب «شوقي أبي شقرا يتذكر» مزيد من كواليس الكبار المؤسسين بعد أن انتقل إلى جريدة «النهار»، إذ يتحدث الكاتب عن استغناء غسان تويني عنه «بسهولة» بعد ثلث قرن، وعن صمت أنسي الحاج، وكيف أن السيدة فيروز كهربت أنسي ومسّته بسحرها