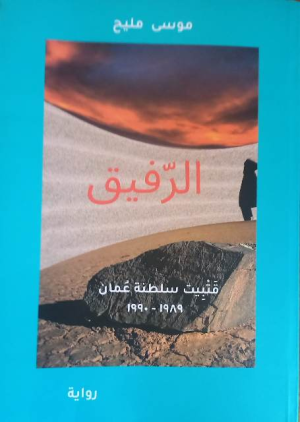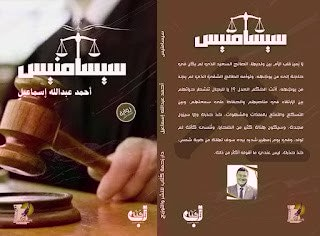إلى إريك ماري Eric Mary
لم يكن عندي أبداًً دفتر يوميات، أو بالأحرى لم أعرف يوماً إذا ما كان عليَّ امتلاك وحداً منها. أحياناً، أبدء، ثم فجأة أتوقف، بعد ذلك بفترة قصيرة، أبدأ ثانية. أنها رغبة خفيفة، متقطعة، بلا أهمية ومن دون تماسك نظري. أعتقد أنه بمقدوري معالجة "مرض" اليوميات هذا : شك لا يُحل يتعلق بقيمة ما نكتبه في ذلك الدفتر.
شك معقد : فهو شك-تأخر .(doute-retard). في اللحظة الأولى، حين أكتب ملاحظة "يومية"، أشعر بلذة معينة : هذا شيء بسيط، سهل. لا داعي هناك للتألم من العثور على ما ينبغي قوله : المادة هنا، حاضرة في الحال؛ وكأنها منجم تحت سماء مفتوحة؛ يكفي أن أنحني والتقطها؛ لا حاجة بي لتحويلها : هذه مادة ولها ثمنها، الخ... في اللحظة الثانية، القريبة من الأولى (على سبيل المثال، إذا ما قرأت ما كتبته بالأمس)، سيكون الانطباع سيئاً : هذا لا يقف على قدميه، وكأنه غذاء فقير وقد أنقلب على نفسه، مُتعفن، وأصبح بعيداً عن إثارة الشهية بين ليلة وضحاها؛ ألمح حينئذ بإحباط حيلة "الإخلاص"، التفاهة الفنية لما هو "عفوي"؛ أسوء من ذلك حتى : أتقززُ وأصدمُ حين ألاحظ بأني كنت قد اتخذت وضعية "متكلفة" (pose) لم أكن أرغب فيها أبداً : في موقف اليوميات، ولأنها بالدقة لم "تُشتغل" (لم تتحول بفعل الشغل) تكون الأنا في وضعية المتكلف (poseur) : أمر يتعلق بالأثر، وليس بالنية، كل صعوبة الأدب تكمن في هذه النقطة. أشعرُ بسرعة كبيرة، وأنا أتقدم في إعادة قراءتي، بالضجر من تلك الجمل الخالية من الأفعال ("ليلة مؤرقة، سلفاً الانضواء الثالث، الخ") أو تلك الجمل التي يتم تقليص فعلها بإهمال ("متقاطعاً مع فتاتين في ساحة س ت")-وحتى إذا ما حاولت إعطاء تلك الجمل شكلاً مناسباً ("التقيت بفتاتين، أو عشت ليلة من الأرق")، يظل قالب كل يوميات، أي إعادة كتابة الفعل، يرن في أذني ويزعجني وكأنه لازمة. في اللحظة الثالثة، إذا ما عدت قراءة صفحات يومياتي بعد عدة أشهر، عدة سنوات، من كتابتها، ومن دون أن يزال شكي، أشعر بنوع من اللذة لتذكري، بفضلها، الحوادث التي ترويها، و، أكثر من ذلك، الانحناءات (انحناءات الضوء، الطقس، المزاج) التي تجعلني أعيشه ثانية. وبشكل عام، ليس ثمة عند هذه النقطة من فائدة أدبية (باستثناء فائدة الصياغات، أي الجمل)، لكن نوع من الالتصاق النرجسي (النرجسي بشكل خفيف، لا ينبغي المبالغة) يشدني بمغامراتي (التي تظل ذكرياتها غامضة، مادام أن التذكر هو في ذات الوقت ملاحظة المرء لشيء وفقدانه مرة وإلى الأبد). لكن، مرة أخرى، هل يبرر حسن الالتفات النهائي هذا، الذي تمّ بلوغه عبر مرحلة من الرفض، التمسك (بصورة نظامية) باليوميات؟ هل يستحق هذا العناء؟
لا أضعُ هنا تخطيطاً لتحليل النوع المسمى "يوميات" (هناك كتب عن هذا)، ولكن مُذاكرة شخصية وحسب، مكرسة لاتخاذ قراراً عملياً : هل يجب عليَّ الاحتفاظ بيومياتي بهدف نشرها؟ هل يمكنني جعل اليوميات "عملاً"؟ لا احتفظ من اليوميات إذاً سوى بوظائفها التي يمكن أن تمس عقلي. على سبيل المثال، كان كافكا يحتفظ بيوميات "للتخلص من قلقه"، أو، إذا شئنا، "للعثور ثانية على "سلامه". لا يمكن لهذا الدافع أن يكون طبيعياً بالنسبة لي، أو لا يمكنه على الأقل أن يكون مستمراً. والأمر ذاته فيما يتعلق بالغايات التي تُسند لليوميات الحميمية؛ فهي لا تبدو لي مبررة. فجميعها تُربط بمنافع ومفاتن "الإخلاص" (أن يقول المرء شيئاً لنفسه، أن يصبح أكثر وضوحاً أمامها ، أن يحكم عليها)، غير أن التحليل النفسي والنقد السارتري لسوء الطوية، والنقد الماركسي للإيديولوجيات قد جعلت اعترافاً كهذا عبثياً : الإخلاص ما هو سوى مُتخيل من الدرجة الثانية. كلا، لا يمكن لتبرير اليوميات الحميمية (كعمل) إلا أن يكون تبريراً أدبياً، بالمعنى المطلق للكلمة، وحتى بمعناها الحنيني. أرى هنا أربعة دوافع.
الأول هو تقديم نصاً ذا صبغة ذاتية في الكتابة، في الأسلوب (كما كان يُقال في الماضي)، لغة فردية خاصة بالمؤلف (idiolecte propre à l’auteur) (كما كان يمكن أن يُقال ذلك سابقاً)؛ لنسمي هذا الدافع : بالشعري (poétique). الدافع الثاني، هو بعثرة آثار مرحلة في الغبار، ويوم بعد آخر، بكل ما فيها من حالات عظمة متمازجة، بدءً من المعلومة الأساسية وحتى تفاصيل اللياقة الاجتماعية؛ ألا أتمتع بلذة حادة عند قراءتي ضمن يوميات تولستوي حياة سيد روسي ينتمي للقرن التاسع عشر؟ لنطلق على هذا الدافع تسمية : التاريخي (historique). الثالث، هو أخذ المؤلف كمادة للرغبة : عن كاتب يعنيني، يمكنني أن أرغب في معرفة حياته الصميمية، الصناعة اليومية لزمنه، الأشياء التي يتذوقها، حالات مزاجه، الظنون التي تنتابه؛ وقد يذهب بي الأمر حد تفضيل شخصه على عمله، وأن القي بنفسي بشراهة على يومياته وأهمل كتبه. يمكنني إذاً، حينما تتولد عندي لذة كان الآخرون قد منحوني إياها، محاولة القيام بالإغواء من طرفي أنا، عبر هذا الالتواء الذي يجعل المرء يعبر من الكاتب إلى الشخص، و العكس بالعكس؛ أو، وهذا ما هو أنكى، أن أبين بأني " أنا أفضل مما أكتب" (في كتبي) : حينئذ، تقوم كتابة اليوميات وكأنها فائض-قوة (force-plus) (نيتشة : إضافة للقوة von Macht )، والذي نظن بأنه سيعوض عن إخفاقات الكتابة نفسها؛ لنسمي هذا الدافع : بالطوباوي utopique، مادمنا في الحقيقة لا نتمكن من الوصول إلى نهاية المُتخيل. الدافع الرابع، هو أن نجعل من اليوميات مُحترف للجمل : ليس للجمل "الجميلة"، ولكن للجمل المضبوطة؛ مضاعفة رهافة التعبير (ولكن ليس العبارة)، بفضل الحماس والمثابرة، وفاء مصيري يتماثل كثيراً مع الانفعال : "وتبتهج خاصرتي حينما تلفظ شفتيك أشياء مضبوطة" (Prov. 23,16). لنسمي هذا الدافع : بالعشقي (أو حتى : العبادي، أنا أعبد الجملة).
بالرغم من انطباعاتي الهزيلة، يمكن إذا تصور رغبتي في أن يكون لي دفتر يوميات. يمكنني التسليم بأنه في إطار اليوميات يمكن المرور من ذلك الشيء الذي بدا لي أولاً وكأنه شيء غير ملائم إلى الأدب، إلى شكل يشابه خصائصه : الشخصنة، الأثر، الإغراء، وثنية اللغة (fétichisme du langage). في الأعوام الأخيرة قمت بثلاث محاولات؛ الأولى، أكثرها أهمية لأنها وقعت أثناء مرض أمي، هي الأطول، ربما لأنها كانت تتناظر إلى حد ما مع هدف كافكا بالتخلص من القلق بفضل الكتابة، أما الاثنتين الباقيتين فلم تستغرق كل واحدة منهما سوى يوم واحد؛ لقد كانتا بالأحرى تجريبيتين، بالرغم من أني لا أعيد قراءتهما من دون حنين إلى ذلك اليوم الذي عشته (لا يمكنني أن أعطي للنشر سوى واحدة منهن، أما الثانية فهي تتعلق بأشخاص غيري).
1- 13 تموز 1977
بنت السيدة ***، الخادمة الجديدة، مصابة بالسكري، وأمها مشغولة بالاعتناء بها، ذلك ما قيل لنا بإخلاص ودقة. رؤيتها لذلك المرض مُحيرة : من جانب، لا تريد التسليم بفكرة أن السكري مرض وراثي (سيكون ذلك مؤشراً على علة بالجنس)، و، من جانب آخر، تقبل طواعية بأن ذلك المرض يؤدي حتمياً إلى الموت، وبهذا تعزله تماماً عن أية مسؤولية تتعلق بأصله. أنها تطرح المرض باعتباره صورة اجتماعية، وبأن هذه الصورة مُكَيدةً. تظهر العلامة وكأنها ينبوعاً للتفاخر والإزعاج: وذلك ما كنت عليه صورة يعقوب-إسرائيل الذي أخرجه الملاك من علبته : متعة وخجل جعل نفسه ملحوظاً.
أفكار معتمة، مخاوف، حالات قلق : أرى موت الكائن الغالي، أجن، الخ... أن هذه المخلية هي معرفة الإيمان بحد ذاته. ذلك لأنها دائماً قبول الحتمية والمخيلة معاً : أن يتكلم المرء، فهذا معناه إثبات ما يقول (مرة أخرى فاشية اللغة). بتخيلي للموت، أحبط المعجزة. فمجنون النظام (le fou de l’Ordre) لم يتكلم، كان يرفض لغة الداخل الثرثارة والمتبجحةِ. ما هو إذاً عجز الإيمان ذاك؟ ربما حب إنساني مفرط؟ هل يقصي الحبي الإيمان؟ والعكس بالعكس؟
شيخوخة وموت أندريه جيد (التي أقرأها في الـ Petit Dame) كانت محاطة بالشهود. لكني لا أعرف ما الذي حل بهؤلاء الشهود : لا شك أن أغلبيتهم قد ماتوا، بدورهم؟ أحياناً يموت الشهود هم أيضاً ومن دون أن يكون هناك شهود على موتهم. هكذا يُصنع التاريخ من بعض انفجارات الحياة، من الأموات الذين لا يناوبهم أحد.
عجز الإنسان ذو "الدرجات"، إنسان العلم على درجات، بالمقابل، قد يمكننا أن نسند لله الكلاسيكي القدرة اللانهائية على رؤية كل الدرجات : سيكون "الله" هو الأسي المطلق (l’Exponentiel absolu).
(الموت، الموت الحقيقي، هو حين يموت الشاهد نفسه. يقول شاتوبريان عن جدته وعمته : "قد أكون أنا الشخص الوحيد الذي يعرف بأن تلك المرأتين قد عاشتا" : نعم، لكن، لأنه كان قد كتب ذلك، أصبحنا نحن أيضاً نعرفه، بالقدر الذي ما نزال فيه نقرأ شاتوبريان).
14- تموز 1977
صبي صغير، عصبي، كالعديد من الصبية الفرنسيين، يقوم بدءً بلعب دور الشخص الناضج، تنكر بزي رامي رمانات في أوبريت (بالأبيض والأحمر)؛ كان يتقدم من دون شك العصابة.
لمَ يكون الهم (Souci) هنا أكبر منه في باريس؟ هذا الريف هو عالم عادي، خالي تماماً من أية فنطازيا، تظهر فيه الحساسية في غير محلها بالمطلق. أنا شخص استحواذي، لذا أُقصي.
يبدو لي بأني أتعلم أشياء كثيرة عن فرنسا، بزمن زيارة سريعة للريف، أكثر مما أتعلمه عنها بأسابيع في باريس. ربما كان ذلك وهماً؟ الوهم الواقعي (L’illusion réaliste)؟ يشكل العالم القروي، الريفي، المحلي المادة التقليدية للواقعي (réalisme). أن يكون المرء كاتباً، في القرن التاسع عشر، فذلك معناه أن يكتب من باريس عن المُقاطعة. فالمسافة هي التي تجعل من كل شيء ذا دلالة. في المدينة، حين أكون في الشارع، تنصب عليَّ المعلومات من كل جانب – لكن ليس المدلولات.
15 تموز 1977
في الساعة الخامسة من بعد الظهر، الدار هادئة، هدوء الريف. ذباب. تؤلمني ساقيّ قليلاً، كما كانت تؤلمني حين كنت طفلاً وكنت أمر في مرحلة ما كان يُسمى أزمة النمو – أو كأني قد أخذت برداً. كله لَزَجُ، يغفو. وكالعادة دائماً، كنت واعياً، وعي حاد، "بوهني" (تناقض في التعبير).
زيارة X.. : في الغرفة المجاورة، تبدو وكأنها بلا نهاية. لا أجرأ على غلق الباب. ما يزعجني هو ليس الضوضاء، لكن مجانية النقاش، (لو كان على الأقل لغة غريبة عني، ولها موسيقاها). أنا دائم الاندهاش، مصعوقاً حتى، من مقاومة الآخرين : الآخر (l’Autre)، بالنسبة لي، هو ذلك الذي لا يتعب (l’Infatigable). الطاقة -لاسيما الطاقة اللغوية- تُذهلني : قد تكون اللحظة الوحيدة (إذا ما وضعنا العنف جانباً) التي أومن فيها بالجنون.

لم يكن عندي أبداًً دفتر يوميات، أو بالأحرى لم أعرف يوماً إذا ما كان عليَّ امتلاك وحداً منها. أحياناً، أبدء، ثم فجأة أتوقف، بعد ذلك بفترة قصيرة، أبدأ ثانية. أنها رغبة خفيفة، متقطعة، بلا أهمية ومن دون تماسك نظري. أعتقد أنه بمقدوري معالجة "مرض" اليوميات هذا : شك لا يُحل يتعلق بقيمة ما نكتبه في ذلك الدفتر.
شك معقد : فهو شك-تأخر .(doute-retard). في اللحظة الأولى، حين أكتب ملاحظة "يومية"، أشعر بلذة معينة : هذا شيء بسيط، سهل. لا داعي هناك للتألم من العثور على ما ينبغي قوله : المادة هنا، حاضرة في الحال؛ وكأنها منجم تحت سماء مفتوحة؛ يكفي أن أنحني والتقطها؛ لا حاجة بي لتحويلها : هذه مادة ولها ثمنها، الخ... في اللحظة الثانية، القريبة من الأولى (على سبيل المثال، إذا ما قرأت ما كتبته بالأمس)، سيكون الانطباع سيئاً : هذا لا يقف على قدميه، وكأنه غذاء فقير وقد أنقلب على نفسه، مُتعفن، وأصبح بعيداً عن إثارة الشهية بين ليلة وضحاها؛ ألمح حينئذ بإحباط حيلة "الإخلاص"، التفاهة الفنية لما هو "عفوي"؛ أسوء من ذلك حتى : أتقززُ وأصدمُ حين ألاحظ بأني كنت قد اتخذت وضعية "متكلفة" (pose) لم أكن أرغب فيها أبداً : في موقف اليوميات، ولأنها بالدقة لم "تُشتغل" (لم تتحول بفعل الشغل) تكون الأنا في وضعية المتكلف (poseur) : أمر يتعلق بالأثر، وليس بالنية، كل صعوبة الأدب تكمن في هذه النقطة. أشعرُ بسرعة كبيرة، وأنا أتقدم في إعادة قراءتي، بالضجر من تلك الجمل الخالية من الأفعال ("ليلة مؤرقة، سلفاً الانضواء الثالث، الخ") أو تلك الجمل التي يتم تقليص فعلها بإهمال ("متقاطعاً مع فتاتين في ساحة س ت")-وحتى إذا ما حاولت إعطاء تلك الجمل شكلاً مناسباً ("التقيت بفتاتين، أو عشت ليلة من الأرق")، يظل قالب كل يوميات، أي إعادة كتابة الفعل، يرن في أذني ويزعجني وكأنه لازمة. في اللحظة الثالثة، إذا ما عدت قراءة صفحات يومياتي بعد عدة أشهر، عدة سنوات، من كتابتها، ومن دون أن يزال شكي، أشعر بنوع من اللذة لتذكري، بفضلها، الحوادث التي ترويها، و، أكثر من ذلك، الانحناءات (انحناءات الضوء، الطقس، المزاج) التي تجعلني أعيشه ثانية. وبشكل عام، ليس ثمة عند هذه النقطة من فائدة أدبية (باستثناء فائدة الصياغات، أي الجمل)، لكن نوع من الالتصاق النرجسي (النرجسي بشكل خفيف، لا ينبغي المبالغة) يشدني بمغامراتي (التي تظل ذكرياتها غامضة، مادام أن التذكر هو في ذات الوقت ملاحظة المرء لشيء وفقدانه مرة وإلى الأبد). لكن، مرة أخرى، هل يبرر حسن الالتفات النهائي هذا، الذي تمّ بلوغه عبر مرحلة من الرفض، التمسك (بصورة نظامية) باليوميات؟ هل يستحق هذا العناء؟
لا أضعُ هنا تخطيطاً لتحليل النوع المسمى "يوميات" (هناك كتب عن هذا)، ولكن مُذاكرة شخصية وحسب، مكرسة لاتخاذ قراراً عملياً : هل يجب عليَّ الاحتفاظ بيومياتي بهدف نشرها؟ هل يمكنني جعل اليوميات "عملاً"؟ لا احتفظ من اليوميات إذاً سوى بوظائفها التي يمكن أن تمس عقلي. على سبيل المثال، كان كافكا يحتفظ بيوميات "للتخلص من قلقه"، أو، إذا شئنا، "للعثور ثانية على "سلامه". لا يمكن لهذا الدافع أن يكون طبيعياً بالنسبة لي، أو لا يمكنه على الأقل أن يكون مستمراً. والأمر ذاته فيما يتعلق بالغايات التي تُسند لليوميات الحميمية؛ فهي لا تبدو لي مبررة. فجميعها تُربط بمنافع ومفاتن "الإخلاص" (أن يقول المرء شيئاً لنفسه، أن يصبح أكثر وضوحاً أمامها ، أن يحكم عليها)، غير أن التحليل النفسي والنقد السارتري لسوء الطوية، والنقد الماركسي للإيديولوجيات قد جعلت اعترافاً كهذا عبثياً : الإخلاص ما هو سوى مُتخيل من الدرجة الثانية. كلا، لا يمكن لتبرير اليوميات الحميمية (كعمل) إلا أن يكون تبريراً أدبياً، بالمعنى المطلق للكلمة، وحتى بمعناها الحنيني. أرى هنا أربعة دوافع.
الأول هو تقديم نصاً ذا صبغة ذاتية في الكتابة، في الأسلوب (كما كان يُقال في الماضي)، لغة فردية خاصة بالمؤلف (idiolecte propre à l’auteur) (كما كان يمكن أن يُقال ذلك سابقاً)؛ لنسمي هذا الدافع : بالشعري (poétique). الدافع الثاني، هو بعثرة آثار مرحلة في الغبار، ويوم بعد آخر، بكل ما فيها من حالات عظمة متمازجة، بدءً من المعلومة الأساسية وحتى تفاصيل اللياقة الاجتماعية؛ ألا أتمتع بلذة حادة عند قراءتي ضمن يوميات تولستوي حياة سيد روسي ينتمي للقرن التاسع عشر؟ لنطلق على هذا الدافع تسمية : التاريخي (historique). الثالث، هو أخذ المؤلف كمادة للرغبة : عن كاتب يعنيني، يمكنني أن أرغب في معرفة حياته الصميمية، الصناعة اليومية لزمنه، الأشياء التي يتذوقها، حالات مزاجه، الظنون التي تنتابه؛ وقد يذهب بي الأمر حد تفضيل شخصه على عمله، وأن القي بنفسي بشراهة على يومياته وأهمل كتبه. يمكنني إذاً، حينما تتولد عندي لذة كان الآخرون قد منحوني إياها، محاولة القيام بالإغواء من طرفي أنا، عبر هذا الالتواء الذي يجعل المرء يعبر من الكاتب إلى الشخص، و العكس بالعكس؛ أو، وهذا ما هو أنكى، أن أبين بأني " أنا أفضل مما أكتب" (في كتبي) : حينئذ، تقوم كتابة اليوميات وكأنها فائض-قوة (force-plus) (نيتشة : إضافة للقوة von Macht )، والذي نظن بأنه سيعوض عن إخفاقات الكتابة نفسها؛ لنسمي هذا الدافع : بالطوباوي utopique، مادمنا في الحقيقة لا نتمكن من الوصول إلى نهاية المُتخيل. الدافع الرابع، هو أن نجعل من اليوميات مُحترف للجمل : ليس للجمل "الجميلة"، ولكن للجمل المضبوطة؛ مضاعفة رهافة التعبير (ولكن ليس العبارة)، بفضل الحماس والمثابرة، وفاء مصيري يتماثل كثيراً مع الانفعال : "وتبتهج خاصرتي حينما تلفظ شفتيك أشياء مضبوطة" (Prov. 23,16). لنسمي هذا الدافع : بالعشقي (أو حتى : العبادي، أنا أعبد الجملة).
بالرغم من انطباعاتي الهزيلة، يمكن إذا تصور رغبتي في أن يكون لي دفتر يوميات. يمكنني التسليم بأنه في إطار اليوميات يمكن المرور من ذلك الشيء الذي بدا لي أولاً وكأنه شيء غير ملائم إلى الأدب، إلى شكل يشابه خصائصه : الشخصنة، الأثر، الإغراء، وثنية اللغة (fétichisme du langage). في الأعوام الأخيرة قمت بثلاث محاولات؛ الأولى، أكثرها أهمية لأنها وقعت أثناء مرض أمي، هي الأطول، ربما لأنها كانت تتناظر إلى حد ما مع هدف كافكا بالتخلص من القلق بفضل الكتابة، أما الاثنتين الباقيتين فلم تستغرق كل واحدة منهما سوى يوم واحد؛ لقد كانتا بالأحرى تجريبيتين، بالرغم من أني لا أعيد قراءتهما من دون حنين إلى ذلك اليوم الذي عشته (لا يمكنني أن أعطي للنشر سوى واحدة منهن، أما الثانية فهي تتعلق بأشخاص غيري).
1- 13 تموز 1977
بنت السيدة ***، الخادمة الجديدة، مصابة بالسكري، وأمها مشغولة بالاعتناء بها، ذلك ما قيل لنا بإخلاص ودقة. رؤيتها لذلك المرض مُحيرة : من جانب، لا تريد التسليم بفكرة أن السكري مرض وراثي (سيكون ذلك مؤشراً على علة بالجنس)، و، من جانب آخر، تقبل طواعية بأن ذلك المرض يؤدي حتمياً إلى الموت، وبهذا تعزله تماماً عن أية مسؤولية تتعلق بأصله. أنها تطرح المرض باعتباره صورة اجتماعية، وبأن هذه الصورة مُكَيدةً. تظهر العلامة وكأنها ينبوعاً للتفاخر والإزعاج: وذلك ما كنت عليه صورة يعقوب-إسرائيل الذي أخرجه الملاك من علبته : متعة وخجل جعل نفسه ملحوظاً.
أفكار معتمة، مخاوف، حالات قلق : أرى موت الكائن الغالي، أجن، الخ... أن هذه المخلية هي معرفة الإيمان بحد ذاته. ذلك لأنها دائماً قبول الحتمية والمخيلة معاً : أن يتكلم المرء، فهذا معناه إثبات ما يقول (مرة أخرى فاشية اللغة). بتخيلي للموت، أحبط المعجزة. فمجنون النظام (le fou de l’Ordre) لم يتكلم، كان يرفض لغة الداخل الثرثارة والمتبجحةِ. ما هو إذاً عجز الإيمان ذاك؟ ربما حب إنساني مفرط؟ هل يقصي الحبي الإيمان؟ والعكس بالعكس؟
شيخوخة وموت أندريه جيد (التي أقرأها في الـ Petit Dame) كانت محاطة بالشهود. لكني لا أعرف ما الذي حل بهؤلاء الشهود : لا شك أن أغلبيتهم قد ماتوا، بدورهم؟ أحياناً يموت الشهود هم أيضاً ومن دون أن يكون هناك شهود على موتهم. هكذا يُصنع التاريخ من بعض انفجارات الحياة، من الأموات الذين لا يناوبهم أحد.
عجز الإنسان ذو "الدرجات"، إنسان العلم على درجات، بالمقابل، قد يمكننا أن نسند لله الكلاسيكي القدرة اللانهائية على رؤية كل الدرجات : سيكون "الله" هو الأسي المطلق (l’Exponentiel absolu).
(الموت، الموت الحقيقي، هو حين يموت الشاهد نفسه. يقول شاتوبريان عن جدته وعمته : "قد أكون أنا الشخص الوحيد الذي يعرف بأن تلك المرأتين قد عاشتا" : نعم، لكن، لأنه كان قد كتب ذلك، أصبحنا نحن أيضاً نعرفه، بالقدر الذي ما نزال فيه نقرأ شاتوبريان).
14- تموز 1977
صبي صغير، عصبي، كالعديد من الصبية الفرنسيين، يقوم بدءً بلعب دور الشخص الناضج، تنكر بزي رامي رمانات في أوبريت (بالأبيض والأحمر)؛ كان يتقدم من دون شك العصابة.
لمَ يكون الهم (Souci) هنا أكبر منه في باريس؟ هذا الريف هو عالم عادي، خالي تماماً من أية فنطازيا، تظهر فيه الحساسية في غير محلها بالمطلق. أنا شخص استحواذي، لذا أُقصي.
يبدو لي بأني أتعلم أشياء كثيرة عن فرنسا، بزمن زيارة سريعة للريف، أكثر مما أتعلمه عنها بأسابيع في باريس. ربما كان ذلك وهماً؟ الوهم الواقعي (L’illusion réaliste)؟ يشكل العالم القروي، الريفي، المحلي المادة التقليدية للواقعي (réalisme). أن يكون المرء كاتباً، في القرن التاسع عشر، فذلك معناه أن يكتب من باريس عن المُقاطعة. فالمسافة هي التي تجعل من كل شيء ذا دلالة. في المدينة، حين أكون في الشارع، تنصب عليَّ المعلومات من كل جانب – لكن ليس المدلولات.
15 تموز 1977
في الساعة الخامسة من بعد الظهر، الدار هادئة، هدوء الريف. ذباب. تؤلمني ساقيّ قليلاً، كما كانت تؤلمني حين كنت طفلاً وكنت أمر في مرحلة ما كان يُسمى أزمة النمو – أو كأني قد أخذت برداً. كله لَزَجُ، يغفو. وكالعادة دائماً، كنت واعياً، وعي حاد، "بوهني" (تناقض في التعبير).
زيارة X.. : في الغرفة المجاورة، تبدو وكأنها بلا نهاية. لا أجرأ على غلق الباب. ما يزعجني هو ليس الضوضاء، لكن مجانية النقاش، (لو كان على الأقل لغة غريبة عني، ولها موسيقاها). أنا دائم الاندهاش، مصعوقاً حتى، من مقاومة الآخرين : الآخر (l’Autre)، بالنسبة لي، هو ذلك الذي لا يتعب (l’Infatigable). الطاقة -لاسيما الطاقة اللغوية- تُذهلني : قد تكون اللحظة الوحيدة (إذا ما وضعنا العنف جانباً) التي أومن فيها بالجنون.