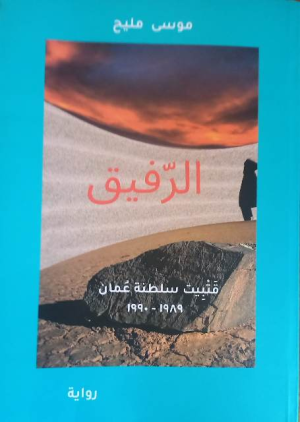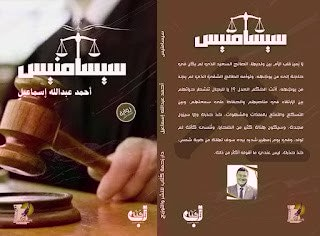ـ 1 ـ
للكتابة القصصية لدى أحمد بوزفور طبيعة خاصة في التركيب والبناء ونسج اللغة وارتياد آفاق التخييل. وربما كانت هذه الطبيعة الخاصة تتجسد في نوعية المواد الواقعية، وفي طريقة تشكيل التفاصيل، وفي الملامح الداخلية والخارجية التي يمنحها الوصف للشخصيات. كما القصة القصيرة لديه، ورغم هذه الخواص الكتابية، فبوزفور يكتبها بإخلاص شديد، يشذب حديقتها ويعتني بمبناها ومبناها، ينسج نسيجها من اللغة والتخييل، ويحرص على أن تكون قصة قصيرة، لا مجرد نفخ في الهواء، وهو بذلك، يظل مخلصا لهذا الجنس الأدبي ومنذ بداية السبعينات (تاريخ كتابة أول نص في مجموعته القصصية الأولى: "يسألونك عن القتل"، يحمل تاريخ (1970). هو كاتب مقل، لم ينشر سوى ثلاث مجموعات قصصية وعلى مدى ثلاثة عقود من الكتابة (النظر في الوجه العزيز، الغابر الظاهر، صياد النعام)، وعلى إقلاله فهو مداوم الحضور، سواء من خلال نشر قصصه في المجلات التي يفضل النشر فيها على النشر في الجرائد، أو من خلال المشاركة في الندوات التي تخص هذا الجنس الأدبي. على انطوائه فهو يمتلك جاذبية خاصة، وبراءة في الحديث، بخلاف بعض الكتاب الذين يجعلون من عدوانيتهم وثرثرتهم أداة لفرض الوجود، فبوزفور، يحرص دوما على أن يكون ظله كقدر قامته، بصمته يعترض، وبكلامه الرصين يختزل الكثير من الكلام. جماعته هي جماعته، تبقى دوما مؤلفة من زملائه المبدعين من أساتذة كلية الآداب ابن مسيك بالدار البيضاء، وهي جماعة خير، من خلال عطاء أفرادها ومن خلال الندوات التي نظموها، أو من خلال المنشورة التي أصدروها، وأيضا من خلال الرفقة الطيبة والعشرة الجميلة، كما يلاحظ ذلك كل من زار "مجموعة البحث في القصة القصيرة بالمغرب، واقترب من أفرادها، ليشعر بنبل العلاقة الإنسانية ومحبة الإبداع. ولعل أحمد بوزفور، هو الأب الروحي لهذه المجموعة، على ما فيها من مبدعين قصاصين ومترجمين ونقاد، وأنا أعرف أن عبارة "الأب الروحي" لن تعجبه، وإن كان أفراد المجموعة يبتهجون لها، حتى وهم زملاؤه في التدريس في الكلية، لكنه الأكبر سنا، وربما حكمة، حتى وإن كانت الحكمة لا تكتسب بالسن، وبمعنى آخر، فهو المحرك لأعمال "مجموعة البحث"، الدافع بعطاءاتها، دون تقليل من جهود الآخرين، بل هو تبادل اعتراف، اعتراف بوزفور بأهمية ما يكتبه أفراد المجموعة، واعتراف أفراد المجموعة بخصوصية الكتابة القصصية كما مارسها أحمد بوزفور. تبادل اعتراف ليس من أجل ممالأة أو تظاهر أو إخوانيات، أو مصلحة من المصالح، بل هو منبع للمحبة والصداقة الجميلة التي أتصور أن أحمد بوزفور يستأنس بها في وحدته وعزلته، هو الذي عاش عازبا، فريدا ووحيدا، منتعشا بالصداقات الجميلة، في زمن عز فيه الصديق، ومنتعشا بروحانية علاقته بالكتابة القصصية، وباقتناصه للعوالم والأخيلة والفضاءات واللحظات الاستثنائية في وجود قد يكون هو ما قبل وما بعد الوجود. من حسن حظه أن لا أحد يتجسس على حياته الخاصة، أو يجعل منه لوكا في الأفواه، فهو في الظل الذي يعيش فيه مستريح إلى أن حياته الخاصة ليست أسطورة، كما هي الحياة الخاصة لمحمد شكري ومحمد زفزاف، أسطورة بناها الكاتبان في أخيلة الأصدقاء حتى امتدت إلى تأثيرها على القراءة والقراء. أحمد بوزفور لا أسطورة له. أسطورته في الكتابة القصصية، تتجلى في أسطورية نصوصه، وبما تحفل به هذه النصوص من عوالم فوق واقعية، أو هي واقعية إلى درجة أن تجاوزت حدود وجودها في الواقع. أخلص أحمد بوزفور لكتابة القصة القصيرة، ولم يتجه نحو كتابة الرواية كما حدث لكتاب مغاربة آخرين، وكما هي العادة في المشرق وفي الغرب أيضا، وحيث بدأ كتاب كثيرون قاصين ثم جاءوا إلى كتابة الرواية ليوسعوا من عوالهم ومن فضاءات التخييل. الأمر قد يكون انتقالا من جنس أدبي إلى آخر، وقد لا يكون انتقالا بمعنى قطع الصلة مع جنس القصة القصيرة، فالمزاوجة بين كتابة القصة القصيرة وكتابة الرواية، مع احترام حدودهما التجنيسية، كان من شأن كتاب عالميين كثيرين، كما هي حالة إرنست همنغواي، بينما كانت حالة أنطوان تشيكوف، تعني مزاوجة أخر بين القصة القصيرة وبين كتابة قصص بالطول الذي يجعل منها أقاصيص، أو روايات قصيرة، ناهيك عن كتاب بدأوا الكتابة على بياض الصفحة، معتقدين أنهم سوف يكتبون قصة قصيرة، ثم أخذهم الاشتغال على الكتابة إلى توسيع المحكيات وتناسل التفاصيل وتعدد الشخصيات إلى أن تجاوزا عدد الصفحات المخصصة لكتابة قصة قصيرة، والأمر ليس معدودا بعدد الكلمات والصفحات، بل هو معدود في القصة القصيرة بأهمية التكثيف، واقتصاد اللغة، وبرقية الرسالة، كما أنه معدود في كتابة الرواية، بتوسيع العوالم والفضاءات، وتداخل الأزمنة أو تقاطعها أو تواترها، وتعدد الشخصيات، وبناء العالم الروائي. ليس من مفاضلة بين الجنسين، فللقصة القصيرة شقها من الحجر، ونبعها من ماء الحجر، لأنها بارقة بخلبها تخطف أبصار قارئها، وللرواية عالمها الواسع، المصوغ لأوضاع مجتمعية في لحظة من لحظات تحول المجتمع. لا مفاضلة. وأحمد بوزفور، ظل يستقطر الماء من الحجر، مخلصا لكتابة القصة القصيرة، كما هو حال إدريس الخوري، الذي كان قد وعد بكتابة سيرته الذاتية، ثم لم يكتبها، أو لم ينشرها، بينما استمر كتاب قاصون كمبارك ربيع وأحمد المديني وكاتب هذه السطور، من جيل الستينات والسبعينات، في ممارسة كتابة القصة القصيرة، وإصدار مجموعات، ومن غير تفضيل بين الجنسين، على مستوى الكتابة والنشر. وربما، لأن كتابة القصة القصيرة، على ما يعتري إنشاءها من تنقيحات وتحويرات، لا تشبه كتابة الرواية، من حيث السيطرة على بناء عالم يظهر وكأنه ينبني من تلقاء ذاته، بينما يوجد من وراء بنائه تصنيع للكتابة ومحاولة للسيطرة على تنظيم فوضاها. كما أ، كتابة الرواية، تحتاج إلى جلوس طويل أمام الورق، أو أمام الحاسوب، وهو جلوس من خلال وقته الطويل، والمداوم، يشبه تعلقا بمراودة صخرة سيزيف، فبالصعود به والانهيار معها تتحقق لحظات أخرى لمحو الكتابة وكتابة الكتابة، وهو شأن الروائي في تشكيل المادة الروائية. وإن كان كاتب الرواية يقعد أمام مكتبه لست ساعات قفي اليوم، وعلى مدى سنة، لإنجاز رواية، فهو من غير شك، وإن كتب كما روائيا كبيرا، سوف يعاني من أمراض الجلوس، حتى وهو يرحل في أخيلة عوالمه. أما كاتب القصة القصيرة، فهو يُبْرِقُ رسالة، كما الشاعر يطفر بطفرة، ويصسد معنى من المعاني، ولذلك، فقد ظل أحمد بوزفور "صياد نعام" في كتابته القصصية، صياد معان وتجليات، صياد أخيلة.
ـ 2 ـ
كأنه يروم مقصدا لا يعرفه أحد، وهو نفسه لم يصل إليه، كشأن المبدعين الذين ليس لهم خطاطات جاهزة لمسارهم الإبداعي. هو الشأن الأدبي، وفي مجال الكتابة القصصية بالتحديد، وحيث يمكن أن توجد ألمعية لوجود الكاتب، كما هو الشأن بالنسبة بألمعية القاص أحمد بوزفور.
ـ 3 ـ
ليس تقليديا، ولا هو تجريبي أو حداثي، منزلته فيما بين الشك واليقين، شك الكتابة في ذاتها، ويقينها بأنها ليست سوى كتابة. لا يراهن على شيء، سوى أن يحقق لنصوصه وضاءتها ونصاعتها في أعين القراءة، فإذا ما كان قراء قصصه نقادا، فذلك ليس هو المبتغى الأول والأخير، فشأن نصوصه أن تنفتح على توسيع كبير لمجالات القراءة، يستعين به القراء على فهم عالمهم من جديد، وبطريقة غير متداولة لفهم العالم، كما يتلذذون بذلك العالم، بما هو ممكن ومحتمل.
ـ 4 ـ
كأنه يروم مقصدا لم يصل إليه بعد، كما هو شأن كل الكتاب التجريبين، الشكاك في الحقيقة ما يمارسون وما يرغبون في إحلاله وتجسيده في نصوص تبقى دائما ممكنة ومحتملة. كأنه النرجسي، المعجب بنصوصه إلى حد تقديسها ورؤية ما عداها فراغ في فراغ. ولعله صاحب رأسمال رمزي يعوض به فراغ المعنى وفقر الحياة وابتذال اللحظات. كأنه ينسج القصة القصيرة من مذاب ماء العين، أو يطرزها بأنامل حساسة و رقيقة. كأنه صاحب رؤيا، ولذلك فقصصه القصيرة تشتغل على الالتباس والغموض . كأنه الشاعر يخرق الحدود بين النثري و الشعري بقوانين الكثافة على مستوى الرؤيا وبتناغم داخلي يدركه القارئ. كأنه ماض نحو قدره، حيث لا شيء سوى الكتابة، وعلى استعصائها، فلا شيء. كأنه "الغابر الظاهر"، وهو يبحث لنار سائل مشفرة عبر "النظر في الوجه العزيز" أو وهو يعود بنا إلى مجازات " صياد النعام " وهو في كل ذلك يذيب جليد الغموض بتفاصيل واقعية تساعد على التأويل. وحيث ترتدي تلك التفاصيل إلى عوامل الطفولة و الحلم، وعوالم الدهشة و لاقتناص، وعوالم اليومي وهي تحل في العوالم الكتابة، وحيث تصبح الكتابة نفسها عالما يحتفل بتفاصيل و موضوعاتها الخاصة.
ـ 5 ـ
وأحمد بوزفور ليس ظاهرة أدبية إلا من حيث اهتمام النقد بأعماله القصصية، وإعجاب الناقد إدريس الناقوري بأعماله التي قام في أكثر من مناسبة بتحليلها، وكان الصديق عبد الجبار السحيمي قد علق على أحد تلك التحليلات بما أسماه "شرح الناقور، فيما ورد في قصص بوزفور". كما أنه ليس ظاهرة أدبية إلا من حيث ترجمة إحدى قصصه إلى العبرية، وهو ما جعله يعرف بين أصحابه بأحمد العبري. وهو نفسه، من يتأبط شره، ولا يستسلم إلا لمصيره في الكتابة. لم يلتف النقد القصصي إلى تجاربه بشكل عام، إلا من حيث تناولات قليلة ونوعية، من أهمها قراءة الأستاذ محمد مفتاح لإحدى قصصه، قراءة بيانية وبنيوية، بمعنى التبيين البلاغي لنص قصصي، على ما أذكر، ومحمد مفتاح ناقد للشعر، كما هو معروف، وعلى خبرته بالنقد الشعري، فقد وجد في أحد نصوص أحمد بوزفور بعدا من أبعاد اشتغاله النقدي. قراءات قديمة وأخرى حديثة، ليست بالعدد المهم لقراءة أعمال أحمد بوزفور، ولكنها تعني تقبل نصوصه القصصية لهذه القراءات على تنوعها.
ـ 6 ـ
من حيث علاقتي به، فلقد اقتربنا بقدر ما تباعدنا. كان لكل واحد منا شأنه في الكتابة ومصيره في الحياة. لأول مرة، التقينا في فاس، وفي ثانوية القرويين، في بداية السنوات الستين من القرن الماضي، وحيث كنت قد بدأت نشاطي الكتابي وأنا تلميذ بتلك الثانوية، وبدأت النشر ، من خلال دراسات أدبية وبعض القصص القصيرة. كان ذلك مغيظا لبعض أساتذتنا، الذين رأوا فيما أنشره ترهة من الترهات، فواجهوني بالسخرية والتحقير. لم يخطر على بالي أن أحمد اليعقوبي (الذي أصبح اسمه أحمد بوزفور فيما بعد) سوف يصبح كاتبا. صورتان تتقابلان معا، الأولى لشاب كان في الستينات يرتدي جلبابه ويتفوق في مادة الإنشاء، والثانية هي التي طلعت علينا في الصحف لنفس الشاب وهو يرتدي جاكتة جلدية سودا، وقد أصبح كاتبا للقصة القصيرة. بين الصورتين مسافة من المعاناة المضاعفة: معاناة المعيش في الحياة ومعاناة المعيش وهو يتحول إلى مواد لمتخيل الكتابة، ومن خلال الصورتين معا، يخضر المتعدد في الزمان والمكان: أحمد بوزفور. ومن قبيل التناسخ بين الصورتين، أن يكون هو أحمد اليعقوبي، الذي تزامنت معه في الدراسة في فترة الستينات في ثانوية القرويين بفاس، قد حل في بدن أحمد بوزفور على صورة مغايرة، ربما في العقلية وشكل اللباس، والأهم، هو حضور الكتابة كرهان معها ومع الذات. أحمد اليعقوبي يذكرني بفضاء الدراسة في القرويين، وبأستاذ مادة الأدب المرحوم إدريس التبر، وبسطوة العلماء كما يذكرني بأحداث 1965 وفاشية الجنرال أو فقير، فقد كان الفتى أحمد اليعقوبي من معتقلي أحداث تلك السنة، وحيث قضى مدة في أحد المعتقلات السرية جنوب البلاد، أما أنا فقد قضيت ليلتين جالسا على الحصى في مخفر الشرطة الذي كان يسمى (الرافان)، ثم أطلق سراحي لحداثة سني، ولتدخل جار شرطي كان في مداومته يحتاج إلى الطعام، فسعى إلى إطلاق سراحي لأخبر زوجته بأنه يحتاج إلى الطعام. فيما بعد، ومع الثمانينات والتسعينات، التقيت بأحمد بوزفور، الذي هو أحمد اليعقوبي، لقاءات عابرة في عدة مدن، حضرناها من أجل قراءات قصصية، وكانت اللقاءات مبهجة لنا معا. حالما استعدنا ذكرياتنا في القرويين، كدفق من اللحظات "الغابرة الظاهرة"، فكرنا في أن نشترك معا في كتابة تلك اللحظات، في كتاب ننشره، باستثنائيتها وغرابتها وجدل العقل والدين فيها، وقلق ما كنا نراه صراعا بين القديم والحديث، لكن الفكرة تأجلت، بسبب بعد المسافة بين الدار البيضاء ومرتيل، وخيرا فعلنا بتأجيلها، فالأفضل أن تبقى كامنة لتتسرب في ثنايا بعض النصوص، بشكل أو بآخر. يذكرني أحمد بوزفور بأحلام وأوهام تلك المرحلة، السابقة على مجيئنا إلى كلية الآداب. في الكلية لم نلتق، رغم وجود فضاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ورغم لقائي مع مبدعين ونقاد طلبة، كان من بينهم إدريس الناقوري وأحمد المديني ومحمد بنيس وعلال الحجام ومحمد بنطلحة وأحمد زيادي وآخرون. ظل أحمد بوزفور "غابرا" في تلك المرحلة من نهاية الستينات وبداية السبعينات، ثم أصبح "ظاهرا" من خلال ما قرأناه له من نصوص قصصية.
ـ 7 ـ
تجربته في الكتابة القصصية، تبدو عصية عن التصنيف ضمن أجيال القصاصين المغاربة، فلا هو من جيل تأسيس قصة قصيرة مغربية بالمعنى التجنيسي للكلمة، كمحمد برادة وعبد الجبار السحيمي وإدريس الخوري ومحمد إبراهيم بوعلو وعبد الكريم غلاب ومحمد زفزاف، ولا هو من جيل رواد تحديد الأشكال، كأحمد المدينى وخناثة بنونة ورفيقة الطبيعة وأبي يوسف طه، ولا هو من فلتات إبداعية أخرى جميلة مارسها كتاب كمصطفى المسناوي ومحمد أنقار ومصطفى يعلى وعبد الرحيم المودن، ولا هو أيضا من جيل جديد يسميه صديقنا نجيب العوفي ثمانينيا أو تسعينيا، وحيث اتسعت النصوص وكثرت الأسماء بتراكم مذهل يحتاج إلى قراءة خاصة، نظرا لما حدث من تراكم على مستوى أسماء الكتاب وعلى مستوى إصداراتهم القصصية. إنه يكتب القصة القصيرة، لكنه يمنحها نكهة خاصة، في تجريب خاص للغة والأشكال، وفي وعي خاصة بأهمية التكثيف والاقتصاد اللغوي، وإدخال الواقع إلى دائرة المتخيل، وتركيب البناء عبر المشهدية والتقطيع. إنه بذلك، ليس مع القصاصين الذين يكتبون مادة حكائية تكتب كما يمكن أن تحكي شفويا، لأنه يحفل بأدبية النص، وشحنه بالمعاني والدلالات، ضدا على كتابة قصصية تكتب الحشو والثرثرات والحوارات الفجة وتسطح الواقع. إنه مع اللحظة البارقة والمسافة الزمنية التي تختزل الأزمنة، ومع الكتابة كخاصية أدبية تخييلية تمارس التقنيات التحديثية للشكل والخطاب.
ـ 8 ـ
هو أحمد بوزفور. إسألوه عن القصة القصيرة، أهي كائن أم ممكن. سيجيب، ربما، وعلى افتراض، بأنها ممكن متجدد. ولأن أحمد بوزفور لا يحب القوالب الجاهزة، وعلب الثلج، والركام، فهو سيقول، ربما، وعلى افتراض، إن طرائق الكتابة القصصية، بلا نهائيتها، هي التي تصوغ معنى النص القصصي وتشكله من البياض. وبما، لن يجيب، تاركا حسن الجواب للنقاد والمنظرين لهذا الجنس الأدبي، ليستسلم إلى كسل جسده، وتوهج روحه الذي يبدد ذلك الكسل، فهو غير عابئ بأن تدخل نصوصه متحف التاريخ، كما أنه لا يداوي على عزلته إلا بالكتابة، وبالكتابة وحدها.

للكتابة القصصية لدى أحمد بوزفور طبيعة خاصة في التركيب والبناء ونسج اللغة وارتياد آفاق التخييل. وربما كانت هذه الطبيعة الخاصة تتجسد في نوعية المواد الواقعية، وفي طريقة تشكيل التفاصيل، وفي الملامح الداخلية والخارجية التي يمنحها الوصف للشخصيات. كما القصة القصيرة لديه، ورغم هذه الخواص الكتابية، فبوزفور يكتبها بإخلاص شديد، يشذب حديقتها ويعتني بمبناها ومبناها، ينسج نسيجها من اللغة والتخييل، ويحرص على أن تكون قصة قصيرة، لا مجرد نفخ في الهواء، وهو بذلك، يظل مخلصا لهذا الجنس الأدبي ومنذ بداية السبعينات (تاريخ كتابة أول نص في مجموعته القصصية الأولى: "يسألونك عن القتل"، يحمل تاريخ (1970). هو كاتب مقل، لم ينشر سوى ثلاث مجموعات قصصية وعلى مدى ثلاثة عقود من الكتابة (النظر في الوجه العزيز، الغابر الظاهر، صياد النعام)، وعلى إقلاله فهو مداوم الحضور، سواء من خلال نشر قصصه في المجلات التي يفضل النشر فيها على النشر في الجرائد، أو من خلال المشاركة في الندوات التي تخص هذا الجنس الأدبي. على انطوائه فهو يمتلك جاذبية خاصة، وبراءة في الحديث، بخلاف بعض الكتاب الذين يجعلون من عدوانيتهم وثرثرتهم أداة لفرض الوجود، فبوزفور، يحرص دوما على أن يكون ظله كقدر قامته، بصمته يعترض، وبكلامه الرصين يختزل الكثير من الكلام. جماعته هي جماعته، تبقى دوما مؤلفة من زملائه المبدعين من أساتذة كلية الآداب ابن مسيك بالدار البيضاء، وهي جماعة خير، من خلال عطاء أفرادها ومن خلال الندوات التي نظموها، أو من خلال المنشورة التي أصدروها، وأيضا من خلال الرفقة الطيبة والعشرة الجميلة، كما يلاحظ ذلك كل من زار "مجموعة البحث في القصة القصيرة بالمغرب، واقترب من أفرادها، ليشعر بنبل العلاقة الإنسانية ومحبة الإبداع. ولعل أحمد بوزفور، هو الأب الروحي لهذه المجموعة، على ما فيها من مبدعين قصاصين ومترجمين ونقاد، وأنا أعرف أن عبارة "الأب الروحي" لن تعجبه، وإن كان أفراد المجموعة يبتهجون لها، حتى وهم زملاؤه في التدريس في الكلية، لكنه الأكبر سنا، وربما حكمة، حتى وإن كانت الحكمة لا تكتسب بالسن، وبمعنى آخر، فهو المحرك لأعمال "مجموعة البحث"، الدافع بعطاءاتها، دون تقليل من جهود الآخرين، بل هو تبادل اعتراف، اعتراف بوزفور بأهمية ما يكتبه أفراد المجموعة، واعتراف أفراد المجموعة بخصوصية الكتابة القصصية كما مارسها أحمد بوزفور. تبادل اعتراف ليس من أجل ممالأة أو تظاهر أو إخوانيات، أو مصلحة من المصالح، بل هو منبع للمحبة والصداقة الجميلة التي أتصور أن أحمد بوزفور يستأنس بها في وحدته وعزلته، هو الذي عاش عازبا، فريدا ووحيدا، منتعشا بالصداقات الجميلة، في زمن عز فيه الصديق، ومنتعشا بروحانية علاقته بالكتابة القصصية، وباقتناصه للعوالم والأخيلة والفضاءات واللحظات الاستثنائية في وجود قد يكون هو ما قبل وما بعد الوجود. من حسن حظه أن لا أحد يتجسس على حياته الخاصة، أو يجعل منه لوكا في الأفواه، فهو في الظل الذي يعيش فيه مستريح إلى أن حياته الخاصة ليست أسطورة، كما هي الحياة الخاصة لمحمد شكري ومحمد زفزاف، أسطورة بناها الكاتبان في أخيلة الأصدقاء حتى امتدت إلى تأثيرها على القراءة والقراء. أحمد بوزفور لا أسطورة له. أسطورته في الكتابة القصصية، تتجلى في أسطورية نصوصه، وبما تحفل به هذه النصوص من عوالم فوق واقعية، أو هي واقعية إلى درجة أن تجاوزت حدود وجودها في الواقع. أخلص أحمد بوزفور لكتابة القصة القصيرة، ولم يتجه نحو كتابة الرواية كما حدث لكتاب مغاربة آخرين، وكما هي العادة في المشرق وفي الغرب أيضا، وحيث بدأ كتاب كثيرون قاصين ثم جاءوا إلى كتابة الرواية ليوسعوا من عوالهم ومن فضاءات التخييل. الأمر قد يكون انتقالا من جنس أدبي إلى آخر، وقد لا يكون انتقالا بمعنى قطع الصلة مع جنس القصة القصيرة، فالمزاوجة بين كتابة القصة القصيرة وكتابة الرواية، مع احترام حدودهما التجنيسية، كان من شأن كتاب عالميين كثيرين، كما هي حالة إرنست همنغواي، بينما كانت حالة أنطوان تشيكوف، تعني مزاوجة أخر بين القصة القصيرة وبين كتابة قصص بالطول الذي يجعل منها أقاصيص، أو روايات قصيرة، ناهيك عن كتاب بدأوا الكتابة على بياض الصفحة، معتقدين أنهم سوف يكتبون قصة قصيرة، ثم أخذهم الاشتغال على الكتابة إلى توسيع المحكيات وتناسل التفاصيل وتعدد الشخصيات إلى أن تجاوزا عدد الصفحات المخصصة لكتابة قصة قصيرة، والأمر ليس معدودا بعدد الكلمات والصفحات، بل هو معدود في القصة القصيرة بأهمية التكثيف، واقتصاد اللغة، وبرقية الرسالة، كما أنه معدود في كتابة الرواية، بتوسيع العوالم والفضاءات، وتداخل الأزمنة أو تقاطعها أو تواترها، وتعدد الشخصيات، وبناء العالم الروائي. ليس من مفاضلة بين الجنسين، فللقصة القصيرة شقها من الحجر، ونبعها من ماء الحجر، لأنها بارقة بخلبها تخطف أبصار قارئها، وللرواية عالمها الواسع، المصوغ لأوضاع مجتمعية في لحظة من لحظات تحول المجتمع. لا مفاضلة. وأحمد بوزفور، ظل يستقطر الماء من الحجر، مخلصا لكتابة القصة القصيرة، كما هو حال إدريس الخوري، الذي كان قد وعد بكتابة سيرته الذاتية، ثم لم يكتبها، أو لم ينشرها، بينما استمر كتاب قاصون كمبارك ربيع وأحمد المديني وكاتب هذه السطور، من جيل الستينات والسبعينات، في ممارسة كتابة القصة القصيرة، وإصدار مجموعات، ومن غير تفضيل بين الجنسين، على مستوى الكتابة والنشر. وربما، لأن كتابة القصة القصيرة، على ما يعتري إنشاءها من تنقيحات وتحويرات، لا تشبه كتابة الرواية، من حيث السيطرة على بناء عالم يظهر وكأنه ينبني من تلقاء ذاته، بينما يوجد من وراء بنائه تصنيع للكتابة ومحاولة للسيطرة على تنظيم فوضاها. كما أ، كتابة الرواية، تحتاج إلى جلوس طويل أمام الورق، أو أمام الحاسوب، وهو جلوس من خلال وقته الطويل، والمداوم، يشبه تعلقا بمراودة صخرة سيزيف، فبالصعود به والانهيار معها تتحقق لحظات أخرى لمحو الكتابة وكتابة الكتابة، وهو شأن الروائي في تشكيل المادة الروائية. وإن كان كاتب الرواية يقعد أمام مكتبه لست ساعات قفي اليوم، وعلى مدى سنة، لإنجاز رواية، فهو من غير شك، وإن كتب كما روائيا كبيرا، سوف يعاني من أمراض الجلوس، حتى وهو يرحل في أخيلة عوالمه. أما كاتب القصة القصيرة، فهو يُبْرِقُ رسالة، كما الشاعر يطفر بطفرة، ويصسد معنى من المعاني، ولذلك، فقد ظل أحمد بوزفور "صياد نعام" في كتابته القصصية، صياد معان وتجليات، صياد أخيلة.
ـ 2 ـ
كأنه يروم مقصدا لا يعرفه أحد، وهو نفسه لم يصل إليه، كشأن المبدعين الذين ليس لهم خطاطات جاهزة لمسارهم الإبداعي. هو الشأن الأدبي، وفي مجال الكتابة القصصية بالتحديد، وحيث يمكن أن توجد ألمعية لوجود الكاتب، كما هو الشأن بالنسبة بألمعية القاص أحمد بوزفور.
ـ 3 ـ
ليس تقليديا، ولا هو تجريبي أو حداثي، منزلته فيما بين الشك واليقين، شك الكتابة في ذاتها، ويقينها بأنها ليست سوى كتابة. لا يراهن على شيء، سوى أن يحقق لنصوصه وضاءتها ونصاعتها في أعين القراءة، فإذا ما كان قراء قصصه نقادا، فذلك ليس هو المبتغى الأول والأخير، فشأن نصوصه أن تنفتح على توسيع كبير لمجالات القراءة، يستعين به القراء على فهم عالمهم من جديد، وبطريقة غير متداولة لفهم العالم، كما يتلذذون بذلك العالم، بما هو ممكن ومحتمل.
ـ 4 ـ
كأنه يروم مقصدا لم يصل إليه بعد، كما هو شأن كل الكتاب التجريبين، الشكاك في الحقيقة ما يمارسون وما يرغبون في إحلاله وتجسيده في نصوص تبقى دائما ممكنة ومحتملة. كأنه النرجسي، المعجب بنصوصه إلى حد تقديسها ورؤية ما عداها فراغ في فراغ. ولعله صاحب رأسمال رمزي يعوض به فراغ المعنى وفقر الحياة وابتذال اللحظات. كأنه ينسج القصة القصيرة من مذاب ماء العين، أو يطرزها بأنامل حساسة و رقيقة. كأنه صاحب رؤيا، ولذلك فقصصه القصيرة تشتغل على الالتباس والغموض . كأنه الشاعر يخرق الحدود بين النثري و الشعري بقوانين الكثافة على مستوى الرؤيا وبتناغم داخلي يدركه القارئ. كأنه ماض نحو قدره، حيث لا شيء سوى الكتابة، وعلى استعصائها، فلا شيء. كأنه "الغابر الظاهر"، وهو يبحث لنار سائل مشفرة عبر "النظر في الوجه العزيز" أو وهو يعود بنا إلى مجازات " صياد النعام " وهو في كل ذلك يذيب جليد الغموض بتفاصيل واقعية تساعد على التأويل. وحيث ترتدي تلك التفاصيل إلى عوامل الطفولة و الحلم، وعوالم الدهشة و لاقتناص، وعوالم اليومي وهي تحل في العوالم الكتابة، وحيث تصبح الكتابة نفسها عالما يحتفل بتفاصيل و موضوعاتها الخاصة.
ـ 5 ـ
وأحمد بوزفور ليس ظاهرة أدبية إلا من حيث اهتمام النقد بأعماله القصصية، وإعجاب الناقد إدريس الناقوري بأعماله التي قام في أكثر من مناسبة بتحليلها، وكان الصديق عبد الجبار السحيمي قد علق على أحد تلك التحليلات بما أسماه "شرح الناقور، فيما ورد في قصص بوزفور". كما أنه ليس ظاهرة أدبية إلا من حيث ترجمة إحدى قصصه إلى العبرية، وهو ما جعله يعرف بين أصحابه بأحمد العبري. وهو نفسه، من يتأبط شره، ولا يستسلم إلا لمصيره في الكتابة. لم يلتف النقد القصصي إلى تجاربه بشكل عام، إلا من حيث تناولات قليلة ونوعية، من أهمها قراءة الأستاذ محمد مفتاح لإحدى قصصه، قراءة بيانية وبنيوية، بمعنى التبيين البلاغي لنص قصصي، على ما أذكر، ومحمد مفتاح ناقد للشعر، كما هو معروف، وعلى خبرته بالنقد الشعري، فقد وجد في أحد نصوص أحمد بوزفور بعدا من أبعاد اشتغاله النقدي. قراءات قديمة وأخرى حديثة، ليست بالعدد المهم لقراءة أعمال أحمد بوزفور، ولكنها تعني تقبل نصوصه القصصية لهذه القراءات على تنوعها.
ـ 6 ـ
من حيث علاقتي به، فلقد اقتربنا بقدر ما تباعدنا. كان لكل واحد منا شأنه في الكتابة ومصيره في الحياة. لأول مرة، التقينا في فاس، وفي ثانوية القرويين، في بداية السنوات الستين من القرن الماضي، وحيث كنت قد بدأت نشاطي الكتابي وأنا تلميذ بتلك الثانوية، وبدأت النشر ، من خلال دراسات أدبية وبعض القصص القصيرة. كان ذلك مغيظا لبعض أساتذتنا، الذين رأوا فيما أنشره ترهة من الترهات، فواجهوني بالسخرية والتحقير. لم يخطر على بالي أن أحمد اليعقوبي (الذي أصبح اسمه أحمد بوزفور فيما بعد) سوف يصبح كاتبا. صورتان تتقابلان معا، الأولى لشاب كان في الستينات يرتدي جلبابه ويتفوق في مادة الإنشاء، والثانية هي التي طلعت علينا في الصحف لنفس الشاب وهو يرتدي جاكتة جلدية سودا، وقد أصبح كاتبا للقصة القصيرة. بين الصورتين مسافة من المعاناة المضاعفة: معاناة المعيش في الحياة ومعاناة المعيش وهو يتحول إلى مواد لمتخيل الكتابة، ومن خلال الصورتين معا، يخضر المتعدد في الزمان والمكان: أحمد بوزفور. ومن قبيل التناسخ بين الصورتين، أن يكون هو أحمد اليعقوبي، الذي تزامنت معه في الدراسة في فترة الستينات في ثانوية القرويين بفاس، قد حل في بدن أحمد بوزفور على صورة مغايرة، ربما في العقلية وشكل اللباس، والأهم، هو حضور الكتابة كرهان معها ومع الذات. أحمد اليعقوبي يذكرني بفضاء الدراسة في القرويين، وبأستاذ مادة الأدب المرحوم إدريس التبر، وبسطوة العلماء كما يذكرني بأحداث 1965 وفاشية الجنرال أو فقير، فقد كان الفتى أحمد اليعقوبي من معتقلي أحداث تلك السنة، وحيث قضى مدة في أحد المعتقلات السرية جنوب البلاد، أما أنا فقد قضيت ليلتين جالسا على الحصى في مخفر الشرطة الذي كان يسمى (الرافان)، ثم أطلق سراحي لحداثة سني، ولتدخل جار شرطي كان في مداومته يحتاج إلى الطعام، فسعى إلى إطلاق سراحي لأخبر زوجته بأنه يحتاج إلى الطعام. فيما بعد، ومع الثمانينات والتسعينات، التقيت بأحمد بوزفور، الذي هو أحمد اليعقوبي، لقاءات عابرة في عدة مدن، حضرناها من أجل قراءات قصصية، وكانت اللقاءات مبهجة لنا معا. حالما استعدنا ذكرياتنا في القرويين، كدفق من اللحظات "الغابرة الظاهرة"، فكرنا في أن نشترك معا في كتابة تلك اللحظات، في كتاب ننشره، باستثنائيتها وغرابتها وجدل العقل والدين فيها، وقلق ما كنا نراه صراعا بين القديم والحديث، لكن الفكرة تأجلت، بسبب بعد المسافة بين الدار البيضاء ومرتيل، وخيرا فعلنا بتأجيلها، فالأفضل أن تبقى كامنة لتتسرب في ثنايا بعض النصوص، بشكل أو بآخر. يذكرني أحمد بوزفور بأحلام وأوهام تلك المرحلة، السابقة على مجيئنا إلى كلية الآداب. في الكلية لم نلتق، رغم وجود فضاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ورغم لقائي مع مبدعين ونقاد طلبة، كان من بينهم إدريس الناقوري وأحمد المديني ومحمد بنيس وعلال الحجام ومحمد بنطلحة وأحمد زيادي وآخرون. ظل أحمد بوزفور "غابرا" في تلك المرحلة من نهاية الستينات وبداية السبعينات، ثم أصبح "ظاهرا" من خلال ما قرأناه له من نصوص قصصية.
ـ 7 ـ
تجربته في الكتابة القصصية، تبدو عصية عن التصنيف ضمن أجيال القصاصين المغاربة، فلا هو من جيل تأسيس قصة قصيرة مغربية بالمعنى التجنيسي للكلمة، كمحمد برادة وعبد الجبار السحيمي وإدريس الخوري ومحمد إبراهيم بوعلو وعبد الكريم غلاب ومحمد زفزاف، ولا هو من جيل رواد تحديد الأشكال، كأحمد المدينى وخناثة بنونة ورفيقة الطبيعة وأبي يوسف طه، ولا هو من فلتات إبداعية أخرى جميلة مارسها كتاب كمصطفى المسناوي ومحمد أنقار ومصطفى يعلى وعبد الرحيم المودن، ولا هو أيضا من جيل جديد يسميه صديقنا نجيب العوفي ثمانينيا أو تسعينيا، وحيث اتسعت النصوص وكثرت الأسماء بتراكم مذهل يحتاج إلى قراءة خاصة، نظرا لما حدث من تراكم على مستوى أسماء الكتاب وعلى مستوى إصداراتهم القصصية. إنه يكتب القصة القصيرة، لكنه يمنحها نكهة خاصة، في تجريب خاص للغة والأشكال، وفي وعي خاصة بأهمية التكثيف والاقتصاد اللغوي، وإدخال الواقع إلى دائرة المتخيل، وتركيب البناء عبر المشهدية والتقطيع. إنه بذلك، ليس مع القصاصين الذين يكتبون مادة حكائية تكتب كما يمكن أن تحكي شفويا، لأنه يحفل بأدبية النص، وشحنه بالمعاني والدلالات، ضدا على كتابة قصصية تكتب الحشو والثرثرات والحوارات الفجة وتسطح الواقع. إنه مع اللحظة البارقة والمسافة الزمنية التي تختزل الأزمنة، ومع الكتابة كخاصية أدبية تخييلية تمارس التقنيات التحديثية للشكل والخطاب.
ـ 8 ـ
هو أحمد بوزفور. إسألوه عن القصة القصيرة، أهي كائن أم ممكن. سيجيب، ربما، وعلى افتراض، بأنها ممكن متجدد. ولأن أحمد بوزفور لا يحب القوالب الجاهزة، وعلب الثلج، والركام، فهو سيقول، ربما، وعلى افتراض، إن طرائق الكتابة القصصية، بلا نهائيتها، هي التي تصوغ معنى النص القصصي وتشكله من البياض. وبما، لن يجيب، تاركا حسن الجواب للنقاد والمنظرين لهذا الجنس الأدبي، ليستسلم إلى كسل جسده، وتوهج روحه الذي يبدد ذلك الكسل، فهو غير عابئ بأن تدخل نصوصه متحف التاريخ، كما أنه لا يداوي على عزلته إلا بالكتابة، وبالكتابة وحدها.