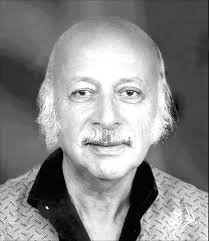إذا نظرنا إلى أحلام فترة النقاهة، سنرى أن الرغبة في سبر الواقع الداخلي للإنسان، الذي يتجاوب مع المعنى الواسع للواقعية الإنسانية. يتشكل في صور مختلفة، تومض على نحو غامض في ثنايا النص الإبداعي سردًا وشعرًا، وتصوفًا، وفلسفة.. إلخ. لكنه ينتهي إلى شكل أدبي جديد ومستقل، بل ومتفرد بذاته في نهاية رحلة الجمال المباركة عند نجيب محفوظ” إن النشاط الحلمي المتميز، يمكن أن يعتبر نوعًا من الإبداع في ذاته، إذا وسعنا تعريف الإبداع بما يستحق”[1](1). كما أن الحلم من إبداع الحالم، وهو الذي يحدد حبكته كما يذهب إريك فورم.
يقول (حمدي النورج) في وصف السرد الذي يسعى إلى تقديم الواقع الداخلي للإنسان “إننا نستقبل كل لحظة، بنية سردية جديدة، تسعى في صمت إلى كسر الحواجز بين الأنواع الأدبية، مع تفجير أنواع أدبية أخرى، وهي على النوع الروائي، أو القصصي، أو حتى تقنيات السردية الروائية التقليدية أكثر، فضلاً عن الطرق التقليدية في تصوير الشخصيات، وتصوير الزمان، والمكان، بل وتفتيت الحبكة والحكاية معًا، في وقت، يستوجب على القارئ ألا يهبط على النص المقدم له بمخططات ذهنية مسبقة، فيقرأ النص ويتلقاه طبقًا لنوع التخطيط المحفور في الذهنية”[2]
وإذا كان سرد الأحلام يسعى إلى تصوير الواقع الداخلي للإنسان، وإذا كان الواقع الداخلي وثيق الصلة بالواقع الخارجي، فنحن لا يمكننا أن نعرف، إذا كان الحلم هو أصل الحقيقة، أم أن الحقيقة هي أصل الحلم؛ وعبر تاريخ الإنسان كانت الأحلام جزءًا من واقع الحياة اليومية، حتى أن قبائل الأشانتي كانت تعتقد بأنه يتوجب على الرجل، الذي حلم بأنه زنا بامرأة رجل آخر، أن يدفع له غرامة الزنا، أي أن الحلم هو وجود موازٍ للواقع الحقيقي. فإذا كان السرد في صورته الخالصة، يفيد من الواقع المعيش ويعود إليه، فما المانع في أن يعود إلى الواقع الداخلي، الذي نختبره ونراه في يقظتنا ونومنا؟ فمن ناحية، ثم اتفاق بين علماء الدماغ على ذاتية الأحلام، وارتباطها بواقع الحياة اليومية، ومن ناحية أخرى فإن الأحلام تأتي في نوبات مستمرة طوال وقت النوم (عشرون دقيقة، كل تسعين دقيقة) أي أن لدينا يوميًا ساعتين نتفرغ فيهما للتحديق في صندوقنا الأسود، عالمنا الداخلي.
التحديق في الداخل أثناء الكتابة مختبر، ومجرب، ونتائجه الإبداعية تشيع في كثير من فنون الأدب، لكننا لم نلتفت إلى إمكانية انفراده بطبيعة الحلم، إلا مع نجيب محفوظ. ورغم ذلك فلدينا تجربة فريدة في هذا الصدد، سنشير إليها على نحو مفصل لاحقًا. وهي تجربة (أحلام سرية) للكاتب مصطفى بيومي، التي صدرت عام (1998م) في طبعة خاصة محدودة لم يقدر لها الانتشار. وهي رواية قصيرة تتألف من تسع وتسعين حلمًا.
في كتابه (عن طبيعة الحلم والإبداع) والذي نعتمد عليه، كونه الكتاب الأكثر إحاطة بتجربة (أحلام فترة النقاهة) من وجهة نظر خبير بالنفس الإنسانية، والإبداع الأدبي، وبشخص نجيب محفوظ معًا. يشير الدكتور يحي الرخاوي، إلى تتبعه لجذور الطبيعة الحُلمية في مجمل أدب نجيب محفوظ، مؤكدًا على أن مستويات الوعي عند نجيب محفوظ، ذات طبقات وثيقة الصلة ببعضها البعض، حتى لا يمكن فصلها، فهذا الفصل، يحرمنا من سيمفونية إبداعه المتداخلة. ومن ثم يشير إلى حضور تيار الوعي جنبًا إلى جنب مع الواقعية في كتاباته، وإن ظل على نحو محدود في سرده، لكنه كان ينمو مع الوقت، كما نرى في ليالي ألف ليلة، ورأيت فيما يرى النائم، وأصداء السيرة الذاتية، وإذا به يكتمل في أحلام فترة النقاهة؛ ليعلن عن هويته فنًا مستقلاً على غير مثال، يمكن أن نطلق عليه فن سرد الأحلام.
كما يومئ الرخاوي، إلى أن تجربة الأحلام، اهتزت وربت، وأنبتت ثمارها، خلال الفترة التي انقطع فيها نجيب محفوظ عن الكتابة، أي فترة النقاهة التي عاشها بعد محاولة اغتياله الآثمة، وتعطلت حركة يده اليمنى عن الكتابة لست سنوات. ربما هذه الواقعة المؤلمة التي جاءت في نهاية رحلة أدبية مليئة بالنجاحات المبهرة، يمكن أن تكون أدخلت محفوظ في سحابة اكتئابية، تشبه أزمة عمر الحمزاوي، فخاض رحلته الداخلية عبر بنيه حلميه، تسمح بفضاء سردي، جديرة برجل عاش حياته في السرد. كان الرخاوي يتابعه فيها ليؤهله نفسيًا، ويدرب يده لتعود إلى الحياة. وكان أول ما خطت يداه على نحو شبه مكتمل، ذا طبيعة حلمية. قد يبدو الأمر أقرب إلى المعجزة، ولا مشاحة أن نتوقع المعجزات عندما يتعلق الأمر بنجيب محفوظ. لكنني أرنو إلى المغزى الأعمق في حكاية الدكتور الرخاوي، إن التجربة النفسية التي عاشها محفوظ بعد واقعة العدوان عليه، وتوقفه عن الكتابة، بوصفها طريقة للتحديق في الواقع المعيش، منحته الفرصة ليحدق في واقعه الداخلي.
وأذكر أنني مررت بشيء قريب من هذا، عندما أصبت بمشكلة في العمود الفقري، اضطرتني للرقود على ظهري عدة أشهر بلا حراك ولا فرصة للحياة غير نوم متكرر من أثر المسكنات، وفي هذه الأثناء، انبثقت أول نصوص (لمح البصر) ويبدو أن أحلام نجيب محفوظ كانت في وجداني رغم مرور سنوات عديدة بعد قراءتها، لكن النصوص الثلاثة الأولى التي كتبتها حينها، بدت عصية على التشكيل المميز لطبيعة الأحلام، مع قلق كبير من شبهة التقليد، فصرفت نظر عن الموضوع كله، حتى رأيت في منامي نجيب محفوظ وهو يجلس بين رفاقه على مقهى بترو بالإسكندرية، وكنت ممسكًا بواحدة من أصداف البحر، فأعطيتها له، وفرح بها. ونصيب هذا الحلم من الحقيقة كبير، فقد كنت في عام (1975م) جنديًا في قاعدة أبي قير البحرية، وكان من هواياتي جمع الأصداف.
أثناء وجودي بالإسكندرية سمعت عن جلست محفوظ ورفاقه التي يعقدونها كل يوم جمعة بمقهى (بترو) ذهبت مبكرًا إليه. وربما من قبيل المصادفة، أو من حسن حظ المبتدئين، أن أول من جاء إلى المقهى، كان نجيب محفوظ، وبعد بضع كلمات حذرة عرضت عليه أن اقرأ له قصة قصيرة جدًا فوافق، ثم أثنى عليها باقتضاب.
كانت هذه هي المرة الوحيدة التي التقيت فيها بمحفوظ وجها لوجه، لكنها كانت كافية لأعيد كتابة القصة مرات عديدة، وأتقدم بها في أول مسابقة للقصة القصيرة تنظمها القوات المسلحة، وقد أحرزت المركز الثاني. وأذكر أن يوسف السباعي كان وزيرًا للثقافة وقتها، وفيما هو يسلمني شهادة التقدير، همس في أذني أنه يرى قصتي تليق بالمركز الأول، لكن الجيش له تقاليده، فقد كان الفائز بالمركز الأول ضابطًا عاملاً فيما كنت جنديًا مجندًا.
حررني الحلم بنجيب محفوظ من قلقي تجاه كتابة أحلام (لمح البصر) لكن يهمني التأكيد على أن كتابتي للحلم بنجيب محفوظ، الذي راودني أثناء مرضي، جاءت شيئًا مختلفًا عن الحلم نفسه، فأثناء الكتابة، نعيش حالة تداعيات لهمسات وأصوات بعيدة وخافتة، إذ تداخلت في كتابة الحلم أصداء التجربة الذاتية، وذكريات الحياة بالإسكندرية، فضلاً عن حرفية السارد، وفاعلية التخييل، وشعرية أحلام اليقظة. هكذا أدركت أن كتابة الأحلام، تجربة إبداعية، تخص كاتبها وحده.
أذكر هذه الحكاية، لأن تصورنا أن نجيب محفوظ، كان يحلم ويسجل أحلامه، لا يقل بساطة عن اعتبار البعض أن أحلام فترة النقاهة، تهويمات رجل تائه في ضباب الشيخوخة. ولا مشاحة في أن كتابة الأحلام قد تبدأ بتهويمات، أو نغبشات كما يسميها نجيب محفوظ والعهدة على يحي الرخاوي[3] لكن إذا كان الحلم نفسه، مهمة اللاوعي، فإن كتابته، هي مهمة واعية بالدرجة الأولى، حيث يقوم العقل الخبير بطرائق السرد، بعملية استبدال فني، لتصوراتنا عن ماهية الحلم. وهذه العملية التي تتم أثناء الكتابة، تضع الحلم المكتوب في أقصى نقطة ممكنة عن حلم النوم، ومع الوقت، يستطيع كاتب الأحلام، أن يستنطق أحلام النوم في يقظته، لتصبح إبداعًا خالصًا، منسوجًا من مادة الحلم وآليات عمله.
*****
عبر التراث الإنساني، كانت الأحلام وتفسيراتها هاجعة في ظلال التفكير الميتافيزيقي، حتى جاء (سيجموند فرويد) الذي نشر في العام (1900م) أولَ محاولة علمية لدراسة الحلم بوصفه نشاطًا آليًا في عمل الدماغ للإنسان. وبهذا، تدخل الأحلام في سياق التفكير العلمي، وتنتج نظرياتها حول تشكل الحلم، وأنماطه، وآليات إنتاجه، ومرجعياته، بل وسيرورته لاستقراء دوره في التركيب النفسي للإنسان عبر تاريخه. ومع ذلك، فقد أكد فرويد، على أن الحلم، مرتبط بالحياة الواعية؛ أو بمعنى آخر بالواقع المعيش، ومن ثم فهو يكشف عن المقموع في الوعي، ولا علاقة له بالنبوءات. هكذا يصبح الحلم خلقًا خياليًا مرجعه الواقع كأي نص أدبي، وفي نفس الوقت، تعبيرًا عن المكبوت في اللاوعي، بتأثيرات الواقع المعيش.
معنى هذا أن الحلم يقدم صورة عن الذات الإنسانية في صورتيها الواعية واللاواعية. ومن ناحية أخرى فلغة الحلم من مادة الصور والرموز، وبهما تُمثّلُ المشاعر والمكبوتات، وهى تقريبًا نفس الآلية التي يعمل بها العقل المبدع. وفي النهاية فإن الأحلام تعكس صراع الإنسان مع محيطه السيسيوثقافي كأي نص أدبي.
لقد رسم (فرويد) للحلم مسارًا محددًا وعلميًا، فالوقائع والأحداث التي تسبق الحلم في يقظتنا، هي مجرد محفزات، لتحريك المكبوت في لاوعينا الشخصي منذ طفولتنا، وهي تخرج أثناء النوم في صور رمزية، ذات معنى جنسي، هكذا يبدو اللاوعي عند فرويد، هو صندوقنا الأسود، أو سلة قمامتنا التي نخفيها.
أما (كارل جوستاف يونج) تلميذه المتمرد، فقد ذهب لأبعد من ذلك كثيرًا. لقد حرر الحلم من الارتباط الشرطي بالجنس، وحرر لغته الرمزية. فاللاوعي هو تكوين (وعي) بدائي يرجع لطفولة الإنسانية، حيث الأساطير الأولى التي تفسر الوجود، وتنتج نماذج قبلْية موجودة عند كل البشر، وهذه النماذج، تمضي في سيرورة رمزية عبر التاريخ لتسكننا، وهي شديدة المراوغة، ذات طبقات ومستويات عدة، ومن ثم ، فهي محملة بكل رموز التاريخ البشري وليس الرموز الجنسية فقط، فالنار، والنجوم، والماء، والبيوت، والمعابد، والرحلة، والموت، وغيرها الكثير، هي رموز قد تظهر في الحلم، ويجب أن تقرأ في سياقها الموضوعي وليس على إطلاقها، ومن ثم، فتفسير الحلم، هو قراءة لرموزه في سياق موضوعه، طبقة بعد أخرى.
إن للحلم بنية كلية مثل أي نص، تترابط علاماته فيما بينها. وفي هذا السياق، يرى (الرخاوي) في معرض قراءة الحلم رقم (4) من أحلام فترة النقاهة: “إن الأهم من البحث عن الرمز هنا وهناك، هو رصد هذه النهايات المفتوحة بشكل تشكيلي محرك لوعي المتلقي”[4] والشاهد في كلام يحيى الرخاوي، أن التعامل مع الأحلام المسرودة كتابةً، لا يكون بتفسيرها الرمزي فحسب كتفسيرنا لأحلام النوم، ولكنها قراءة تشمل كل طرائق وأساليب تشكيل الحلم، بوصفه نصًا أدبيًا.
ولأن الأحلام هي أكثر آليات اللاوعي اشتغالاً في حياة البشر، نجد أن حضورها المصاحب للشخصيات الروائية والقصصية، شائعًا ومألوفًا كما هو في الحياة؛ لهذا كانت الأحلام ومازالت موضوعًا أدبيًا، سواء كانت مضمرة في ثنايا العمل الأدبي، وهو الشائع المعتاد، أو مقصودة لذاتها كأحلام فترة النقاهة.
كان السرياليون قد التفتوا إلى أهمية توظيف اللاوعي وآليات إنتاج الحلم، وكتبوا بها قصصهم ورواياتهم، فجاءت مميزة في لغتها وعوالمها عن الأدب الواقعي. إذ أن السرياليين رأوا أن الانهماك في الواقع يعمق عزلة الفنان عن ذاته المبدعة، ومن ثم يتحول الإبداع إلى وظيفة فاقدة للروح. وتقوم فلسفتهم على إخضاع الكتابة لقوة داخلية تقهر الوعي، وتسمح بانفلاتات محسوبة للاوعي، فثم اعتقاد أن قوانين الواقع فرضت على الإنسان أن يعيش عبر أقنعة. والمبدع السيريالي الذي يسعى لاستنطاق اللاوعي، يهدف إلى تحطيم هذه الأقنعة، وتحرير الداخل، بإطلاق الصور، والأخيولات، والرؤى السجينة فيه. ويمكننا ملاحظة أن هذه الوظيفة التي يسعى إليها المبدع السيريالي، وثيقة الصلة بالوظيفة التعويضية، التي تحدث الاتزان عند (يونج) أي أنها وظيفة ذاتية تخص كاتبها، وليست موجهة إلى الشأن العام كدأب الأدب الواقعي بمختلف اتجاهاته. ومادام الأمر ذاتيًا على هذا النحو، فالكاتب، يحتاج إلى تدريبات على الاستبطان واستقراء الداخل، مع قدر كبير من الشجاعة على مواجهته، واحترام مخرجاته، مهما كانت مؤلمة أو مخجلة أو حتى مخيفة وغير مفهومة.
وسواء كانت وظيفة الأحلام، فضح المقموعات التي تسكننا، كما يذهب فرويد، أو إحداث الاتزان من قبيل التعويض النفسي كما عند يونج، فإن كتابة الأحلام يمكنها أن تقوم بهذا الدور على نحو آمن. أي أن كتابة الأحلام ليست مجرد نشاط أدبي وحسب، بل هي مواجهة مباشرة مع ذواتنا، واستنطاق للاوعينا، وتحريره من تراكمات رحلة وجودنا. لذلك، فكتابة الأحلام، هي رحلة استشفاء، وتجديد لطاقة الحياة فينا، ربما لهذا، اختار نجيب محفوظ أن يسميها، أحلام فترة النقاهة.
غير أن التأكيد على معنى الذاتية في سرد الأحلام، قد يوحي للبعض، أنها لا تخص سوى كاتبها، ومن ثم، يسقطون ما في الحلم على شخص الكاتب. هذا احتراز مهم يقوله يحي الرخاوي في إشارته إلى الحلم رقم (10) من أحلام فترة النقاهة، فهو على نحو تهكمي، لا يخفي تخوفه من أن يسعى أحد الفرويديين، إلى إحالة الطيران في نهاية الحلم، إلى مغزى جنسي متعسف، ويسقطه على شيخ يغالب نقاهته.[5]
قد يبدو للبعض أن الأحلام تجربة ذاتية جدًا، لا تخص سوى صاحبها، وبهذا يعرض عن قراءتها البعض، ولكننا نرى فيها شيئًا جديرًا بالقراءة، ليس للغتها المكثفة، وطاقتها الرمزية والشعرية، فحسب، ولا حتى لطرافة التخييل وعمق المعنى، بل هي تقدم لنا معرفة جديرة بالاعتبار، فثمة معان وموضوعات مشتركة في الأحلام بين البشر.
صحيح أن (كارل يونج) يتفق مع (فرويد) على ذاتية الحلم، نتيجة لأن اللاوعي الفردي يرتبط مباشرة بالسيرة الذاتية للفرد وبتجاربه الحياتية – وهذا في حد ذاته كاف لأن يجعلها تجربة إبداعية- إلا أن (يونج) يؤكد على أن لغة الأحلام تستمد طاقتها الرمزية من عالم أبعد كثيرًا من الواقع المعيش والتجارب الذاتية، فترجع إلى عالم بدائي سحيق، قبل أن تبدأ الحضارة الإنسانية في تشكيل منظومة القيم، والمحرمات، والعادات، والتقاليد الاجتماعية، التي كونت النسيج الثقافي للمجتمعات، وأفضت إلى التمايز فيما بينها؛ بما يعني أن هذه اللغة البدائية، والتي يسميها (إيريك فروم) اللغة المنسية، كانت مشتركة بين كل البشر، وهي مازالت كامنة على نحو رمزي في اللاوعي. ومن خلال الوقوف على رموزها يمكننا تفسير الأحلام، بل وقراءة هنات الوعي وزلات لسان، وتعبيرات الجسد اللاإرادية.
اللغة البدائية للحلم، تفسر لنا وجود أحلام مشتركة في موضوعاتها بين البشر. فمثلاً: أحلام السقوط من المرتفعات، والاحتجاز في الأماكن الضيقة، أو التيه في الأماكن المظلمة، أو التعري بين الغرباء، أو الخوف من خطر النار، التي تعتبر من أشهر الرموز البدائية، التي حظيت بالاهتمام في التحليل النفسي على نحو ما تناولها جاستون باشلار[6]. ولذلك تظل أهمية الحلم مرتبطة برموزه، كما هي مرتبطة بموضوعه، بل وحبكته سواء جاءت مفككة على هيئة صور متناثرة، أو جاءت عبر وقائع وأحداث متسقة فيما بينها. ومع ذلك فحتى الأحلام المشتركة في موضوعاتها بين البشر، تحظى بخصوصية ترتبط بالتجارب النفسية والممارسات الحياتية لحالميها. فأطفال المدارس مثلاً، قد تروادهم أحلام التأخر عن مواعيد المدرسة، أو التيه في الطريق إليها، أو نسيان شيء من مستلزماتها، كالحقيبة أو كراسة الواجب. لكن تفسير مثل هذه الأحلام يعتمد على رمزية موضوع النسيان لا النسيان نفسه. فمثلاً: نسيان التلميذ للواجب المدرسي قد يعكس معنى تعويضيًا يسقطه التلميذ على المدرس، فتجاهل الواجب المدرسي هو تجاهل للمدرس، أو نوع من العقاب له، هكذا ينتقم التلميذ من مدرسه ويتحرر من الخوف، بعمل لا يجرؤ عليه في يقظته. وقد يكون نفس الحلم مجرد حافز ينبه التلميذ إلى أهمية العناية بواجباته المدرسية، كما قد يكون تعبيرًا عن إحساس عميق بالذنب والتقصير في مجال آخر لا علاقة له بالواجب المدرسي، حيث يرى (فرويد) أن الإحساس بالذنب ينشأ في طفولة مبكرة مع المرحلة الشرجية. وعلى ما تقدم فإن رموز الأحلام ذات مستويات وطبقات متعددة، تمنحنا فرصًا لتأويلات وتفسيرات متعددة للحلم الواحد، تمامًا كما نفعل مع النص الأدبي الثري.
وعلى أية حال، فالتشابهات في موضوعات الأحلام لا تنفي ذاتيتها. نتيجة لتماهي المسافة بين الذاتي والموضوعي في الحلم. وهذا التماهي جزء مهم في تجربة الإبداع أيضًا، عندما يصبح موضوع النص مرادفًا لذات المبدع، ومن ثم يتمكن من التعبير عن ذاته في نفس الوقت الذي يعبر فيه عن موضوعه الواقعي.
مما سبق، نفهم أن الأحلام هي الممارسة الإنسانية الأقرب إلى تجربة الكتابة، وكأننا نكتب ذواتنا كل ليلة في الأحلام. وإذا كنا اعتدنا أن نحكي أحلامنا ونحاول تفسيرها، فهذا لقابليتها للحكي والتأويل، كأي تجربة واقعية معيشة. لهذا، ففكرة كتابة الأحلام ممكنة ومقبولة، ليس فقط لتوظيفها في العمل الأدبي، ولكنها يمكن أن تكون سردًا مستقلاً ومميزًا في حد ذاته، على نحو ما كتب نجيب محفوظ (أحلام فترة النقاهة) فأنتجت شكلها الخاص سواء في كثافتها ودلالتها الوامضة، أو في لغتها الرمزية المفتوحة على التجربة الإنسانية الشخصية والعامة في نفس الوقت، أو في طاقتها التخييلية المتجاوزة لحدود الواقع.
كما أن قراءة الأحلام مثل كتابتها، فهي من ناحية تنطق بتجارب إنسانية مشتركة، لكنها تبقي على الجزء الذاتي لكاتبها. وهذا الجزء الذاتي، هو الذي يعطيها قابلية التأويل المتعدد عند القراء، ويشملها بالسحر الذي قد نجده في النص الأدبي. فمثلاً، الكثير من قراء نجيب محفوظ استخدموا آلية الإسقاط على الواقع الاجتماعي لتفسير أحلام فترة النقاهة؛ ففي الحلم رقم (4) ثم من اعتبر أن شخصية الزعيم التي ظهرت في الحلم، تحيل إلى شخص جمال عبد الناصر، وهو تفسير مقبول ولكنه مباشر وضيق؛ أما الدكتور (يحي الرخاوي) الذي جمع بين خبرة عالم النفس والأديب، يدرك أن رمزية الحلم قد تمتد إلى زمن سحيق في الفكر الإنساني. فالزعيم يمكن أن يكون له بعد إنساني واسع لأسطورة البطل المنقذ، التي تتجلى في فكرة النبي، أو المهدي المنتظر، أو المسيح المخلِّص، كما يمكن وفقًا لآلية التمويه في الأحلام، أن يتماهى المسح المخلص، بالمسيخ الدجال، وفقًا للأسطورة أيضًا. أي أن الرمز قد يحمل المعنى ونقيضه، بفضل آلية التمويه التي يمارسها اللاوعي، على نحو ما رأيت في منامي، مقهى (بترو) متماهيًا مع التكية.
وهذا التركيب الخاص لسرد الأحلام، يجعله مختلفًا عن الواقعية السحرية، كون الأخيرة عملية توظيف لثراث الإنسانية الغرائبي، يغيب فيها المعنيين: الشخصي والذاتي. كما أنه يختلف عن السيريالية التي تمثل بناءًا مجردًا من أي بعد واقعي، يحمل المضامين الانفعالية والفكرية على نحو تلقائي، وخارج عن أي انشغال جمالي أو موضوعي.
أما الحلم فله سمات أكثر مرونة وتعقيدًا في نفس الوقت، حيث يلتبس بالوقائع والحقائق والأشكال المعينة، المرئية بالعين؛ لهذا قد تبدو بعض الأحلام منطقية ومتماسكة فيمكن تذكرها وحكيها، ومن ثم محاكاتها سردًا. لكن علماء النفس يعتقدون أن ما نتذكره من أحلامنا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جدًا، أي أن ما نحكيه من الحلم بعد استيقاظنا، ليس هو بالضبط ما حلمنا به، بل تداعياته، بتدخلات من الوعي، وخبرات لأحلام سابقة لنا أو لآخرين، ووقائع نكون طرفًا فيها، فضلاً مهاراتنا الخاصة في الحكي وتأويله، لهذا فحكي الحلم ممارسة إبداعية. أما كتابته، فهي إعادة إنتاج لرموزه وآلياته بشروط أدبية كاملة.
لكن عندما يصبح سرد الأحلام فنًا، نتمكن من السيطرة عليه، وإدارته وفق شروط أدبية، فلسنا في حاجة إلى أحلام النوم لنكتبها، بل يمكننا صناعة نص حلمي كاملاً عبر استنطاق اللاوعي، وتوظيف آليات إنتاج الأحلام. ولابد أن نجيب محفوظ في شيخوخته ونقاهته، لم يجلس ليتذكر كل هذا العدد من الأحلام ليكتبها، إنما هو أفاد من خبرته في استنطاق اللاوعي وتوظيف آليات الحلم، وتلك أساليب، وتقنيات، نراها في كثير من أعماله السابقة على أحلام فترة النقاهة، مكنته من اعتبار كتابة الحلم فنًا أدبيًا مستقلاً بذاته.
وسواء كانت كتابة الحلم مرجعها إلى حلم حقيقي، أو استنطاقًا يقظًا للداخل، فهي تلتزم بحرفية السرد الإبداعي، في معالجتها لآليات الحلم ولغته التي لا تظهر بوصفها معان، بل رموز وصور تنهمر في الفضاء الحُلمي الغامض، لهذا تظل ملتبسة بحيل اللاوعي من: تمويه وإبدال وتضخيم، وإنكار، وإسقاط. كما أنها مكتنزة بالتأثيرات الشعورية كالألم والخوف والحزن والنشوة. ثم يأتي الخيال الأدبي ليشمل كل هذا، وهو خيال بلا حدود. فإذا كانت لغة الأحلام تحيلنا إلى خيال بدائي كظلال تتراقص على جدران كهف، فإن ارتباطها بالتجربة الشخصية، تسمح لها بمقاربة الواقع المعيش، لتبدو مثل واقع افتراضي فائق القدرة.
كتابة الأحلام لا تحقق إشباعًا جماليًا لكاتبها فحسب، بل تفضي به إلى تجربة نفسية وروحية خاصة، على ما فيها من مواجهات مع النفس. ولأن لغة التخاطب المعتادة، يصعب عليها التعبير عن الرؤى الحلمية نظرًا لطبيعة الحلم المنفلتة من المعيارية، فإن على كاتب الأحلام أن يكتشف أدواته التعبيرية بنفسه، عندئذ نحصل على نصوص غاية في الثراء والجمال. ولا أستطيع القول بأن هذا يتحقق مع كل النصوص، فمستويات الغوص الداخلي متفاوتة في كتابة الأحلام، كما هي متفاوتة في أحلام النوم نفسها، فبعض الأحلام تكون قريبة من سطح الوعي فتطرح معناها ببساطة، وبعضها يكون عميقًا وغامضًا ومتشظيًا.
إن حق الريادة، الذي اقتنصه نجيب محفوظ عن اقتدار، ومشروعه السردي التجريبي الواسع، مترامي الأطراف، يضعنا أمام مسئولية، تفضي إلى النظر لأحلام فترة النقاهة بوصفها تجربة متفردة، ليس بالنسبة لتاريخ صاحبها فحسب، بل بالنسبة لتاريخ الأدب العربي الحديث. لقد أعطى نجيب محفوظ لسرد الأحلام حق الوجود المنفرد، بوصفه فنًا قصصيًا، جاء في زمن الرواية، ليؤكد أن ممكنات القصة القصيرة مازالت واعدة، وقادرة على خلق مسارات جديدة، حتى ليأتي سرد الأحلام، بوصفه فنًا مميزًا في لغته، وتقنياته، وأساليب سرده، فيقف جنبًا إلى جنب مع أشكال مختلفة من التعبير القصصي، كالمتتاليات القصصية، أوالبورتريهات والانفعالات التي كتبتها ناتالي ساروت، أو النصوص عابرة النوع التي دمجت النثر بالشعر، أو القصة القصيرة جدًا (الأقصوصة) التي بلغت في السنوات الأخيرة شأنًا وشيوعًا في كتابتها، متأثرة بلغة الرسائل النصية على الإنترنت والهواتف المحمولة.
أحلام (فترة النقاهة) نجحت في أن تجعل كتابة الأحلام عملاً فنيًا مستقلاً في بنيته ولغته، يحقق مستويات من التعبير أكبر مما تتيحه القصة بانهماكها في الواقع اليومي والمعاش، فلم تعد تجربة وحيدة تخص نجيب محفوظ وحده، بقدر ما هي دعوة للالتفات إلى أن كتابة الأحلام شكل سردي جديد، يقف على التخوم بين الأقصوصة في بنيتها المكثفة، والحلم في فضائه التخييلي، والشعر في فضائه اللغوي. إنها دعوة رائدة، لنكتب أحلامنا، كما كتبنا قصصنا، وقصائدنا.
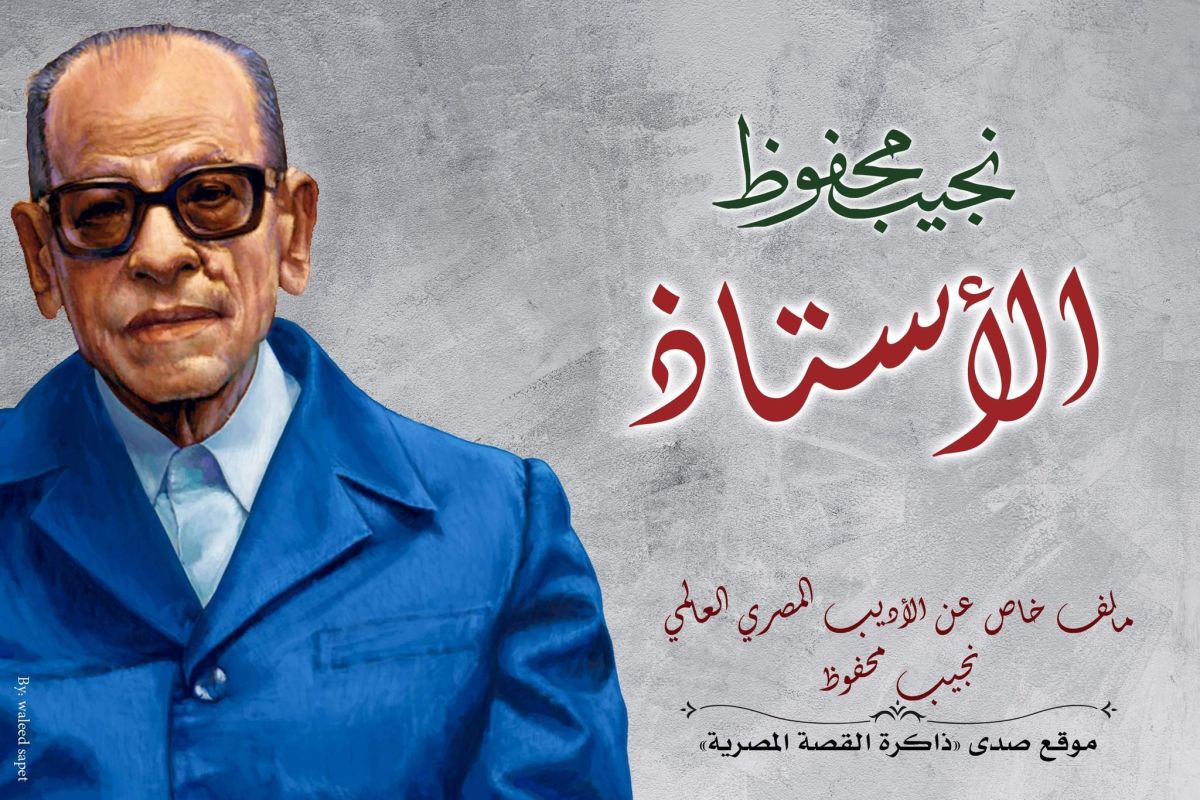
 sadazakera.wordpress.com
sadazakera.wordpress.com
يقول (حمدي النورج) في وصف السرد الذي يسعى إلى تقديم الواقع الداخلي للإنسان “إننا نستقبل كل لحظة، بنية سردية جديدة، تسعى في صمت إلى كسر الحواجز بين الأنواع الأدبية، مع تفجير أنواع أدبية أخرى، وهي على النوع الروائي، أو القصصي، أو حتى تقنيات السردية الروائية التقليدية أكثر، فضلاً عن الطرق التقليدية في تصوير الشخصيات، وتصوير الزمان، والمكان، بل وتفتيت الحبكة والحكاية معًا، في وقت، يستوجب على القارئ ألا يهبط على النص المقدم له بمخططات ذهنية مسبقة، فيقرأ النص ويتلقاه طبقًا لنوع التخطيط المحفور في الذهنية”[2]
وإذا كان سرد الأحلام يسعى إلى تصوير الواقع الداخلي للإنسان، وإذا كان الواقع الداخلي وثيق الصلة بالواقع الخارجي، فنحن لا يمكننا أن نعرف، إذا كان الحلم هو أصل الحقيقة، أم أن الحقيقة هي أصل الحلم؛ وعبر تاريخ الإنسان كانت الأحلام جزءًا من واقع الحياة اليومية، حتى أن قبائل الأشانتي كانت تعتقد بأنه يتوجب على الرجل، الذي حلم بأنه زنا بامرأة رجل آخر، أن يدفع له غرامة الزنا، أي أن الحلم هو وجود موازٍ للواقع الحقيقي. فإذا كان السرد في صورته الخالصة، يفيد من الواقع المعيش ويعود إليه، فما المانع في أن يعود إلى الواقع الداخلي، الذي نختبره ونراه في يقظتنا ونومنا؟ فمن ناحية، ثم اتفاق بين علماء الدماغ على ذاتية الأحلام، وارتباطها بواقع الحياة اليومية، ومن ناحية أخرى فإن الأحلام تأتي في نوبات مستمرة طوال وقت النوم (عشرون دقيقة، كل تسعين دقيقة) أي أن لدينا يوميًا ساعتين نتفرغ فيهما للتحديق في صندوقنا الأسود، عالمنا الداخلي.
التحديق في الداخل أثناء الكتابة مختبر، ومجرب، ونتائجه الإبداعية تشيع في كثير من فنون الأدب، لكننا لم نلتفت إلى إمكانية انفراده بطبيعة الحلم، إلا مع نجيب محفوظ. ورغم ذلك فلدينا تجربة فريدة في هذا الصدد، سنشير إليها على نحو مفصل لاحقًا. وهي تجربة (أحلام سرية) للكاتب مصطفى بيومي، التي صدرت عام (1998م) في طبعة خاصة محدودة لم يقدر لها الانتشار. وهي رواية قصيرة تتألف من تسع وتسعين حلمًا.
في كتابه (عن طبيعة الحلم والإبداع) والذي نعتمد عليه، كونه الكتاب الأكثر إحاطة بتجربة (أحلام فترة النقاهة) من وجهة نظر خبير بالنفس الإنسانية، والإبداع الأدبي، وبشخص نجيب محفوظ معًا. يشير الدكتور يحي الرخاوي، إلى تتبعه لجذور الطبيعة الحُلمية في مجمل أدب نجيب محفوظ، مؤكدًا على أن مستويات الوعي عند نجيب محفوظ، ذات طبقات وثيقة الصلة ببعضها البعض، حتى لا يمكن فصلها، فهذا الفصل، يحرمنا من سيمفونية إبداعه المتداخلة. ومن ثم يشير إلى حضور تيار الوعي جنبًا إلى جنب مع الواقعية في كتاباته، وإن ظل على نحو محدود في سرده، لكنه كان ينمو مع الوقت، كما نرى في ليالي ألف ليلة، ورأيت فيما يرى النائم، وأصداء السيرة الذاتية، وإذا به يكتمل في أحلام فترة النقاهة؛ ليعلن عن هويته فنًا مستقلاً على غير مثال، يمكن أن نطلق عليه فن سرد الأحلام.
كما يومئ الرخاوي، إلى أن تجربة الأحلام، اهتزت وربت، وأنبتت ثمارها، خلال الفترة التي انقطع فيها نجيب محفوظ عن الكتابة، أي فترة النقاهة التي عاشها بعد محاولة اغتياله الآثمة، وتعطلت حركة يده اليمنى عن الكتابة لست سنوات. ربما هذه الواقعة المؤلمة التي جاءت في نهاية رحلة أدبية مليئة بالنجاحات المبهرة، يمكن أن تكون أدخلت محفوظ في سحابة اكتئابية، تشبه أزمة عمر الحمزاوي، فخاض رحلته الداخلية عبر بنيه حلميه، تسمح بفضاء سردي، جديرة برجل عاش حياته في السرد. كان الرخاوي يتابعه فيها ليؤهله نفسيًا، ويدرب يده لتعود إلى الحياة. وكان أول ما خطت يداه على نحو شبه مكتمل، ذا طبيعة حلمية. قد يبدو الأمر أقرب إلى المعجزة، ولا مشاحة أن نتوقع المعجزات عندما يتعلق الأمر بنجيب محفوظ. لكنني أرنو إلى المغزى الأعمق في حكاية الدكتور الرخاوي، إن التجربة النفسية التي عاشها محفوظ بعد واقعة العدوان عليه، وتوقفه عن الكتابة، بوصفها طريقة للتحديق في الواقع المعيش، منحته الفرصة ليحدق في واقعه الداخلي.
وأذكر أنني مررت بشيء قريب من هذا، عندما أصبت بمشكلة في العمود الفقري، اضطرتني للرقود على ظهري عدة أشهر بلا حراك ولا فرصة للحياة غير نوم متكرر من أثر المسكنات، وفي هذه الأثناء، انبثقت أول نصوص (لمح البصر) ويبدو أن أحلام نجيب محفوظ كانت في وجداني رغم مرور سنوات عديدة بعد قراءتها، لكن النصوص الثلاثة الأولى التي كتبتها حينها، بدت عصية على التشكيل المميز لطبيعة الأحلام، مع قلق كبير من شبهة التقليد، فصرفت نظر عن الموضوع كله، حتى رأيت في منامي نجيب محفوظ وهو يجلس بين رفاقه على مقهى بترو بالإسكندرية، وكنت ممسكًا بواحدة من أصداف البحر، فأعطيتها له، وفرح بها. ونصيب هذا الحلم من الحقيقة كبير، فقد كنت في عام (1975م) جنديًا في قاعدة أبي قير البحرية، وكان من هواياتي جمع الأصداف.
أثناء وجودي بالإسكندرية سمعت عن جلست محفوظ ورفاقه التي يعقدونها كل يوم جمعة بمقهى (بترو) ذهبت مبكرًا إليه. وربما من قبيل المصادفة، أو من حسن حظ المبتدئين، أن أول من جاء إلى المقهى، كان نجيب محفوظ، وبعد بضع كلمات حذرة عرضت عليه أن اقرأ له قصة قصيرة جدًا فوافق، ثم أثنى عليها باقتضاب.
كانت هذه هي المرة الوحيدة التي التقيت فيها بمحفوظ وجها لوجه، لكنها كانت كافية لأعيد كتابة القصة مرات عديدة، وأتقدم بها في أول مسابقة للقصة القصيرة تنظمها القوات المسلحة، وقد أحرزت المركز الثاني. وأذكر أن يوسف السباعي كان وزيرًا للثقافة وقتها، وفيما هو يسلمني شهادة التقدير، همس في أذني أنه يرى قصتي تليق بالمركز الأول، لكن الجيش له تقاليده، فقد كان الفائز بالمركز الأول ضابطًا عاملاً فيما كنت جنديًا مجندًا.
حررني الحلم بنجيب محفوظ من قلقي تجاه كتابة أحلام (لمح البصر) لكن يهمني التأكيد على أن كتابتي للحلم بنجيب محفوظ، الذي راودني أثناء مرضي، جاءت شيئًا مختلفًا عن الحلم نفسه، فأثناء الكتابة، نعيش حالة تداعيات لهمسات وأصوات بعيدة وخافتة، إذ تداخلت في كتابة الحلم أصداء التجربة الذاتية، وذكريات الحياة بالإسكندرية، فضلاً عن حرفية السارد، وفاعلية التخييل، وشعرية أحلام اليقظة. هكذا أدركت أن كتابة الأحلام، تجربة إبداعية، تخص كاتبها وحده.
أذكر هذه الحكاية، لأن تصورنا أن نجيب محفوظ، كان يحلم ويسجل أحلامه، لا يقل بساطة عن اعتبار البعض أن أحلام فترة النقاهة، تهويمات رجل تائه في ضباب الشيخوخة. ولا مشاحة في أن كتابة الأحلام قد تبدأ بتهويمات، أو نغبشات كما يسميها نجيب محفوظ والعهدة على يحي الرخاوي[3] لكن إذا كان الحلم نفسه، مهمة اللاوعي، فإن كتابته، هي مهمة واعية بالدرجة الأولى، حيث يقوم العقل الخبير بطرائق السرد، بعملية استبدال فني، لتصوراتنا عن ماهية الحلم. وهذه العملية التي تتم أثناء الكتابة، تضع الحلم المكتوب في أقصى نقطة ممكنة عن حلم النوم، ومع الوقت، يستطيع كاتب الأحلام، أن يستنطق أحلام النوم في يقظته، لتصبح إبداعًا خالصًا، منسوجًا من مادة الحلم وآليات عمله.
*****
عبر التراث الإنساني، كانت الأحلام وتفسيراتها هاجعة في ظلال التفكير الميتافيزيقي، حتى جاء (سيجموند فرويد) الذي نشر في العام (1900م) أولَ محاولة علمية لدراسة الحلم بوصفه نشاطًا آليًا في عمل الدماغ للإنسان. وبهذا، تدخل الأحلام في سياق التفكير العلمي، وتنتج نظرياتها حول تشكل الحلم، وأنماطه، وآليات إنتاجه، ومرجعياته، بل وسيرورته لاستقراء دوره في التركيب النفسي للإنسان عبر تاريخه. ومع ذلك، فقد أكد فرويد، على أن الحلم، مرتبط بالحياة الواعية؛ أو بمعنى آخر بالواقع المعيش، ومن ثم فهو يكشف عن المقموع في الوعي، ولا علاقة له بالنبوءات. هكذا يصبح الحلم خلقًا خياليًا مرجعه الواقع كأي نص أدبي، وفي نفس الوقت، تعبيرًا عن المكبوت في اللاوعي، بتأثيرات الواقع المعيش.
معنى هذا أن الحلم يقدم صورة عن الذات الإنسانية في صورتيها الواعية واللاواعية. ومن ناحية أخرى فلغة الحلم من مادة الصور والرموز، وبهما تُمثّلُ المشاعر والمكبوتات، وهى تقريبًا نفس الآلية التي يعمل بها العقل المبدع. وفي النهاية فإن الأحلام تعكس صراع الإنسان مع محيطه السيسيوثقافي كأي نص أدبي.
لقد رسم (فرويد) للحلم مسارًا محددًا وعلميًا، فالوقائع والأحداث التي تسبق الحلم في يقظتنا، هي مجرد محفزات، لتحريك المكبوت في لاوعينا الشخصي منذ طفولتنا، وهي تخرج أثناء النوم في صور رمزية، ذات معنى جنسي، هكذا يبدو اللاوعي عند فرويد، هو صندوقنا الأسود، أو سلة قمامتنا التي نخفيها.
أما (كارل جوستاف يونج) تلميذه المتمرد، فقد ذهب لأبعد من ذلك كثيرًا. لقد حرر الحلم من الارتباط الشرطي بالجنس، وحرر لغته الرمزية. فاللاوعي هو تكوين (وعي) بدائي يرجع لطفولة الإنسانية، حيث الأساطير الأولى التي تفسر الوجود، وتنتج نماذج قبلْية موجودة عند كل البشر، وهذه النماذج، تمضي في سيرورة رمزية عبر التاريخ لتسكننا، وهي شديدة المراوغة، ذات طبقات ومستويات عدة، ومن ثم ، فهي محملة بكل رموز التاريخ البشري وليس الرموز الجنسية فقط، فالنار، والنجوم، والماء، والبيوت، والمعابد، والرحلة، والموت، وغيرها الكثير، هي رموز قد تظهر في الحلم، ويجب أن تقرأ في سياقها الموضوعي وليس على إطلاقها، ومن ثم، فتفسير الحلم، هو قراءة لرموزه في سياق موضوعه، طبقة بعد أخرى.
إن للحلم بنية كلية مثل أي نص، تترابط علاماته فيما بينها. وفي هذا السياق، يرى (الرخاوي) في معرض قراءة الحلم رقم (4) من أحلام فترة النقاهة: “إن الأهم من البحث عن الرمز هنا وهناك، هو رصد هذه النهايات المفتوحة بشكل تشكيلي محرك لوعي المتلقي”[4] والشاهد في كلام يحيى الرخاوي، أن التعامل مع الأحلام المسرودة كتابةً، لا يكون بتفسيرها الرمزي فحسب كتفسيرنا لأحلام النوم، ولكنها قراءة تشمل كل طرائق وأساليب تشكيل الحلم، بوصفه نصًا أدبيًا.
ولأن الأحلام هي أكثر آليات اللاوعي اشتغالاً في حياة البشر، نجد أن حضورها المصاحب للشخصيات الروائية والقصصية، شائعًا ومألوفًا كما هو في الحياة؛ لهذا كانت الأحلام ومازالت موضوعًا أدبيًا، سواء كانت مضمرة في ثنايا العمل الأدبي، وهو الشائع المعتاد، أو مقصودة لذاتها كأحلام فترة النقاهة.
كان السرياليون قد التفتوا إلى أهمية توظيف اللاوعي وآليات إنتاج الحلم، وكتبوا بها قصصهم ورواياتهم، فجاءت مميزة في لغتها وعوالمها عن الأدب الواقعي. إذ أن السرياليين رأوا أن الانهماك في الواقع يعمق عزلة الفنان عن ذاته المبدعة، ومن ثم يتحول الإبداع إلى وظيفة فاقدة للروح. وتقوم فلسفتهم على إخضاع الكتابة لقوة داخلية تقهر الوعي، وتسمح بانفلاتات محسوبة للاوعي، فثم اعتقاد أن قوانين الواقع فرضت على الإنسان أن يعيش عبر أقنعة. والمبدع السيريالي الذي يسعى لاستنطاق اللاوعي، يهدف إلى تحطيم هذه الأقنعة، وتحرير الداخل، بإطلاق الصور، والأخيولات، والرؤى السجينة فيه. ويمكننا ملاحظة أن هذه الوظيفة التي يسعى إليها المبدع السيريالي، وثيقة الصلة بالوظيفة التعويضية، التي تحدث الاتزان عند (يونج) أي أنها وظيفة ذاتية تخص كاتبها، وليست موجهة إلى الشأن العام كدأب الأدب الواقعي بمختلف اتجاهاته. ومادام الأمر ذاتيًا على هذا النحو، فالكاتب، يحتاج إلى تدريبات على الاستبطان واستقراء الداخل، مع قدر كبير من الشجاعة على مواجهته، واحترام مخرجاته، مهما كانت مؤلمة أو مخجلة أو حتى مخيفة وغير مفهومة.
وسواء كانت وظيفة الأحلام، فضح المقموعات التي تسكننا، كما يذهب فرويد، أو إحداث الاتزان من قبيل التعويض النفسي كما عند يونج، فإن كتابة الأحلام يمكنها أن تقوم بهذا الدور على نحو آمن. أي أن كتابة الأحلام ليست مجرد نشاط أدبي وحسب، بل هي مواجهة مباشرة مع ذواتنا، واستنطاق للاوعينا، وتحريره من تراكمات رحلة وجودنا. لذلك، فكتابة الأحلام، هي رحلة استشفاء، وتجديد لطاقة الحياة فينا، ربما لهذا، اختار نجيب محفوظ أن يسميها، أحلام فترة النقاهة.
غير أن التأكيد على معنى الذاتية في سرد الأحلام، قد يوحي للبعض، أنها لا تخص سوى كاتبها، ومن ثم، يسقطون ما في الحلم على شخص الكاتب. هذا احتراز مهم يقوله يحي الرخاوي في إشارته إلى الحلم رقم (10) من أحلام فترة النقاهة، فهو على نحو تهكمي، لا يخفي تخوفه من أن يسعى أحد الفرويديين، إلى إحالة الطيران في نهاية الحلم، إلى مغزى جنسي متعسف، ويسقطه على شيخ يغالب نقاهته.[5]
قد يبدو للبعض أن الأحلام تجربة ذاتية جدًا، لا تخص سوى صاحبها، وبهذا يعرض عن قراءتها البعض، ولكننا نرى فيها شيئًا جديرًا بالقراءة، ليس للغتها المكثفة، وطاقتها الرمزية والشعرية، فحسب، ولا حتى لطرافة التخييل وعمق المعنى، بل هي تقدم لنا معرفة جديرة بالاعتبار، فثمة معان وموضوعات مشتركة في الأحلام بين البشر.
صحيح أن (كارل يونج) يتفق مع (فرويد) على ذاتية الحلم، نتيجة لأن اللاوعي الفردي يرتبط مباشرة بالسيرة الذاتية للفرد وبتجاربه الحياتية – وهذا في حد ذاته كاف لأن يجعلها تجربة إبداعية- إلا أن (يونج) يؤكد على أن لغة الأحلام تستمد طاقتها الرمزية من عالم أبعد كثيرًا من الواقع المعيش والتجارب الذاتية، فترجع إلى عالم بدائي سحيق، قبل أن تبدأ الحضارة الإنسانية في تشكيل منظومة القيم، والمحرمات، والعادات، والتقاليد الاجتماعية، التي كونت النسيج الثقافي للمجتمعات، وأفضت إلى التمايز فيما بينها؛ بما يعني أن هذه اللغة البدائية، والتي يسميها (إيريك فروم) اللغة المنسية، كانت مشتركة بين كل البشر، وهي مازالت كامنة على نحو رمزي في اللاوعي. ومن خلال الوقوف على رموزها يمكننا تفسير الأحلام، بل وقراءة هنات الوعي وزلات لسان، وتعبيرات الجسد اللاإرادية.
اللغة البدائية للحلم، تفسر لنا وجود أحلام مشتركة في موضوعاتها بين البشر. فمثلاً: أحلام السقوط من المرتفعات، والاحتجاز في الأماكن الضيقة، أو التيه في الأماكن المظلمة، أو التعري بين الغرباء، أو الخوف من خطر النار، التي تعتبر من أشهر الرموز البدائية، التي حظيت بالاهتمام في التحليل النفسي على نحو ما تناولها جاستون باشلار[6]. ولذلك تظل أهمية الحلم مرتبطة برموزه، كما هي مرتبطة بموضوعه، بل وحبكته سواء جاءت مفككة على هيئة صور متناثرة، أو جاءت عبر وقائع وأحداث متسقة فيما بينها. ومع ذلك فحتى الأحلام المشتركة في موضوعاتها بين البشر، تحظى بخصوصية ترتبط بالتجارب النفسية والممارسات الحياتية لحالميها. فأطفال المدارس مثلاً، قد تروادهم أحلام التأخر عن مواعيد المدرسة، أو التيه في الطريق إليها، أو نسيان شيء من مستلزماتها، كالحقيبة أو كراسة الواجب. لكن تفسير مثل هذه الأحلام يعتمد على رمزية موضوع النسيان لا النسيان نفسه. فمثلاً: نسيان التلميذ للواجب المدرسي قد يعكس معنى تعويضيًا يسقطه التلميذ على المدرس، فتجاهل الواجب المدرسي هو تجاهل للمدرس، أو نوع من العقاب له، هكذا ينتقم التلميذ من مدرسه ويتحرر من الخوف، بعمل لا يجرؤ عليه في يقظته. وقد يكون نفس الحلم مجرد حافز ينبه التلميذ إلى أهمية العناية بواجباته المدرسية، كما قد يكون تعبيرًا عن إحساس عميق بالذنب والتقصير في مجال آخر لا علاقة له بالواجب المدرسي، حيث يرى (فرويد) أن الإحساس بالذنب ينشأ في طفولة مبكرة مع المرحلة الشرجية. وعلى ما تقدم فإن رموز الأحلام ذات مستويات وطبقات متعددة، تمنحنا فرصًا لتأويلات وتفسيرات متعددة للحلم الواحد، تمامًا كما نفعل مع النص الأدبي الثري.
وعلى أية حال، فالتشابهات في موضوعات الأحلام لا تنفي ذاتيتها. نتيجة لتماهي المسافة بين الذاتي والموضوعي في الحلم. وهذا التماهي جزء مهم في تجربة الإبداع أيضًا، عندما يصبح موضوع النص مرادفًا لذات المبدع، ومن ثم يتمكن من التعبير عن ذاته في نفس الوقت الذي يعبر فيه عن موضوعه الواقعي.
مما سبق، نفهم أن الأحلام هي الممارسة الإنسانية الأقرب إلى تجربة الكتابة، وكأننا نكتب ذواتنا كل ليلة في الأحلام. وإذا كنا اعتدنا أن نحكي أحلامنا ونحاول تفسيرها، فهذا لقابليتها للحكي والتأويل، كأي تجربة واقعية معيشة. لهذا، ففكرة كتابة الأحلام ممكنة ومقبولة، ليس فقط لتوظيفها في العمل الأدبي، ولكنها يمكن أن تكون سردًا مستقلاً ومميزًا في حد ذاته، على نحو ما كتب نجيب محفوظ (أحلام فترة النقاهة) فأنتجت شكلها الخاص سواء في كثافتها ودلالتها الوامضة، أو في لغتها الرمزية المفتوحة على التجربة الإنسانية الشخصية والعامة في نفس الوقت، أو في طاقتها التخييلية المتجاوزة لحدود الواقع.
كما أن قراءة الأحلام مثل كتابتها، فهي من ناحية تنطق بتجارب إنسانية مشتركة، لكنها تبقي على الجزء الذاتي لكاتبها. وهذا الجزء الذاتي، هو الذي يعطيها قابلية التأويل المتعدد عند القراء، ويشملها بالسحر الذي قد نجده في النص الأدبي. فمثلاً، الكثير من قراء نجيب محفوظ استخدموا آلية الإسقاط على الواقع الاجتماعي لتفسير أحلام فترة النقاهة؛ ففي الحلم رقم (4) ثم من اعتبر أن شخصية الزعيم التي ظهرت في الحلم، تحيل إلى شخص جمال عبد الناصر، وهو تفسير مقبول ولكنه مباشر وضيق؛ أما الدكتور (يحي الرخاوي) الذي جمع بين خبرة عالم النفس والأديب، يدرك أن رمزية الحلم قد تمتد إلى زمن سحيق في الفكر الإنساني. فالزعيم يمكن أن يكون له بعد إنساني واسع لأسطورة البطل المنقذ، التي تتجلى في فكرة النبي، أو المهدي المنتظر، أو المسيح المخلِّص، كما يمكن وفقًا لآلية التمويه في الأحلام، أن يتماهى المسح المخلص، بالمسيخ الدجال، وفقًا للأسطورة أيضًا. أي أن الرمز قد يحمل المعنى ونقيضه، بفضل آلية التمويه التي يمارسها اللاوعي، على نحو ما رأيت في منامي، مقهى (بترو) متماهيًا مع التكية.
وهذا التركيب الخاص لسرد الأحلام، يجعله مختلفًا عن الواقعية السحرية، كون الأخيرة عملية توظيف لثراث الإنسانية الغرائبي، يغيب فيها المعنيين: الشخصي والذاتي. كما أنه يختلف عن السيريالية التي تمثل بناءًا مجردًا من أي بعد واقعي، يحمل المضامين الانفعالية والفكرية على نحو تلقائي، وخارج عن أي انشغال جمالي أو موضوعي.
أما الحلم فله سمات أكثر مرونة وتعقيدًا في نفس الوقت، حيث يلتبس بالوقائع والحقائق والأشكال المعينة، المرئية بالعين؛ لهذا قد تبدو بعض الأحلام منطقية ومتماسكة فيمكن تذكرها وحكيها، ومن ثم محاكاتها سردًا. لكن علماء النفس يعتقدون أن ما نتذكره من أحلامنا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جدًا، أي أن ما نحكيه من الحلم بعد استيقاظنا، ليس هو بالضبط ما حلمنا به، بل تداعياته، بتدخلات من الوعي، وخبرات لأحلام سابقة لنا أو لآخرين، ووقائع نكون طرفًا فيها، فضلاً مهاراتنا الخاصة في الحكي وتأويله، لهذا فحكي الحلم ممارسة إبداعية. أما كتابته، فهي إعادة إنتاج لرموزه وآلياته بشروط أدبية كاملة.
لكن عندما يصبح سرد الأحلام فنًا، نتمكن من السيطرة عليه، وإدارته وفق شروط أدبية، فلسنا في حاجة إلى أحلام النوم لنكتبها، بل يمكننا صناعة نص حلمي كاملاً عبر استنطاق اللاوعي، وتوظيف آليات إنتاج الأحلام. ولابد أن نجيب محفوظ في شيخوخته ونقاهته، لم يجلس ليتذكر كل هذا العدد من الأحلام ليكتبها، إنما هو أفاد من خبرته في استنطاق اللاوعي وتوظيف آليات الحلم، وتلك أساليب، وتقنيات، نراها في كثير من أعماله السابقة على أحلام فترة النقاهة، مكنته من اعتبار كتابة الحلم فنًا أدبيًا مستقلاً بذاته.
وسواء كانت كتابة الحلم مرجعها إلى حلم حقيقي، أو استنطاقًا يقظًا للداخل، فهي تلتزم بحرفية السرد الإبداعي، في معالجتها لآليات الحلم ولغته التي لا تظهر بوصفها معان، بل رموز وصور تنهمر في الفضاء الحُلمي الغامض، لهذا تظل ملتبسة بحيل اللاوعي من: تمويه وإبدال وتضخيم، وإنكار، وإسقاط. كما أنها مكتنزة بالتأثيرات الشعورية كالألم والخوف والحزن والنشوة. ثم يأتي الخيال الأدبي ليشمل كل هذا، وهو خيال بلا حدود. فإذا كانت لغة الأحلام تحيلنا إلى خيال بدائي كظلال تتراقص على جدران كهف، فإن ارتباطها بالتجربة الشخصية، تسمح لها بمقاربة الواقع المعيش، لتبدو مثل واقع افتراضي فائق القدرة.
كتابة الأحلام لا تحقق إشباعًا جماليًا لكاتبها فحسب، بل تفضي به إلى تجربة نفسية وروحية خاصة، على ما فيها من مواجهات مع النفس. ولأن لغة التخاطب المعتادة، يصعب عليها التعبير عن الرؤى الحلمية نظرًا لطبيعة الحلم المنفلتة من المعيارية، فإن على كاتب الأحلام أن يكتشف أدواته التعبيرية بنفسه، عندئذ نحصل على نصوص غاية في الثراء والجمال. ولا أستطيع القول بأن هذا يتحقق مع كل النصوص، فمستويات الغوص الداخلي متفاوتة في كتابة الأحلام، كما هي متفاوتة في أحلام النوم نفسها، فبعض الأحلام تكون قريبة من سطح الوعي فتطرح معناها ببساطة، وبعضها يكون عميقًا وغامضًا ومتشظيًا.
إن حق الريادة، الذي اقتنصه نجيب محفوظ عن اقتدار، ومشروعه السردي التجريبي الواسع، مترامي الأطراف، يضعنا أمام مسئولية، تفضي إلى النظر لأحلام فترة النقاهة بوصفها تجربة متفردة، ليس بالنسبة لتاريخ صاحبها فحسب، بل بالنسبة لتاريخ الأدب العربي الحديث. لقد أعطى نجيب محفوظ لسرد الأحلام حق الوجود المنفرد، بوصفه فنًا قصصيًا، جاء في زمن الرواية، ليؤكد أن ممكنات القصة القصيرة مازالت واعدة، وقادرة على خلق مسارات جديدة، حتى ليأتي سرد الأحلام، بوصفه فنًا مميزًا في لغته، وتقنياته، وأساليب سرده، فيقف جنبًا إلى جنب مع أشكال مختلفة من التعبير القصصي، كالمتتاليات القصصية، أوالبورتريهات والانفعالات التي كتبتها ناتالي ساروت، أو النصوص عابرة النوع التي دمجت النثر بالشعر، أو القصة القصيرة جدًا (الأقصوصة) التي بلغت في السنوات الأخيرة شأنًا وشيوعًا في كتابتها، متأثرة بلغة الرسائل النصية على الإنترنت والهواتف المحمولة.
أحلام (فترة النقاهة) نجحت في أن تجعل كتابة الأحلام عملاً فنيًا مستقلاً في بنيته ولغته، يحقق مستويات من التعبير أكبر مما تتيحه القصة بانهماكها في الواقع اليومي والمعاش، فلم تعد تجربة وحيدة تخص نجيب محفوظ وحده، بقدر ما هي دعوة للالتفات إلى أن كتابة الأحلام شكل سردي جديد، يقف على التخوم بين الأقصوصة في بنيتها المكثفة، والحلم في فضائه التخييلي، والشعر في فضائه اللغوي. إنها دعوة رائدة، لنكتب أحلامنا، كما كتبنا قصصنا، وقصائدنا.
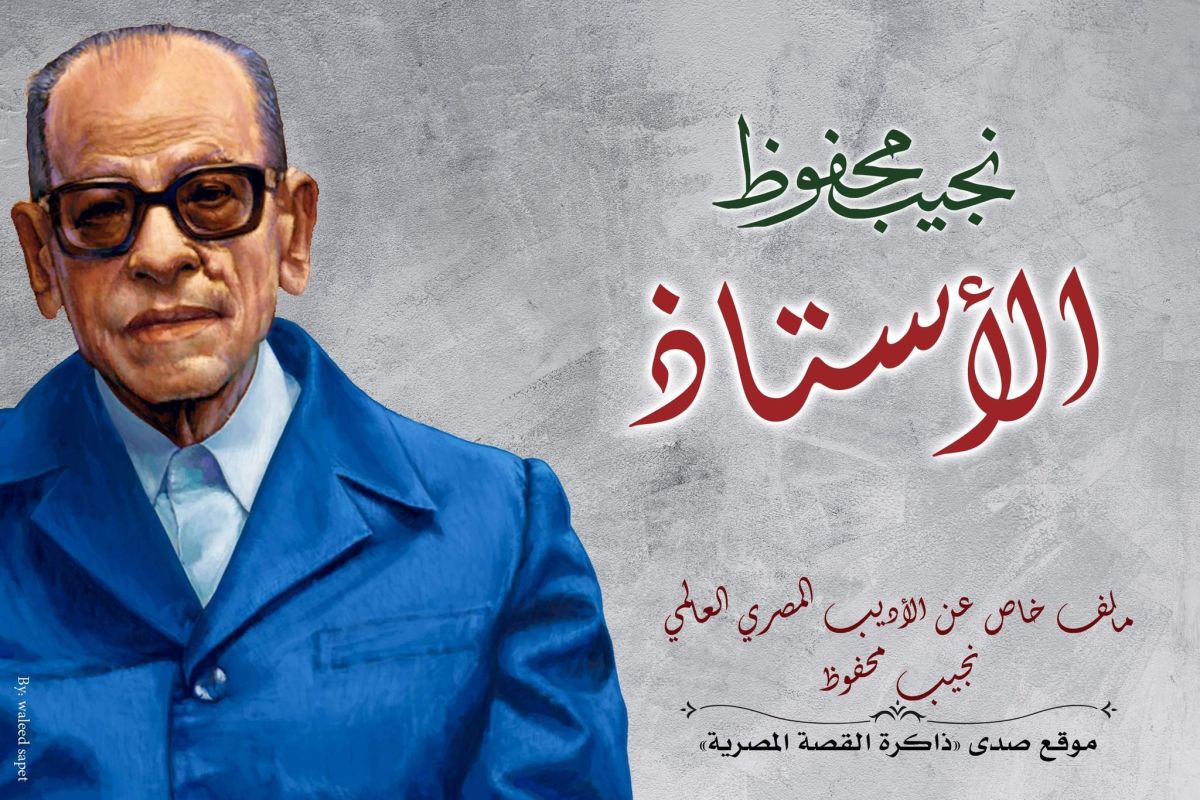
الأستاذ….” ملف خاص “عن نجيب محفوظ (2)
الجزء الثاني المحتويات أولا: فن كتابة الأحلام، تأسيس نظري. سيد الوكيل : أحلام نجيب محفوظ. د. ذكي سالم ثانيا: سينما نجيب محفوظ: ( شريف الوكيل.. أهل القمة – د. مصطفى ال…