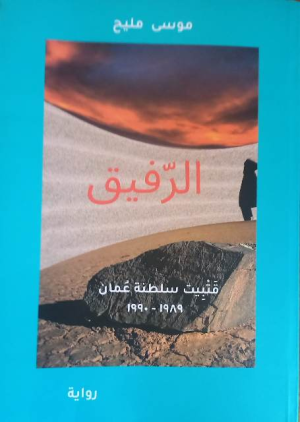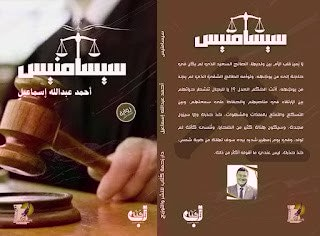يقول العلماء: “إن الزمان ينتج من حركة المكان؛ فلولا حركة الأرض ما أظلم ليل أو سطع نهار”؛ وهما صنوان فلا وجود لجرم أو حدث أو أي شيء خارج نطاقيهما؛ فهناك مكان يضمنا، وزمان يمر علينا؛ الأول بما يحدث فيه، والآخر بما يقام عليه، يقول “أوغستين”: “إن معرفة الوقت (الزمن) يعتمد على حركة الأشياء، ومن هنا لا وقت حيث لا توجد مخلوقات لقياس مروره” وعندما يتجمد المكان في عالم البرزخ، يرتفع البعد الزمني، وتتعطل حركة المئين والآلاف في معجم أهل البرزخ!
وأنا أقول: لم تعد المسافات مقياسا لتنائي المكان، لكن يبقى الحاضر سجافا بيننا وبين غابر الزمان؛ فمن منا يستطيع العودة إلى الماضي مهما انتقى خياله من آلات الزمن، أو احتاز بلده من معامل العلوم؟! ولكن أنا وأنت يمكننا الوصول إلى غاية العالم في سويعات.
وهذا يستحثنا على ألا نتغافل عن مدى تقاربهما، وبيان المفارقة فيهما؛ حيث اختلاف جذريهما، وتنوع دلالة كلٍّ في الواقع؛ المكان مكين يُنْزَعُ إلى الاستقرار عليه فهو يُعْتَلى غير خافٍ على ذي عينين، وهو أقرب إلى السكون، “والاستاتيكية” فيه بادية، أما الزمان فمولوج فيه، ولا يزال منطلقا صوب المستقبل، وهذا مدعاة للاستمرارية “والدينامكية”؛ حيث تصهل خيوله في مضمار الحاضر؛ تنشد المستقبل متخطية حاجز المكان، وقد خلف وراءه الماضي في ذمة التاريخ وذاكرته، وريثًا شرعيًّا يحفظ عنه ويروي، فالزمن في تجدد مشهود غير منكور، والمكان باقٍ على سكونه، و إذا غضب الزمن؛ رسم لوحة من الشقاء على ظاهر أعيانه، أما إذا استمرأه فتلك غرة تعلو جبينه، ولكن لا ملجأ ولا منجى من سهام التعرية؛ فكم من ديار قد غَبَرَت وعفت رسومها، وروى الزمان (التاريخ) فيها عن قوم قد بادوا؛ فتحقق فيها سنة التداول! قال تعالى: (إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ… الآية) (آل عمران: ١٤٠) ولعل هذ ما جعل أن لا مُلك (المكان) يدوم أكثر من أربعين سنة؛ فإما أن يزول الملك(المكان) عن صاحبه، وإما أن يزول عنه صاحبه، وقد اختطها القدر لبني إسرائيل منذ أن أقاموا في التيه أربعين سنة؛ ولعلها أضحت سنة في جميع الحوادث؛ ليظل التاريخ يدق ناقوس التداول والحراك الحضاري ما بُسطت أرض، وما ارتفعت سماء، وإن كان كلاهما لا يخرج عن رِبقَة الرق، بيد أن المكان مُستحَلٌّ بقانون الإحلال والفناء، أما الزمان فقائم شاهد ما بقيت الحياة، وقصارى ما يُكَاد له العبث بأحداثه.
الزمن عنصر التكوين الإنساني في مطلق المكان، ولا قيمة للمكان إلا بتقادم العهد، والاستئناس بغابر الزمان؛ فتصبح جدر الغائط- بفعل الزمن- أرقي من قصور “فينسيا” الحديثة؛ وبعض الدول التي أُعْلِنَ عن قيامها في حيز المكان تقاصر عمرها على أن يكون تربا لكثير من المتعاصرين؛ فمولد أبي يناهز ميلاد كثير من الممالك والأمصار، وأنا خطوت إلى الدنيا قبل أن تخطر بعد البلاد بسنين؛ فمهما أثبتت تلك البلاد حضورها المكاني ستظل بنية البعد الزماني هشة، لا يضرب لها بسهم في عمقها التاريخي؛ أرأيت لو عرضنا صخرة أو حفنة من تراب مصر، ومثلها من هذه الدول في بورصة الزمان (الآثار- التاريخ) فكيف يكون تقييم كلٍّ منها؟!… الصخرة هي الصخرة، ولكن عامل الزمن يعطيها قيمة لم تكن لصنوها في البلد الآخر!
وهذا ما جعل الكثيرين يتدثرون بقيمة البعد الزمني (أصول العائلات والعرقية عبر السنين) ومن أخطأته أقام سؤددا زائفا؛ فمن أفراد يتصنعون مجدا لنسب تليد يقيم لهم بين الناس الفخار، وهم من لقطاء الحي، إلى دول تسرق زمنا وصَوْلَةَ تاريخٍ ليس لهم – وهم من سقط المتاع – ليتحصل لهم المكان المكين، ولا يرفعهم ما تزيَّوا به من خَز الأمم، وما تحلت به نحورهم من جمانها، إلى أمم (اليهود) سطوا على مقادير الأمة؛ حيث يرفدون شرايين مكانهم بدماء بعض من أهلوا مع التاريخ، وهل التاريخ سوى الزمان؟!
وما هذا كله سوى مظهر(ما عليه محدثو النعمة) حضاري مُسْتَهلَك، وليس من أسباب الحضارة في شيء، لكنهم يستطيعون اختزال الزمن إذا ابتنوا حضارة أبعادها: العلم والعقل والقيم والوجدان- وليس من حجارة فيكون التقاصر والخذلان- حيث تكسبهم بعدا زمنيا ربما في مقام الآلاف، بينما غيرهم لا يزال يحبو في مقام الآحاد؛ فليس كل الطعام غذاء، فحساء الشعير يملأ البطن كما تملؤه لحوم الخراف، ولكن هيهات!
تعتمد فلسفة المكان على الزمن ووعائه التاريخي، والزمان يعلو ببعد الكيف، بينما تقاصر بالمكان البعد الكمي وحيِّز الحجوم، وهو أمر خارج عن مطلق الاعتداد به؛ فمهما كنت أضخم من أبيك فلن تكون أكبر منه بحال!، ومعظم الشعائر الدينية تقوم على البعد الزمني أولا، خلا الحج فيتفق له البعدان: الزماني والمكاني؛ فأنا لا أصلي الظهر إلا بعد الزوال، ولا أؤدي زكاتي إلا في يوم حصاده أو مرور الحول، ولكني أحج في زمان ومكان متأنيين.
وينسب التطوير في حركة المكان إلى خبرات الزمان؛ فكثير من الجمادات كالجبال أشرق عليها نور الوجود الأزلي، ووجودها – في ظاهره – فطري مثل تلك الحيوانات؛ فقد توقفت عند خبرات أسلافها الأوائل؛ فلم يطالها تطور، ولَم تُقَم لها حضارة، والذي أعطى الأهرامات بعدا أرقى هو الزمن، فضلا عما صُبَّ فيها من نشاط عقلي، وإبداع غير مسبوق أو متبوع.
وتبقى بعض الأماكن هيكلا جامدا، وفراغا متجانسا لم يتغشاه جرم، ولَم يسلكه حدث؛ لما فيه من فجوات بينية يعكسها المهجور منها غير المأهول كالصحاري الشواسع… أما الزمان ففيه صروف وتبديل وحراك لا يفتر، وعارٍ عن البينية الزمانية؛ فالتزامن من الممكن؛ فأنا الآن أكتب، وهناك ملايين تفعل مثلي على امتداد البسيطة، وقد يعتري التوارد بعضهم، أما التماكن فهو كالأبلق العقوق؛ فوجودي في بيتي الآن ينفي حتما وجودي فيما دونه، ومكان بيتي لا يكون بحال هو مكان بيتك، أو البيت البيضاوي.
المكان علم بإحداثيات ثلاث: الطول والعرض والارتفاع؛ فاقتضى التحديد المادي، وإلا كان في الفراغ المطلق، أما الزمان فعلم بذاته، يروي عنه التاريخ ويسطر؛ فهو في الأصل مسموع وسبيله الأذن، والمكان منظور وآلته البصر، لذا كان للسمع السبق في مضمار إدراك الحواس منذ بداية تكوين الخلقة في الأرحام، قال تعالى: “وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة…” الآية (المؤمنون ٧٨) ويعلق الناقد مصطفى الضبع قائلا: “إن الجنين يسمع ولا يرى، وتختزل حواسه في السمع، ثم إننا نستطيع السماع في أوضاع مختلفة” أما الرؤية فيكفي كل عين مقدار أنملة تعترض مجال رؤيتها فلا تبصر الأنملة الأخرى، ليبقى في السمع (آلة التاريخ والزمن) الاستعاضة، وفي القرآن الكريم الدليل.
وأنا أقول: لم تعد المسافات مقياسا لتنائي المكان، لكن يبقى الحاضر سجافا بيننا وبين غابر الزمان؛ فمن منا يستطيع العودة إلى الماضي مهما انتقى خياله من آلات الزمن، أو احتاز بلده من معامل العلوم؟! ولكن أنا وأنت يمكننا الوصول إلى غاية العالم في سويعات.
وهذا يستحثنا على ألا نتغافل عن مدى تقاربهما، وبيان المفارقة فيهما؛ حيث اختلاف جذريهما، وتنوع دلالة كلٍّ في الواقع؛ المكان مكين يُنْزَعُ إلى الاستقرار عليه فهو يُعْتَلى غير خافٍ على ذي عينين، وهو أقرب إلى السكون، “والاستاتيكية” فيه بادية، أما الزمان فمولوج فيه، ولا يزال منطلقا صوب المستقبل، وهذا مدعاة للاستمرارية “والدينامكية”؛ حيث تصهل خيوله في مضمار الحاضر؛ تنشد المستقبل متخطية حاجز المكان، وقد خلف وراءه الماضي في ذمة التاريخ وذاكرته، وريثًا شرعيًّا يحفظ عنه ويروي، فالزمن في تجدد مشهود غير منكور، والمكان باقٍ على سكونه، و إذا غضب الزمن؛ رسم لوحة من الشقاء على ظاهر أعيانه، أما إذا استمرأه فتلك غرة تعلو جبينه، ولكن لا ملجأ ولا منجى من سهام التعرية؛ فكم من ديار قد غَبَرَت وعفت رسومها، وروى الزمان (التاريخ) فيها عن قوم قد بادوا؛ فتحقق فيها سنة التداول! قال تعالى: (إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ… الآية) (آل عمران: ١٤٠) ولعل هذ ما جعل أن لا مُلك (المكان) يدوم أكثر من أربعين سنة؛ فإما أن يزول الملك(المكان) عن صاحبه، وإما أن يزول عنه صاحبه، وقد اختطها القدر لبني إسرائيل منذ أن أقاموا في التيه أربعين سنة؛ ولعلها أضحت سنة في جميع الحوادث؛ ليظل التاريخ يدق ناقوس التداول والحراك الحضاري ما بُسطت أرض، وما ارتفعت سماء، وإن كان كلاهما لا يخرج عن رِبقَة الرق، بيد أن المكان مُستحَلٌّ بقانون الإحلال والفناء، أما الزمان فقائم شاهد ما بقيت الحياة، وقصارى ما يُكَاد له العبث بأحداثه.
الزمن عنصر التكوين الإنساني في مطلق المكان، ولا قيمة للمكان إلا بتقادم العهد، والاستئناس بغابر الزمان؛ فتصبح جدر الغائط- بفعل الزمن- أرقي من قصور “فينسيا” الحديثة؛ وبعض الدول التي أُعْلِنَ عن قيامها في حيز المكان تقاصر عمرها على أن يكون تربا لكثير من المتعاصرين؛ فمولد أبي يناهز ميلاد كثير من الممالك والأمصار، وأنا خطوت إلى الدنيا قبل أن تخطر بعد البلاد بسنين؛ فمهما أثبتت تلك البلاد حضورها المكاني ستظل بنية البعد الزماني هشة، لا يضرب لها بسهم في عمقها التاريخي؛ أرأيت لو عرضنا صخرة أو حفنة من تراب مصر، ومثلها من هذه الدول في بورصة الزمان (الآثار- التاريخ) فكيف يكون تقييم كلٍّ منها؟!… الصخرة هي الصخرة، ولكن عامل الزمن يعطيها قيمة لم تكن لصنوها في البلد الآخر!
وهذا ما جعل الكثيرين يتدثرون بقيمة البعد الزمني (أصول العائلات والعرقية عبر السنين) ومن أخطأته أقام سؤددا زائفا؛ فمن أفراد يتصنعون مجدا لنسب تليد يقيم لهم بين الناس الفخار، وهم من لقطاء الحي، إلى دول تسرق زمنا وصَوْلَةَ تاريخٍ ليس لهم – وهم من سقط المتاع – ليتحصل لهم المكان المكين، ولا يرفعهم ما تزيَّوا به من خَز الأمم، وما تحلت به نحورهم من جمانها، إلى أمم (اليهود) سطوا على مقادير الأمة؛ حيث يرفدون شرايين مكانهم بدماء بعض من أهلوا مع التاريخ، وهل التاريخ سوى الزمان؟!
وما هذا كله سوى مظهر(ما عليه محدثو النعمة) حضاري مُسْتَهلَك، وليس من أسباب الحضارة في شيء، لكنهم يستطيعون اختزال الزمن إذا ابتنوا حضارة أبعادها: العلم والعقل والقيم والوجدان- وليس من حجارة فيكون التقاصر والخذلان- حيث تكسبهم بعدا زمنيا ربما في مقام الآلاف، بينما غيرهم لا يزال يحبو في مقام الآحاد؛ فليس كل الطعام غذاء، فحساء الشعير يملأ البطن كما تملؤه لحوم الخراف، ولكن هيهات!
تعتمد فلسفة المكان على الزمن ووعائه التاريخي، والزمان يعلو ببعد الكيف، بينما تقاصر بالمكان البعد الكمي وحيِّز الحجوم، وهو أمر خارج عن مطلق الاعتداد به؛ فمهما كنت أضخم من أبيك فلن تكون أكبر منه بحال!، ومعظم الشعائر الدينية تقوم على البعد الزمني أولا، خلا الحج فيتفق له البعدان: الزماني والمكاني؛ فأنا لا أصلي الظهر إلا بعد الزوال، ولا أؤدي زكاتي إلا في يوم حصاده أو مرور الحول، ولكني أحج في زمان ومكان متأنيين.
وينسب التطوير في حركة المكان إلى خبرات الزمان؛ فكثير من الجمادات كالجبال أشرق عليها نور الوجود الأزلي، ووجودها – في ظاهره – فطري مثل تلك الحيوانات؛ فقد توقفت عند خبرات أسلافها الأوائل؛ فلم يطالها تطور، ولَم تُقَم لها حضارة، والذي أعطى الأهرامات بعدا أرقى هو الزمن، فضلا عما صُبَّ فيها من نشاط عقلي، وإبداع غير مسبوق أو متبوع.
وتبقى بعض الأماكن هيكلا جامدا، وفراغا متجانسا لم يتغشاه جرم، ولَم يسلكه حدث؛ لما فيه من فجوات بينية يعكسها المهجور منها غير المأهول كالصحاري الشواسع… أما الزمان ففيه صروف وتبديل وحراك لا يفتر، وعارٍ عن البينية الزمانية؛ فالتزامن من الممكن؛ فأنا الآن أكتب، وهناك ملايين تفعل مثلي على امتداد البسيطة، وقد يعتري التوارد بعضهم، أما التماكن فهو كالأبلق العقوق؛ فوجودي في بيتي الآن ينفي حتما وجودي فيما دونه، ومكان بيتي لا يكون بحال هو مكان بيتك، أو البيت البيضاوي.
المكان علم بإحداثيات ثلاث: الطول والعرض والارتفاع؛ فاقتضى التحديد المادي، وإلا كان في الفراغ المطلق، أما الزمان فعلم بذاته، يروي عنه التاريخ ويسطر؛ فهو في الأصل مسموع وسبيله الأذن، والمكان منظور وآلته البصر، لذا كان للسمع السبق في مضمار إدراك الحواس منذ بداية تكوين الخلقة في الأرحام، قال تعالى: “وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة…” الآية (المؤمنون ٧٨) ويعلق الناقد مصطفى الضبع قائلا: “إن الجنين يسمع ولا يرى، وتختزل حواسه في السمع، ثم إننا نستطيع السماع في أوضاع مختلفة” أما الرؤية فيكفي كل عين مقدار أنملة تعترض مجال رؤيتها فلا تبصر الأنملة الأخرى، ليبقى في السمع (آلة التاريخ والزمن) الاستعاضة، وفي القرآن الكريم الدليل.