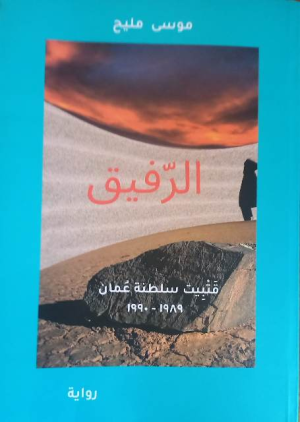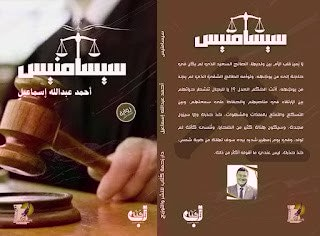بين السياسيِّ المحنّك والصحفية المثيرة، وهما بطلا القصّة، علاقةٌ إباحيّة تتخلّلها بعض العواطف الساذجة التي لا تجدي نفعاً ولا تحوّل العلاقة نحو مساراتٍ جديّة ومتوازنة، فتكون خاتمتها كما بدايتها.
هذا ملخّص رواية «الزانية» للكاتب البرازيلي باولو كويلو صاحب رواية الخيميائي التي أحدثت تحوّلاً جذريّاً في خطّ الرواية الغربيّة عندما حطّت رحالها في ناموس الصحارى الشرقيّة وجمالها وحوافر أقدام خيولها، حتّى كاد ينافس في فنّ تصوير المناخ الصحرواي فيها الكاتب الليبي إبراهيم الكوني الذي هيّأ البادية للقارئ كلوحةٍ فولوكلوريّة قديمة لها من صرامة التقاليد وقداسة الشهامة وكلمة العهد ما يضاهي حضارات التمدّن والعصر الحديث فتنةً وغموضاً واتّقاداً للحواس وانبهاراً بها، فسار المتلقّي معه في تيّار السرد حتّى وصوله إلى ذهب الحكمة الخالدة.
«الزانية» هي رواية صادمة بمفعول سلبيٍّ يعودُ على متصفّحها بالخيبة، تدلهِمّ على ليلٍ حالكٍ للرغبات الجسدية المتوحّشة، حيث يغلب صوتُ الشيطان على صوت العقل، لتكون مجلبةً للهموم والعذاب الروحي لدى البطلة ليندا وهي سيّدة في منتصف الثلاثينات متزوّجة من رجل أعمال ثريّ، وتعمل في مجال الصحافة، تزوّجت بعد قصّة حبٍّ جميلة وأنجبت ولدين، أصبحت ملمّة بمدى الرتابة التي تعيشها بعد صحوةٍ عنيفة دَهَمتها حين سمعت شاعراً يقول انّ الروتين قاتلٌ لامرئيّ ينفذ إلى الأعماق ليشلّها، فأصبح هذا الموضوع محرّكاً لتغييرٍ لمشاعرها وانجذابها لحياتها الزوجيّة، إذ جعلها تشعر بأنّها تعيش محصورةً داخل قمقمٍ ضيّق يمنع عنها الهواء والماء وأشعّة الشمس، وتتوق للرذاذ النقيّ لتنفث كبتها في أوردةِ الحياة من جديد.
تلتقي ليندا بصديقها القديم جاكوب وقد أصبح سياسيّاً مرموقاً وارتبط بأستاذة جامعيّة تدعى ماريان، فتنشأ بينهما على الفور علاقة جنسيّة، تتحوّل على أثرها إلى إنسانةٍ صاخبة ماجنة، تحترقُ بشهوة شبقة محوّلة اهتمامها إلى عريها الجسدي الذي اصطحب معه عريها الروحي فانتقصت من قدر نفسها وفقدت احترامها الذاتي، واتّقدت على جمر الإحساس بالذنب والتقصير والتهويل والتأنيب، ورغم هذه الأحاسيس المتضاربة، فهي لم ترتدع أو تتراجع، بل تمادت في فسقها وفجورها.
تنحلُّ عن ليندا قيودُ الإحترام لنفسها، فتبدأ بشنّ هجومٍ كبير على ماريانا مدفوعةً بغيرةٍ جهنميّة تصبّ بركانها في آتون عواطفها تجاه جاكوب، ليصلَ بها الأمرُ الى أن تتدبّر أمر شراء المخدّرات لتنصب فخّاً تنزلق فيه ماريانا وتخطّط للشرّ الذي لم تعتده يوماً في أعماقها بضميرٍ آمن، ولكنّها تستيقظ من رقاد نزوتها بشكلٍ فجائيّ، وتقرّر إنهاء علاقتها بعشيقها وعدم إلحاق الأذى بماريانا والعودة إلى منزلها من غير أضرار، وهنا يحضر قول الفيلسوف الصوفي جلال الدين الرومي: «الحب الذي لا يهتمُّ إلّا بالجمال الجسدي ليس حبّاً حقيقيّاً».
لقد أثار باولو كويلو في «الزانية» رغوةً عارمة من التعطّش الجسدي للحبّ المحرّم، وانغمس في وصف العلاقة الجسدية بين ليندا وجاكوب بأسلوبٍ إباحيّ أقرب منه إلى الإبتذال، ولم يراعِ حشمة الوله الإنسيابيّ الذي فاض من روايته الخيميائي وجعله قريباً من القارئ، عزيزاً عليه، ففاض واستفاض في شرح التفاصيل الدقيقة لعلاقة العاشقين، متلهّياً أو ربما متحاشياً الجانب الإبداعي من المضمون، فقد كتب جوستاف فلوبير في روايته «مدام بوفاري» عن الخيانة وعلاقة الزنا، ولكنّه لم يركّز على الوصف الحميم، بل ذكره عرضاً في مشاهد توحي للقارئ بالدرك الذي هبطت إليه الزوجة مع عشيقها، ويعكس صورة المجتمع في عصره ومدى تورّط البطلة في محرّماتها، وكذلك فعل الأديب ميخائيل نعيمة في كتابه «سبعون» الذي كتبه كسيرة ذاتيّة له، واعترف فيه بعلاقاته العاطفية، وإقامته علاقة حبٍّ مع سيّدة متزوّجة من دون تخطيطٍ مسبق، ولكنّه ركّز فيها على جانب الشعور الإنسانيّ بالحب والإلتحام الروحي قبل الجسدي، ولم يحصد بمنجل كلماته أماكن مظلمة لعلاقة الجنس، بل تورّع عن الخوض في جانبٍ سريّ احتفظ بذكرياته لنفسه.
وقد دخل سيغموند فرويد صاحب مدرسة التحليل النفسي، في نفق الخيانة الزوجية ودهاليزه، وإيثار الجنس على الفضيلة، وما تحمله العلاقة الجسدية من مخلّفات وآثار نفسيّة جامحة، وبلغَ توصيفه لأهميّة الأمر بأن أوصى تلميذه كارل غوستاف يونغ بانفعال عظيم بما يلي:
«عزيزي يونغ، عاهدني على عدم التخلي عن نظرية الجنس أبدًا، فذلك الأمر بالغ الأهمية. أترى، يجب أن نجعل منه عقيدة وحِصنًا لا يُهد»، ثمّ إصراره في تحليله على أنّ «الجنس يفسّر كلّ شيء».
وقد حاول كويلو أن يمزج بين الأدب الايروتيكي ونظرية فرويد فاجتاح كيان القارئ بروايةٍ سطحيّة استساغ فيها ابداعاته السابقة ليضع إسمه ويصنّفها الجميع على أنّها «سورة دينيّة منزّلةً» من أديبٍ كبير له من مغامرات الخيميائي ما يغني عن النقد والسبر في غور الفراغ الكبير الذي خلّفته أحداث قصّته، وقد انعقدت في تسلسل الأحداث ألسنة الحواشي الفنيّة، متيحة المساحات والمسافات لصدى الشهوات الصارخة الجامحة، ليستمدّ البصر في القصّ من خلال سراج العبثية والجنس والمجون، ربّما لظنّه بأنّه يقدّم ابداعاً أصيلاً ونصّاً عظيماً لروايةٍ تكرّرت حكمتها على مرّ الدهور.
لقد نَهَكت البطلة جسدَها بغرائزها الضالّة، فاستيقظ شرّها وحاولت أن تؤذي غيرها ولكنّها تابت في آخر المطاف، وهذه روايةٌ لا حكمة فيها ولا تبصّر أو بصيرة، ويمكن اختصارها في جملٍ قصيرة، فلا يلفت الانتباه فيها إلّا الانغماس التفصيلي في الجنس والعربدة.
باولو كويلو حاول تسليط الضوء على أهميّة التغيير في حياة الزوجين حتّى لا يلجأ أيُّ طرفٍ منهما إلى الخيانة والهرب من قوقعة الروتين والتّكرار، مفصّلاً أهميّة الجنس في إحياء الجسد، ولكنّه عجز عجزاً فادحاً عن تدوير عقدة الرواية وشواهدها وإيجاد الحلّ والوضع النهائيّ الملائم لخيانةٍ عظمى لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام من دون عقابٍ صارم على صاحبها، سواء من نفسه أو غيره أو حتّى خالقه.
نسرين بلوط / لبنان
هذا ملخّص رواية «الزانية» للكاتب البرازيلي باولو كويلو صاحب رواية الخيميائي التي أحدثت تحوّلاً جذريّاً في خطّ الرواية الغربيّة عندما حطّت رحالها في ناموس الصحارى الشرقيّة وجمالها وحوافر أقدام خيولها، حتّى كاد ينافس في فنّ تصوير المناخ الصحرواي فيها الكاتب الليبي إبراهيم الكوني الذي هيّأ البادية للقارئ كلوحةٍ فولوكلوريّة قديمة لها من صرامة التقاليد وقداسة الشهامة وكلمة العهد ما يضاهي حضارات التمدّن والعصر الحديث فتنةً وغموضاً واتّقاداً للحواس وانبهاراً بها، فسار المتلقّي معه في تيّار السرد حتّى وصوله إلى ذهب الحكمة الخالدة.
«الزانية» هي رواية صادمة بمفعول سلبيٍّ يعودُ على متصفّحها بالخيبة، تدلهِمّ على ليلٍ حالكٍ للرغبات الجسدية المتوحّشة، حيث يغلب صوتُ الشيطان على صوت العقل، لتكون مجلبةً للهموم والعذاب الروحي لدى البطلة ليندا وهي سيّدة في منتصف الثلاثينات متزوّجة من رجل أعمال ثريّ، وتعمل في مجال الصحافة، تزوّجت بعد قصّة حبٍّ جميلة وأنجبت ولدين، أصبحت ملمّة بمدى الرتابة التي تعيشها بعد صحوةٍ عنيفة دَهَمتها حين سمعت شاعراً يقول انّ الروتين قاتلٌ لامرئيّ ينفذ إلى الأعماق ليشلّها، فأصبح هذا الموضوع محرّكاً لتغييرٍ لمشاعرها وانجذابها لحياتها الزوجيّة، إذ جعلها تشعر بأنّها تعيش محصورةً داخل قمقمٍ ضيّق يمنع عنها الهواء والماء وأشعّة الشمس، وتتوق للرذاذ النقيّ لتنفث كبتها في أوردةِ الحياة من جديد.
تلتقي ليندا بصديقها القديم جاكوب وقد أصبح سياسيّاً مرموقاً وارتبط بأستاذة جامعيّة تدعى ماريان، فتنشأ بينهما على الفور علاقة جنسيّة، تتحوّل على أثرها إلى إنسانةٍ صاخبة ماجنة، تحترقُ بشهوة شبقة محوّلة اهتمامها إلى عريها الجسدي الذي اصطحب معه عريها الروحي فانتقصت من قدر نفسها وفقدت احترامها الذاتي، واتّقدت على جمر الإحساس بالذنب والتقصير والتهويل والتأنيب، ورغم هذه الأحاسيس المتضاربة، فهي لم ترتدع أو تتراجع، بل تمادت في فسقها وفجورها.
تنحلُّ عن ليندا قيودُ الإحترام لنفسها، فتبدأ بشنّ هجومٍ كبير على ماريانا مدفوعةً بغيرةٍ جهنميّة تصبّ بركانها في آتون عواطفها تجاه جاكوب، ليصلَ بها الأمرُ الى أن تتدبّر أمر شراء المخدّرات لتنصب فخّاً تنزلق فيه ماريانا وتخطّط للشرّ الذي لم تعتده يوماً في أعماقها بضميرٍ آمن، ولكنّها تستيقظ من رقاد نزوتها بشكلٍ فجائيّ، وتقرّر إنهاء علاقتها بعشيقها وعدم إلحاق الأذى بماريانا والعودة إلى منزلها من غير أضرار، وهنا يحضر قول الفيلسوف الصوفي جلال الدين الرومي: «الحب الذي لا يهتمُّ إلّا بالجمال الجسدي ليس حبّاً حقيقيّاً».
لقد أثار باولو كويلو في «الزانية» رغوةً عارمة من التعطّش الجسدي للحبّ المحرّم، وانغمس في وصف العلاقة الجسدية بين ليندا وجاكوب بأسلوبٍ إباحيّ أقرب منه إلى الإبتذال، ولم يراعِ حشمة الوله الإنسيابيّ الذي فاض من روايته الخيميائي وجعله قريباً من القارئ، عزيزاً عليه، ففاض واستفاض في شرح التفاصيل الدقيقة لعلاقة العاشقين، متلهّياً أو ربما متحاشياً الجانب الإبداعي من المضمون، فقد كتب جوستاف فلوبير في روايته «مدام بوفاري» عن الخيانة وعلاقة الزنا، ولكنّه لم يركّز على الوصف الحميم، بل ذكره عرضاً في مشاهد توحي للقارئ بالدرك الذي هبطت إليه الزوجة مع عشيقها، ويعكس صورة المجتمع في عصره ومدى تورّط البطلة في محرّماتها، وكذلك فعل الأديب ميخائيل نعيمة في كتابه «سبعون» الذي كتبه كسيرة ذاتيّة له، واعترف فيه بعلاقاته العاطفية، وإقامته علاقة حبٍّ مع سيّدة متزوّجة من دون تخطيطٍ مسبق، ولكنّه ركّز فيها على جانب الشعور الإنسانيّ بالحب والإلتحام الروحي قبل الجسدي، ولم يحصد بمنجل كلماته أماكن مظلمة لعلاقة الجنس، بل تورّع عن الخوض في جانبٍ سريّ احتفظ بذكرياته لنفسه.
وقد دخل سيغموند فرويد صاحب مدرسة التحليل النفسي، في نفق الخيانة الزوجية ودهاليزه، وإيثار الجنس على الفضيلة، وما تحمله العلاقة الجسدية من مخلّفات وآثار نفسيّة جامحة، وبلغَ توصيفه لأهميّة الأمر بأن أوصى تلميذه كارل غوستاف يونغ بانفعال عظيم بما يلي:
«عزيزي يونغ، عاهدني على عدم التخلي عن نظرية الجنس أبدًا، فذلك الأمر بالغ الأهمية. أترى، يجب أن نجعل منه عقيدة وحِصنًا لا يُهد»، ثمّ إصراره في تحليله على أنّ «الجنس يفسّر كلّ شيء».
وقد حاول كويلو أن يمزج بين الأدب الايروتيكي ونظرية فرويد فاجتاح كيان القارئ بروايةٍ سطحيّة استساغ فيها ابداعاته السابقة ليضع إسمه ويصنّفها الجميع على أنّها «سورة دينيّة منزّلةً» من أديبٍ كبير له من مغامرات الخيميائي ما يغني عن النقد والسبر في غور الفراغ الكبير الذي خلّفته أحداث قصّته، وقد انعقدت في تسلسل الأحداث ألسنة الحواشي الفنيّة، متيحة المساحات والمسافات لصدى الشهوات الصارخة الجامحة، ليستمدّ البصر في القصّ من خلال سراج العبثية والجنس والمجون، ربّما لظنّه بأنّه يقدّم ابداعاً أصيلاً ونصّاً عظيماً لروايةٍ تكرّرت حكمتها على مرّ الدهور.
لقد نَهَكت البطلة جسدَها بغرائزها الضالّة، فاستيقظ شرّها وحاولت أن تؤذي غيرها ولكنّها تابت في آخر المطاف، وهذه روايةٌ لا حكمة فيها ولا تبصّر أو بصيرة، ويمكن اختصارها في جملٍ قصيرة، فلا يلفت الانتباه فيها إلّا الانغماس التفصيلي في الجنس والعربدة.
باولو كويلو حاول تسليط الضوء على أهميّة التغيير في حياة الزوجين حتّى لا يلجأ أيُّ طرفٍ منهما إلى الخيانة والهرب من قوقعة الروتين والتّكرار، مفصّلاً أهميّة الجنس في إحياء الجسد، ولكنّه عجز عجزاً فادحاً عن تدوير عقدة الرواية وشواهدها وإيجاد الحلّ والوضع النهائيّ الملائم لخيانةٍ عظمى لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام من دون عقابٍ صارم على صاحبها، سواء من نفسه أو غيره أو حتّى خالقه.
نسرين بلوط / لبنان