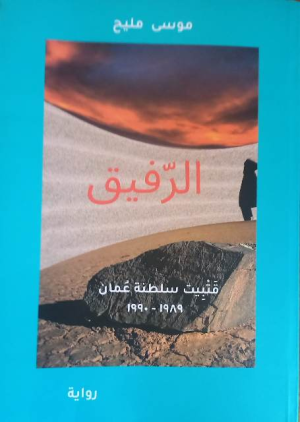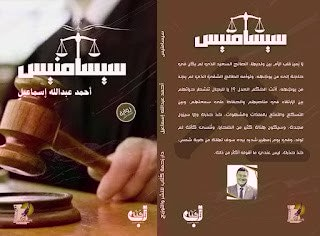ملاحظة: الورقة هي ليست عمل تطبيقي نقدي يتناول التصوير الزمكاني والشخوص داخل العمل الروائي ، لذلك ربما يكون العنوان عند البعض نقيض للمحتوى الأدبي ، لكن مثلما يقول الشاعر التونسي أنيس شوشان (العنوان يظلم أبيات أخرى من القصيدة) تظل هناك عين عاشرة للنظر للأشياء.
،، أصبح الخيال العلمي ظاهرة كونية ، وهي ظاهرة من بين أبرز تطوراتها الخروج من فلك الغرب ومن الهيمنة الإنجليزية - الأمريكية تحديداٌ ،،
مينغ وي سونغ أستاذ مشارك بكلية ويلزلي ومتخصص في أدب الخيال العلمي الصيني.
من الواضح أن الناس إذ شاهدت (شيطان) يمتص جميع ماء النهر سوف تكون حكاية أسطورية قد يتداولها الناس لأمد طويل من الزمان وقد تمتد الحكاية لجغرافيا أخرى قريبة أو بعيدة المدى ، لكن أن يشهد الناس غرق شخص داخل النهر هو لأمر طبيعي ومألوف لن تمتد حكايته للعالم الآخر. أي الآن الجميع سمع بمثلث برمودة لكن لا أحد قد يعلم أن أحمد النور الآن لدغته عقرب في أحدى قرى شمال السودان، من هذا المنطلق قد تكمن المفارقات الجمالية ما بين الواقعي والمتخيل ، ما بين دهشة الخيال (اللامعقول) وطبيعية الواقع (المعقول) والأخير هو الأقل دهشة أو بلا دهشة ممكنة.
فمن تعريفي الخاص: الخيال العلمي أو الواقعية السحرية أو الفنتازيا في الرواية هما (إبداع داخل إبداع) إذ كان تعريف الإبداع عموماً في مختلف الفنون والمجالات العملية هو إنقلاب على (الإعتيادية) أو خروج أو تمرد على (المألوف) والمتخيل خصوصاً مثل أن تصبح للقطة أجنحة وللطائر أربعة أرجل وللإنسان نصف حيواني هو (الإبداع داخل الإبداع) فالواقعي هو الإبداع والمتخيل هو إبداع سقفي (يأخذ حيزه من أعلى الهرم) ، من هنا قد نحكم ونبرر - إذ جعلنا للأمر خصوصية من حيث سودانيتنا - أن الأدب الروائي السوداني هو أدب غير مقروء (فقير) جداً لإفتقاده الإبداع الداخلي (الخيال العلمي/الواقعية السحرية/الفنتازيا) ، (الواقعية السحرية) في الرواية السودانية نفسها أخذت ذاتيتها أو خصوصيتها - التي فشلت فيها تميزاً أو حضوراً مفتوناً به - ولم تأتي أو تتأثر حتى بمحكاة (للواقعية السحرية) اللاتينية عند خورخي لويس بورخيس وماركيز وإيزابيل الليندي أو عند تصور الناقد الألماني فرانتز روه المكتشف الأول (للواقعية السحرية) 1925 ، وربما من وجهة نظري الخاصة الأخرى - بعيداً عن رواية موسم الهجرة إلى الشمال - أفضل رواية أنتجها الأدب السوداني هي رواية (مسيح دارفور) لعبد العزيز بركة ساكن لذلك وجدت قبول عالمي وفرنسي خصوصاً (بتدريسها في جامعة السوربون 2022 - 2023) لتصنيفها من ضمن أدب الواقعية السحرية أو لأخذها طابع روائي غرائبي عن الصورة (الإعتيادية) للرواية العربية والسودانية على وجه الخصوص ، ذلك من حيثيات عديدة بعضها مأخوذ من جانب أيديولوجي في أن (مسيح دارفور) أخذت قبولها من تصويرها للإنسان الأفريقي في حالة من الفقر والنزاعات والتخلف الحضاري وطرحها لقضية (دارفور) إنشغال العالم.. ولعل هذا ما يحتاجه الإنسان الغربي (النخبوي السياسي) الذي بالمقابل يرفض أن يدرس رواية مثل (موسم الهجرة للشمال) للطيب صالح الذي جعل من هذه الرواية على وجه التحديد صورة موازية للحالة ((البيولوجية الفكرية)) ما بين ماهيتها عند الإنسان الأفريقي والإنسان الغربي (فهي حرب باردة أو ثورة مضادة خاضها الطيب صالح ضد الغرب بمعرفة كبيرة تخلو من الإنحياز المكاني والإنساني) وفاض فيها ادورد سعيد في كتابه (الاستشراق) الذي عرى فيه ((العقلية الإستعمارية)) للغرب ، كذلك هناك رواية (وحش القلزم) لعماد البليك - التي لم تحظي بإهتمام واسع يستحقها رغم أنها حققت الفوز بجائزة أطلس (أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي) - والفوز من المؤكد هو ليس بمعيار مطلق للتميُز - فهي تصنف من أدب الخيال العلمي وتصنف الرواية الوحيدة الموجودة في المكتبة الأدبية السودانية من هذا الجنس الأدبي بين أدب الرواية ، رغم أني في الحقيقة لم أقراء هذه الرواية لأحكم عليها إحكام شخصي لكن قرأت دراسة نقدية لها تتحدث عن أن الكاتب أصاب الرواية بمقتل في جزئيات عديدة مال فيها للواقعية التي أقحمها في جزئيات لا داعي لتداعيها أو لم تكن تتماشى مع مجريات الفكرة العامة للرواية المصنفة كأدب خيال علمي ، ولعل هذا ما يجعلني أسميها محاولة أو محكاة لصورة أدب الخيال العلمي الشائع والمتفرد فيه الغرب.
لكل ذلك من بين محاور عديدة معيبة من بينها إفتقار الرواية السودانية للمنولوج وطغيان المباشرة بين السرد واللغة الشاعرية التي تعبر عن إنعكاس لحالة شاعر ((فاشل)) يبرر ((لفشله)) عبر الرواية ، هو ما يعيب الرواية السودانية التي لم تخرج من نطاق (المحلية) من حيث إفتقارها لم أشرنا له وللخيال عامة موضع نقاشنا الآن ، فالواقعية الغارقة فيها الرواية السودانية لن ترغم القارئ الآخر بالجذب أو الإنتباه ، خصوصاً الرواية التي تغلب عليها (العامية السودانية) ، لكنها ربما ترغم القارئ المحلي بشدة لأنها تنسخ أو تمثل واقعه اليومي وفلكلوره أو تراثه وثقافته وتاريخه القريب البعيد فيجد فيها نفسه متعايشاً مع كلماتها بشغف أو رؤية أو إحساس بالوجود الذاتي بينها ، ذلك بعكس القارئ الآخر الذي يحس فيها (بالإنحباس) فيتعايش معها قسراً دون جماليات أو (لذة) قد يستشعرها معها ، من حيث خصوصيتها ونمطيتها أو واقعيتها المبتذلة ، واقعيتها التي تخلو من حيز الوجود ((الفكري)) الذي يجعلك ((تفكر)) وتتسأل!؟ فالأدب الذي لا يجعلك ((تفكر)) أو تتسأل هو أدب أجوف لا يخدم الإنسانية في حاضرها الآني والمستقبلي بشيء سوى الأثارة الفانية بعد اللحظة الاطلاعية.. وفي ذلك قد ((نفكر)) ما الذي ميز رواية مثل (مئة عام من العزلة) لماركيز!؟
الحاضر الآن وسط التقدم العلمي وتوسع الرأسمالية العالمية لا يحتاج للواقعية إذ نظرنا للآداب كأداة تقود للتطور الحضاري - أداة غير معترف بها في العالم الثالث المتخلف - إنما هو يحتاج للتمدد العلمي لذلك تظل الرواية ذات الخيال العلمي والفنتازي هي الرواية التي تجد إنتشارها وسط القراء من العالم الأوروبي الصناعي ، كالسيريالية والتجريدية في الفن التشكيلي تأخذ حيزاً أكبر عند المتذوق أو المتلقي العالمي والغربي خصوصاً والفرنسي (المثقف العارف والمهتم) على وجه التحديد.. وكالسينماء الغربية التي أصبحت مؤخراً تميل لأخذ قصصها من أدب الخيال العلمي مثل فلم أنا أسطورة (I Am legend) الماخؤذ من رواية (أنا أسطورة) للمؤلف الأمريكي ريتشارد ماثيسون وهو ما مثل فيه دور بطل الفلم الممثل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية (ويل اسميث) الذي حاول أن يخلق صورة موازية لصورة الإنسان الأبيض المهتم بعلم الفيروسات المستخدمة كأسلحة بيولوجية.
أم إذا أجبنا عن تميز (مئة عام من العزلة) هي تميزت من بين مميزات محاورها العديدة عن كونها رواية إستشراقية وغرائبية ولدت أحداثها في عالم خيالي أسماه الكاتب (ماكوندو).
كذلك إذ أخذنا نموذج آخر وتسألنا: في (مزرعة الحيوان) لجورج أورويل الرواية الدستوبية هل إذ حافظ الكاتب على ذات المضمون أو فكرة الرواية وحل من بدل الشخوص (الحيوانات) مثل ميجر العجوز ونابليون وسنوبول.. أبطال الرواية مكانهما (الإنسان) هل سوف يحدث بها صوت صارخ مسموع للعالم!؟
من المؤكد سوف تكون رواية أكثر من كونها عادية قد ترغم النقاد على قول أنها كان يفضل أن تكتب كمقال سياسي في صحيفة الصنداي تايمز أو ذي إندبندنت أو ديلي تلغراف.. فمن هنا ربما سميت الكتابة ((بالكتابة الإبداعية)) لكون الخيال محور أساسي من الإبداع والمقال كجنس أدبي هو أقالها إبداعاً من بين الأجناس الأدبية الأخرى لواقعيته والمباشرة فيه.
لكن فوق كل ذلك قد نجد المبرر في أن الإنسان هو ابن بيئته، اي ((المكان)) تحديداً للكاتب يمثل مادته الخام في ((الكتابة الإبداعية)) ، فالإنسان الغربي لم يعش وسط فقر مدقع أو مجاعة أو حروب دامية أو تردي في الأوضاع الصحية والتعليمية.. لذا من الطبيعي أن تجده يستخدم المخيلة كمادة خام لصناعة محتواه الأدبي ، والعكس عند الإنسان من العالم الثالث (العربي/الأفريقي).
،، أصبح الخيال العلمي ظاهرة كونية ، وهي ظاهرة من بين أبرز تطوراتها الخروج من فلك الغرب ومن الهيمنة الإنجليزية - الأمريكية تحديداٌ ،،
مينغ وي سونغ أستاذ مشارك بكلية ويلزلي ومتخصص في أدب الخيال العلمي الصيني.
من الواضح أن الناس إذ شاهدت (شيطان) يمتص جميع ماء النهر سوف تكون حكاية أسطورية قد يتداولها الناس لأمد طويل من الزمان وقد تمتد الحكاية لجغرافيا أخرى قريبة أو بعيدة المدى ، لكن أن يشهد الناس غرق شخص داخل النهر هو لأمر طبيعي ومألوف لن تمتد حكايته للعالم الآخر. أي الآن الجميع سمع بمثلث برمودة لكن لا أحد قد يعلم أن أحمد النور الآن لدغته عقرب في أحدى قرى شمال السودان، من هذا المنطلق قد تكمن المفارقات الجمالية ما بين الواقعي والمتخيل ، ما بين دهشة الخيال (اللامعقول) وطبيعية الواقع (المعقول) والأخير هو الأقل دهشة أو بلا دهشة ممكنة.
فمن تعريفي الخاص: الخيال العلمي أو الواقعية السحرية أو الفنتازيا في الرواية هما (إبداع داخل إبداع) إذ كان تعريف الإبداع عموماً في مختلف الفنون والمجالات العملية هو إنقلاب على (الإعتيادية) أو خروج أو تمرد على (المألوف) والمتخيل خصوصاً مثل أن تصبح للقطة أجنحة وللطائر أربعة أرجل وللإنسان نصف حيواني هو (الإبداع داخل الإبداع) فالواقعي هو الإبداع والمتخيل هو إبداع سقفي (يأخذ حيزه من أعلى الهرم) ، من هنا قد نحكم ونبرر - إذ جعلنا للأمر خصوصية من حيث سودانيتنا - أن الأدب الروائي السوداني هو أدب غير مقروء (فقير) جداً لإفتقاده الإبداع الداخلي (الخيال العلمي/الواقعية السحرية/الفنتازيا) ، (الواقعية السحرية) في الرواية السودانية نفسها أخذت ذاتيتها أو خصوصيتها - التي فشلت فيها تميزاً أو حضوراً مفتوناً به - ولم تأتي أو تتأثر حتى بمحكاة (للواقعية السحرية) اللاتينية عند خورخي لويس بورخيس وماركيز وإيزابيل الليندي أو عند تصور الناقد الألماني فرانتز روه المكتشف الأول (للواقعية السحرية) 1925 ، وربما من وجهة نظري الخاصة الأخرى - بعيداً عن رواية موسم الهجرة إلى الشمال - أفضل رواية أنتجها الأدب السوداني هي رواية (مسيح دارفور) لعبد العزيز بركة ساكن لذلك وجدت قبول عالمي وفرنسي خصوصاً (بتدريسها في جامعة السوربون 2022 - 2023) لتصنيفها من ضمن أدب الواقعية السحرية أو لأخذها طابع روائي غرائبي عن الصورة (الإعتيادية) للرواية العربية والسودانية على وجه الخصوص ، ذلك من حيثيات عديدة بعضها مأخوذ من جانب أيديولوجي في أن (مسيح دارفور) أخذت قبولها من تصويرها للإنسان الأفريقي في حالة من الفقر والنزاعات والتخلف الحضاري وطرحها لقضية (دارفور) إنشغال العالم.. ولعل هذا ما يحتاجه الإنسان الغربي (النخبوي السياسي) الذي بالمقابل يرفض أن يدرس رواية مثل (موسم الهجرة للشمال) للطيب صالح الذي جعل من هذه الرواية على وجه التحديد صورة موازية للحالة ((البيولوجية الفكرية)) ما بين ماهيتها عند الإنسان الأفريقي والإنسان الغربي (فهي حرب باردة أو ثورة مضادة خاضها الطيب صالح ضد الغرب بمعرفة كبيرة تخلو من الإنحياز المكاني والإنساني) وفاض فيها ادورد سعيد في كتابه (الاستشراق) الذي عرى فيه ((العقلية الإستعمارية)) للغرب ، كذلك هناك رواية (وحش القلزم) لعماد البليك - التي لم تحظي بإهتمام واسع يستحقها رغم أنها حققت الفوز بجائزة أطلس (أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي) - والفوز من المؤكد هو ليس بمعيار مطلق للتميُز - فهي تصنف من أدب الخيال العلمي وتصنف الرواية الوحيدة الموجودة في المكتبة الأدبية السودانية من هذا الجنس الأدبي بين أدب الرواية ، رغم أني في الحقيقة لم أقراء هذه الرواية لأحكم عليها إحكام شخصي لكن قرأت دراسة نقدية لها تتحدث عن أن الكاتب أصاب الرواية بمقتل في جزئيات عديدة مال فيها للواقعية التي أقحمها في جزئيات لا داعي لتداعيها أو لم تكن تتماشى مع مجريات الفكرة العامة للرواية المصنفة كأدب خيال علمي ، ولعل هذا ما يجعلني أسميها محاولة أو محكاة لصورة أدب الخيال العلمي الشائع والمتفرد فيه الغرب.
لكل ذلك من بين محاور عديدة معيبة من بينها إفتقار الرواية السودانية للمنولوج وطغيان المباشرة بين السرد واللغة الشاعرية التي تعبر عن إنعكاس لحالة شاعر ((فاشل)) يبرر ((لفشله)) عبر الرواية ، هو ما يعيب الرواية السودانية التي لم تخرج من نطاق (المحلية) من حيث إفتقارها لم أشرنا له وللخيال عامة موضع نقاشنا الآن ، فالواقعية الغارقة فيها الرواية السودانية لن ترغم القارئ الآخر بالجذب أو الإنتباه ، خصوصاً الرواية التي تغلب عليها (العامية السودانية) ، لكنها ربما ترغم القارئ المحلي بشدة لأنها تنسخ أو تمثل واقعه اليومي وفلكلوره أو تراثه وثقافته وتاريخه القريب البعيد فيجد فيها نفسه متعايشاً مع كلماتها بشغف أو رؤية أو إحساس بالوجود الذاتي بينها ، ذلك بعكس القارئ الآخر الذي يحس فيها (بالإنحباس) فيتعايش معها قسراً دون جماليات أو (لذة) قد يستشعرها معها ، من حيث خصوصيتها ونمطيتها أو واقعيتها المبتذلة ، واقعيتها التي تخلو من حيز الوجود ((الفكري)) الذي يجعلك ((تفكر)) وتتسأل!؟ فالأدب الذي لا يجعلك ((تفكر)) أو تتسأل هو أدب أجوف لا يخدم الإنسانية في حاضرها الآني والمستقبلي بشيء سوى الأثارة الفانية بعد اللحظة الاطلاعية.. وفي ذلك قد ((نفكر)) ما الذي ميز رواية مثل (مئة عام من العزلة) لماركيز!؟
الحاضر الآن وسط التقدم العلمي وتوسع الرأسمالية العالمية لا يحتاج للواقعية إذ نظرنا للآداب كأداة تقود للتطور الحضاري - أداة غير معترف بها في العالم الثالث المتخلف - إنما هو يحتاج للتمدد العلمي لذلك تظل الرواية ذات الخيال العلمي والفنتازي هي الرواية التي تجد إنتشارها وسط القراء من العالم الأوروبي الصناعي ، كالسيريالية والتجريدية في الفن التشكيلي تأخذ حيزاً أكبر عند المتذوق أو المتلقي العالمي والغربي خصوصاً والفرنسي (المثقف العارف والمهتم) على وجه التحديد.. وكالسينماء الغربية التي أصبحت مؤخراً تميل لأخذ قصصها من أدب الخيال العلمي مثل فلم أنا أسطورة (I Am legend) الماخؤذ من رواية (أنا أسطورة) للمؤلف الأمريكي ريتشارد ماثيسون وهو ما مثل فيه دور بطل الفلم الممثل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية (ويل اسميث) الذي حاول أن يخلق صورة موازية لصورة الإنسان الأبيض المهتم بعلم الفيروسات المستخدمة كأسلحة بيولوجية.
أم إذا أجبنا عن تميز (مئة عام من العزلة) هي تميزت من بين مميزات محاورها العديدة عن كونها رواية إستشراقية وغرائبية ولدت أحداثها في عالم خيالي أسماه الكاتب (ماكوندو).
كذلك إذ أخذنا نموذج آخر وتسألنا: في (مزرعة الحيوان) لجورج أورويل الرواية الدستوبية هل إذ حافظ الكاتب على ذات المضمون أو فكرة الرواية وحل من بدل الشخوص (الحيوانات) مثل ميجر العجوز ونابليون وسنوبول.. أبطال الرواية مكانهما (الإنسان) هل سوف يحدث بها صوت صارخ مسموع للعالم!؟
من المؤكد سوف تكون رواية أكثر من كونها عادية قد ترغم النقاد على قول أنها كان يفضل أن تكتب كمقال سياسي في صحيفة الصنداي تايمز أو ذي إندبندنت أو ديلي تلغراف.. فمن هنا ربما سميت الكتابة ((بالكتابة الإبداعية)) لكون الخيال محور أساسي من الإبداع والمقال كجنس أدبي هو أقالها إبداعاً من بين الأجناس الأدبية الأخرى لواقعيته والمباشرة فيه.
لكن فوق كل ذلك قد نجد المبرر في أن الإنسان هو ابن بيئته، اي ((المكان)) تحديداً للكاتب يمثل مادته الخام في ((الكتابة الإبداعية)) ، فالإنسان الغربي لم يعش وسط فقر مدقع أو مجاعة أو حروب دامية أو تردي في الأوضاع الصحية والتعليمية.. لذا من الطبيعي أن تجده يستخدم المخيلة كمادة خام لصناعة محتواه الأدبي ، والعكس عند الإنسان من العالم الثالث (العربي/الأفريقي).