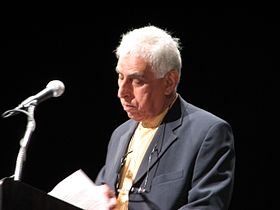سعدي يوسف ثالث ثلاثة ممن أعطوا للشعر العربي في العصر الحديث دفَقا، ونقلوه من المحلية إلى العالمية، إلى جانب درويش وأدونيس، على اختلاف تجاربهم الإبداعية والفكرية. مسار سعدي، وتجربته يتميزان عن سابقَيه. يطفح شعره بثراء تاريخ عريق، من أرض أعطت للبشرية في ملحمة جلجاميش أحد أهم المراجع حول إشكالية الوجود والخلود ، وللعربية شاعرها المميز، المتنبي، وللحضارة الإسلامية هاماتها الكبيرة في ضروب المعرفة، وللغة العربية قواعدها، ما بين مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، و للفكر توهجه في مناظرات أهل النظر وأصحاب الأثر، بلا تكفير ولا تخوين. تعيش قرية الخصيب، حيث رأى سعدي النور، من أعمال البصرة، في وجدانه، إذ يلتقى النهران، كما تلتقى روافد عدة في تجربة سعدي. وتظل القضايا الوجودية الكبرى التي طرحتها ملحمة جلجاميش حاضرة في شعره، وشَمم المتنبي ساريا في نسغه، والتمرد غالبا على طبعه، كما لو أنه قرمطي قديم، في لبوس شيوعي حديث. لا يستهويه أي شيء في زمن غلبت فيه “الواقعية”، وانهارت الأحلام، فظل الشيوعيَ الأخير في زمن ترنحت فيه الشيوعية. انتكس الحلم العربي، ولم ينتكس إباؤه. كان حيث كان وهجُه، في الجزائر، في الستينيات، بسيدي بلعباس حيث عاش لست سنين، ثم عاد إلى باتنة لثلاث سنوات، وكان في بيروت مع الفدائيين أثناء الحصار. ينطلق من الإنسان، كي يكون العربي كونيا، ومن الكونية التي لا تزري بالثقافة العربية. ينفر من عناصر لم تتآلف كي تدخل حِمى الحداثة فبقيت نشازا. يثور لا عن قِلى، بل عن أسى.
كان الشعر عنده طبعا، يمتحُه من فيض حياته وثراء تجربته، وحساسيته الجياشة حد الإفراط. يثور لأي نأمة، ويبتهج لأي عارض. كما طفل. كان شاعرا في حياته، وكانت حياته شعرا.. ظل طفلا، وليس الشاعر إلا من يظل وفيا للطفولة، كما يقول الشاعر ريلكيه، يستدرُّها ويغترف من مَعينها.
عرفت سعدي الشاعر أسوة بشريحة من جيلي، قارئا، وعرفت الإنسان فيما تأتّى من مصادفات. كان ضيفا على المركز الثقافي الفرنسي بمكناس خريف 2006 وأنا حينها وال بها، فحضرت إنشاده. دعوته ضيفا لعشاء مع ثلة من مثقفي مكناس في رياض بالمدينة العتيقة، واحتبينا الأرض في جلسة إمتاع و مؤانسة.. تحلل يوسف سعدي من عِذاره، ذلك الذي يفرضه لقاء منظم، وأخذ ينشد أشعارا للمتنبي . ذُهلت، وكنت أحسَبه ألقى التراث ظِهْريا. كنت أمام حالة فريدة، تقتل الأب، كما يقول بذلك فرويد، ولكن لا تقطع حبل النسب معه. أنقل ما كتبه في يومياته إذ حل بمكناس :
“وكان المساء في أوائله ، رأيت الشابّات والشبّـان منطلقين في الشوارع والحدائق وهو مشهدٌ صرنا نفتقده في كثيرٍ من المدن العربية، كما لمحتُ ، للمرة الأولى ، أسوار المدينة العتيقة ، عاصمة (السلطان) مولاي اسماعيل … شمس الغروب على الأسوار ، والمنارة الراسخة تشقّ طريقها الدائمة نحو السماء . ما ذا أقول؟ كلّــما جئتُ واحدةً من عواصمنا العربيةِ صلَّيتُ :
“ها أنتِ ذي !/ أنتِ ما زلتِ حاضرةً ( مثلَما كنتِ في كتبِ الجِلْـدِ مخطوطةً/ أو مُـرَنّـحـةً في الأغاني ) /السلامُ عليكِ /…السلامُ على من رأى في خرائطِكِ الـحُلـمَ / واستافَ في خلْـجةٍ من هوائكِ والماءِ ذاكَ الشــميمَ / الـمُـضَـوَّعَ من جـنّـةٍ ؛”
جال في أرجاء مكناس، بمآثرها و رياضاتها وحداقها، ووقف على بابها المعروف بالمنصور، فكأنه البحترى يتقرّى ديوان كسرى، كما ورد في يومياته. ثم نزل إلى سراديب سجنها الرهيب، حبس قارة. كتب عني ما لا أجرؤ نقله، تقديرا وعرفانا وعفة.
عاد سعدي لمكناس سنة 2008، وقر قرار سعدي، من خلال تلك الومضة التي أتاحتها له مدينة مكناس، أن يستقر بها. غادر المغرب وهو عزمٌ، أن يقيم بمكناس. استهوته المدينة، وأرادها مستقرا له لما تبقى من حياته. ولكن الرياح جرت بما لا تشتهيه السفن.
تحللت من أي مسؤولية في الدولة، في ديسمبر 2010، ولم أسلم من حملات وتخرصات، وإذا أنا أجد في غمرة ذلك، في جريدة القدس، بتاريخ 30 ديسمبر قصيدة بعنوان “مديح إلى مؤرخ مغربي” مشفوعة باسمي.
يُشرِّح سعدي المغرب ويَشرحه، في هذه القصيدة، من مخزن يملؤه الكادحون، وغرق في ثبج البحر يهيء إلى بزوغ نسر من الريف، ومراكش التي تحيل إلى زمن المجد، وقد جمعت أطراف بلاد المغرب، وهي زهرة طينية الأوراق، إحالة إلى لون أسوارها، وتعلق الشاعر بعبقها، والانكسار الذي هو انكسار جماعي، وأمل قرطبة، في هذا المقطع المُعبر :
“أيّان يأتينا زمان النظرة الأولى/ وأيّان تُرانا قرطبة ؟ / نحن خلف العربة/ قد تعلقنا، وعُلقنا، قناديل/ ولكن من زجاج “البلد/المخزن” حيث المأدبة/ حلقة من رؤساء البدو/ في خان على النهر/ سكارى، يحكمون الساعة المنقلبة.”
قرأت لسعدي قصيدة، نشرتها جريدة القدس في مايو 2011 بعنوان “أي ربيع عربي” لا يتوسم فيه أي عنفوان، في شعر تقريري لا يرقى، من حيث النظم، لوهج سعدي، ولكنه يطفح بقوة الحدس : “الدجاج وحده / سيقول : ربيع عربي. (..) أي ربيع هذا ؟ / نعرف تماما أن / أمرا صدر من دائرة / أمريكية معينة.”
أثارت قصيدته تلك نقاشا في المغرب، وكان من علّق عليها، الشاعر صلاح بوسريف فيما كتبه في جريدة أخبار اليوم 13 مايو 2011، وهي الجريدة التي توقفت، وكانت الظل الذي يتفيؤه مَن هم خارج السرب : “العزيز سعدي، هذه الثورات، حتى إذا حدث وسُرقت، فثمة أمور كثيرة سيجري تبديلها. ستتغير مفاهيمنا للأشياء ونظرتنا لها، وكذلك مجال القيم. . (..) مواطنون بسطاء (..) أشهروا أصواتهم في وجه أنظمة كانت من أسباب ما نحن فيه من هزائم، بتواطؤ الغرب.” ويضيف بوسريف في هذا النقاش الذي أثاره سعدي : “لست يائسا، فيما يجري. هو لحظة تاريخية علينا أن ننظر إليها بما يعتمل فيها من فصول السنة الكاملة، وليس باختزالها في فصل دون آخر”.
تحضرني هذه اللُّمع التي لا ترقى لتقييم تجربة شاعر من الفحول، كما كان يقال قديما، أريدها ذكرى ووفاء لشاعر كبير وإنسان يخفي ظاهره ما يموج في باطنه من دماثة وحساسية مفرطة.. يخلف برحيله فراغا مهولا. وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر.
كان الشعر عنده طبعا، يمتحُه من فيض حياته وثراء تجربته، وحساسيته الجياشة حد الإفراط. يثور لأي نأمة، ويبتهج لأي عارض. كما طفل. كان شاعرا في حياته، وكانت حياته شعرا.. ظل طفلا، وليس الشاعر إلا من يظل وفيا للطفولة، كما يقول الشاعر ريلكيه، يستدرُّها ويغترف من مَعينها.
عرفت سعدي الشاعر أسوة بشريحة من جيلي، قارئا، وعرفت الإنسان فيما تأتّى من مصادفات. كان ضيفا على المركز الثقافي الفرنسي بمكناس خريف 2006 وأنا حينها وال بها، فحضرت إنشاده. دعوته ضيفا لعشاء مع ثلة من مثقفي مكناس في رياض بالمدينة العتيقة، واحتبينا الأرض في جلسة إمتاع و مؤانسة.. تحلل يوسف سعدي من عِذاره، ذلك الذي يفرضه لقاء منظم، وأخذ ينشد أشعارا للمتنبي . ذُهلت، وكنت أحسَبه ألقى التراث ظِهْريا. كنت أمام حالة فريدة، تقتل الأب، كما يقول بذلك فرويد، ولكن لا تقطع حبل النسب معه. أنقل ما كتبه في يومياته إذ حل بمكناس :
“وكان المساء في أوائله ، رأيت الشابّات والشبّـان منطلقين في الشوارع والحدائق وهو مشهدٌ صرنا نفتقده في كثيرٍ من المدن العربية، كما لمحتُ ، للمرة الأولى ، أسوار المدينة العتيقة ، عاصمة (السلطان) مولاي اسماعيل … شمس الغروب على الأسوار ، والمنارة الراسخة تشقّ طريقها الدائمة نحو السماء . ما ذا أقول؟ كلّــما جئتُ واحدةً من عواصمنا العربيةِ صلَّيتُ :
“ها أنتِ ذي !/ أنتِ ما زلتِ حاضرةً ( مثلَما كنتِ في كتبِ الجِلْـدِ مخطوطةً/ أو مُـرَنّـحـةً في الأغاني ) /السلامُ عليكِ /…السلامُ على من رأى في خرائطِكِ الـحُلـمَ / واستافَ في خلْـجةٍ من هوائكِ والماءِ ذاكَ الشــميمَ / الـمُـضَـوَّعَ من جـنّـةٍ ؛”
جال في أرجاء مكناس، بمآثرها و رياضاتها وحداقها، ووقف على بابها المعروف بالمنصور، فكأنه البحترى يتقرّى ديوان كسرى، كما ورد في يومياته. ثم نزل إلى سراديب سجنها الرهيب، حبس قارة. كتب عني ما لا أجرؤ نقله، تقديرا وعرفانا وعفة.
عاد سعدي لمكناس سنة 2008، وقر قرار سعدي، من خلال تلك الومضة التي أتاحتها له مدينة مكناس، أن يستقر بها. غادر المغرب وهو عزمٌ، أن يقيم بمكناس. استهوته المدينة، وأرادها مستقرا له لما تبقى من حياته. ولكن الرياح جرت بما لا تشتهيه السفن.
تحللت من أي مسؤولية في الدولة، في ديسمبر 2010، ولم أسلم من حملات وتخرصات، وإذا أنا أجد في غمرة ذلك، في جريدة القدس، بتاريخ 30 ديسمبر قصيدة بعنوان “مديح إلى مؤرخ مغربي” مشفوعة باسمي.
يُشرِّح سعدي المغرب ويَشرحه، في هذه القصيدة، من مخزن يملؤه الكادحون، وغرق في ثبج البحر يهيء إلى بزوغ نسر من الريف، ومراكش التي تحيل إلى زمن المجد، وقد جمعت أطراف بلاد المغرب، وهي زهرة طينية الأوراق، إحالة إلى لون أسوارها، وتعلق الشاعر بعبقها، والانكسار الذي هو انكسار جماعي، وأمل قرطبة، في هذا المقطع المُعبر :
“أيّان يأتينا زمان النظرة الأولى/ وأيّان تُرانا قرطبة ؟ / نحن خلف العربة/ قد تعلقنا، وعُلقنا، قناديل/ ولكن من زجاج “البلد/المخزن” حيث المأدبة/ حلقة من رؤساء البدو/ في خان على النهر/ سكارى، يحكمون الساعة المنقلبة.”
قرأت لسعدي قصيدة، نشرتها جريدة القدس في مايو 2011 بعنوان “أي ربيع عربي” لا يتوسم فيه أي عنفوان، في شعر تقريري لا يرقى، من حيث النظم، لوهج سعدي، ولكنه يطفح بقوة الحدس : “الدجاج وحده / سيقول : ربيع عربي. (..) أي ربيع هذا ؟ / نعرف تماما أن / أمرا صدر من دائرة / أمريكية معينة.”
أثارت قصيدته تلك نقاشا في المغرب، وكان من علّق عليها، الشاعر صلاح بوسريف فيما كتبه في جريدة أخبار اليوم 13 مايو 2011، وهي الجريدة التي توقفت، وكانت الظل الذي يتفيؤه مَن هم خارج السرب : “العزيز سعدي، هذه الثورات، حتى إذا حدث وسُرقت، فثمة أمور كثيرة سيجري تبديلها. ستتغير مفاهيمنا للأشياء ونظرتنا لها، وكذلك مجال القيم. . (..) مواطنون بسطاء (..) أشهروا أصواتهم في وجه أنظمة كانت من أسباب ما نحن فيه من هزائم، بتواطؤ الغرب.” ويضيف بوسريف في هذا النقاش الذي أثاره سعدي : “لست يائسا، فيما يجري. هو لحظة تاريخية علينا أن ننظر إليها بما يعتمل فيها من فصول السنة الكاملة، وليس باختزالها في فصل دون آخر”.
تحضرني هذه اللُّمع التي لا ترقى لتقييم تجربة شاعر من الفحول، كما كان يقال قديما، أريدها ذكرى ووفاء لشاعر كبير وإنسان يخفي ظاهره ما يموج في باطنه من دماثة وحساسية مفرطة.. يخلف برحيله فراغا مهولا. وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر.