عندما غادرتُ ثكنات الهايكستيب ظهر ذلك اليوم، لم أتصوّر أنّنس سأعود إليها قبل انتهاء إجازتي الأسبوعية، لم تمض منها سوى يضع ساعات، حتّى اُلغيت فجأة في المساء. صدرت الأوامر من القيادة بضرورة التوجّه إلى وحدتي الساعة ستمائة صباحَا. تأزّم الموقف على الحدود، أهلي لم يصدّقوا حين أدركوا أن الحكاية جد، بكوا، أردتُ أن أقول لهم لم ألتحق بالكليّة الحربيّة لأتبغدد بالبدلة الكاكي بالنجمتين، لكن الطبيب لا يضع يده على الجرح مباشرة. هو يقترب منه رويدًا رويدًا، يدور حوله دورة، دورتين … ثلاث، حتى يشعر الجريح أن حركة يده عاديّة، فلا يشعر بمباغتة تفقده إن توجّهت يد الطبيب إلى الجرح مرّة واحدة، رحتُ أدور جول الموضوع … انقطع نفسي … لم تبد منهم بادرة اطمئنان … تضاعف خوفهم … ازداد الهم … هم يرون أكثر من علامة خطر حمراء على طريقي الذي بدا لهم مظلمًا، خاليَا … صامتًا … قرّرتُ أن أكف عن محاولاتي معهم … اعتزلتهم … خلوتُ إلى نفسي على أن أقرّر مصيري … أستطيع أن أعثر على طريقة ما تُمكّنني من البقاء في القاهرة، أستطيع كذلك أن أذهب إلى أرض العمليّات الحربيّة … حرتُ وأحسستُ بلوعةٍ مضنية … ليس الأمر خيّنًا أن يدرك المرء أن مصيره انتهى إليه وحده، بمطبق حريّته … باختياره، يستطيع أن يقرّره ويلزم الآخرين بقراره هذه، فكّرتُ كثيرًا، قلّبتُ الأمر على كل وجوهه المختلفة، قم قرّرتُ مع خيوط النهار الأولى … لمعت دموع أبي … حبيتْ أمي نفسها في غرفتها … يصلني نشيجها متقطّعًا … مزّقني كما “السونكي” … هي لم تفكّر منذ خرجتُ إلى الدنيا أن وليدها قد يتعرض لتجربة ربما تودي بحياته ذات يوم، ما دام يضحك … يبكي … يلقم ثديها … يحرك يديه ورجليه، كمن يسبح في محيط واسع يراه هو بينما هي لا تراه.
كانت سعيدة تطبق آمالها مع الغد البعيد … تعيش مع فارسها الصغير … ليس من السهل إذن أن تفرط في … أخض شقيقي الأصغر ينطُّ مزهوًّا … يجري … يدق الأرض برجايه … يضرب الحائط بيديه … إن أخاه سيَضربُ بالمدفع … ربما حسبه كمدفع العيد … امتدت نظرات بقيّة إخوتي كأذرع واجفة تحتضنني في رجاء تغلّب عليه اليأس، أخذتْ شقيقتي سعاد تزجر الصغير اللاهي المبسوط … تُسرف في ذلك شيئًا فشيئًا لتنسى أنّني ذاهب لتهرب من الحقيقة الوشيكة الوقوع.
حانت اللحظة الحاسمة، جفّت دموع أبي … أراد أن يودّعني … فقط كرجل … انقطع نشيج أمي … حبستْ أنفاسها … كانت الأذرع الممتدة من عيون إخوتي لا تزال تحتضنني … في هذه المرة أبت أن تتركني … تشبّثتْ … ألحّتْ … أصرَتْ … تداعى زجر سعاد لشقيقنا الأصغر … جمدتْ يداها … سكن صوتها … حاولتْ أن ـنظر إليّ … أخفقتْ … أحسّت بفشلها … اندفعت إلى حجرة أمي هاربة … اصطدمت بالباب صدمة عنيفة كانت كطلقة مدفع مكتومة … ذكّرتني بحقيقة الوضع … انطلقتُ من بينهم إلى السيارة الصفراء الواقفة بالباب … صعدتُ إليها … حشرتُ جسدي بين الزملاء.
كان عددنا يربو على الثلاثين ضابطًا، ومع ذلك فشلتْ أنفاسنا في تدفئة جو السيارة المقفلة علينا بغطاء سميك، أعمارنا في مجموعها تتراوح بين العشرين والثانية والعشرين، أكبرنا سنًّا الصول عبد التواب، جاوز الأربعين من عمره، تناثرت شعيرات بيضاء يسن شعره الأسود … كان خالعًا قبعته، … خالف الأوامر العسكريّة … إننا جميعًا لم نفكر فيها، ربما نسيناها، ربما لم نجد مُبرّرًا لاتباعها، فمن العبث أن نلب من الجندي الذاهب إلى ميدان القتال أن يراعي أصول الإيتيكيت!
راح كل منا بنظر إلى الآخر في ضيق، كنا كالغرباء … مع أن معظمنا من دفعة واحدة، لكنّني رأيتهم وقد تضاعف احتمال موتهم أكثر من سائر الناس … قانونهم الذي يوشك أن يحكمهم قريبًا يا قاتل يا مقتول … صحيح فرص الحياة متاحة لهم إلا أن حظهم منها – دون شك – قليل، هم لذلك يبدون غرباء.
اشتدّت البرودة عن ذي قب مع أنه قد مضت فترة كانت تكفي – في ما سبق – لأن يدفئ هذا العدد منّا جوّ السيارة، كما لو تشبّث كل منهم بأنفاسه يخاف أ، تذهب ولا ترتد إلى مكانها في الصدور، فلم أجد بُدًّا من معانقة نفسي … رحتُ أبتعد … أبتعد، وما لبثتُ أن بدت السيارة تحت ناظريّ خالية، وحدس أستطيع أن أفكر … أرتجف، وربما أبكي، أمّا مع الآخرين فأحس كما لو كنت عاريًا من دونهم جميعًا.
توقّفتْ السيارة … رفعتُ غطاءها القماشي … رأيتُ المعسكرات كخليّة نحل … الجنود يسرعون … يتجمّعون … ينتظمون في طوابير تتحرّك… تُشحن في اللوريّات ضخمة واحدة بعد الأخرى، تنطلق بهم إلى هناك حيث العدو … زهرت نجوم على صفحة السماء السوداء ثم تساقطتْ عند الأفق … برز جسم مصفر يلمع … يضيء كل ما حولنا، أشبه ما يكون بأرض مهجورة موحشة معلّقة في فضاء بعيد … الشمس! هي لا تعني شيئًا ذا قيمة بالنسبة لإنسان قد لا تقع عيناه عليها مرّة أخرى. مضت علينا أربع وعشرون ساعة منذ تحرّكتْ وحدتنا إلى (أبو عجيلة)، السيارات تزمجر وتهتز بعنف، والصحراء مليئة بالمطبّات، زاخرة بالرمال الخادعة حين تطبق على السيارة فتترنح … تختلج كطائر جريح، ثم تشرع بعد ذلك في مقاومتها … أحيانًا تفشل … أحيانًا أخرى تتخلص من براثنها، على مرمى البصر يقف جبل ضخم يميل لونه إلى الاحمرار … يقوم العدو خلفه بتحركاته… اقترب الجبل … اتضحت نتوءاته.
قبيل الغروب انتشرتْ القوات على أرض الصحراء تزحف في دقة ونظام … الأنفاس تحتبس … النظرات الزائغة تستقر على الهدف … هو يبدو كقطعة من ظلال الجبل … بقيت على ساعة الصفر لحظات … رفعتُ رأسي … الصحراء من حولي مظلمة شاسعة … الجبل الضخم يترقّب … كل شيء يوحي بالتوتر كبالونة منفوخة إلى أقصى حد … مجرد شكّة دبّوس ويحدث الانفجار … يتحوّل الصمت إلى ضجيج … والظلام إلى أضواء تلمع على فوهات البنادق … تحمل الموت.
سرت برودة في أوصالي … نبتت حبّات عرق على جسدي … راحت تنزلق فوقه ببطء فتُشعرني بالحياة التي تكاد تتسرّب منّي بين لحظة وأخرى. هو أمر يوجب الأسى أن يفقد المرء شيئًا عثر عليه قبل أن يتبيّنه. لقد بدأتْ قصتي مع الحياة قبل اثنين وعشرين سنة فقط.
اجتمع نساء العائلة حول امرأة تصره بين الحسن والآخر، فتفرغ شحنتها من الألم، توسّطتْ ذك الجمع حكيمة بدينة، رأيتها لمّا كبرت، فتعجّبتُ كثيرًا. تساءلتُ في نفسي: كيف استطاعت أن تخرجني إلى دنيا الناس؟ هي في ما يبدو تحتاج إلى ونش يحرّكها. قيل لي ذات مرّة إنها خفيفة كالريشة حين يبدأ العمل الجدّ كما بدأ في ذلك الصباح البعيد… اخضرّ شاربي … كبر … اتضحت شعيراته السوداء … تكاثف تمامًا … وقتها تقريبًا وُضعتْ نجمة ذهبيّة على كل من كتفيّ … نظرتُ إليهما … خفّ بريقهما كثيرًا، فقد تركتهما في القاهرة مكتفيًا بنجمتين من قمشا أبيض تراكم غبار الطريف فوقهماـ أدرتُ بصري في السماء، كانت النجوم تلمع، هي كذلك منذ الأزل، لم تخب، لم تسقط، لم تدفن في طيّات الزمن، سَرَت من حولي همهمة مبهمة فنظرت إلى الهدف أمامي مرّة أخرى، تحوّل إلى كتلة سوداء داكنة.
أحسستُ أنّني سأواجه الكتيبة المعتدية بمفردي، إن التراجع الآن أمر عسير، بل مستحيل … والبقاء في مكاني محفوف بالمخاطر، فالنهار سوف يطلع بعد ساعات فيفتضح أمري. لم يبق إلا أن أتحمّل تبعات الموقف الذي ارتضيته لنفسي … ضغطتُ على المدفع الرشاش، دفعته … وقفت على قدمي.
انطبقتْ في نفس اللحظة أجسام ملتهبة من بين يدي … اهتزّ الرشاش … ارتفعت حرارته … التحمت أصوات متنافرة … اصطكّت أجسام لامعة بعضها ببعض … تناثرتْ قطع اللهب من حولي … بعضها يتدفّق من خلفي والبعض الآخر يتداعى من أمامي … مرّ جسم منها إلى جوار أذني … أحدثّ طنينًا عاليًا … راحت قدماي تغوصان في الرمال وتخرجان لتغوصا … حسنًا مازلتُ أجري…
اشتدّ الصراخ من حولي، في هذه المرّة … امتزج بحشرجة رهيبة … ملأ احتكاك الأجسام اللامعة أذنيّ، لمحت مرّة أخرى أحد ألجسام الملتهبة، اصطدم ببطني، شعرتُ بلسعة أخرى … تدفّق الدم الحار بعدها … غاصت قدماي … لم تخرجا … هدأ الرشاش … خمد تمامًا … سرت البرودة فيه … ارتفع أنين يبدو أنه صدر مني … لف الظلام كلّ شيء.
وفجأة، لاح بيت عن قرب … يبدو أنني قد عدتُ … انبعثتْ منّي رائحة صبغة يود … أتير … كلوروفورم … رأسي ثقيلة … عيناي ملتهبتان كأنهما مملوءتان بحبّات رمل ناعمة … جفوني مشدودة بأحجار … أين أنا؟ أسير؟ عبثًا يحصلون مني على أيّة معلومات … وأردتُ أن أتبيّن موقعي، انفرجت جفوني بعد محاولات شاقة … كانت الدموع تملأ عيني … أخذتْ تتسرّب منها … صفت الرؤية أمام ناظري، ورأيت جدرانًا بيضاء ناصعة … أدرتُ بصري … ارتفع أنين متقطّع … كان والدي يقف على مقربة مني … إذن فقد عدتُ إلى البيت … هربت … تخلّيتُ عن إصراري … لم أنفذ قراري الذي سبق لي أن اتخذته … هو يشعر بالخجل … يكاد يختنق بالعار الذي جلبته له، للعائلة كلها … تحرّك والدي مبتعدًا … ثم اختفى. وفجأة سقطتْ عيناي على وجه أعرفه تمامًا … الصول عبد التواب يجلس نصف جلسة على فراش مجاور لي، أراح نظراته عليّ في حنان أبويّ … قلت له:
احنا فين يا صول عبد التواب؟
تبيّن لي أن هذه الكلمات ماتت قبل أن تخرج من حلقي، حاولتُ مرة أخرى، ثالثة، رابعة، جاءتني أخيرًا من ناجيته كلمات بيّنت لي أنّني نجحت في محاولاتي.
بلاش تتكلم كتير يا حضر الضابط علشان النزيف … حقول لك على كل حاجة … احنا دلوقت في المستشفى … في مصر.
كانت كلماته كفتحة النور والهواء حين تنفرج الظلمة التي تطوي سجيّتنا تحت الأنقاض، تقيّد حركته الأتربة تحبس أنفاسه بقيَة من هواء مشبعة بغبار مكثف، لم أهرب إذن … لم أضعف … سقطتُ في المعركة … وترامى إليّ صوتي كأنما ينبعث من أعماق سحيقة واهنًا متقطّعًا.
إيه … إيه اللي … حصل؟
أغمض الرجل عينيه … زوى ما بين حاجبيه … راح يحكي…
لما قربت من الكتيبة اليهودية شعرت إني حواجه اليهود وحدي … جريت عليهم بالرشاش … هات يا ضرب فيهم..
لست أنا فقط الذي أحس بوحدته … انطلق كل منا من داخله … ومضى وحيدًا منفردًا … ومع ذلك فقد كنا وحدة مترابطة في المعركة، سكت الصول عيد التواب … أو أنني لم أعد أنصت إليه تمامًا … ثم تسلل إلى سمعي صوت ضعيف يأتي من قريب هامسًا:
كنت زي ما أكون وحدي … قدام كتيبة العدو …. و ….
عاد أبي مرّة أخرى، في عينيه مسحة من هدوء البال، لم يكن وحده، اصطحب الجميع … على شفتي أمي ابتسامة حانية … أخيرًا خرجتْ من سجنها الانفرادي بحجرتها … راحت الأذرع الممتدّة من عيون إخوتي تحضنني في شوق وأمل، واجهتْ شقيقتي سعاد الموقف بشجاعة، لم تهرب منه بضرب شقيقنا الأصغر الذي راخ يتصفح العنبر في دهشة … انكمش … لبد في سعاد … سوف يضرب الحائط بيديه … يدق الأرض برجليه … ينطُّ مزهوًّا حين أعطيه رصاصتيّ المدفع اللتين استقرتا في جسدي عندما أعود قريبًا، ويصبح كل شيء على ما يرام.
فبراير – 1964
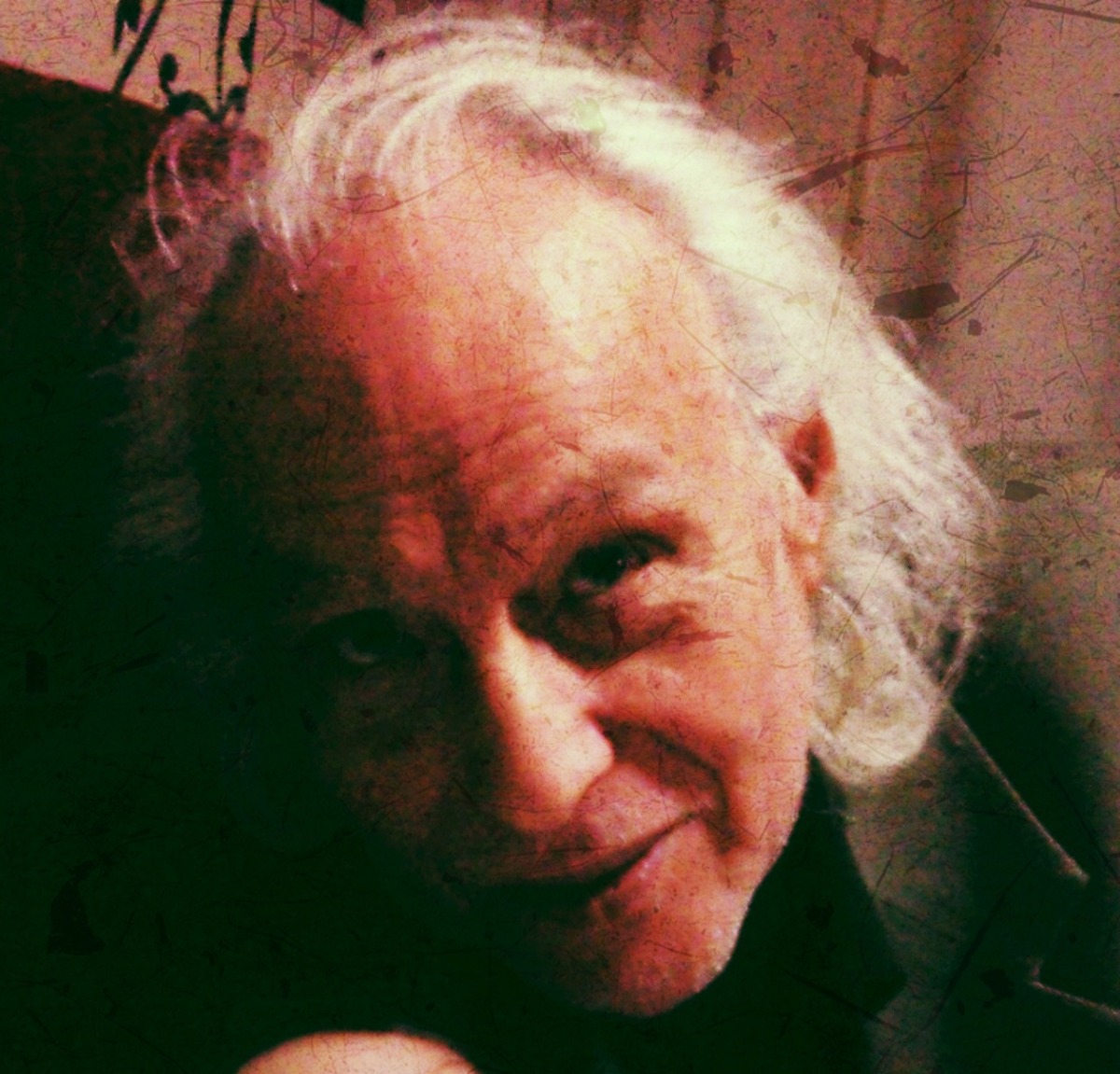
 sadazakera.wordpress.com
sadazakera.wordpress.com
كانت سعيدة تطبق آمالها مع الغد البعيد … تعيش مع فارسها الصغير … ليس من السهل إذن أن تفرط في … أخض شقيقي الأصغر ينطُّ مزهوًّا … يجري … يدق الأرض برجايه … يضرب الحائط بيديه … إن أخاه سيَضربُ بالمدفع … ربما حسبه كمدفع العيد … امتدت نظرات بقيّة إخوتي كأذرع واجفة تحتضنني في رجاء تغلّب عليه اليأس، أخذتْ شقيقتي سعاد تزجر الصغير اللاهي المبسوط … تُسرف في ذلك شيئًا فشيئًا لتنسى أنّني ذاهب لتهرب من الحقيقة الوشيكة الوقوع.
حانت اللحظة الحاسمة، جفّت دموع أبي … أراد أن يودّعني … فقط كرجل … انقطع نشيج أمي … حبستْ أنفاسها … كانت الأذرع الممتدة من عيون إخوتي لا تزال تحتضنني … في هذه المرة أبت أن تتركني … تشبّثتْ … ألحّتْ … أصرَتْ … تداعى زجر سعاد لشقيقنا الأصغر … جمدتْ يداها … سكن صوتها … حاولتْ أن ـنظر إليّ … أخفقتْ … أحسّت بفشلها … اندفعت إلى حجرة أمي هاربة … اصطدمت بالباب صدمة عنيفة كانت كطلقة مدفع مكتومة … ذكّرتني بحقيقة الوضع … انطلقتُ من بينهم إلى السيارة الصفراء الواقفة بالباب … صعدتُ إليها … حشرتُ جسدي بين الزملاء.
كان عددنا يربو على الثلاثين ضابطًا، ومع ذلك فشلتْ أنفاسنا في تدفئة جو السيارة المقفلة علينا بغطاء سميك، أعمارنا في مجموعها تتراوح بين العشرين والثانية والعشرين، أكبرنا سنًّا الصول عبد التواب، جاوز الأربعين من عمره، تناثرت شعيرات بيضاء يسن شعره الأسود … كان خالعًا قبعته، … خالف الأوامر العسكريّة … إننا جميعًا لم نفكر فيها، ربما نسيناها، ربما لم نجد مُبرّرًا لاتباعها، فمن العبث أن نلب من الجندي الذاهب إلى ميدان القتال أن يراعي أصول الإيتيكيت!
راح كل منا بنظر إلى الآخر في ضيق، كنا كالغرباء … مع أن معظمنا من دفعة واحدة، لكنّني رأيتهم وقد تضاعف احتمال موتهم أكثر من سائر الناس … قانونهم الذي يوشك أن يحكمهم قريبًا يا قاتل يا مقتول … صحيح فرص الحياة متاحة لهم إلا أن حظهم منها – دون شك – قليل، هم لذلك يبدون غرباء.
اشتدّت البرودة عن ذي قب مع أنه قد مضت فترة كانت تكفي – في ما سبق – لأن يدفئ هذا العدد منّا جوّ السيارة، كما لو تشبّث كل منهم بأنفاسه يخاف أ، تذهب ولا ترتد إلى مكانها في الصدور، فلم أجد بُدًّا من معانقة نفسي … رحتُ أبتعد … أبتعد، وما لبثتُ أن بدت السيارة تحت ناظريّ خالية، وحدس أستطيع أن أفكر … أرتجف، وربما أبكي، أمّا مع الآخرين فأحس كما لو كنت عاريًا من دونهم جميعًا.
توقّفتْ السيارة … رفعتُ غطاءها القماشي … رأيتُ المعسكرات كخليّة نحل … الجنود يسرعون … يتجمّعون … ينتظمون في طوابير تتحرّك… تُشحن في اللوريّات ضخمة واحدة بعد الأخرى، تنطلق بهم إلى هناك حيث العدو … زهرت نجوم على صفحة السماء السوداء ثم تساقطتْ عند الأفق … برز جسم مصفر يلمع … يضيء كل ما حولنا، أشبه ما يكون بأرض مهجورة موحشة معلّقة في فضاء بعيد … الشمس! هي لا تعني شيئًا ذا قيمة بالنسبة لإنسان قد لا تقع عيناه عليها مرّة أخرى. مضت علينا أربع وعشرون ساعة منذ تحرّكتْ وحدتنا إلى (أبو عجيلة)، السيارات تزمجر وتهتز بعنف، والصحراء مليئة بالمطبّات، زاخرة بالرمال الخادعة حين تطبق على السيارة فتترنح … تختلج كطائر جريح، ثم تشرع بعد ذلك في مقاومتها … أحيانًا تفشل … أحيانًا أخرى تتخلص من براثنها، على مرمى البصر يقف جبل ضخم يميل لونه إلى الاحمرار … يقوم العدو خلفه بتحركاته… اقترب الجبل … اتضحت نتوءاته.
قبيل الغروب انتشرتْ القوات على أرض الصحراء تزحف في دقة ونظام … الأنفاس تحتبس … النظرات الزائغة تستقر على الهدف … هو يبدو كقطعة من ظلال الجبل … بقيت على ساعة الصفر لحظات … رفعتُ رأسي … الصحراء من حولي مظلمة شاسعة … الجبل الضخم يترقّب … كل شيء يوحي بالتوتر كبالونة منفوخة إلى أقصى حد … مجرد شكّة دبّوس ويحدث الانفجار … يتحوّل الصمت إلى ضجيج … والظلام إلى أضواء تلمع على فوهات البنادق … تحمل الموت.
سرت برودة في أوصالي … نبتت حبّات عرق على جسدي … راحت تنزلق فوقه ببطء فتُشعرني بالحياة التي تكاد تتسرّب منّي بين لحظة وأخرى. هو أمر يوجب الأسى أن يفقد المرء شيئًا عثر عليه قبل أن يتبيّنه. لقد بدأتْ قصتي مع الحياة قبل اثنين وعشرين سنة فقط.
اجتمع نساء العائلة حول امرأة تصره بين الحسن والآخر، فتفرغ شحنتها من الألم، توسّطتْ ذك الجمع حكيمة بدينة، رأيتها لمّا كبرت، فتعجّبتُ كثيرًا. تساءلتُ في نفسي: كيف استطاعت أن تخرجني إلى دنيا الناس؟ هي في ما يبدو تحتاج إلى ونش يحرّكها. قيل لي ذات مرّة إنها خفيفة كالريشة حين يبدأ العمل الجدّ كما بدأ في ذلك الصباح البعيد… اخضرّ شاربي … كبر … اتضحت شعيراته السوداء … تكاثف تمامًا … وقتها تقريبًا وُضعتْ نجمة ذهبيّة على كل من كتفيّ … نظرتُ إليهما … خفّ بريقهما كثيرًا، فقد تركتهما في القاهرة مكتفيًا بنجمتين من قمشا أبيض تراكم غبار الطريف فوقهماـ أدرتُ بصري في السماء، كانت النجوم تلمع، هي كذلك منذ الأزل، لم تخب، لم تسقط، لم تدفن في طيّات الزمن، سَرَت من حولي همهمة مبهمة فنظرت إلى الهدف أمامي مرّة أخرى، تحوّل إلى كتلة سوداء داكنة.
أحسستُ أنّني سأواجه الكتيبة المعتدية بمفردي، إن التراجع الآن أمر عسير، بل مستحيل … والبقاء في مكاني محفوف بالمخاطر، فالنهار سوف يطلع بعد ساعات فيفتضح أمري. لم يبق إلا أن أتحمّل تبعات الموقف الذي ارتضيته لنفسي … ضغطتُ على المدفع الرشاش، دفعته … وقفت على قدمي.
انطبقتْ في نفس اللحظة أجسام ملتهبة من بين يدي … اهتزّ الرشاش … ارتفعت حرارته … التحمت أصوات متنافرة … اصطكّت أجسام لامعة بعضها ببعض … تناثرتْ قطع اللهب من حولي … بعضها يتدفّق من خلفي والبعض الآخر يتداعى من أمامي … مرّ جسم منها إلى جوار أذني … أحدثّ طنينًا عاليًا … راحت قدماي تغوصان في الرمال وتخرجان لتغوصا … حسنًا مازلتُ أجري…
اشتدّ الصراخ من حولي، في هذه المرّة … امتزج بحشرجة رهيبة … ملأ احتكاك الأجسام اللامعة أذنيّ، لمحت مرّة أخرى أحد ألجسام الملتهبة، اصطدم ببطني، شعرتُ بلسعة أخرى … تدفّق الدم الحار بعدها … غاصت قدماي … لم تخرجا … هدأ الرشاش … خمد تمامًا … سرت البرودة فيه … ارتفع أنين يبدو أنه صدر مني … لف الظلام كلّ شيء.
وفجأة، لاح بيت عن قرب … يبدو أنني قد عدتُ … انبعثتْ منّي رائحة صبغة يود … أتير … كلوروفورم … رأسي ثقيلة … عيناي ملتهبتان كأنهما مملوءتان بحبّات رمل ناعمة … جفوني مشدودة بأحجار … أين أنا؟ أسير؟ عبثًا يحصلون مني على أيّة معلومات … وأردتُ أن أتبيّن موقعي، انفرجت جفوني بعد محاولات شاقة … كانت الدموع تملأ عيني … أخذتْ تتسرّب منها … صفت الرؤية أمام ناظري، ورأيت جدرانًا بيضاء ناصعة … أدرتُ بصري … ارتفع أنين متقطّع … كان والدي يقف على مقربة مني … إذن فقد عدتُ إلى البيت … هربت … تخلّيتُ عن إصراري … لم أنفذ قراري الذي سبق لي أن اتخذته … هو يشعر بالخجل … يكاد يختنق بالعار الذي جلبته له، للعائلة كلها … تحرّك والدي مبتعدًا … ثم اختفى. وفجأة سقطتْ عيناي على وجه أعرفه تمامًا … الصول عبد التواب يجلس نصف جلسة على فراش مجاور لي، أراح نظراته عليّ في حنان أبويّ … قلت له:
احنا فين يا صول عبد التواب؟
تبيّن لي أن هذه الكلمات ماتت قبل أن تخرج من حلقي، حاولتُ مرة أخرى، ثالثة، رابعة، جاءتني أخيرًا من ناجيته كلمات بيّنت لي أنّني نجحت في محاولاتي.
بلاش تتكلم كتير يا حضر الضابط علشان النزيف … حقول لك على كل حاجة … احنا دلوقت في المستشفى … في مصر.
كانت كلماته كفتحة النور والهواء حين تنفرج الظلمة التي تطوي سجيّتنا تحت الأنقاض، تقيّد حركته الأتربة تحبس أنفاسه بقيَة من هواء مشبعة بغبار مكثف، لم أهرب إذن … لم أضعف … سقطتُ في المعركة … وترامى إليّ صوتي كأنما ينبعث من أعماق سحيقة واهنًا متقطّعًا.
إيه … إيه اللي … حصل؟
أغمض الرجل عينيه … زوى ما بين حاجبيه … راح يحكي…
لما قربت من الكتيبة اليهودية شعرت إني حواجه اليهود وحدي … جريت عليهم بالرشاش … هات يا ضرب فيهم..
لست أنا فقط الذي أحس بوحدته … انطلق كل منا من داخله … ومضى وحيدًا منفردًا … ومع ذلك فقد كنا وحدة مترابطة في المعركة، سكت الصول عيد التواب … أو أنني لم أعد أنصت إليه تمامًا … ثم تسلل إلى سمعي صوت ضعيف يأتي من قريب هامسًا:
كنت زي ما أكون وحدي … قدام كتيبة العدو …. و ….
عاد أبي مرّة أخرى، في عينيه مسحة من هدوء البال، لم يكن وحده، اصطحب الجميع … على شفتي أمي ابتسامة حانية … أخيرًا خرجتْ من سجنها الانفرادي بحجرتها … راحت الأذرع الممتدّة من عيون إخوتي تحضنني في شوق وأمل، واجهتْ شقيقتي سعاد الموقف بشجاعة، لم تهرب منه بضرب شقيقنا الأصغر الذي راخ يتصفح العنبر في دهشة … انكمش … لبد في سعاد … سوف يضرب الحائط بيديه … يدق الأرض برجليه … ينطُّ مزهوًّا حين أعطيه رصاصتيّ المدفع اللتين استقرتا في جسدي عندما أعود قريبًا، ويصبح كل شيء على ما يرام.
فبراير – 1964
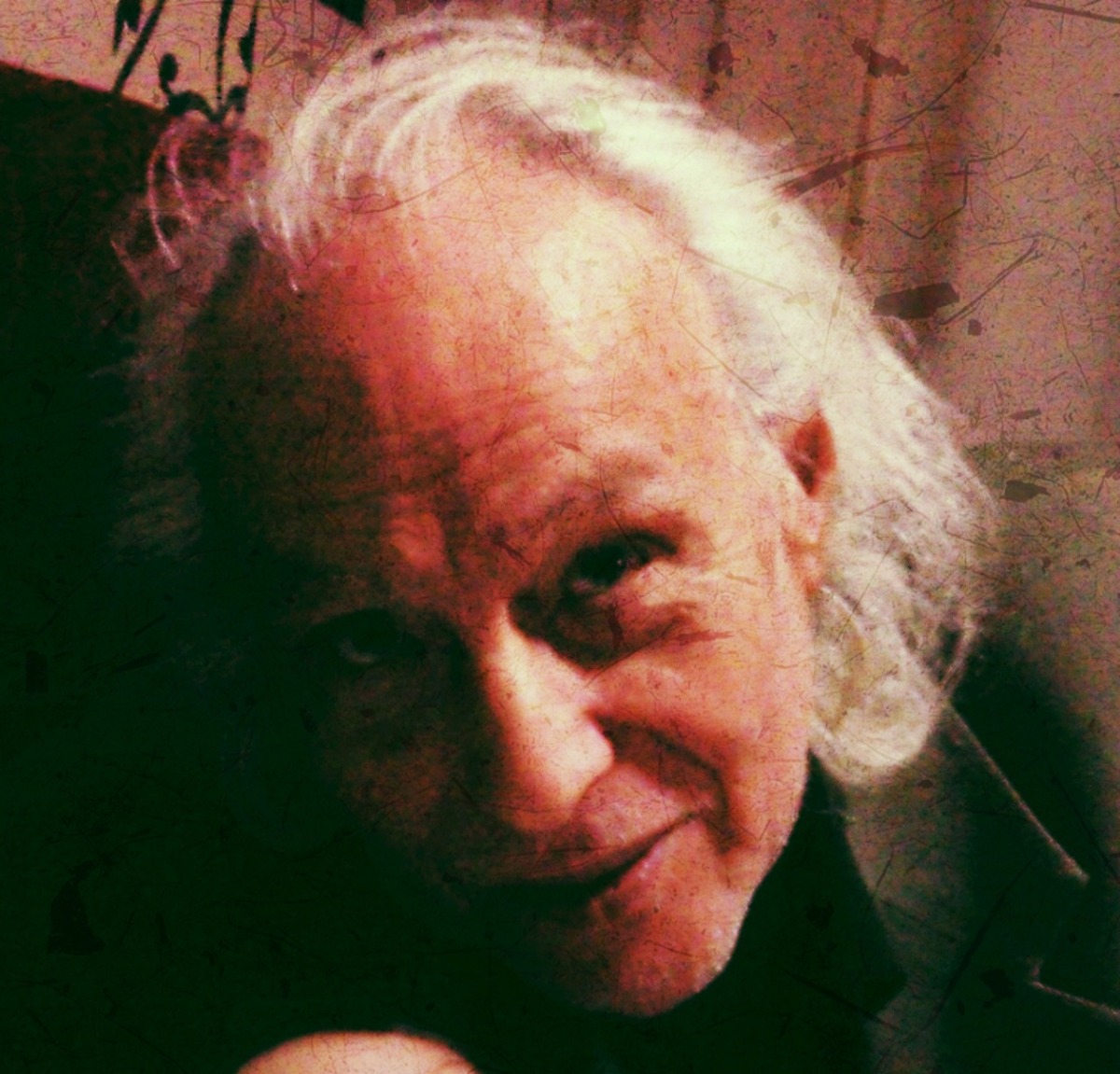
على ما يُرام…قصة: سمير ندا
عندما غادرتُ ثكنات الهايكستيب ظهر ذلك اليوم، لم أتصوّر أنّنس سأعود إليها قبل انتهاء إجازتي الأسبوعية، لم تمض منها سوى يضع ساعات، حتّى اُلغيت فجأة في المساء. صدرت الأوامر من القيادة بضرورة التوجّه إ…


