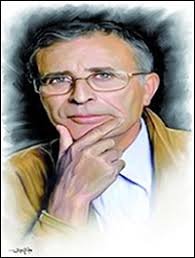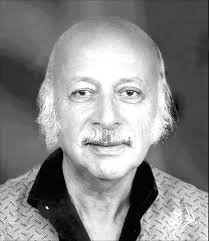قبل وفاته بثلاثة أعوام، أصدر الكاتب والمفكر المغربي المرموق عبدالكبير الخطيبي (1938- 2009م) عن دار «المنار» بالرباط كتابًا بعنوان: «الرباعي الشعري» خصصه لأربعة من شعراء الغرب الكبار، وهم: الألمانيان غوته وريلكه، والسويديان أكيلوف ولوندكفيست. ويبدو جليًّا أنه اختار هؤلاء لأنهم أظهروا اهتمامًا كبيرًا بالإسلام، وبالثقافة الشرقية.
وفي نصه الذي حمل عنوان: «نذْرُ الصمت»، يستحضر الخطيبي جملة لريلكه (1875-1926م) فيها يقول: «ليس هناك أشدّ قوة من الصمت. ولو أننا لم نولد في قلب الكلمة لكان من المحتمل ألّا ينقطع». كما يستحضر جملة لبيكت يقول فيها: «الصمت هو لغتنا الأم» ليقول بأن الشاعر يجد نفسه وحيدًا أمام القوة اللامتناهية للصمت، «الضامن والهوّة» لنشيده. ثم يضيف قائلًا: «الشاعر يحسّ أن اللغة التي يتكلمها وُهبت له كما لو أنها ستسلب منه فيما بعد، بسبب ابتزاز أو ثقل الصمت الذي يغذّي في أوقات الحيرة والضياع، حياته الصعبة. إن نذر الصمت –سواء كان مطلقًا أو نسبيًّا- الذي يطالب به، يؤسس لإنسان الوحدة التجربة الفريدة للشاعر ولوجهه الآخر الصموت. وعشاق الصمت يعرفون هذا السر».
أما عبدالكبير الخطيبي، فقد يجد الشاعر في تدفق اللغة نشوة عارمة، ووهمًا بحرية لا حدود لها. لكن تدفق الكلمات قد يتوقف فجأة. لذلك لا أحد يعلم لماذا فضّل شاعر مُلهم مثل رامبو أن يتخلى عن الكلمات ليخلد إلى الصمت المطلق. ومثل الزهاد الكبار، كان ريلكه يطمح إلى تطهير النفس والجسد حتى لو تطلَّب منه ذلك تحمّل عذابات أليمة. فبعد المحنة التي يمر بها في ساعة التطهير، يعود الجسد إلى نفسه في بهجة الصمت. وأما الروح فتحلم أن تكون ملاكًا للحقيقة. وكان ريلكه يعشق الوحدة. إليها يلجأ كلما اقترب المخاض. مخاض ولادة القصيدة؛ لذا لا أحد مثله مجّدَ التحالف بين الصمت والقصيدة. وفي الرسائل التي كان يبعث بها إلى لو أندرياس صالومي، وإلى حبيباته الأخريات، كان يشير دائمًا إلى حلم الشاعر المفتون بالصمت، وبمكان مثاليّ فيه ينعم بسلام لا متناه بعيدًا من صخب البشر وعنفهم وضجيجهم. وهناك يبدأ حوار الشاعر مع نفسه أمام أفق تشع فيها الصور والإشارات والمعاني الخفية. أما ريلكه، فيحتاج الشاعر دائمًا إلى «صمت جديد لا يذكره بأيّ شيء». صمت بديع لا يقطعه صراخ ولا شكوى، يرافق انبثاق الاستعارات المتراكمة في ذاكرة تعوَّدت على التنقل بين الأمكنة والأزمنة. ذاك هو ثمن القصيدة. تلك القصيدة التي تُصَوّبُ إلى ما هو جوهري وأساسي، وإلى الصفاء المطلق لأصوات الكلمات الذي يُجْتَثّ من نشوة اللحظة. ويكتب الخطيبي قائلًا: «الصمت ليس الصمت. هو ينفجر في اتجاهين، تمامًا مثل الحاضر بالنسبة للماضي أو المستقبل. وهو يمضي في الوقت نفسه، وربما على مسافة متقاربة، باتجاه الحياة والموت. ذاكرته غير مُتَوَقّعَة. وهو يهمس كما يمكن أن ينفجر. وعندما يُحْدث صخبًا، هو يحدثه إما في الخسّة والدناءة، وإما تدريجيًّا بالهمس والوشوشة. عندئذ تسّاقط أوراق تعلن عن الريح، أو عن النسيم الذي يأتي ليستريح على قمم الأشجار. هكذا تختلج الطبيعة. وعدم إنجازنا يتجذّرُ في أجزاء هذه الأشياء، هناك حيث تترك الطبيعة كلمتنا تتبرْعَمُ».
أما ريلكه، فلا يكفي الصمت والوحدة؛ إذ لا بدّ للشاعر من مغامرة، ومن فرار من أشباحه. لذلك هو يفرض على نفسه نظام عمل قاسيًا يحتّم عليه التركيز ليظل شبه أصم وهو جالس بين أشياء العالم. وعندما كان على ضفاف البحر الأدرياتيكي عام 1912م، سمع ريلكه البيت الأول من قصيدته الشهيرة «مراثي دوينو» :
من يسمعني إذن إذا ما أنا صرخت،
بين مراتب الملائكة؟
كل أبواب العالم
وفي ختام نصه عن ريلكه، يكتب الخطيبي قائلًا: «بين كلمة الشاعر والصمت، هناك تغييرات –على خلفية هوة. وكل قصيدة جميلة تولد من التدمير الذي لا يرحم لآثارها. مستندة إلى الصمت، هي موضوعة هناك في هذا الكتاب مثل باب أعمى على جدار لا مرئي. وإذا ما نحن فتحنا كل أبواب العالم، فأين نكون في الصقع غير المحتمل للمجهول؟».
وفي النص الذي خصصه له، والذي جاء بعنوان «الشاعر مُقَنّعًا»، يلقي الخطيبي الأضواء على عالم غوته (1748- 1832م) الروحي والشعري من خلال ديوانه الشهير «الديوان الشرقي من خلال الشاعر الغربي»، مشيرًا في البداية إلى أن صاحب «فاوست» كتب هذا الديوان في شيخوخته. ومن خلاله أراد أن يتحاور مع شعراء الشرق الكبار. ويعني ذلك أنه لم يكن يبتغي تقليدهم، وإنما أن يصيغ انطلاقًا من ثقافته، ومن عالمه، ما يمكن أن يقيم جسورًا روحيه بينه وبينهم.
وكان غوته قد بلغ في سنة 1814م الخامسة والستين من عمره. وكان يعيش في عزلة شبه تامة. وكانت حالته النفسيّة يشوبها الاضطراب، والتمزّق، والقلق. فقد هزم نابليون، بطله المفضّل عام 1813م. فكانت تلك الهزيمة ضربة قاسية له. ورغم أنه كان في قمة المجد والشهرة، فإن نبال الأعداء، والمناوئين كانت تصيبه بين وقت وآخر، مُخلّفة في الروح جراحًا عميقة. ولكي يتجاوز محنته تلك، ويتخلص من القلق النفسيّ الرّهيب الذي كان يعصف بحياته، ويعطّل قدراته الإبداعية، شعر غوته أن أفضل مخرج هو الهروب «إلى عالم خياليّ مثالي» فيه ينعم «بما شاء من الملاذ والأحلام بالقدر الذي تحتمله قواه». ولم يكن هذا العالم غير ذلك الشرق الذي سحره وفتنه وهو يقرأ القرآن، والمعلقات، وشعراء بلاد فارس. وفي تلك السنة نفسها، عاش غوته أحداثًا وثّقت صِلَاته بالشرق. ولعلّ أهم تلك الأحداث هو قراءته ديوان الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي. وعن ذلك كتب يقول في مذكراته عام 1815م: «استطعت أن أحصل في العام الماضي على ترجمة فون همر لديوان حافظ كلّه. وإذا كنت لم أظفر بشيء من قراءتي لما ترجم لهذا الشاعر العظيم من قبلُ من قطع نُشرت في المجلّات هنا وهناك، فإن مجموعة أشعاره قد أثّرت فيّ تأثيرًا عميقًا، وقويًّا حملني على أن أنتج، وأفيض بما أحسّ وأشعر لأني لم أكن قادرًا على مقاومة هذا التأثير القوي على نحو آخر، لقد كان التأثير حيًّا قويًّا، فوضعت الترجمة الألمانيّة بين يدي، وجدتُ نفسي أندفع إلى مشاركته في وجدانه. وإذا بكلّ ما كان كامنًا في نفسي مما يشبه ما يقوله حافظ سواء في موضوعه، أو في معناه يبدو ويظهر، وينبعث بقوة وحرارة حتى إني شعرت شعورًا قويًّا ملحًّا بحاجتي إلى الفرار عن عالم الواقع المليء بالأخطار التي تتهدّدني من كلّ النواحي سواء في السرّ، أو علانية؛ لكي أحيا في عالم خيالي مثالي أنعم فيه بما شئت من المتع حسب طاقتي».
بعد قراءته ديوان حافظ الشيرازي، قرّر غوته مغادرة «فايمار» حيث كان يقيم لقضاء مدة الراحة والاستجمام في منطقة «الراين» الجنوبية التي أمضى فيها حقبة من حياته عندما كان طالبًا في جامعة سترازبورغ. وقد بدأت تلك الرحلة في 15 يوليو- تموز 1814م. وخلال توجهه إلى «فيسبادن» حيث سيمضي بضعة أسابيع، كانت أبواق الحرب تختلط بإشاعات السلام. وها هو الشاعر الشيخ يواجه ماضيه، ومرابع طفولته من جديد محاولًا من خلال الذكريات السعيدة نسيان ما كان يثقل نفسه من آلام وأوجاع.
قصة حب عاصفة
وفي شهر أيّار- مايو من السنة التالية (1815م) عاد غوته من جديد إلى منطقة الراين الجنوبية. وخلال رحلته عاش قصّة حبّ عاصفة ستبدو آثارها جليّة في «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي». فقد نزل غوته ضيفًا على صديقه القديم فيلمير. وهو شخصيّة من شخصيّات فرانكفورت المرموقة. وكان فيلمير قد تزوّج قبل عام فتاة جميلة تدعى ماريان تصغره بخمسة وعشرين عامًا. وكانت ماريان قارئة نهمة. وكانت قد أتت على جميع مؤلفات غوته. لذلك انجذبت إليه، وخفق له قلبها حبًّا من النظرة الأولى. وفي «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» سوف تصبح ماريان «زليخة»، امرأة العزيز التي راودت النبي يوسف عن نفسه. أما غوته فسوف يختار لنفسه اسم حاتم. في القصيدة التي تأتي في خاتمة كتاب «زليخة»، يقول غوته:
بإمكانك أن تتخفّي في ألف شكل/ غير أني أيّتها الحبيبة، سأعرفك على الفور/ قد تخفين محيّاك وراء الأقنعة الساحرة/ لكني أيّتها الحاضرة في كلّ شيء/ سأعرفك على الفور./
في وشوشة القناة الصافية الموج/ سأعرفك على الفور!.
في مستهلّ «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي»، يسمّي غوته رحلته الخياليّة إلى الشرق بـ«الهجرة». وفي القصيدة التي حملت العنوان نفسه، يقول: الشمال، والغرب، والجنوب، كلّ هذا/ يتحطّم ويتناثر/ فلنهاجر إذن إلى الشرق في طهره وصفائه/ كي نستروح جوّ الهداة والمرسلين!/هناك حيث الحب والشرب والغناء/ سيعيدك ينبوع الخضر شابًّا من جديد،/ إلى هناك حيث الطهر والحقّ والصّفاء/ أودّ أن أقود الأجناس البشريّة فأنفذ بها إلى أعماق/ الماضي السحيق/ حيث كانت تتلقّى من لدن الربّ وحي السماء بلغة الأرض/ دون أن تضني الرأس بالتفكير».
وفي مكان آخر يعبّر غوته عن هذه الهجرة نفسها قائلًا: «دعوني وحدي مقيمًا على سرج جوادي،/ وأقيموا ما شئتم في دياركم/ مضارب خيامكم،/ أما أنا فسأجوب من الأنحاء قاصيها/ على صهوة فرسي/ فرحًا مسرورًا لا يعلو على قلنسوتي/ غير نجوم السّماء!».
ولا ينسى غوته أن يقدّم لقراء «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» في فقرات مكثفة للغاية قائمة الشعراء، وجميعهم من شعراء الفرس الذين تأثر بهم. وتبدأ هذه القائمة بالفردوسي الذي عاش في القرن الحادي عشر، وتنتهي بعبدالرحمن الجامي الذي عاش في القرن السادس عشر. وهؤلاء الشعراء مختلفون في نزعاتهم، وفي أغراضهم الشعرية والوجوديّة، سوى جلال الدين الرومي الذي يعاب عليه توجّهه التجريدي، ولجوؤه إلى نظريّة «الوحدة الكونيّة»، يجرّ غوته بقية الشعراء إلى عصره محاولًا أن يسبغ عليهم بعض القيم الإنسانية النبيلة السائدة فيه. أما الشاعر الأقرب إلى نفسه فهو بلا شك حافظ الشيرازي؛ لذا هو لا يتردد في أن يعلن أن هذا الأخير هو معلمه، والنموذج الذي يحتذي به. عنه كتب يقول: «من قصائد هذا الشاعر يتدفق سيل من الحياة لا ينقطع، حافل بالاتّزان. وكان راضيًا ببساطة حاله، فرحًا، حكيمًا، يشارك في خيرات هذا العالم، ويلقي بنظرة بعيدة على أسرار الألوهيّة، مُنصرفًا عن أداء الفروض الدينية، وعن ملذّات الحواس في وقت واحد، حتى إن نوع شعره، وإن كان يبدو أنه يعظ، ويعلّم، يحتفظ بحركة شكّيّة دائمًا».
غير أن الشرق ليس هو وحده الحاضر في «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي»، وليس كلّ ما فيه خيالًا. فهناك الشاعر الغربي الذي هو غوته. وهو يعبّر عن ضيقه بمن يسمّيهم «الرّهبان الصغار الذين لا يضعون على رؤوسهم قلنصوات». هناك أيضًا الرجل الذي هو غوته وقد بدأ يشيخ، ويواجه خطر الأمراض. ولكي ينسى ذلك، ويستعيد طاقة الشباب، ها هو يهرب إلى ذكريات الماضي. غير أنها تبدو من دون نفع ولا جدوى: غربت الشمس/ لكنها لا تزال تلمع في المغرب/ بودي أن أعرف كم من الزمان/ سيستمر هذا البريق الذهبي؟».
صدر «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» أول مرة عام 1819م. غير أن أهم ما تضمّنه من قصائد هي تلك التي كتبها غوته خلال الرحلتين اللتين قام بهما إلى منطقة الراين الجنوبية عامَيْ 1814م، و1815م. وربما يعود ذلك إلى أن غوته كان خلال الرحلتين في أقصى درجات توهجه الشعري والذّهني. كما أنه كان عاشقًا متيّمًا. بعد «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي»، ظلّت الغنائيّة حاضرة في قصائد الشعراء الألمان. إلّا أن جمال هذا الديوان لم يتجدّد بعد غوته أبدًا…
الدليل إلى جهنم
ومثل غوته، فتن الشاعر السويدي غونار أكيلوف (1907- 1968م) بالشرق وبشعرائه، وتحديدًا بمحيي الدين بن عربي. انعكس ذلك من خلال الدواوين التي أصدرها مثل: «ديوان حول الأمير»، و«أسطورة فطومة»، و«الدليل إلى جهنم». وكان غونار أكيلوف قد بدأ يهتم بالأدب العربي مبكرًا؛ إذ تعلم البعض من مبادئ اللغة العربية في قسم اللغات الشرقية بجامعة «أوبسالا». بعدها انتقل إلى لندن ليواصل دراسته في المجال نفسه، مجال اللغات الشرقية. وهناك اكتشف محيي الدين بن عربي من خلال ديوان «ترجمان الأشواق» الذي كان قد نقله إلى لغة شكسبير المستشرق البريطاني نيكولسون. ومنذ ذلك الحين، سوف يصبح هذا الديوان، المرجع الأساسي لغونار أكيلوف، وسوف يجد فيه ملامح التيارات الشعرية الطلائعية التي كانت شائعة في عصره مثل الرمزية والسوريالية.
وتحت تأثير «ترجمان الأشواق» تخيّل غونار أكيلوف قصة حب بين شاب يدعى حبيب، وشابة تدعى فطومة. وفي ذلك كتب يقول: حبيب! حبيبي، هل نلتقي عندك أو عندي/ كان ذلك هو صدى صوتها الساحر في الليل،/ نلتقي عندك، كان ذلك صدى جوابه الساحر،/ وتجولا ثانية في خلال الليل، بعيدًا عن المدينة/ بعيدًا عن أطراف المدينة، وتجاوزا الواحات حتى وصلا قلب الليل وبزغ الفجر الأحمر، أمامهما على الطريق/ وأضاع الفجر نفسه في الرحال، في الشمس التي صعدت خارج الليل،/ وأصبح القمر شاحبًا، وألقت الشمس ظلالًا أكثر دكنة/ وحين غربت جاءا إلى مكانهما، في الليل/ واختفت كل الطرقات، وأغفيا بجوار بعضهما البعض/ ودونه كان لا يبين شيء من ظلها ولكن حين غيّرا وضعهما كما يفعل العشاق/ كان شيء ما لا يبين تحت ظله/ وهكذا أصبح الليل نهارًا، والنهار ليلًا».
وفي مقطع آخر من القصيد ذاته، كتب أكيلوف يقول: في أحلامي سمعت صوتًا/ هل تحبّ هذه الزهرة، يا حبيب/ أم ورقة من أوراقها/ عندئذ وقعت في حيرة/ فقد كان هذا السؤال الملغز هو سؤال حياتي/ هل أفضّل الجزء على الكل/ أو الكل على الجزء/ لا، إني أريد كليهما/ جزء الكل، والكل/ ولا يكون في هذا الاختيار أي تناقض».
وفي قصائد أخرى تقمص أكيلوف شخصية ديجينيس أكريتاس الذي كان قد وُلد عربيًّا. غير أن الروم قاموا بأسره خلال الحروب الصليبية، فأصبح مسيحيًّا رغمًا عنه. وعندما اكتشف الروم أنه ظل وفيًّا لعروبته، ألقوا به في السجن. وظل هناك إلى أن قضى. غير أن أكيلوف لا يلبث أن يعود إلى محيي الدين بن عربي ليكتب قصيدة عن نظام، وفيها يقول: «الشباب يرقصون ويدقون ساقًا بساق/ والفتيات يغطين وجوههن كل واحدة بنقابها/ كل من الفريقين يعبّر عن رغبته بطريقته/ وهي رغبة متبادلة بينهم/ أما أنت فتبقين خارج مجال الحصول،/ تبقين أنت الواحدة المفردة».
بعد أن أمضى بضع سنوات في لندن، انتقل أكيلوف إلى باريس حيث أقام في فندق متواضع. وكان يقضي جلّ أوقاته في الكتابة، وفي الاستماع إلى سيمفونيات سترافينسكي الذي كان يعشقه. وكانت الكآبة تشتد عليه أحيانًا، حتى إنه فكر أكثر من مرة في الانتحار. ولأنه اكتشف أن التمرد عملية عبثية، مآلها الخيبة والخسران، فإنه ازداد ميلًا إلى العزلة والوحدة. وكانت بلاده السويد، تبدو له من بعيد سوداء قاتمة، كأنها ليل بلا نهاية؛ لذلك كان إحساسه بالغربة شديدًا. وهذا ما تكشفه الأبيات التالية: «أنا غريب في هذه البلاد/ غير أن هذه البلاد ليست غريبة عني/ ليس لي وطن في هذه البلاد/ غير أن هذه البلاد تريد أن تكون لي وطنًا في داخلي!».
ومع اندلاع الحرب الكونية الثانية، بدأ أكيلوف يشعر أن التاريخ معادٍ لآمال الإنسانية، ومطامحها في الحرية، والحب، والعدالة؛ لذا ازداد تشاؤمًا ويأسًا، وأصبح فصل الخريف رمزًا للاحتضار، وللتعفن الشامل. وفي قصيدة بعنوان «مرآة أكتوبر» كتب يقول: «الأعصاب تصرّ بهدوء في الأصيل/ الذي يسيل رماديًّا ولطيفًا عبر النافذة/ والأزهار الحمراء تؤلم قليلًا في الغروب/ والمصباح الكهربائي يغني وحيدًا في الركن/ الصمت يشرب أمطار الخريف الهادئة/ والتي لا تأتي بأي شيء للمحصول الزراعي/ والأيدي المضمومة تتدفأ/ والنظرات الثابتة تتغشى في الجمر./ بالمعجزة التي تلامس المنازل».
ويرى عبدالكبير الخطيبي أن أكيلوف كان يرغب دائمًا في أن يكتب قصائده التي يحضر فيها الشرق على شكل مسبحة مشرقية؛ إذ إن كل قصيدة تبدأ وتنتهي دائمًا بالحركة نفسها. والمسبحة له هي لعبة من ألعاب الجسد. وخاصيتها أنها توقظ الحواس، وتنتظم حباتها تنظيمًا شعريًّا يتكون من تتابع دائري بين الكلمات والاستعارات. وفي الشرق، يتعلم الشاعر لغة الطيور، والملائكة والنساء المتبرجات في ظلال البيوت بعيدًا من أنظار المتطفلين. كما يتعلم كيف ينسج النظرات، والكلمات، والصرخات، والضحكات.
خطورة الحياة وكثافة الأشياء
وفي الليلة الفاصلة بين التاسع والعشرين من شهر فبراير وفاتح مارس 1960م، ضرب زلزال عنيف مدينة أغادير المغربية مخلفًا 50000 قتيل. وكان الشاعر السويدي آرتور لوندكفيست (1906- 1991م) موجودًا في المدينة المنكوبة برفقة زوجته الشاعرة ماريا فين. والاثنان نجيا من الكارثة التي من وحيها كتب الشاعر السويدي قصيدة حملت عنوان «أغادير». وعلى هامش ندوة انتظمت في أغادير يومي 10 و11 إبريل 1997م بحضور زوجة الشاعر، قدم عبدالكبير الخطيبي قراءة لقصيدة لوندكفيست من خلال مداخلة بعنوان «ما بعد الكارثة». وهو يرى أن الشاعر نجح إلى حد بعيد في بلورة صورة شعرية رائعة لمدينة دمرها الزلزال، مثبتًا بذلك أن الشعر قادر على أن يستكشف خطورة الحياة وكثافة الأشياء، وعلى أن يبتكر مجالات جديدة لكل حدث يتسبب في مأساة إنسانية.
وكان الشاعر لوندكفيست بصدد قراءة كتاب لما ضرب الزلزال أغادير. وكان الوقت شهر رمضان. وفي النصوص القديمة نحن نعاين أن الحيوانات والطيور هي التي تبادر بالإعلان عن الكوارث الطبيعية. وفي بداية قصيدته، يتحدث الشاعر عن حمامة تطير من بين صفحات الكتاب وهو في حالة من الانزعاج والخوف. ثم فجأة تهتز الأرض، وتتحول المدينة إلى ركام من الأطلال. وتلك اللحظات العصيبة التي تحدث فيها الكارثة تبدو بلا نهاية. ويكتب الشاعر قائلًا:
أسمع نفسي أصرخ/ كم من الوقت سيدوم كل هذا؟/ عشر ثوان؟/ أكثر؟ أقل؟/ أو أنه لا وقت محددًا لذلك- الوقت انقطع/ فاقدًا امتداده المحدد،/ ربما تكون هناك كرة سوداء من الزمن مضغوطة/ ومثقلة بقرارات سريعة مثل البرق:/ ذلك أن العالم كان قد انبثق من جديد هادئًا، صامتًا،/ والوعي اتحد مرة أخرى بالجسد، وها أنا أجد نفسي حيًّا،/ (أو ربما تكون مجرد فكرة في لحظة الموت).
ويشير عبدالكبير الخطيبي إلى أن لوندكفيست حَوّل قصيدته إلى ملحمة شعرية؛ إذ إن الكوارث الطبيعية لا يليق بها غير ذلك. ومُعلقًا على البيت التالي في القصيدة نفسها: «أغادير، كوني متهيئة، تذكري ما ينتظرنا ربما: الدمار الشامل»، يضيف عبدالكبير الخطيبي قائلًا: «ربما هذه لا بد أن تظل راسخة في قوى الصمت، وفي كل ما هو شاسع وغير مُقَدّر، أو إذا ما نحن أردنا، في ما يشير إلى الوعد. وهكذا نتعلم مع الشعراء أن الحياة مهنة، أو هي فن. وكان لوندكفيست يعلم أن كل واحد منا يحمل في ذاته مزدوجه الذي هو مستعد أن يلعب لعبة الناجي من الموت. وهذا المزدوج هو الصورة الحزينة للشاعر الذي يأخذنا باتجاه العالم الآخر، مثل هاملت الذي يعيد على ركح كل مسارح العالم تكشيرته أمام رعب العدم. وفي حد ذاتها، تكون قصيدة لوندكفيست تجربة قصوى، وتمرينًا يهيّئنا لنهايتنا، تمرينًا حقيقيًّا لتزهدنا، ولاستكشاف قدراتنا».
وفي نصه الذي حمل عنوان: «نذْرُ الصمت»، يستحضر الخطيبي جملة لريلكه (1875-1926م) فيها يقول: «ليس هناك أشدّ قوة من الصمت. ولو أننا لم نولد في قلب الكلمة لكان من المحتمل ألّا ينقطع». كما يستحضر جملة لبيكت يقول فيها: «الصمت هو لغتنا الأم» ليقول بأن الشاعر يجد نفسه وحيدًا أمام القوة اللامتناهية للصمت، «الضامن والهوّة» لنشيده. ثم يضيف قائلًا: «الشاعر يحسّ أن اللغة التي يتكلمها وُهبت له كما لو أنها ستسلب منه فيما بعد، بسبب ابتزاز أو ثقل الصمت الذي يغذّي في أوقات الحيرة والضياع، حياته الصعبة. إن نذر الصمت –سواء كان مطلقًا أو نسبيًّا- الذي يطالب به، يؤسس لإنسان الوحدة التجربة الفريدة للشاعر ولوجهه الآخر الصموت. وعشاق الصمت يعرفون هذا السر».
أما عبدالكبير الخطيبي، فقد يجد الشاعر في تدفق اللغة نشوة عارمة، ووهمًا بحرية لا حدود لها. لكن تدفق الكلمات قد يتوقف فجأة. لذلك لا أحد يعلم لماذا فضّل شاعر مُلهم مثل رامبو أن يتخلى عن الكلمات ليخلد إلى الصمت المطلق. ومثل الزهاد الكبار، كان ريلكه يطمح إلى تطهير النفس والجسد حتى لو تطلَّب منه ذلك تحمّل عذابات أليمة. فبعد المحنة التي يمر بها في ساعة التطهير، يعود الجسد إلى نفسه في بهجة الصمت. وأما الروح فتحلم أن تكون ملاكًا للحقيقة. وكان ريلكه يعشق الوحدة. إليها يلجأ كلما اقترب المخاض. مخاض ولادة القصيدة؛ لذا لا أحد مثله مجّدَ التحالف بين الصمت والقصيدة. وفي الرسائل التي كان يبعث بها إلى لو أندرياس صالومي، وإلى حبيباته الأخريات، كان يشير دائمًا إلى حلم الشاعر المفتون بالصمت، وبمكان مثاليّ فيه ينعم بسلام لا متناه بعيدًا من صخب البشر وعنفهم وضجيجهم. وهناك يبدأ حوار الشاعر مع نفسه أمام أفق تشع فيها الصور والإشارات والمعاني الخفية. أما ريلكه، فيحتاج الشاعر دائمًا إلى «صمت جديد لا يذكره بأيّ شيء». صمت بديع لا يقطعه صراخ ولا شكوى، يرافق انبثاق الاستعارات المتراكمة في ذاكرة تعوَّدت على التنقل بين الأمكنة والأزمنة. ذاك هو ثمن القصيدة. تلك القصيدة التي تُصَوّبُ إلى ما هو جوهري وأساسي، وإلى الصفاء المطلق لأصوات الكلمات الذي يُجْتَثّ من نشوة اللحظة. ويكتب الخطيبي قائلًا: «الصمت ليس الصمت. هو ينفجر في اتجاهين، تمامًا مثل الحاضر بالنسبة للماضي أو المستقبل. وهو يمضي في الوقت نفسه، وربما على مسافة متقاربة، باتجاه الحياة والموت. ذاكرته غير مُتَوَقّعَة. وهو يهمس كما يمكن أن ينفجر. وعندما يُحْدث صخبًا، هو يحدثه إما في الخسّة والدناءة، وإما تدريجيًّا بالهمس والوشوشة. عندئذ تسّاقط أوراق تعلن عن الريح، أو عن النسيم الذي يأتي ليستريح على قمم الأشجار. هكذا تختلج الطبيعة. وعدم إنجازنا يتجذّرُ في أجزاء هذه الأشياء، هناك حيث تترك الطبيعة كلمتنا تتبرْعَمُ».
أما ريلكه، فلا يكفي الصمت والوحدة؛ إذ لا بدّ للشاعر من مغامرة، ومن فرار من أشباحه. لذلك هو يفرض على نفسه نظام عمل قاسيًا يحتّم عليه التركيز ليظل شبه أصم وهو جالس بين أشياء العالم. وعندما كان على ضفاف البحر الأدرياتيكي عام 1912م، سمع ريلكه البيت الأول من قصيدته الشهيرة «مراثي دوينو» :
من يسمعني إذن إذا ما أنا صرخت،
بين مراتب الملائكة؟
كل أبواب العالم
وفي ختام نصه عن ريلكه، يكتب الخطيبي قائلًا: «بين كلمة الشاعر والصمت، هناك تغييرات –على خلفية هوة. وكل قصيدة جميلة تولد من التدمير الذي لا يرحم لآثارها. مستندة إلى الصمت، هي موضوعة هناك في هذا الكتاب مثل باب أعمى على جدار لا مرئي. وإذا ما نحن فتحنا كل أبواب العالم، فأين نكون في الصقع غير المحتمل للمجهول؟».
وفي النص الذي خصصه له، والذي جاء بعنوان «الشاعر مُقَنّعًا»، يلقي الخطيبي الأضواء على عالم غوته (1748- 1832م) الروحي والشعري من خلال ديوانه الشهير «الديوان الشرقي من خلال الشاعر الغربي»، مشيرًا في البداية إلى أن صاحب «فاوست» كتب هذا الديوان في شيخوخته. ومن خلاله أراد أن يتحاور مع شعراء الشرق الكبار. ويعني ذلك أنه لم يكن يبتغي تقليدهم، وإنما أن يصيغ انطلاقًا من ثقافته، ومن عالمه، ما يمكن أن يقيم جسورًا روحيه بينه وبينهم.
وكان غوته قد بلغ في سنة 1814م الخامسة والستين من عمره. وكان يعيش في عزلة شبه تامة. وكانت حالته النفسيّة يشوبها الاضطراب، والتمزّق، والقلق. فقد هزم نابليون، بطله المفضّل عام 1813م. فكانت تلك الهزيمة ضربة قاسية له. ورغم أنه كان في قمة المجد والشهرة، فإن نبال الأعداء، والمناوئين كانت تصيبه بين وقت وآخر، مُخلّفة في الروح جراحًا عميقة. ولكي يتجاوز محنته تلك، ويتخلص من القلق النفسيّ الرّهيب الذي كان يعصف بحياته، ويعطّل قدراته الإبداعية، شعر غوته أن أفضل مخرج هو الهروب «إلى عالم خياليّ مثالي» فيه ينعم «بما شاء من الملاذ والأحلام بالقدر الذي تحتمله قواه». ولم يكن هذا العالم غير ذلك الشرق الذي سحره وفتنه وهو يقرأ القرآن، والمعلقات، وشعراء بلاد فارس. وفي تلك السنة نفسها، عاش غوته أحداثًا وثّقت صِلَاته بالشرق. ولعلّ أهم تلك الأحداث هو قراءته ديوان الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي. وعن ذلك كتب يقول في مذكراته عام 1815م: «استطعت أن أحصل في العام الماضي على ترجمة فون همر لديوان حافظ كلّه. وإذا كنت لم أظفر بشيء من قراءتي لما ترجم لهذا الشاعر العظيم من قبلُ من قطع نُشرت في المجلّات هنا وهناك، فإن مجموعة أشعاره قد أثّرت فيّ تأثيرًا عميقًا، وقويًّا حملني على أن أنتج، وأفيض بما أحسّ وأشعر لأني لم أكن قادرًا على مقاومة هذا التأثير القوي على نحو آخر، لقد كان التأثير حيًّا قويًّا، فوضعت الترجمة الألمانيّة بين يدي، وجدتُ نفسي أندفع إلى مشاركته في وجدانه. وإذا بكلّ ما كان كامنًا في نفسي مما يشبه ما يقوله حافظ سواء في موضوعه، أو في معناه يبدو ويظهر، وينبعث بقوة وحرارة حتى إني شعرت شعورًا قويًّا ملحًّا بحاجتي إلى الفرار عن عالم الواقع المليء بالأخطار التي تتهدّدني من كلّ النواحي سواء في السرّ، أو علانية؛ لكي أحيا في عالم خيالي مثالي أنعم فيه بما شئت من المتع حسب طاقتي».
بعد قراءته ديوان حافظ الشيرازي، قرّر غوته مغادرة «فايمار» حيث كان يقيم لقضاء مدة الراحة والاستجمام في منطقة «الراين» الجنوبية التي أمضى فيها حقبة من حياته عندما كان طالبًا في جامعة سترازبورغ. وقد بدأت تلك الرحلة في 15 يوليو- تموز 1814م. وخلال توجهه إلى «فيسبادن» حيث سيمضي بضعة أسابيع، كانت أبواق الحرب تختلط بإشاعات السلام. وها هو الشاعر الشيخ يواجه ماضيه، ومرابع طفولته من جديد محاولًا من خلال الذكريات السعيدة نسيان ما كان يثقل نفسه من آلام وأوجاع.
قصة حب عاصفة
وفي شهر أيّار- مايو من السنة التالية (1815م) عاد غوته من جديد إلى منطقة الراين الجنوبية. وخلال رحلته عاش قصّة حبّ عاصفة ستبدو آثارها جليّة في «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي». فقد نزل غوته ضيفًا على صديقه القديم فيلمير. وهو شخصيّة من شخصيّات فرانكفورت المرموقة. وكان فيلمير قد تزوّج قبل عام فتاة جميلة تدعى ماريان تصغره بخمسة وعشرين عامًا. وكانت ماريان قارئة نهمة. وكانت قد أتت على جميع مؤلفات غوته. لذلك انجذبت إليه، وخفق له قلبها حبًّا من النظرة الأولى. وفي «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» سوف تصبح ماريان «زليخة»، امرأة العزيز التي راودت النبي يوسف عن نفسه. أما غوته فسوف يختار لنفسه اسم حاتم. في القصيدة التي تأتي في خاتمة كتاب «زليخة»، يقول غوته:
بإمكانك أن تتخفّي في ألف شكل/ غير أني أيّتها الحبيبة، سأعرفك على الفور/ قد تخفين محيّاك وراء الأقنعة الساحرة/ لكني أيّتها الحاضرة في كلّ شيء/ سأعرفك على الفور./
في وشوشة القناة الصافية الموج/ سأعرفك على الفور!.
في مستهلّ «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي»، يسمّي غوته رحلته الخياليّة إلى الشرق بـ«الهجرة». وفي القصيدة التي حملت العنوان نفسه، يقول: الشمال، والغرب، والجنوب، كلّ هذا/ يتحطّم ويتناثر/ فلنهاجر إذن إلى الشرق في طهره وصفائه/ كي نستروح جوّ الهداة والمرسلين!/هناك حيث الحب والشرب والغناء/ سيعيدك ينبوع الخضر شابًّا من جديد،/ إلى هناك حيث الطهر والحقّ والصّفاء/ أودّ أن أقود الأجناس البشريّة فأنفذ بها إلى أعماق/ الماضي السحيق/ حيث كانت تتلقّى من لدن الربّ وحي السماء بلغة الأرض/ دون أن تضني الرأس بالتفكير».
وفي مكان آخر يعبّر غوته عن هذه الهجرة نفسها قائلًا: «دعوني وحدي مقيمًا على سرج جوادي،/ وأقيموا ما شئتم في دياركم/ مضارب خيامكم،/ أما أنا فسأجوب من الأنحاء قاصيها/ على صهوة فرسي/ فرحًا مسرورًا لا يعلو على قلنسوتي/ غير نجوم السّماء!».
ولا ينسى غوته أن يقدّم لقراء «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» في فقرات مكثفة للغاية قائمة الشعراء، وجميعهم من شعراء الفرس الذين تأثر بهم. وتبدأ هذه القائمة بالفردوسي الذي عاش في القرن الحادي عشر، وتنتهي بعبدالرحمن الجامي الذي عاش في القرن السادس عشر. وهؤلاء الشعراء مختلفون في نزعاتهم، وفي أغراضهم الشعرية والوجوديّة، سوى جلال الدين الرومي الذي يعاب عليه توجّهه التجريدي، ولجوؤه إلى نظريّة «الوحدة الكونيّة»، يجرّ غوته بقية الشعراء إلى عصره محاولًا أن يسبغ عليهم بعض القيم الإنسانية النبيلة السائدة فيه. أما الشاعر الأقرب إلى نفسه فهو بلا شك حافظ الشيرازي؛ لذا هو لا يتردد في أن يعلن أن هذا الأخير هو معلمه، والنموذج الذي يحتذي به. عنه كتب يقول: «من قصائد هذا الشاعر يتدفق سيل من الحياة لا ينقطع، حافل بالاتّزان. وكان راضيًا ببساطة حاله، فرحًا، حكيمًا، يشارك في خيرات هذا العالم، ويلقي بنظرة بعيدة على أسرار الألوهيّة، مُنصرفًا عن أداء الفروض الدينية، وعن ملذّات الحواس في وقت واحد، حتى إن نوع شعره، وإن كان يبدو أنه يعظ، ويعلّم، يحتفظ بحركة شكّيّة دائمًا».
غير أن الشرق ليس هو وحده الحاضر في «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي»، وليس كلّ ما فيه خيالًا. فهناك الشاعر الغربي الذي هو غوته. وهو يعبّر عن ضيقه بمن يسمّيهم «الرّهبان الصغار الذين لا يضعون على رؤوسهم قلنصوات». هناك أيضًا الرجل الذي هو غوته وقد بدأ يشيخ، ويواجه خطر الأمراض. ولكي ينسى ذلك، ويستعيد طاقة الشباب، ها هو يهرب إلى ذكريات الماضي. غير أنها تبدو من دون نفع ولا جدوى: غربت الشمس/ لكنها لا تزال تلمع في المغرب/ بودي أن أعرف كم من الزمان/ سيستمر هذا البريق الذهبي؟».
صدر «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» أول مرة عام 1819م. غير أن أهم ما تضمّنه من قصائد هي تلك التي كتبها غوته خلال الرحلتين اللتين قام بهما إلى منطقة الراين الجنوبية عامَيْ 1814م، و1815م. وربما يعود ذلك إلى أن غوته كان خلال الرحلتين في أقصى درجات توهجه الشعري والذّهني. كما أنه كان عاشقًا متيّمًا. بعد «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي»، ظلّت الغنائيّة حاضرة في قصائد الشعراء الألمان. إلّا أن جمال هذا الديوان لم يتجدّد بعد غوته أبدًا…
الدليل إلى جهنم
ومثل غوته، فتن الشاعر السويدي غونار أكيلوف (1907- 1968م) بالشرق وبشعرائه، وتحديدًا بمحيي الدين بن عربي. انعكس ذلك من خلال الدواوين التي أصدرها مثل: «ديوان حول الأمير»، و«أسطورة فطومة»، و«الدليل إلى جهنم». وكان غونار أكيلوف قد بدأ يهتم بالأدب العربي مبكرًا؛ إذ تعلم البعض من مبادئ اللغة العربية في قسم اللغات الشرقية بجامعة «أوبسالا». بعدها انتقل إلى لندن ليواصل دراسته في المجال نفسه، مجال اللغات الشرقية. وهناك اكتشف محيي الدين بن عربي من خلال ديوان «ترجمان الأشواق» الذي كان قد نقله إلى لغة شكسبير المستشرق البريطاني نيكولسون. ومنذ ذلك الحين، سوف يصبح هذا الديوان، المرجع الأساسي لغونار أكيلوف، وسوف يجد فيه ملامح التيارات الشعرية الطلائعية التي كانت شائعة في عصره مثل الرمزية والسوريالية.
وتحت تأثير «ترجمان الأشواق» تخيّل غونار أكيلوف قصة حب بين شاب يدعى حبيب، وشابة تدعى فطومة. وفي ذلك كتب يقول: حبيب! حبيبي، هل نلتقي عندك أو عندي/ كان ذلك هو صدى صوتها الساحر في الليل،/ نلتقي عندك، كان ذلك صدى جوابه الساحر،/ وتجولا ثانية في خلال الليل، بعيدًا عن المدينة/ بعيدًا عن أطراف المدينة، وتجاوزا الواحات حتى وصلا قلب الليل وبزغ الفجر الأحمر، أمامهما على الطريق/ وأضاع الفجر نفسه في الرحال، في الشمس التي صعدت خارج الليل،/ وأصبح القمر شاحبًا، وألقت الشمس ظلالًا أكثر دكنة/ وحين غربت جاءا إلى مكانهما، في الليل/ واختفت كل الطرقات، وأغفيا بجوار بعضهما البعض/ ودونه كان لا يبين شيء من ظلها ولكن حين غيّرا وضعهما كما يفعل العشاق/ كان شيء ما لا يبين تحت ظله/ وهكذا أصبح الليل نهارًا، والنهار ليلًا».
وفي مقطع آخر من القصيد ذاته، كتب أكيلوف يقول: في أحلامي سمعت صوتًا/ هل تحبّ هذه الزهرة، يا حبيب/ أم ورقة من أوراقها/ عندئذ وقعت في حيرة/ فقد كان هذا السؤال الملغز هو سؤال حياتي/ هل أفضّل الجزء على الكل/ أو الكل على الجزء/ لا، إني أريد كليهما/ جزء الكل، والكل/ ولا يكون في هذا الاختيار أي تناقض».
وفي قصائد أخرى تقمص أكيلوف شخصية ديجينيس أكريتاس الذي كان قد وُلد عربيًّا. غير أن الروم قاموا بأسره خلال الحروب الصليبية، فأصبح مسيحيًّا رغمًا عنه. وعندما اكتشف الروم أنه ظل وفيًّا لعروبته، ألقوا به في السجن. وظل هناك إلى أن قضى. غير أن أكيلوف لا يلبث أن يعود إلى محيي الدين بن عربي ليكتب قصيدة عن نظام، وفيها يقول: «الشباب يرقصون ويدقون ساقًا بساق/ والفتيات يغطين وجوههن كل واحدة بنقابها/ كل من الفريقين يعبّر عن رغبته بطريقته/ وهي رغبة متبادلة بينهم/ أما أنت فتبقين خارج مجال الحصول،/ تبقين أنت الواحدة المفردة».
بعد أن أمضى بضع سنوات في لندن، انتقل أكيلوف إلى باريس حيث أقام في فندق متواضع. وكان يقضي جلّ أوقاته في الكتابة، وفي الاستماع إلى سيمفونيات سترافينسكي الذي كان يعشقه. وكانت الكآبة تشتد عليه أحيانًا، حتى إنه فكر أكثر من مرة في الانتحار. ولأنه اكتشف أن التمرد عملية عبثية، مآلها الخيبة والخسران، فإنه ازداد ميلًا إلى العزلة والوحدة. وكانت بلاده السويد، تبدو له من بعيد سوداء قاتمة، كأنها ليل بلا نهاية؛ لذلك كان إحساسه بالغربة شديدًا. وهذا ما تكشفه الأبيات التالية: «أنا غريب في هذه البلاد/ غير أن هذه البلاد ليست غريبة عني/ ليس لي وطن في هذه البلاد/ غير أن هذه البلاد تريد أن تكون لي وطنًا في داخلي!».
ومع اندلاع الحرب الكونية الثانية، بدأ أكيلوف يشعر أن التاريخ معادٍ لآمال الإنسانية، ومطامحها في الحرية، والحب، والعدالة؛ لذا ازداد تشاؤمًا ويأسًا، وأصبح فصل الخريف رمزًا للاحتضار، وللتعفن الشامل. وفي قصيدة بعنوان «مرآة أكتوبر» كتب يقول: «الأعصاب تصرّ بهدوء في الأصيل/ الذي يسيل رماديًّا ولطيفًا عبر النافذة/ والأزهار الحمراء تؤلم قليلًا في الغروب/ والمصباح الكهربائي يغني وحيدًا في الركن/ الصمت يشرب أمطار الخريف الهادئة/ والتي لا تأتي بأي شيء للمحصول الزراعي/ والأيدي المضمومة تتدفأ/ والنظرات الثابتة تتغشى في الجمر./ بالمعجزة التي تلامس المنازل».
ويرى عبدالكبير الخطيبي أن أكيلوف كان يرغب دائمًا في أن يكتب قصائده التي يحضر فيها الشرق على شكل مسبحة مشرقية؛ إذ إن كل قصيدة تبدأ وتنتهي دائمًا بالحركة نفسها. والمسبحة له هي لعبة من ألعاب الجسد. وخاصيتها أنها توقظ الحواس، وتنتظم حباتها تنظيمًا شعريًّا يتكون من تتابع دائري بين الكلمات والاستعارات. وفي الشرق، يتعلم الشاعر لغة الطيور، والملائكة والنساء المتبرجات في ظلال البيوت بعيدًا من أنظار المتطفلين. كما يتعلم كيف ينسج النظرات، والكلمات، والصرخات، والضحكات.
خطورة الحياة وكثافة الأشياء
وفي الليلة الفاصلة بين التاسع والعشرين من شهر فبراير وفاتح مارس 1960م، ضرب زلزال عنيف مدينة أغادير المغربية مخلفًا 50000 قتيل. وكان الشاعر السويدي آرتور لوندكفيست (1906- 1991م) موجودًا في المدينة المنكوبة برفقة زوجته الشاعرة ماريا فين. والاثنان نجيا من الكارثة التي من وحيها كتب الشاعر السويدي قصيدة حملت عنوان «أغادير». وعلى هامش ندوة انتظمت في أغادير يومي 10 و11 إبريل 1997م بحضور زوجة الشاعر، قدم عبدالكبير الخطيبي قراءة لقصيدة لوندكفيست من خلال مداخلة بعنوان «ما بعد الكارثة». وهو يرى أن الشاعر نجح إلى حد بعيد في بلورة صورة شعرية رائعة لمدينة دمرها الزلزال، مثبتًا بذلك أن الشعر قادر على أن يستكشف خطورة الحياة وكثافة الأشياء، وعلى أن يبتكر مجالات جديدة لكل حدث يتسبب في مأساة إنسانية.
وكان الشاعر لوندكفيست بصدد قراءة كتاب لما ضرب الزلزال أغادير. وكان الوقت شهر رمضان. وفي النصوص القديمة نحن نعاين أن الحيوانات والطيور هي التي تبادر بالإعلان عن الكوارث الطبيعية. وفي بداية قصيدته، يتحدث الشاعر عن حمامة تطير من بين صفحات الكتاب وهو في حالة من الانزعاج والخوف. ثم فجأة تهتز الأرض، وتتحول المدينة إلى ركام من الأطلال. وتلك اللحظات العصيبة التي تحدث فيها الكارثة تبدو بلا نهاية. ويكتب الشاعر قائلًا:
أسمع نفسي أصرخ/ كم من الوقت سيدوم كل هذا؟/ عشر ثوان؟/ أكثر؟ أقل؟/ أو أنه لا وقت محددًا لذلك- الوقت انقطع/ فاقدًا امتداده المحدد،/ ربما تكون هناك كرة سوداء من الزمن مضغوطة/ ومثقلة بقرارات سريعة مثل البرق:/ ذلك أن العالم كان قد انبثق من جديد هادئًا، صامتًا،/ والوعي اتحد مرة أخرى بالجسد، وها أنا أجد نفسي حيًّا،/ (أو ربما تكون مجرد فكرة في لحظة الموت).
ويشير عبدالكبير الخطيبي إلى أن لوندكفيست حَوّل قصيدته إلى ملحمة شعرية؛ إذ إن الكوارث الطبيعية لا يليق بها غير ذلك. ومُعلقًا على البيت التالي في القصيدة نفسها: «أغادير، كوني متهيئة، تذكري ما ينتظرنا ربما: الدمار الشامل»، يضيف عبدالكبير الخطيبي قائلًا: «ربما هذه لا بد أن تظل راسخة في قوى الصمت، وفي كل ما هو شاسع وغير مُقَدّر، أو إذا ما نحن أردنا، في ما يشير إلى الوعد. وهكذا نتعلم مع الشعراء أن الحياة مهنة، أو هي فن. وكان لوندكفيست يعلم أن كل واحد منا يحمل في ذاته مزدوجه الذي هو مستعد أن يلعب لعبة الناجي من الموت. وهذا المزدوج هو الصورة الحزينة للشاعر الذي يأخذنا باتجاه العالم الآخر، مثل هاملت الذي يعيد على ركح كل مسارح العالم تكشيرته أمام رعب العدم. وفي حد ذاتها، تكون قصيدة لوندكفيست تجربة قصوى، وتمرينًا يهيّئنا لنهايتنا، تمرينًا حقيقيًّا لتزهدنا، ولاستكشاف قدراتنا».