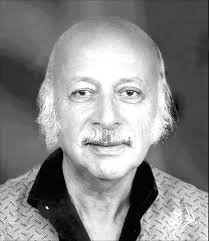يتماهى عبدالفتاح كيليطو مع أصدقائه من الكتاب القدامى كما المحدثين.. لكن، ومهما بقي صاحبنا منشغلا بصداقة ثيرفانطيس وشكسبير وكافكا وبالزاك وبورخيس وبارت، وأقرانهم، إلا أنه يظل أكثر انجذابا إلى أسلافه في تاريخ الأدب العربي الكلاسيكي، من الجاحظ إلى التوحيدي، ومن الهمذاني إلى المعري، ومن ابن حزم إلى ابن رشد، ومن ابن عربي إلى ابن الزيات المغربي.
لم ينشغل عبد الفتاح كيليطو بأعمال هؤلاء وعوالمهم فقط، لكنه تأثر بأساليبهم، واستلهم صيغهم السردية وطرائقهم في الكتابة، حتى وهو يؤلف بالفرنسية… وهنا، ربما، وَرِثَ عنهم واحدة من «أخلاقيات» الكتابة العربية التراثية الخلاقة، وهي «السرقات الأدبية»، كيف لا، والحال أنها التهمة النبيلة التي لم يحظ بشرفها إلا قلة قليلة وغالبة، منذ امرئ القيس مرورا بحسان حتى الفرزدق، ومن البحتري وأبي تمام وأبي نواس إلى غاية المتنبي.
فعن منشورات المتوسط صدر في ميلانو الإيطالية كتاب جديد لعبد الفتاح كيليطو بعنوان «في جو من الندم الفكري»، وهو عنوان أخذه المؤلف، حرفيا، من مقولة لفيلسوف الشعريات والقطائع الإبستيمولوجية غاستون باشلار، مثلما أخذ عنوان كتابه السابق من فرانز كافكا، وهكذا… ذلك أن «الفنان الجيد يستعير، أما الفنان العظيم فيسرق»، كما يقول بيكاسو. وسرقات كيليطو ليست سرية، بل هي معلنة ومدونة في كتبه، بدءا بالاستهلالات التي يُصَدِّرُ بها أعماله، ومنها كتابه هذا الذي يتضمن المقطع الذي نهل منه عنوان الكتاب، منسوبا إلى باشلار، ومطلعه «إذا ما تحررنا من ماضي الأخطاء، فإننا نلفي الحقيقة في جو من الندم الفكري». ألم يقل غاستون باشلار في سياق آخر «إن تاريخ العلم هو تاريخ الأخطاء»؟، مثلما يخبرنا كيليطو في لقاء سابق معلنا «أن تكتب معناه أن تخطئ». (مخلص الصغير، مجلة ثقافات، مارس 2016).
سيرة قارئ
في جو من الندم الفكري، يكاشفنا الناقد المغربي عبدالفتاح كيليطو وهو يكشف عن أسرار صنعته النقدية كما الأدبية، سواء بسواء. فمنذ مطلع كتابه الجديد، يحدد المؤلف جوهر الفرق بين الناقد وصاحب الكتابة الأدبية. فالأول يكتب باسمه الشخصي، ويتحمل عبء ما يقول مباشرة، بينما يخاطب صاحب الكتابة الأدبية قارئه بصفة غير مباشرة، لأنه ينسب الكلام إلى رواة وإلى شخوص آخرين… وكذلك كان كيليطو، صاحب كتابة أدبية، في تجربته النقدية، كما في أعماله التخييلية السردية.
يحكي كيليطو في هذا الكتاب سيرته، أو «سيرة القارئ كيليطو»، منذ أدرك أن في استطاعته مطالعة كتاب بمفرده، «وبالتالي قراءة كل الكتب المتاحة. إنه مكسب تحرزه وحدك، دون أن يساعدك أحد، لا المعلم ولا الأم ولا الأب ولا الأخ الأكبر». وهنا، تبدأ مرحلة جديدة في حياة الإنسان عندما ينتهي من قراءة الكتاب الأول، فيشرع في البحث عن كتب أخرى لاستئناف شغف القراءة، «وإذا بك تخصص وقتك كله للأدب، فيرافقك منذ صغرك ولا تتصور الوجود دونه».
يفتح كيليطو أمامنا خزائن ما قرأ في طفولته، من النصوص الفرنسية أو المترجمة إليها، في مقابل النصوص العربية. كأني به يواصل كتابة تاريخ القراءة، ذلك المبحث الذي أسس له تلميذ بورخيس ألبيرتو مانغيل، وهو يعتبر أن «التاريخ الحقيقي للقراءة هو في الواقع تاريخ كل قارئ مع القراءة».
يذكرنا كيليطو بواقعة طريفة في سيرته مع الكتب، حين تعرف إلى الآداب الأنجلوسكسونية عن طريق الفرنسية، بينما تعرف إلى الآداب الفرنسية عن طريق اللغة العربية، حين قرأ للمنفلوطي، والذي كان ينقل قصصا فرنسية لم يقرأها في الغالب، ولكنه كان يسمع بها شفاهة، ثم يحرر ما بدا له، ولكن بأسلوب متميز جعله يفرض نفسه كمؤلف أصيل. مثلما يذكرنا المؤلف بتجربة أخرى في القراءات الأولى، لمّا قرأ الأدب الأمريكي بالفرنسية، فطالع عوالم وأمكنة لا يعرفها، وبدا له أن الروايات الأمريكية، مثلا، إنما تدور في فضاءات موحشة وبحار نائية…
بعدما ألف مانغيل «تاريخ القراءة»، قدم لنا أكثر من كتاب عن سيرته كقارئ، أخص بالذكر كتاب «يوميات القراءة»، ثم كتاب «فن القراءة»، وفيه يؤكد أن الإنسان حيوان قارئ، وأن القراءة هي التي تميز الإنسان عن غيره، إنها جوهر الكائن الإنساني.
المهنة قارئ
هذا الولع بالقراءة منذ الطفولة هو الذي رسم مصير الطفل كيليطو وحدد مستقبله، فكان من الطبيعي أن يمارس مهنة تدريس الأدب، كما يقول. وبينما تخصص صاحب «الأدب والغرابة» في الأدب الفرنسي، سوى أنه سيعد أطروحة حول مقامات الهمذاني والحريري. هنا، يستأنف كيليطو سرقاته، حين يخبرنا أن أحد الباحثين (لا أتذكر اسمه ولا سياق إشارته، أتذكر فقط أن النص كان بالإنجليزية)، كتب قبل مدة أن مقامات الحريري الخمسين كادت تكون رواية لو راعى فيها مؤلفها ترتيبا زمنيا محكما… ثم يستعرض كيليطو طرح الباحث، وهو يشبّه المقامات بالرواية الشطارية الإسبانية، مثلا، قبل أن يخلص إلى أن الحريري كاد يكون كاتبا أوروبيا، وأنه كتب ما يشبه وعدا بالرواية. هكذا، ينسى كيليطو الباحث ودراسته عن الحريري، لـ”يسرق” أفكاره ويقدمها لنا في صيغة مبتكرة. ألم يقل خلف الأحمر لأبي نواس إن عليه أن يحفظ ألف بيت من الشعر، فلما حفظها طلب منه أن ينسى ما حفظه حتى يكتب…
يحدثنا المؤلف في «سيرته « أيضا، عن فشله الموفق في مجال اللسانيات وإعمالها في تحليل النصوص الأدبية. ويقر صاحبنا بأنه لم يجد نفسه مؤهلا للخوض في التنظير اللساني والأدبي، رغم أنه أفاد كثيرا من أعمال المتخصصين في هذا المضمار. كما يقر بأنه عجز عجزا واضحا عن كتابة دراسة رصينة وفق المعايير الجامعية المعهودة. كما أنني، يقول المؤلف، «لست قادرا على تأليف بحث مستفيض لموضوع ما في فوصل متراصة البناء». ليذكرنا هنا بقصة فشل الحريري في كتابة رواية منسجمة الحكايا متصلة الفصول… وهذا ما يحدد اليوم «أسلوبية كيليطو»، وطريقته الخاصة في الكتابة النقدية، القائمة على الاستطراد والحكي، وإعمال التأويل في القراءة والمقارنة والتحليل. ونكاية في تواضع كيليطو هذا، يمكن أن نسوق ما أورده المفكر عبدالكبير الخطيبي، وهو يقدم كتاب «الأدب والغرابة» لكيليطو، معتبرا أن هذا «المتواضع» بقدر ما «يتمثل نظريات ومناهج التحليل، يتحتم عليه بأن يكون أديبا، وذلك باستبطان الأشكال الإستطيقية لتحليله، حتى يتمكن، ليس فقط من الحديث عنها بدقة، بل، من أن يصبح فنا للكتابة الخصوصية»… ما أسماها الخطيبي «كتابة نقدية بالمعنى العميق».
ولئن كان صاحب «لسان آدم» قد جرى مَجْرَى المؤلفين المغاربة القدامى في الاستطراد والتداعي الحر آناء الكتابة وحين التأليف، لكنه يرفع هذا الأسلوب الرفيع إلى الجاحظ، وهو سيد المستطردين من المؤلفين العرب. وكان الجاحظ قد برر هذا الاختيار الأسلوبي في أكثر من سياق، لَمّا أرجعه إلى تخوفه الشديد من أن يمل القارئ من رتابة الخوض في الموضوع الواحد والإطناب والتفصيل الممل. يشبّه كيليطو مذهب الجاحظ بمذهب أبرز كتاب عصر النهضة في فرنسا، وهو ميشيل دي مونتين، الكاتب الذي رافق الملك شارل التاسع، وكتب أدب الاستطراد الكلاسيكي، على طريقة الكتابة بالقفز والوثب، بتوصيفه. (انظر كتاب: “الكتابة بالقفز والوثب” لعبدالسلام بنعبدالعالي، منشورات المتوسط، ميلانو، 2020).
علاقة بالجاحظ، كان هذا الموسوعي العربي أول من تحدث عن السرقات الأدبية، وقد عرض لها «طردا» في كتاب «الحيوان»، لما عقد فصلا عن «إغارة الشعراء على المعاني»، مقرا بأن «المعاني الأصيلة كلما سبق إليها شاعر سرقها الذين يأتون من بعده. إذ لا يعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام، وفي معنى غريب عجيب، أو في معنى شريف كريم، أو في بديع مخترع، إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده، أو معه، إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره». بهذا المعنى «الخلاق» يمكن الحديث عن سرقات كيليطو، وهو يغريك أيضا بسرقته، كلما تحدثت عن عمل من أعماله.
يشرع كيليطو في تأليف كتاب جديد، فيعقد الفصل الأول أو الثاني لموضوعه. يقيم مقارناته بين الجاحظ وكافكا، بين المعري وبورخيس، بين فن المقامة وفن الرواية، وهكذا… ثم سرعان ما يعود إلى موضوعه الأثير، وإلى نصه المرجعي، ألا وهو نص «ألف ليلة وليلة». هكذا صار شأنه في مصنفاته وتآليفه النقدية الأخيرة. لا ينام كيليطو ولا يرفّ له جفن ما لم يستحضر الليالي، ما لم يستمع لحكاية، وما لم يستمتع بها. سبق أن شَبَّهْتُ هذا الناقدَ بشهريار. كل ناقد هو شهريار بمعنى ما، لا يمكن أن ينام ما لم يستمع إلى حكاية، كي ما يحللها حينما يدركه النهار. في هذا الكتاب يطرح كيليطو سؤالا من هذا القبيل: لماذا لا ينام الناس في الحكاية؟ لماذا لا ينام شهريار ولا تنام شهرزاد وأختها دنيازاد. في ترجمة أنطوان غالان، وهي أول ترجمة لليالي تعود إلى بداية القرن الثامن عشر، يكتشف كيليطو رواية ترجمية أخرى، تقول إن دنيازاد كانت توقظ أختها لكي تروي الحكاية. وفي جميع الحالات، يستيقظ من يروي الحكاية ومن ينصت إليها، ولا أحد ينام في الليالي.
في الفصول الموالية من هذا الكتاب، يعود كيليطو ليتوقف عند ألف ليلة وليلة أكثر من مرة، على عادته في جل كتبه. يتحول كيليطو إلى «شهريار نقدي»، وهو يسعى في سماع حكاية أخرى من الليالي حتى لا ينام. لا يرتد له جفن، وهو يؤول الليالي من جديد، ويعيد ما كتبه السابقون، ويقارن مع ما كتبه الآخرون، فإذا لم يجد ما «يسرقه» من هؤلاء وهؤلاء، يسرق من دراساته السابقة، لأن الناقد الجيد يستعير، أما الناقد العظيم فيسرق، كما تقدم مع بيكاسو. في كل مرة يقدم كيليطو قراءات وتآويل جديدة لليالي، ولغيرها، وهو يعترف أحيانا، بل كثيرا، و»في جو من الندم الفكري»، بأنه طالما أخطأ، وما كان ليكتب لو لم يخطئ…هكذا، يعيد كيليطو قراءة الليالي من جديد، استنادا إلى رؤية جديدة، أو تمثل آخر، أو طبعة أو ترجمة أخرى… وذلك حتى لا تنام شهرزاد ومن معها، وحتى لا تنام الحكايات وتطمئن إلى متعة واحدة. ذلك أن «النص جمال نائم يوقظه القارئ»، بتوصيف أمبرتو إيكو.
يختم المؤلف كتابه هذا بالحديث عن الليلة الأخيرة من الليالي، أي الليلة الواحدة بعد الألف. هي حكاية تنسبها شهرزاد إلى شخص آخر، فيرد عليها شهريار «الحكاية التي حكى إليك صاحبك تشبه لحكاية ملك أنا أعرفه»، كما وردت في طبعة ماكسيمليانوس. ثم ينتبه شهريار إلى أن الحكاية إنما هي حكايته هو، وقد روتها له شهرزاد بضمير الغائب… ثم أعادت على مسامعه القصة الأولى من الليالي، أي القصة الإطار، حيث «غدت القصة الأولى هي الأخيرة، واختتم الكتاب ببدايته».
ينسى كيليطو أو يتناسى الليلة الثانية بعد الستمائة، والتي تحكي فيها شهرزاد حكاية شهريار بشكل مباشر، تقريبا. وهي الحكاية التي يقول عنها بورخيس «أليس رائعا أن يستمع الملك شهريار إلى قصته هو على لسان شهرزاد؟». تروي شهرزاد في هذه الحكاية أن ملكا اختلى بجارية فوجدها بكرا، وأغرم بها، لكنها لم تتكلم في حضرته، فازداد ولعا بها، وأسرّ لها بأنه يتمنى أن تنجب منه ولدا يرث المُلك من بعده. فلما تكلمت وأخبرته أنها حاملة منه، فقال «الحمد لله الذي منّ علي بأمرين كنت أتمناهما، الأول كلامك، والثاني إخبارك إياي بالحمل مني». هكذا، كان الملك متشوقا إلى سماع كلام الجارية، والاستمتاع بحكايتها، قبل سماع خبر الحمل، الذي سيضمن للملك الاستمرارية والخلود.
لنعد إلى الليلة ما بعد الأخيرة، والتي تحكي هي الأخرى حكاية الملك شهريار. فلو لم يستيقظ شهريار من سكرته لأعادت شهرزاد كل ما سبق أن حكته من الليلة الأولى إلى الأخيرة. هكذا، يقع المتلقي تحت تأثير الحكاية و”تخدير” الراوي، فلا يستيقظ من سكرته، ولا ينام. وفي كل ليلة يدخل أحدهم ليسرق الحكاية، ويرويها من جديد.
مخلص الصغير
بتاريخ : 10/09/2021

لم ينشغل عبد الفتاح كيليطو بأعمال هؤلاء وعوالمهم فقط، لكنه تأثر بأساليبهم، واستلهم صيغهم السردية وطرائقهم في الكتابة، حتى وهو يؤلف بالفرنسية… وهنا، ربما، وَرِثَ عنهم واحدة من «أخلاقيات» الكتابة العربية التراثية الخلاقة، وهي «السرقات الأدبية»، كيف لا، والحال أنها التهمة النبيلة التي لم يحظ بشرفها إلا قلة قليلة وغالبة، منذ امرئ القيس مرورا بحسان حتى الفرزدق، ومن البحتري وأبي تمام وأبي نواس إلى غاية المتنبي.
فعن منشورات المتوسط صدر في ميلانو الإيطالية كتاب جديد لعبد الفتاح كيليطو بعنوان «في جو من الندم الفكري»، وهو عنوان أخذه المؤلف، حرفيا، من مقولة لفيلسوف الشعريات والقطائع الإبستيمولوجية غاستون باشلار، مثلما أخذ عنوان كتابه السابق من فرانز كافكا، وهكذا… ذلك أن «الفنان الجيد يستعير، أما الفنان العظيم فيسرق»، كما يقول بيكاسو. وسرقات كيليطو ليست سرية، بل هي معلنة ومدونة في كتبه، بدءا بالاستهلالات التي يُصَدِّرُ بها أعماله، ومنها كتابه هذا الذي يتضمن المقطع الذي نهل منه عنوان الكتاب، منسوبا إلى باشلار، ومطلعه «إذا ما تحررنا من ماضي الأخطاء، فإننا نلفي الحقيقة في جو من الندم الفكري». ألم يقل غاستون باشلار في سياق آخر «إن تاريخ العلم هو تاريخ الأخطاء»؟، مثلما يخبرنا كيليطو في لقاء سابق معلنا «أن تكتب معناه أن تخطئ». (مخلص الصغير، مجلة ثقافات، مارس 2016).
سيرة قارئ
في جو من الندم الفكري، يكاشفنا الناقد المغربي عبدالفتاح كيليطو وهو يكشف عن أسرار صنعته النقدية كما الأدبية، سواء بسواء. فمنذ مطلع كتابه الجديد، يحدد المؤلف جوهر الفرق بين الناقد وصاحب الكتابة الأدبية. فالأول يكتب باسمه الشخصي، ويتحمل عبء ما يقول مباشرة، بينما يخاطب صاحب الكتابة الأدبية قارئه بصفة غير مباشرة، لأنه ينسب الكلام إلى رواة وإلى شخوص آخرين… وكذلك كان كيليطو، صاحب كتابة أدبية، في تجربته النقدية، كما في أعماله التخييلية السردية.
يحكي كيليطو في هذا الكتاب سيرته، أو «سيرة القارئ كيليطو»، منذ أدرك أن في استطاعته مطالعة كتاب بمفرده، «وبالتالي قراءة كل الكتب المتاحة. إنه مكسب تحرزه وحدك، دون أن يساعدك أحد، لا المعلم ولا الأم ولا الأب ولا الأخ الأكبر». وهنا، تبدأ مرحلة جديدة في حياة الإنسان عندما ينتهي من قراءة الكتاب الأول، فيشرع في البحث عن كتب أخرى لاستئناف شغف القراءة، «وإذا بك تخصص وقتك كله للأدب، فيرافقك منذ صغرك ولا تتصور الوجود دونه».
يفتح كيليطو أمامنا خزائن ما قرأ في طفولته، من النصوص الفرنسية أو المترجمة إليها، في مقابل النصوص العربية. كأني به يواصل كتابة تاريخ القراءة، ذلك المبحث الذي أسس له تلميذ بورخيس ألبيرتو مانغيل، وهو يعتبر أن «التاريخ الحقيقي للقراءة هو في الواقع تاريخ كل قارئ مع القراءة».
يذكرنا كيليطو بواقعة طريفة في سيرته مع الكتب، حين تعرف إلى الآداب الأنجلوسكسونية عن طريق الفرنسية، بينما تعرف إلى الآداب الفرنسية عن طريق اللغة العربية، حين قرأ للمنفلوطي، والذي كان ينقل قصصا فرنسية لم يقرأها في الغالب، ولكنه كان يسمع بها شفاهة، ثم يحرر ما بدا له، ولكن بأسلوب متميز جعله يفرض نفسه كمؤلف أصيل. مثلما يذكرنا المؤلف بتجربة أخرى في القراءات الأولى، لمّا قرأ الأدب الأمريكي بالفرنسية، فطالع عوالم وأمكنة لا يعرفها، وبدا له أن الروايات الأمريكية، مثلا، إنما تدور في فضاءات موحشة وبحار نائية…
بعدما ألف مانغيل «تاريخ القراءة»، قدم لنا أكثر من كتاب عن سيرته كقارئ، أخص بالذكر كتاب «يوميات القراءة»، ثم كتاب «فن القراءة»، وفيه يؤكد أن الإنسان حيوان قارئ، وأن القراءة هي التي تميز الإنسان عن غيره، إنها جوهر الكائن الإنساني.
المهنة قارئ
هذا الولع بالقراءة منذ الطفولة هو الذي رسم مصير الطفل كيليطو وحدد مستقبله، فكان من الطبيعي أن يمارس مهنة تدريس الأدب، كما يقول. وبينما تخصص صاحب «الأدب والغرابة» في الأدب الفرنسي، سوى أنه سيعد أطروحة حول مقامات الهمذاني والحريري. هنا، يستأنف كيليطو سرقاته، حين يخبرنا أن أحد الباحثين (لا أتذكر اسمه ولا سياق إشارته، أتذكر فقط أن النص كان بالإنجليزية)، كتب قبل مدة أن مقامات الحريري الخمسين كادت تكون رواية لو راعى فيها مؤلفها ترتيبا زمنيا محكما… ثم يستعرض كيليطو طرح الباحث، وهو يشبّه المقامات بالرواية الشطارية الإسبانية، مثلا، قبل أن يخلص إلى أن الحريري كاد يكون كاتبا أوروبيا، وأنه كتب ما يشبه وعدا بالرواية. هكذا، ينسى كيليطو الباحث ودراسته عن الحريري، لـ”يسرق” أفكاره ويقدمها لنا في صيغة مبتكرة. ألم يقل خلف الأحمر لأبي نواس إن عليه أن يحفظ ألف بيت من الشعر، فلما حفظها طلب منه أن ينسى ما حفظه حتى يكتب…
يحدثنا المؤلف في «سيرته « أيضا، عن فشله الموفق في مجال اللسانيات وإعمالها في تحليل النصوص الأدبية. ويقر صاحبنا بأنه لم يجد نفسه مؤهلا للخوض في التنظير اللساني والأدبي، رغم أنه أفاد كثيرا من أعمال المتخصصين في هذا المضمار. كما يقر بأنه عجز عجزا واضحا عن كتابة دراسة رصينة وفق المعايير الجامعية المعهودة. كما أنني، يقول المؤلف، «لست قادرا على تأليف بحث مستفيض لموضوع ما في فوصل متراصة البناء». ليذكرنا هنا بقصة فشل الحريري في كتابة رواية منسجمة الحكايا متصلة الفصول… وهذا ما يحدد اليوم «أسلوبية كيليطو»، وطريقته الخاصة في الكتابة النقدية، القائمة على الاستطراد والحكي، وإعمال التأويل في القراءة والمقارنة والتحليل. ونكاية في تواضع كيليطو هذا، يمكن أن نسوق ما أورده المفكر عبدالكبير الخطيبي، وهو يقدم كتاب «الأدب والغرابة» لكيليطو، معتبرا أن هذا «المتواضع» بقدر ما «يتمثل نظريات ومناهج التحليل، يتحتم عليه بأن يكون أديبا، وذلك باستبطان الأشكال الإستطيقية لتحليله، حتى يتمكن، ليس فقط من الحديث عنها بدقة، بل، من أن يصبح فنا للكتابة الخصوصية»… ما أسماها الخطيبي «كتابة نقدية بالمعنى العميق».
ولئن كان صاحب «لسان آدم» قد جرى مَجْرَى المؤلفين المغاربة القدامى في الاستطراد والتداعي الحر آناء الكتابة وحين التأليف، لكنه يرفع هذا الأسلوب الرفيع إلى الجاحظ، وهو سيد المستطردين من المؤلفين العرب. وكان الجاحظ قد برر هذا الاختيار الأسلوبي في أكثر من سياق، لَمّا أرجعه إلى تخوفه الشديد من أن يمل القارئ من رتابة الخوض في الموضوع الواحد والإطناب والتفصيل الممل. يشبّه كيليطو مذهب الجاحظ بمذهب أبرز كتاب عصر النهضة في فرنسا، وهو ميشيل دي مونتين، الكاتب الذي رافق الملك شارل التاسع، وكتب أدب الاستطراد الكلاسيكي، على طريقة الكتابة بالقفز والوثب، بتوصيفه. (انظر كتاب: “الكتابة بالقفز والوثب” لعبدالسلام بنعبدالعالي، منشورات المتوسط، ميلانو، 2020).
علاقة بالجاحظ، كان هذا الموسوعي العربي أول من تحدث عن السرقات الأدبية، وقد عرض لها «طردا» في كتاب «الحيوان»، لما عقد فصلا عن «إغارة الشعراء على المعاني»، مقرا بأن «المعاني الأصيلة كلما سبق إليها شاعر سرقها الذين يأتون من بعده. إذ لا يعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام، وفي معنى غريب عجيب، أو في معنى شريف كريم، أو في بديع مخترع، إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده، أو معه، إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره». بهذا المعنى «الخلاق» يمكن الحديث عن سرقات كيليطو، وهو يغريك أيضا بسرقته، كلما تحدثت عن عمل من أعماله.
يشرع كيليطو في تأليف كتاب جديد، فيعقد الفصل الأول أو الثاني لموضوعه. يقيم مقارناته بين الجاحظ وكافكا، بين المعري وبورخيس، بين فن المقامة وفن الرواية، وهكذا… ثم سرعان ما يعود إلى موضوعه الأثير، وإلى نصه المرجعي، ألا وهو نص «ألف ليلة وليلة». هكذا صار شأنه في مصنفاته وتآليفه النقدية الأخيرة. لا ينام كيليطو ولا يرفّ له جفن ما لم يستحضر الليالي، ما لم يستمع لحكاية، وما لم يستمتع بها. سبق أن شَبَّهْتُ هذا الناقدَ بشهريار. كل ناقد هو شهريار بمعنى ما، لا يمكن أن ينام ما لم يستمع إلى حكاية، كي ما يحللها حينما يدركه النهار. في هذا الكتاب يطرح كيليطو سؤالا من هذا القبيل: لماذا لا ينام الناس في الحكاية؟ لماذا لا ينام شهريار ولا تنام شهرزاد وأختها دنيازاد. في ترجمة أنطوان غالان، وهي أول ترجمة لليالي تعود إلى بداية القرن الثامن عشر، يكتشف كيليطو رواية ترجمية أخرى، تقول إن دنيازاد كانت توقظ أختها لكي تروي الحكاية. وفي جميع الحالات، يستيقظ من يروي الحكاية ومن ينصت إليها، ولا أحد ينام في الليالي.
في الفصول الموالية من هذا الكتاب، يعود كيليطو ليتوقف عند ألف ليلة وليلة أكثر من مرة، على عادته في جل كتبه. يتحول كيليطو إلى «شهريار نقدي»، وهو يسعى في سماع حكاية أخرى من الليالي حتى لا ينام. لا يرتد له جفن، وهو يؤول الليالي من جديد، ويعيد ما كتبه السابقون، ويقارن مع ما كتبه الآخرون، فإذا لم يجد ما «يسرقه» من هؤلاء وهؤلاء، يسرق من دراساته السابقة، لأن الناقد الجيد يستعير، أما الناقد العظيم فيسرق، كما تقدم مع بيكاسو. في كل مرة يقدم كيليطو قراءات وتآويل جديدة لليالي، ولغيرها، وهو يعترف أحيانا، بل كثيرا، و»في جو من الندم الفكري»، بأنه طالما أخطأ، وما كان ليكتب لو لم يخطئ…هكذا، يعيد كيليطو قراءة الليالي من جديد، استنادا إلى رؤية جديدة، أو تمثل آخر، أو طبعة أو ترجمة أخرى… وذلك حتى لا تنام شهرزاد ومن معها، وحتى لا تنام الحكايات وتطمئن إلى متعة واحدة. ذلك أن «النص جمال نائم يوقظه القارئ»، بتوصيف أمبرتو إيكو.
يختم المؤلف كتابه هذا بالحديث عن الليلة الأخيرة من الليالي، أي الليلة الواحدة بعد الألف. هي حكاية تنسبها شهرزاد إلى شخص آخر، فيرد عليها شهريار «الحكاية التي حكى إليك صاحبك تشبه لحكاية ملك أنا أعرفه»، كما وردت في طبعة ماكسيمليانوس. ثم ينتبه شهريار إلى أن الحكاية إنما هي حكايته هو، وقد روتها له شهرزاد بضمير الغائب… ثم أعادت على مسامعه القصة الأولى من الليالي، أي القصة الإطار، حيث «غدت القصة الأولى هي الأخيرة، واختتم الكتاب ببدايته».
ينسى كيليطو أو يتناسى الليلة الثانية بعد الستمائة، والتي تحكي فيها شهرزاد حكاية شهريار بشكل مباشر، تقريبا. وهي الحكاية التي يقول عنها بورخيس «أليس رائعا أن يستمع الملك شهريار إلى قصته هو على لسان شهرزاد؟». تروي شهرزاد في هذه الحكاية أن ملكا اختلى بجارية فوجدها بكرا، وأغرم بها، لكنها لم تتكلم في حضرته، فازداد ولعا بها، وأسرّ لها بأنه يتمنى أن تنجب منه ولدا يرث المُلك من بعده. فلما تكلمت وأخبرته أنها حاملة منه، فقال «الحمد لله الذي منّ علي بأمرين كنت أتمناهما، الأول كلامك، والثاني إخبارك إياي بالحمل مني». هكذا، كان الملك متشوقا إلى سماع كلام الجارية، والاستمتاع بحكايتها، قبل سماع خبر الحمل، الذي سيضمن للملك الاستمرارية والخلود.
لنعد إلى الليلة ما بعد الأخيرة، والتي تحكي هي الأخرى حكاية الملك شهريار. فلو لم يستيقظ شهريار من سكرته لأعادت شهرزاد كل ما سبق أن حكته من الليلة الأولى إلى الأخيرة. هكذا، يقع المتلقي تحت تأثير الحكاية و”تخدير” الراوي، فلا يستيقظ من سكرته، ولا ينام. وفي كل ليلة يدخل أحدهم ليسرق الحكاية، ويرويها من جديد.
مخلص الصغير
بتاريخ : 10/09/2021

سرقات كيليطو - AL ITIHAD
يتماهى عبدالفتاح كيليطو مع أصدقائه من الكتاب القدامى كما المحدثين.. لكن، ومهما بقي صاحبنا منشغلا بصداقة ثيرفانطيس وشكسبير وكافكا وبالزاك
alittihad.info