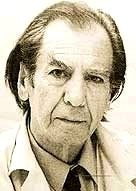«القاضي الحاجّ حمّاد يتذكَّر هذا جيّداً : حين جاءت الخادمة التي عنده لتخبره بأن متشرِّداً أشعث الشعر ورثيث الثياب ينتظره بالباب، كانت دادا مسعودة عاكفة على تحضير قصعة «العصيدة» احتفاءً بذكرى مولد النبي.
كان اليوم، إذن، يوم عيد المولد، وكانت العادة، في مثل هذا اليوم، أن يفطر الناس في الصباح الباكر، فيحتسون «العصيدة» بواسطة ملاعق خشبية يغمسونها في صحن من الخزف الصيني يطفح بـ «السميدة» المخلوطة بعسل داكن عَطِرِ الرائحة.
وقد خاطب الحاج حمّاد خادمته الزهرة، قائلاً لها إنه لا يعرف أيّ متشرِّد، ولا يرغب في معرفة واحد من فصيلة الناس هؤلاء، لكنها أجابته بأن مَنْ ينتظره بالباب لا شبه له، إطلاقاً، بأولئك المتسوِّلين المألوفين، وبأن النور يسطع من وجهه.
لكِ خيال جيّاش، قال لها.
ثم توجَّه نحو الباب، يحدوه في ذلك بعض الفضول، وخاصّةً رغبته، في يوم العيد هذا، في عدم معاكسة خادمته الصغيرة التي كان يعاملها معاملة ابنته، فوجد الرجل واقفاً مستنداً إلى الحائط المبنيّ بالآجر. كان طويل القامة، تشعّ عيناه بجمال فتّان، وتوحي هيأته، على رغم أسماله وآثار التعب في وجهه، بعزّة النفس والوقار. فإذا بالقاضي يتساءل مبهوتاً: هل هو في حضرة سلطان خرافيّ متنكِّر في هيئة متسوِّل انبعث، فجأةً، من أعماق زمان غابر، وأقبل إليه لينعم عليه بالمال والجاه؟
وقبل أن يفتح المتشرِّد فمه، بادره الحاجّ حمّاد القول :
– مولاي، الدار دارك، هلّا تفضَّلت بالدخول. ستأكل إذا كنت جوعان، وستشرب إذا كنت عطشان. نزِّلْني منزلة أخيك، ولا تتصرَّف في داري تصرُّف الغريب.
– إذا كنتُ طرقتُ بابك، فلأن يداً خيِّرة اقتادتني إليك. أشعر بأن ما قلتَه، قبل حين، لا لياقة فيه، ولا مجاملة. أجل، سأدخل، أ الحاجّ حمّاد، هيّا بنا، قدّم لنا «العصيدة» بالعسل حتى نحتفل معاً بالحدث الأعظم؛ مولدِ خير البشر، وأجمل نور في الكون.
ثم اتَّجه الرجلان نحو قاعة الاستقبال، وجلسا على أريكتَيْن فاخرتَيْن مكسوّتَيْن بالحرير، وتبادلا، في أثناء الأكل، أطراف الحديث على ضوء نور خافت، كرفيقَيْن متوادَّيْن عركتهما تصاريف الدهر، وخبِرا بني آدم، وأفراحهم وأتراحهم. ولمّا أنهيا الأكل، اقترح القاضي على ضيفه، بلين وتأدُّب، أن يقيم في غرفة بمؤخَّر الحديقة، حيث يمكنه، بحرّية، وبدون كلفة، أن يصلّي أو يستريح، وهو ما وافقه عليه، دونما اعتراض أو تحفُّظ.
في إثر ذلك، خرج الحاجّ حمّاد لملاقاة أصحابه وأصدقائه الاعتياديِّين، لكنه لم يخبرهم بما حدث. وفي المساء، وبعد صلاة العشاء، عاد إلى داره، حيث استفسر خدّامه عن أحوال ضيفه، فأخبروه بأنه لم يغادر الغرفة طيلة اليوم، ولم يطلب طعاماً أو شراباً. فظنّ الحاجّ حمّاد أن ضيفه، ربّما يكون آثر أن ينام ليستريح، ويستعيد عافيته، فقصد غرفة الحديقة ليوقظه، ويعرض عليه أن يشاركه طعام العشاء؛ عسى ذلك أن يخفِّف تعبه، فوجد الرجل متمدِّداً فوق الفراش، متسربلاً بقميص أبيض، طويل ومرقَّع، لكنه نظيف، فبادر في عتبة الباب إلى تحيَّته بما يقتضيه الأدب:
السلام عليكم. فردَّ عليه:
وعليكم السلام. أنا عاجز عن القيام لاستقبالك، أيُّها الأخ الكريم، فمعذرة. لقد مشيت مدّة طويلة لأجل ملاقاتك، لكنني لم أكن أتصوَّر أن موتي مقدّر عليّ في ضيافتك. أنا، الآن، موقن بذلك. أترجّاك، إذن، أن تلبّي لي رغبة أخيرة: أحضِرْ لي أوراقاً بيضاء ومداداً وريشات للكتابة،فأنا حريص على أن أترك لك تذكاراً يكون بمنزلة تعبير مني عن سعادتي بالتعرُّف إليك..
فقاطعه الحاج حمّاد:
ماذا تقول، يا مولاي؟ دعك من الكلام عن الموت، لعلَّ برد الليالي، في أثناء ترحالك، قد جمَّد الدم في عروقك، وهذا يوجعك الآن، أو لعلَّ جسدك في حاجة إلى الراحة وإلى أطعمة مقوِّية. سأطلب إحضار طبيب ليلطِّف آلامك.
لا داعي لذلك أ الحاج حمّاد، فأنا لا أتألَّم. لست مريضاً. كلّ ما في الأمر أن أجَلي قد حان. أحْضِر لي الأوراق والمداد والريشات، وستعرف سبب رحلتي إليك، ومعناها، والغاية منها. هيّا، أ الحاج حمّاد، نفِّذ طلبي بسرعة. أحسُّ أن جسدي سيسلم روحه لبارئها.
أرخى القاضي عينيه في استسلام، ينظر إلى الأرض متنهِّداً، ثم قصد دولاباً أخرج منه حزمة أوراق، ودواة، وريشات من قصب، ثم وضعها بين يدي الرجل المحتضر، وقبل أن ينصرف، سأله إن كان يريد أن يأكل أو يشرب، فأجابه بالرفض، راغباً، فقط، في كمِّية كبيرة من الشموع، وبعد أن زوَّده بها، ودّعه، والتحق بأهله.
وفي صباح الغد، زار الحاج حمّاد ضيفه باكراً، متمنِّياً له يوماً سعيداً ومستفسراً عن حاله. وبكثير من الجهد، أجابه بطيف ابتسامة، مؤكِّداً له أن ما بقي له من قوّة سيكفيه، بعون الله، لإنهاء ما تعاهد مع نفسه على إنجازه. كان مظهره يوحي بالدعة والهدوء وهو منهمك في الكتابة، رافعاً ركبته، مسنداً ظهره إلى مخدّات، وبجانبه كانت أوراق كثيرة متراكمة مكتوبة بخطّ أنيق. ومرّةً أخرى، امتنع عن الأكل والشرب.
وفي المساء، عاد القاضي إلى زيارته. كانت الأوراق تتكدَّس فوق الأوراق من غير أن يبارح الرجل فراشه.
وفي اليوم الثالث، وقبل أن يلتحق الحاجّ حمّاد بأهله، عرّج جهة الحديقة، فكان أن لفت انتباهه استغراق الغرفة في ظلام مطبق. حيَّره الأمر، ثم بدأ ينادي، مرّةً تلو الأخرى: مولاي! يا مولاي! لكن الصمت كان وحده ما يجيب، فأسرع لإحضار فانوس، واقتحم الغرفة. كانت آخر شمعة قد انطفأت، بعد أن انقضت ذبالتها في مشكاة نحاسية، وأكداس الأوراق متناثرة على الأرض، غير بعيد عن الفراش، حيث كان الرجل مضطجعاً على ظهره، فاغر العينين، مرتخية قسمات وجهه. فاقترب منه، وحقَّق النظر فيه مليّاً قبل أن يطبق جفنيه بحركة في منتهى الرقّة واللطف، ثم تربَّع مباشرةً على الأرض، وشرع في تلاوة سورة من القرآن».
***
قل لنا، أ الحاجّ حمّاد: ما اسم هذا الرجل؟، وما مصير مخطوطه؟، وهل هو صالح للنشر؟
أبداً، لم أسأل ضيف الأيّام الثلاثة عن اسمه. أمّا المخطوط الذي ملّكني إيّاه، فمعظمه أضرمتُ فيه النار في لحظة تهوّر واستخفاف، حيث لم أحتفظ منه إلا بهذا النزر اليسير. هاؤم، اقرأوا أوراقه:
يا صِحابي..
أضع بين أيديكم عصارة تجربتي الطويلة والمؤلمة في الحياة، فلا تتخذنّها هزؤاً. انظروا إليها نظرة رفق ورأفة. تعرفون كم أنا فقير، ومع ذلك أمنحكم الكثير. فهلاّ تتقبّلون هبّة قلبٍ بسيط رهيف، قلب مفعم بالمحبّة والإخاء، فلا تُعرضوا عنه بابتسامة سخرية.
مأوايَ الطيني البارد يتَّسع لاستقبالكم، أدعوكم ليلاً إلى الروابي، لتشاركوني رؤاي وهَلْوساتي. تعالوا أنّى شئتم لنتسكَّع معاً في دروبي العتيقة، ولا تنسوا أن تأخذوا ملء أيديكم، باقات صور. إذا كنتم يائسين أو مكتئبين، فسأعلّمكم أناشيد تحبّب الحياة إليكم، وتشيع البهجة في أنفسكم.
يا صِحابي..
نحن نتكلَّم اللّغة نفسها، أليس كذلك؟ فلننسَ أرذل العمر، ولنعد إلى لهونا ومرحنا. أوصيكم بإدمان الضحك. ليس في نيَّتي أن أعِظكم. حسبي أني أستعذب مخاطبتكم. فما أحلى أن يتكلَّم المرء مع أصدقائه في أوقات الشدّة والوحدة. قولوا عني إني ثرثار، قولوا عني إني كسلان، انعتوني بالبلَه أو بالهبل، فلن يهمَّني كلّ هذا. أمّا أنا، فلن أفصح عن رأيي فيكم. لن أدينكم. أنا، كما أنتم، غير معصوم من التناقض والخطأ. خليط أنا من الغرور والأنانية… ألم يُخلق الإنسان ضعيفاً؟ لكني، كما أنتم، أتطلَّع إلى الحقيقة، وأصبو، كما أنتم، إلى المحبّة والتسامح. نحن جميعاً مدعوّون إلى الوليمة نفسها. لنأكل من الصحن نفسه، ولنشرب من القدح نفسه. لا تبعدوني عنكم كما لو كنت مصاباً بالطاعون.
إن من لا يخدم عشيرته لا يمكنه إلّا أن يسيء إليها. لكن، مَن يخدم مَن؟ بل ما معنى أن تخدم أحداً؟ لماذا إكراه الشاعر على أن يهتمّ بعالم يرفضه؟ إن تمجيد الغباوة ليس، أبداً، ديدنه.
كثيراً ما تقولون لنا، نحن -زمرة الشعراء-: تكلَّموا بلغة نستطيع فهمها، أو أمسكوا عن الكلام ! أمّا أنا، فأقول لكم : مهما تحاولوا عن الكلام ردعي، فما أنا بصامت! افهموا بأنفسكم، إن كنتم ترغبون في ذلك، وإلّا فلديكم ما شاء الله من فقهاء اللّغة والأساتذة والمنظّرين والجغرافيِّين والمؤرِّخين والعلماء ليساعدوكم على الفهم.
لا شيء عندي أعلّمكم إيّاه. أنا نفسي لا أعرف شيئاً. تتحدَّثون عن الحرّيّة ! كونوا معي أسخياء، وامنحوني حرّيّة أن أحلم، وأن أغنّي في أوقات فراغي. امنحوني حرّيّة أن أتدبَّر ذاتي كما أشاء، لأكون كما أشاء. امنحوني -باختصار- حرّيّة أن أحقِّق فرحي الأسمى.
لن أحكي لكم ما رأيته بأمّ عيني، وأنتم لم تبوحوا لي بأيّة أسرار. إن عالم الكلمات هو عالمي، فالكلمات أدوات عملي. إنها موادّ حيّة، جواهر جوهرية. حاجتي ماسّة إلى كلمات تطفح بالشمس والألوان. تارةً، أنا موسيقيّ، وتارةً رسّام، لكن العالم الذي أترنَّم به، وأرسمه ليس عالمكم. بحثتُ عنه في الواقع، فوجدته في أحلامي.
كيف يمكن لي أن أسيء إلى عشيرتي؟ هي تملك السلطة… دمغتْ جسدي بالنار… قيَّدتْ اسمي في سجلّاتها الكبيرة… أمرتني بالطاعة… فانبطحتُ أمام أعيانها من أجل قسط من الراحة.. وكلّ يوم أقتل بعضاً من كياني؛ تلبيةً لنداء الواجب المقيت. فليكن. أنا راض بما يمليه عليّ قانون العشيرة. لا أتمرَّد، ولا أصرخ. إذا كنت لا أستحقّ أن آكل من الكعكة، فلن أمدّ إليها يدي، وإذا كان ماء هذه العين محبّساً على حلقوم ما، محظوظ، فلن يتطاول عليه فمي.
كلوا واشربوا -يا أصحابي- هنيئاً مريئاً، فخيرات الدنيا كلّها ملككم. عندكم شعراء ليخلّدوا مناقبكم، ويتغنّوا بلوعات الشوق في قلوبكم، ويُثنوا على آلهتكم. لديكم بهاليل يُنسُونكم ملل الاحتفالات الرسمية وقساوة الطقوس الدينية. تتفرَّجون على هرجهم الذي يستثير الضحك، وعلى مرجهم الذي يستدرّ الشفقة.
أيا صِحابي..
نهبتموني، ولمّا ينضب جشعكم. ماذا يهمّني أن أكون فقيراً؟ دعوني أخفِّف أحزاني. دعوني أغنِّ على مقام الألحان الذي يعجبني. اتركوا لي حرّيّة أن أختار موضوعات قصائدي. لا تنصتوا إلى أهازيجي، إن كانت لا تطربكم. وإذا شنَّفت إحداها آذانكم، فأنا أعرف ما ستقولونه، ستقولون: « إنه صوت شاعر آخر يدّعيه لنفسه». لا، صدِّقوني. فالصوت الذي تكونون قد استمعتم إليه، هو ما حباني الله -تعالى- إيّاه، فشكراً على نعمه.
كنت أصبحت غصناً ميِّتاً تذروه ريح الخريف، فشكراً لك، يا مولاي، على أن أرجعت لي غنائي. أحسّ برياح لواقح تسري في عروقي. يُخيَّل إليّ أن براعم تنبت، ببطء، في جسدي، وتوشك أن تتفتَّح عن أزاهير. ها قد عادت الشمس بعد طول انكساف عن كياني، طوال سباتي. هي ذي أشعَّتها تنعشني، كالسهام تخترقني، الدفء تبثّه في أعضائي، فترقص لها فرحاً روحي. فيا لروعة الفتنة التي تنبعث من هذا الضياء!
إلهي، كم يخيفني البرد والليل! ملكوتك يدعوني، الآن، إليه. لا وقت لي للحقد، ولا اقتدار لي على الخصام».
***
أخبِرنا، أ الحاج حمّاد، بما تلمّح إليه هذه الأوراق…
لا أعرف، لا أعرف، ثم ماذا عساها أن تلمّح إليه من معانٍ؟ حسْبُها أنها رسالة من صديق ائتمنني عليها.
كان اليوم، إذن، يوم عيد المولد، وكانت العادة، في مثل هذا اليوم، أن يفطر الناس في الصباح الباكر، فيحتسون «العصيدة» بواسطة ملاعق خشبية يغمسونها في صحن من الخزف الصيني يطفح بـ «السميدة» المخلوطة بعسل داكن عَطِرِ الرائحة.
وقد خاطب الحاج حمّاد خادمته الزهرة، قائلاً لها إنه لا يعرف أيّ متشرِّد، ولا يرغب في معرفة واحد من فصيلة الناس هؤلاء، لكنها أجابته بأن مَنْ ينتظره بالباب لا شبه له، إطلاقاً، بأولئك المتسوِّلين المألوفين، وبأن النور يسطع من وجهه.
لكِ خيال جيّاش، قال لها.
ثم توجَّه نحو الباب، يحدوه في ذلك بعض الفضول، وخاصّةً رغبته، في يوم العيد هذا، في عدم معاكسة خادمته الصغيرة التي كان يعاملها معاملة ابنته، فوجد الرجل واقفاً مستنداً إلى الحائط المبنيّ بالآجر. كان طويل القامة، تشعّ عيناه بجمال فتّان، وتوحي هيأته، على رغم أسماله وآثار التعب في وجهه، بعزّة النفس والوقار. فإذا بالقاضي يتساءل مبهوتاً: هل هو في حضرة سلطان خرافيّ متنكِّر في هيئة متسوِّل انبعث، فجأةً، من أعماق زمان غابر، وأقبل إليه لينعم عليه بالمال والجاه؟
وقبل أن يفتح المتشرِّد فمه، بادره الحاجّ حمّاد القول :
– مولاي، الدار دارك، هلّا تفضَّلت بالدخول. ستأكل إذا كنت جوعان، وستشرب إذا كنت عطشان. نزِّلْني منزلة أخيك، ولا تتصرَّف في داري تصرُّف الغريب.
– إذا كنتُ طرقتُ بابك، فلأن يداً خيِّرة اقتادتني إليك. أشعر بأن ما قلتَه، قبل حين، لا لياقة فيه، ولا مجاملة. أجل، سأدخل، أ الحاجّ حمّاد، هيّا بنا، قدّم لنا «العصيدة» بالعسل حتى نحتفل معاً بالحدث الأعظم؛ مولدِ خير البشر، وأجمل نور في الكون.
ثم اتَّجه الرجلان نحو قاعة الاستقبال، وجلسا على أريكتَيْن فاخرتَيْن مكسوّتَيْن بالحرير، وتبادلا، في أثناء الأكل، أطراف الحديث على ضوء نور خافت، كرفيقَيْن متوادَّيْن عركتهما تصاريف الدهر، وخبِرا بني آدم، وأفراحهم وأتراحهم. ولمّا أنهيا الأكل، اقترح القاضي على ضيفه، بلين وتأدُّب، أن يقيم في غرفة بمؤخَّر الحديقة، حيث يمكنه، بحرّية، وبدون كلفة، أن يصلّي أو يستريح، وهو ما وافقه عليه، دونما اعتراض أو تحفُّظ.
في إثر ذلك، خرج الحاجّ حمّاد لملاقاة أصحابه وأصدقائه الاعتياديِّين، لكنه لم يخبرهم بما حدث. وفي المساء، وبعد صلاة العشاء، عاد إلى داره، حيث استفسر خدّامه عن أحوال ضيفه، فأخبروه بأنه لم يغادر الغرفة طيلة اليوم، ولم يطلب طعاماً أو شراباً. فظنّ الحاجّ حمّاد أن ضيفه، ربّما يكون آثر أن ينام ليستريح، ويستعيد عافيته، فقصد غرفة الحديقة ليوقظه، ويعرض عليه أن يشاركه طعام العشاء؛ عسى ذلك أن يخفِّف تعبه، فوجد الرجل متمدِّداً فوق الفراش، متسربلاً بقميص أبيض، طويل ومرقَّع، لكنه نظيف، فبادر في عتبة الباب إلى تحيَّته بما يقتضيه الأدب:
السلام عليكم. فردَّ عليه:
وعليكم السلام. أنا عاجز عن القيام لاستقبالك، أيُّها الأخ الكريم، فمعذرة. لقد مشيت مدّة طويلة لأجل ملاقاتك، لكنني لم أكن أتصوَّر أن موتي مقدّر عليّ في ضيافتك. أنا، الآن، موقن بذلك. أترجّاك، إذن، أن تلبّي لي رغبة أخيرة: أحضِرْ لي أوراقاً بيضاء ومداداً وريشات للكتابة،فأنا حريص على أن أترك لك تذكاراً يكون بمنزلة تعبير مني عن سعادتي بالتعرُّف إليك..
فقاطعه الحاج حمّاد:
ماذا تقول، يا مولاي؟ دعك من الكلام عن الموت، لعلَّ برد الليالي، في أثناء ترحالك، قد جمَّد الدم في عروقك، وهذا يوجعك الآن، أو لعلَّ جسدك في حاجة إلى الراحة وإلى أطعمة مقوِّية. سأطلب إحضار طبيب ليلطِّف آلامك.
لا داعي لذلك أ الحاج حمّاد، فأنا لا أتألَّم. لست مريضاً. كلّ ما في الأمر أن أجَلي قد حان. أحْضِر لي الأوراق والمداد والريشات، وستعرف سبب رحلتي إليك، ومعناها، والغاية منها. هيّا، أ الحاج حمّاد، نفِّذ طلبي بسرعة. أحسُّ أن جسدي سيسلم روحه لبارئها.
أرخى القاضي عينيه في استسلام، ينظر إلى الأرض متنهِّداً، ثم قصد دولاباً أخرج منه حزمة أوراق، ودواة، وريشات من قصب، ثم وضعها بين يدي الرجل المحتضر، وقبل أن ينصرف، سأله إن كان يريد أن يأكل أو يشرب، فأجابه بالرفض، راغباً، فقط، في كمِّية كبيرة من الشموع، وبعد أن زوَّده بها، ودّعه، والتحق بأهله.
وفي صباح الغد، زار الحاج حمّاد ضيفه باكراً، متمنِّياً له يوماً سعيداً ومستفسراً عن حاله. وبكثير من الجهد، أجابه بطيف ابتسامة، مؤكِّداً له أن ما بقي له من قوّة سيكفيه، بعون الله، لإنهاء ما تعاهد مع نفسه على إنجازه. كان مظهره يوحي بالدعة والهدوء وهو منهمك في الكتابة، رافعاً ركبته، مسنداً ظهره إلى مخدّات، وبجانبه كانت أوراق كثيرة متراكمة مكتوبة بخطّ أنيق. ومرّةً أخرى، امتنع عن الأكل والشرب.
وفي المساء، عاد القاضي إلى زيارته. كانت الأوراق تتكدَّس فوق الأوراق من غير أن يبارح الرجل فراشه.
وفي اليوم الثالث، وقبل أن يلتحق الحاجّ حمّاد بأهله، عرّج جهة الحديقة، فكان أن لفت انتباهه استغراق الغرفة في ظلام مطبق. حيَّره الأمر، ثم بدأ ينادي، مرّةً تلو الأخرى: مولاي! يا مولاي! لكن الصمت كان وحده ما يجيب، فأسرع لإحضار فانوس، واقتحم الغرفة. كانت آخر شمعة قد انطفأت، بعد أن انقضت ذبالتها في مشكاة نحاسية، وأكداس الأوراق متناثرة على الأرض، غير بعيد عن الفراش، حيث كان الرجل مضطجعاً على ظهره، فاغر العينين، مرتخية قسمات وجهه. فاقترب منه، وحقَّق النظر فيه مليّاً قبل أن يطبق جفنيه بحركة في منتهى الرقّة واللطف، ثم تربَّع مباشرةً على الأرض، وشرع في تلاوة سورة من القرآن».
***
قل لنا، أ الحاجّ حمّاد: ما اسم هذا الرجل؟، وما مصير مخطوطه؟، وهل هو صالح للنشر؟
أبداً، لم أسأل ضيف الأيّام الثلاثة عن اسمه. أمّا المخطوط الذي ملّكني إيّاه، فمعظمه أضرمتُ فيه النار في لحظة تهوّر واستخفاف، حيث لم أحتفظ منه إلا بهذا النزر اليسير. هاؤم، اقرأوا أوراقه:
يا صِحابي..
أضع بين أيديكم عصارة تجربتي الطويلة والمؤلمة في الحياة، فلا تتخذنّها هزؤاً. انظروا إليها نظرة رفق ورأفة. تعرفون كم أنا فقير، ومع ذلك أمنحكم الكثير. فهلاّ تتقبّلون هبّة قلبٍ بسيط رهيف، قلب مفعم بالمحبّة والإخاء، فلا تُعرضوا عنه بابتسامة سخرية.
مأوايَ الطيني البارد يتَّسع لاستقبالكم، أدعوكم ليلاً إلى الروابي، لتشاركوني رؤاي وهَلْوساتي. تعالوا أنّى شئتم لنتسكَّع معاً في دروبي العتيقة، ولا تنسوا أن تأخذوا ملء أيديكم، باقات صور. إذا كنتم يائسين أو مكتئبين، فسأعلّمكم أناشيد تحبّب الحياة إليكم، وتشيع البهجة في أنفسكم.
يا صِحابي..
نحن نتكلَّم اللّغة نفسها، أليس كذلك؟ فلننسَ أرذل العمر، ولنعد إلى لهونا ومرحنا. أوصيكم بإدمان الضحك. ليس في نيَّتي أن أعِظكم. حسبي أني أستعذب مخاطبتكم. فما أحلى أن يتكلَّم المرء مع أصدقائه في أوقات الشدّة والوحدة. قولوا عني إني ثرثار، قولوا عني إني كسلان، انعتوني بالبلَه أو بالهبل، فلن يهمَّني كلّ هذا. أمّا أنا، فلن أفصح عن رأيي فيكم. لن أدينكم. أنا، كما أنتم، غير معصوم من التناقض والخطأ. خليط أنا من الغرور والأنانية… ألم يُخلق الإنسان ضعيفاً؟ لكني، كما أنتم، أتطلَّع إلى الحقيقة، وأصبو، كما أنتم، إلى المحبّة والتسامح. نحن جميعاً مدعوّون إلى الوليمة نفسها. لنأكل من الصحن نفسه، ولنشرب من القدح نفسه. لا تبعدوني عنكم كما لو كنت مصاباً بالطاعون.
إن من لا يخدم عشيرته لا يمكنه إلّا أن يسيء إليها. لكن، مَن يخدم مَن؟ بل ما معنى أن تخدم أحداً؟ لماذا إكراه الشاعر على أن يهتمّ بعالم يرفضه؟ إن تمجيد الغباوة ليس، أبداً، ديدنه.
كثيراً ما تقولون لنا، نحن -زمرة الشعراء-: تكلَّموا بلغة نستطيع فهمها، أو أمسكوا عن الكلام ! أمّا أنا، فأقول لكم : مهما تحاولوا عن الكلام ردعي، فما أنا بصامت! افهموا بأنفسكم، إن كنتم ترغبون في ذلك، وإلّا فلديكم ما شاء الله من فقهاء اللّغة والأساتذة والمنظّرين والجغرافيِّين والمؤرِّخين والعلماء ليساعدوكم على الفهم.
لا شيء عندي أعلّمكم إيّاه. أنا نفسي لا أعرف شيئاً. تتحدَّثون عن الحرّيّة ! كونوا معي أسخياء، وامنحوني حرّيّة أن أحلم، وأن أغنّي في أوقات فراغي. امنحوني حرّيّة أن أتدبَّر ذاتي كما أشاء، لأكون كما أشاء. امنحوني -باختصار- حرّيّة أن أحقِّق فرحي الأسمى.
لن أحكي لكم ما رأيته بأمّ عيني، وأنتم لم تبوحوا لي بأيّة أسرار. إن عالم الكلمات هو عالمي، فالكلمات أدوات عملي. إنها موادّ حيّة، جواهر جوهرية. حاجتي ماسّة إلى كلمات تطفح بالشمس والألوان. تارةً، أنا موسيقيّ، وتارةً رسّام، لكن العالم الذي أترنَّم به، وأرسمه ليس عالمكم. بحثتُ عنه في الواقع، فوجدته في أحلامي.
كيف يمكن لي أن أسيء إلى عشيرتي؟ هي تملك السلطة… دمغتْ جسدي بالنار… قيَّدتْ اسمي في سجلّاتها الكبيرة… أمرتني بالطاعة… فانبطحتُ أمام أعيانها من أجل قسط من الراحة.. وكلّ يوم أقتل بعضاً من كياني؛ تلبيةً لنداء الواجب المقيت. فليكن. أنا راض بما يمليه عليّ قانون العشيرة. لا أتمرَّد، ولا أصرخ. إذا كنت لا أستحقّ أن آكل من الكعكة، فلن أمدّ إليها يدي، وإذا كان ماء هذه العين محبّساً على حلقوم ما، محظوظ، فلن يتطاول عليه فمي.
كلوا واشربوا -يا أصحابي- هنيئاً مريئاً، فخيرات الدنيا كلّها ملككم. عندكم شعراء ليخلّدوا مناقبكم، ويتغنّوا بلوعات الشوق في قلوبكم، ويُثنوا على آلهتكم. لديكم بهاليل يُنسُونكم ملل الاحتفالات الرسمية وقساوة الطقوس الدينية. تتفرَّجون على هرجهم الذي يستثير الضحك، وعلى مرجهم الذي يستدرّ الشفقة.
أيا صِحابي..
نهبتموني، ولمّا ينضب جشعكم. ماذا يهمّني أن أكون فقيراً؟ دعوني أخفِّف أحزاني. دعوني أغنِّ على مقام الألحان الذي يعجبني. اتركوا لي حرّيّة أن أختار موضوعات قصائدي. لا تنصتوا إلى أهازيجي، إن كانت لا تطربكم. وإذا شنَّفت إحداها آذانكم، فأنا أعرف ما ستقولونه، ستقولون: « إنه صوت شاعر آخر يدّعيه لنفسه». لا، صدِّقوني. فالصوت الذي تكونون قد استمعتم إليه، هو ما حباني الله -تعالى- إيّاه، فشكراً على نعمه.
كنت أصبحت غصناً ميِّتاً تذروه ريح الخريف، فشكراً لك، يا مولاي، على أن أرجعت لي غنائي. أحسّ برياح لواقح تسري في عروقي. يُخيَّل إليّ أن براعم تنبت، ببطء، في جسدي، وتوشك أن تتفتَّح عن أزاهير. ها قد عادت الشمس بعد طول انكساف عن كياني، طوال سباتي. هي ذي أشعَّتها تنعشني، كالسهام تخترقني، الدفء تبثّه في أعضائي، فترقص لها فرحاً روحي. فيا لروعة الفتنة التي تنبعث من هذا الضياء!
إلهي، كم يخيفني البرد والليل! ملكوتك يدعوني، الآن، إليه. لا وقت لي للحقد، ولا اقتدار لي على الخصام».
***
أخبِرنا، أ الحاج حمّاد، بما تلمّح إليه هذه الأوراق…
لا أعرف، لا أعرف، ثم ماذا عساها أن تلمّح إليه من معانٍ؟ حسْبُها أنها رسالة من صديق ائتمنني عليها.