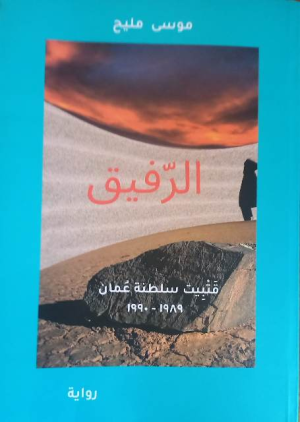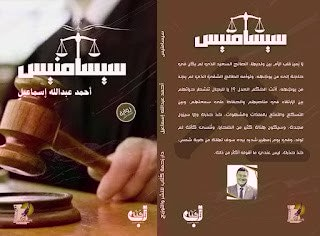في ثلاثة أجزاء هي (الفراشات - المكابدات - التحرر) جاء هذا العمل العظيم (التحديق في الشرر)، وهو السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور (أيمن تعيلب) أستاذ النقد الأدبي، والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة (السويس). وقد صدر عن دار (أروقة للأبحاث والترجمة والنشر) بالقاهرة عام 2021.
والسير الذاتية فن دخل الأدب بفضل ارتكاز مُنشئِه على الطاقة الشعورية خلال كتابته، واتكائه على قيم التعبير الفني والأسلوب الأدبي الرشيق، وتأسيسه هيكل سيرته على معمار بنيوي ينظّم خيط السرد، وينتظم زمان الأحداث انتظاما يختاره الكاتب وَفق رؤيته الفنية. كما أن منشئ السيرة الذاتية يعيد بثّ الروح في المكان الذي هو موضوع مقالنا القائم على أن السيرة لا توجد إلا بوجود المكان.
1- التحديق في الشرر:
العنوان مثير حقا، وداعٍ إلى التأمل. وعناوين الأعمال الأدبية، عامة، عنصر جوهري من عناصر العمل، وأداة فعّالة من أدوات فهمه وتحليله، حتى لقد عدّ (روبرت شولز) العنوان "مُسندا إليه عاما، وباقي المكونات النصية فروعا مُعزِّزة ومُسنَدات له"!
ما أخطر التحديق في الشرر! أليس الشرر نارًا تتطاير؟ أليست العين المُحدِّقة عُرضةٌ لأن تُصاب بشيء منه؟ ومهما حدّقت العيون؛ هل بإمكانها الإحاطة به؟ وهل لديها القدرة على تأليف شتاته لتصنع منها شمعة مضيئة أو نبراسًا منيرًا؟ أحسب أن الدكتور أيمن كان على وعي تام بصعوبة ما أقدم عليه من مغامرة فنية مثيرة؛ فعَنوَنها بهذا العنوان الدقيق. وأحسبه استشعر مشكلة الفصل بين (الحقيقي) و(الخيالي) وهو يكتب سيرته. ولكن، ما عليه! إن (جوته) سمّى سيرته الذاتية (الشعر والحقيقة)؛ ليشير إلى أن حيوات الناس إنما هي مزيج من الحقيقة والخيال؛ يقول (موروا). والقارئ المنصف يدرك استحالة الصدق الخالص في مثل هذا الميدان الشائك، ويدرك أن الصدق الذاتي أمر نسبي، وأنه مجرد محاولة لا تصل إلى مرحلة التحقق. والمؤلِّف يصرّح بذلك دون مواربة: "أريد أن أكون صريحًا إلى حد كبير يا صديقي، أريد أن أكون صادقًا مع نفسي ومع القارئ في كتابة نفسي، لكن هل أستطيع أن أكون صادقًا حقًّا؟ لا أظن ذلك يا صديقي، ليس لأنني كاذب لا قدّر الله، بل لأنَّ لغتي نفسها لا تستطيع ذلك مهما أوتيت من إحاطة ونفاذ؟ نحن نخاف من الحرية، نخاف أن نكون أنفسنا حقًّا، نريد أن نظل في نظر الآخرين مثاليين مهما كان الثمن غاليًا، المهم أن نكون عند حسن ظن الناس، حتى لو كلفنا ذلك أن نحيا حياة شكلانية جديبة مقفرة، فلا يهم، المهم الصورة، اللقطة، حتى يتسنّى لنا أن ننام نومًا قريرًا. وفي الحقيقة نحن عاجزون عن النوم واليقظة، كلما نمنا سَلّت علينا أحلامُنا وأوهامنا وأوجاعنا سيوفَ الرعب والقلق، فلا منام ولا يقظة، أين الصدق إذن"؟
2- ثراء العمل:
لم يُسعدني الحظ بقراءة العمل قراءة كاملة بعد، وإنما كان اطلاعي على (شذرات) أظهرنا عليها صديقنا الدكتور من خلال حسابه الشخصي في (الفيسبوك). وقد كانت هذه المقتطفات كافية للدلالة على ثراء هذا العمل الأدبي المكتنز بمظاهر فنية وفيرة، يحتاج كل مظهر منها إلى دراسة مستقلة؛ فإن هذه اللغة البليغة التي نهضت في وجه (اللغة الصحفية) الشائعة بين الأدباء أنفسهم - تحتاج إلى دراسة مستقلة. ونمو الشخصية وتطوّرها يحتاج أيضا إلى دراسة منفردة. ولا يقل عن ذلك خطرًا وأثرًا دراسةُ الهدف من كتابة هذه السيرة، مع العناية بالسؤال: لماذا الآن؟ وما علاقتها بالحاضر؟ وكيف بنى الأستاذ الزمن السردي؛ إذ جنح إلى الطريقة السردية الحكائية في مجمل ما قرأت. هذا كله وغيره فضلٌ عن بنية المكان التي نحاول أن نقول فيها كلمة.
3- مقام الفناء:
لا يصف (الأستاذ) المكان وصفا موضوعيا محايدًا، وإنما يعمد في وصفه إلى مزج الذات بالمكان، وصهرها به صهرًا كاملا حتى يذوب فيه كما يذوب الحَبَبُ في الكأس، ويفنى! هكذا وصف المحبين! لولا أن حب الكاتب حبٌّ من طراز خاص، إنه حب (المُريد) المُتفاني الذي ينظر في المكان ويحدّق بروح (الصوفي) الذي حاز كل عيون الكون؛ فهو يرى ويرسم ما لا نرى ولا نتخيل؛ فنُدهش، وهو يحاور أشياء المكان فينوب عنها في الحديث وتنوب عنه في الكشف، تحل فيه عشقا ويحل فيها سُكرًا وهُياما؛ فإذا به محضُ حال!
يقول حين زار قريته بعد عهد طويل: "على مرمى السمع صوت ديك مُسنّ، وزقزقة عصفور زغيب، وتسبيحة كروان متصوف. أعيش كثافة فائقة إلى حد الذوبان والطيران، أمشي كما لو كنت أمشي في حلم أو أنظر في مياه شفافة عميقة"!
تلك هي روح المُريد، وهذي هي محبته التي تجعل المحبوب ذا قدسية خاصة، يقول في هذا المقام نفسه: "كلما التفت القلب ارتعشَ بذكرى هنا أو انتفض لسر هناك، اخلع نعليك يا أيمن، فأنت بالوادي المقدس طوى"!
ثم تأمل كيف رسم، من خلال وصف المكان، هذه الرحلة القصيرة المثيرة ما بين (الاغتراب) و(العرفان): "فجأة توقفتُ! أرهف السمع، أتسمّع صوتًا غريبًا غامضًا، أحاول أن أستبين مصدره البعيد، أرهف السمع أكثر وأكثر، وضعت حقيبتي على الأرض، ثم خلعت حذائي، ومشيت حافيًا، كلما تخففنا من أشياء الدنيا اقتربنا أكثر، أرهف السمع أكثر، أتخفّى في جسدي، ألاشي خطواتي، وأكتم أنفاسي، كأنني أقتفي أثري كي أستبين، شاهدتُ في ركن صامت بعيد يمامة كانت ترقد على بيوض بضة وضيئة، طفرت دمعة من عيني مخلوطة بطعم الملح ونار الوجع، هنا كانت تجلس أمي وحيدة حزينة تنتظر فرج النهار بعد سواد الليل الطويل"!
4- شاعرية المكان:
أغلب ما قرأته للكاتب من وصف للمكان هو مما يسميه النقاد (الوصف التعبيري) الذي يتناول وقع مكونات المكان على النفس، ويجسّم الإحساس الذي تثيره الأشياء في نفس الكاتب، والمتلقي أيضا. يقول: "رأيت الغيطان تترامى في روحي، كأنها تسافر في الخيال. أستنشق الهواء بعمق؛ فيتدفق في جميع شراييني، أتسمّع في نبضات الهواء الأصداء القديمة للمخلوقات والطين والتراب، أتشمّم نور الفجر إذ تتوالد عرائس بهجته الأولى، يتسرسب إلى روحي هواء لطيف ورقيق ورطب؛ فيكتسي وجهي برذاذ الطهر والسكينة"!
وللكاتب (الأستاذ) قدرة هائلة على وصف المكان وصفا شعريا يصوّر الخواطر والانفعالات التي تختلج بها الذات في تفاعلها مع المكان؛ فنشاركه نحن إحساسه وجوّه الشعوري العام. إن الوصف النثري في كثير من (لوحات) هذا العمل لينوب عن الشعر؛ فيرتفع إلى مستوى يدنو من مستواه ويكاد يذوب فيه عبر نوبات شعورية مفعمة بالقوة والجيشان. نقرأ له: "الأحلام هي الكرسي المتحرك لمن شَلت حركتهم مخالبُ دنياهم، هي المنّ والسلوى للفقراء الذين تخطفت أشواقهم خفافيش العوز والحاجة، في الأحلام يحلق الفقراء في حكاياتهم خفافًا بلا أجنحة؛ فيرتادون سماوات مباهجهم الخفية لكن قريبا من نور التراب. الفقراء يشقّون جبال المستحيل المركوزة في التراب، عزاؤهم الوحيد الهواء والضياء، النبتة البرية المنسية تسقيها السماء. لا تصدق قارئي أن التحليق لا يكون إلا إلى أعلى، أروع ألوان التحليق ما كان إلى أسفل في نور التراب. الفقراء يحلمون دائمًا قريبًا من التراب، لكنهم يرون أبواب السماء مُفتّحة في التراب؛ فيعرجون إليها، وإن يومًا من حياة الحُلم كألف سنة مما تعدون"! هذه هي روح الشعر في أسمى معانيها.
5- الصورة السردية:
كل ما قراته من شذرات هذا العمل الماتع ينبئ - كما قلنا - بأن (الأستاذ) اختار لعمله الطريقة الحكائية السردية، والسرد لا يخلو من وصف. وقد يُقال إن الوصف يتّسم بالسكون، وإن السرد يجسّد الحركة. هذه إشكالية تجاوزها الكاتب برسم (الصورة السردية) الرائعة التي تنبض بالحركة والحيوية، والتي تخاطب عين القارئ فتقدم لها الأشكال والألوان والظلال كأنها تراها على وجه الحقيقة. وهنا يظهر دور اليد اللَبِقة التي تُوظف اللغة توظيفا يوحي بخشونة الأشياء ونعومتها ويفوح بعطرها وينطق بأصواتها، وهي بذلك لا تنسى نصيبها من الخيال. نتأمل قوله: "لا أنسى مشهد دجاجتنا البنية الضخمة وهي ترقد على بيضها في حنوّ ورَهف حتى يفقس، رأيتُ فراخها لأول مرة تحبو من جانبَي حفافِي جناحيها المنفوشين الراقدين، كانت الكتاكيت الزغيبة تبصبص بمناقيرها الطرية من خلل جناحيها، توصوص وصوصة خفيتة، ثم تقشّر عن جناحيها المبلولين خط الضياء، تتسحّب الكتاكيت من تحت أمها رويدًا رويدًا توقًا إلى براح الفضاء الوضيء. اقتربت من الدجاجة ألتقط من تحتها كتكوتًا أبيض، كان قد أسرني لونه الحليبي الملتمع، كان مثل نجمة تضوي، نفشت الدجاجة ريشها، وقأقأت في وجهي بصوتها الحاد حتى شاهدتها في مُخيّلتى على هيئة الأسد، قفزت الدجاجة في وجهي! منظر لم أكن أتوقعه قط، ظلت تطاردني، وأنا أتقافز أمامها حتى آخر البيت، شاهدتني أمي فجلجلت ضحكاتها: أتخاف من دجاجة"؟!
وهذا النوع من الصور السردية إذا بلغ ذروته الفنية فإنه يكوّن مع (الوصف التعبيري) مشاهد مؤثرة حقا وبليغة الدلالة على الحس الإنساني المرهف والعمق النفسي الذي يمتاح منه الكاتب الأديب؛ فتبدو عناصر المشهد أصداء للأشياء - لا الأشياء مستقلة! - أصداء تعود إلى سطح الوجود بعد تفاعلها العميق مع الذات وتلوينها بلون المزاج الخاص بالمُنتِج الأديب. وهذا إجراء فني يؤدي دورًا مُهمًا في إضفاء الحياة على مكوّنات الصورة، وربما تجاوز إلى (أنسنة) هذه المكوّنات. يرسم (الأستاذ) هذه الصورة الإنسانية الكاشفة - ربما - عن موقفه وفلسفته إزاء بعض النماذج البشرية: "هنا كان كلبنا (ركس) الوفي الأمين، كان قد مات بعد وفاة أبي بشهرين، لا أنسى يوم شيعنا جثمان والدي إلى مثواه الأخير، كان الكلب يرافقنا في الجنازة دون أن ننتبه، كان الكلب يتدافع بجسده من بين أرجل الرجال المهرولين في موكب العزاء تحت النعش ماسحًا جسده بأجساد الرجال، سمعتُه يغمغم بصوت كظيم مبحوح في عويل صامت مجروح، ثم يبصبص بذنبه. ما أفجع حزن الحيوانات"!
6- الوصف الواقعي:
ينحو (الأستاذ) أحيانا منحى الروائيين الواقعيين؛ فيعمد إلى وصف المكان (من الخارج)، من خارج الذات، وصفا موضوعيا يتتبّع كل العناصر المكوّنة له في سكونها وثباتها. ربما يصدق على طريقته هذه مصطلح (الوصف التصنيفي) القائم على الاستقصاء والاستنفاد، مجسّدًا الشيء بكل حذافيره، بغض النظر عن الأصداء النفسية، ومن ذلك هذه الصورة حين يصف مدرسته الابتدائية بأنها "على دورين بالطوب الأحمر. كانت هي المبنى الوحيد المميز بين بيوت حي (العيسوية) التي بُني معظمها من الطوب اللبن الرمادي الداكن. كانت المدرسة تطل على مصرف (بحر البقر). ما زلت أذكر حيطانها المطليّة باللون البيج الغامق، وعلى مدار الجهات الأربع لحيطان المدرسة كُتبت الآيات الكريمة الأولى من سورة (القلم): "اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم". أتذكّر أن الآيات كُتبت بخط الثلث بالغ الأناقة والجمال، كانت مقاعد الفصول من خشب خشن لا يعرف الملاسة ولا الرقة".
على أن الصورة الواقعية، عموما، وفي هذا العمل الشائق خصوصا قد تُوصف بما قاله (موباسان) من "أن الواقعي إذا كان فنانا حقا؛ فلن يذهب إلى عرض الحياة في صورة فوتغرافية ساذجة، ولكنه سيذهب إلى عرضها في صورة أكثر حقيقة وحيوية وكمالا من الحقيقة نفسها". والحقيقة أن الكاتب يجنح كثيرا في وصف المكان إلى أداة سحرية جذّابة، يجنح إلى نجوى الذات ووصف الحركات النفسية، بعاطفة حارة، ولغة ممتعة سلسة، وأسلوب رشيق، وحسّ أدبي يعي أن الناس يحبون الحقائق مغلفة بالطلاوة. يقول في وصف شجرة الجميز القائمة في المقابر: "شجرة الجميز التي ارتبطت بالموت في روحي وخيالي، كان شكل الشجرة أسطوريًا غامضًا، شجرة ضخمة عتيقة موغلة في تراب الماضي كأنها كائن خرافي جاثم يحلم بالنسيان الغارق في الماضي، ما إن تحدّق فيها حتى يتولّد فيك شعور بالغربة والوحشة والخوف، شعور بالفراق يتخلل كيانك كله، شكلها المتكوّم على هيئة أغصان مستشزرات معقوصة مدببة يتلوى بعضها على بعض على هيئة عقد كثيفة مدببة لا تعرف أولها من نهايتها، ثم تتمدد فجأة سابحة في أعلى السماء، بعضها يغطس في التراب تاركًا عظامه المستشزرات ناتئة فوق التراب، لكنها مشتبكة به بألف ذراع وذراع. فيما تظهر مجموعة من جذورها المتداخلة المعقوصة بعضها فوق بعض على سطح الأرض وكأنها ضاقت ذرعًا ببطن الظلام المخيف، ومَلّت حكايات الأموات فأرادت أن تستنشق هواء الفضاء قليلًا. كلما سرحتُ بمخاوفي في شكل شجرة الجميز ظننتُ أن عروقها المتشعبة العتيقة قد شاخت من هموم البشر! كم عانقت هذه الشجرة رجالًا ونساء وأطفالًا! فاشرأبت تهرب من الظلمة إلى النور، علها تتمتع بما تتمتع به الجذوع والأوراق والثمار في النور بعيدًا عن عتمة التراب! هل كانت الشجرة تتحسّر على سنوات عمرها التي قضتها مدفونة في الظلام؛ فتراها تحتضن الأرض بإحكام صارم، تحاصر التراب، وتضغط عليه من كل جهة، خوفًا من أن يتم إعادتها إلى وحشة الظلمة من جديد؟! هل تصدقني إن قلت لك – قارئي - إنني كنت أحس للمَوات صوتًا كان يسكن شجرة الجميز العتيقة"؟!
وَهْمٌ أن نقول إن الكاتب ينقل لنا صورة واقعية للشجرة، بل هو مكر فني وحيلة تصويرية في رسم مشهد نقطة انطلاقه هي الواقع، لكن نقطة الوصول ليست أبدًا هي العودة إلى هذا الواقع نفسه. لقد وصل بنا المشهد إلى عرض فلسفة الكاتب حول الحياة والموت والقضايا الوجودية الكبرى، وهذا المحور يحتاج، كغيره، إلى دراسة مستقلة.
شكرا للأستاذ الدكتور أيمن تعيلب على هذه السياحة الحميمية بين الروح والمكان. لقد عشنا معه وتعاطفنا، وأحسسنا أن هذه الأماكن التي يصفها هي أماكن نعرفها ونألفها، ولسوف تمضي بنا السنون وذكراها في نفوسنا لا يريم، ولا يكاد!
والسير الذاتية فن دخل الأدب بفضل ارتكاز مُنشئِه على الطاقة الشعورية خلال كتابته، واتكائه على قيم التعبير الفني والأسلوب الأدبي الرشيق، وتأسيسه هيكل سيرته على معمار بنيوي ينظّم خيط السرد، وينتظم زمان الأحداث انتظاما يختاره الكاتب وَفق رؤيته الفنية. كما أن منشئ السيرة الذاتية يعيد بثّ الروح في المكان الذي هو موضوع مقالنا القائم على أن السيرة لا توجد إلا بوجود المكان.
1- التحديق في الشرر:
العنوان مثير حقا، وداعٍ إلى التأمل. وعناوين الأعمال الأدبية، عامة، عنصر جوهري من عناصر العمل، وأداة فعّالة من أدوات فهمه وتحليله، حتى لقد عدّ (روبرت شولز) العنوان "مُسندا إليه عاما، وباقي المكونات النصية فروعا مُعزِّزة ومُسنَدات له"!
ما أخطر التحديق في الشرر! أليس الشرر نارًا تتطاير؟ أليست العين المُحدِّقة عُرضةٌ لأن تُصاب بشيء منه؟ ومهما حدّقت العيون؛ هل بإمكانها الإحاطة به؟ وهل لديها القدرة على تأليف شتاته لتصنع منها شمعة مضيئة أو نبراسًا منيرًا؟ أحسب أن الدكتور أيمن كان على وعي تام بصعوبة ما أقدم عليه من مغامرة فنية مثيرة؛ فعَنوَنها بهذا العنوان الدقيق. وأحسبه استشعر مشكلة الفصل بين (الحقيقي) و(الخيالي) وهو يكتب سيرته. ولكن، ما عليه! إن (جوته) سمّى سيرته الذاتية (الشعر والحقيقة)؛ ليشير إلى أن حيوات الناس إنما هي مزيج من الحقيقة والخيال؛ يقول (موروا). والقارئ المنصف يدرك استحالة الصدق الخالص في مثل هذا الميدان الشائك، ويدرك أن الصدق الذاتي أمر نسبي، وأنه مجرد محاولة لا تصل إلى مرحلة التحقق. والمؤلِّف يصرّح بذلك دون مواربة: "أريد أن أكون صريحًا إلى حد كبير يا صديقي، أريد أن أكون صادقًا مع نفسي ومع القارئ في كتابة نفسي، لكن هل أستطيع أن أكون صادقًا حقًّا؟ لا أظن ذلك يا صديقي، ليس لأنني كاذب لا قدّر الله، بل لأنَّ لغتي نفسها لا تستطيع ذلك مهما أوتيت من إحاطة ونفاذ؟ نحن نخاف من الحرية، نخاف أن نكون أنفسنا حقًّا، نريد أن نظل في نظر الآخرين مثاليين مهما كان الثمن غاليًا، المهم أن نكون عند حسن ظن الناس، حتى لو كلفنا ذلك أن نحيا حياة شكلانية جديبة مقفرة، فلا يهم، المهم الصورة، اللقطة، حتى يتسنّى لنا أن ننام نومًا قريرًا. وفي الحقيقة نحن عاجزون عن النوم واليقظة، كلما نمنا سَلّت علينا أحلامُنا وأوهامنا وأوجاعنا سيوفَ الرعب والقلق، فلا منام ولا يقظة، أين الصدق إذن"؟
2- ثراء العمل:
لم يُسعدني الحظ بقراءة العمل قراءة كاملة بعد، وإنما كان اطلاعي على (شذرات) أظهرنا عليها صديقنا الدكتور من خلال حسابه الشخصي في (الفيسبوك). وقد كانت هذه المقتطفات كافية للدلالة على ثراء هذا العمل الأدبي المكتنز بمظاهر فنية وفيرة، يحتاج كل مظهر منها إلى دراسة مستقلة؛ فإن هذه اللغة البليغة التي نهضت في وجه (اللغة الصحفية) الشائعة بين الأدباء أنفسهم - تحتاج إلى دراسة مستقلة. ونمو الشخصية وتطوّرها يحتاج أيضا إلى دراسة منفردة. ولا يقل عن ذلك خطرًا وأثرًا دراسةُ الهدف من كتابة هذه السيرة، مع العناية بالسؤال: لماذا الآن؟ وما علاقتها بالحاضر؟ وكيف بنى الأستاذ الزمن السردي؛ إذ جنح إلى الطريقة السردية الحكائية في مجمل ما قرأت. هذا كله وغيره فضلٌ عن بنية المكان التي نحاول أن نقول فيها كلمة.
3- مقام الفناء:
لا يصف (الأستاذ) المكان وصفا موضوعيا محايدًا، وإنما يعمد في وصفه إلى مزج الذات بالمكان، وصهرها به صهرًا كاملا حتى يذوب فيه كما يذوب الحَبَبُ في الكأس، ويفنى! هكذا وصف المحبين! لولا أن حب الكاتب حبٌّ من طراز خاص، إنه حب (المُريد) المُتفاني الذي ينظر في المكان ويحدّق بروح (الصوفي) الذي حاز كل عيون الكون؛ فهو يرى ويرسم ما لا نرى ولا نتخيل؛ فنُدهش، وهو يحاور أشياء المكان فينوب عنها في الحديث وتنوب عنه في الكشف، تحل فيه عشقا ويحل فيها سُكرًا وهُياما؛ فإذا به محضُ حال!
يقول حين زار قريته بعد عهد طويل: "على مرمى السمع صوت ديك مُسنّ، وزقزقة عصفور زغيب، وتسبيحة كروان متصوف. أعيش كثافة فائقة إلى حد الذوبان والطيران، أمشي كما لو كنت أمشي في حلم أو أنظر في مياه شفافة عميقة"!
تلك هي روح المُريد، وهذي هي محبته التي تجعل المحبوب ذا قدسية خاصة، يقول في هذا المقام نفسه: "كلما التفت القلب ارتعشَ بذكرى هنا أو انتفض لسر هناك، اخلع نعليك يا أيمن، فأنت بالوادي المقدس طوى"!
ثم تأمل كيف رسم، من خلال وصف المكان، هذه الرحلة القصيرة المثيرة ما بين (الاغتراب) و(العرفان): "فجأة توقفتُ! أرهف السمع، أتسمّع صوتًا غريبًا غامضًا، أحاول أن أستبين مصدره البعيد، أرهف السمع أكثر وأكثر، وضعت حقيبتي على الأرض، ثم خلعت حذائي، ومشيت حافيًا، كلما تخففنا من أشياء الدنيا اقتربنا أكثر، أرهف السمع أكثر، أتخفّى في جسدي، ألاشي خطواتي، وأكتم أنفاسي، كأنني أقتفي أثري كي أستبين، شاهدتُ في ركن صامت بعيد يمامة كانت ترقد على بيوض بضة وضيئة، طفرت دمعة من عيني مخلوطة بطعم الملح ونار الوجع، هنا كانت تجلس أمي وحيدة حزينة تنتظر فرج النهار بعد سواد الليل الطويل"!
4- شاعرية المكان:
أغلب ما قرأته للكاتب من وصف للمكان هو مما يسميه النقاد (الوصف التعبيري) الذي يتناول وقع مكونات المكان على النفس، ويجسّم الإحساس الذي تثيره الأشياء في نفس الكاتب، والمتلقي أيضا. يقول: "رأيت الغيطان تترامى في روحي، كأنها تسافر في الخيال. أستنشق الهواء بعمق؛ فيتدفق في جميع شراييني، أتسمّع في نبضات الهواء الأصداء القديمة للمخلوقات والطين والتراب، أتشمّم نور الفجر إذ تتوالد عرائس بهجته الأولى، يتسرسب إلى روحي هواء لطيف ورقيق ورطب؛ فيكتسي وجهي برذاذ الطهر والسكينة"!
وللكاتب (الأستاذ) قدرة هائلة على وصف المكان وصفا شعريا يصوّر الخواطر والانفعالات التي تختلج بها الذات في تفاعلها مع المكان؛ فنشاركه نحن إحساسه وجوّه الشعوري العام. إن الوصف النثري في كثير من (لوحات) هذا العمل لينوب عن الشعر؛ فيرتفع إلى مستوى يدنو من مستواه ويكاد يذوب فيه عبر نوبات شعورية مفعمة بالقوة والجيشان. نقرأ له: "الأحلام هي الكرسي المتحرك لمن شَلت حركتهم مخالبُ دنياهم، هي المنّ والسلوى للفقراء الذين تخطفت أشواقهم خفافيش العوز والحاجة، في الأحلام يحلق الفقراء في حكاياتهم خفافًا بلا أجنحة؛ فيرتادون سماوات مباهجهم الخفية لكن قريبا من نور التراب. الفقراء يشقّون جبال المستحيل المركوزة في التراب، عزاؤهم الوحيد الهواء والضياء، النبتة البرية المنسية تسقيها السماء. لا تصدق قارئي أن التحليق لا يكون إلا إلى أعلى، أروع ألوان التحليق ما كان إلى أسفل في نور التراب. الفقراء يحلمون دائمًا قريبًا من التراب، لكنهم يرون أبواب السماء مُفتّحة في التراب؛ فيعرجون إليها، وإن يومًا من حياة الحُلم كألف سنة مما تعدون"! هذه هي روح الشعر في أسمى معانيها.
5- الصورة السردية:
كل ما قراته من شذرات هذا العمل الماتع ينبئ - كما قلنا - بأن (الأستاذ) اختار لعمله الطريقة الحكائية السردية، والسرد لا يخلو من وصف. وقد يُقال إن الوصف يتّسم بالسكون، وإن السرد يجسّد الحركة. هذه إشكالية تجاوزها الكاتب برسم (الصورة السردية) الرائعة التي تنبض بالحركة والحيوية، والتي تخاطب عين القارئ فتقدم لها الأشكال والألوان والظلال كأنها تراها على وجه الحقيقة. وهنا يظهر دور اليد اللَبِقة التي تُوظف اللغة توظيفا يوحي بخشونة الأشياء ونعومتها ويفوح بعطرها وينطق بأصواتها، وهي بذلك لا تنسى نصيبها من الخيال. نتأمل قوله: "لا أنسى مشهد دجاجتنا البنية الضخمة وهي ترقد على بيضها في حنوّ ورَهف حتى يفقس، رأيتُ فراخها لأول مرة تحبو من جانبَي حفافِي جناحيها المنفوشين الراقدين، كانت الكتاكيت الزغيبة تبصبص بمناقيرها الطرية من خلل جناحيها، توصوص وصوصة خفيتة، ثم تقشّر عن جناحيها المبلولين خط الضياء، تتسحّب الكتاكيت من تحت أمها رويدًا رويدًا توقًا إلى براح الفضاء الوضيء. اقتربت من الدجاجة ألتقط من تحتها كتكوتًا أبيض، كان قد أسرني لونه الحليبي الملتمع، كان مثل نجمة تضوي، نفشت الدجاجة ريشها، وقأقأت في وجهي بصوتها الحاد حتى شاهدتها في مُخيّلتى على هيئة الأسد، قفزت الدجاجة في وجهي! منظر لم أكن أتوقعه قط، ظلت تطاردني، وأنا أتقافز أمامها حتى آخر البيت، شاهدتني أمي فجلجلت ضحكاتها: أتخاف من دجاجة"؟!
وهذا النوع من الصور السردية إذا بلغ ذروته الفنية فإنه يكوّن مع (الوصف التعبيري) مشاهد مؤثرة حقا وبليغة الدلالة على الحس الإنساني المرهف والعمق النفسي الذي يمتاح منه الكاتب الأديب؛ فتبدو عناصر المشهد أصداء للأشياء - لا الأشياء مستقلة! - أصداء تعود إلى سطح الوجود بعد تفاعلها العميق مع الذات وتلوينها بلون المزاج الخاص بالمُنتِج الأديب. وهذا إجراء فني يؤدي دورًا مُهمًا في إضفاء الحياة على مكوّنات الصورة، وربما تجاوز إلى (أنسنة) هذه المكوّنات. يرسم (الأستاذ) هذه الصورة الإنسانية الكاشفة - ربما - عن موقفه وفلسفته إزاء بعض النماذج البشرية: "هنا كان كلبنا (ركس) الوفي الأمين، كان قد مات بعد وفاة أبي بشهرين، لا أنسى يوم شيعنا جثمان والدي إلى مثواه الأخير، كان الكلب يرافقنا في الجنازة دون أن ننتبه، كان الكلب يتدافع بجسده من بين أرجل الرجال المهرولين في موكب العزاء تحت النعش ماسحًا جسده بأجساد الرجال، سمعتُه يغمغم بصوت كظيم مبحوح في عويل صامت مجروح، ثم يبصبص بذنبه. ما أفجع حزن الحيوانات"!
6- الوصف الواقعي:
ينحو (الأستاذ) أحيانا منحى الروائيين الواقعيين؛ فيعمد إلى وصف المكان (من الخارج)، من خارج الذات، وصفا موضوعيا يتتبّع كل العناصر المكوّنة له في سكونها وثباتها. ربما يصدق على طريقته هذه مصطلح (الوصف التصنيفي) القائم على الاستقصاء والاستنفاد، مجسّدًا الشيء بكل حذافيره، بغض النظر عن الأصداء النفسية، ومن ذلك هذه الصورة حين يصف مدرسته الابتدائية بأنها "على دورين بالطوب الأحمر. كانت هي المبنى الوحيد المميز بين بيوت حي (العيسوية) التي بُني معظمها من الطوب اللبن الرمادي الداكن. كانت المدرسة تطل على مصرف (بحر البقر). ما زلت أذكر حيطانها المطليّة باللون البيج الغامق، وعلى مدار الجهات الأربع لحيطان المدرسة كُتبت الآيات الكريمة الأولى من سورة (القلم): "اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم". أتذكّر أن الآيات كُتبت بخط الثلث بالغ الأناقة والجمال، كانت مقاعد الفصول من خشب خشن لا يعرف الملاسة ولا الرقة".
على أن الصورة الواقعية، عموما، وفي هذا العمل الشائق خصوصا قد تُوصف بما قاله (موباسان) من "أن الواقعي إذا كان فنانا حقا؛ فلن يذهب إلى عرض الحياة في صورة فوتغرافية ساذجة، ولكنه سيذهب إلى عرضها في صورة أكثر حقيقة وحيوية وكمالا من الحقيقة نفسها". والحقيقة أن الكاتب يجنح كثيرا في وصف المكان إلى أداة سحرية جذّابة، يجنح إلى نجوى الذات ووصف الحركات النفسية، بعاطفة حارة، ولغة ممتعة سلسة، وأسلوب رشيق، وحسّ أدبي يعي أن الناس يحبون الحقائق مغلفة بالطلاوة. يقول في وصف شجرة الجميز القائمة في المقابر: "شجرة الجميز التي ارتبطت بالموت في روحي وخيالي، كان شكل الشجرة أسطوريًا غامضًا، شجرة ضخمة عتيقة موغلة في تراب الماضي كأنها كائن خرافي جاثم يحلم بالنسيان الغارق في الماضي، ما إن تحدّق فيها حتى يتولّد فيك شعور بالغربة والوحشة والخوف، شعور بالفراق يتخلل كيانك كله، شكلها المتكوّم على هيئة أغصان مستشزرات معقوصة مدببة يتلوى بعضها على بعض على هيئة عقد كثيفة مدببة لا تعرف أولها من نهايتها، ثم تتمدد فجأة سابحة في أعلى السماء، بعضها يغطس في التراب تاركًا عظامه المستشزرات ناتئة فوق التراب، لكنها مشتبكة به بألف ذراع وذراع. فيما تظهر مجموعة من جذورها المتداخلة المعقوصة بعضها فوق بعض على سطح الأرض وكأنها ضاقت ذرعًا ببطن الظلام المخيف، ومَلّت حكايات الأموات فأرادت أن تستنشق هواء الفضاء قليلًا. كلما سرحتُ بمخاوفي في شكل شجرة الجميز ظننتُ أن عروقها المتشعبة العتيقة قد شاخت من هموم البشر! كم عانقت هذه الشجرة رجالًا ونساء وأطفالًا! فاشرأبت تهرب من الظلمة إلى النور، علها تتمتع بما تتمتع به الجذوع والأوراق والثمار في النور بعيدًا عن عتمة التراب! هل كانت الشجرة تتحسّر على سنوات عمرها التي قضتها مدفونة في الظلام؛ فتراها تحتضن الأرض بإحكام صارم، تحاصر التراب، وتضغط عليه من كل جهة، خوفًا من أن يتم إعادتها إلى وحشة الظلمة من جديد؟! هل تصدقني إن قلت لك – قارئي - إنني كنت أحس للمَوات صوتًا كان يسكن شجرة الجميز العتيقة"؟!
وَهْمٌ أن نقول إن الكاتب ينقل لنا صورة واقعية للشجرة، بل هو مكر فني وحيلة تصويرية في رسم مشهد نقطة انطلاقه هي الواقع، لكن نقطة الوصول ليست أبدًا هي العودة إلى هذا الواقع نفسه. لقد وصل بنا المشهد إلى عرض فلسفة الكاتب حول الحياة والموت والقضايا الوجودية الكبرى، وهذا المحور يحتاج، كغيره، إلى دراسة مستقلة.
شكرا للأستاذ الدكتور أيمن تعيلب على هذه السياحة الحميمية بين الروح والمكان. لقد عشنا معه وتعاطفنا، وأحسسنا أن هذه الأماكن التي يصفها هي أماكن نعرفها ونألفها، ولسوف تمضي بنا السنون وذكراها في نفوسنا لا يريم، ولا يكاد!