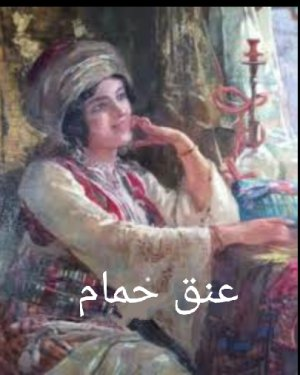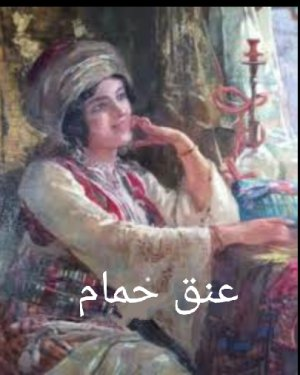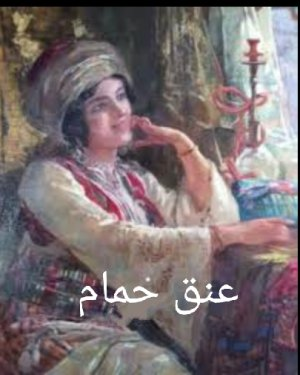جلست يوما من أيام إيقافي عن العمل سنة 1991 - 1992 في مقهى البلفدير بالعاصمة وجلس إليّ كهل أشقر أنيق رشيق. خاطبني بلهجة بدت لي لبنانية أو سورية يريد أن أسمح له بالجلوس إلى طاولتي متعللا باكتظاظ المقهى. أذنت له بالجلوس ومضى يسألني أسئلة شتى. قال : ماذا تشتغل؟ قلت: أستاذ لغة عربية. كم راتبك؟ لم يكن لي وقتها لا شغل ولا راتب ولكني أجبته : ما يعادل أربعمائة دولار. قال: هذا غير كاف بالمرة. قلت: هو عندي أكثر من كاف. قال: كيف؟ قلت: الدينار التونسي يعادل دولارا أمريكيا أو يفوقه بقليل وهذا في حد ذاته مكسب. اكتفى بابتسامة خفيفة ثم نقل موضوع الحديث. لم أبد اهتماما به. سألته: الأخ لبناني أم سوري؟ قال: بل أمريكي تعلمت العربية أيام إقامتي الطويلة بالأردن. وقبل أن أسأله عن سبب وجوده هناك ثم هنا في تونس قال: أنا أعمل مديرا في شركة لتصدير السيارات إلى أسواق الشرق الأوسط كلها. لم أصدقه. فبلادنا ليست سوقا للسيارات الأمريكية ثم سألته: وأنت اليوم في تونس لاستقبال شحنة سيارات قادمة إلى الميناء. قال: لا. ولكني دعيت منذ شهر لإعداد دراسة حول السوق التونسية لعلها تكون في سياق الإصلاحات التي يعتزم الرئيس بن علي إنجازها سوقا نافعة لشركتنا. ثم استغل الحديث عن بن علي ليقول : أعتقد أن الرئيس بن علي يسير بالبلاد نحو انفتاح اقتصادي ستكون مخاطره على الفئات الشعبيّة وخيمة. لم أرتح إلى تعليقه وخفت على نفسي فأنا محل متابعة وكل حديث في هذه المواضيع عواقبه مجهولة ولكني قلت: هو أدرى بما ينفع البلد. لم يعجبه تعليقي. لابد أنه كان يتوقع مني موقفا معارضا فابتكر مسلكا آخر. ها هو يجرني إلى المفاضلة بين بورقيبة وبن على. قال: كان بورقيبة أذكى في سباساته الاقتصادية والاجتماعية. فقلت: ولكن تلك السياسات الذكية ولدت أزمات عديدة فضلا عن تمسكه بالسلطة وهو هرم لا يكاد يقوى على المشي. فهم الأمريكي من حديثي أني أساند إجراءات 7 نوفمبر وما ترتب عليها من تحولات فمضى يعدد سلبيات التغيير المبارك وشدّد في حديثه على ملاحقة المعارضين من الإسلاميين والشيوعيين خاصة فقلت له: هذا شأن وطني يخص سيادة الرئيس وحده والمعارضون له لم يدركوا أبعاده الكبرى. سكت لحظة ثم نبّهني إلى إمرأة تجلس غير بعيد عن طاولتنا. كانت تضع حجابا أسود وتشرب قهوة سوداء وتدخن. قال: أرأيت هذه؟ هي تدعي الإسلام ولكنها منافقة. قلت: هي حرة تلبس ما يحلو لها وتأتي ما يليق بها. ثم من أين لك أن تحكم عليها وأنت لا تكاد تعرف شيئا عنها؟ قال: أنا أقيم هناك، وأشار بيده إلى العمارة المواجهة لمقهى البلفدير، منذ أسبوع وأجلس في هذا المقهى كل يوم ساعة على الأقل وفي كل يوم أراها هناك. ستراها بعد قليل تغادر المقهى رفقة رجل. قلت: لعله زوجها أو أخوها أو زميل من زملائها أو هو صديق لها. قال: لو كان هو الرجل نفسه كل يوم لقلت ما تقول ولكنه يتغير باستمرار. هي كل يوم مع رجل مختلف. قلت: هي حرة ما لم تسئ إليك. بدا لي الرجل الغريب مزعجا وحشريا وقلت في نفسي : أيكون هذا أمريكيا كما يدّعي؟ ثم ضحكت فاستغرب لضحكتي وقال: أتعرفها؟ قلت: لا ولكني وجدتك لا تختلف في شيء عن عموم التونسيين. وأرجو أن تكفّ عن هذه العادة السيئة التي اكتسبتها في أقل من أسبوع. سكتنا دقيقتين أو أكثر دخّنت فيها بتوتر ظاهر. وقطع عني خلوتي إلى نفسي بأن سألني من جديد عن عملي. فقلت بحدّة: ألم أقل لك إني أستاذ عربية. ؟ قال: نعم. أردت أين تعمل؟ قلت هنا بمعهد من معاهد العاصمة وراحتي الأسبوعية يوم السبت وأدرّس 18 ساعة في الأسبوع ولا أجلس في هذا المقهى إلا مساء السبت. قال: أراك انزعجت فالمعذرة على الإزعاج. لم أتفاعل معه. فناولني سيجارة أمريكية وهو يقول: أرأيت ما فعل صدام حسين بشعبه؟ لقد جنى على نفسه وخرّب بلده بيديه حتى ألّب عليه كل العالم. قلت: ومع ذلك هو رجل حارب أمريكا وتحدّاها وقصف تلّ أبيب وأحيا في قلوب العرب قيما كادت تموت. سكت برهة ثمّ مضى يقدح في ملوك العرب كلّهم وأفاض في الحديث عن ملك الأردن. قلت: هو أذكى الملوك، أمّن لبلده الصغير الفقير أهمّ شروط الحياة وهي الصحة والتعليم. عرف كيف يستثمر علاقته بالكيان الصهيوني لصالح بلده. لم تعجبه كلماتي، أنا أيضا كنت أقول كلاما لست مقتنعا به. كنت فقط أواجه أمريكيّا يريد أن يحرّضني على عربيّ. وقال: أتعجّب من كلامك هذا. قلت: ما العجيب فيه؟ قال رجل مثقّف ويقول عن ملك الأردن ما يقول؟ قلت ضاحكا: أنا متحمّس للدفاع عن كلّ عربيّ مهما كانت سيّئاته إذا رأيت واحدا مثلك من وراء البحار ينتقده ويكشف عوراته. ضحك ضحكة لفتت انتباه روّاد المقهى كلّهم. حتّى صاحبة الحجاب الأسود التفتت إلينا وضحكت كأنّها كانت تسمع ما يدور بيننا. وجد الرجل في التفاتة الجمهور إليه ما يشجّعه على الاستمرار في لغوه فقال بصوت مسموع: ومعمّر القذافي؟ قلت: ما به؟ قال: يحوز بلده ثروة هائلة ولكنه من أكثر البلدان تخلّفا، نظام تعليمي هزيل، ونظام صحّي ضعيف، وشعب لا يعمل. قلت ومع ذلك هو بلد مستقلّ وسيادته بين يديه. قال: غريب والله، أتقول عن رجل مجنون مثل هذا؟ قلت: الجنون فلسفة لا تدركها لا أنت ولا رئيسكم. يئس الرجل منّي. لم يضحك. قفز من كرسيّه ومشى نحو المرأة صاحبة الحجاب الأسود. استقبلته بحفاوة. أمّا أنا فغادرت المقهى. وما خطوت خطوتين حتّى استوقفني شرطي بزي مدنيّ وقال: من ذلك الذي كنت تحدّثه؟ قلت: لا أدري. اسأله، ها هو يجلس هناك. ومضيت. ولم أعد إلى مقهى البلفدير بعدها أبدا. عفوا. بل عدت بعد أكثر من عشرين سنة ومعي زوجتي واطفالي. كانوا يرغبون في مشاهدة الفيل والأسد والنمر والطاووس.
(2)
لم أر شتاء أقسى عليّ من شتاء تلك السنة. ولم تكن قسوته عليّ ممّا كان فيه من الرياح العاتية والبرد القارس بل ممّا صرت إليه من إفلاس حقيقي بعد أن قطعت عني الدولة مورد رزقي ورزق أبي وأمي. وكان آخر ما دخل حسابي البنكي منحة متأخرة من بعض المنح التي كان يأخذها المدرسون ولا أدري إن كانت منحة إنتاج أو منحة الساعات الإضافية. ما أذكره أنها كانت دون الثلاثين دينارا وفوق العشرين. ومبلغ كهذا يكاد يزن شيئا في العاصمة وقتها كأن تشتري به حزمة كتب أو طاقم ملابس ولكني وجدت فيه سبيلا إلى الجلوس في مقهى باريس حيث يجلس مثقّفون ووجهاء وأثرياء أو في مقهى الهناء الدولي حيث يجلس عرب وأفارقة وتونسيون مرفهون. كان ثمن زجاجة البيرة الواحدة في ذلك المقهى وقتها لا يتعدّى الدينار ونصف الدينار وعشرون دينارا أو يزيد يمكن أن تسافر بي بعيدا جدّا جدّا. شكرت الدولة على وفائها بالتزاماتها تجاه موظفيها المطرودين وسحبت المبلغ القليل ظاهرا الثقيل أثرا وحدّثت نفسي بأمسية تنسيني ما كنت فيه. لم أكن أواعدا أحدا بعد المساء. فكل الذين أعرفهم يؤوبون إلى ديارهم هنالك في ضواحي العاصمة أما أنا فكنت قد اتخذت لي مسكنا في قلب العاصمة في غرفة في الطابق الثالث في نزل شعبي جدا يقبع في ظهر قاعة البرناس للسينما واخترته لدواع كثيرة أهمها أنه يليق بي شكلا وإمكانيات. كل رواده على وجوههم علامات تشي بما هم فيه من ضيق. كان فيهم المريض القادم من الأقاصي للعلاج في مستشفى شارل نيكول أو في مستشفى الرابطة واختار أهله أن يتركوه هنالك في نزل كورسي (Qurcy) حتى يحين موعده مع الطبيب بعد شهر، وفيهم من كان طالبا في سنته الأخيرة اختار أن يعمل في هذا النزل ليلا مقابل أن يضمن لنفسه إقامة بعد أن استوفى حقه في المبيت الجامعي، وكان فيهم من يعمل ممثلا في فرقة من فرق المسرح الكثيرة واختار أن يعيش عيشة الفنانين المهمشين. ولم تكن بيني وبين أحد من هؤلاء جميعا علاقة. ولعل ما كان يبدو على وجهي من معاني الصرامة هو ما جعل المحيطين بي هناك يتخذون مني مسافة فيكتفون في الغالب بالتحية من بعيد. حتّى العم عمر القيم على كورسي كان شديد الحذر مني ولم يتجرأ على ممازحتي إلا حين رآني ليلة أدخل مبللا فحياتي وقال: كل هذا بسبب الحب. وكان يعني طبعا حبي للنادي الإفريقي فقد كان يلعب في ملعب المنزه ضد فريق إفريقي سقط عني اسمه للفوز بكأس الأبطال الإفريقية وكان يوما ممطرا جدا وقفت فيه في مدارج الملعب المكشوفة بلا مطرية وصحت من أعمق أعماقي لا فرحا بالأهداف الستة التي سجلها الإفريقي في شباك منافسه فقط بل رغبة مني في أن أصيح بعنف لعلي أتخلص مما كان يملأ صدري.
(3)
لم أكن إذن أواعدا أحدا. كنت أدخل المقاهي الليلية وحدي، وأجلس فيها وحدي وأدخّن الكريستال وحدي. سجائري الشعبيّة لا تحرجني البتّة وكذلك مظهري اللافت لانتباه الكثيرين. حاولت في السنوات الثلاث التي عملت فيها أستاذا أن أظهر في صورة الأستاذ الكلاسيكية ولكن بلا كسوة ولا ربطة عنق، فقط بملابس مدنيّة عوضا عن لباس العمّال الأزرق الذي عرفني به كلّ من درس معي بالجامعة، حتّى أنّ واحدة من زميلات الدراسة جرت بيننا مودّة عابرة في آخر سنة جامعية قالت تمازحني: كنت أحسبك عاملا من عمال الكلية مكلفا بصيانة شبكة الماء أو شبكة الكهرباء فأقول ماذا يفعل هذا هنا في ساحة الجامعة وكيف يحق له أن يأخذ الكلمة في حلقات النقاش الطلابية وأن يخطب في الطلاب ومن أين جاءته الفصاحة؟ تخلّيت إذن عن ذلك اللباس الأزرق مدة من الزمن ثم عدت إليه في قلب العاصمة في ذروة الشتاء والإفلاس واقتحمت به مكتب المدير العام للتعليم الثانوي محتجّا ودخلت به مكاتب أخرى في سفارات العراق وليبيا والسنغال أيضا. أما سفارة العراق فقال لي أحد موظفيها معتذرا: يا حسرة على العراق أيام كان يحتضن الإخوة العرب للدراسة أو العمل. وأما سفارة ليبيا فأرسلني إليها صديق قال إن صديقا له يعمل هنالك ويمكن أن يساعدني للترسيم في جامعة طرابس. ولكني لم أتحمس كثيرا لهذا العرض ولا أدري لذلك سببا. ولعل صورة الرجل الذي كان ينتظرني هناك هي السبب. فقد كان يتحدث إلي دون أن تكون عيناه في عيني، وأما سفارة السنغال فكانت في أقصى شارع الحرية في قلب العاصمة وكان فيها موظف سنغالي يبحث عن مدرس عربية يقدم لابنه دروسا ليلية بمقابل محترم فلما زرته اعتذر قائلا :للأسف الشديد يا أستاذ فقد انتدبت أستاذا جاءني قبلك بيوم. لم أصدقه. أعتقد الآن أنه نسج تلك القصة ليتخلص من رجل لا شيء فيه يدل على صورة الأستاذ النمطية. يا لتلك الكسوة العمالية الزرقاء. كنت أدخل كل تلك المكاتب بكسوتي الزرقاء فكيف لا أقتحم بها مقهى باريس أو مقهى الهناء الدوليّ.
(2)
لم أر شتاء أقسى عليّ من شتاء تلك السنة. ولم تكن قسوته عليّ ممّا كان فيه من الرياح العاتية والبرد القارس بل ممّا صرت إليه من إفلاس حقيقي بعد أن قطعت عني الدولة مورد رزقي ورزق أبي وأمي. وكان آخر ما دخل حسابي البنكي منحة متأخرة من بعض المنح التي كان يأخذها المدرسون ولا أدري إن كانت منحة إنتاج أو منحة الساعات الإضافية. ما أذكره أنها كانت دون الثلاثين دينارا وفوق العشرين. ومبلغ كهذا يكاد يزن شيئا في العاصمة وقتها كأن تشتري به حزمة كتب أو طاقم ملابس ولكني وجدت فيه سبيلا إلى الجلوس في مقهى باريس حيث يجلس مثقّفون ووجهاء وأثرياء أو في مقهى الهناء الدولي حيث يجلس عرب وأفارقة وتونسيون مرفهون. كان ثمن زجاجة البيرة الواحدة في ذلك المقهى وقتها لا يتعدّى الدينار ونصف الدينار وعشرون دينارا أو يزيد يمكن أن تسافر بي بعيدا جدّا جدّا. شكرت الدولة على وفائها بالتزاماتها تجاه موظفيها المطرودين وسحبت المبلغ القليل ظاهرا الثقيل أثرا وحدّثت نفسي بأمسية تنسيني ما كنت فيه. لم أكن أواعدا أحدا بعد المساء. فكل الذين أعرفهم يؤوبون إلى ديارهم هنالك في ضواحي العاصمة أما أنا فكنت قد اتخذت لي مسكنا في قلب العاصمة في غرفة في الطابق الثالث في نزل شعبي جدا يقبع في ظهر قاعة البرناس للسينما واخترته لدواع كثيرة أهمها أنه يليق بي شكلا وإمكانيات. كل رواده على وجوههم علامات تشي بما هم فيه من ضيق. كان فيهم المريض القادم من الأقاصي للعلاج في مستشفى شارل نيكول أو في مستشفى الرابطة واختار أهله أن يتركوه هنالك في نزل كورسي (Qurcy) حتى يحين موعده مع الطبيب بعد شهر، وفيهم من كان طالبا في سنته الأخيرة اختار أن يعمل في هذا النزل ليلا مقابل أن يضمن لنفسه إقامة بعد أن استوفى حقه في المبيت الجامعي، وكان فيهم من يعمل ممثلا في فرقة من فرق المسرح الكثيرة واختار أن يعيش عيشة الفنانين المهمشين. ولم تكن بيني وبين أحد من هؤلاء جميعا علاقة. ولعل ما كان يبدو على وجهي من معاني الصرامة هو ما جعل المحيطين بي هناك يتخذون مني مسافة فيكتفون في الغالب بالتحية من بعيد. حتّى العم عمر القيم على كورسي كان شديد الحذر مني ولم يتجرأ على ممازحتي إلا حين رآني ليلة أدخل مبللا فحياتي وقال: كل هذا بسبب الحب. وكان يعني طبعا حبي للنادي الإفريقي فقد كان يلعب في ملعب المنزه ضد فريق إفريقي سقط عني اسمه للفوز بكأس الأبطال الإفريقية وكان يوما ممطرا جدا وقفت فيه في مدارج الملعب المكشوفة بلا مطرية وصحت من أعمق أعماقي لا فرحا بالأهداف الستة التي سجلها الإفريقي في شباك منافسه فقط بل رغبة مني في أن أصيح بعنف لعلي أتخلص مما كان يملأ صدري.
(3)
لم أكن إذن أواعدا أحدا. كنت أدخل المقاهي الليلية وحدي، وأجلس فيها وحدي وأدخّن الكريستال وحدي. سجائري الشعبيّة لا تحرجني البتّة وكذلك مظهري اللافت لانتباه الكثيرين. حاولت في السنوات الثلاث التي عملت فيها أستاذا أن أظهر في صورة الأستاذ الكلاسيكية ولكن بلا كسوة ولا ربطة عنق، فقط بملابس مدنيّة عوضا عن لباس العمّال الأزرق الذي عرفني به كلّ من درس معي بالجامعة، حتّى أنّ واحدة من زميلات الدراسة جرت بيننا مودّة عابرة في آخر سنة جامعية قالت تمازحني: كنت أحسبك عاملا من عمال الكلية مكلفا بصيانة شبكة الماء أو شبكة الكهرباء فأقول ماذا يفعل هذا هنا في ساحة الجامعة وكيف يحق له أن يأخذ الكلمة في حلقات النقاش الطلابية وأن يخطب في الطلاب ومن أين جاءته الفصاحة؟ تخلّيت إذن عن ذلك اللباس الأزرق مدة من الزمن ثم عدت إليه في قلب العاصمة في ذروة الشتاء والإفلاس واقتحمت به مكتب المدير العام للتعليم الثانوي محتجّا ودخلت به مكاتب أخرى في سفارات العراق وليبيا والسنغال أيضا. أما سفارة العراق فقال لي أحد موظفيها معتذرا: يا حسرة على العراق أيام كان يحتضن الإخوة العرب للدراسة أو العمل. وأما سفارة ليبيا فأرسلني إليها صديق قال إن صديقا له يعمل هنالك ويمكن أن يساعدني للترسيم في جامعة طرابس. ولكني لم أتحمس كثيرا لهذا العرض ولا أدري لذلك سببا. ولعل صورة الرجل الذي كان ينتظرني هناك هي السبب. فقد كان يتحدث إلي دون أن تكون عيناه في عيني، وأما سفارة السنغال فكانت في أقصى شارع الحرية في قلب العاصمة وكان فيها موظف سنغالي يبحث عن مدرس عربية يقدم لابنه دروسا ليلية بمقابل محترم فلما زرته اعتذر قائلا :للأسف الشديد يا أستاذ فقد انتدبت أستاذا جاءني قبلك بيوم. لم أصدقه. أعتقد الآن أنه نسج تلك القصة ليتخلص من رجل لا شيء فيه يدل على صورة الأستاذ النمطية. يا لتلك الكسوة العمالية الزرقاء. كنت أدخل كل تلك المكاتب بكسوتي الزرقاء فكيف لا أقتحم بها مقهى باريس أو مقهى الهناء الدوليّ.