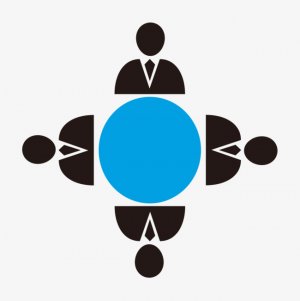من يا ترى يعيد لنا العيد لأصوله الحقيقية، عيد الأضحى الذي كان موعداً سنوياً عامراً بالثقافة الروحية والاجتماعية والعائلية العالية؟.
لن أتحدث عن الجانب الروحاني والعقائدي في العيد، تلك الخصائص العميقة التي كادت أن تختفي من مظاهر العيد عندنا، لكنني سأتعرض لثقافة أخرى طغت على العيد وجرّته نحو الاستهلاك والمال والتنافس المادي القائم على طغيان المظهر واغتيال كل ما هو إنساني داخلي روحي.
هي مقاربة لسوسيولوجيا العيد، وكيف تغيّر الناس والاحتفال بهذا العيد مع زحف التوحش الرأسمالي بثقافته العنيفة الباحثة بالأساس عن الربح، ضاربة بعرض الحائط كل ما هو أخلاقي وجمالي.
وحين نقوم بقراءة سوسيولوجيا العيد فهذا يعني بالأساس أننا نبحث في المتغيرات التي طرأت على "الفرد المحتفل" بالعيد في مجتمعاتنا من الناحية الاجتماعية والثقافية والعائلية.
علينا أن نكون صرحاء مع أنفسنا وأن نتأمل سلوكنا جيداً وأن نكون قادرين على قبول النقد حتى لو كان مرّاً، والوقوف على ما يعيشه مجتمعنا من سلوكات فاسدة جديدة يتم ربطها وإلصاقها بالاحتفال بالعيد، وتشريحها لا يعني مطلقاً أننا نتلذذ بتعرية الأخطاء التي لحقت باحتفالاتنا الدينية، ولكن نقول ذلك من باب توصيف ما آل إليه الفرد والمجتمع من سقوط ذريع أخلاقياً وروحياً وثقافياً ومادياً.
أول أسباب انحدار ثقافة الاحتفال بالعيد وسقوطها هو أن مجتمعاتنا أغرقت الدين في السياسة والتجارة والقروض والمنافسات السخيفة، هذا الدين الذي من المفروض أن يظل بعيداً ومنزهاً عن مثل هذه الأمور البشرية الموسمية المتغيرة والزائلة، وتتجلى هذه الحقيقة المحزنة من خلال كثير من مظاهر الاحتفالات بعيد الأضحى في الجزائر، بل في بلدان شمال أفريقيا بصورة عامة، وللأسف، أضحت هذه المظاهر هي الغالبة في العيد ونقيضها هو البدعة أو الشذوذ.
كنّا أطفالاً وكان عيد الأضحى رحمة على العالمين، والعالمين تبدأ منا نحن الأطفال، كان رحمة علينا وعلى الكبار، يحل العيد ولم نكُن نطرح على أنفسنا سؤال، هل نحن أغنياء أم فقراء؟، لم نكُن نفكر في ذلك مطلقاً، ولم يكُن العيد بكل ما فيه من طقوس خاصة ليجعلنا في مربع المقارنة أو الموازنة الاجتماعية أو المادية مع الآخرين، لم نشعر ونحن في هذا اليوم الكبير بأننا على كفة الميزان بيننا والآخرين من الجيران أو الأقارب، وكان المجتمع كما هو الآن فيه الفقير وفيه الغني وفيه متوسط الحال، وفيه الموظف والفلاح والعاطل، والشيخ والشاب والمقيم والمهاجر والمريض والمعافى... ولم يكُن العيد ليتعمق الإحساس بالفقر عند الفقير، ولا بالغنى عند الغني، كان العيد عبارة عن يوم فرح عمومي عارم تنتفي فيه الفوارق الاجتماعية بصورة واضحة، وكان العيد احتفالاً قائماً على البساطة والمحبة والرحمة، وكان الفقير لا يشعر بحرج يوم العيد، لا شيء يدفعه إلى تحمل شراء أضحية ليس بمقدوره دفع ثمنها، ولم يكُن ذلك عيباً ولا قلة "رجولة" ولا "قلة دين" ولا قلة إيمان، ولم يكُن أبناء الغني يخرجون الكبش في الشارع لعرض طول قرونه على الجيران كما عارضة الأزياء تعرض الفساتين أمام الجمهور.
على مرّ سنين الطفولة والمراهقة، لا أذكر في الاحتفال بعيد الأضحى "صورة الأضحية" ولكنني أذكر جيداً صورة الفرح على وجوه المحتفلين الذين كانوا يزوروننا والذين كنا نلقاهم في الشارع أو في الساحة أو في المسجد، لا أذكر يوماً أنني تساءلت كيف يحضر الخروف عندنا أو عند جيراننا، أو كيف لا يحضر، ولكنني كنت، كما أبناء الأعمام والأخوال والجيران، ننتظر طلوع صباح يوم العيد بشعور سعيد وغامض، صباح لا يشبه الصباحات الأخرى.
كان الرجال الكبار في يوم العيد مبتسمين متسامحين، يقبّل أحدهم الآخر بصدق وعمق، وكانت لحظات التغافر قوية وعميقة بين المتغافرين. وتحيات العيد لا تشبه التحيات الأخرى في الأيام الأخرى. وكان الكبار يلبسون لباساً جزائرياً بسيطاً لكنه لباس العيد بما يحمله من دلالات روحية ومحلية.
وكانت النساء متعطرات فرحات ولم يكُن حديثهن عن "تنظيف وغسيل أحشاء الأضحية" كما هو الآن، كنّ يتحدثن عن حال الغائب في المهجر الذي لم يتمكن من حضور هذا اليوم البهيج، وفي مثل هذا اليوم تتسامح الواحدة مع جارة لها أساءت إليها ذات يوم.
كان العيد سعادة أن نستقبل فيه العم الذي لم نلتقِ به منذ فترة، ونقبّل رأس الخالة والعمة والجارة الحنونة، ونشرب الشاي ونأكل الملفوف من دون حديث عن سعر الخروف أو وزنه أو طول قرونه.
كان العيد هو الموعد الوحيد القادر على قلب صفحة العداوات بين الجيران أو الخلان، أن يعيد الجميع إلى مائدة العيد، شاي وملفوف وكسكسي بسيط، لكنه كسكسي العيد.
كان العيد بما فيه من قيم أخلاقية عالية متوارثة أباً عن جد قادراً على أن يحرر الفرد والجماعة من الشحن الاجتماعي والخلافات التي تحدث، وهذا شيء طبيعي بين أبناء القرية والحي والمدينة والبلد بصورة عامة.
كان يوم العيد فضاء زمنياً واجتماعياً تسمو فيه ثقافة الفرح وثقافة التكاتف والعفة، وكان العيد عاملاً لتمتين العلاقة الإنسانية بين الساكنة، علاقة قائمة على الاحترام والود والتمدن والتشاركية الاجتماعية المادية والمعنوية.
اليوم هجمت ثقافة السوق المتوحشة على الجميع بما تحمله من قيم فاسدة تمثلت بصورة واضحة في لهفة التجار، تجار بعيدون كل البعد من أخلاق التجارة وفنونها، لهفة أصابت الجميع من الموّال إلى بائع الفحم مروراً ببائع اللفت والزيت وسفافيد الشواء الصينية. اليوم الواحد يريد أن يأكل لحم أخيه حيّاً قبل أن يأكل لحم الخروف مشوياً!.
اليوم في المدن كما في القرى، الناس يجرون والخرفان تجري، من يجري خلف من؟، ولا حديث سوى حديث الخرفان الذي أنسى الناس الحديث عن الإيمان.
كل شيء متوتر.
الفقير يبحث عن الاقتراض كي يقتني أضحية بقرون أكبر وأطول من قرون أضحية الجار الذي في الطابق الأعلى أو الأسفل، قروض الناس بحجم قرون الأضاحي. قرون البشر أم قرون الأضاحي؟، لقد اختلط الأمر وتشابه البقر!.
كنّا أطفالاً وكان عيد الأضحى يوم ثقافة، ثقافة فعلاً، فكانت قاعات السينما تمتلئ على آخرها، ونسعد في هذا اليوم لمشاهدة أفلام هندية وإيطالية وأميركية ومصرية، وكنا نفكر في أبطال الأفلام أكثر من التفكير في قرون الخروف، وكان العيد يمنحنا السعادة لأنه يمنحنا فرصة الذهاب إلى قاعة السينما مع الأصدقاء، خرجة جماعية لا تنسى. اليوم لا أحد يفكر في ارتياد قاعات السينما، مؤسسات مقفلة وربما تذبح عند عتباتها الأضاحي؟. والأفلام التي نشاهدها اليوم هي أفلام حية وعلى المباشر، سينما الواقع، أبطالها الأضاحي في الشارع أو في الحوش أو في البلكون.
كي نعيّد للعيد ثقافة الفرح ونحرر المسلم البسيط من توحش السوق ومطحنة الاستهلاك، علينا أن نعيد النظر في برامج المدرسة وفي خطب المساجد وفي خطاب الإعلام العنيف الذي يروّج لما يشوه صورة العيد كما ورثناه من الأجداد.
(ككل خميس، هذا المقال الأسبوعي بأندبندنت اللندنية، الخميس 20 جوان 2024....)
لن أتحدث عن الجانب الروحاني والعقائدي في العيد، تلك الخصائص العميقة التي كادت أن تختفي من مظاهر العيد عندنا، لكنني سأتعرض لثقافة أخرى طغت على العيد وجرّته نحو الاستهلاك والمال والتنافس المادي القائم على طغيان المظهر واغتيال كل ما هو إنساني داخلي روحي.
هي مقاربة لسوسيولوجيا العيد، وكيف تغيّر الناس والاحتفال بهذا العيد مع زحف التوحش الرأسمالي بثقافته العنيفة الباحثة بالأساس عن الربح، ضاربة بعرض الحائط كل ما هو أخلاقي وجمالي.
وحين نقوم بقراءة سوسيولوجيا العيد فهذا يعني بالأساس أننا نبحث في المتغيرات التي طرأت على "الفرد المحتفل" بالعيد في مجتمعاتنا من الناحية الاجتماعية والثقافية والعائلية.
علينا أن نكون صرحاء مع أنفسنا وأن نتأمل سلوكنا جيداً وأن نكون قادرين على قبول النقد حتى لو كان مرّاً، والوقوف على ما يعيشه مجتمعنا من سلوكات فاسدة جديدة يتم ربطها وإلصاقها بالاحتفال بالعيد، وتشريحها لا يعني مطلقاً أننا نتلذذ بتعرية الأخطاء التي لحقت باحتفالاتنا الدينية، ولكن نقول ذلك من باب توصيف ما آل إليه الفرد والمجتمع من سقوط ذريع أخلاقياً وروحياً وثقافياً ومادياً.
أول أسباب انحدار ثقافة الاحتفال بالعيد وسقوطها هو أن مجتمعاتنا أغرقت الدين في السياسة والتجارة والقروض والمنافسات السخيفة، هذا الدين الذي من المفروض أن يظل بعيداً ومنزهاً عن مثل هذه الأمور البشرية الموسمية المتغيرة والزائلة، وتتجلى هذه الحقيقة المحزنة من خلال كثير من مظاهر الاحتفالات بعيد الأضحى في الجزائر، بل في بلدان شمال أفريقيا بصورة عامة، وللأسف، أضحت هذه المظاهر هي الغالبة في العيد ونقيضها هو البدعة أو الشذوذ.
كنّا أطفالاً وكان عيد الأضحى رحمة على العالمين، والعالمين تبدأ منا نحن الأطفال، كان رحمة علينا وعلى الكبار، يحل العيد ولم نكُن نطرح على أنفسنا سؤال، هل نحن أغنياء أم فقراء؟، لم نكُن نفكر في ذلك مطلقاً، ولم يكُن العيد بكل ما فيه من طقوس خاصة ليجعلنا في مربع المقارنة أو الموازنة الاجتماعية أو المادية مع الآخرين، لم نشعر ونحن في هذا اليوم الكبير بأننا على كفة الميزان بيننا والآخرين من الجيران أو الأقارب، وكان المجتمع كما هو الآن فيه الفقير وفيه الغني وفيه متوسط الحال، وفيه الموظف والفلاح والعاطل، والشيخ والشاب والمقيم والمهاجر والمريض والمعافى... ولم يكُن العيد ليتعمق الإحساس بالفقر عند الفقير، ولا بالغنى عند الغني، كان العيد عبارة عن يوم فرح عمومي عارم تنتفي فيه الفوارق الاجتماعية بصورة واضحة، وكان العيد احتفالاً قائماً على البساطة والمحبة والرحمة، وكان الفقير لا يشعر بحرج يوم العيد، لا شيء يدفعه إلى تحمل شراء أضحية ليس بمقدوره دفع ثمنها، ولم يكُن ذلك عيباً ولا قلة "رجولة" ولا "قلة دين" ولا قلة إيمان، ولم يكُن أبناء الغني يخرجون الكبش في الشارع لعرض طول قرونه على الجيران كما عارضة الأزياء تعرض الفساتين أمام الجمهور.
على مرّ سنين الطفولة والمراهقة، لا أذكر في الاحتفال بعيد الأضحى "صورة الأضحية" ولكنني أذكر جيداً صورة الفرح على وجوه المحتفلين الذين كانوا يزوروننا والذين كنا نلقاهم في الشارع أو في الساحة أو في المسجد، لا أذكر يوماً أنني تساءلت كيف يحضر الخروف عندنا أو عند جيراننا، أو كيف لا يحضر، ولكنني كنت، كما أبناء الأعمام والأخوال والجيران، ننتظر طلوع صباح يوم العيد بشعور سعيد وغامض، صباح لا يشبه الصباحات الأخرى.
كان الرجال الكبار في يوم العيد مبتسمين متسامحين، يقبّل أحدهم الآخر بصدق وعمق، وكانت لحظات التغافر قوية وعميقة بين المتغافرين. وتحيات العيد لا تشبه التحيات الأخرى في الأيام الأخرى. وكان الكبار يلبسون لباساً جزائرياً بسيطاً لكنه لباس العيد بما يحمله من دلالات روحية ومحلية.
وكانت النساء متعطرات فرحات ولم يكُن حديثهن عن "تنظيف وغسيل أحشاء الأضحية" كما هو الآن، كنّ يتحدثن عن حال الغائب في المهجر الذي لم يتمكن من حضور هذا اليوم البهيج، وفي مثل هذا اليوم تتسامح الواحدة مع جارة لها أساءت إليها ذات يوم.
كان العيد سعادة أن نستقبل فيه العم الذي لم نلتقِ به منذ فترة، ونقبّل رأس الخالة والعمة والجارة الحنونة، ونشرب الشاي ونأكل الملفوف من دون حديث عن سعر الخروف أو وزنه أو طول قرونه.
كان العيد هو الموعد الوحيد القادر على قلب صفحة العداوات بين الجيران أو الخلان، أن يعيد الجميع إلى مائدة العيد، شاي وملفوف وكسكسي بسيط، لكنه كسكسي العيد.
كان العيد بما فيه من قيم أخلاقية عالية متوارثة أباً عن جد قادراً على أن يحرر الفرد والجماعة من الشحن الاجتماعي والخلافات التي تحدث، وهذا شيء طبيعي بين أبناء القرية والحي والمدينة والبلد بصورة عامة.
كان يوم العيد فضاء زمنياً واجتماعياً تسمو فيه ثقافة الفرح وثقافة التكاتف والعفة، وكان العيد عاملاً لتمتين العلاقة الإنسانية بين الساكنة، علاقة قائمة على الاحترام والود والتمدن والتشاركية الاجتماعية المادية والمعنوية.
اليوم هجمت ثقافة السوق المتوحشة على الجميع بما تحمله من قيم فاسدة تمثلت بصورة واضحة في لهفة التجار، تجار بعيدون كل البعد من أخلاق التجارة وفنونها، لهفة أصابت الجميع من الموّال إلى بائع الفحم مروراً ببائع اللفت والزيت وسفافيد الشواء الصينية. اليوم الواحد يريد أن يأكل لحم أخيه حيّاً قبل أن يأكل لحم الخروف مشوياً!.
اليوم في المدن كما في القرى، الناس يجرون والخرفان تجري، من يجري خلف من؟، ولا حديث سوى حديث الخرفان الذي أنسى الناس الحديث عن الإيمان.
كل شيء متوتر.
الفقير يبحث عن الاقتراض كي يقتني أضحية بقرون أكبر وأطول من قرون أضحية الجار الذي في الطابق الأعلى أو الأسفل، قروض الناس بحجم قرون الأضاحي. قرون البشر أم قرون الأضاحي؟، لقد اختلط الأمر وتشابه البقر!.
كنّا أطفالاً وكان عيد الأضحى يوم ثقافة، ثقافة فعلاً، فكانت قاعات السينما تمتلئ على آخرها، ونسعد في هذا اليوم لمشاهدة أفلام هندية وإيطالية وأميركية ومصرية، وكنا نفكر في أبطال الأفلام أكثر من التفكير في قرون الخروف، وكان العيد يمنحنا السعادة لأنه يمنحنا فرصة الذهاب إلى قاعة السينما مع الأصدقاء، خرجة جماعية لا تنسى. اليوم لا أحد يفكر في ارتياد قاعات السينما، مؤسسات مقفلة وربما تذبح عند عتباتها الأضاحي؟. والأفلام التي نشاهدها اليوم هي أفلام حية وعلى المباشر، سينما الواقع، أبطالها الأضاحي في الشارع أو في الحوش أو في البلكون.
كي نعيّد للعيد ثقافة الفرح ونحرر المسلم البسيط من توحش السوق ومطحنة الاستهلاك، علينا أن نعيد النظر في برامج المدرسة وفي خطب المساجد وفي خطاب الإعلام العنيف الذي يروّج لما يشوه صورة العيد كما ورثناه من الأجداد.
(ككل خميس، هذا المقال الأسبوعي بأندبندنت اللندنية، الخميس 20 جوان 2024....)