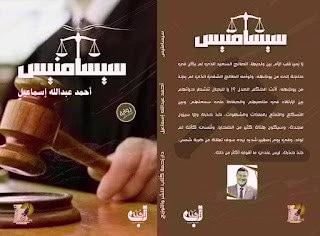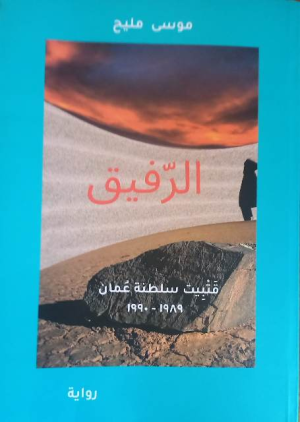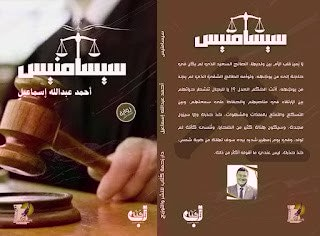هل تختلف معايير الناقد عند النظر للعمل الأول لكاتب ما عن معاييره عند النظر لعمل جديد لكاتب متمرس وراءه رصيد متنام من الأعمال؟ هل معايير النقد مطلقة أم نسبية؟ هل يتناول الناقد العمل الأدبي كما يتناول الأستاذ المصحح كراسة الإجابة على أسئلة الامتحان وقد طوى طرفها فلا يُعرف اسم الطالب ولا يُعرف عنه شيء غير اسمه، وإنما هو رقم مجهول الهوية إلى أن يتم التصحيح وتوضع العلامة وتسجل في قوائم الدرجات؟ وضع هذه القواعد ضمانا لحيدة المصحح وإبعادا لفعل الأهواء الشخصية أن تؤثر سلبا أو إيجابا على الناتج. فهل ينبغي للناقد الأدبي أن ينتهج نهجا شبيها بذلك فيمحو اسم المؤلف من على غلاف الكتاب المنقود ويمحو من ذاكرته كل ما قد يكون مختزنا فيها من معلومات حول الكاتب وسنه وبيئته وخبرته في الحياة وأعماله السابقة إن سبقت له أعمال؟ أم ينبغي للناقد أن يأخذ كل هذا في الحسبان فيترفق بالمبتدئين ولا يحاسبهم حساب الحرفيين الذين أتقنوا صنعتهم ووصلوا موهبتهم؟
الحق أنه قليل من الكُتاب من يولد ناضجا، بل ينبغي أن نعيد صوغ هذه الجملة فنقول أنه ما من كاتب يولد ناضجا، فالكتابة في نطاق أي شكل من الأشكال الأدبية هي حرفة لها أصولها وقواعدها التي لابد من تعلمها لمن يتصدى للكتابة. ولسنا نعني بهذا أنه ينبغي أن يكون هناك "معهد للشعراء" وآخر للروائيين، كل من يحمل إجازة علمية منه نستطيع أن نتوقع منه شعرا جيدا أو روايات فنية رفيعة، مثل هذه المعاهد – إن وجدت – نستطيع أن نعلم الأصول والقواعد وتاريخ الأنواع الأدبية.. إلخ، ولكن يبقى بعد ذلك أو قبله دور الموهبة، وهذه استعداد فطري لا سبيل إليه بالدراسة والإجازات العلمية، ولكن الموهبة من جهة أخرى إن لم تصقل بالدرس والتأمل والمثابرة على التجريب ونقد الذات وتمثل نقد الآخرين فأنها تضيع وتذهب بددا أو تبقى طاقة فطرية غير مهذبة وغير مستغلة مثل منجم ذهب لم يكتشف أو هجر بعد استغلال عروقه السطحية غير عالم هاجروه بالعروق المختبئة على عمق أكبر.
لننظر مثلا إلى توفيق الحكيم. إن من يطالع القائمة المألوفة لمؤلفاته والتي تتصدر أغلب كتبه يجد أن أولى مسرحياته هي "أهل الكهف" المنشورة سنة 1933 وقد بلغ الحكيم من العمر 35 عاما وهي المسرحية التي تعد اليوم من كلاسيكيات الأدب العربي الحديث والتي لهج لسان طه حسين إبان نشرها بالثناء عليها ناعتا إياها بأنها فتح جديد في الأدب العربي، فهل وُلد، توفيق الحكيم عملاقا حتى يكون لعمله الأول هذا الأثر المبهر الذي لم يفل منه الزمان؟ هذا ما قد يتوهمه ملقي النظرة العابرة، لكن الحقيقة أن الحكيم كان يكتب للمسرح لخمس عشرة سنة قبل هذا التاريخ. فقد كان يقتبس ويؤلف لفرقة عكاشة المسرحية وهو بعد طالب وكان ينتحل اسما مستعارا إتقاء لغضب أهله، وأهم من ذلك سنوات بعثته الأربع التي قضاها في باريس وعكف فيها على درس المسرح وغيره من مظاهر الحضارة الأوروبية درسا دقيقا، وتجاربه الكثيرة التي يقصها علينا في التمرس على كتابة الحوار طورا بالفرنسية وطورا بالعربية حتى أتقنه وصارت سلاسة الحوار من أبرز معالم فنه المسرحي فيما بعد، لم يولد ناضجا إذاً، وإنما كانت لديه موهبة تعرف عليها وصقلها بالدرس الدؤوب والتجريب المضني، إلا أن الحكيم أهمل أكثر ما كتبه قبل "أهل الكهف" فلم ينشره بعد أن ذاع صيته باعتنباره من أعمال صباه الفكري، وكثير من الكتاب العظام رفض الناشرون أعمالهم المبكرة أو نشرت أعمالهم فلم تحظ باهتمام حتى أتقنوا فنهم فالتفت إليهم النقاد والقراء. وكأن الكتاب يمكن تقسيمهم إلى صنفين: صنف يتعلم على المكشوف فهو يكتب وينشر أولا بأول يطلع الملأ على تجاربه وأخطائه حتى ينضج أمام أعينهم، وصنف يستتر بعيدا عن الأعين يكتب ويمزق ولا يرى بواكير أعماله ناشر أو ناقد وإنما تلتهم أسطرها سلال المهملات وأدراج النسيان فلا يخرج على العالم إلا مكتمل الإهاب، ناضجا في الصنعة والفكر، ومن الكتاب من يعود بعد أن يشهد له بالسموق في ميدانه فينشر أعمال يفاعته من باب التندر أو الرغبة في إطلاع القراء والنقاد على بذور فكره الأولى، ولهذا الباب من الأدب اصطلاح موقوف على وصفه في الآداب الغربية هو Juvenilia مما تجوز ترجمته بأعمال اليفاعة أو الصبا، وغني عن الذكر أن أعمال اليفاعة لا قيمة تذكر لها في حد ذاتها، وإنما قيمتها دائما مرتبطة بانتسابها إلى كاتب صارت له أعمال عظيمة فيما بعد، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك في الأدب العربي الروايات الثلاث الأولى لنجيب محفوظ التي اصطلح على وصفها بالتاريخية أو الرومانسية فهي أعمال لو لم يصبح محفوظ بعدها من هو لما بقيت حية حتى اليوم وهي أعمال لم يكد يلتفت إليها النقاد في وقتها، ولكنهم عادوا إليها بحماسة شديدة حتى اشتهر محفوظ بفضل أعماله الناضجة.
كل هذه الخواطر عبرت بذهني حين فرغت من قراءة رواية "السباحة في قمقم على قاع المحيط" للصحفية المصرية هالة البدري ومن الغلاف الخلفي للرواية نعلم أنها في منتصف العقد الرابع من عمرها، وأنها كانت سباحة مرموقة فازت ببطولة الجمهورية عدة مرات قبل أن يستغرقها العمل الصحفي والحياة العملية، ومن كلمة التقديم الحماسية التي كتبها لها الدكتور يوسف إدريس تعلم أن هذه روايتها الأولى. وإذا رجعنا إلى التصنيف السابق فسنجد أن هالة البدري تنتمي إلى ذلك القسم من الكُتاب الذي يؤثر أن يتعلم فن الكتابة على الملأ، فروايتها تحمل "العلامة المسجلة" للعمل الأول بكل ما يتميز به من أوجه قصور هي طبيعية في عملية نمو الكاتب وصقل الموهبة، إلا أن من الأعمال الأولى ما تبدأ قراءته فلا تصمد لها حتى الانتهاء منه، أو تنتهي منه فتقسم بينك وبين نفسك أنك لا تضيع وقتك في قراءة هذا الكتاب ثانية. وليست من هذا النوع رواية هالة البدري، فأنت تبدأ قراءتها فلا تجد عناء في المثابرة على صفحاتها المئة والخمسين بل تجد متعة في مواضع كثيرة، وأنت تلمس موهبة سردية وتصويرية فياضة بالحيوية لا ينقصها إلا الصقل الذي لا يتأتى إلا بالقراءة المتأنية والواسعة لأعلام الفن الروائي ورصد التقنيات المختلفة المتاحة للروائي في السرد ورسم الشخصيات وعقد خيوط الحبكة إلى آخره.
رواية الأستاذة البدري تنتمي إلى لون من ألوان الكتابة الروائية اصطلح النقاد الغربيون على وصفه بالكلمة الألمانية Bildungsroman وهي ما يمكن ترجمته برواية النمو أو تعلم الحياة أو الانتقال من حال البراءة إلى حال المعرفة، وهذا الضرب من الرواية غالبا ما يكون السرد فيه بصيغة المتكلم فيروي الحدث وتقدم بقية الشخصيات من وجهة نظر الراوية الذي هو أيضا البطل أو الشخصية الرئيسية في الرواية.. وهذا هو أسلوب السرد الذي تختاره الروائية، وهو أسلوب قد فرض نفسه عليها بلا شك باعتباره أنسب وسيلة للسرد بسبب عنصر السيرة الذاتية القوي في الرواية، فالكاتبة كما قلنا كانت سباحة محترفة بارعة، وروايتها هي قصة علاقة فتاة بالماء منذ سني الطفولة حتى بداية الأنوثة الناضجة، ومن هنا فإن التوحد شبه كامل بين الشخصية الروائية وبين الكاتبة خالفتها، وهو توحد لا يملك القارئ، إلا أن يشعر به، والتفاصيل الواقعية في الرواية لابد أنها مستمدة بالكامل تقريبا من الخبرة الشخصية المباشرة للروائية، فتسعون في المئة على الأقل من الحدثي الروائي يدور حول حوض السباحة بأحد النوادي الذي تنتمي إليه البطلة، وجميع أصدقائها وكلهم أيضا سباحون في فريق النادي متطلعون إلى السبق والبطولة، ولأن الكاتبة تعتمد بالكامل على خبرتها الشخصية المباشرة فإن القارئ، أحياناً ما ينسى أنه يقرأ رواية، ويتصور أنه يقرأ "مذكرات سباحة" وهو إحساس يزكيه أن الكاتبة لا تحسن دائما السيطرة على الوقائع والتفاصيل فتورد منها ما قد يكون شيقا في حد ذاته إلا أنه بلا وظيفة داخل البناء الروائي.
ولعل المأخذ الرئيسي الآخر على الرواية هو أن الكاتبة تتعجل رسم الشخصيات ولا تغوص بما فيه الكفاية وراء دوافع السلوك، وإنما تعمد كثيرا إلى التصوير الخارجي والتقرير بدلا من التجسيد، فيبقى الحدث خارجا، وقائعيا، سريع الحركة، قليل العمق أغلب الوقت، وكل هذا مكتوب بلغة سهلة بسيطة تتميز بالجمل القصيرة والإيقاع السريع، وهي لغة ملائمة لروح الرواية، وهي بلا شك لغة تعلمتها الكاتبة في مدرسة الصحاف التي تعمل بها، ويا ليتها تتعلم مستقبلا أن تضفي عليها شيئا من كثافة لغة الأدب والشعر من دون أن تتخلى عن طابع الحيوية فيها.
أكثرت من الكلام على الجوانب السلبية في البداية غير أن هذا قدر الكاتب الذي يقرر أن ينمو يتطور منشورا على الملأ فاتحا صدره لسهام القراء والنقاد، كما أن الحديث عن السلبيات إنما هو مقدمة للحديث عن الإيجابيات. ولو كانت الرواية تخلو من عناصر إجادة تشفع لعناصر النقصان لما استحقت الالتفات لها. أما أبرز ما في الرواية من عناصر النجاح الفني فهو البناء، فالكاتبة قد وفقت توفيقا كبيرا في توحيد عناصر خبرتها الحياتية وصبها في قالب متماسك البنيان وذي معنى محدد. وهي على هذا قد نجحت أيضا في العثور على العام في الخاص. وهذا مطلب أساسي في الفن الجيد، وهكذا فإن وقائع حياتها حول حوض السباحة وتفاصيل علاقتها بصديقاتها في النادي وبأسرتها و"الكابتن فكري" مدرب السباحة خاصة تصبح في الوقت ذاته وقائع نموها الوجداني من الطفولة في إدراك "أنثويتها" ومعنى هذه الأنثوية في السياق الاجتماعي، وتصبح الرواية ليست سيرة سباحة وإنما سيرة فتاة تحاول التوفيق بين أنوثتها وبين المجتمع، فتاة لا تريد أن تثير سخط المجتمع عليها، ولكنها أيضا لا تريد أن تفقد تفردها وأن تخضع أنوثتها لقيود تقاليد بالية، ومما يحمد للأستاذة البدري أنها تعالج هذا الموضوع في الرواية، وهو موضوع لابد لصيق بوجدانها من حيث أنها أنثى تكتب عن خبرة أنثوية – أنها فعل ذلك دون حماسة زائدة ودون أن تتحول روايتها إلى نفير دعاية لقضية الأنثى المضطهدة في مجتمع رجولي على نحو ما نجد مثلا في روايات الدكتورة نوال السعداوي حيث المواقف والعلاقات مفتعلة من أجل خدمة قضية الأنثوية Feminism التي تبنتها الدكتورة السعداوي من منظور غربي، على حين تبقى هالة البدري متبنية للقضية بشكل طبيعي دون افتعال أو انفعال ومن موقع التعامل مع المجتمع من داخله ليس رفضه رفضا مطلقا.
الرواية إذن تتناول موضوع تحرر الأنثى من المجتمع على المستوى الواقعي، إلا أن للرواية مستوى رمزيا رفيعا يصبح معه هذا التحرر رمزا لتحرر المجتمع كله سياسيا ونضوجه اجتماعيا بحيث يتجاوز هزائمه وأوهامه ويرفض حكم الفرد ويتجه نحو حكم ديمقراطي. ففي الرواية شخصية ساحرة وكريهة في وقت واحد هي شخصية "الكابتن فكري" مدرب السباحة. هو مدرب كفء يجلب لفريقه وناديه البطولات والجوائز، إلا أنه جبار متسلط يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في حياة فتيات الفريق ويكاد يحصي عليهن أنفاسهن ونظراتهن ويلغي حياتهن العاطفية بدعوى حسن السمعة، ولا يقنع إلا بأن يكن له جواري مطيعات مؤلهات في السر والجهر وفي الفكر والفعل، وبما له من سلطة وكفاءة وشخصية آسرة وبما يضربهن الواحدة بالأخرى ينجح في إحكام سيطرته المطلقة عليهن جميعا. إلا أن أحداث الرواية تكشف عن زيفه وخبثه وتطلعه الطبقي، ويصبح الحدث محاولة من جانب الفتيات للتحرر من أسره الخانق، وهو ما ينجحن فيه في النهاية، ويتزامن هذا مع أحداث على المستوى العام تنتهي بحرب أكتوبر وعبور القناة والنضوج السياسي للبلد المتمثل في رفض حكم الفرد والحركة نحو الديمقراطية. تقول الراوية في أواخر الرواية:
"كنا نحس بشعور يجمع بيننا هو أننا كبرنا، ولم نعد مجرد قطع شطرنج، وكان ذلك واضحا أثناء الاجتماع فلم يعد الكابتن يتدفق بالحديث دون اعتراض من أحد. كانت لنا ملاحظاتنا واقتراحاتنا وتحفظاتنا. والغريب أن الكابتن فكري استوعب هذا التحول أو على الأقل تصرف كأنه رجل جديد وسع الصدر حليم وديمقراطي".
وتقول في موضع آخر:
"كرهنا البطولة التي تستعبد الإنسان وتسقط به إلى نقيضها، إلى الهوان والمتهان (...) واقتنعنا أن الإنسان إذا فقد احترام ذاته لا ينفعه هتاف الآخرين بحياته، ولن تزيل أكاليل الغار وصمة الذل عن جبينه".
هذه الكلمات تنصرف إلى علاقة الفريق بالكابتن الديكتاتور على المستوى الخاص للحدث في الرواية، أما على المستوى العام، فمغزى هذا الكلام ومعزى علاقة الفريق بالكابتن ليس ببعيدة المنال عن علاقة الشعب المصري بالحاكم الفرد في عصري عبدالناصر والسادات. إلا أن هالة البدري توفق توفيقا – لا يملك إلا أن يحسدها عليه كتاب أذيع صيتا وأعرق مرانة بالفن الروائي – في مزج الرمز بالنسيج الواقعي للرواية فلا تستطيع أن تفصل بينهما، بل إنه يبلغ من "خفة يدها" أن المرء يبقى في شك ما إذا كانت قصدت عمدا إلى المستوى الرمزي أم أنه جاء عفو الخاطر ومن حيث لم تكن تحتسب.
"السباحة في قمقم على قاع المحيط"
رواية – هالة البدري
دار الغد – القاهرة – 1988
الحق أنه قليل من الكُتاب من يولد ناضجا، بل ينبغي أن نعيد صوغ هذه الجملة فنقول أنه ما من كاتب يولد ناضجا، فالكتابة في نطاق أي شكل من الأشكال الأدبية هي حرفة لها أصولها وقواعدها التي لابد من تعلمها لمن يتصدى للكتابة. ولسنا نعني بهذا أنه ينبغي أن يكون هناك "معهد للشعراء" وآخر للروائيين، كل من يحمل إجازة علمية منه نستطيع أن نتوقع منه شعرا جيدا أو روايات فنية رفيعة، مثل هذه المعاهد – إن وجدت – نستطيع أن نعلم الأصول والقواعد وتاريخ الأنواع الأدبية.. إلخ، ولكن يبقى بعد ذلك أو قبله دور الموهبة، وهذه استعداد فطري لا سبيل إليه بالدراسة والإجازات العلمية، ولكن الموهبة من جهة أخرى إن لم تصقل بالدرس والتأمل والمثابرة على التجريب ونقد الذات وتمثل نقد الآخرين فأنها تضيع وتذهب بددا أو تبقى طاقة فطرية غير مهذبة وغير مستغلة مثل منجم ذهب لم يكتشف أو هجر بعد استغلال عروقه السطحية غير عالم هاجروه بالعروق المختبئة على عمق أكبر.
لننظر مثلا إلى توفيق الحكيم. إن من يطالع القائمة المألوفة لمؤلفاته والتي تتصدر أغلب كتبه يجد أن أولى مسرحياته هي "أهل الكهف" المنشورة سنة 1933 وقد بلغ الحكيم من العمر 35 عاما وهي المسرحية التي تعد اليوم من كلاسيكيات الأدب العربي الحديث والتي لهج لسان طه حسين إبان نشرها بالثناء عليها ناعتا إياها بأنها فتح جديد في الأدب العربي، فهل وُلد، توفيق الحكيم عملاقا حتى يكون لعمله الأول هذا الأثر المبهر الذي لم يفل منه الزمان؟ هذا ما قد يتوهمه ملقي النظرة العابرة، لكن الحقيقة أن الحكيم كان يكتب للمسرح لخمس عشرة سنة قبل هذا التاريخ. فقد كان يقتبس ويؤلف لفرقة عكاشة المسرحية وهو بعد طالب وكان ينتحل اسما مستعارا إتقاء لغضب أهله، وأهم من ذلك سنوات بعثته الأربع التي قضاها في باريس وعكف فيها على درس المسرح وغيره من مظاهر الحضارة الأوروبية درسا دقيقا، وتجاربه الكثيرة التي يقصها علينا في التمرس على كتابة الحوار طورا بالفرنسية وطورا بالعربية حتى أتقنه وصارت سلاسة الحوار من أبرز معالم فنه المسرحي فيما بعد، لم يولد ناضجا إذاً، وإنما كانت لديه موهبة تعرف عليها وصقلها بالدرس الدؤوب والتجريب المضني، إلا أن الحكيم أهمل أكثر ما كتبه قبل "أهل الكهف" فلم ينشره بعد أن ذاع صيته باعتنباره من أعمال صباه الفكري، وكثير من الكتاب العظام رفض الناشرون أعمالهم المبكرة أو نشرت أعمالهم فلم تحظ باهتمام حتى أتقنوا فنهم فالتفت إليهم النقاد والقراء. وكأن الكتاب يمكن تقسيمهم إلى صنفين: صنف يتعلم على المكشوف فهو يكتب وينشر أولا بأول يطلع الملأ على تجاربه وأخطائه حتى ينضج أمام أعينهم، وصنف يستتر بعيدا عن الأعين يكتب ويمزق ولا يرى بواكير أعماله ناشر أو ناقد وإنما تلتهم أسطرها سلال المهملات وأدراج النسيان فلا يخرج على العالم إلا مكتمل الإهاب، ناضجا في الصنعة والفكر، ومن الكتاب من يعود بعد أن يشهد له بالسموق في ميدانه فينشر أعمال يفاعته من باب التندر أو الرغبة في إطلاع القراء والنقاد على بذور فكره الأولى، ولهذا الباب من الأدب اصطلاح موقوف على وصفه في الآداب الغربية هو Juvenilia مما تجوز ترجمته بأعمال اليفاعة أو الصبا، وغني عن الذكر أن أعمال اليفاعة لا قيمة تذكر لها في حد ذاتها، وإنما قيمتها دائما مرتبطة بانتسابها إلى كاتب صارت له أعمال عظيمة فيما بعد، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك في الأدب العربي الروايات الثلاث الأولى لنجيب محفوظ التي اصطلح على وصفها بالتاريخية أو الرومانسية فهي أعمال لو لم يصبح محفوظ بعدها من هو لما بقيت حية حتى اليوم وهي أعمال لم يكد يلتفت إليها النقاد في وقتها، ولكنهم عادوا إليها بحماسة شديدة حتى اشتهر محفوظ بفضل أعماله الناضجة.
كل هذه الخواطر عبرت بذهني حين فرغت من قراءة رواية "السباحة في قمقم على قاع المحيط" للصحفية المصرية هالة البدري ومن الغلاف الخلفي للرواية نعلم أنها في منتصف العقد الرابع من عمرها، وأنها كانت سباحة مرموقة فازت ببطولة الجمهورية عدة مرات قبل أن يستغرقها العمل الصحفي والحياة العملية، ومن كلمة التقديم الحماسية التي كتبها لها الدكتور يوسف إدريس تعلم أن هذه روايتها الأولى. وإذا رجعنا إلى التصنيف السابق فسنجد أن هالة البدري تنتمي إلى ذلك القسم من الكُتاب الذي يؤثر أن يتعلم فن الكتابة على الملأ، فروايتها تحمل "العلامة المسجلة" للعمل الأول بكل ما يتميز به من أوجه قصور هي طبيعية في عملية نمو الكاتب وصقل الموهبة، إلا أن من الأعمال الأولى ما تبدأ قراءته فلا تصمد لها حتى الانتهاء منه، أو تنتهي منه فتقسم بينك وبين نفسك أنك لا تضيع وقتك في قراءة هذا الكتاب ثانية. وليست من هذا النوع رواية هالة البدري، فأنت تبدأ قراءتها فلا تجد عناء في المثابرة على صفحاتها المئة والخمسين بل تجد متعة في مواضع كثيرة، وأنت تلمس موهبة سردية وتصويرية فياضة بالحيوية لا ينقصها إلا الصقل الذي لا يتأتى إلا بالقراءة المتأنية والواسعة لأعلام الفن الروائي ورصد التقنيات المختلفة المتاحة للروائي في السرد ورسم الشخصيات وعقد خيوط الحبكة إلى آخره.
رواية الأستاذة البدري تنتمي إلى لون من ألوان الكتابة الروائية اصطلح النقاد الغربيون على وصفه بالكلمة الألمانية Bildungsroman وهي ما يمكن ترجمته برواية النمو أو تعلم الحياة أو الانتقال من حال البراءة إلى حال المعرفة، وهذا الضرب من الرواية غالبا ما يكون السرد فيه بصيغة المتكلم فيروي الحدث وتقدم بقية الشخصيات من وجهة نظر الراوية الذي هو أيضا البطل أو الشخصية الرئيسية في الرواية.. وهذا هو أسلوب السرد الذي تختاره الروائية، وهو أسلوب قد فرض نفسه عليها بلا شك باعتباره أنسب وسيلة للسرد بسبب عنصر السيرة الذاتية القوي في الرواية، فالكاتبة كما قلنا كانت سباحة محترفة بارعة، وروايتها هي قصة علاقة فتاة بالماء منذ سني الطفولة حتى بداية الأنوثة الناضجة، ومن هنا فإن التوحد شبه كامل بين الشخصية الروائية وبين الكاتبة خالفتها، وهو توحد لا يملك القارئ، إلا أن يشعر به، والتفاصيل الواقعية في الرواية لابد أنها مستمدة بالكامل تقريبا من الخبرة الشخصية المباشرة للروائية، فتسعون في المئة على الأقل من الحدثي الروائي يدور حول حوض السباحة بأحد النوادي الذي تنتمي إليه البطلة، وجميع أصدقائها وكلهم أيضا سباحون في فريق النادي متطلعون إلى السبق والبطولة، ولأن الكاتبة تعتمد بالكامل على خبرتها الشخصية المباشرة فإن القارئ، أحياناً ما ينسى أنه يقرأ رواية، ويتصور أنه يقرأ "مذكرات سباحة" وهو إحساس يزكيه أن الكاتبة لا تحسن دائما السيطرة على الوقائع والتفاصيل فتورد منها ما قد يكون شيقا في حد ذاته إلا أنه بلا وظيفة داخل البناء الروائي.
ولعل المأخذ الرئيسي الآخر على الرواية هو أن الكاتبة تتعجل رسم الشخصيات ولا تغوص بما فيه الكفاية وراء دوافع السلوك، وإنما تعمد كثيرا إلى التصوير الخارجي والتقرير بدلا من التجسيد، فيبقى الحدث خارجا، وقائعيا، سريع الحركة، قليل العمق أغلب الوقت، وكل هذا مكتوب بلغة سهلة بسيطة تتميز بالجمل القصيرة والإيقاع السريع، وهي لغة ملائمة لروح الرواية، وهي بلا شك لغة تعلمتها الكاتبة في مدرسة الصحاف التي تعمل بها، ويا ليتها تتعلم مستقبلا أن تضفي عليها شيئا من كثافة لغة الأدب والشعر من دون أن تتخلى عن طابع الحيوية فيها.
أكثرت من الكلام على الجوانب السلبية في البداية غير أن هذا قدر الكاتب الذي يقرر أن ينمو يتطور منشورا على الملأ فاتحا صدره لسهام القراء والنقاد، كما أن الحديث عن السلبيات إنما هو مقدمة للحديث عن الإيجابيات. ولو كانت الرواية تخلو من عناصر إجادة تشفع لعناصر النقصان لما استحقت الالتفات لها. أما أبرز ما في الرواية من عناصر النجاح الفني فهو البناء، فالكاتبة قد وفقت توفيقا كبيرا في توحيد عناصر خبرتها الحياتية وصبها في قالب متماسك البنيان وذي معنى محدد. وهي على هذا قد نجحت أيضا في العثور على العام في الخاص. وهذا مطلب أساسي في الفن الجيد، وهكذا فإن وقائع حياتها حول حوض السباحة وتفاصيل علاقتها بصديقاتها في النادي وبأسرتها و"الكابتن فكري" مدرب السباحة خاصة تصبح في الوقت ذاته وقائع نموها الوجداني من الطفولة في إدراك "أنثويتها" ومعنى هذه الأنثوية في السياق الاجتماعي، وتصبح الرواية ليست سيرة سباحة وإنما سيرة فتاة تحاول التوفيق بين أنوثتها وبين المجتمع، فتاة لا تريد أن تثير سخط المجتمع عليها، ولكنها أيضا لا تريد أن تفقد تفردها وأن تخضع أنوثتها لقيود تقاليد بالية، ومما يحمد للأستاذة البدري أنها تعالج هذا الموضوع في الرواية، وهو موضوع لابد لصيق بوجدانها من حيث أنها أنثى تكتب عن خبرة أنثوية – أنها فعل ذلك دون حماسة زائدة ودون أن تتحول روايتها إلى نفير دعاية لقضية الأنثى المضطهدة في مجتمع رجولي على نحو ما نجد مثلا في روايات الدكتورة نوال السعداوي حيث المواقف والعلاقات مفتعلة من أجل خدمة قضية الأنثوية Feminism التي تبنتها الدكتورة السعداوي من منظور غربي، على حين تبقى هالة البدري متبنية للقضية بشكل طبيعي دون افتعال أو انفعال ومن موقع التعامل مع المجتمع من داخله ليس رفضه رفضا مطلقا.
الرواية إذن تتناول موضوع تحرر الأنثى من المجتمع على المستوى الواقعي، إلا أن للرواية مستوى رمزيا رفيعا يصبح معه هذا التحرر رمزا لتحرر المجتمع كله سياسيا ونضوجه اجتماعيا بحيث يتجاوز هزائمه وأوهامه ويرفض حكم الفرد ويتجه نحو حكم ديمقراطي. ففي الرواية شخصية ساحرة وكريهة في وقت واحد هي شخصية "الكابتن فكري" مدرب السباحة. هو مدرب كفء يجلب لفريقه وناديه البطولات والجوائز، إلا أنه جبار متسلط يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في حياة فتيات الفريق ويكاد يحصي عليهن أنفاسهن ونظراتهن ويلغي حياتهن العاطفية بدعوى حسن السمعة، ولا يقنع إلا بأن يكن له جواري مطيعات مؤلهات في السر والجهر وفي الفكر والفعل، وبما له من سلطة وكفاءة وشخصية آسرة وبما يضربهن الواحدة بالأخرى ينجح في إحكام سيطرته المطلقة عليهن جميعا. إلا أن أحداث الرواية تكشف عن زيفه وخبثه وتطلعه الطبقي، ويصبح الحدث محاولة من جانب الفتيات للتحرر من أسره الخانق، وهو ما ينجحن فيه في النهاية، ويتزامن هذا مع أحداث على المستوى العام تنتهي بحرب أكتوبر وعبور القناة والنضوج السياسي للبلد المتمثل في رفض حكم الفرد والحركة نحو الديمقراطية. تقول الراوية في أواخر الرواية:
"كنا نحس بشعور يجمع بيننا هو أننا كبرنا، ولم نعد مجرد قطع شطرنج، وكان ذلك واضحا أثناء الاجتماع فلم يعد الكابتن يتدفق بالحديث دون اعتراض من أحد. كانت لنا ملاحظاتنا واقتراحاتنا وتحفظاتنا. والغريب أن الكابتن فكري استوعب هذا التحول أو على الأقل تصرف كأنه رجل جديد وسع الصدر حليم وديمقراطي".
وتقول في موضع آخر:
"كرهنا البطولة التي تستعبد الإنسان وتسقط به إلى نقيضها، إلى الهوان والمتهان (...) واقتنعنا أن الإنسان إذا فقد احترام ذاته لا ينفعه هتاف الآخرين بحياته، ولن تزيل أكاليل الغار وصمة الذل عن جبينه".
هذه الكلمات تنصرف إلى علاقة الفريق بالكابتن الديكتاتور على المستوى الخاص للحدث في الرواية، أما على المستوى العام، فمغزى هذا الكلام ومعزى علاقة الفريق بالكابتن ليس ببعيدة المنال عن علاقة الشعب المصري بالحاكم الفرد في عصري عبدالناصر والسادات. إلا أن هالة البدري توفق توفيقا – لا يملك إلا أن يحسدها عليه كتاب أذيع صيتا وأعرق مرانة بالفن الروائي – في مزج الرمز بالنسيج الواقعي للرواية فلا تستطيع أن تفصل بينهما، بل إنه يبلغ من "خفة يدها" أن المرء يبقى في شك ما إذا كانت قصدت عمدا إلى المستوى الرمزي أم أنه جاء عفو الخاطر ومن حيث لم تكن تحتسب.
"السباحة في قمقم على قاع المحيط"
رواية – هالة البدري
دار الغد – القاهرة – 1988