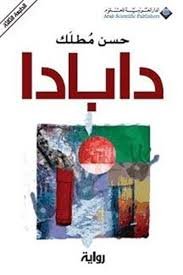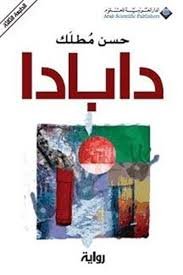ماذا يفعل الكاتب المتمرس أو المحترف عندما ينوي كتابة عمل رواية أو قصة قصيرة يريد لها مسبقاً أن تملك صوتاً خاصاً متميزاً ناجحاً في إثارة الانتباه، متوغلاً في بعض مساءلاته أكثر من غيره في ملامسة الجذور الحية للموضوعات التي تحركت باتجاهها؟.
بل ماذا يفعل كاتب شاب، ليس محترفاً ولا متمرساً عندما ينوي كتابة عمل رواية أو قصة يريد لها مسبقاً أن تسحب الضوء أو بعضاً منه في فرصة تصنعها بنفسها مثل مئات الروايات والقصص؟. لابد من شيء جديد.. هذا هو الجواب. لابد من شيء جديد وشكل جديد وطريقة جديدة على الأقل في اتجاه أو بعض اتجاه من اتجاهاتها الفنية التي تبشر بمصداقية هذا التوجه بما فيه من جديد لاكتساب الهوية المميزة. لابد من الكتابة بطريقة جديدة.. بمعنى لابد من البداية من الصفر.. كيف؟.
ولأنني مازلت أحوم حول الموضوع ينبغي أن لا يتبادر إلى الذهن أنني أعني تجريد الكاتب مما علق فيه عبر قراءاته المتعددة أو عبر فعل القراءة لروايات وقصص لآخرين يفترض أنها كتبت بنفس الطريقة الجديدة أو أنني أفكر بعزل ما استطاع أن يتمثله من هذه الكتابات عبر فعل القراءة المتواصلة. إن تأكيد أهمية أن يقول الكاتب ـ أي كاتب ـ أشياءه بطريقته الخاصة وبلسانه هو تتمحور بداخله كل رؤاه وأفكاره.
ومن هنا فإن إجابة القاص حسن مطلك عبر روايته ـ دابادا ـ تتفق مع ما ذهبت إليه لتقول بلا مواربة؛ أن الكاتب ـ أي كاتب ـ إنما يعيد قول أشياء قيلت مئات المرات ولكن في أُطر جديدة وبطريقة خاصة وعبر اختزال كل ذلك التردد والتنظير. ويقول عبر هذه الرواية؛ أنه إذا كانت المواضيع ذاتها التي تناولها الأدب عبر الآف السنين فإنه تبقى هناك فرص جديدة دائماً لقول مثل هذه المواضيع مئات المرات أيضاً، الآن وفي المستقبل، ولكن لكل مرة طريقة جديدة قد يقترب فيها أو يبتعد من هذا الروائي أو ذاك في هذه الحقبة أو تلك دون أن يغيب تحت عباءة هذا أو جبة ذاك، بل أن يظل محتفظاً ـ ولو بصورة جزئية ـ بصوته الخاص أو بنبرته الخاصة إذا اختلطت الأصوات.. إنها مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
صعبة لأن الكتابة أصلاً أصعب المهمات. وصعبة لأن الإبداع وفي كل العصور من الخيارات الصعبة التي يستحيل فيها الإيهام أو الخداع.. ولكن ما فعله (حسن مطلك) في روايته البكر ( دابادا ) وما فهمته من قراءاتي لهذه الرواية يجعلني أميل إلى القول بإمكانية تحقق ذلك الهاجس الإبداعي في أي زمن. هذه الرواية ـ دابادا ـ حاولت أن توهمني أول وهلة بأن الكتابة بهذه الطريقة التي يقترحها ليست صعبة كما يشاع ولكن بمجرد إخضاعها للتحليل والإمساك بمفاتيحها أشعرتني أن كاتبها قد اختار المسلك الصعب من بين مسالك كثيرة صعبة جميعها تحجم عن اللجوء إلى التسلسل المنطقي للأحداث والأزمنة والأمكنة والأفعال والشخوص.. أهي خدعة في الكتابة استطاع مبتدعها ـ حسن مطلك ـ أن يمرر علينا؛ على أنها رواية جديدة ويفاجئنا بجدتها مستغلاً حنيننا الدائم لمواصلة الكتابة والقراءة وابتكار الطرق أو محاولة الوقوف على ما استجد من الطرق الكفيلة باستيعاب أفكارنا وهمومنا.. أم هي فعلاً غير ذلك؟!.
إن الأمر يتطلب مهارة عالية في فن الخداع. والرواية والقصة فن يشكل خداع المخيلة جزءاً كبيراً من تكوينه. ولكن ما هو حقيقي وواضح هو أن حسن مطلك يقترح علينا الكتابة خارج شروط الرواية أو خارج شروط الفن المتوارثة وبذلك يقطع الطريق على المخيلة وخداعها ولا يعطيها إلا أقل جسامة في العمل الروائي، وبذلك يطمئننا إلى أنها ليست خدعة، إنما هي غير ذلك. إنه يقترح علينا نقل الرواية أثناء تكونها خارج هويتها التقليدية حتى تصبح مطابقة إلى حد كبير للحياة ولا تختلف عنها قيد شعرة. يقترح علينا (بعيداً عن امتطاء المخيلة) أن ندع الحياة تدون أحداثها وسيرها ومحاورها وهوامشها ومفرداتها وكل الأشياء الداخلة المشتركة في تكوينها. وعلى هواها بلا تدخل ( إلا بحدود ضيقة) للمخيلة لنقع بالتالي على شكل جديد من أشكال الرواية الجديدة.. شكل مبتكر.
أجل الرواية الجديدة التي كتبتها فرجينيا وولف وآلان روب غرييه بالذات. ولكن إلى أي مدى نستطيع تقبل اقتراح الكتابة بدون شروط الحالة النفسية أو الفكرية أو الاجتماعية بعد أن نقتنع بأن هذه ليست نظرية جديدة في التلقي ولا هي محاولة لإضفاء شيء من الشرعية على كتابات من هذا النوع، إنما هي مجرد اقتراحات قابلة للمناقشة.. للرفض والقبول.
إنه اقتراح معقول.. الذي يريد للكتابة أن تأخذ شكل جريان الحياة وتعاقب الليل والنهار.. الظهور والاختفاء، الضحك والبكاء، المهم والثانوي، الفن والتخلف، الرغبة والحياة.... إلخ.
.. أن نكتب كما نعيش. لأن نعيش ونقترح بالكتابة نمطاً للعيش.. أن نسعى لأن نكتب كما نعيش بدقة؛ نستيقظ صباحاً لنشرب الشاي، نرتدي ملابسنا، نذهب إلى أعمالنا، نلتقي، نحب، نكره، نتذمر، نتفاءل، نتخاصم بسبب وبدون سبب، نبحث في الزوايا الميتة في القرية والروايات الميتة في نفوسنا عن دوافع جديدة لعيش يوم جديد، لإثارة مواضيع وشهوات ورغبات جديدة نتابعها ونحن في طريق تكونها وتوجهاتها.. نراقب حركات بعضنا بدقة، نفسرها على هوانا، لا لكي نعطي هذا الفعل الذي اجتذبنا أكثر من غيره في الرواية حجمه الحقيقي وننقم بالمقابل على فعل آخر لا يروق لنا، إنما لنعطي هذه الحركة مصداقيتها في الجانب المتعلق بنا كحركة متوقعة في الحياة، ولا بأس من التستر عليها بعض الوقت حتى تنضج ويصبح بالإمكان الاحساس بها كحقيقة مجردة.
إن الكتابة عن الحياة كما هي وبدون تدخل كما تتدفق وتتعرج؛ هي كتابة أو نمط من الكتابة عن الحياة ليس جديداً، ولكنه نمط مفتوح دائماً على مساحات واسعة للإبتكار والتجديد والمغامرة المحفوفة بالمخاطر. لقد كتب بها العديد من الكتاب مستخدمين " المهارة " والصنعة والمخيلة، لكننا أمام نص روائي لا يصنف مع تداعي تيار الوعي ولا مع البناء السردي القائم على كسر خطوط السرد بقصدية مبالغ فيها تسعى في جوهرها للإقتراب من مكونات إشكالية البناء الروائي وتعدديته.. وبطريقة خاصة جداً..
إن رواية ـ دابادا ـ نقلتنا إلى الحياة في القرية وجعلتنا نستغني عن دور الكاتب الذي لم يكن يظهر لنا ونحن نعيش حياة هذه القرية المجزأة بين ماضي شاحب وحاضر مخاتل ومستقبل لا يفصح عن نفسه بسهولة، لكنه ينهض من حين لآخر. نقلتنا إلى القرية دون اللجوء إلى النص بين عالم روائي متخيل مبتدع وبين عالم حسي حقيقي للقرية التي تدور فيها أحداث الرواية. إن الرواية تبدأ الحديث في آن.. عن حشد من أحداث وأشخاص وعلاقات وتدفع بها إلى نهاياتها البعيدة المستحيلة، ولكن دون أن تهينها أو توضحها بصورة تامة، بل تجمدها عند نقاط معينة من النص لتبدأ من جديد بصنع حشد من موج من أحداث جديدة وأشخاص وعلاقات، ولترتفع بها أيضاً إلى أقصى نقاطها ثم تجميدها مرة أخرى هناك والعودة مرة أخرى لدفع أو تحريك الحشد الأول الذي تجمد عند نقاط معينة في الرواية.. وهكذا ففي كل مرة يريد إثارة موجة جديدة يبدأ بعبارة يختارها بعناية فائقة من تلك العبارات التي أنهى عندها مرحلة ما من الرواية أو ليبدأ مرحلة جديدة لم يكن يخطط لها بقدر ما كانت حاضرة في المشهد الروائي أو التربوي، ولكنها مؤجلة بعض الوقت... فعلى الصفحة (5) نراه يبدأ حديثاً جديداً أو يعطي فرصة لجزء من القرية لأن تتقدم ممهداً له بهذه العبارة:" وأخيراً انتهت القناعات مع زوال الفصول وأصبح رضاه نادراً، فبدأ بنقر الغلاف مثل فرخ في بيضة". وبهذه العبارة نفسها نفاجأ بأنه قد اختتم أو أوقف بعضاً من تلك المشاهد مؤجلاً إياها بعض الوقت، أي حتى الصفحة (8) حيث ينهي بصراحة حضور بعض مكونات الرواية، لا لينتقل إلى غيرها بصورة تقليدية وإنما ليعزز مسعاه في دمج وعي الكتابة بوعي الحياة، وعي الكاتب بوعي أي فرد من أفراد هذه القرية الصغيرة. إن التجميد المؤقت لأي حشد من الأحداث يتم لضرورة اكتشاف بدايات سليمة لمسارات جديدة لمرحلة لاحقة مع الحياة/الرواية. وعندما تشرف الحياة على صفحة جديدة من صفحاتها المتلاحقة، وعندما يرى أن تلك العبارة أو الحقيقة أو الجملة الطويلة قد التحقت بما تم تجميده، فإنه يلجأ إلى مقدمات جديدة ونهايات جديدة، فبانتهاء المشهد الأولي للرواية/للقرية عند الصفحة (16) يجد أنه من المناسب البحث عن مدخل جديد للمشهد الآتي الذي نراه قبل أن يخترعه لنا، فيكفي أن يضع يده على العبارة المناسبة ويقول: " الغرف مظلمة ماعدا غرفته لأنها مرتفعة. مكان دائم لتبدل الفصول، مكان خاص للنوم والطعام والعري ". تلك العبارة التي وردت عرضاً في الصفحة (8) عند نهاية مشهد صغير من الرواية، وبعد أن يفتح أبواب الرواية أمام مشاهد جديدة أو بعد أن يقترب من مشاهد مؤجلة في القرية.. بروايتها يعود إلى تلك المسارات القديمة المتعرجة التي تأخذ ـ بالضبط ـ شكل سير الحياة وشكل تفاصيلها ومفرداتها... وليست العبارة الطويلة هي الوحيدة التي يستخدمها في تكنيكه هذا.. بل يلجأ، في كثير من الأحيان، وبنفس الشغف إلى الاحتكاك بالحقائق الموجزة. ومنها أن والد (شاهين) الشخصية الأكثر حضوراً في القرية، كان قد اختفى بسبب ركضه وراء أرنب مُـبَـقَع، فكان يلجأ إلى تسخير هذه الحقيقة للاقتراب أكثر فأكثر من الحقائق النفسية والاجتماعية والفكرية والحسية التي تتمخض عنها شخصية شاهين أو شخصية أمـه. فيبدأ في الصفحة الأولى بالقول: " ضياع الأب في البراري بسبب أرنب مبقع ". ليعود بعد عدة صفحات لاستغلال وتطوير الإمكانية الكاشفة لهذه الحقيقة، فيعيد القول:" عن الأب الذاهب خلف أرنب مبقع ". في الصفحة (9) ثم ليعود في الصفحة (24) لتكرار العبارة نفسها بحذافيرها، ليبدأ متابعة الجانب المؤجل من الحياة في الجانب الواضح من القرية وعلاقاتها... وهكذا تتواصل الحلقات بخيط سردي لا ينقطع ولكنه يختفي أحياناً ويتلون أحياناً أخرى بلون الحديث الآني الذي يستجد على الدوام.. لا ينقطع ولكنه يأخذ حجم الأسى أو حجم الضحكة أو لون الابتسامة أو شكل الرغبة الجسدية أو تباطؤ المخيلة المعطلة أو جموحها وهي تتقد في حدود واضحة.. لا يهم ما موجود خلفها أو على الجانبين.
وهكذا أيضاً تمضي الحياة، ثقيلة أو ساخنة، بليدة أو مفعمة بالشهوات والشهقات الآتية من أعماق (هاجر) و(عزيزة) و(شاهين).. وهكذا تلتم وتكتمل خطوط الرواية التي قدمت نفسها في هذا الإطار الحياتي الحقيقي، أو هكذا تتقدم نحونا القرية ذاتها مؤطرة بهذا الإطار الذي يحافظ فقط على إمكانية التحرك ولو مؤقتاً في (مكان) واحد محدد.
إن القاص حسن مطلك يتناول خيطاً واحداً من مجموعة خيوط مشتبكة تكون بمجموعها نسيج الرواية، أو تنسج على نحو جديد علاقات القرية، ما ظهر منها وما بطن، أي أنه يلتقط شخصية أو حركة لشخصية أو عادة لأكثر من شخصية، أو ملامح ما أو وجهات نظر أو تقرير مباشر أو أحاسيس بينة.. ليعيد من خلال متابعته تداخله مع غيره من خيوط النسيج في أكثر من مكان وفي أكثر من وشيجة، وليعيد بالتالي تشكيل قدرة الرواية.. مجدداً على التدفق والجريان بين دروب القرية ودواخل نفوس أبنائها ومناخاتها ولياليها وشموسها وأراضيها ودهاليزها المكتظة بالحيوانات المختلفة أو الموت المطلق. ومرة بعد مرة نكتشف بأن هذه الرواية أو هذه الذروة من الرواية ماتزال تصلح لأن تكون منطلقاً جديداً لامتداد جديد في الرواية. ومرة بعد مرة يأخذنا في مجاهيل قرية صغيرة، في مكانها وبشرها التي تكبر في أزمانها وعلاقاتها وتحديقها في ظرفها ومحنتها. ومرة بعد مرة يفتح مضطراً؛ منافذ جديدة من خلال التقاط الخيوط التي يوهمنا أنها ضائعة في بعضها البعض حتى يتعذر الامساك بها إلا بعد أن تصل الشخصيات والأحداث إلى ذروتها، وبعد أن يصل الكاتب (الذي لا يمكن تمييزه عن أي واحد من أبناء القرية) إلى الاقتناع بضرورة إغلاقها أو إنهائها... ودائماً، ودون أية أهمية تذكر على صعيد من أصعدة الرواية ومستوياتها أو أي صعيد من أصعدة العلاقات الحقيقية في القرية أن يتناول الحديث أو الخيط المسحوب من النسيج لشخصية ثانوية أو هامشية أو رديئة، لأن كل أشخاص الرواية الذين يعلنون عن وجودهم من حين لآخر في الحياة وفي صورتها؛ في الرواية: هاجر وشاهين وشرار (الكلب) وعواد وعزيزة وحلاب ووزة وزهرة والحمار والأرنب المبقع " والمعذَّب صابر يوم الأربعاء بعد المطر ". لأنهم كلهم مرتبطون بقوة أسباب الحياة، وبقوة أسباب البناء الروائي، مرتبطون بنسيج قوي لا يمكن أن يستل منه خيط واحد دون أن تتحرك بقية الخيوط كما هي حقيقة الحياة في القرية.
.. وبعد.. فهذه قراءة أولية لرواية (دابادا) لكاتب شاب مبدع هو حسن مطلك الذي سبق لبعض قصصه القصيرة أن فازت بجوائز في مسابقات قصص الحرب، مثل قصة (عرانيس) المعروفة التي فازت بالجائزة الأولى... أقول هذه قراءة أولية أردت أن أُشير من خلالها إلى أن هذه الرواية التي صدرت عام 1988 تستحق القراءة مرة أخرى، وتستحق أن تنال بعضاً من الاهتمام الجاد من جانب النقد والنقاد.. فهي بحق تبشر بموهبة إبـداعية جديـدة.
----------------------------------------------
* نشر هذا المقال في جريدة (القادسية) العدد3095 بتاريخ 5/12/1989م.بغداد.
* ونشرت في مجلة (ألواح) العدد 11 سنة 2001م مدريد.

بل ماذا يفعل كاتب شاب، ليس محترفاً ولا متمرساً عندما ينوي كتابة عمل رواية أو قصة يريد لها مسبقاً أن تسحب الضوء أو بعضاً منه في فرصة تصنعها بنفسها مثل مئات الروايات والقصص؟. لابد من شيء جديد.. هذا هو الجواب. لابد من شيء جديد وشكل جديد وطريقة جديدة على الأقل في اتجاه أو بعض اتجاه من اتجاهاتها الفنية التي تبشر بمصداقية هذا التوجه بما فيه من جديد لاكتساب الهوية المميزة. لابد من الكتابة بطريقة جديدة.. بمعنى لابد من البداية من الصفر.. كيف؟.
ولأنني مازلت أحوم حول الموضوع ينبغي أن لا يتبادر إلى الذهن أنني أعني تجريد الكاتب مما علق فيه عبر قراءاته المتعددة أو عبر فعل القراءة لروايات وقصص لآخرين يفترض أنها كتبت بنفس الطريقة الجديدة أو أنني أفكر بعزل ما استطاع أن يتمثله من هذه الكتابات عبر فعل القراءة المتواصلة. إن تأكيد أهمية أن يقول الكاتب ـ أي كاتب ـ أشياءه بطريقته الخاصة وبلسانه هو تتمحور بداخله كل رؤاه وأفكاره.
ومن هنا فإن إجابة القاص حسن مطلك عبر روايته ـ دابادا ـ تتفق مع ما ذهبت إليه لتقول بلا مواربة؛ أن الكاتب ـ أي كاتب ـ إنما يعيد قول أشياء قيلت مئات المرات ولكن في أُطر جديدة وبطريقة خاصة وعبر اختزال كل ذلك التردد والتنظير. ويقول عبر هذه الرواية؛ أنه إذا كانت المواضيع ذاتها التي تناولها الأدب عبر الآف السنين فإنه تبقى هناك فرص جديدة دائماً لقول مثل هذه المواضيع مئات المرات أيضاً، الآن وفي المستقبل، ولكن لكل مرة طريقة جديدة قد يقترب فيها أو يبتعد من هذا الروائي أو ذاك في هذه الحقبة أو تلك دون أن يغيب تحت عباءة هذا أو جبة ذاك، بل أن يظل محتفظاً ـ ولو بصورة جزئية ـ بصوته الخاص أو بنبرته الخاصة إذا اختلطت الأصوات.. إنها مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
صعبة لأن الكتابة أصلاً أصعب المهمات. وصعبة لأن الإبداع وفي كل العصور من الخيارات الصعبة التي يستحيل فيها الإيهام أو الخداع.. ولكن ما فعله (حسن مطلك) في روايته البكر ( دابادا ) وما فهمته من قراءاتي لهذه الرواية يجعلني أميل إلى القول بإمكانية تحقق ذلك الهاجس الإبداعي في أي زمن. هذه الرواية ـ دابادا ـ حاولت أن توهمني أول وهلة بأن الكتابة بهذه الطريقة التي يقترحها ليست صعبة كما يشاع ولكن بمجرد إخضاعها للتحليل والإمساك بمفاتيحها أشعرتني أن كاتبها قد اختار المسلك الصعب من بين مسالك كثيرة صعبة جميعها تحجم عن اللجوء إلى التسلسل المنطقي للأحداث والأزمنة والأمكنة والأفعال والشخوص.. أهي خدعة في الكتابة استطاع مبتدعها ـ حسن مطلك ـ أن يمرر علينا؛ على أنها رواية جديدة ويفاجئنا بجدتها مستغلاً حنيننا الدائم لمواصلة الكتابة والقراءة وابتكار الطرق أو محاولة الوقوف على ما استجد من الطرق الكفيلة باستيعاب أفكارنا وهمومنا.. أم هي فعلاً غير ذلك؟!.
إن الأمر يتطلب مهارة عالية في فن الخداع. والرواية والقصة فن يشكل خداع المخيلة جزءاً كبيراً من تكوينه. ولكن ما هو حقيقي وواضح هو أن حسن مطلك يقترح علينا الكتابة خارج شروط الرواية أو خارج شروط الفن المتوارثة وبذلك يقطع الطريق على المخيلة وخداعها ولا يعطيها إلا أقل جسامة في العمل الروائي، وبذلك يطمئننا إلى أنها ليست خدعة، إنما هي غير ذلك. إنه يقترح علينا نقل الرواية أثناء تكونها خارج هويتها التقليدية حتى تصبح مطابقة إلى حد كبير للحياة ولا تختلف عنها قيد شعرة. يقترح علينا (بعيداً عن امتطاء المخيلة) أن ندع الحياة تدون أحداثها وسيرها ومحاورها وهوامشها ومفرداتها وكل الأشياء الداخلة المشتركة في تكوينها. وعلى هواها بلا تدخل ( إلا بحدود ضيقة) للمخيلة لنقع بالتالي على شكل جديد من أشكال الرواية الجديدة.. شكل مبتكر.
أجل الرواية الجديدة التي كتبتها فرجينيا وولف وآلان روب غرييه بالذات. ولكن إلى أي مدى نستطيع تقبل اقتراح الكتابة بدون شروط الحالة النفسية أو الفكرية أو الاجتماعية بعد أن نقتنع بأن هذه ليست نظرية جديدة في التلقي ولا هي محاولة لإضفاء شيء من الشرعية على كتابات من هذا النوع، إنما هي مجرد اقتراحات قابلة للمناقشة.. للرفض والقبول.
إنه اقتراح معقول.. الذي يريد للكتابة أن تأخذ شكل جريان الحياة وتعاقب الليل والنهار.. الظهور والاختفاء، الضحك والبكاء، المهم والثانوي، الفن والتخلف، الرغبة والحياة.... إلخ.
.. أن نكتب كما نعيش. لأن نعيش ونقترح بالكتابة نمطاً للعيش.. أن نسعى لأن نكتب كما نعيش بدقة؛ نستيقظ صباحاً لنشرب الشاي، نرتدي ملابسنا، نذهب إلى أعمالنا، نلتقي، نحب، نكره، نتذمر، نتفاءل، نتخاصم بسبب وبدون سبب، نبحث في الزوايا الميتة في القرية والروايات الميتة في نفوسنا عن دوافع جديدة لعيش يوم جديد، لإثارة مواضيع وشهوات ورغبات جديدة نتابعها ونحن في طريق تكونها وتوجهاتها.. نراقب حركات بعضنا بدقة، نفسرها على هوانا، لا لكي نعطي هذا الفعل الذي اجتذبنا أكثر من غيره في الرواية حجمه الحقيقي وننقم بالمقابل على فعل آخر لا يروق لنا، إنما لنعطي هذه الحركة مصداقيتها في الجانب المتعلق بنا كحركة متوقعة في الحياة، ولا بأس من التستر عليها بعض الوقت حتى تنضج ويصبح بالإمكان الاحساس بها كحقيقة مجردة.
إن الكتابة عن الحياة كما هي وبدون تدخل كما تتدفق وتتعرج؛ هي كتابة أو نمط من الكتابة عن الحياة ليس جديداً، ولكنه نمط مفتوح دائماً على مساحات واسعة للإبتكار والتجديد والمغامرة المحفوفة بالمخاطر. لقد كتب بها العديد من الكتاب مستخدمين " المهارة " والصنعة والمخيلة، لكننا أمام نص روائي لا يصنف مع تداعي تيار الوعي ولا مع البناء السردي القائم على كسر خطوط السرد بقصدية مبالغ فيها تسعى في جوهرها للإقتراب من مكونات إشكالية البناء الروائي وتعدديته.. وبطريقة خاصة جداً..
إن رواية ـ دابادا ـ نقلتنا إلى الحياة في القرية وجعلتنا نستغني عن دور الكاتب الذي لم يكن يظهر لنا ونحن نعيش حياة هذه القرية المجزأة بين ماضي شاحب وحاضر مخاتل ومستقبل لا يفصح عن نفسه بسهولة، لكنه ينهض من حين لآخر. نقلتنا إلى القرية دون اللجوء إلى النص بين عالم روائي متخيل مبتدع وبين عالم حسي حقيقي للقرية التي تدور فيها أحداث الرواية. إن الرواية تبدأ الحديث في آن.. عن حشد من أحداث وأشخاص وعلاقات وتدفع بها إلى نهاياتها البعيدة المستحيلة، ولكن دون أن تهينها أو توضحها بصورة تامة، بل تجمدها عند نقاط معينة من النص لتبدأ من جديد بصنع حشد من موج من أحداث جديدة وأشخاص وعلاقات، ولترتفع بها أيضاً إلى أقصى نقاطها ثم تجميدها مرة أخرى هناك والعودة مرة أخرى لدفع أو تحريك الحشد الأول الذي تجمد عند نقاط معينة في الرواية.. وهكذا ففي كل مرة يريد إثارة موجة جديدة يبدأ بعبارة يختارها بعناية فائقة من تلك العبارات التي أنهى عندها مرحلة ما من الرواية أو ليبدأ مرحلة جديدة لم يكن يخطط لها بقدر ما كانت حاضرة في المشهد الروائي أو التربوي، ولكنها مؤجلة بعض الوقت... فعلى الصفحة (5) نراه يبدأ حديثاً جديداً أو يعطي فرصة لجزء من القرية لأن تتقدم ممهداً له بهذه العبارة:" وأخيراً انتهت القناعات مع زوال الفصول وأصبح رضاه نادراً، فبدأ بنقر الغلاف مثل فرخ في بيضة". وبهذه العبارة نفسها نفاجأ بأنه قد اختتم أو أوقف بعضاً من تلك المشاهد مؤجلاً إياها بعض الوقت، أي حتى الصفحة (8) حيث ينهي بصراحة حضور بعض مكونات الرواية، لا لينتقل إلى غيرها بصورة تقليدية وإنما ليعزز مسعاه في دمج وعي الكتابة بوعي الحياة، وعي الكاتب بوعي أي فرد من أفراد هذه القرية الصغيرة. إن التجميد المؤقت لأي حشد من الأحداث يتم لضرورة اكتشاف بدايات سليمة لمسارات جديدة لمرحلة لاحقة مع الحياة/الرواية. وعندما تشرف الحياة على صفحة جديدة من صفحاتها المتلاحقة، وعندما يرى أن تلك العبارة أو الحقيقة أو الجملة الطويلة قد التحقت بما تم تجميده، فإنه يلجأ إلى مقدمات جديدة ونهايات جديدة، فبانتهاء المشهد الأولي للرواية/للقرية عند الصفحة (16) يجد أنه من المناسب البحث عن مدخل جديد للمشهد الآتي الذي نراه قبل أن يخترعه لنا، فيكفي أن يضع يده على العبارة المناسبة ويقول: " الغرف مظلمة ماعدا غرفته لأنها مرتفعة. مكان دائم لتبدل الفصول، مكان خاص للنوم والطعام والعري ". تلك العبارة التي وردت عرضاً في الصفحة (8) عند نهاية مشهد صغير من الرواية، وبعد أن يفتح أبواب الرواية أمام مشاهد جديدة أو بعد أن يقترب من مشاهد مؤجلة في القرية.. بروايتها يعود إلى تلك المسارات القديمة المتعرجة التي تأخذ ـ بالضبط ـ شكل سير الحياة وشكل تفاصيلها ومفرداتها... وليست العبارة الطويلة هي الوحيدة التي يستخدمها في تكنيكه هذا.. بل يلجأ، في كثير من الأحيان، وبنفس الشغف إلى الاحتكاك بالحقائق الموجزة. ومنها أن والد (شاهين) الشخصية الأكثر حضوراً في القرية، كان قد اختفى بسبب ركضه وراء أرنب مُـبَـقَع، فكان يلجأ إلى تسخير هذه الحقيقة للاقتراب أكثر فأكثر من الحقائق النفسية والاجتماعية والفكرية والحسية التي تتمخض عنها شخصية شاهين أو شخصية أمـه. فيبدأ في الصفحة الأولى بالقول: " ضياع الأب في البراري بسبب أرنب مبقع ". ليعود بعد عدة صفحات لاستغلال وتطوير الإمكانية الكاشفة لهذه الحقيقة، فيعيد القول:" عن الأب الذاهب خلف أرنب مبقع ". في الصفحة (9) ثم ليعود في الصفحة (24) لتكرار العبارة نفسها بحذافيرها، ليبدأ متابعة الجانب المؤجل من الحياة في الجانب الواضح من القرية وعلاقاتها... وهكذا تتواصل الحلقات بخيط سردي لا ينقطع ولكنه يختفي أحياناً ويتلون أحياناً أخرى بلون الحديث الآني الذي يستجد على الدوام.. لا ينقطع ولكنه يأخذ حجم الأسى أو حجم الضحكة أو لون الابتسامة أو شكل الرغبة الجسدية أو تباطؤ المخيلة المعطلة أو جموحها وهي تتقد في حدود واضحة.. لا يهم ما موجود خلفها أو على الجانبين.
وهكذا أيضاً تمضي الحياة، ثقيلة أو ساخنة، بليدة أو مفعمة بالشهوات والشهقات الآتية من أعماق (هاجر) و(عزيزة) و(شاهين).. وهكذا تلتم وتكتمل خطوط الرواية التي قدمت نفسها في هذا الإطار الحياتي الحقيقي، أو هكذا تتقدم نحونا القرية ذاتها مؤطرة بهذا الإطار الذي يحافظ فقط على إمكانية التحرك ولو مؤقتاً في (مكان) واحد محدد.
إن القاص حسن مطلك يتناول خيطاً واحداً من مجموعة خيوط مشتبكة تكون بمجموعها نسيج الرواية، أو تنسج على نحو جديد علاقات القرية، ما ظهر منها وما بطن، أي أنه يلتقط شخصية أو حركة لشخصية أو عادة لأكثر من شخصية، أو ملامح ما أو وجهات نظر أو تقرير مباشر أو أحاسيس بينة.. ليعيد من خلال متابعته تداخله مع غيره من خيوط النسيج في أكثر من مكان وفي أكثر من وشيجة، وليعيد بالتالي تشكيل قدرة الرواية.. مجدداً على التدفق والجريان بين دروب القرية ودواخل نفوس أبنائها ومناخاتها ولياليها وشموسها وأراضيها ودهاليزها المكتظة بالحيوانات المختلفة أو الموت المطلق. ومرة بعد مرة نكتشف بأن هذه الرواية أو هذه الذروة من الرواية ماتزال تصلح لأن تكون منطلقاً جديداً لامتداد جديد في الرواية. ومرة بعد مرة يأخذنا في مجاهيل قرية صغيرة، في مكانها وبشرها التي تكبر في أزمانها وعلاقاتها وتحديقها في ظرفها ومحنتها. ومرة بعد مرة يفتح مضطراً؛ منافذ جديدة من خلال التقاط الخيوط التي يوهمنا أنها ضائعة في بعضها البعض حتى يتعذر الامساك بها إلا بعد أن تصل الشخصيات والأحداث إلى ذروتها، وبعد أن يصل الكاتب (الذي لا يمكن تمييزه عن أي واحد من أبناء القرية) إلى الاقتناع بضرورة إغلاقها أو إنهائها... ودائماً، ودون أية أهمية تذكر على صعيد من أصعدة الرواية ومستوياتها أو أي صعيد من أصعدة العلاقات الحقيقية في القرية أن يتناول الحديث أو الخيط المسحوب من النسيج لشخصية ثانوية أو هامشية أو رديئة، لأن كل أشخاص الرواية الذين يعلنون عن وجودهم من حين لآخر في الحياة وفي صورتها؛ في الرواية: هاجر وشاهين وشرار (الكلب) وعواد وعزيزة وحلاب ووزة وزهرة والحمار والأرنب المبقع " والمعذَّب صابر يوم الأربعاء بعد المطر ". لأنهم كلهم مرتبطون بقوة أسباب الحياة، وبقوة أسباب البناء الروائي، مرتبطون بنسيج قوي لا يمكن أن يستل منه خيط واحد دون أن تتحرك بقية الخيوط كما هي حقيقة الحياة في القرية.
.. وبعد.. فهذه قراءة أولية لرواية (دابادا) لكاتب شاب مبدع هو حسن مطلك الذي سبق لبعض قصصه القصيرة أن فازت بجوائز في مسابقات قصص الحرب، مثل قصة (عرانيس) المعروفة التي فازت بالجائزة الأولى... أقول هذه قراءة أولية أردت أن أُشير من خلالها إلى أن هذه الرواية التي صدرت عام 1988 تستحق القراءة مرة أخرى، وتستحق أن تنال بعضاً من الاهتمام الجاد من جانب النقد والنقاد.. فهي بحق تبشر بموهبة إبـداعية جديـدة.
----------------------------------------------
* نشر هذا المقال في جريدة (القادسية) العدد3095 بتاريخ 5/12/1989م.بغداد.
* ونشرت في مجلة (ألواح) العدد 11 سنة 2001م مدريد.