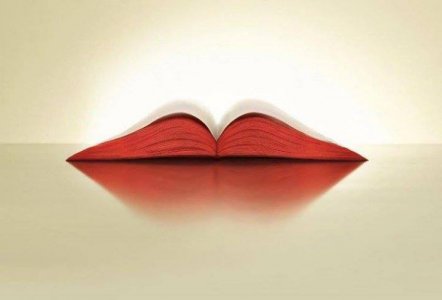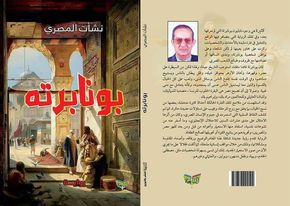ليس مصادفةً أن تكون مدينة دمشق أقدم المدن المأهولة، مكان ولادة أوّل مكتبة متخصصّة بالعلوم، إذ إن خالد بن يزيد بن معاوية الأموي (90 هـ/634 م) الذي يُعرف بحكيم آل مروان، كان مولعاً بعلم الكيمياء، وترجم فيه، وألّفَ فيه. وتذكر الكتب القديمة أنه كان أوّل من «جُمِعت له الكتب وجعلها في خزائن الإسلام»، ففي دمشق- على الأرجح- أُنشِئت أوّل دار للكتب في العالم العربي، دمشق التي عُرفت بوصفها «أوّل سوق نفقت فيه بضاعة العلم والأدب».
المصادفة أيضاً كانت وراء حظّي في العمل (أمينة مكتبة) في مكتبة المعهد الفرنسي بدمشق. مكتبة غنية ومنمنمة تشبه دمشق في غير ما جانب؛ إذ هي تنوس بين التراث والحداثة قلباً وقالباً، وتضمّ كتباً ومجلّدات منتقاة بعناية وأناة، تؤلّف في مجملها موزاييكاً ثريّاً، يجمع الماضي العربي التليد إلى الحاضر الذي ما برح يتلكّأ ويتعثّر. ولعلّ هذا ما جعلني أدرك- منذ البداية- أن مهنتي أقرب إلى الشؤون العاطفية منها إلى أيّة مهنة أخرى.
فـ (أمين المكتبة) هو في الكتب العربية القديمة (خازن الكتب)، وتخبّر تلك الكتب عن صفاته، وتعدّ على رأسها الأمانة، والنزاهة، والمعرفة، وتذكُّر أهمّ العاملين فيها. بيد أن كتاباً عربياً قديماً، لا أذكر عنوانه، وجدت فيه «رخصة» تناسبني؛ إذ يبدو أنّه كان يحقّ لخازن الكتب الاحتفاظ ببعض منها، الأمر الذي خفّف إلى حدّ المحــــــــــو، شـــــعور الذنب المصاحـــــــب لـ «استعارة» كتاب ما، لمدّة قد لا تنتهي. لكنّ شعوراً بالذنب من نوع آخر، كان يطلّ عند كلّ كتاب تقريباً أمسكته بين يدي، إذ غدت قراءة الكتاب في أثناء العمل مُوَلّدةً لمجموعة متناقضة من المشاعر التي تشي بالعاطفية الزائدة لهذه المهنة، وترسم - إلى حدّ بعيد - مراحل سير الكتاب من يدي إلى الرفّ في المخازن: فأوّل شعور هو الفضول والترقُّب، تليه الغبطة والراحة إن أعجبني، فالسعادة المشوبة بسرقة الوقت، حال انتخبتُ فصلاً لقراءته على عجلٍ (ما أورثني عقدة الشعور بالذنب في أثناء القراءة)، ثمّ الاستكانة «المشروعة» بين دفَّتَيْه، حال وصلتُ إلى مرحلة فهرسته، وهي المرحلة التي- لحسن الحظّ- كانت تتبع فهرسةً وتصنيفاً فرنسيين، وُضعا خصّيصاً لهذه المكتبة. ولعلّ أدّق وصف يمكن استعماله هنا هو مثلٌ فرنسيّ شهير يشير إلى العقليّة البيروقراطية: لمَ تبسيط الأمر إن كان تعقيده ممكناً؟ الفهرسة المعقَّدة تلك، كانت تتناسب مع حجم المكتبة المنمنم، وتختلف عن تصنيف ديوي الشهير واسع الانتشار الذي يوحي بثراء المكتبة واتِّساعها، إذ تُترَك الرفوف- وفقاً له- فارغة بانتظار الكتب المناسبة لتصنيفٍ معيَّن، أي تلك التي لمّا تصل بعد. أمّا في المنمنمة الدمشقيّة، فقد كانت الكتب مرصوصةً ومرتَّبةً بأرقام متسلسلة تشي بميعاد وصولها إلى الرفّ. لكن، كان للتصنيف الفرنسي المعقّد ميزة كبرى، إذ هو ينحاز إلى الـ (أمين) الذي يجد فيه حجّةً سهلةً للغوص في الكتاب والاستغراق في قراءته، بغية وضع تلك الأرقام الدالّة على المواضيع التي لا تنتهي، ويتطرّق الكتاب إليها. ومهما استغرقتُ ومهما قرأتُ كان الوقت يهربُ مني، ويزداد شعوري بالذنب، فأركن الكتاب جانباً لـ «أستعيره»، أو أقوم- كما يفعل أصحاب هذه المهنة العاطفية- بتدوين عناوين الكتب التي تعجبهم، وتلك التي يجب الحصول عليها للمكتبة، وتلك التي يجب الحصول عليها لنا وللمكتبة، سلسلة لا تنتهي من القصاصات المتوالدة بسبب «حكايا» الكتب إن جازَ التعبير، فكلّ كتاب يشير إلى كتابٍ آخر، وكلّ كاتب يعجبنا يشير إلى كتبه الأخرى، في سلسلة لا متناهية من ألف كتابٍ وكتاب. ويزيدُ من ذلك، أن القرّاء في المنمنمة الدمشقيّة، هم من القرّاء العليمين أي الباحثين، الممتلئين شغفاً بحبّ القراءة والبحث، تَتَّقد عيونهم عند استلام كتابٍ ما، ولا يضيّعون الفرصة في اصطياد أمين المكتبة، ونصبِ فخاخٍ مبتكرة له من نوع: يجب الحصول على هذا الكتاب للمكتبة، أو أهوى هذا الكاتب ولديه كتاب مهمّ جداً غير موجود في المكتبة، أو صدر توّاً كتاب جديد لا بدّ منه للمكتبة، فيدوّن الأمين على القصاصات عناوين جديدة أصابته في مقتلِ شغفِ القراءة هو أيضاً، هذا الشغف الذي يزيدُ من عاطفية هذه المهنة، إذ إن كلّ كتابٍ جديد تقتنيه المكتبة يوحي لأمينها أن الاقتناء مشترك بينه وبينها، وأن اقتناءه يعني حيازته، وحيازته تعني امتلاكه، وامتلاكه يعني ملكيّته، وأن هذه الأخيرة مشتركة- لا ريب- بين المكتبة وأمينها.
ليست العاطفية الزائدة، وحدها، الصفّة الرئيسة لأمين المكتبة أو لروادها، بل إن المكتبة على ما يبدو لي بالتجربّة، تُربينا وتهذبنا؛ فأن تكون في المخزن بين رفوف الكتب التي لا تنتهي، يمثّل تجربةً حيّة، وصورةً أمينة لتجربة الماثِل أمام مكتبة الإيطالي الساحر أمبيرتو إيكو، الذي صنّف زوار مكتبته الضخمة إلى نوعين: النوع الذي ما إن يقف حيالها حتّى يصرخ: كم كتاباً من الثلاثين ألف هذه قرأت سيد إيكو؟، والنوع الثاني الذي يقف حيالها، فيدرك أنها ليست محفِّزة لتضخّم الأنا والتباهي، بل إنها أداة بحث. وهو ما لفت نظر الحصيف والذكي نسيم نيكولاس طالب في كتابه الشهير «البجعة السوداء»، فطوّر ملاحظة إيكو في أنه لم يقرأ «كلّ» الكتـــــــــب في مكتبته، إلى مفهــــــوم «ANTI LIBRARY»، أي «المكتبة – الضدّ»، أي كلّ ما لم نقرأ من كتب، هكذا هذّبتني المنمنمة الدمشقية، ففي كلّ مرّة دخلتُ إلى مخزن الكتب، كنتُ أقول لنفسي؛ لستُ في المكتبة بل في «ضدّها». لكن تلك الكتب الكثيرة غير المقروءة، كانت تتصيّدني لأنقلها من حيّز الضدّ هذا إلى حيّزها الطبيعي؛ أي أن تكون مقروءة، وبالطبع كانت عناوينها هي الأكثر إغراءً وإغواءً، وحيال إغراءٍ مماثل كنتُ أردّد قولاً فرنسياً آخر يعجبني: «أستطيع مقاومة كلّ شيء إلا ما يغريني!».
وبالطبع كان ثمة الكثير مما يغريني، ومنه ما تحتويه الكتب من جملٍ تخصّ المكتبة وتعجبني، فأدوّنها وأطبعها وأعلّقها في مكتبي. الشعور بالغبطة والزهو كان يرافقني كلّما قرأتُ قول بورخيس الشهير: «لطالما تخيّلتُ الفردوس على هيئة مكتبة»، فأمازح روّاد المكتبة من أصدقائي المقربين: أنا واحدة من «ملائكة الفردوس». والشعور بالإنجاز كان يساورني كلّما قرأتُ قول ألبيرتو مانغويل: «في طيش فتوّتي، حين كان أصدقائي يحلمون بمآثر بطولية في حقول الهندسة والقانون والمال ولسياسة، كان حلمي أن أصبح أمين مكتبة».
للمنمنمة الدمشقيّة وما يشبهها من مكتبات- إن وُجدت- ميزة الاختلاف المحبّب عن مكتبة مانغويل الشخصيّة التي وصفها في كتابه «المكتبة في الليل»: «تخيّلتُ رفوفاً للكتب، تبدأ من مستوى خصري وتعلو فقط بالارتفاع الذي يمكن لأصابع يدي حين أبسطها على طولها، أن تناله. لأني تعلّمت من التجربة بأن الكتب التي تكون على رفوف عالية وتتطلَّب السلالم، أو تلك التي على رفوف واطئة وتدفع القارئ إلى الزحف على الأرض، غالباً ما تحظى باهتمام أقلّ من تلك التي تقع في الوسط، مهما كانت مواضيعها أو جدارتها». فهنا كلّ الكتب متساوية، ولا فضل لعربي منها على فرنجي أو أعجمي أو سرياني أو غير ذلك، إلا وفقاً لاختيار روّاد المكتبة، إذ لم يكن لعلو الرفّ أو عكسه، صفة تميّزه، ونادراً ما كنت أجلب السلّم للوصول إلى كتاب مرتفع؛ إذ إن الحماسّة كانت تزيّن لي تسلُّق الرفوف المعدنية بخفّة لقطفِ الكتاب المطلوب. الرفوف المعدنية الضخمة في المنمنمة الدمشقيّة، لم تكن ثابتةً، بل كانت تتحرّك على دواليب قويّة وصابرة، وقد صُمّمت على هذا النحو لاستعمال المساحة إلى أقصى حدّ ممكن. وعلى الرفوف- سواءٌ أكانت عالية أم واطئة، في مرمى النظر، ودائماً في متناول اليد- كانت تطلّ قطع من الورق المقوّى التي توضع محلّ الكتب المستعارة، وتسمّى (الشبح)، ومهما تكاثرت الأشباح، فإنها لم تكن تمثّل إلا جزءاً يسيراً من المكتبة، فالمنمنمة الدمشقيّة احتفظت دائماً بتلك الصفّة المفضّلة لإيكو: المكتبة – الضدّ، وبدت على الدوام بالنسبة لي فردوساً بورخسياً متخيّلاً، ومكاناً قيل عنه أجمل الكلام العربي: «لكلّ صاحب لذّة مُتَنزَّهٌ أبداً. ونزهة العالِم في كتبه»، فأحوّر قليلاً وأقول: «في مكتبته».

المصادفة أيضاً كانت وراء حظّي في العمل (أمينة مكتبة) في مكتبة المعهد الفرنسي بدمشق. مكتبة غنية ومنمنمة تشبه دمشق في غير ما جانب؛ إذ هي تنوس بين التراث والحداثة قلباً وقالباً، وتضمّ كتباً ومجلّدات منتقاة بعناية وأناة، تؤلّف في مجملها موزاييكاً ثريّاً، يجمع الماضي العربي التليد إلى الحاضر الذي ما برح يتلكّأ ويتعثّر. ولعلّ هذا ما جعلني أدرك- منذ البداية- أن مهنتي أقرب إلى الشؤون العاطفية منها إلى أيّة مهنة أخرى.
فـ (أمين المكتبة) هو في الكتب العربية القديمة (خازن الكتب)، وتخبّر تلك الكتب عن صفاته، وتعدّ على رأسها الأمانة، والنزاهة، والمعرفة، وتذكُّر أهمّ العاملين فيها. بيد أن كتاباً عربياً قديماً، لا أذكر عنوانه، وجدت فيه «رخصة» تناسبني؛ إذ يبدو أنّه كان يحقّ لخازن الكتب الاحتفاظ ببعض منها، الأمر الذي خفّف إلى حدّ المحــــــــــو، شـــــعور الذنب المصاحـــــــب لـ «استعارة» كتاب ما، لمدّة قد لا تنتهي. لكنّ شعوراً بالذنب من نوع آخر، كان يطلّ عند كلّ كتاب تقريباً أمسكته بين يدي، إذ غدت قراءة الكتاب في أثناء العمل مُوَلّدةً لمجموعة متناقضة من المشاعر التي تشي بالعاطفية الزائدة لهذه المهنة، وترسم - إلى حدّ بعيد - مراحل سير الكتاب من يدي إلى الرفّ في المخازن: فأوّل شعور هو الفضول والترقُّب، تليه الغبطة والراحة إن أعجبني، فالسعادة المشوبة بسرقة الوقت، حال انتخبتُ فصلاً لقراءته على عجلٍ (ما أورثني عقدة الشعور بالذنب في أثناء القراءة)، ثمّ الاستكانة «المشروعة» بين دفَّتَيْه، حال وصلتُ إلى مرحلة فهرسته، وهي المرحلة التي- لحسن الحظّ- كانت تتبع فهرسةً وتصنيفاً فرنسيين، وُضعا خصّيصاً لهذه المكتبة. ولعلّ أدّق وصف يمكن استعماله هنا هو مثلٌ فرنسيّ شهير يشير إلى العقليّة البيروقراطية: لمَ تبسيط الأمر إن كان تعقيده ممكناً؟ الفهرسة المعقَّدة تلك، كانت تتناسب مع حجم المكتبة المنمنم، وتختلف عن تصنيف ديوي الشهير واسع الانتشار الذي يوحي بثراء المكتبة واتِّساعها، إذ تُترَك الرفوف- وفقاً له- فارغة بانتظار الكتب المناسبة لتصنيفٍ معيَّن، أي تلك التي لمّا تصل بعد. أمّا في المنمنمة الدمشقيّة، فقد كانت الكتب مرصوصةً ومرتَّبةً بأرقام متسلسلة تشي بميعاد وصولها إلى الرفّ. لكن، كان للتصنيف الفرنسي المعقّد ميزة كبرى، إذ هو ينحاز إلى الـ (أمين) الذي يجد فيه حجّةً سهلةً للغوص في الكتاب والاستغراق في قراءته، بغية وضع تلك الأرقام الدالّة على المواضيع التي لا تنتهي، ويتطرّق الكتاب إليها. ومهما استغرقتُ ومهما قرأتُ كان الوقت يهربُ مني، ويزداد شعوري بالذنب، فأركن الكتاب جانباً لـ «أستعيره»، أو أقوم- كما يفعل أصحاب هذه المهنة العاطفية- بتدوين عناوين الكتب التي تعجبهم، وتلك التي يجب الحصول عليها للمكتبة، وتلك التي يجب الحصول عليها لنا وللمكتبة، سلسلة لا تنتهي من القصاصات المتوالدة بسبب «حكايا» الكتب إن جازَ التعبير، فكلّ كتاب يشير إلى كتابٍ آخر، وكلّ كاتب يعجبنا يشير إلى كتبه الأخرى، في سلسلة لا متناهية من ألف كتابٍ وكتاب. ويزيدُ من ذلك، أن القرّاء في المنمنمة الدمشقيّة، هم من القرّاء العليمين أي الباحثين، الممتلئين شغفاً بحبّ القراءة والبحث، تَتَّقد عيونهم عند استلام كتابٍ ما، ولا يضيّعون الفرصة في اصطياد أمين المكتبة، ونصبِ فخاخٍ مبتكرة له من نوع: يجب الحصول على هذا الكتاب للمكتبة، أو أهوى هذا الكاتب ولديه كتاب مهمّ جداً غير موجود في المكتبة، أو صدر توّاً كتاب جديد لا بدّ منه للمكتبة، فيدوّن الأمين على القصاصات عناوين جديدة أصابته في مقتلِ شغفِ القراءة هو أيضاً، هذا الشغف الذي يزيدُ من عاطفية هذه المهنة، إذ إن كلّ كتابٍ جديد تقتنيه المكتبة يوحي لأمينها أن الاقتناء مشترك بينه وبينها، وأن اقتناءه يعني حيازته، وحيازته تعني امتلاكه، وامتلاكه يعني ملكيّته، وأن هذه الأخيرة مشتركة- لا ريب- بين المكتبة وأمينها.
ليست العاطفية الزائدة، وحدها، الصفّة الرئيسة لأمين المكتبة أو لروادها، بل إن المكتبة على ما يبدو لي بالتجربّة، تُربينا وتهذبنا؛ فأن تكون في المخزن بين رفوف الكتب التي لا تنتهي، يمثّل تجربةً حيّة، وصورةً أمينة لتجربة الماثِل أمام مكتبة الإيطالي الساحر أمبيرتو إيكو، الذي صنّف زوار مكتبته الضخمة إلى نوعين: النوع الذي ما إن يقف حيالها حتّى يصرخ: كم كتاباً من الثلاثين ألف هذه قرأت سيد إيكو؟، والنوع الثاني الذي يقف حيالها، فيدرك أنها ليست محفِّزة لتضخّم الأنا والتباهي، بل إنها أداة بحث. وهو ما لفت نظر الحصيف والذكي نسيم نيكولاس طالب في كتابه الشهير «البجعة السوداء»، فطوّر ملاحظة إيكو في أنه لم يقرأ «كلّ» الكتـــــــــب في مكتبته، إلى مفهــــــوم «ANTI LIBRARY»، أي «المكتبة – الضدّ»، أي كلّ ما لم نقرأ من كتب، هكذا هذّبتني المنمنمة الدمشقية، ففي كلّ مرّة دخلتُ إلى مخزن الكتب، كنتُ أقول لنفسي؛ لستُ في المكتبة بل في «ضدّها». لكن تلك الكتب الكثيرة غير المقروءة، كانت تتصيّدني لأنقلها من حيّز الضدّ هذا إلى حيّزها الطبيعي؛ أي أن تكون مقروءة، وبالطبع كانت عناوينها هي الأكثر إغراءً وإغواءً، وحيال إغراءٍ مماثل كنتُ أردّد قولاً فرنسياً آخر يعجبني: «أستطيع مقاومة كلّ شيء إلا ما يغريني!».
وبالطبع كان ثمة الكثير مما يغريني، ومنه ما تحتويه الكتب من جملٍ تخصّ المكتبة وتعجبني، فأدوّنها وأطبعها وأعلّقها في مكتبي. الشعور بالغبطة والزهو كان يرافقني كلّما قرأتُ قول بورخيس الشهير: «لطالما تخيّلتُ الفردوس على هيئة مكتبة»، فأمازح روّاد المكتبة من أصدقائي المقربين: أنا واحدة من «ملائكة الفردوس». والشعور بالإنجاز كان يساورني كلّما قرأتُ قول ألبيرتو مانغويل: «في طيش فتوّتي، حين كان أصدقائي يحلمون بمآثر بطولية في حقول الهندسة والقانون والمال ولسياسة، كان حلمي أن أصبح أمين مكتبة».
للمنمنمة الدمشقيّة وما يشبهها من مكتبات- إن وُجدت- ميزة الاختلاف المحبّب عن مكتبة مانغويل الشخصيّة التي وصفها في كتابه «المكتبة في الليل»: «تخيّلتُ رفوفاً للكتب، تبدأ من مستوى خصري وتعلو فقط بالارتفاع الذي يمكن لأصابع يدي حين أبسطها على طولها، أن تناله. لأني تعلّمت من التجربة بأن الكتب التي تكون على رفوف عالية وتتطلَّب السلالم، أو تلك التي على رفوف واطئة وتدفع القارئ إلى الزحف على الأرض، غالباً ما تحظى باهتمام أقلّ من تلك التي تقع في الوسط، مهما كانت مواضيعها أو جدارتها». فهنا كلّ الكتب متساوية، ولا فضل لعربي منها على فرنجي أو أعجمي أو سرياني أو غير ذلك، إلا وفقاً لاختيار روّاد المكتبة، إذ لم يكن لعلو الرفّ أو عكسه، صفة تميّزه، ونادراً ما كنت أجلب السلّم للوصول إلى كتاب مرتفع؛ إذ إن الحماسّة كانت تزيّن لي تسلُّق الرفوف المعدنية بخفّة لقطفِ الكتاب المطلوب. الرفوف المعدنية الضخمة في المنمنمة الدمشقيّة، لم تكن ثابتةً، بل كانت تتحرّك على دواليب قويّة وصابرة، وقد صُمّمت على هذا النحو لاستعمال المساحة إلى أقصى حدّ ممكن. وعلى الرفوف- سواءٌ أكانت عالية أم واطئة، في مرمى النظر، ودائماً في متناول اليد- كانت تطلّ قطع من الورق المقوّى التي توضع محلّ الكتب المستعارة، وتسمّى (الشبح)، ومهما تكاثرت الأشباح، فإنها لم تكن تمثّل إلا جزءاً يسيراً من المكتبة، فالمنمنمة الدمشقيّة احتفظت دائماً بتلك الصفّة المفضّلة لإيكو: المكتبة – الضدّ، وبدت على الدوام بالنسبة لي فردوساً بورخسياً متخيّلاً، ومكاناً قيل عنه أجمل الكلام العربي: «لكلّ صاحب لذّة مُتَنزَّهٌ أبداً. ونزهة العالِم في كتبه»، فأحوّر قليلاً وأقول: «في مكتبته».