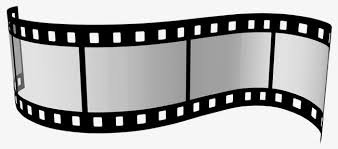«الدائرة التأويلية تعني أن عملية فهم النص ليست غاية سهلة، بل عملية معقَّدة ومركَّبة، يبدأ المفسِّر بها من أي نقطة شاء، لكن عليه أن يكون مستعداً لأن يعدِّل فهمه وفقاً لما يُسفِر عنه دورانه في جزئيات النص وتفاصيله».. شير ماخر، 1843م.
موضوع العمل الفنيّ (الموسيقيّ) يعرفه الفنان وحده، أما المستمعون فكل واحد منهم يفسّر الإيحاءات الموسيقية وفق رؤيته وانفعاله، وما تثيره فيه من حالات نفسية(1). ومحاولة تفكيك العمل الفني إلى مكوناته ودوافعه أو أصوله الذاتية والموضوعية عملية ليست سهلة، ويحفّها كثير من العقبات، وقد تبيّن ذلك بوضوح بعد تجاوز المدارس والنظريات النقدية القائمة على الفلسفة الوضعية والعقلية لدى كانط وهيجل مع الضربات التي وجهتها لها الشكلانية بإسهاماتها المتميزة وما قدمته البنيوية، فأدى ذلك إلى مراجعة شاملة للأداء النقدي فيما يعرف بما بعد الحداثة، وكانت النتيجة الكبرى هي تهدّم ما يعرف بـ (العقل الخالص) وانهياره، وصارت الرؤية العلميّة في مجال الإنسانيات أكثر تواضعاً في ادعاءاتها، وحلّت علاقة اللغة بالعالَم محلّ علاقة الذات بالموضوع(2).
ساهمت التطورات التي حدثت في كثير من العلوم في الوصول إلى هذا الانقلاب. ولم تستطع فلسفة العلم، التي اعتمدتها الوضعية، أن تنجح في مجال الإنسانيات؛ بسبب التكوين (الذاتي/ الموضوعي) للنوع الإنساني(3). فالعمل الفني -بلا شك- هو تلك الوحدة الموضوعية في داخله، المتمسّكة بتكوينها الذي يعطيها شكلها الذي هي عليه، ويحقّق وجودها المتميز، ومكانتها ووظيفتها الاجتماعيتين والتعبيريتين. ومع ذلك نظل دائماً في حاجة إلى (الولوج) إلى عالم العمل الفني وقراءته التي قد لا تكون ضرورية لتمتُّعنا به وتذوُّقه، بل ربما كان لها أثر سلبي في استمتاعنا به، فقد تفتر جاذبية العمل الفني، وربما تقضي عليها (القراءة) التحليلية، والفهم الناتج من النقد.
الموضوع وأهميته
ينشأ هنا سؤال قد تسهم مناقشته ومحاولة الإجابة عنه في فهم طبيعة العمل الفني ودوافعه وبنيته وقيمته وتذوقه على نحو أفضل. السؤال هو: ما مكانة الموضوع بـ(المعنى الوصفي) في العمل الفني؟ وما أهميته؟
ومع أن السؤال قديم، لكنه صار أكثر إلحاحاً مع الفن الحديث، وخصوصاً في الشعر، وبشكل أكثر خصوصية في الفنّ التشكيليّ الحديث. فالمعروف أن الموضوع كانت له مكانة جوهرية، وربما المكانة الأولى في العمل الفنيّ الكلاسيكيّ بواقعيته المثالية أو النموذجية المستندة إلى قيم اجتماعية محددة، هي قيم المجتمع الأرستقراطي (المسيطر) على السلطة والثروة، وصاحب الحق في فرض القيم والعقائد.
كانت لغة الفن في ذلك الوقت مباشِرة تتميز بالوضوح، أو فلنقل: إنها تقصده؛ لأن كثيراً من الأغراض قد تتسرب إلى العمل الفني من دون قصد مبدعه. ومع مرور الزمن تطور العمل الفني وفق ظروفه الاجتماعية، وبنيته الكاملة من مؤثرات اقتصادية وسياسية واجتماعية وعلمية وفكرية.
وقد ظل العمل الفني -بسبب تعدد وظائفه النفسية والجمالية والاجتماعية- يتمرّد على الأُطُر والقوالب؛ كي يحافظ على وجوده وحيويته وجدته، ويتمكن من أداء وظائفه المتعددة من دون أن يفقد هويته.
رأي متعالٍ
لا شك أن الفنانين -كثيراً منهم على الأقل- اكتشفوا القيم الجمالية البحتة ومتعتها وأثرها في النفس؛ مما أدى إلى ظهور ما يُعرَف بالفن الصافيّ، الذي لا شك في أنه كان موجوداً بشكل أكثر تلقائية بعيداً من الفلسفة والفكر، خلافاً لما ذهبت إليه كاتبة أوربية من أن (الفن) بمعناه الحالي هو اختراع أوربيّ. ربما هي تعني فلسفة الفن وعلم الجمال، لكن لا شك في أن الفن بقدرته التلقائية على أداء وظيفته نشأ مع الإنسان.
هذا الرأي فيه نوع من التعالي، وتوجد له نماذج -أيضاً- عند المبدعين؛ فقد ظهر تعبير (الصناعات الثقافية) في الثلاثينيات والأربعينيات؛ لنقد الترفيه الجماهيري الذي أتاحه التطور الصناعيّ، وقد عُدّ إنتاج البضائع الثقافية وتوزيعها على نطاق صناعيّ واسع في (مصانع الأحلام)، مثل: هوليود، كارثةً!! بدعوى (ضمان الجودة)، وقد انضم إلى ذلك مثقَّفو مدرسة فرانكفورت، إلى جانب مثقّفين محافظين مثل ت. س. إليوت(4)، ووجد مناهضون لها من مثقَّفي اليمين واليسار، وتناول هذه (البرجوازية) الثقافية الناقد التشكيلي السوداني عبدالله بولا في مجموعة مقالات (مصرع الإنسان الممتاز في السبعينيات).
ولعل قراءة محددة للعمل الفني هي مجرد قراءة ممكنة ضمن قراءات أخرى، وإن ادَّعى مبدِع العمل موافقتَه إياها، وقال: إن هذا هو ما قصده بالضبط من إنتاجه هذا العمل من ناحية فهمه بوصفه موضوعاً.
وهنا يجب أن نقف قليلاً أمام المفردة (موضوع)، فموضوع العمل الفني هو مجرد جسمه الظاهر فقط، فالعمل الفني أكثر عمقاً من مجرد موضوعه، وهو ما سنوضِّحه لاحقاً.
وفي حال وجود قراءة للعمل الفنيّ تجد تأييداً من مبدعه، ولا يعني ذلك الحجر على قراءات أخرى ممكنة، بل إنها قد تكون أكثر إقناعاً من تلك التي وافق عليها مبدع العمل نفسه؛ لأن العمل الفني بتفلّته وتسلّل العوالم الذاتية والنفسية والإبداعية إليه كثيراً ما يخامر الموضوع، ويجنح وينجح في التعبير عن (حقيقة أخرى) تكون غالباً غير محددة المعالم أو غير واعية، أو بلا وعي من المبدع نفسه؛ فالفنان قد يحرفه البحث عن اكتمال الجمال الشكليّ بعيداً من (موضوعه)، فينساق وراءه بحثاً عن ذلك الاكتمال أو (الكمال) بلا وعي، وخضوعاً لـ(إرادة) داخلية في ظاهرها؛ فمثلاً القانون الجماليّ (للصنعة) الفنية كامن في ذات الفنان، وهو يكتشفه فقط، وينساق وراءه، أما الاحتمال الثاني فهو سيطرة (السيكولوجي الذاتي) غير الواعي على الوعي وخداعه بقناع (موضوعي)، وهو ما عبر عنه أحدهم بقوله: «لا أكتب القصيدة، إنما تكتبني القصيدة»، وفي حال الانصياع للقانون الجمالي قد يكون ذلك عمداً من المبدع؛ لاكتشافه أهمية البنية الشكلية وقيمتها -على الأقل- على مستوى التنافس الإبداعي.
الفن في خدمة الدين
المعروف أن الفن بدأ نفعياً، واستمرّ كذلك على مر العصور، خادماً العقيدة (الدين) والسلطة (الملك)، ولهما معاً في حال lojoتحالفهما الغالب، لكن المبدع كثيراً ما (راوغ) الانصياع الحرفي لهذه الوظيفة الاجتماعية، ومال إلى قوانين صنعته، أو التعبير عن دواخله النفسية، وهما الملمحان اللذان صارا أكثر أهمية مع الفن الحديث ومنذ بدايات الرومانسية وعلى نحو متصاعد؛ مثلاً: «كانت التراتيل الموسيقية في القرن الثاني عشر توظف في الكنيسة الفن الرسمي والمعترف به وبقيمته، لكن الموسيقيين سرعان ما اكتشفوا إمكانية إضافة ميلوديات أجمل من مجرد متابعة التراتيل، مع أن التراتيل كانت لا تزال موقرة، وتمثل سلطة الكنيسة»(5).
واستمرّ التراخي وانقطاع الفنّ عن خدمة الدين مع ضعف قبضة الأخير على المجتمع الغربي؛ بسبب النموذج المتطرّف الذي قدمته الكنيسة المسيحية في القرون الوسطى؛ وهذا الأمر أدى إلى تسميتها بعصور الظلام، فقد ضعفت هذه البنية السلطوية الدينية السياسية مع نهاية عصر الإقطاع؛ من نهايات القرن الرابع عشر إلى بداية القرن الخامس عشر في الغرب، و«لم يكن مفاجئاً في مثل هذا المناخ أن يميل المؤلّفون إلى التأليف الموسيقيّ الدنيويّ عوضاً عن الأخرويّ الذي كان سائداً من قبلُ»(6). وظهرت مثالاً لذلك موسيقا جيلوم دي ماشوت وأغانيه الجميلة المملوءة بالزخارف، مع أنه كان قسيساً، وذلك بتأثير وقوعه في غرام فتاة في التاسعة عشرة من العمر بينما كان هو في الستين من عمره. ومن أمثلة أغانيه (The Notre Dam Mass) التي تعدُّ واحدة من أجمل إبداعات القرون الوسطى(7)، وهو ما يدلّ على قوّة الدوافع الذاتية وحيويّتها -في ظاهرها- وتأثيرها في الفنّ، أو كما يعبّر فرويد: حبّ (الأنا) هو المصدر الأول لكل حبّ.
كانت مثل هذه الأعمال والأجواء إرهاصاً للنهضة الأوربية التي جاءت بعد ذلك في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، والتي عُنيت بإعادة ميلاد الإنسان، أو إعادة الإيمان بقدرته على الإبداع والابتكار بعد أن تحجّر؛ بسبب تأثير تعاليم الكنيسة في العصور الوسطى في الغرب.
احتجاج مضمر
المعروف أن القرون الوسطى هي حقبة ازدهار الحضارة الإسلامية وإسهامها الضخم في العلوم والثقافة والفنون، وقد أرجع بعض الباحثين، ومنهم الناقد السوري يوسف اليوسف، ظهور الغزل العذريّ في عصر بني أمية في عهد عبدالملك بن مروان إلى تعبير عن احتجاج سياسيّ على عصر شهد تحولات سياسية في نظام الحكم، وفي رأيه أن الشعر العذريّ هو احتجاج مضمر على قيم العصر على الرغم من الانصياع لها؛ أي: أنه تكيُّف مع القمع ورفض له، وهو خليط من الشعور بالذنب والحسّ الشبقيّ(8). سنعود إلى موضوع الغزل والحبّ العذري لاحقاً برؤية خاصّة في هذه المقالة، وإن تشاركت فيها مع آراء سابقة.
وهكذا سيطرت النزعة الإنسانية على الثقافة والمجتمع الغربيّ في عصر النهضة الأوربية، فأثّرت بقوّة في الفنّ، ولجأ الفنّانون إلى استلهام التراث الكلاسيكيّ والأسطوريّ الإغريقيّ، ورجعوا مرّة أخرى في التشكيل إلى نقل الجسم البشريّ العاري كموضوع مفضّل، كما كان في التراث الأوربي، الذي صار في العصور الوسطى مدعاة للخجل، وهذا الأمر دفع فنّاني العصور الوسطى إلى اللجوء كثيراً إلى الرمزية الدينية بدلاً من محاكاة الحياة اليومية، لعلّها تماثل سيطرة فكرة (الطهر) على الغزل العذريّ في الشعر العربيّ. بينما صار فنّانو النهضة أكثر اهتماماً بالواقع، كما في أعمال دافنشي، ورفائيل، ومايكل أنجلو، واستخدموا من أجل ذلك المنظور الخطيّ؛ لخلق إيهام بصريّ بالعمق في الصورة، كما تخلّوا عن رسم العذراء (مريم) طفلة بريئة فحسْب، بل رسموها على شكل امرأة جميلة(9).
ومن بين العوامل التي أدَّت إلى ذلك -كما قلنا- ضعف الكنيسة الكاثوليكيّة؛ بسبب ظهور المذهب البروتستانتيّ، وتصاعد حركة التعليم الدنيويّ لدى النبلاء وأبناء الطبقة الوسطى، إلى جانب انتشار الطباعة التي ظهرت عام 1450م. وعلى الرغم من بقاء الكنيسة وحدة من وحدات النشاط الموسيقيّ فإن الملمح الأساسيّ للنشاط الموسيقيّ صار هو بلاطات الملوك والأمراء والنبلاء. وهكذا صارت هناك موسيقا دنيوية في القصور، ودينية في الكنائس، وصار للموسيقيين مكانة مميّزة في المجتمع، ونالوا أجوراً مرتفعة(10).
ويظهر توظيف الفن في خدمة العقيدة والسلطة على نحو كامل تقريباً في الحضارات القديمة؛ مثل: حضارة وادي النيل، وحضارة ما بين النهرين في العراق، رجوعاً بالفنّ إلى العصر الحجريّ؛ إذ نلحظ عدم ظهور اسم الفنان في الأعمال التي ينتجها. وقويت هذه النزعة وسادت بعد عصر النهضة، على نحو يشير إلى سيادة الاتجاه الذاتيّ بوصفه نموذجاً للإنسان بدلاً من فنائه في الجمعيّ كما في المجتمعات السابقة، باستثناء بعض فناني أثينا الإغريقية.
روح الفنان
أثّرت الوظيفة الإيضاحية التواصلية الاجتماعية في شكل العمل الفنيّ، وفرضت عليه الشكل والموضوع، لكن -كما سبق القول- ما فتئت الذاتية تتسلّل إلى العمل الفنّيّ من خلال السمات الأسلوبية للفنّان، ولمسات الفرشاة أو العائلات اللونية حتى النسب والتصميم والرموز؛ لأن (روح) الفنّان لا بدّ أن تطبع عمله بسمات خاصّة به تميّزه من غيره، وتعبّر عن ذاتيته، مهما حاول أن يكون موضوعياً، وهذا ما يسحرنا عند الوقوف أمام الأعمال الفنية، وهي بذلك تقول أكثر مما قصد أن يقوله المبدع، وهذا الشيء الغامض المختبئ -المتسلّل رغماً عنا، وبتمنّعه علينا- يمنح العمل الفني علينا سلطة أخرى؛ إذ يمارس علينا قدراً من التعالي والشاعرية، فهو بعبارة شوبنهاور عن الشعر: «يهدف إلى إدراك المثل -أي: الكشف عن الحقائق الكلية كما تتجلّى في الموجودات الفردية- ومن ثَمَّ يرتبط الشعر بالفلسفة»(11).
وبفعل الفنّ وقدرته على قول أكثر مما عنينا، فإنه يحفز أخيلتنا إلى براحات واسعة، واحتمالات كثيرة للمعنى، ونحن حين نقاربه لسبر غوره نقوم بإعادة إنتاجه في أخيلتنا، وبذلك تكون قراءة العمل الفنيّ هي إنتاج عمل فنيّ قائم على العمل الذي نحاول قراءته، وخصوصاً في حال تغيّر اللغة من بصرية (التشكيل) أو (صوتية) الموسيقا إلى لغوية فيما يسمى بالإكفراسية (وهي دخول النص الشفاهي على النص العلامي الذي يدرك بصرياً).
وبعدم سبر غور العمل أو التيقّن من ذلك يظل العمل محتفظاً بسلطته علينا؛ فاحتفاظه بسرّه يمنحه نوعاً من التحدّي لإدراكنا؛ فيظلّ عقلنا مشغولاً به، ولعل هذا ما استندت إليه فكرة (المظهر الجديد) في الموضة، بينما فهمنا له يفقده سيطرته وسلطته على فضولنا إلى حدّ كبير، إلا في حال تفاعلنا معه وجدانياً أو جمالياً. أما إذا ارتبط الاستعصام بالغموض مع عجز العمل عن التواصل معنا وجدانياً أو جمالياً؛ أي: عدم قدرته على إثارة إعجابنا به، فغالباً ما يسقط اهتمامنا به مع ما في الحياة من زحمة موضوعات ومشاغل.
تعطي عدم المباشرة، وتدثّر المعاني بالأسرار، العمل الفنيّ كثيراً من قيمته وسحره، وهو أحد الأسباب التي تجعل الفنّان يلجأ إلى الإيحاء والإيماء بدلاً من التصريح والتحديد، وهو ما يعطي متسعاً من التأويل، ويتيح مزيداً من القراءات، وتوليد المعاني التي تصير في حدّ ذاتها إبداعاً. وقد ظلّ الفنّ -أو يكاد- يعيد الإجابة عن الأسئلة الوجوديّة نفسها، لكن بأشكال تمنحها جِدَّة تُجاري ما يطرأ على الكائن البشري من تطوُّر أو تغيُّر، وبهذا التجديد والتنوّع نظلّ قادرين على احتمال الحياة والتمتّع بها على الرغم من قول زهير بن أبي سلمى:
سئمت تكاليف الحياة ومَنْ يَعِشْ = ثمانين حولاً لا أبا لك يَسْأَمِ
لكن هل يسمح لنا أصحاب النظرة الاجتماعية المباشرة بهذا القدر من الترف والحرية في الفنّ؟
لا شك أنهم سيسارعون إلى النقد وإطلاق النعوت، كلٌّ حسَب معجمه، فقد يقول بعضهم: إنه عبث ولهو، ويسميه آخرون خيانة، أو يقول قائل: إنه إسراف أو رجعيّة، ومن يمنع بسلطته ومن يكفر، ولا ننكر أن هناك دوراً اجتماعياً للفنّ بالمعنى المباشر؛ أي: وظيفة اجتماعية مباشرة للفنّ قد تستدعيها بعض الظروف بإلحاح كثير، وذلك حين يدعو إلى تغيير قيم أو أوضاع أو ترسيخهما، وهو هنا يكون جزءاً من البنية الأخلاقية أو السياسية أو الفكرية للمجتمع، وهو ما تطالب به هذه الفئات و(السلطات) الاجتماعية المختصّة؛ إذ تطالبه أن يكون واضحاً ومحدّداً في موضوعاته التي يحدِّدونها له سلفاً بما يتوافق مع أهدافهم، وقد يستجيب بعض الفنانين، ويقبلون القيام بهذا الدور إيماناً أو خضوعاً، لكن لا شك في أن كثيراً من الفنانين يتمرَّدون على هذه (القيود) الاجتماعية التي تحدّ من حرية التعبير، وخصوصاً في المجتمع الحديث، مع صعود قيمة الحرية، وما يسمى بـ(حقوق الإنسان)، وما يزيد على ذلك أن كثيرين يرون أن الفنّ هو في الأصل تعبير عن الانفعال بالحياة.
لا يسمح حرّاس المجتمع والعقيدة والأخلاقيون والسلطويون بهذه الحرية التعبيرية ما دام العمل الفنيّ يحفز إلى محاولة (الفهم)؛ وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إدراك الواقع على نحو مختلف عما هو سائد وتهديد استقراره، وتهديد مصالح وأوضاع لهما أنصارهما، فيناصبانه العداء والحرب.
إن الوظيفة الاجتماعية المباشرة للفنّ -على أقل تقدير- يجب ألا تسلبه خصائصه التي تميّزه بوصفه منتجاً إنسانياً ذا سِمات محدّدة، فلا تطغى عليه النفعية أو التّزمّت الأخلاقيّ أو غيرهما، فكيف يمكن للعمل الفنيّ أن يتحوّل إلى أداة اجتماعية محضة خالية من الروح الجمالية والإنسانية التي تميّزه؟
يحاول العمل الفني دائماً أن يكون ساحراً وجذّاباً، لا خطاباً تطبيقياً محضاً، يقصد إلى فائدة نفعية مباشرة. ولا نعني بذلك أن العمل التطبيقي ليس فناً، إنما العمل يمكن أن يكون تطبيقياً وجمالياً في الوقت نفسه، كاللذة في الطعام. وهناك كثير من الأمثلة على ذلك من المنتجات الصناعية الحديثة أو اليدوية التقليدية والتراثية. ولا نَعني بعدم المباشرة في العمل الفنيّ الغموضَ (المصنوع) من أجل الغموض، إنما المقصود أن الموضوع مع أهميته ليس هو العمل الفنيّ، ولا هو أهمّ ما في العمل الفنيّ. وعلى حسَب الفن الحديث، فقد صار الشكل هو حجر الزاوية، وهو المعادِل للمحتوى في الفنّ الحديث(12).
تأثيرات متنوعة في الرؤية الأوربية
ظلّ الفنّ يحاول بلوغ الكمال ويبحث عنه إلى أن توّج هذا البحث على يد التكعيبيين في التشكيل، ثم الانطلاق إلى الأدب بضروبه المختلفة، ثم أضيف إلى ذلك إسهامات أخرى من التجريديين -التعبيريون منهم والبصريون الهندسيون- من أمثال: كاندنسكي، وكلي، وموتدريان، وقاسرللي. وفي رحلته هذه استفاد الفنّ الغربيّ من فنون شعوب أخرى؛ كالفنون الإسلامية والآسيوية والإفريقية. وقد أسهمت هذه الفنون في تطوير الجمالية الأوربية، وبثّت فيها دماء، لكنّها لم تمنحها روحها. ويمكن تتبّع ذلك من خلال المدارس الغربية؛ إذ نجد تأثير الرومانسية في الشرق الإسلامي، وقد مضى الرومانسيون إلى الشرق على هدي من الدعوة الشّعرية التي أطلقها جوته في عام 1819م حين كتب:
الخراب يعم الشمال والغرب والجنوب
هوت العروش وسقطت الممالك..
فامضِ إلى الشرق البعيد
واستنشق الأنسام الطيّبة
إلى أصقاع الخمر والعشق والغناء..
ولتبعث هناك حياة جديدة(13).
وقد تأثّرت الانطباعية بالشرق الأقصى، وبخاصة فنون اليابان، ومرة أخرى نهل الفنّ الغربي من المعين الإسلامي مع الوحشية. أما التكعيبية -الانقلاب الفنيّ الكبير- فقد استندت إلى الفنّ الإفريقيّ.
البساطة والمفاهيمية
انفصام الفنّ عن الموضوع، ومحاولته الاستقلال بنفسه -على أساس أنه يحمل قيمة عليا- أتاحا له كثيراً من الإمكانيات التعبيرية، لكن ذلك -أيضاً- أدخله في نوع من العزلة الاجتماعية. وصار الفنّ بانفصاله عن الموضوع يحمل قيمتين متناقضتين؛ أولاهما: هي قيمة البساطة التي لا تبحث في الفن سوى عن الجمال الشكليّ، الذي يمكن أن يدركه بسهولة الأطفال، أما القيمة الأخرى فهي التعبيرية أو المفاهيمية التي تتحقّق من خلال تحويل العمل الفنيّ إلى رموز دالّة؛ مما جعل الفنّ قريباً وبعيداً في الوقت ذاته.
أما الموضوع فلم يفقد أهميته تماماً؛ لأنه محرك ضروري للفنان بوصفه المتلقي المنفعل بالواقع؛ إذ لا يمكن أن نتصوّر إنتاجاً فنياً من دون تفاعل مع موضوع، وهذا التفاعل يصبغ الموضوع بـ(ذات) الفنّان، وبذلك يكون الموضوع ملتبساً بذات الفنان إن لم يكن تجسيماً له. فالموضوع قد يكون رمزاً أو جسماً لمضمون آخر خارجه، فالفكرة أو المضمون ربما كان مختمراً في ذهن المبدع إلى الوقت الذي التقى فيه المبدع بالمثير المناسب، الذي حرّكه وساهم في إخراجه إلى الوجود، ولكن تظلّ الفكرة أبعد من مجرّد الموضوع الذي قد لا يعدو أن يكون مثيراً. ويظهر ذلك في الحب العذري بشكل واضح؛ فالمحب العذري قد لا يرجو لقاء محبوبته، ومع ذلك يظل وفياً لها، كما هو في حال جميل بثينة، الذي راودها، وحين لامته على ذلك، ذكر أنها لو قبلت لقتلها هو بسيفه، وذلك يعني أنها لو قبلتْ لقتلت عنده (الفكرة) السامية التي يحبّها، فتحوّلت المحبوبة هنا من امرأة من لحم ودم إلى صورة مثالية تجسّدت في هذه المرأة. هذه الصورة هي صورة جمالية روحية أقرب إلى التصوّف، ولا تخفى العلاقة بين الحبّ والغزل العذريّ والتصوّف والفن؛ فكلّها موضوعها الجمال والحبّ. فالمتصوّف يبحث عن الفناء في الذات الإلهية من دون وسيط، والمحبّ العذريّ يتسامى عن الجسد حقاً أو تقوى لله؛ فخوفه من الخطيئة والذنب حوّل الطاقة الجنسية عنده إلى طاقة حبّ الجمال، وعشق الفكرة، وهو بذلك لا يزال ينفعل بإرادة الحياة على الرغم مما قاله بعضهم عما في الحبّ العذريّ من ماسوشية، أو ما سمّاها آخرون شبقية مغلّفة؛ فالتسامي بالشبقية هو انتصار لفكرة الخير والحقّ، مع التعبير عن التوق الطبيعي إلى اتحاد بالمعشوق؛ لاستمرار الحياة. ألا تكون المعشوقة هنا (رمزاً) إلى فكرة، مع أنها شخصية معيّنة؟ فهي تعبير عن إرادة الحياة، لكن ليس كما قال شوبنهاور عن هذه الإرادة: إنها قوة عمياء (لا عاقلة)، بل هي إرادة الخالق التي تسيّر الكون، وتحفظ نظامه، ونقوم نحن بتنفيذها، ويحاول الفن أن يعبّر عن هذه الإرادة. إننا لسنا مجرّد أشياء، إنما هناك شيء ما ورائيّ ميتافيزيقيّ، هو الذي يدفعنا إلى استعمال اللغة على نحو خاصّ، واستخدام الصور الرمزية؛ لتقول ما تعجز عنه اللغة مباشرة.
* نقلا عن:
الموضوع والشكل في العمل الفني | مجلة الفيصل
موضوع العمل الفنيّ (الموسيقيّ) يعرفه الفنان وحده، أما المستمعون فكل واحد منهم يفسّر الإيحاءات الموسيقية وفق رؤيته وانفعاله، وما تثيره فيه من حالات نفسية(1). ومحاولة تفكيك العمل الفني إلى مكوناته ودوافعه أو أصوله الذاتية والموضوعية عملية ليست سهلة، ويحفّها كثير من العقبات، وقد تبيّن ذلك بوضوح بعد تجاوز المدارس والنظريات النقدية القائمة على الفلسفة الوضعية والعقلية لدى كانط وهيجل مع الضربات التي وجهتها لها الشكلانية بإسهاماتها المتميزة وما قدمته البنيوية، فأدى ذلك إلى مراجعة شاملة للأداء النقدي فيما يعرف بما بعد الحداثة، وكانت النتيجة الكبرى هي تهدّم ما يعرف بـ (العقل الخالص) وانهياره، وصارت الرؤية العلميّة في مجال الإنسانيات أكثر تواضعاً في ادعاءاتها، وحلّت علاقة اللغة بالعالَم محلّ علاقة الذات بالموضوع(2).
ساهمت التطورات التي حدثت في كثير من العلوم في الوصول إلى هذا الانقلاب. ولم تستطع فلسفة العلم، التي اعتمدتها الوضعية، أن تنجح في مجال الإنسانيات؛ بسبب التكوين (الذاتي/ الموضوعي) للنوع الإنساني(3). فالعمل الفني -بلا شك- هو تلك الوحدة الموضوعية في داخله، المتمسّكة بتكوينها الذي يعطيها شكلها الذي هي عليه، ويحقّق وجودها المتميز، ومكانتها ووظيفتها الاجتماعيتين والتعبيريتين. ومع ذلك نظل دائماً في حاجة إلى (الولوج) إلى عالم العمل الفني وقراءته التي قد لا تكون ضرورية لتمتُّعنا به وتذوُّقه، بل ربما كان لها أثر سلبي في استمتاعنا به، فقد تفتر جاذبية العمل الفني، وربما تقضي عليها (القراءة) التحليلية، والفهم الناتج من النقد.
الموضوع وأهميته
ينشأ هنا سؤال قد تسهم مناقشته ومحاولة الإجابة عنه في فهم طبيعة العمل الفني ودوافعه وبنيته وقيمته وتذوقه على نحو أفضل. السؤال هو: ما مكانة الموضوع بـ(المعنى الوصفي) في العمل الفني؟ وما أهميته؟
ومع أن السؤال قديم، لكنه صار أكثر إلحاحاً مع الفن الحديث، وخصوصاً في الشعر، وبشكل أكثر خصوصية في الفنّ التشكيليّ الحديث. فالمعروف أن الموضوع كانت له مكانة جوهرية، وربما المكانة الأولى في العمل الفنيّ الكلاسيكيّ بواقعيته المثالية أو النموذجية المستندة إلى قيم اجتماعية محددة، هي قيم المجتمع الأرستقراطي (المسيطر) على السلطة والثروة، وصاحب الحق في فرض القيم والعقائد.
كانت لغة الفن في ذلك الوقت مباشِرة تتميز بالوضوح، أو فلنقل: إنها تقصده؛ لأن كثيراً من الأغراض قد تتسرب إلى العمل الفني من دون قصد مبدعه. ومع مرور الزمن تطور العمل الفني وفق ظروفه الاجتماعية، وبنيته الكاملة من مؤثرات اقتصادية وسياسية واجتماعية وعلمية وفكرية.
وقد ظل العمل الفني -بسبب تعدد وظائفه النفسية والجمالية والاجتماعية- يتمرّد على الأُطُر والقوالب؛ كي يحافظ على وجوده وحيويته وجدته، ويتمكن من أداء وظائفه المتعددة من دون أن يفقد هويته.
رأي متعالٍ
لا شك أن الفنانين -كثيراً منهم على الأقل- اكتشفوا القيم الجمالية البحتة ومتعتها وأثرها في النفس؛ مما أدى إلى ظهور ما يُعرَف بالفن الصافيّ، الذي لا شك في أنه كان موجوداً بشكل أكثر تلقائية بعيداً من الفلسفة والفكر، خلافاً لما ذهبت إليه كاتبة أوربية من أن (الفن) بمعناه الحالي هو اختراع أوربيّ. ربما هي تعني فلسفة الفن وعلم الجمال، لكن لا شك في أن الفن بقدرته التلقائية على أداء وظيفته نشأ مع الإنسان.
هذا الرأي فيه نوع من التعالي، وتوجد له نماذج -أيضاً- عند المبدعين؛ فقد ظهر تعبير (الصناعات الثقافية) في الثلاثينيات والأربعينيات؛ لنقد الترفيه الجماهيري الذي أتاحه التطور الصناعيّ، وقد عُدّ إنتاج البضائع الثقافية وتوزيعها على نطاق صناعيّ واسع في (مصانع الأحلام)، مثل: هوليود، كارثةً!! بدعوى (ضمان الجودة)، وقد انضم إلى ذلك مثقَّفو مدرسة فرانكفورت، إلى جانب مثقّفين محافظين مثل ت. س. إليوت(4)، ووجد مناهضون لها من مثقَّفي اليمين واليسار، وتناول هذه (البرجوازية) الثقافية الناقد التشكيلي السوداني عبدالله بولا في مجموعة مقالات (مصرع الإنسان الممتاز في السبعينيات).
ولعل قراءة محددة للعمل الفني هي مجرد قراءة ممكنة ضمن قراءات أخرى، وإن ادَّعى مبدِع العمل موافقتَه إياها، وقال: إن هذا هو ما قصده بالضبط من إنتاجه هذا العمل من ناحية فهمه بوصفه موضوعاً.
وهنا يجب أن نقف قليلاً أمام المفردة (موضوع)، فموضوع العمل الفني هو مجرد جسمه الظاهر فقط، فالعمل الفني أكثر عمقاً من مجرد موضوعه، وهو ما سنوضِّحه لاحقاً.
وفي حال وجود قراءة للعمل الفنيّ تجد تأييداً من مبدعه، ولا يعني ذلك الحجر على قراءات أخرى ممكنة، بل إنها قد تكون أكثر إقناعاً من تلك التي وافق عليها مبدع العمل نفسه؛ لأن العمل الفني بتفلّته وتسلّل العوالم الذاتية والنفسية والإبداعية إليه كثيراً ما يخامر الموضوع، ويجنح وينجح في التعبير عن (حقيقة أخرى) تكون غالباً غير محددة المعالم أو غير واعية، أو بلا وعي من المبدع نفسه؛ فالفنان قد يحرفه البحث عن اكتمال الجمال الشكليّ بعيداً من (موضوعه)، فينساق وراءه بحثاً عن ذلك الاكتمال أو (الكمال) بلا وعي، وخضوعاً لـ(إرادة) داخلية في ظاهرها؛ فمثلاً القانون الجماليّ (للصنعة) الفنية كامن في ذات الفنان، وهو يكتشفه فقط، وينساق وراءه، أما الاحتمال الثاني فهو سيطرة (السيكولوجي الذاتي) غير الواعي على الوعي وخداعه بقناع (موضوعي)، وهو ما عبر عنه أحدهم بقوله: «لا أكتب القصيدة، إنما تكتبني القصيدة»، وفي حال الانصياع للقانون الجمالي قد يكون ذلك عمداً من المبدع؛ لاكتشافه أهمية البنية الشكلية وقيمتها -على الأقل- على مستوى التنافس الإبداعي.
الفن في خدمة الدين
المعروف أن الفن بدأ نفعياً، واستمرّ كذلك على مر العصور، خادماً العقيدة (الدين) والسلطة (الملك)، ولهما معاً في حال lojoتحالفهما الغالب، لكن المبدع كثيراً ما (راوغ) الانصياع الحرفي لهذه الوظيفة الاجتماعية، ومال إلى قوانين صنعته، أو التعبير عن دواخله النفسية، وهما الملمحان اللذان صارا أكثر أهمية مع الفن الحديث ومنذ بدايات الرومانسية وعلى نحو متصاعد؛ مثلاً: «كانت التراتيل الموسيقية في القرن الثاني عشر توظف في الكنيسة الفن الرسمي والمعترف به وبقيمته، لكن الموسيقيين سرعان ما اكتشفوا إمكانية إضافة ميلوديات أجمل من مجرد متابعة التراتيل، مع أن التراتيل كانت لا تزال موقرة، وتمثل سلطة الكنيسة»(5).
واستمرّ التراخي وانقطاع الفنّ عن خدمة الدين مع ضعف قبضة الأخير على المجتمع الغربي؛ بسبب النموذج المتطرّف الذي قدمته الكنيسة المسيحية في القرون الوسطى؛ وهذا الأمر أدى إلى تسميتها بعصور الظلام، فقد ضعفت هذه البنية السلطوية الدينية السياسية مع نهاية عصر الإقطاع؛ من نهايات القرن الرابع عشر إلى بداية القرن الخامس عشر في الغرب، و«لم يكن مفاجئاً في مثل هذا المناخ أن يميل المؤلّفون إلى التأليف الموسيقيّ الدنيويّ عوضاً عن الأخرويّ الذي كان سائداً من قبلُ»(6). وظهرت مثالاً لذلك موسيقا جيلوم دي ماشوت وأغانيه الجميلة المملوءة بالزخارف، مع أنه كان قسيساً، وذلك بتأثير وقوعه في غرام فتاة في التاسعة عشرة من العمر بينما كان هو في الستين من عمره. ومن أمثلة أغانيه (The Notre Dam Mass) التي تعدُّ واحدة من أجمل إبداعات القرون الوسطى(7)، وهو ما يدلّ على قوّة الدوافع الذاتية وحيويّتها -في ظاهرها- وتأثيرها في الفنّ، أو كما يعبّر فرويد: حبّ (الأنا) هو المصدر الأول لكل حبّ.
كانت مثل هذه الأعمال والأجواء إرهاصاً للنهضة الأوربية التي جاءت بعد ذلك في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، والتي عُنيت بإعادة ميلاد الإنسان، أو إعادة الإيمان بقدرته على الإبداع والابتكار بعد أن تحجّر؛ بسبب تأثير تعاليم الكنيسة في العصور الوسطى في الغرب.
احتجاج مضمر
المعروف أن القرون الوسطى هي حقبة ازدهار الحضارة الإسلامية وإسهامها الضخم في العلوم والثقافة والفنون، وقد أرجع بعض الباحثين، ومنهم الناقد السوري يوسف اليوسف، ظهور الغزل العذريّ في عصر بني أمية في عهد عبدالملك بن مروان إلى تعبير عن احتجاج سياسيّ على عصر شهد تحولات سياسية في نظام الحكم، وفي رأيه أن الشعر العذريّ هو احتجاج مضمر على قيم العصر على الرغم من الانصياع لها؛ أي: أنه تكيُّف مع القمع ورفض له، وهو خليط من الشعور بالذنب والحسّ الشبقيّ(8). سنعود إلى موضوع الغزل والحبّ العذري لاحقاً برؤية خاصّة في هذه المقالة، وإن تشاركت فيها مع آراء سابقة.
وهكذا سيطرت النزعة الإنسانية على الثقافة والمجتمع الغربيّ في عصر النهضة الأوربية، فأثّرت بقوّة في الفنّ، ولجأ الفنّانون إلى استلهام التراث الكلاسيكيّ والأسطوريّ الإغريقيّ، ورجعوا مرّة أخرى في التشكيل إلى نقل الجسم البشريّ العاري كموضوع مفضّل، كما كان في التراث الأوربي، الذي صار في العصور الوسطى مدعاة للخجل، وهذا الأمر دفع فنّاني العصور الوسطى إلى اللجوء كثيراً إلى الرمزية الدينية بدلاً من محاكاة الحياة اليومية، لعلّها تماثل سيطرة فكرة (الطهر) على الغزل العذريّ في الشعر العربيّ. بينما صار فنّانو النهضة أكثر اهتماماً بالواقع، كما في أعمال دافنشي، ورفائيل، ومايكل أنجلو، واستخدموا من أجل ذلك المنظور الخطيّ؛ لخلق إيهام بصريّ بالعمق في الصورة، كما تخلّوا عن رسم العذراء (مريم) طفلة بريئة فحسْب، بل رسموها على شكل امرأة جميلة(9).
ومن بين العوامل التي أدَّت إلى ذلك -كما قلنا- ضعف الكنيسة الكاثوليكيّة؛ بسبب ظهور المذهب البروتستانتيّ، وتصاعد حركة التعليم الدنيويّ لدى النبلاء وأبناء الطبقة الوسطى، إلى جانب انتشار الطباعة التي ظهرت عام 1450م. وعلى الرغم من بقاء الكنيسة وحدة من وحدات النشاط الموسيقيّ فإن الملمح الأساسيّ للنشاط الموسيقيّ صار هو بلاطات الملوك والأمراء والنبلاء. وهكذا صارت هناك موسيقا دنيوية في القصور، ودينية في الكنائس، وصار للموسيقيين مكانة مميّزة في المجتمع، ونالوا أجوراً مرتفعة(10).
ويظهر توظيف الفن في خدمة العقيدة والسلطة على نحو كامل تقريباً في الحضارات القديمة؛ مثل: حضارة وادي النيل، وحضارة ما بين النهرين في العراق، رجوعاً بالفنّ إلى العصر الحجريّ؛ إذ نلحظ عدم ظهور اسم الفنان في الأعمال التي ينتجها. وقويت هذه النزعة وسادت بعد عصر النهضة، على نحو يشير إلى سيادة الاتجاه الذاتيّ بوصفه نموذجاً للإنسان بدلاً من فنائه في الجمعيّ كما في المجتمعات السابقة، باستثناء بعض فناني أثينا الإغريقية.
روح الفنان
أثّرت الوظيفة الإيضاحية التواصلية الاجتماعية في شكل العمل الفنيّ، وفرضت عليه الشكل والموضوع، لكن -كما سبق القول- ما فتئت الذاتية تتسلّل إلى العمل الفنّيّ من خلال السمات الأسلوبية للفنّان، ولمسات الفرشاة أو العائلات اللونية حتى النسب والتصميم والرموز؛ لأن (روح) الفنّان لا بدّ أن تطبع عمله بسمات خاصّة به تميّزه من غيره، وتعبّر عن ذاتيته، مهما حاول أن يكون موضوعياً، وهذا ما يسحرنا عند الوقوف أمام الأعمال الفنية، وهي بذلك تقول أكثر مما قصد أن يقوله المبدع، وهذا الشيء الغامض المختبئ -المتسلّل رغماً عنا، وبتمنّعه علينا- يمنح العمل الفني علينا سلطة أخرى؛ إذ يمارس علينا قدراً من التعالي والشاعرية، فهو بعبارة شوبنهاور عن الشعر: «يهدف إلى إدراك المثل -أي: الكشف عن الحقائق الكلية كما تتجلّى في الموجودات الفردية- ومن ثَمَّ يرتبط الشعر بالفلسفة»(11).
وبفعل الفنّ وقدرته على قول أكثر مما عنينا، فإنه يحفز أخيلتنا إلى براحات واسعة، واحتمالات كثيرة للمعنى، ونحن حين نقاربه لسبر غوره نقوم بإعادة إنتاجه في أخيلتنا، وبذلك تكون قراءة العمل الفنيّ هي إنتاج عمل فنيّ قائم على العمل الذي نحاول قراءته، وخصوصاً في حال تغيّر اللغة من بصرية (التشكيل) أو (صوتية) الموسيقا إلى لغوية فيما يسمى بالإكفراسية (وهي دخول النص الشفاهي على النص العلامي الذي يدرك بصرياً).
وبعدم سبر غور العمل أو التيقّن من ذلك يظل العمل محتفظاً بسلطته علينا؛ فاحتفاظه بسرّه يمنحه نوعاً من التحدّي لإدراكنا؛ فيظلّ عقلنا مشغولاً به، ولعل هذا ما استندت إليه فكرة (المظهر الجديد) في الموضة، بينما فهمنا له يفقده سيطرته وسلطته على فضولنا إلى حدّ كبير، إلا في حال تفاعلنا معه وجدانياً أو جمالياً. أما إذا ارتبط الاستعصام بالغموض مع عجز العمل عن التواصل معنا وجدانياً أو جمالياً؛ أي: عدم قدرته على إثارة إعجابنا به، فغالباً ما يسقط اهتمامنا به مع ما في الحياة من زحمة موضوعات ومشاغل.
تعطي عدم المباشرة، وتدثّر المعاني بالأسرار، العمل الفنيّ كثيراً من قيمته وسحره، وهو أحد الأسباب التي تجعل الفنّان يلجأ إلى الإيحاء والإيماء بدلاً من التصريح والتحديد، وهو ما يعطي متسعاً من التأويل، ويتيح مزيداً من القراءات، وتوليد المعاني التي تصير في حدّ ذاتها إبداعاً. وقد ظلّ الفنّ -أو يكاد- يعيد الإجابة عن الأسئلة الوجوديّة نفسها، لكن بأشكال تمنحها جِدَّة تُجاري ما يطرأ على الكائن البشري من تطوُّر أو تغيُّر، وبهذا التجديد والتنوّع نظلّ قادرين على احتمال الحياة والتمتّع بها على الرغم من قول زهير بن أبي سلمى:
سئمت تكاليف الحياة ومَنْ يَعِشْ = ثمانين حولاً لا أبا لك يَسْأَمِ
لكن هل يسمح لنا أصحاب النظرة الاجتماعية المباشرة بهذا القدر من الترف والحرية في الفنّ؟
لا شك أنهم سيسارعون إلى النقد وإطلاق النعوت، كلٌّ حسَب معجمه، فقد يقول بعضهم: إنه عبث ولهو، ويسميه آخرون خيانة، أو يقول قائل: إنه إسراف أو رجعيّة، ومن يمنع بسلطته ومن يكفر، ولا ننكر أن هناك دوراً اجتماعياً للفنّ بالمعنى المباشر؛ أي: وظيفة اجتماعية مباشرة للفنّ قد تستدعيها بعض الظروف بإلحاح كثير، وذلك حين يدعو إلى تغيير قيم أو أوضاع أو ترسيخهما، وهو هنا يكون جزءاً من البنية الأخلاقية أو السياسية أو الفكرية للمجتمع، وهو ما تطالب به هذه الفئات و(السلطات) الاجتماعية المختصّة؛ إذ تطالبه أن يكون واضحاً ومحدّداً في موضوعاته التي يحدِّدونها له سلفاً بما يتوافق مع أهدافهم، وقد يستجيب بعض الفنانين، ويقبلون القيام بهذا الدور إيماناً أو خضوعاً، لكن لا شك في أن كثيراً من الفنانين يتمرَّدون على هذه (القيود) الاجتماعية التي تحدّ من حرية التعبير، وخصوصاً في المجتمع الحديث، مع صعود قيمة الحرية، وما يسمى بـ(حقوق الإنسان)، وما يزيد على ذلك أن كثيرين يرون أن الفنّ هو في الأصل تعبير عن الانفعال بالحياة.
لا يسمح حرّاس المجتمع والعقيدة والأخلاقيون والسلطويون بهذه الحرية التعبيرية ما دام العمل الفنيّ يحفز إلى محاولة (الفهم)؛ وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إدراك الواقع على نحو مختلف عما هو سائد وتهديد استقراره، وتهديد مصالح وأوضاع لهما أنصارهما، فيناصبانه العداء والحرب.
إن الوظيفة الاجتماعية المباشرة للفنّ -على أقل تقدير- يجب ألا تسلبه خصائصه التي تميّزه بوصفه منتجاً إنسانياً ذا سِمات محدّدة، فلا تطغى عليه النفعية أو التّزمّت الأخلاقيّ أو غيرهما، فكيف يمكن للعمل الفنيّ أن يتحوّل إلى أداة اجتماعية محضة خالية من الروح الجمالية والإنسانية التي تميّزه؟
يحاول العمل الفني دائماً أن يكون ساحراً وجذّاباً، لا خطاباً تطبيقياً محضاً، يقصد إلى فائدة نفعية مباشرة. ولا نعني بذلك أن العمل التطبيقي ليس فناً، إنما العمل يمكن أن يكون تطبيقياً وجمالياً في الوقت نفسه، كاللذة في الطعام. وهناك كثير من الأمثلة على ذلك من المنتجات الصناعية الحديثة أو اليدوية التقليدية والتراثية. ولا نَعني بعدم المباشرة في العمل الفنيّ الغموضَ (المصنوع) من أجل الغموض، إنما المقصود أن الموضوع مع أهميته ليس هو العمل الفنيّ، ولا هو أهمّ ما في العمل الفنيّ. وعلى حسَب الفن الحديث، فقد صار الشكل هو حجر الزاوية، وهو المعادِل للمحتوى في الفنّ الحديث(12).
تأثيرات متنوعة في الرؤية الأوربية
ظلّ الفنّ يحاول بلوغ الكمال ويبحث عنه إلى أن توّج هذا البحث على يد التكعيبيين في التشكيل، ثم الانطلاق إلى الأدب بضروبه المختلفة، ثم أضيف إلى ذلك إسهامات أخرى من التجريديين -التعبيريون منهم والبصريون الهندسيون- من أمثال: كاندنسكي، وكلي، وموتدريان، وقاسرللي. وفي رحلته هذه استفاد الفنّ الغربيّ من فنون شعوب أخرى؛ كالفنون الإسلامية والآسيوية والإفريقية. وقد أسهمت هذه الفنون في تطوير الجمالية الأوربية، وبثّت فيها دماء، لكنّها لم تمنحها روحها. ويمكن تتبّع ذلك من خلال المدارس الغربية؛ إذ نجد تأثير الرومانسية في الشرق الإسلامي، وقد مضى الرومانسيون إلى الشرق على هدي من الدعوة الشّعرية التي أطلقها جوته في عام 1819م حين كتب:
الخراب يعم الشمال والغرب والجنوب
هوت العروش وسقطت الممالك..
فامضِ إلى الشرق البعيد
واستنشق الأنسام الطيّبة
إلى أصقاع الخمر والعشق والغناء..
ولتبعث هناك حياة جديدة(13).
وقد تأثّرت الانطباعية بالشرق الأقصى، وبخاصة فنون اليابان، ومرة أخرى نهل الفنّ الغربي من المعين الإسلامي مع الوحشية. أما التكعيبية -الانقلاب الفنيّ الكبير- فقد استندت إلى الفنّ الإفريقيّ.
البساطة والمفاهيمية
انفصام الفنّ عن الموضوع، ومحاولته الاستقلال بنفسه -على أساس أنه يحمل قيمة عليا- أتاحا له كثيراً من الإمكانيات التعبيرية، لكن ذلك -أيضاً- أدخله في نوع من العزلة الاجتماعية. وصار الفنّ بانفصاله عن الموضوع يحمل قيمتين متناقضتين؛ أولاهما: هي قيمة البساطة التي لا تبحث في الفن سوى عن الجمال الشكليّ، الذي يمكن أن يدركه بسهولة الأطفال، أما القيمة الأخرى فهي التعبيرية أو المفاهيمية التي تتحقّق من خلال تحويل العمل الفنيّ إلى رموز دالّة؛ مما جعل الفنّ قريباً وبعيداً في الوقت ذاته.
أما الموضوع فلم يفقد أهميته تماماً؛ لأنه محرك ضروري للفنان بوصفه المتلقي المنفعل بالواقع؛ إذ لا يمكن أن نتصوّر إنتاجاً فنياً من دون تفاعل مع موضوع، وهذا التفاعل يصبغ الموضوع بـ(ذات) الفنّان، وبذلك يكون الموضوع ملتبساً بذات الفنان إن لم يكن تجسيماً له. فالموضوع قد يكون رمزاً أو جسماً لمضمون آخر خارجه، فالفكرة أو المضمون ربما كان مختمراً في ذهن المبدع إلى الوقت الذي التقى فيه المبدع بالمثير المناسب، الذي حرّكه وساهم في إخراجه إلى الوجود، ولكن تظلّ الفكرة أبعد من مجرّد الموضوع الذي قد لا يعدو أن يكون مثيراً. ويظهر ذلك في الحب العذري بشكل واضح؛ فالمحب العذري قد لا يرجو لقاء محبوبته، ومع ذلك يظل وفياً لها، كما هو في حال جميل بثينة، الذي راودها، وحين لامته على ذلك، ذكر أنها لو قبلت لقتلها هو بسيفه، وذلك يعني أنها لو قبلتْ لقتلت عنده (الفكرة) السامية التي يحبّها، فتحوّلت المحبوبة هنا من امرأة من لحم ودم إلى صورة مثالية تجسّدت في هذه المرأة. هذه الصورة هي صورة جمالية روحية أقرب إلى التصوّف، ولا تخفى العلاقة بين الحبّ والغزل العذريّ والتصوّف والفن؛ فكلّها موضوعها الجمال والحبّ. فالمتصوّف يبحث عن الفناء في الذات الإلهية من دون وسيط، والمحبّ العذريّ يتسامى عن الجسد حقاً أو تقوى لله؛ فخوفه من الخطيئة والذنب حوّل الطاقة الجنسية عنده إلى طاقة حبّ الجمال، وعشق الفكرة، وهو بذلك لا يزال ينفعل بإرادة الحياة على الرغم مما قاله بعضهم عما في الحبّ العذريّ من ماسوشية، أو ما سمّاها آخرون شبقية مغلّفة؛ فالتسامي بالشبقية هو انتصار لفكرة الخير والحقّ، مع التعبير عن التوق الطبيعي إلى اتحاد بالمعشوق؛ لاستمرار الحياة. ألا تكون المعشوقة هنا (رمزاً) إلى فكرة، مع أنها شخصية معيّنة؟ فهي تعبير عن إرادة الحياة، لكن ليس كما قال شوبنهاور عن هذه الإرادة: إنها قوة عمياء (لا عاقلة)، بل هي إرادة الخالق التي تسيّر الكون، وتحفظ نظامه، ونقوم نحن بتنفيذها، ويحاول الفن أن يعبّر عن هذه الإرادة. إننا لسنا مجرّد أشياء، إنما هناك شيء ما ورائيّ ميتافيزيقيّ، هو الذي يدفعنا إلى استعمال اللغة على نحو خاصّ، واستخدام الصور الرمزية؛ لتقول ما تعجز عنه اللغة مباشرة.
* نقلا عن:
الموضوع والشكل في العمل الفني | مجلة الفيصل