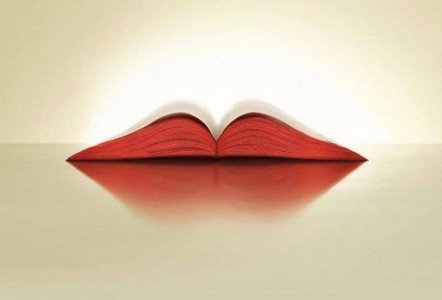أتي علينا زمن يكتب فيه أناس أضعافا مضاعفة لما يقرأون، ويتيهون بامتناعهم عن القراءة أو ضآلتها علي ما عداهم من الكُتَّاب، متوهمين أن البديهة وحدها، أو الموهبة منفردة، بوسعها أن تكون كافية شافية كي تصنع كاتبا يدوم.
أفهم أن تعطي الفطرة السليمة، والقريحة المتوقدة، والذاكرة الطازجة، شخصا يمسك بالقلم، فرصة هائلة كي يكتب نصا فريدا، سردا كان أو شعرا، أدبا أو فكرا، يضع فيه كل انفعالاته ومواجيده وانشغالاته وتصوراته وخبراته الذاتية، لكن إمكانية تحول هذا الشخص إلي كاتب صاحب مشروع، بصرف النظر عن النوع الذي يكتبه، يتطلب حيازة معرفة، لا يسلم بها، ويستسلم لها، ويعمل ويعمد إلي تكرارها وترديدها أو اجترارها، إنما يقوم بإمعان النظر فيها، يتأملها علي مهل، وينقدها، ويضيف إليها، ويتجنب مزالقها، ويستر عوراتها، ويسد فراغاتها، فيفتح أمامها بابا واسعا للنمو والتكاثر والانتشار.
والقراءة المتواصلة المتأصلة تجعل الكاتب قادرا علي تقييم ما ينتجه من خلال وضعه في مضاهاة مع ما ينتجه غيره، فبضدها تتميز الأشياء، ثم قياسه علي ما خلفه السابقون علي درب الكتابة، ليس لتقليدهم، أو اتباع خطاهم دون زحزحة يمنة أو يسرة، إنما لتوسيع هذا الدرب، وترسيخه، حتي تتقدم الكتابة دوما نحو اجتياز حواجز، وارتياد مناطق مجهولة، وانطلاق إلي آفاق رحبة.
لكن ليست كل قراءة تؤدي بالضرورة عند جميع البشر هذه الوظيفة، فأغلب القراء ليسوا بكتاب، ولو تساوي الطرفان عددا لصرنا أمام مشكلة عويصة، إذ لا يمكن لحياة ثقافية أن تمضي قوية عفية في ظل ندرة في القراء، ووفرة في الكُتَّاب، لاسيما إن كان أغلب من يطلقون علي أنفسهم كتابا لا يلبون الحد الأدني من الشروط المتعارف عليها، كي يحملوا هذه الصفة، التي أراها، بحق، عظيمة نبيلة.
وكل كاتب يقصد بالأساس أولئك القراء الذين يطالعون الكتب، بحثا عن متعة وفائدة، ويهيم أكثر بأولئك الذين يدمنون القراءة، فإن مر يوم دونها يحسبه هؤلاء أنه قد ذهب سدي، وإن أتي الليل وعيونهم لم تصافح كتابا، جافاها النوم، أو نامت مع لوم شديد للنفس، ووعد بالتعويض في الغد، ولا انفكاك إلا بفعل هذا، ليخبو التوتر، وتهدأ الخواطر، وتستكين الأنفس المتعطشة للمعرفة والعلم.
يجب ابتداء، أن تحكم مسار القراءة الناجزة والنافعة والناجعةخمسة مبادئ أساسية، أولها أن نعي القاعدة الذهبية التي سبق أن وضعها نجيب محفوظ في معرض نصيحته لأديب شاب وهي »القراءة بلا حدود وفي أي اتجاه»، وثانيها أن نعطي أولوية للكتاب الذي نختلف مع مضمونه وتوجهات مؤلفه، وليس الكتاب الذي يوافق رأينا وهوانا، إذ إن الأخير لن يضيف إلينا شيئا كثيرا. وثالثها ألا ندخل إلي القراءة متربصين بالكاتب، إن كنا نعرف من سيرته أننا علي اختلاف فكري معه، أو مع عنوان كتابه إن صدمنا، أو مضمونه إن لم يكن مألوفا لدينا. وهنا يجب أن نفرق بين ثلاثة مواقف أو أدوار: التعقب، والعقاب، والتعقيب، فالأخير هو الذي علينا أن نسلكه، ويكون في صورة نقد بناء لما نطالعه، أما الأول والثاني، فيسقطان القراءة في فخ الثأر والانتقام، وهو ما يفقدها دورها الحقيقي في التنوير.
والمبدأ الرابع هو اليقظة التامة أثناء القراءة من خلال التأمل فيما نقرأه، وإعادة ما لم نفهمه للوهلة الأولي، ووضع الملاحظات في هوامش الكتب، وطرح التساؤلات حول ما نريد أن نستفهم عنه، وإن كانت قراءتنا أكثر عمقا فإنها ستساعدنا علي توليد أفكار جديدة مما نقرؤه، فيها نقد له أو إضافة إليه واستفاضة فيه أو إلهام مستمد منه. ويمكن لمثل هذا القراءة أن تفرض علينا الاستزادة، فقد نقابل أفكارا أو أسماء كتاب أو مصطلحات ومفاهيم تتطلب البحث عنها في كتب أخري.
والمبدأ الخامس هو تنوع القراءة، فالعلوم مفتوحة بعضها علي بعض بلا حد ولا سد ولا انقطاع، ونحن حتي إن أردنا أن نقرأ في مجال فلن نلم به كاملا إلا إذا انفتحنا علي ما يتقاطع معه، وما يحيط به، وما يختلط فيه من معارف، فنكون بهذا كمثل من أراد أن يتخير الجلوس تحت ظل شجرة لكنه يعمل قبلها علي أن يري كل الغابة من عل، حتي يُعيَّن موقعه وموضعه جيدا.
وفق هذه المبادئ الخمسة نجد أمامنا صنفين من القراءة: وظيفية، وتعني أن يقوم القارئ بالاطلاع علي مادة معرفية أو علمية معنية بغية إعداد مادة أخري في الموضوع نفسه أو في مسألة قريبة من هذا، وهو ما يفعله محترفو البحث العلمي والكتابة الصحفية أو الأدبية ومعدو الكتب بشكل عام. أما الثانية فيقوم بها قراء هواة شغوفون بالقراءة لأنها تشبع فضولهم إلي المعرفة، أو تمنحهم فرصة لتقضية وقت طيب، وبعضهم يؤمن بأن الكتاب خير جليس أو صديق.
والتعامل مع الكتب يتم وفق معيارين، الأول ينظر إليها حسب أهميتها، فيوزعها علي »كتب عُمد»، وهي تمثل المرجعية الأساسية في كل حقل معرفي، بحيث يكون كل ما يأتي بعدها أقرب إلي شرح وتفسير أو اختصار لها، أو هامش علي متنها، وحاشية علي مجراها الأصلي، حتي لو انطوي علي محاولات بسيطة لإتمام ما ينقصها أو إجلاء الغامض فيها، وهذا هو وضع الكتب الثانوية. والمعيار الثاني هو توزيع الكتب حسب المضمون، لنجد منها ما يغذي معارفنا ويعزز طريقتنا في التفكير أو يمدنا بطرق أخري جديدة، ومنها ما يعطينا معلومات إضافية. والميل إلي النوع الأول أهم وأجدي بالطبع.
ويوجد اتجاهان للقراءة، الأول أفقي حيث يرحل القارئ عرضيا في الكتب متنقلا من مجال إلي آخر دون ترتيب أو وفق برنامج محدد. أما الثاني فهو اختيار مسألة، ولو صغيرة، ثم البحث في الكتب عما يعمق فهمها، في حال أشبه بالحفر المعرفي المدروس.
وعلينا في النهاية أن نكون متسامحين مع الكتب، أي نبتعد عن القراءة البيوجرافية التي تذهب إلي الكتاب بحمولات ذهنية مسبقة عن كاتبه، وفق الحكمة السابعة: »يُعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال»، ونقرأ أي كتاب كوحدة معرفية، لا نحاكم الجزء إلا في إطار الكل، ولا نتسرع في بناء رأي عن بعضه حتي نستكمله جميعا.
هذا الصنف من القراء يتراجع في حياتنا بشكل مخيف، لأسباب عدة، علي رأسها نظام تعليمي لا يصنع شغفا بالقراءة في نفوس أبنائنا، وعائلو أسر من أمهات وآباء، لا تحتل القراءة موقعا متقدما في اهتمامهم حين يجلسون ليلا أو نهارا يرتبون طرق تربية ذويهم، وكذلك قيم عميقة تتراجع في معاشنا، بشكل عام، كالصبر والدأب والتأمل والتفتح، لاسيما عند أجيال جديدة، وكلها قيم تعوزها القراءة، مثلما يعوزها تحسين شروط الحياة.
لكن لا تزال هناك استثناءات، وإلا بارت الكتب، وأحبط الكُتَّاب تماما، فجفت أقلامهم، وكسلت قرائحهم، فهاموا في الشوارع يضربهم الجنون، أو تجاسروا علي جوعهم للكتابة وانصرفوا للبحث عن مهن أخري، وهي، ومهما ارتقت في مراتبها الاجتماعية وارتفع ما تغله من مال، لن تشفي غليلهم، وليس بوسعها أن تغنيهم أبدا عن الكتابة، حتي لو ابتعدت الشقة بينهم وبينها إلي أقصي الأرض.
يعد »إبراهيم عادل» وهو كاتب بديع لكنه يقدم نفسه دوما علي أنه قارئ نهم، مثلا ناصعا علي هذا الاستثناء، وهو مثل عميق لديه إلي درجة أن دفعه لنشر كتاب بعنوان »أن تعيش فتقرأ»، في تناص مع كتاب ماركيز »أن تعيش لتروي»، لكنه استبدل »ما يروي» بوصفه كتابة، بما »يطالع» باعتباره قراءة، ومن لهفه لم يترك »لام التعليل» علي حالها، إنما وضع مكانها »فاء السرعة»، فإن كان ماركيز يحتاج إلي ما يبرهن به علي سبب عيشه، فإن إبراهيم، لا وقت لديه لبرهنة أو تقديم حجة في هذا الاتجاه، إذ تسارع القراءة حتي تقتحم حياته، ولا تترك له وقتا ليسأل نفسه: لماذا أقرأ؟
ويوجه الكاتب/ القارئ كتابه هذا إلي صديقة، تشاركه الشغف بالقراءة، فيأتي في صيغة رسالة طويلة متدفقة، لا تقطعها العناوين المتتابعة، ولا اللجوء إلي اقتباسات واقتطافات، من هنا وهناك، ولا يعطبها التمهل قليلا من أجل التأمل في كل ما قرأه، ومشاكسته، ومساءلته، وتقليبه علي وجوه عدة، وهو يغوص من المظاهر إلي الجواهر، ومن القشور إلي اللباب.
إن القراءة هنا، بالنسبة لصاحبها، هي طريقة عيش، لا غني عنها، ولا تصور لمفارقتها يوما، بل هي داء مقيم، ليس بوسع من حل بجسده أن يخفف من الألم الذي يسببه سوي بالنظر الطويل في سطور الكتب، وهنا يقول: »لكل منا طريقته التي يرتضي العيش بها، وأنا لا أعلم من غرس فيَّ تحديدا هذا الداء حتي استشري، واستفحل أمره. كنت أود لو أن فعلا كالقراءة يكافئون الناس عليه، ويقيمون له مهرجانات حقيقية لا صورية، لكنت حزت مراكز متقدمة ولا شك».
لكن ليس كل القراء سواء، حتي لو تشابه شغفهم بالقراءة أو تطابق، لأن الكتب ليست سواء، لاسيما في زمن تقذف فيها المطابع الكثير من الغث، والقليل من السمين، ويغلب فيه الأدعياء الأولياء، وتصعد الشعبوية في عالم الثقافة، مثلما صعدت في عوالم أخري، منتقلة من الأطراف إلي القلب، ومن الهامش إلي المتن. وأدي هذا بالتبعية إلي خلق طلب كبير علي الكتب العابرة والعارضة والسطحية والمتعجلة، التي تلبي احتياجات جمهور يسعي وراء ما يسليه، ويثير غرائزه، ويخاطبه علي قدر عقله، الذي له حظ ضئيل من المعرفة، أو يواكب إيقاع زمن سريع، وحياة متقلبة، تتدفق بلا هوادة، قاطعة الأمكنة والأزمنة في يسر، وبلا حدود.
والآفة أن كثيرا من الناشرين ناداهم هذا الجمهور بهمس خفي، أو بصوت جهور، فاستجابوا له طائعين كتجار مخلصين للربح قبل الرسالة، بل إنهم شاركوا قطاعا منه إفكا متأصلا يتحدث طيلة الوقت عن »الأكثر مبيعا» ولا يريد أن يتوقف عند »الأقوي تأثيرا» و »الأقدر بقاء»، حتي لو استعنا عليهم بالآية الكريمة: »فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ».
مثل هذا الجمهور سيقف متعجبا من قول إبراهيم في كتابه الصادر عن »دار أجيال»: »درنا في حيرة، هل نبدأ بالأساتذة الكبار القدماء والجاهليين، ومن تبعهم بإحسان، أما من تلاهم من عصور حتي نصل إلي العصر الحديث، أن يستقر بنا المقام والمطاف إلي معاصرينا، هؤلاء الذين يتقافزون أو تتقافز كتاباتهم أمامنا كالبهلوانات»، فالجمهور الذي أعنيه هنا، لا يعرف من هؤلاء »الكبار»، ولا يعطي نفسه فرصة للبحث عنهم، وبعضه ينساق وراء العبارة المصكوكة منذ زمن »جيل بلا أساتذة»، وبعضه تبدو لغة القدماء مستغلقة علي فهمه، فيجري منها كما يجري السليم من الأجرب.
وحتي القارئ الجاد، الساعي وراء الراسخ والعميق والمقيم، لن يكون بوسعه أن يقرأ كل شيء مكتوبا بلغتنا العربية أو مترجما عن لغات أخري، سواء كان مطبوعا أو إلكترونيا، وهي مسألة أثارت تساؤل إبراهيم: »لا أعلم كيف يتسني لنا أن نفرح بكتب وكتابة جديدة وأمامنا هذه الأعداد المهولة من الكتب والكتاب، لم نستكشفها، ولم نعرفها بعد؟!»، وهو هنا يعبر عن قراء، بل كتاب، كثيرا ما يبوحون لنا بأنهم يقفون حائرين بالفعل أمام أرفف مكتباتهم العامرة، لا يعرفون بأي كتاب يبدأون الآن، ومتي ستنتهي بهم القراءة، وكيف أنهم يحتاجون إلي أعمار فوق أعمارهم حتي يقرأوا كل الذي يروق لهم، إن تغلبوا عن مطاردة ما تعرضه أمامهم وسائط التواصل الاجتماعي علي شبكة الإنترنت من مقولات ونقولات وصور ورسوم، أذابت الكثير من التخوم التاريخية بين منتج المعرفة وناقلها.
إن صاحب هذا الكتاب، وهو أيضا قاص وناقد، يقدم لنا مثلا مبهرا عن قارئ مخلص، يسعي دوما وراء كل ثمين وسمين ونفيس، مؤمنا بأن حياته لا يمكن لها أن تستقر وتستقيم من غير صبر وجلد ودأب وشغف بالكتب، في مجتمع بات في أمس الحاجة إلي تعميم مثل هذه الحالة، أو اندياح ذلك النموذج، حتي يخرج من ضيق الآني إلي براح الآتي.
د. عمار علي حسن
5/11/2019 11:30:55 AM
* في أصناف القراءة والقراء
أفهم أن تعطي الفطرة السليمة، والقريحة المتوقدة، والذاكرة الطازجة، شخصا يمسك بالقلم، فرصة هائلة كي يكتب نصا فريدا، سردا كان أو شعرا، أدبا أو فكرا، يضع فيه كل انفعالاته ومواجيده وانشغالاته وتصوراته وخبراته الذاتية، لكن إمكانية تحول هذا الشخص إلي كاتب صاحب مشروع، بصرف النظر عن النوع الذي يكتبه، يتطلب حيازة معرفة، لا يسلم بها، ويستسلم لها، ويعمل ويعمد إلي تكرارها وترديدها أو اجترارها، إنما يقوم بإمعان النظر فيها، يتأملها علي مهل، وينقدها، ويضيف إليها، ويتجنب مزالقها، ويستر عوراتها، ويسد فراغاتها، فيفتح أمامها بابا واسعا للنمو والتكاثر والانتشار.
والقراءة المتواصلة المتأصلة تجعل الكاتب قادرا علي تقييم ما ينتجه من خلال وضعه في مضاهاة مع ما ينتجه غيره، فبضدها تتميز الأشياء، ثم قياسه علي ما خلفه السابقون علي درب الكتابة، ليس لتقليدهم، أو اتباع خطاهم دون زحزحة يمنة أو يسرة، إنما لتوسيع هذا الدرب، وترسيخه، حتي تتقدم الكتابة دوما نحو اجتياز حواجز، وارتياد مناطق مجهولة، وانطلاق إلي آفاق رحبة.
لكن ليست كل قراءة تؤدي بالضرورة عند جميع البشر هذه الوظيفة، فأغلب القراء ليسوا بكتاب، ولو تساوي الطرفان عددا لصرنا أمام مشكلة عويصة، إذ لا يمكن لحياة ثقافية أن تمضي قوية عفية في ظل ندرة في القراء، ووفرة في الكُتَّاب، لاسيما إن كان أغلب من يطلقون علي أنفسهم كتابا لا يلبون الحد الأدني من الشروط المتعارف عليها، كي يحملوا هذه الصفة، التي أراها، بحق، عظيمة نبيلة.
وكل كاتب يقصد بالأساس أولئك القراء الذين يطالعون الكتب، بحثا عن متعة وفائدة، ويهيم أكثر بأولئك الذين يدمنون القراءة، فإن مر يوم دونها يحسبه هؤلاء أنه قد ذهب سدي، وإن أتي الليل وعيونهم لم تصافح كتابا، جافاها النوم، أو نامت مع لوم شديد للنفس، ووعد بالتعويض في الغد، ولا انفكاك إلا بفعل هذا، ليخبو التوتر، وتهدأ الخواطر، وتستكين الأنفس المتعطشة للمعرفة والعلم.
يجب ابتداء، أن تحكم مسار القراءة الناجزة والنافعة والناجعةخمسة مبادئ أساسية، أولها أن نعي القاعدة الذهبية التي سبق أن وضعها نجيب محفوظ في معرض نصيحته لأديب شاب وهي »القراءة بلا حدود وفي أي اتجاه»، وثانيها أن نعطي أولوية للكتاب الذي نختلف مع مضمونه وتوجهات مؤلفه، وليس الكتاب الذي يوافق رأينا وهوانا، إذ إن الأخير لن يضيف إلينا شيئا كثيرا. وثالثها ألا ندخل إلي القراءة متربصين بالكاتب، إن كنا نعرف من سيرته أننا علي اختلاف فكري معه، أو مع عنوان كتابه إن صدمنا، أو مضمونه إن لم يكن مألوفا لدينا. وهنا يجب أن نفرق بين ثلاثة مواقف أو أدوار: التعقب، والعقاب، والتعقيب، فالأخير هو الذي علينا أن نسلكه، ويكون في صورة نقد بناء لما نطالعه، أما الأول والثاني، فيسقطان القراءة في فخ الثأر والانتقام، وهو ما يفقدها دورها الحقيقي في التنوير.
والمبدأ الرابع هو اليقظة التامة أثناء القراءة من خلال التأمل فيما نقرأه، وإعادة ما لم نفهمه للوهلة الأولي، ووضع الملاحظات في هوامش الكتب، وطرح التساؤلات حول ما نريد أن نستفهم عنه، وإن كانت قراءتنا أكثر عمقا فإنها ستساعدنا علي توليد أفكار جديدة مما نقرؤه، فيها نقد له أو إضافة إليه واستفاضة فيه أو إلهام مستمد منه. ويمكن لمثل هذا القراءة أن تفرض علينا الاستزادة، فقد نقابل أفكارا أو أسماء كتاب أو مصطلحات ومفاهيم تتطلب البحث عنها في كتب أخري.
والمبدأ الخامس هو تنوع القراءة، فالعلوم مفتوحة بعضها علي بعض بلا حد ولا سد ولا انقطاع، ونحن حتي إن أردنا أن نقرأ في مجال فلن نلم به كاملا إلا إذا انفتحنا علي ما يتقاطع معه، وما يحيط به، وما يختلط فيه من معارف، فنكون بهذا كمثل من أراد أن يتخير الجلوس تحت ظل شجرة لكنه يعمل قبلها علي أن يري كل الغابة من عل، حتي يُعيَّن موقعه وموضعه جيدا.
وفق هذه المبادئ الخمسة نجد أمامنا صنفين من القراءة: وظيفية، وتعني أن يقوم القارئ بالاطلاع علي مادة معرفية أو علمية معنية بغية إعداد مادة أخري في الموضوع نفسه أو في مسألة قريبة من هذا، وهو ما يفعله محترفو البحث العلمي والكتابة الصحفية أو الأدبية ومعدو الكتب بشكل عام. أما الثانية فيقوم بها قراء هواة شغوفون بالقراءة لأنها تشبع فضولهم إلي المعرفة، أو تمنحهم فرصة لتقضية وقت طيب، وبعضهم يؤمن بأن الكتاب خير جليس أو صديق.
والتعامل مع الكتب يتم وفق معيارين، الأول ينظر إليها حسب أهميتها، فيوزعها علي »كتب عُمد»، وهي تمثل المرجعية الأساسية في كل حقل معرفي، بحيث يكون كل ما يأتي بعدها أقرب إلي شرح وتفسير أو اختصار لها، أو هامش علي متنها، وحاشية علي مجراها الأصلي، حتي لو انطوي علي محاولات بسيطة لإتمام ما ينقصها أو إجلاء الغامض فيها، وهذا هو وضع الكتب الثانوية. والمعيار الثاني هو توزيع الكتب حسب المضمون، لنجد منها ما يغذي معارفنا ويعزز طريقتنا في التفكير أو يمدنا بطرق أخري جديدة، ومنها ما يعطينا معلومات إضافية. والميل إلي النوع الأول أهم وأجدي بالطبع.
ويوجد اتجاهان للقراءة، الأول أفقي حيث يرحل القارئ عرضيا في الكتب متنقلا من مجال إلي آخر دون ترتيب أو وفق برنامج محدد. أما الثاني فهو اختيار مسألة، ولو صغيرة، ثم البحث في الكتب عما يعمق فهمها، في حال أشبه بالحفر المعرفي المدروس.
وعلينا في النهاية أن نكون متسامحين مع الكتب، أي نبتعد عن القراءة البيوجرافية التي تذهب إلي الكتاب بحمولات ذهنية مسبقة عن كاتبه، وفق الحكمة السابعة: »يُعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال»، ونقرأ أي كتاب كوحدة معرفية، لا نحاكم الجزء إلا في إطار الكل، ولا نتسرع في بناء رأي عن بعضه حتي نستكمله جميعا.
هذا الصنف من القراء يتراجع في حياتنا بشكل مخيف، لأسباب عدة، علي رأسها نظام تعليمي لا يصنع شغفا بالقراءة في نفوس أبنائنا، وعائلو أسر من أمهات وآباء، لا تحتل القراءة موقعا متقدما في اهتمامهم حين يجلسون ليلا أو نهارا يرتبون طرق تربية ذويهم، وكذلك قيم عميقة تتراجع في معاشنا، بشكل عام، كالصبر والدأب والتأمل والتفتح، لاسيما عند أجيال جديدة، وكلها قيم تعوزها القراءة، مثلما يعوزها تحسين شروط الحياة.
لكن لا تزال هناك استثناءات، وإلا بارت الكتب، وأحبط الكُتَّاب تماما، فجفت أقلامهم، وكسلت قرائحهم، فهاموا في الشوارع يضربهم الجنون، أو تجاسروا علي جوعهم للكتابة وانصرفوا للبحث عن مهن أخري، وهي، ومهما ارتقت في مراتبها الاجتماعية وارتفع ما تغله من مال، لن تشفي غليلهم، وليس بوسعها أن تغنيهم أبدا عن الكتابة، حتي لو ابتعدت الشقة بينهم وبينها إلي أقصي الأرض.
يعد »إبراهيم عادل» وهو كاتب بديع لكنه يقدم نفسه دوما علي أنه قارئ نهم، مثلا ناصعا علي هذا الاستثناء، وهو مثل عميق لديه إلي درجة أن دفعه لنشر كتاب بعنوان »أن تعيش فتقرأ»، في تناص مع كتاب ماركيز »أن تعيش لتروي»، لكنه استبدل »ما يروي» بوصفه كتابة، بما »يطالع» باعتباره قراءة، ومن لهفه لم يترك »لام التعليل» علي حالها، إنما وضع مكانها »فاء السرعة»، فإن كان ماركيز يحتاج إلي ما يبرهن به علي سبب عيشه، فإن إبراهيم، لا وقت لديه لبرهنة أو تقديم حجة في هذا الاتجاه، إذ تسارع القراءة حتي تقتحم حياته، ولا تترك له وقتا ليسأل نفسه: لماذا أقرأ؟
ويوجه الكاتب/ القارئ كتابه هذا إلي صديقة، تشاركه الشغف بالقراءة، فيأتي في صيغة رسالة طويلة متدفقة، لا تقطعها العناوين المتتابعة، ولا اللجوء إلي اقتباسات واقتطافات، من هنا وهناك، ولا يعطبها التمهل قليلا من أجل التأمل في كل ما قرأه، ومشاكسته، ومساءلته، وتقليبه علي وجوه عدة، وهو يغوص من المظاهر إلي الجواهر، ومن القشور إلي اللباب.
إن القراءة هنا، بالنسبة لصاحبها، هي طريقة عيش، لا غني عنها، ولا تصور لمفارقتها يوما، بل هي داء مقيم، ليس بوسع من حل بجسده أن يخفف من الألم الذي يسببه سوي بالنظر الطويل في سطور الكتب، وهنا يقول: »لكل منا طريقته التي يرتضي العيش بها، وأنا لا أعلم من غرس فيَّ تحديدا هذا الداء حتي استشري، واستفحل أمره. كنت أود لو أن فعلا كالقراءة يكافئون الناس عليه، ويقيمون له مهرجانات حقيقية لا صورية، لكنت حزت مراكز متقدمة ولا شك».
لكن ليس كل القراء سواء، حتي لو تشابه شغفهم بالقراءة أو تطابق، لأن الكتب ليست سواء، لاسيما في زمن تقذف فيها المطابع الكثير من الغث، والقليل من السمين، ويغلب فيه الأدعياء الأولياء، وتصعد الشعبوية في عالم الثقافة، مثلما صعدت في عوالم أخري، منتقلة من الأطراف إلي القلب، ومن الهامش إلي المتن. وأدي هذا بالتبعية إلي خلق طلب كبير علي الكتب العابرة والعارضة والسطحية والمتعجلة، التي تلبي احتياجات جمهور يسعي وراء ما يسليه، ويثير غرائزه، ويخاطبه علي قدر عقله، الذي له حظ ضئيل من المعرفة، أو يواكب إيقاع زمن سريع، وحياة متقلبة، تتدفق بلا هوادة، قاطعة الأمكنة والأزمنة في يسر، وبلا حدود.
والآفة أن كثيرا من الناشرين ناداهم هذا الجمهور بهمس خفي، أو بصوت جهور، فاستجابوا له طائعين كتجار مخلصين للربح قبل الرسالة، بل إنهم شاركوا قطاعا منه إفكا متأصلا يتحدث طيلة الوقت عن »الأكثر مبيعا» ولا يريد أن يتوقف عند »الأقوي تأثيرا» و »الأقدر بقاء»، حتي لو استعنا عليهم بالآية الكريمة: »فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ».
مثل هذا الجمهور سيقف متعجبا من قول إبراهيم في كتابه الصادر عن »دار أجيال»: »درنا في حيرة، هل نبدأ بالأساتذة الكبار القدماء والجاهليين، ومن تبعهم بإحسان، أما من تلاهم من عصور حتي نصل إلي العصر الحديث، أن يستقر بنا المقام والمطاف إلي معاصرينا، هؤلاء الذين يتقافزون أو تتقافز كتاباتهم أمامنا كالبهلوانات»، فالجمهور الذي أعنيه هنا، لا يعرف من هؤلاء »الكبار»، ولا يعطي نفسه فرصة للبحث عنهم، وبعضه ينساق وراء العبارة المصكوكة منذ زمن »جيل بلا أساتذة»، وبعضه تبدو لغة القدماء مستغلقة علي فهمه، فيجري منها كما يجري السليم من الأجرب.
وحتي القارئ الجاد، الساعي وراء الراسخ والعميق والمقيم، لن يكون بوسعه أن يقرأ كل شيء مكتوبا بلغتنا العربية أو مترجما عن لغات أخري، سواء كان مطبوعا أو إلكترونيا، وهي مسألة أثارت تساؤل إبراهيم: »لا أعلم كيف يتسني لنا أن نفرح بكتب وكتابة جديدة وأمامنا هذه الأعداد المهولة من الكتب والكتاب، لم نستكشفها، ولم نعرفها بعد؟!»، وهو هنا يعبر عن قراء، بل كتاب، كثيرا ما يبوحون لنا بأنهم يقفون حائرين بالفعل أمام أرفف مكتباتهم العامرة، لا يعرفون بأي كتاب يبدأون الآن، ومتي ستنتهي بهم القراءة، وكيف أنهم يحتاجون إلي أعمار فوق أعمارهم حتي يقرأوا كل الذي يروق لهم، إن تغلبوا عن مطاردة ما تعرضه أمامهم وسائط التواصل الاجتماعي علي شبكة الإنترنت من مقولات ونقولات وصور ورسوم، أذابت الكثير من التخوم التاريخية بين منتج المعرفة وناقلها.
إن صاحب هذا الكتاب، وهو أيضا قاص وناقد، يقدم لنا مثلا مبهرا عن قارئ مخلص، يسعي دوما وراء كل ثمين وسمين ونفيس، مؤمنا بأن حياته لا يمكن لها أن تستقر وتستقيم من غير صبر وجلد ودأب وشغف بالكتب، في مجتمع بات في أمس الحاجة إلي تعميم مثل هذه الحالة، أو اندياح ذلك النموذج، حتي يخرج من ضيق الآني إلي براح الآتي.
د. عمار علي حسن
5/11/2019 11:30:55 AM
* في أصناف القراءة والقراء