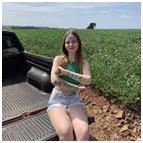تسكن اللغة، قلب هوية الشعوب ومقاومتها للمشاريع الكولونيالية. غير، أن العربي، يتميز بخصوصية “تأرجحه”، بين اللغة الكلاسيكية ولهجات محلية، أحيانا غير مفهومة لبعضها البعض. فهل، بوسعنا أن نصنع من هذه الثنائية غنى وقوة ؟
كيف نتكلم ونكتب العربية ؟ السؤال خطير إلى حد ما، تحكمه عوامل إيديولوجية، لا صلة لها بالتجربة الحية لهذه اللغة في علاقتها بمتكلميها الأصليين. لا أعرف، مصدر هذا التصور الذي يؤكد بأن العربي، يجسد أساسا عنفا مرعبا وغير مفهوم. هكذا لم يكن عبثا، أن أثث أشرار بعمائم شاشات هوليود طيلة سنوات 1940 و 1950، فيتكلمون عن ضحاياهم بنبرة جارحة وبنوع من التلذذ السادي. ومما ساعد أيضا مؤخرا على هذا المنحى، تركيز وسائل الإعلام الأمريكية على الإرهاب، الذي أرجع كل شيء إلى العرب.
يعود تاريخ، البلاغة والبيان في التقليد الأدبي العربي، إلى عشرات القرون : وبالضبط مع كتّاب بغداد مثل الجاحظ والجرجاني، الذين بنوا أنساقا مذهلة تركيبيا، ومعاصرة بشكل مدهش حتى نفهم البلاغة والبيان والاستعارات. لقد، ارتكز، عملهم على العربية الكلاسيكية المكتوبة، دون المتداولة شفويا كل يوم. فالأولى قائمة على القرآن الذي أرسى في الآن ذاته، منبعا ونموذجا، لكل ما سيأتي بعده بخصوص المادة اللسانية. تصور كهذا، غير مألوف إلى حد ما لدى مستعملي اللغات الأوروبية الحديثة، بحيث تتطابق لديهم النسختان، الشفوية والأدبية. بالتالي، فقدت الكتابة المقدسة كليّا، سلطتها الفعلية. أما العرب، فالتجأوا إلى توظيف لهجة، تتنوع كثيرا بين المناطق، وكذا من بلد إلى آخر.
ترعرعت وسط أسرة، تكلم أفرادها لغة، تعتبر بمثابة مزيج لما كان سائدا في فلسطين ولبنان وسوريا : هذه اللهجات الثلاث، تكشف بما يكفي عن فروقات، كي يمكننا مثلا، تمييز شخص ينحدر من القدس عن آخر ينتمي إلى بيروت أو دمشق، لكن با ستطاعتهم التواصل دون مجهود كبير.
عندما ذهبت إلى المدرسة في القاهرة، حيث قضيت قسطا مهما من شبابي، تكلمت أيضا ـ وبسلاسة ـ اللهجة المصرية وبشكل أكثر سرعة ولباقة، مقارنة مع تلك التي تعلمتها بين أحضان أسرتي. حقا، كانت اللهجة المصرية منتشرة جدا : تقريبا جميع الأفلام العربية والدراما الإذاعية والمسلسلات التلفزية، أُنتجت داخل مصر مما جعل هذه المنظومة التعبيرية معروفة عند ساكنة العالم العربي.
خلال سنوات 1970 و 1980، دفع الارتفاع المفاجئ لأسعار البترول، بلدانا أخرى كي تفكر بدورها في إنتاج دراما متلفزة، وهذه المرة بالعربية الكلاسيكية. سياق، أفرز أعمالا متنكرة ومتكلّفة ومُنهِكة، اُفترض معها الاستجابة لأذواق المسلمين (ومسيحيين محافظين، بشكل عام أكثرهم تزمتا)، لكنها أخفقت في تحويل أنظارنا عن أفلام القاهرة المفعمة موهبة، فقد بدت جد مضجرة ! أما المسلسل المصري، الذي تم توضيبه بسرعة، فكان يدخل البهجة علينا، أفضل من الإنتاجات الدرامية المحكمة جيدا في اللغة الكلاسيكية.
إجمالا، من بين كل اللهجات، وحدها المصرية عرفت انتشارا واضحا. في المقابل، سأواجه كل صعوبات العالم كي أفهم جزائريا، فالاختلاف شاسع بما يكفي، بين لهجات المشرق وكذا المغرب. نفس الوضع سأعيشه مع عراقي أو أيضا متحدث تطغى عليه لكنة خليجية. لذلك، توظف النشرات الإخبارية الإذاعية و المتلفزة، لغة حديثة مُعدلة عن الكلاسيكية، تُفهم على امتداد جغرافية العالم العربي من الخليج إلى المغرب، سواء تعلق الأمر بسجالات وبرامج وثائقية ولقاءات وندوات ومواعظ المسجد وتلك الخطابات التي تسود اجتماعات الوطنيين أو التجمعات اليومية بين مواطنين يتكلمون لغات مختلفة جدا.
على غرار اللاتينية، بالنسبة للهجات الأوروبية المتكلَّمة إلى حدود القرن الماضي، بقيت فعلا العربية الكلاسيكية حاضرة بثقل، كلغة مشتركة للكتابة، بالرغم من المنابع الهائلة لسلسلة من اللهجات السائدة، التي باستثناء المصرية، لم تنتشر خارج بلدانها المعتادة. أيضا، هي لهجات تفتقد، لرحابة الأدب العربي الكلاسيكي.
لكن، الكُتّاب الذين يُنعتون بأنهم “محليون” ينزعون إلى استعمال لغة كلاسيكية مُعصرنة، ولا يستدعون إلا مؤقتا العربية المحلية. عمليا، شخص متعلم يمتلك رافدين لسانيين جد متميزين. إلى حد، مثلا، أنك قد تثرثر باللهجة المحلية مع محقق صحفي، يشتغل لحساب جريدة أو التلفزة، لكن فجأة، حينما يبدأ التسجيل، سينتقل دون مقدمات إلى اللغة الكلاسيكية، التي هي جوهريا أكثر تعقيدا وتنقيحا.
هناك بالتأكيد، صلة بين اللسانين : غالبا، الحروف متماثلة وكذا نظام الكلمات. لكن، يختلف التلفظ والمصطلحات، في نطاق كون العربية الكلاسيكية، النص النموذجي للغة تفقد كل أثر للهجة الإقليمية، وتبرز كأداة رنّانة، تعدّلت طبقاتها بعناية، إنها رفيعة ومرنة بشكل مذهل، بحيث تسمح صيغها بفصاحة معتبرة.
إن العربية الكلاسيكية، المشتغلة بطريقة سليمة، ليس لها نظيرا على مستوى دقة العبارة والكيفية المدهشة التي بواسطتها تمكن تغيرات الحروف الذاتية لكلمة (لاسيما النهايات) من بلورة أشياء متباينة جدا.
أيضا هي لغة، مضبوطة بلا مثيل، قياسا للثقافة العربية: مثلما كتب ياغوسلاف ستيكيفتش Jaroslav Stekevych، والذي خصص لها أفضل دراسة في العهد الحديث[2] : ((إنها مثل فينوس Vénus، لقد انبثقت في إطار حالة من الجمال التام، ثم احتفظت به على الرغم من طوارئ الزمان وإكراهاته)). بالنسبة للطالب الغربي : ((توحي العربية، بفكرة انجذاب تشبه الرياضيات تقريبا. النظام الممتاز للصوامت الثلاثة ذات الجذر الكيميائي، والأشكال المتنامية للأفعال مع دلالاتها القاعدية، ثم التشكل الدقيق لاسم الفاعل واسم المفعول. كل شيء واضح ومنطقي وممنهج ومجرد)). كذلك، هي جميلة، حينما نتأملها في صورتها المكتوبة. من هنا، الدور المحوري والدائم لفن الخط. فن تركيبي، يتميز بأعلى درجات التعقيد، ويدنو من الزخرفة والأرابيسك، أكثر من التفسير الاستدلالي.
خلال الأيام الأولى، لحرب أفغانستان سنة 2001، قدمت قناة الجزيرة، نقاشات وروبورتاجات، لا نجدها في وسائل الإعلام الأمريكية. وما كان مثيرا للانتباه، غير مضمون المادة المعروضة بالرغم من تعقد الإشكالات المطروحة، ذاك المستوى العالي لبلاغة المشاركين في الجدالات، مع حيثيات أسوأ الصعوبات وأفظعها. حتى السيد أسامة بن لادن، كان يتكلم بصوت خافت دون تلعثم أو ارتكابه لأقل زلة، مما خدم حتما تأثيره. نفس الأمر، انطبق أيضا، وإن في نطاق أقل، على غير العرب وبالضبط شخصيات أفغانية أمثال “برهان الدين رباني”، و”قلب الدين حكمتيار”، والذين مع عدم إتقانهم العربية، فقد تحدثوا اللسان الكلاسيكي بطلاقة مدهشة.
بالتأكيد، ما نسميه العربية الحديثة المعيارية (أو الكلاسيكية) ليست بالضبط، تلك التي جاء بها القرآن منذ أربعة عشر قرنا. ومع أن الكتاب المقدس، ظل نصا خاضعا للبحث والتمحيص، فإن لغته تبدو عتيقة بل مغالية. لذا، يتعذر استعمالها في كل الأوقات. ومقارنة بالنثر الحديث، فهي لغة تتوفر على مسالك القصيدة الرنانة.
إن العربية الكلاسيكية التي خضعت للتطور، تعتبر حصيلة مسار ابتدأ مع العقود الأخيرة من القرن19 ـ فترة النهضة ـ بفضل عمل مجموعة من الأسماء تواجدت بسوريا ولبنان وفلسطين ومصر (عدد كبير منهم ينتمي للطائفة المسيحية) ، انكبوا جماعة على تغيير اللغة العربية بتعديل وتبسيط بوجه من الأوجه، للمكون التركيبي لنسخة القرن السابع عن طريق الاستعراب : يتعلق الأمر بإدخال كلمات مثل : “قطار”، “شركة”، “ديمقراطية”أو “اشتراكية”، وهي طبعا لم تكن موجودة إبان الفترة الكلاسيكية. كيف ذلك ؟ بالعودة إلى المصادر الضخمة للغة، اعتمادا على الإجراء النحوي التقني للقياس. هؤلاء الأشخاص، أسسوا قاموسا جديدا كليا، يمثل ما يقارب %60 من اللغة الكلاسيكية المعيارية. كذلك، حققت النهضة تحريرا للنصوص الدينية، بأن أدخلت ضمنيا لائكية جديدة، بخصوص ما يقوله العرب ويكتبونه.
النحو العربي معقد للغاية، و أيضا جذاب بمنطقة، بحيث أن تلميذا متقدما في السن، بوسعه استيعابه بسهولة واضحة، مادام يمكنه تقدير الحدود الدقيقة لاستدلالات هذا النحو. وفي معاهد لسانية، تنتمي إلى مصر وتونس وسوريا ولبنان وكذا فيرمون Vermont، نعثر على أفضل منظومة تعليمية للعربية، تقدم لغير العرب.
حينما، أجبرتني الحرب العربية ـ الإسرائيلية سنة 1967، على الالتزام سياسيا، وإن على بعد، فقد تنبهت قبل كل شيء للحقيقة التالية: لم تستند السياسة على العامية أو العربية المحلية، لغة الجمهور الواسع، بل توخت في أغلب الأحيان الفصحى أو اللغة الصارمة شكليا، فأدركتُ على الفور، بأنه يتم تقديم تحليلات سياسية إلى التجمعات واللقاءات، توحي بعمق غير ما هي عليه في واقع الأمر.
اكتشفت بخيبة أمل كبيرة، أن ذلك ينطبق على المقاربات التي تضمنتها رطانة الماركسيين وكذا حركات التحرر خلال الحقبة، تعريفات: الطبقات، المصالح المادية، رأسمال، وكذا الحركة العمالية، فقد نُقلت إلى العربية ووجهت عبر مونولوجات طويلة، ليس إلى الشعب، بل مناضلين آخرين أكثر دراية.
بشكل خاص، فإن رموزا جماهيرية مثل ياسر عرفات وجمال عبد الناصر، واللذان جمعتني بهما لقاءات ، فقد استثمرا جيدا اللغة المحلية، بطريقة تفوقت على الماركسيين، مع أن مناضلي هذا التيار كانوا أفضل ثقافة من القائدين. عبد الناصر، تحديدا، خاطب حشود مناصريه باللهجة المصرية إلى جانب جمل صاخبة من اللغة الفصحى. لكن ياسر عرفات، وبما أن البيان في العربية، يتوقف على المنسوب الدراماتيكي، فقد كانت له شهرة خطيب تحت المعدل : أخطاؤه التلفظية، تلعثمه، وموارباته وتلميحاته غير الموفقة، ستظهر بالنسبة لأذن شخص مطلع ، مثل فيل يتجول داخل متجر للخزف الصيني.
تعتبر جامعة الأزهر بالقاهرة، من أقدم معاهد التدريس العالي، في العالم. ثم صارت، مقرا للأرتودوكسية الإسلامية، فرئيس هذه الجامعة يمثل السلطة الدينية الأولى في مصر السنية. أيضا، الأزهر يلقن ـ أساسا وليس استثناء ـ معرفة إسلامية، جوهرها القرآن وكذا مختلف ما يدخل في إطار مناهج التأويل والقضاء والحديث واللغة والنحو.
إتقان الغة الكلاسيكية، يتموضع إذن، عند نواة الثقافة الإسلامية في الأزهر، سواء للعرب والمسلمين. القرآن، في نظر المسلمين بمثابة كلام الله الذي أنزل على محمد عبر سلسلة الوحي، بالتالي، لغته مقدسة تتضمن قواعد ونماذج إجبارية بالنسبة لمن تسري عليهم. ولأنها لغة مفارقة، فلا يمكنهم قط نظرا لإعجازها، التمكن من تقليدها.
ما يقارب ستون سنة، ونحن نستمع إلى الخطباء، ونتعقّب بشكل دائم تصحيح لغتهم، قدر ما ينتجونه من كلام. عندما ألقيت أول خطاب بالعربية في القاهرة، منذ عقدين من الزمان، اقترب مني أحد أقاربي الشباب بعد الانتهاء كي يخبرني بتذمره، لأني لم أكن فصيحا : ((هل استوعبت ما قلته لك))، سألني، بصوت يضمر معاني الأنين. لقد تركز اهتمامي لحظتها على توضيح بعض المحاور الحساسة سياسيا وفلسفيا : ((نعم، بالتأكيد، أجابني بنبرة الاستخفاف، لا مشكل، بيد أنك لم تكن بليغا أو خطيبا ما يكفي)). هذه المؤاخذة، ظلت تلاحقني حتى الوقت الحاضر، كلما سعيت إلى مواجهة الجمهور، فأنا عاجز على تقمص صورة الخطيب القوي. أمزج بين تعابير لهجية وكلاسيكية، بطريقة برغماتية، فينتهي ذلك إلى نتائج غير مقنعة. لذلك، صاغوا في حقي ذات مرة، عبارة طريفة، لما شبهوني بشخص يمتلك سيارة رولس رويس Rolls Royce ، لكنه يفضل أخرى من نوع فولكزفاكن Volkswagen.
فقط، في غضون عشرة أو خمس عشرة سنة الأخيرة، اكتشفت ما يلي : إن أهم النصوص النثرية العربية، وأرقاها تمحيصا ودقة، والتي لم يسبق لي أن اطلعت عليها أو سمعت عنها، كتبها روائيون (وليس نقاد) أمثال “إلياس خوري” و “جمال الغيطاني”. أو جاءت من طرف شاعرينا الكبيران، أدونيس ومحمود درويش : لقد أدرك كل واحد منهما في قصائده الغنائية مستويات موسيقية رفيعة جدا، تستهوي عددا هائلا من المستمعين، وهم في قمة الافتتان الهائم.
بالنسبة لتلك الأقلام، فالنثر أداة أرسطوطاليسية حادة مثل شفرة موسى. معرفتهم باللغة هائلة وفطرية جدا. مواهبهم غنية كثيرة، بحيث يعبرون ببلاغة ووضوح، دونما حاجة إلى كلمات حشو وإطناب متعب وزخرف لا طائل من ورائه.
في حين أنا، يستفد من تكوين تحت سقف نظام مدرسي وطني عربي بل “في إطار منظومة كولونيالية”، فيلزمني بذل مجهودات واعية، حتى أخلق جملة عربية كلاسيكية بطريقة صحيحة ومرتبة بشكل معقول، غير أن النتائج ليست دائما ذات قيمة طبقا لمعاني الأناقة.
ينبغي في كل الأحوال، الاعتراف بذلك.
[1] – Edward W. Said : manière de voir n°117, 2011, Page 70/74.
* شغل إدوارد سعيد، منصب أستاذ للأدب المقارن بجامعة كولومبيا (الولايات المتحدة الأمريكية)، وقد توفي شهر شتنبر 2003.
[2] – Reorientation arabic and Per
حكمة | من أجل اجتهاد ثقافي وفلسفي

كيف نتكلم ونكتب العربية ؟ السؤال خطير إلى حد ما، تحكمه عوامل إيديولوجية، لا صلة لها بالتجربة الحية لهذه اللغة في علاقتها بمتكلميها الأصليين. لا أعرف، مصدر هذا التصور الذي يؤكد بأن العربي، يجسد أساسا عنفا مرعبا وغير مفهوم. هكذا لم يكن عبثا، أن أثث أشرار بعمائم شاشات هوليود طيلة سنوات 1940 و 1950، فيتكلمون عن ضحاياهم بنبرة جارحة وبنوع من التلذذ السادي. ومما ساعد أيضا مؤخرا على هذا المنحى، تركيز وسائل الإعلام الأمريكية على الإرهاب، الذي أرجع كل شيء إلى العرب.
يعود تاريخ، البلاغة والبيان في التقليد الأدبي العربي، إلى عشرات القرون : وبالضبط مع كتّاب بغداد مثل الجاحظ والجرجاني، الذين بنوا أنساقا مذهلة تركيبيا، ومعاصرة بشكل مدهش حتى نفهم البلاغة والبيان والاستعارات. لقد، ارتكز، عملهم على العربية الكلاسيكية المكتوبة، دون المتداولة شفويا كل يوم. فالأولى قائمة على القرآن الذي أرسى في الآن ذاته، منبعا ونموذجا، لكل ما سيأتي بعده بخصوص المادة اللسانية. تصور كهذا، غير مألوف إلى حد ما لدى مستعملي اللغات الأوروبية الحديثة، بحيث تتطابق لديهم النسختان، الشفوية والأدبية. بالتالي، فقدت الكتابة المقدسة كليّا، سلطتها الفعلية. أما العرب، فالتجأوا إلى توظيف لهجة، تتنوع كثيرا بين المناطق، وكذا من بلد إلى آخر.
ترعرعت وسط أسرة، تكلم أفرادها لغة، تعتبر بمثابة مزيج لما كان سائدا في فلسطين ولبنان وسوريا : هذه اللهجات الثلاث، تكشف بما يكفي عن فروقات، كي يمكننا مثلا، تمييز شخص ينحدر من القدس عن آخر ينتمي إلى بيروت أو دمشق، لكن با ستطاعتهم التواصل دون مجهود كبير.
عندما ذهبت إلى المدرسة في القاهرة، حيث قضيت قسطا مهما من شبابي، تكلمت أيضا ـ وبسلاسة ـ اللهجة المصرية وبشكل أكثر سرعة ولباقة، مقارنة مع تلك التي تعلمتها بين أحضان أسرتي. حقا، كانت اللهجة المصرية منتشرة جدا : تقريبا جميع الأفلام العربية والدراما الإذاعية والمسلسلات التلفزية، أُنتجت داخل مصر مما جعل هذه المنظومة التعبيرية معروفة عند ساكنة العالم العربي.
خلال سنوات 1970 و 1980، دفع الارتفاع المفاجئ لأسعار البترول، بلدانا أخرى كي تفكر بدورها في إنتاج دراما متلفزة، وهذه المرة بالعربية الكلاسيكية. سياق، أفرز أعمالا متنكرة ومتكلّفة ومُنهِكة، اُفترض معها الاستجابة لأذواق المسلمين (ومسيحيين محافظين، بشكل عام أكثرهم تزمتا)، لكنها أخفقت في تحويل أنظارنا عن أفلام القاهرة المفعمة موهبة، فقد بدت جد مضجرة ! أما المسلسل المصري، الذي تم توضيبه بسرعة، فكان يدخل البهجة علينا، أفضل من الإنتاجات الدرامية المحكمة جيدا في اللغة الكلاسيكية.
إجمالا، من بين كل اللهجات، وحدها المصرية عرفت انتشارا واضحا. في المقابل، سأواجه كل صعوبات العالم كي أفهم جزائريا، فالاختلاف شاسع بما يكفي، بين لهجات المشرق وكذا المغرب. نفس الوضع سأعيشه مع عراقي أو أيضا متحدث تطغى عليه لكنة خليجية. لذلك، توظف النشرات الإخبارية الإذاعية و المتلفزة، لغة حديثة مُعدلة عن الكلاسيكية، تُفهم على امتداد جغرافية العالم العربي من الخليج إلى المغرب، سواء تعلق الأمر بسجالات وبرامج وثائقية ولقاءات وندوات ومواعظ المسجد وتلك الخطابات التي تسود اجتماعات الوطنيين أو التجمعات اليومية بين مواطنين يتكلمون لغات مختلفة جدا.
على غرار اللاتينية، بالنسبة للهجات الأوروبية المتكلَّمة إلى حدود القرن الماضي، بقيت فعلا العربية الكلاسيكية حاضرة بثقل، كلغة مشتركة للكتابة، بالرغم من المنابع الهائلة لسلسلة من اللهجات السائدة، التي باستثناء المصرية، لم تنتشر خارج بلدانها المعتادة. أيضا، هي لهجات تفتقد، لرحابة الأدب العربي الكلاسيكي.
لكن، الكُتّاب الذين يُنعتون بأنهم “محليون” ينزعون إلى استعمال لغة كلاسيكية مُعصرنة، ولا يستدعون إلا مؤقتا العربية المحلية. عمليا، شخص متعلم يمتلك رافدين لسانيين جد متميزين. إلى حد، مثلا، أنك قد تثرثر باللهجة المحلية مع محقق صحفي، يشتغل لحساب جريدة أو التلفزة، لكن فجأة، حينما يبدأ التسجيل، سينتقل دون مقدمات إلى اللغة الكلاسيكية، التي هي جوهريا أكثر تعقيدا وتنقيحا.
هناك بالتأكيد، صلة بين اللسانين : غالبا، الحروف متماثلة وكذا نظام الكلمات. لكن، يختلف التلفظ والمصطلحات، في نطاق كون العربية الكلاسيكية، النص النموذجي للغة تفقد كل أثر للهجة الإقليمية، وتبرز كأداة رنّانة، تعدّلت طبقاتها بعناية، إنها رفيعة ومرنة بشكل مذهل، بحيث تسمح صيغها بفصاحة معتبرة.
إن العربية الكلاسيكية، المشتغلة بطريقة سليمة، ليس لها نظيرا على مستوى دقة العبارة والكيفية المدهشة التي بواسطتها تمكن تغيرات الحروف الذاتية لكلمة (لاسيما النهايات) من بلورة أشياء متباينة جدا.
أيضا هي لغة، مضبوطة بلا مثيل، قياسا للثقافة العربية: مثلما كتب ياغوسلاف ستيكيفتش Jaroslav Stekevych، والذي خصص لها أفضل دراسة في العهد الحديث[2] : ((إنها مثل فينوس Vénus، لقد انبثقت في إطار حالة من الجمال التام، ثم احتفظت به على الرغم من طوارئ الزمان وإكراهاته)). بالنسبة للطالب الغربي : ((توحي العربية، بفكرة انجذاب تشبه الرياضيات تقريبا. النظام الممتاز للصوامت الثلاثة ذات الجذر الكيميائي، والأشكال المتنامية للأفعال مع دلالاتها القاعدية، ثم التشكل الدقيق لاسم الفاعل واسم المفعول. كل شيء واضح ومنطقي وممنهج ومجرد)). كذلك، هي جميلة، حينما نتأملها في صورتها المكتوبة. من هنا، الدور المحوري والدائم لفن الخط. فن تركيبي، يتميز بأعلى درجات التعقيد، ويدنو من الزخرفة والأرابيسك، أكثر من التفسير الاستدلالي.
خلال الأيام الأولى، لحرب أفغانستان سنة 2001، قدمت قناة الجزيرة، نقاشات وروبورتاجات، لا نجدها في وسائل الإعلام الأمريكية. وما كان مثيرا للانتباه، غير مضمون المادة المعروضة بالرغم من تعقد الإشكالات المطروحة، ذاك المستوى العالي لبلاغة المشاركين في الجدالات، مع حيثيات أسوأ الصعوبات وأفظعها. حتى السيد أسامة بن لادن، كان يتكلم بصوت خافت دون تلعثم أو ارتكابه لأقل زلة، مما خدم حتما تأثيره. نفس الأمر، انطبق أيضا، وإن في نطاق أقل، على غير العرب وبالضبط شخصيات أفغانية أمثال “برهان الدين رباني”، و”قلب الدين حكمتيار”، والذين مع عدم إتقانهم العربية، فقد تحدثوا اللسان الكلاسيكي بطلاقة مدهشة.
بالتأكيد، ما نسميه العربية الحديثة المعيارية (أو الكلاسيكية) ليست بالضبط، تلك التي جاء بها القرآن منذ أربعة عشر قرنا. ومع أن الكتاب المقدس، ظل نصا خاضعا للبحث والتمحيص، فإن لغته تبدو عتيقة بل مغالية. لذا، يتعذر استعمالها في كل الأوقات. ومقارنة بالنثر الحديث، فهي لغة تتوفر على مسالك القصيدة الرنانة.
إن العربية الكلاسيكية التي خضعت للتطور، تعتبر حصيلة مسار ابتدأ مع العقود الأخيرة من القرن19 ـ فترة النهضة ـ بفضل عمل مجموعة من الأسماء تواجدت بسوريا ولبنان وفلسطين ومصر (عدد كبير منهم ينتمي للطائفة المسيحية) ، انكبوا جماعة على تغيير اللغة العربية بتعديل وتبسيط بوجه من الأوجه، للمكون التركيبي لنسخة القرن السابع عن طريق الاستعراب : يتعلق الأمر بإدخال كلمات مثل : “قطار”، “شركة”، “ديمقراطية”أو “اشتراكية”، وهي طبعا لم تكن موجودة إبان الفترة الكلاسيكية. كيف ذلك ؟ بالعودة إلى المصادر الضخمة للغة، اعتمادا على الإجراء النحوي التقني للقياس. هؤلاء الأشخاص، أسسوا قاموسا جديدا كليا، يمثل ما يقارب %60 من اللغة الكلاسيكية المعيارية. كذلك، حققت النهضة تحريرا للنصوص الدينية، بأن أدخلت ضمنيا لائكية جديدة، بخصوص ما يقوله العرب ويكتبونه.
النحو العربي معقد للغاية، و أيضا جذاب بمنطقة، بحيث أن تلميذا متقدما في السن، بوسعه استيعابه بسهولة واضحة، مادام يمكنه تقدير الحدود الدقيقة لاستدلالات هذا النحو. وفي معاهد لسانية، تنتمي إلى مصر وتونس وسوريا ولبنان وكذا فيرمون Vermont، نعثر على أفضل منظومة تعليمية للعربية، تقدم لغير العرب.
حينما، أجبرتني الحرب العربية ـ الإسرائيلية سنة 1967، على الالتزام سياسيا، وإن على بعد، فقد تنبهت قبل كل شيء للحقيقة التالية: لم تستند السياسة على العامية أو العربية المحلية، لغة الجمهور الواسع، بل توخت في أغلب الأحيان الفصحى أو اللغة الصارمة شكليا، فأدركتُ على الفور، بأنه يتم تقديم تحليلات سياسية إلى التجمعات واللقاءات، توحي بعمق غير ما هي عليه في واقع الأمر.
اكتشفت بخيبة أمل كبيرة، أن ذلك ينطبق على المقاربات التي تضمنتها رطانة الماركسيين وكذا حركات التحرر خلال الحقبة، تعريفات: الطبقات، المصالح المادية، رأسمال، وكذا الحركة العمالية، فقد نُقلت إلى العربية ووجهت عبر مونولوجات طويلة، ليس إلى الشعب، بل مناضلين آخرين أكثر دراية.
بشكل خاص، فإن رموزا جماهيرية مثل ياسر عرفات وجمال عبد الناصر، واللذان جمعتني بهما لقاءات ، فقد استثمرا جيدا اللغة المحلية، بطريقة تفوقت على الماركسيين، مع أن مناضلي هذا التيار كانوا أفضل ثقافة من القائدين. عبد الناصر، تحديدا، خاطب حشود مناصريه باللهجة المصرية إلى جانب جمل صاخبة من اللغة الفصحى. لكن ياسر عرفات، وبما أن البيان في العربية، يتوقف على المنسوب الدراماتيكي، فقد كانت له شهرة خطيب تحت المعدل : أخطاؤه التلفظية، تلعثمه، وموارباته وتلميحاته غير الموفقة، ستظهر بالنسبة لأذن شخص مطلع ، مثل فيل يتجول داخل متجر للخزف الصيني.
تعتبر جامعة الأزهر بالقاهرة، من أقدم معاهد التدريس العالي، في العالم. ثم صارت، مقرا للأرتودوكسية الإسلامية، فرئيس هذه الجامعة يمثل السلطة الدينية الأولى في مصر السنية. أيضا، الأزهر يلقن ـ أساسا وليس استثناء ـ معرفة إسلامية، جوهرها القرآن وكذا مختلف ما يدخل في إطار مناهج التأويل والقضاء والحديث واللغة والنحو.
إتقان الغة الكلاسيكية، يتموضع إذن، عند نواة الثقافة الإسلامية في الأزهر، سواء للعرب والمسلمين. القرآن، في نظر المسلمين بمثابة كلام الله الذي أنزل على محمد عبر سلسلة الوحي، بالتالي، لغته مقدسة تتضمن قواعد ونماذج إجبارية بالنسبة لمن تسري عليهم. ولأنها لغة مفارقة، فلا يمكنهم قط نظرا لإعجازها، التمكن من تقليدها.
ما يقارب ستون سنة، ونحن نستمع إلى الخطباء، ونتعقّب بشكل دائم تصحيح لغتهم، قدر ما ينتجونه من كلام. عندما ألقيت أول خطاب بالعربية في القاهرة، منذ عقدين من الزمان، اقترب مني أحد أقاربي الشباب بعد الانتهاء كي يخبرني بتذمره، لأني لم أكن فصيحا : ((هل استوعبت ما قلته لك))، سألني، بصوت يضمر معاني الأنين. لقد تركز اهتمامي لحظتها على توضيح بعض المحاور الحساسة سياسيا وفلسفيا : ((نعم، بالتأكيد، أجابني بنبرة الاستخفاف، لا مشكل، بيد أنك لم تكن بليغا أو خطيبا ما يكفي)). هذه المؤاخذة، ظلت تلاحقني حتى الوقت الحاضر، كلما سعيت إلى مواجهة الجمهور، فأنا عاجز على تقمص صورة الخطيب القوي. أمزج بين تعابير لهجية وكلاسيكية، بطريقة برغماتية، فينتهي ذلك إلى نتائج غير مقنعة. لذلك، صاغوا في حقي ذات مرة، عبارة طريفة، لما شبهوني بشخص يمتلك سيارة رولس رويس Rolls Royce ، لكنه يفضل أخرى من نوع فولكزفاكن Volkswagen.
فقط، في غضون عشرة أو خمس عشرة سنة الأخيرة، اكتشفت ما يلي : إن أهم النصوص النثرية العربية، وأرقاها تمحيصا ودقة، والتي لم يسبق لي أن اطلعت عليها أو سمعت عنها، كتبها روائيون (وليس نقاد) أمثال “إلياس خوري” و “جمال الغيطاني”. أو جاءت من طرف شاعرينا الكبيران، أدونيس ومحمود درويش : لقد أدرك كل واحد منهما في قصائده الغنائية مستويات موسيقية رفيعة جدا، تستهوي عددا هائلا من المستمعين، وهم في قمة الافتتان الهائم.
بالنسبة لتلك الأقلام، فالنثر أداة أرسطوطاليسية حادة مثل شفرة موسى. معرفتهم باللغة هائلة وفطرية جدا. مواهبهم غنية كثيرة، بحيث يعبرون ببلاغة ووضوح، دونما حاجة إلى كلمات حشو وإطناب متعب وزخرف لا طائل من ورائه.
في حين أنا، يستفد من تكوين تحت سقف نظام مدرسي وطني عربي بل “في إطار منظومة كولونيالية”، فيلزمني بذل مجهودات واعية، حتى أخلق جملة عربية كلاسيكية بطريقة صحيحة ومرتبة بشكل معقول، غير أن النتائج ليست دائما ذات قيمة طبقا لمعاني الأناقة.
ينبغي في كل الأحوال، الاعتراف بذلك.
[1] – Edward W. Said : manière de voir n°117, 2011, Page 70/74.
* شغل إدوارد سعيد، منصب أستاذ للأدب المقارن بجامعة كولومبيا (الولايات المتحدة الأمريكية)، وقد توفي شهر شتنبر 2003.
[2] – Reorientation arabic and Per
حكمة | من أجل اجتهاد ثقافي وفلسفي