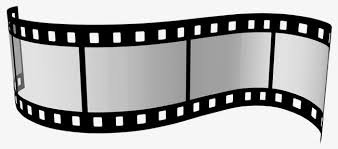وجدت الدنيا، كل شيء فيها جميل، رائع، باق، خالد، لا يموت، إلا الإنسان، فإنه وحده المالك فيها.. ليته لم يوجد.. ليته لم يذق حلاوتها.. ألا يمكن أن يضاعف عمره.. لماذا يموت؟!
استطاعت البشرية أن تتخلص من دنيا الهمجية، وأن تدخل في عصر جديد، هو عصر البداوة الاجتماعية، عندما بدأت تضيف إلي تعاليم "الغريزة" تعاليم جديدة، جليلة، أخذتها عن معلمها الجديد "العقل" .. في فصول "الملاحظة"!
وكانت أولي الملاحظات التي احتلت مكان العقيدة من الناس، أن الاجتماع خير من الهمجية، ومن تفكك الفردية، ففيه الأمن، والتعاون، والراحة.
كانت البشرية "تعيش" فرادي.. في حياة يومية مهددة، وصارت بالاجتماع "تحيا" حياة اجتماعية آمنة.
بل لقد لاحظت البشرية، أن الموت، هذا السيف المسلط علي رقاب العباد، قد تقلص عدد أعوانه ومأموريه في المجتمع، بعد أن نظمت مطاردة الوحش، والذئب، والإعصار، والفيضان، والجدب، وقوانين الغابة.
ولكن....؟
ألم يعد للموت أعوان ورسل..؟
أليس "الظلم" رسولاً من رسل الموت.. و"الشر" النفوس الشريرة؟! إنها تشبه، وقد تفوق أحياناً، الوحش والإعصار وقوانين الغابة.
لماذا يصدر الظلم عن الناس، ولماذا نرضي به.. وأليس هناك من سبيل للقضاء عليه وعلي الشر، وتهديد الحياة.. صبرنا رضينا بهذا اللغز المحير.. خروج الحياة منا، الموت الطبيعي.. فهل نرضي بهذه الأعداء الأخري التي تصيب مجتمعاتنا بالضعف والتفكك، وتكاد تعيدنا إلي حياة الهمجية.. حيث لا يأمن الإنسان علي نفسه أن يحيا حتي يحين أجله الطبيعي..؟!
للفناء رسل وأعوان ومندوبون ما أكثرهم، وأصبح لنا سلاح سحري رهيب، عرفنا به الطريق إلي البقاء، والحياة الخالدة، هو المجتمع، فلماذا لا نطهره من أعدائه.. مفاهيمنا الجاهلة، وعاداتنا الضارة، ورغباتنا المتشردة، وبعض ما كان صواباً بالأمس، وصار اليوم خطأ.
ما هي الدراما.....؟
منذ عرفت البشرية حياة الاجتماع، وذاقت حلاوته، وحلاوة ثمراته من أمن وعلاقات منظمة بين الناس وتمييز بين الخير والشر، والحق والباطل، منذ ذلك الوقت والبشرية لم تعد "بشرية" أي مجرد وحدات آدمية تدور في فلك الغريزة، وإنما أصبحت البشرية "إنسانية" لها فضائلها الطبيعية، وصفاتها المتجددة.. ميراثها الخالد.
وكان أول انتصار لحياة المجتمعات، أنها غيرت مفاهيم الناس، عن الحياة، فقد أصبحت حياة الإنسان جزءاً من حياة قومه، فهذه القومية، صغيرة كانت أو كبيرة، أسرة كانت أو قبيلة، عنصراً أو أمة، هي التي تعطي بتجددها وصيانتها ونمائها للإنسان تجدده وصيانته ونماءه، تعطيه سعادته.
ومن هنا، بدأت المجتمعات تجتر هذه الأفكار، وتمضغها، وتستدعيها، ومن هنا لبي المفكرون، والفنانون، نداء مجتمعاتهم بالضرورة، ورسموا لها الطرقات الصاعدة.
ومن هناك لعبت "الجاذبية القومية" دورها في الفن، ولئن كنا ونحن في القرن العشرين، قادرين علي أن نخضع هذه الملاحظات، والأفكار، والمضامين إلي عبارات، فإن أجدادنا الكبار، من الكتّاب والفنانين أخضعوا هذه المفاهيم المنتشرة في وجدانات مجتمعاتهم.. أخضعوها للعمل الفني نفسه.
ولقد جهدت الإنسانية، بهذه الأعمال الفنية، في المحافظة علي ميراثها الخالد، كوصلة من حيل إلي جيل، عاملة ما وسعتها الوسيلة، لا علي ألا يتبدد وحسب، وإنما علي أن ينمو، وأن يضاف إلي معتقدات الحياة عنه، ما يساعد علي إنمائه وزيادته، بالقضاء علي أعداء الحياة الإنسانية، من الفعال الضارة، والمعتقدات المتعفنة، والمفاهيم البالية، ابتغاء السعادة الإنسانية.
وهذا هو عمل الدراما..
وليس دورنا هنا دوراً تاريخياً، وإنما هو دور أدبي محض، فإذا ما قلنا إن مصر، عرفت الدراما قبل اليونان، وفارس، فإننا لا نبتغي من وراء ذلك فخراً، علي ما فيه من فخر، وإنما نحن نقول ذلك لنتحسر إذا كيف نبدأ في الإسهام بهذا العمل الإنساني الرائع للإنسانية، ثم نرانا اليوم وكأننا لا نعرف شيئاً عن الدراما.. سحرها، وجلالها، وأثرها في بناء أفكارنا، وشخصياتنا، وعناصر النمو فينا، لخلق القابلية في تطورنا الجديد، ونحن نخلع الأردية النفسية من عهد إقطاعي زائف، ونلبس أردية نفسية لعهد، نام، جديد.
إنني ألاحظ أن واقعنا الاجتماعي، يتحرك، في اندفاع وفي توثب القوانين، والأنظمة والعلاقات الاجتماعية، وكل شيء، إننا نبني الحياة المصرية الجديدة، علي أنقاض الإقطاع المتعفنة، ولكن الفنانين مازالوا في المشربيات والجناين.
الفنانون الذين يعيشون في مصر، ويتمتعون بخيراتها، ويتنسمون هواءها المحسود.. انكب كل منهم علي الورقة، أو علي العود، ورواح يجسم لنا عشقه الفردي، في ابتذال وقح، وراح يشغل أذهان الناس، ووجدان مجتمعه، بالحكاية اللزجة النتنة.. حكاية تأوهاته وأوجاعه.. وليس الخطر كامناً في الناحية الأخلاقية وحدها، وإنما هو كامن في تعميق انعزال الفن عن المجتمع في لحظة دهرية حرجة، هي لحظة التخلص من شكل مجتمع إقطاعي، بأفكاره، ومفاهيمه، وانطباعاته النفسية، وصوره، إلي مجتمع نام متطور جديد.
أين دور الدراما؟!
إن من الحقائق الرائعة، لتاريخ الفن المصري القومي، أن اليونان بدأت تعرف الدراما.. في أعمال إفيلوس ويوردبيديز واريستوفان، في مولد الأمة اليونانية تاريخياً، بينما كانت مصر في ذلك الوقت، في النزع بعد حضارة قومية خصيبة امتدت آلاف السنين، فيوم أن دخل قمبيز مصر، وكان المفكرون اليونان بقيادة سقراط يبحثون عن خطوط الحضارة الاجتماعية، كانت مصر قد طوت عهداً من الحضارة الاجتماعية مذهلاً، فالنظام والقانون والأمن والعلاقات والمحاكم والمدارس وبيت المال والضرائب، بل وساعي البريد كل ذلك كان موجوداً من المجتمع الإنساني المصري، في إطار من الفن الموسيقي والشعر والرقص والغناء والدراما.
والبناء الفني للدراما معروف، فهي إما أن تمثل موضوع تاريخياً، وإما أن تمثل موضوعاً خيالياً "أسطورياً" وإما أن تمزج بينها، علي أن يتم البناء في وحدة فنية تهدف إلي تفسير جديد للمفاهيم السائدة.
وظل البناء الدرامي علي حاله في عصورنا الأخيرة، بأن يختار المؤلف حادثة من الماضي، دينية أو سياسية، ثم يصبها في إطار معاصر، وبذلك استطاع المؤلفون تحريك مفاهيم الناس عن الحياة.
من هنا كان لشوقي مكانه في التاريخ، فبالدراما، ولا شيء آخر سواها، ضمن لنفسه البقاء، عندما مال إلي "مجنون ليلي" و"مصرع كليوباترا" و"قمبيز" و"علي بك الكبير" علي الرغم من أنه- رحمه الله- كان في هذه الأعمال، أقرب إلي مؤلف كتب الرواية والأخبار في شعر، منه إلي المؤلف الدرامي.. لأنه ملأ أفئدتنا وجوانحنا بعشق الماضي، ولم ينم فيها عنصر من عناصر دفعنا إلي الحاضر، وتشويقنا إلي المستقبل، وغنائنا مع أشواق الحياة.
ومن هنا أيضاً، ضمن بيرم التونسي- مد الله في عمره- خلود الذكر بالدراما، في "ليلة من ألف ليلة" و"عزيزة ويونس" كما ضمن زكريا أحمد وأحمد صدقي لأنفسهما مكاناً في تاريخ الموسيقي، ومعهما محمود الشريف الذي يأتي كل يوم بالمعجز في أركانه الدرامية ببرامج الإذاعة رغم قصرها.. وهؤلاء الثلاثة.. هم الفرصة الذهبية لمسرحنا الغنائي.. لو أنه وجد.
والأمر المحير، أن هذه الأعمال الدرامية التي أنتجها شوقي، لم تمتد الموسيقي إلا إلي كل ما هو "عربي" منها، أما "المصرية" فمسكينة معزولة.
ولاشك في أنه عمل مجيد ذلك الاتجاه الذي يخلق لنا في عالمنا الفني دراما حول محيطنا العربي، قوميتنا الثانية، ولكنه عمل أمجد، أن تدل موسيقانا علي الدراما المصرية، لتخلق في عالمنا الفني صورة لقوميتنا الأولي، مصر.
و"قمبيز" خير ما كتب شوقي، فيما نري، من وجهة نظرنا هذا، وأكثرهم مطابقة للعمل الدرامي، فما بال الموسيقيين المصريين المحدثين، يصطرعون في دوامة الحياة اليومية، ويتناقشون في التفضيل بين عبدالحليم حافظ وكمال حسني، بينما الحياة الخالدة، تمد يدها لتخليدهم، إن هم مالوا نحو قمبيز لتلحينها وصب عالمها الموسيقي.
أو لم ير هؤلاء السادة كيف عاش أبطال الفنانين، في البلاد الأخري، لتخليد قومياتهم، ببعث تاريخ الأفذاذ، من الرجال والأيام.
ويتطلع الإنسان إلي كل الجوانب، في الماضي البعيد والماضي القريب، فلا يكاد يري زماناً أحفل بالحوادث وأجدر بالتخليد من ماضينا المصري العجيب.. فكيف بهذه الأيام الفذة، والتاريخ الصامد، لا ينبه شعراءنا وموسيقيينا إلي خلق الدراما المصرية.
إن موسيقيي الغرب، لم يكتفوا بالروايات الدرامية لبناء قومياتهم بأحجار الفل المتلألئة، وملاطها الشعوري البهيج، فراحوا يقرأون الشعر، ويبحثون عن القصائد ذات الرنين القومي العظيم، وترجموها.. ترجموا القصائد من "كلام" إلي موسيقي.. ملتزمين في ذلك المعاني فقرة فقرة.. وتطور هذا المنهاج إلي تدوين القصائد بالموسيقي مباشرة، وهي القصائد المسماة بالقصائد السيمفونية، وهي عمل درامي رائع، فبدلاً من أن يستدعي الشعراء لتمجيد أيام بلادهم، استدعي الموسيقيون للقيام بالعملين دفعة واحدة، صب المعني الشعري وتلحينه في قصيدة سيمفونية.
استدعي تشايكوفسكي لإلقاء كلمة بالموسيقي، في احتفال تدشين كنيسة موسكو، وهي الكنيسة التي ظلت محتفظة بمعالم التخريب التي وقعت لموسكو علي أيدي الجيش النابليوني، فألقي تشايكوفسكي بين المتكلمين كلمته، وهي القصيدة السيمفونية الخالدة التي سماها "1812" وهو يشير بذلك إلي تاريخ مجيد في حياة بلاده، و1812 هو تاريخ محاصرة جيوش نابليون لموسكو، وماتت كل الكلمات علي جدران الآذان المستمعة، وفي بطون أوراق الكتب، ولكن كلمة تشايكوفسكي، مازالت تهز القلب الروسي وتدفعه للتلذذ بكل خطر، أي خطر، من أجل بناء الحياة الروسية.
والذي يقال عن تشايكوفسكي يقال عن جميع الموسيقيين الكبار في الغرب من حيث كتابة هذه القصائد السيمفونية، وبهذا الأسلوب الدرامي، خلد تشايكوفسكي في أوبراته العشر.
إن الشعب الألماني، لا يدل علي حديث القوميات، إلا بمقاطع درامية من قصائد بيتهوفن السيمفونية، وبأوبرات فاجنر الدرامية.
وكذلك الشعب الهنغاري الذي عمق ملامحه فرانز ليست في تاريخ الموسيقي.
وفرنسا التي تنافس علي تخليدها في أبهاء الفن المشرقة، كاميل سان سان، وماسينيه.
وإيطاليا، أم "فردي" و"روسيني" و"بوتشيني" كل هؤلاء خلدوا قومياتهم، في أعمال من واقع التاريخ القومي لبلادهم، وتعدي بعضهم الحدود، فخلد التاريخ الإنساني المجيد في قوميات أخري، مثلما فعل "روسيني" في تخليد القومية السويسرية، في أوبرا "وليم تل" البطل السويسري، وهي الدراما الشعرية التي كتبها شيللر، وكما فعل "فردي" في تخليد القومية المصرية الدهرية، في عايدة.. وكما فعل "سان سان" في حديث الغرام الكبير بين "شمشون ودليلة" وكما فعل "ماسينيه" في "ميروديا" بالإضافة إلي "مانون" و"فرتر" و"تاييس" التي اختلط طابع المصرية فيها بالرقة الفرنسية.
والدراما، بحتمية بنائها الفني، وبضرورة مهمتها الاجتماعية، غنية بالعواطف، وبالأحزان، وبالانفعالات المؤثرة، وبالأصوات العالية التي تتناوح من خلف كل عبارة وكل حركة معبرة عن أشواق الإنسانية للحياة، وكراهيتها لعوامل الفناء، وتقديسها لفضائلها الطبيعية، تلك التي تركزت في ميراثها الخالد، ولكن معجزة الموسيقي تحول لنا هذه الانفعالات الحزينة المؤثرة، إلي عواطف أنقي من الحزن المتشائم، المقيت، إنها تجعلنا نبكي.. ولكننا مع ذلك نري من خلال الدموع مشارف المستقبل الأبيض.. هناك.. عند الأفق.. إنه حزن متفائل.
ولهذا فإن الدراما من شأنها أن تمتص من وجداناتنا عوامل الغناء الكامنة فينا، اليأس والقنوط والتشاؤم والاستسلام وجمود القابلية مع الواقع المتحرك، والانعزال عن الاندماج في عناصر الحياة النامية..
فهل تفعل الأغاني ذلك..
ليتها لا تحلي ولا تسر، كأشياء كثيرة في فننا المعاصر، وإنما هي تمر.. بحرارة لا تترك فينا وجداناً حياً، ولا طاقة روحية، بل تتركنا مجرد مجموعة من الناس، تنتهبهم العصبية لشيء مجهول لديهم، فليس كل منا علي موعد.. مع حبيب مجهول أو معروف..! إننا نعجب لفيلسوف مثل "هيروفليطس" يقول في ذلك الزمن المتقدم علي مولد المسيح:
"إن الموسيقي تساوق بين العوامل المختلفة، وتجعلها مؤتلفة، إنها تؤالف بين أصوات الرجال والنساء".
نعجب لمثل هذا القول الذي أصبح بديهية في الإطار الموسيقي لكل عمل درامي مسرحي، فما من مشهد من مشاهدها إلا وخلفه أصوات "السوبرانو" من النساء والرجال يتناوح كأنه هو الانفعال البعيد الذي يتناوح في ضمائر البشرية وهي تحاصر عناصر الفناء وتنشد أشواق الحياة.. نعجب له، ونحن نعلم أنه كان عملاً مصرياً، في دراما "إيزيس" الخالدة.
بل إن حقيقة مذهلة أخري علينا أن ندركها اليوم، وهي أن الموسيقي كانت مادة من مواد التعليم في مدارسنا الفرعونية، فإلي جانب قيمة "الكتابة" و"المعرفة" و"الاجتهاد" التي كان يلقنه المعلمون لتلاميذهم كل يوم، كانت الكتب التي يقرأون فيها عن كل ذلك، تقول لهم "لقد تعلمت كيف تغني علي القيثارة.. وعلي الأرغول.. وتضرب علي العود مترنماً.. فكيف تسلمني عقلك.. لكل أنواع الأشياء الصماء..!! والكوميديا؟!
هذه الدراما المعكوسة، ذات السخرية الفاجعة، والضحك الحزين الأسيف.. لقد كانت سلاح "ارستوفانز" قديماً، وسلاح "موليير" أخيراً، واستطاع بتارتوب أن يقض مضجع المفاهيم الفرنسية القديمة في جو من الضحك، ويعقوب صنوع "موليير مصر" الذي طرده الخديو إسماعيل بعد أن أضحكه علي نفسه، وبعد أن أفاق نفاه.
إننا بالدراما وبالكوميديا، استطعنا أن نجز أعناق عوامل الجمود والفناء قبل ثورة 1919 في مسرحنا الغنائي الخالد، مسرح سيد درويش، بمعاونة رفاقه العظام بيرم التونسي وبديع خيري ثم نجيب الريحاني وأمين صدقي.
لقد استطعنا بالفن أن نرسب إلي أعماق الأمة المصرية، عناصر النماء، وعوامل الحياة المتجددة، فإذا بالصور والانطباعات السابحة في ضمير هذه الأمة، منذ كان أديبنا المصري الفرعوني "ايبور" يتهم صراحة ضعف الفرعون واستسلامه لاحتلال الهكسوس.. أول احتلال ذاقته مصر..إذ بالصور والانطباعات السابحة في ضمائرنا منذ ذلك اليوم، تتجمع، وتتزايد، وتترسب، وتندفع، رابطة الماضي السحيق، بالماضي القريب، وتضرب الضربة الحاسمة، بتطويح الملكية والإقطاع إلي الأبد.
هذه الانتصارات للشعب، تترك للورقة، وللعود، وللتأوهات والمواجع، وإذا رفعنا أصواتنا بالنقد، قيل لنا همساً، وأحياناً في علانية مأخوذة، إننا من أنصار القديم.
هذا هو القديم جداً، الواغل في القدم، منذ أربعة آلاف سنة، ولكنه مايزال جديداً، وسيظل جديداً لأنه جديد متحرك تام، أما الأغنية فإنها مهما تتشبث بحرارة الشعر واللحن، لا تعبر إلا عن نفسها.. عن شريحة عاطفة هازلة، هي في حقيقتها.. وحش.. ذئب.. إعصار.. طوفان.. عدو من هذه الأعداء التي حاربتها الإنسانية، بالإنسانية، وبحضارتها، وبتقاليدها.. ميراثها الخالد.
لأم كلثوم صاحبة أخلص صوت للجمال، آلاف الأغاني، ولكن أغنية واحدة من "سلامة" لزكريا أحمد، أي أغنية، لا ترفعنا معها إلي عالم الطرب والجمال فحسب، وإنما تفتح فينا كوي العواطف الخالدة، لنا، للإنسانية جمعاء، أو تفتح لعواطفنا طريق الخلود.
يا أم كلثوم.. الدراما
الدراما.. يا أم كلثوم
شيء آخر عبقري من طراز سلاّمة، شيء مصرياً، شيء مصري خالد من عمل زكريا أحمد، أو أحمد صدقي، أو محمود الشريف، ومعهم قادة التأليف الموسيقي المصري، الشجاعي وأحمد عبيد وحجاج والظاهري ونويرة.
أيها الناس.. تريد مصر أن تري نفسها في مرآة الجمال.. في الدراما.. فافعلوا شيئاً من أجل أمنا العظمي.. مصر.
____________________
العدد الواحد والعشرون
ديسمبر 1955
استطاعت البشرية أن تتخلص من دنيا الهمجية، وأن تدخل في عصر جديد، هو عصر البداوة الاجتماعية، عندما بدأت تضيف إلي تعاليم "الغريزة" تعاليم جديدة، جليلة، أخذتها عن معلمها الجديد "العقل" .. في فصول "الملاحظة"!
وكانت أولي الملاحظات التي احتلت مكان العقيدة من الناس، أن الاجتماع خير من الهمجية، ومن تفكك الفردية، ففيه الأمن، والتعاون، والراحة.
كانت البشرية "تعيش" فرادي.. في حياة يومية مهددة، وصارت بالاجتماع "تحيا" حياة اجتماعية آمنة.
بل لقد لاحظت البشرية، أن الموت، هذا السيف المسلط علي رقاب العباد، قد تقلص عدد أعوانه ومأموريه في المجتمع، بعد أن نظمت مطاردة الوحش، والذئب، والإعصار، والفيضان، والجدب، وقوانين الغابة.
ولكن....؟
ألم يعد للموت أعوان ورسل..؟
أليس "الظلم" رسولاً من رسل الموت.. و"الشر" النفوس الشريرة؟! إنها تشبه، وقد تفوق أحياناً، الوحش والإعصار وقوانين الغابة.
لماذا يصدر الظلم عن الناس، ولماذا نرضي به.. وأليس هناك من سبيل للقضاء عليه وعلي الشر، وتهديد الحياة.. صبرنا رضينا بهذا اللغز المحير.. خروج الحياة منا، الموت الطبيعي.. فهل نرضي بهذه الأعداء الأخري التي تصيب مجتمعاتنا بالضعف والتفكك، وتكاد تعيدنا إلي حياة الهمجية.. حيث لا يأمن الإنسان علي نفسه أن يحيا حتي يحين أجله الطبيعي..؟!
للفناء رسل وأعوان ومندوبون ما أكثرهم، وأصبح لنا سلاح سحري رهيب، عرفنا به الطريق إلي البقاء، والحياة الخالدة، هو المجتمع، فلماذا لا نطهره من أعدائه.. مفاهيمنا الجاهلة، وعاداتنا الضارة، ورغباتنا المتشردة، وبعض ما كان صواباً بالأمس، وصار اليوم خطأ.
ما هي الدراما.....؟
منذ عرفت البشرية حياة الاجتماع، وذاقت حلاوته، وحلاوة ثمراته من أمن وعلاقات منظمة بين الناس وتمييز بين الخير والشر، والحق والباطل، منذ ذلك الوقت والبشرية لم تعد "بشرية" أي مجرد وحدات آدمية تدور في فلك الغريزة، وإنما أصبحت البشرية "إنسانية" لها فضائلها الطبيعية، وصفاتها المتجددة.. ميراثها الخالد.
وكان أول انتصار لحياة المجتمعات، أنها غيرت مفاهيم الناس، عن الحياة، فقد أصبحت حياة الإنسان جزءاً من حياة قومه، فهذه القومية، صغيرة كانت أو كبيرة، أسرة كانت أو قبيلة، عنصراً أو أمة، هي التي تعطي بتجددها وصيانتها ونمائها للإنسان تجدده وصيانته ونماءه، تعطيه سعادته.
ومن هنا، بدأت المجتمعات تجتر هذه الأفكار، وتمضغها، وتستدعيها، ومن هنا لبي المفكرون، والفنانون، نداء مجتمعاتهم بالضرورة، ورسموا لها الطرقات الصاعدة.
ومن هناك لعبت "الجاذبية القومية" دورها في الفن، ولئن كنا ونحن في القرن العشرين، قادرين علي أن نخضع هذه الملاحظات، والأفكار، والمضامين إلي عبارات، فإن أجدادنا الكبار، من الكتّاب والفنانين أخضعوا هذه المفاهيم المنتشرة في وجدانات مجتمعاتهم.. أخضعوها للعمل الفني نفسه.
ولقد جهدت الإنسانية، بهذه الأعمال الفنية، في المحافظة علي ميراثها الخالد، كوصلة من حيل إلي جيل، عاملة ما وسعتها الوسيلة، لا علي ألا يتبدد وحسب، وإنما علي أن ينمو، وأن يضاف إلي معتقدات الحياة عنه، ما يساعد علي إنمائه وزيادته، بالقضاء علي أعداء الحياة الإنسانية، من الفعال الضارة، والمعتقدات المتعفنة، والمفاهيم البالية، ابتغاء السعادة الإنسانية.
وهذا هو عمل الدراما..
وليس دورنا هنا دوراً تاريخياً، وإنما هو دور أدبي محض، فإذا ما قلنا إن مصر، عرفت الدراما قبل اليونان، وفارس، فإننا لا نبتغي من وراء ذلك فخراً، علي ما فيه من فخر، وإنما نحن نقول ذلك لنتحسر إذا كيف نبدأ في الإسهام بهذا العمل الإنساني الرائع للإنسانية، ثم نرانا اليوم وكأننا لا نعرف شيئاً عن الدراما.. سحرها، وجلالها، وأثرها في بناء أفكارنا، وشخصياتنا، وعناصر النمو فينا، لخلق القابلية في تطورنا الجديد، ونحن نخلع الأردية النفسية من عهد إقطاعي زائف، ونلبس أردية نفسية لعهد، نام، جديد.
إنني ألاحظ أن واقعنا الاجتماعي، يتحرك، في اندفاع وفي توثب القوانين، والأنظمة والعلاقات الاجتماعية، وكل شيء، إننا نبني الحياة المصرية الجديدة، علي أنقاض الإقطاع المتعفنة، ولكن الفنانين مازالوا في المشربيات والجناين.
الفنانون الذين يعيشون في مصر، ويتمتعون بخيراتها، ويتنسمون هواءها المحسود.. انكب كل منهم علي الورقة، أو علي العود، ورواح يجسم لنا عشقه الفردي، في ابتذال وقح، وراح يشغل أذهان الناس، ووجدان مجتمعه، بالحكاية اللزجة النتنة.. حكاية تأوهاته وأوجاعه.. وليس الخطر كامناً في الناحية الأخلاقية وحدها، وإنما هو كامن في تعميق انعزال الفن عن المجتمع في لحظة دهرية حرجة، هي لحظة التخلص من شكل مجتمع إقطاعي، بأفكاره، ومفاهيمه، وانطباعاته النفسية، وصوره، إلي مجتمع نام متطور جديد.
أين دور الدراما؟!
إن من الحقائق الرائعة، لتاريخ الفن المصري القومي، أن اليونان بدأت تعرف الدراما.. في أعمال إفيلوس ويوردبيديز واريستوفان، في مولد الأمة اليونانية تاريخياً، بينما كانت مصر في ذلك الوقت، في النزع بعد حضارة قومية خصيبة امتدت آلاف السنين، فيوم أن دخل قمبيز مصر، وكان المفكرون اليونان بقيادة سقراط يبحثون عن خطوط الحضارة الاجتماعية، كانت مصر قد طوت عهداً من الحضارة الاجتماعية مذهلاً، فالنظام والقانون والأمن والعلاقات والمحاكم والمدارس وبيت المال والضرائب، بل وساعي البريد كل ذلك كان موجوداً من المجتمع الإنساني المصري، في إطار من الفن الموسيقي والشعر والرقص والغناء والدراما.
والبناء الفني للدراما معروف، فهي إما أن تمثل موضوع تاريخياً، وإما أن تمثل موضوعاً خيالياً "أسطورياً" وإما أن تمزج بينها، علي أن يتم البناء في وحدة فنية تهدف إلي تفسير جديد للمفاهيم السائدة.
وظل البناء الدرامي علي حاله في عصورنا الأخيرة، بأن يختار المؤلف حادثة من الماضي، دينية أو سياسية، ثم يصبها في إطار معاصر، وبذلك استطاع المؤلفون تحريك مفاهيم الناس عن الحياة.
من هنا كان لشوقي مكانه في التاريخ، فبالدراما، ولا شيء آخر سواها، ضمن لنفسه البقاء، عندما مال إلي "مجنون ليلي" و"مصرع كليوباترا" و"قمبيز" و"علي بك الكبير" علي الرغم من أنه- رحمه الله- كان في هذه الأعمال، أقرب إلي مؤلف كتب الرواية والأخبار في شعر، منه إلي المؤلف الدرامي.. لأنه ملأ أفئدتنا وجوانحنا بعشق الماضي، ولم ينم فيها عنصر من عناصر دفعنا إلي الحاضر، وتشويقنا إلي المستقبل، وغنائنا مع أشواق الحياة.
ومن هنا أيضاً، ضمن بيرم التونسي- مد الله في عمره- خلود الذكر بالدراما، في "ليلة من ألف ليلة" و"عزيزة ويونس" كما ضمن زكريا أحمد وأحمد صدقي لأنفسهما مكاناً في تاريخ الموسيقي، ومعهما محمود الشريف الذي يأتي كل يوم بالمعجز في أركانه الدرامية ببرامج الإذاعة رغم قصرها.. وهؤلاء الثلاثة.. هم الفرصة الذهبية لمسرحنا الغنائي.. لو أنه وجد.
والأمر المحير، أن هذه الأعمال الدرامية التي أنتجها شوقي، لم تمتد الموسيقي إلا إلي كل ما هو "عربي" منها، أما "المصرية" فمسكينة معزولة.
ولاشك في أنه عمل مجيد ذلك الاتجاه الذي يخلق لنا في عالمنا الفني دراما حول محيطنا العربي، قوميتنا الثانية، ولكنه عمل أمجد، أن تدل موسيقانا علي الدراما المصرية، لتخلق في عالمنا الفني صورة لقوميتنا الأولي، مصر.
و"قمبيز" خير ما كتب شوقي، فيما نري، من وجهة نظرنا هذا، وأكثرهم مطابقة للعمل الدرامي، فما بال الموسيقيين المصريين المحدثين، يصطرعون في دوامة الحياة اليومية، ويتناقشون في التفضيل بين عبدالحليم حافظ وكمال حسني، بينما الحياة الخالدة، تمد يدها لتخليدهم، إن هم مالوا نحو قمبيز لتلحينها وصب عالمها الموسيقي.
أو لم ير هؤلاء السادة كيف عاش أبطال الفنانين، في البلاد الأخري، لتخليد قومياتهم، ببعث تاريخ الأفذاذ، من الرجال والأيام.
ويتطلع الإنسان إلي كل الجوانب، في الماضي البعيد والماضي القريب، فلا يكاد يري زماناً أحفل بالحوادث وأجدر بالتخليد من ماضينا المصري العجيب.. فكيف بهذه الأيام الفذة، والتاريخ الصامد، لا ينبه شعراءنا وموسيقيينا إلي خلق الدراما المصرية.
إن موسيقيي الغرب، لم يكتفوا بالروايات الدرامية لبناء قومياتهم بأحجار الفل المتلألئة، وملاطها الشعوري البهيج، فراحوا يقرأون الشعر، ويبحثون عن القصائد ذات الرنين القومي العظيم، وترجموها.. ترجموا القصائد من "كلام" إلي موسيقي.. ملتزمين في ذلك المعاني فقرة فقرة.. وتطور هذا المنهاج إلي تدوين القصائد بالموسيقي مباشرة، وهي القصائد المسماة بالقصائد السيمفونية، وهي عمل درامي رائع، فبدلاً من أن يستدعي الشعراء لتمجيد أيام بلادهم، استدعي الموسيقيون للقيام بالعملين دفعة واحدة، صب المعني الشعري وتلحينه في قصيدة سيمفونية.
استدعي تشايكوفسكي لإلقاء كلمة بالموسيقي، في احتفال تدشين كنيسة موسكو، وهي الكنيسة التي ظلت محتفظة بمعالم التخريب التي وقعت لموسكو علي أيدي الجيش النابليوني، فألقي تشايكوفسكي بين المتكلمين كلمته، وهي القصيدة السيمفونية الخالدة التي سماها "1812" وهو يشير بذلك إلي تاريخ مجيد في حياة بلاده، و1812 هو تاريخ محاصرة جيوش نابليون لموسكو، وماتت كل الكلمات علي جدران الآذان المستمعة، وفي بطون أوراق الكتب، ولكن كلمة تشايكوفسكي، مازالت تهز القلب الروسي وتدفعه للتلذذ بكل خطر، أي خطر، من أجل بناء الحياة الروسية.
والذي يقال عن تشايكوفسكي يقال عن جميع الموسيقيين الكبار في الغرب من حيث كتابة هذه القصائد السيمفونية، وبهذا الأسلوب الدرامي، خلد تشايكوفسكي في أوبراته العشر.
إن الشعب الألماني، لا يدل علي حديث القوميات، إلا بمقاطع درامية من قصائد بيتهوفن السيمفونية، وبأوبرات فاجنر الدرامية.
وكذلك الشعب الهنغاري الذي عمق ملامحه فرانز ليست في تاريخ الموسيقي.
وفرنسا التي تنافس علي تخليدها في أبهاء الفن المشرقة، كاميل سان سان، وماسينيه.
وإيطاليا، أم "فردي" و"روسيني" و"بوتشيني" كل هؤلاء خلدوا قومياتهم، في أعمال من واقع التاريخ القومي لبلادهم، وتعدي بعضهم الحدود، فخلد التاريخ الإنساني المجيد في قوميات أخري، مثلما فعل "روسيني" في تخليد القومية السويسرية، في أوبرا "وليم تل" البطل السويسري، وهي الدراما الشعرية التي كتبها شيللر، وكما فعل "فردي" في تخليد القومية المصرية الدهرية، في عايدة.. وكما فعل "سان سان" في حديث الغرام الكبير بين "شمشون ودليلة" وكما فعل "ماسينيه" في "ميروديا" بالإضافة إلي "مانون" و"فرتر" و"تاييس" التي اختلط طابع المصرية فيها بالرقة الفرنسية.
والدراما، بحتمية بنائها الفني، وبضرورة مهمتها الاجتماعية، غنية بالعواطف، وبالأحزان، وبالانفعالات المؤثرة، وبالأصوات العالية التي تتناوح من خلف كل عبارة وكل حركة معبرة عن أشواق الإنسانية للحياة، وكراهيتها لعوامل الفناء، وتقديسها لفضائلها الطبيعية، تلك التي تركزت في ميراثها الخالد، ولكن معجزة الموسيقي تحول لنا هذه الانفعالات الحزينة المؤثرة، إلي عواطف أنقي من الحزن المتشائم، المقيت، إنها تجعلنا نبكي.. ولكننا مع ذلك نري من خلال الدموع مشارف المستقبل الأبيض.. هناك.. عند الأفق.. إنه حزن متفائل.
ولهذا فإن الدراما من شأنها أن تمتص من وجداناتنا عوامل الغناء الكامنة فينا، اليأس والقنوط والتشاؤم والاستسلام وجمود القابلية مع الواقع المتحرك، والانعزال عن الاندماج في عناصر الحياة النامية..
فهل تفعل الأغاني ذلك..
ليتها لا تحلي ولا تسر، كأشياء كثيرة في فننا المعاصر، وإنما هي تمر.. بحرارة لا تترك فينا وجداناً حياً، ولا طاقة روحية، بل تتركنا مجرد مجموعة من الناس، تنتهبهم العصبية لشيء مجهول لديهم، فليس كل منا علي موعد.. مع حبيب مجهول أو معروف..! إننا نعجب لفيلسوف مثل "هيروفليطس" يقول في ذلك الزمن المتقدم علي مولد المسيح:
"إن الموسيقي تساوق بين العوامل المختلفة، وتجعلها مؤتلفة، إنها تؤالف بين أصوات الرجال والنساء".
نعجب لمثل هذا القول الذي أصبح بديهية في الإطار الموسيقي لكل عمل درامي مسرحي، فما من مشهد من مشاهدها إلا وخلفه أصوات "السوبرانو" من النساء والرجال يتناوح كأنه هو الانفعال البعيد الذي يتناوح في ضمائر البشرية وهي تحاصر عناصر الفناء وتنشد أشواق الحياة.. نعجب له، ونحن نعلم أنه كان عملاً مصرياً، في دراما "إيزيس" الخالدة.
بل إن حقيقة مذهلة أخري علينا أن ندركها اليوم، وهي أن الموسيقي كانت مادة من مواد التعليم في مدارسنا الفرعونية، فإلي جانب قيمة "الكتابة" و"المعرفة" و"الاجتهاد" التي كان يلقنه المعلمون لتلاميذهم كل يوم، كانت الكتب التي يقرأون فيها عن كل ذلك، تقول لهم "لقد تعلمت كيف تغني علي القيثارة.. وعلي الأرغول.. وتضرب علي العود مترنماً.. فكيف تسلمني عقلك.. لكل أنواع الأشياء الصماء..!! والكوميديا؟!
هذه الدراما المعكوسة، ذات السخرية الفاجعة، والضحك الحزين الأسيف.. لقد كانت سلاح "ارستوفانز" قديماً، وسلاح "موليير" أخيراً، واستطاع بتارتوب أن يقض مضجع المفاهيم الفرنسية القديمة في جو من الضحك، ويعقوب صنوع "موليير مصر" الذي طرده الخديو إسماعيل بعد أن أضحكه علي نفسه، وبعد أن أفاق نفاه.
إننا بالدراما وبالكوميديا، استطعنا أن نجز أعناق عوامل الجمود والفناء قبل ثورة 1919 في مسرحنا الغنائي الخالد، مسرح سيد درويش، بمعاونة رفاقه العظام بيرم التونسي وبديع خيري ثم نجيب الريحاني وأمين صدقي.
لقد استطعنا بالفن أن نرسب إلي أعماق الأمة المصرية، عناصر النماء، وعوامل الحياة المتجددة، فإذا بالصور والانطباعات السابحة في ضمير هذه الأمة، منذ كان أديبنا المصري الفرعوني "ايبور" يتهم صراحة ضعف الفرعون واستسلامه لاحتلال الهكسوس.. أول احتلال ذاقته مصر..إذ بالصور والانطباعات السابحة في ضمائرنا منذ ذلك اليوم، تتجمع، وتتزايد، وتترسب، وتندفع، رابطة الماضي السحيق، بالماضي القريب، وتضرب الضربة الحاسمة، بتطويح الملكية والإقطاع إلي الأبد.
هذه الانتصارات للشعب، تترك للورقة، وللعود، وللتأوهات والمواجع، وإذا رفعنا أصواتنا بالنقد، قيل لنا همساً، وأحياناً في علانية مأخوذة، إننا من أنصار القديم.
هذا هو القديم جداً، الواغل في القدم، منذ أربعة آلاف سنة، ولكنه مايزال جديداً، وسيظل جديداً لأنه جديد متحرك تام، أما الأغنية فإنها مهما تتشبث بحرارة الشعر واللحن، لا تعبر إلا عن نفسها.. عن شريحة عاطفة هازلة، هي في حقيقتها.. وحش.. ذئب.. إعصار.. طوفان.. عدو من هذه الأعداء التي حاربتها الإنسانية، بالإنسانية، وبحضارتها، وبتقاليدها.. ميراثها الخالد.
لأم كلثوم صاحبة أخلص صوت للجمال، آلاف الأغاني، ولكن أغنية واحدة من "سلامة" لزكريا أحمد، أي أغنية، لا ترفعنا معها إلي عالم الطرب والجمال فحسب، وإنما تفتح فينا كوي العواطف الخالدة، لنا، للإنسانية جمعاء، أو تفتح لعواطفنا طريق الخلود.
يا أم كلثوم.. الدراما
الدراما.. يا أم كلثوم
شيء آخر عبقري من طراز سلاّمة، شيء مصرياً، شيء مصري خالد من عمل زكريا أحمد، أو أحمد صدقي، أو محمود الشريف، ومعهم قادة التأليف الموسيقي المصري، الشجاعي وأحمد عبيد وحجاج والظاهري ونويرة.
أيها الناس.. تريد مصر أن تري نفسها في مرآة الجمال.. في الدراما.. فافعلوا شيئاً من أجل أمنا العظمي.. مصر.
____________________
العدد الواحد والعشرون
ديسمبر 1955