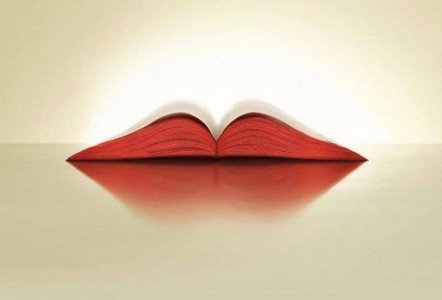حينما قدمت صحيفة «الواشنطن بوست» غاي تاليس بالمتناقضات في كتابه الجديد «فندق المتلصص»، كانت ردة فعل تاليس مذهلة: «أنا لن أروّج لهذا الكتاب»، هكذا أعلن، «كيف أجرؤ على الترويج له حينما تكون مصداقيته في أسفل المرحاض؟». الواشنطن بوست نشرت القصة تحت عنوان رئيسي (الكاتب غاي تاليس يتنكر لكتابه الأخير وسط تساؤلات حول المصداقية). مع ذلك، فبعد يوم واحد فقط تراجع المؤلف: «دعوني أكن واضحاً»، أخبر النيويورك تايمز، «أنا لست متنصلاً من الكتاب»
لو كان قد تمسك برد فعله الأولي لأضحى «فندق المتلصص» أهم مساهمة تدرج في ذلك العام ضمن فرع أدبيّ غريب: الكتب المُنكَرَة. فيما كان تنصل تاليس ينظر إليه كنوع من اليأس، ففي الحقيقة كان سينضم إلى قائمة لامعة من المؤلفين الذين رموا بكتبهم خارج أعمالهم الإبداعية، من ضمنهم آيفي كومبتون ـ بورنيت، دون ديليلو، وأنتوني برجس.
حين أقول «الكتب المُنكَرة»، لا أعني بذلك العدد العظيم من المخطوطات المحترقة، التي تطوف جزيئاتها في الهواء المحيط بنا، بل أعني، بالأحرى، تلك الكتب التي مرت عبر دورة تأليف، نشر، واستقبال، لكي تُحرق مجازياً، فيما بعد، بسبب
ندم المؤلف.
هذه الكتب هي أيتام الأدب، أو ربما ليست يتامى بقدر ما هي محرومة من الإرث. رغم كل شيء، لم يتم نشرها مجهولة الهوية، فهوية المؤلف معروفة. ما حدث عوضاً عن ذلك هو نقض للمعاهدة. تقليدياً، المؤلف والكتاب يتشاطران عهداً محدّداً، غامضاً لكنه سرمديّ. الكاتب يتقبّل قدر الكتاب باعتباره قدره الخاص. وأيّما كان سيأتي به ـ مديحاً أو إساءة أو لا مبالاة ـ سيقاس به في النهاية مدى نجاح الفنان أو إخفاقه. الكتاب المُنكَر، من جانب آخر، قد تم بتر مصيره عن المؤلف. إنه ينجرف عبر تاريخ الأدب، حاملاً علامة الرفض.
التنصل يمكن أن يُعزَّز عبر تغيّر شخصية المؤلف. الشاعرة الإنجليزية روزماري تونكس (1928 ـ 2014) تنكّرت لمجموعتها الكاملة كلها باعتبارها «هراء خطيراً» حينما شرعت فيما أصبح أربعة عقود من العزلة الروحية. كتب نيلس أستلي في نعيها: «لقد تبعت خطى رامبو في نبذ الأدب كليّاً، معتقدة أن بروست، تشيخوف، تولستوي وشعر القرن التاسع عشر الفرنسي قد ذهبوا بعقلها». لكن التغيير يمكن أن يكون مادّياً. ماي هوتون (1860 ـ 1915)، إحدى قائدات حق التصويت المؤثرات في إقليم شمال غرب الباسفيك، كتبت رواية تشهيرية عن المعاملة البائسة التي يلقاها عمال المناجم في إيداهو. وفي وقت لاحق من حياتها، بعدما أصبحت شخصياً مالكة منجم ثرية، حاولت إعادة شراء كل نسخة من كتابها.
في أغلب الأوقات، مع ذلك، يتنصل المؤلفون بدافع حفظ الذات. في حالة الصحافة مثل حالة تاليس، فالإنكار يمارس كعلاج جذري لترميم المصداقية. من خلال رفضه لكتابه الخاص فالصحفي يقف، وإن يكن على ساقين مهتزتين، دفاعاً عن المبادئ الصحفية. لكن عندما يجحد كاتبٌ خلاق كتاباً له، فثمة مبادئ أكثر غموضاً على المحكّ. إن المعايير التي يحاكم بها الفنانون أنفسهم معايير شخصية، غير محددة، وغالباً ما تكون متناقضة. التنصّل الفنّي لا يمت بعلاقة تذكر إلى الجمهور، وعلى الأصح، فإنه يفيد كنوع من العلاج الذاتي.
غالباً ما تقترن الكتب المرفوضة بالمهارة الفنية غير الناضجة، ومن ثم فإن وظيفة التنصّل تكون طريقة للحجر من قبل المؤلف عما يشخصه على أنه عمل جاد في مرحلة تدريبه المهني. معتبراً إياها تطهيراً أدبياً. وفقاً لناشره، تحدث ناثانيال هوثورن (1804 ـ 1864) عن روايته الأولى، «فانشاو» (1828)، «باشمئزاز كبير» واقترح أنه من باب المصلحة المشتركة «أن يتم حجبها» إضافة إلى «حماقات أخرى من مرحلة ما قبل نضجي». آيفي كومبتون ـ بورنيت (1884 ـ 1969) أغفلت ببساطة روايتها الأولى، «دولوريس» (1911)، من لائحة منشوراتها. « من الواضح حتى أن مؤلفتها لا تريد أن تتذكرها»، اقرأ ما كتب على قميص الكتاب (الغلاف مطوي) للطبعة التي ظهرت بعد وفاتها (نفدت الطبعة منذ ذلك الحين). مثل أفضل الاغتيالات، يميل التنصّل الأدبي لأن يحدث بصمت، على طريقة كومبتون ـ بورنيت في الحذف والإغفال. لكن في بعض الأحيان يطعن المؤلفون كتبهم في الواجهة تماماً. في رسالة إلى هنري ميلر، بعد أسبوع واحد فقط من نشره في الولايات المتحدة الأمريكية، أشار جورج أورويل إلى روايته «إبنة الكاهن» التي صدرت في 1935، بأنها «محض هراء»، فيما أنّ غراهام غرين الذي تنصّل من روايتين له، «اسم العمل» (1939) و»شائعات عند هبوط الليل» (1931)، قال في مذكراته: «كلا الكتابين من السوء بحيث أن قوة النقد تستحضر بشكل صحيح».
بعض الكتّاب يأخذون فكرة أكثر تسامحاً تجاه حماقاتهم، فيما هم يواصلون عملياً إقصاء أعمالهم الناضجة وغير الناضجة. طبقاً لرغبات وصيته، «لا شيء سوى الليل» (1948)، الرواية الأولى لمؤلف «ستونر»، جون وليامز (1922 ـ 1994)، قد تم استبعادها من إعادة طبع أعماله التي حظيت بنجاح هائل. على الرغم من أن زوجته، نانسي ويليامز، قد كتبت لي أن «التنصل» مفردة عنيفة جداً لوصف موقف جون تجاه «لا شيء سوى الليل»، ومع ذلك، كما تتذكر، «فإن تلميذته، الروائية ميشيل لاتيوليس قد أخبرتني أن جون قال لها ذات مرة: أنا لم أكتب تلك الرواية»، ضاحكاً بالطبع. ما هي الأحاسيس التي تنتابنا عند قراءة كتاب تم رفضه؟ أضحيت مهتماً بهذا النوع من الأدب في البدء بعد عثوري على نسخة من رواية «الأمازونيات» (1980) التي كتبته كليو بردويل. «مذكرات حميمة لأول امرأة على الإطلاق لعبت في دوري الهوكي الوطني». «الأمازونيات» تقتفي حياة كليو بردويل على مدار موسم مع فريق
نيويورك رينجرز.
منذ بداية نشرها، كان سراً مكشوفاً أن تلك الرواية مكتوبة في الواقع من قبل دون ديليلو (مع متعاون). الكاتب الحقيقي يختفي في مشهد جلي: كل صفحة من صفحات «الأمازونيات» تفرقع بنسخة أخف وأقل تبعية لفكاهة ديليلو المميزة. مع ذلك ظل صامتاً بشأن مؤلفه. لم تعد طباعة «الأمازونيات» أبداً، وحين دونت القائمة الرسمية لمؤلفاته طلب ديليلو أن يتم استبعادها منها.
تجربة قراءة «الأمازونيات» بدت وكأنها غير شرعية تقريباً. حتى قراءة رسائل الكاتب ربما، أو رواية نشرت له بعد موته لا تسير بهذه الصراحة بالضد من رغباتهم. وبالرغم من أنني كنت أؤمن دائماً أن «موت المؤلف» قد بولغ في تضخيمه كثيراً، إلاّ أن قراءة كتاب متنصَّل منه يبدو في الحقيقة وكأنه انتصار للقارئ على الكاتب. قد كنت في حالة حيازة بضاعة مسروقة. هذا الغبش هو ذاته الذي يغمر بظلاله جميع أعمال كافكا التي أمر بإحراقها، ومن الجدير بالسؤال عن الإحساس الكافكوي ـ الانتهاك في عالم منتهِك ـ قد أعلم جزئياً من خلال معرفتنا بأن كل شيء نقرأه قد تم رفضه.
الاستمتاع بأحد هذه الكتب، كما فعلت أنا مع «الأمازونيات»، يضع القارئ في موقف غريب حتى. لأنه حينما يكون الكتاب سيئاً فعلاً، فسيمكن للقارئ الانضمام إلى المؤلف في شجبه؛ يتقاسمان المزح المبطنة عن تكلفة الكتاب. لكن ماذا نفعل بكل هذا الثناء؟ الرابطة بين المؤلف والعمل قد فصمت، وبالتالي سيبدو من غير المناسب أن نغدق عليه بالأوسمة. إذا لم تعترف بنسب طفل فلن يكون عليك تبديل حفاظاته؛ لكن لن يمكن أيضاً الحصول على أي حساب ائتمان فيما إذا كبر
وأصبح رئيساً.
أنتوني يرجس (1917 ـ 1993) غامر بأجرأ تنصل حينما كتب في دراسة له عام 1985 عن د. أتش. لورنس: «الكتاب الذي اشتهرت به على نحو أفضل، أو الذي أنا مشهور بسببه فقط، هو رواية أنا مستعد للتنصل منها». كان يشير إلى روايته «البرتقالة الميكانيكية» (1962)، وبعد ثلاثين عاماً تبين فقط أن شكواه كانت أكثر صحة. في الوقت الذي عرفت فيه معجبين بعمله الروائي (القوى الأرضية» 1980، كما أنني شخصياً معجب بروايته عن شكسبير، «لا شيء يشبه الشمس» (1964)، أجد من الصعب عدم الاتفاق بأن إرثه مرتبط بشكل وثيق بعمله «البرتقالة الميكانيكية»، ففي فصول عديدة هو مترادف لها. بالتنصل عن الكتاب خاطر برجس بتدمير اسمه، وأضحى كل ذلك الثناء باطلاً. لكن في النهاية كبحته الشعبية المطبقة عن التنصل عنه عملياً، ربما لهذا السبب كان فقط «مستعداً» دائماً. «البرتقالة الميكانيكية» أضحت وحش فرانكشتاين الخاص به، إذا ما بدا الوحش جميلاً ومتجانساً.
على العموم، جمهور القراء يميل للسماح بالتنصل. في الوقت الذي حتى أكثر التعليقات عفوية يمكن أن تطارد الشخص للأبد، فنحن نظهر كرماً عجيباً تجاه التنصل الفني. فنحن ببساطة، بناء على طلبه أو طلبها، نزيح من على كاهل المؤلف عبء مئات الألوف من الكلمات الملتبسة. لا أحد يحمل أوكتافيا بتلر المسؤولية عن روايتها «الناجي» (1978)، أو جون بانفيل عن «بيدق الليل» (1971). لماذا؟ هل لأن الرواية، حتى في أحسن حالاتها، تعتبر جزءاً من تدفق كلّي لتعابير غير مقصودة؟ كلنا قال شيئاً ندمنا عليه. أفترض أن الحيلة تكمن في أنها لا تؤخذ على محمل الجد في المقام الأول.
لو كان قد تمسك برد فعله الأولي لأضحى «فندق المتلصص» أهم مساهمة تدرج في ذلك العام ضمن فرع أدبيّ غريب: الكتب المُنكَرَة. فيما كان تنصل تاليس ينظر إليه كنوع من اليأس، ففي الحقيقة كان سينضم إلى قائمة لامعة من المؤلفين الذين رموا بكتبهم خارج أعمالهم الإبداعية، من ضمنهم آيفي كومبتون ـ بورنيت، دون ديليلو، وأنتوني برجس.
حين أقول «الكتب المُنكَرة»، لا أعني بذلك العدد العظيم من المخطوطات المحترقة، التي تطوف جزيئاتها في الهواء المحيط بنا، بل أعني، بالأحرى، تلك الكتب التي مرت عبر دورة تأليف، نشر، واستقبال، لكي تُحرق مجازياً، فيما بعد، بسبب
ندم المؤلف.
هذه الكتب هي أيتام الأدب، أو ربما ليست يتامى بقدر ما هي محرومة من الإرث. رغم كل شيء، لم يتم نشرها مجهولة الهوية، فهوية المؤلف معروفة. ما حدث عوضاً عن ذلك هو نقض للمعاهدة. تقليدياً، المؤلف والكتاب يتشاطران عهداً محدّداً، غامضاً لكنه سرمديّ. الكاتب يتقبّل قدر الكتاب باعتباره قدره الخاص. وأيّما كان سيأتي به ـ مديحاً أو إساءة أو لا مبالاة ـ سيقاس به في النهاية مدى نجاح الفنان أو إخفاقه. الكتاب المُنكَر، من جانب آخر، قد تم بتر مصيره عن المؤلف. إنه ينجرف عبر تاريخ الأدب، حاملاً علامة الرفض.
التنصل يمكن أن يُعزَّز عبر تغيّر شخصية المؤلف. الشاعرة الإنجليزية روزماري تونكس (1928 ـ 2014) تنكّرت لمجموعتها الكاملة كلها باعتبارها «هراء خطيراً» حينما شرعت فيما أصبح أربعة عقود من العزلة الروحية. كتب نيلس أستلي في نعيها: «لقد تبعت خطى رامبو في نبذ الأدب كليّاً، معتقدة أن بروست، تشيخوف، تولستوي وشعر القرن التاسع عشر الفرنسي قد ذهبوا بعقلها». لكن التغيير يمكن أن يكون مادّياً. ماي هوتون (1860 ـ 1915)، إحدى قائدات حق التصويت المؤثرات في إقليم شمال غرب الباسفيك، كتبت رواية تشهيرية عن المعاملة البائسة التي يلقاها عمال المناجم في إيداهو. وفي وقت لاحق من حياتها، بعدما أصبحت شخصياً مالكة منجم ثرية، حاولت إعادة شراء كل نسخة من كتابها.
في أغلب الأوقات، مع ذلك، يتنصل المؤلفون بدافع حفظ الذات. في حالة الصحافة مثل حالة تاليس، فالإنكار يمارس كعلاج جذري لترميم المصداقية. من خلال رفضه لكتابه الخاص فالصحفي يقف، وإن يكن على ساقين مهتزتين، دفاعاً عن المبادئ الصحفية. لكن عندما يجحد كاتبٌ خلاق كتاباً له، فثمة مبادئ أكثر غموضاً على المحكّ. إن المعايير التي يحاكم بها الفنانون أنفسهم معايير شخصية، غير محددة، وغالباً ما تكون متناقضة. التنصّل الفنّي لا يمت بعلاقة تذكر إلى الجمهور، وعلى الأصح، فإنه يفيد كنوع من العلاج الذاتي.
غالباً ما تقترن الكتب المرفوضة بالمهارة الفنية غير الناضجة، ومن ثم فإن وظيفة التنصّل تكون طريقة للحجر من قبل المؤلف عما يشخصه على أنه عمل جاد في مرحلة تدريبه المهني. معتبراً إياها تطهيراً أدبياً. وفقاً لناشره، تحدث ناثانيال هوثورن (1804 ـ 1864) عن روايته الأولى، «فانشاو» (1828)، «باشمئزاز كبير» واقترح أنه من باب المصلحة المشتركة «أن يتم حجبها» إضافة إلى «حماقات أخرى من مرحلة ما قبل نضجي». آيفي كومبتون ـ بورنيت (1884 ـ 1969) أغفلت ببساطة روايتها الأولى، «دولوريس» (1911)، من لائحة منشوراتها. « من الواضح حتى أن مؤلفتها لا تريد أن تتذكرها»، اقرأ ما كتب على قميص الكتاب (الغلاف مطوي) للطبعة التي ظهرت بعد وفاتها (نفدت الطبعة منذ ذلك الحين). مثل أفضل الاغتيالات، يميل التنصّل الأدبي لأن يحدث بصمت، على طريقة كومبتون ـ بورنيت في الحذف والإغفال. لكن في بعض الأحيان يطعن المؤلفون كتبهم في الواجهة تماماً. في رسالة إلى هنري ميلر، بعد أسبوع واحد فقط من نشره في الولايات المتحدة الأمريكية، أشار جورج أورويل إلى روايته «إبنة الكاهن» التي صدرت في 1935، بأنها «محض هراء»، فيما أنّ غراهام غرين الذي تنصّل من روايتين له، «اسم العمل» (1939) و»شائعات عند هبوط الليل» (1931)، قال في مذكراته: «كلا الكتابين من السوء بحيث أن قوة النقد تستحضر بشكل صحيح».
بعض الكتّاب يأخذون فكرة أكثر تسامحاً تجاه حماقاتهم، فيما هم يواصلون عملياً إقصاء أعمالهم الناضجة وغير الناضجة. طبقاً لرغبات وصيته، «لا شيء سوى الليل» (1948)، الرواية الأولى لمؤلف «ستونر»، جون وليامز (1922 ـ 1994)، قد تم استبعادها من إعادة طبع أعماله التي حظيت بنجاح هائل. على الرغم من أن زوجته، نانسي ويليامز، قد كتبت لي أن «التنصل» مفردة عنيفة جداً لوصف موقف جون تجاه «لا شيء سوى الليل»، ومع ذلك، كما تتذكر، «فإن تلميذته، الروائية ميشيل لاتيوليس قد أخبرتني أن جون قال لها ذات مرة: أنا لم أكتب تلك الرواية»، ضاحكاً بالطبع. ما هي الأحاسيس التي تنتابنا عند قراءة كتاب تم رفضه؟ أضحيت مهتماً بهذا النوع من الأدب في البدء بعد عثوري على نسخة من رواية «الأمازونيات» (1980) التي كتبته كليو بردويل. «مذكرات حميمة لأول امرأة على الإطلاق لعبت في دوري الهوكي الوطني». «الأمازونيات» تقتفي حياة كليو بردويل على مدار موسم مع فريق
نيويورك رينجرز.
منذ بداية نشرها، كان سراً مكشوفاً أن تلك الرواية مكتوبة في الواقع من قبل دون ديليلو (مع متعاون). الكاتب الحقيقي يختفي في مشهد جلي: كل صفحة من صفحات «الأمازونيات» تفرقع بنسخة أخف وأقل تبعية لفكاهة ديليلو المميزة. مع ذلك ظل صامتاً بشأن مؤلفه. لم تعد طباعة «الأمازونيات» أبداً، وحين دونت القائمة الرسمية لمؤلفاته طلب ديليلو أن يتم استبعادها منها.
تجربة قراءة «الأمازونيات» بدت وكأنها غير شرعية تقريباً. حتى قراءة رسائل الكاتب ربما، أو رواية نشرت له بعد موته لا تسير بهذه الصراحة بالضد من رغباتهم. وبالرغم من أنني كنت أؤمن دائماً أن «موت المؤلف» قد بولغ في تضخيمه كثيراً، إلاّ أن قراءة كتاب متنصَّل منه يبدو في الحقيقة وكأنه انتصار للقارئ على الكاتب. قد كنت في حالة حيازة بضاعة مسروقة. هذا الغبش هو ذاته الذي يغمر بظلاله جميع أعمال كافكا التي أمر بإحراقها، ومن الجدير بالسؤال عن الإحساس الكافكوي ـ الانتهاك في عالم منتهِك ـ قد أعلم جزئياً من خلال معرفتنا بأن كل شيء نقرأه قد تم رفضه.
الاستمتاع بأحد هذه الكتب، كما فعلت أنا مع «الأمازونيات»، يضع القارئ في موقف غريب حتى. لأنه حينما يكون الكتاب سيئاً فعلاً، فسيمكن للقارئ الانضمام إلى المؤلف في شجبه؛ يتقاسمان المزح المبطنة عن تكلفة الكتاب. لكن ماذا نفعل بكل هذا الثناء؟ الرابطة بين المؤلف والعمل قد فصمت، وبالتالي سيبدو من غير المناسب أن نغدق عليه بالأوسمة. إذا لم تعترف بنسب طفل فلن يكون عليك تبديل حفاظاته؛ لكن لن يمكن أيضاً الحصول على أي حساب ائتمان فيما إذا كبر
وأصبح رئيساً.
أنتوني يرجس (1917 ـ 1993) غامر بأجرأ تنصل حينما كتب في دراسة له عام 1985 عن د. أتش. لورنس: «الكتاب الذي اشتهرت به على نحو أفضل، أو الذي أنا مشهور بسببه فقط، هو رواية أنا مستعد للتنصل منها». كان يشير إلى روايته «البرتقالة الميكانيكية» (1962)، وبعد ثلاثين عاماً تبين فقط أن شكواه كانت أكثر صحة. في الوقت الذي عرفت فيه معجبين بعمله الروائي (القوى الأرضية» 1980، كما أنني شخصياً معجب بروايته عن شكسبير، «لا شيء يشبه الشمس» (1964)، أجد من الصعب عدم الاتفاق بأن إرثه مرتبط بشكل وثيق بعمله «البرتقالة الميكانيكية»، ففي فصول عديدة هو مترادف لها. بالتنصل عن الكتاب خاطر برجس بتدمير اسمه، وأضحى كل ذلك الثناء باطلاً. لكن في النهاية كبحته الشعبية المطبقة عن التنصل عنه عملياً، ربما لهذا السبب كان فقط «مستعداً» دائماً. «البرتقالة الميكانيكية» أضحت وحش فرانكشتاين الخاص به، إذا ما بدا الوحش جميلاً ومتجانساً.
على العموم، جمهور القراء يميل للسماح بالتنصل. في الوقت الذي حتى أكثر التعليقات عفوية يمكن أن تطارد الشخص للأبد، فنحن نظهر كرماً عجيباً تجاه التنصل الفني. فنحن ببساطة، بناء على طلبه أو طلبها، نزيح من على كاهل المؤلف عبء مئات الألوف من الكلمات الملتبسة. لا أحد يحمل أوكتافيا بتلر المسؤولية عن روايتها «الناجي» (1978)، أو جون بانفيل عن «بيدق الليل» (1971). لماذا؟ هل لأن الرواية، حتى في أحسن حالاتها، تعتبر جزءاً من تدفق كلّي لتعابير غير مقصودة؟ كلنا قال شيئاً ندمنا عليه. أفترض أن الحيلة تكمن في أنها لا تؤخذ على محمل الجد في المقام الأول.