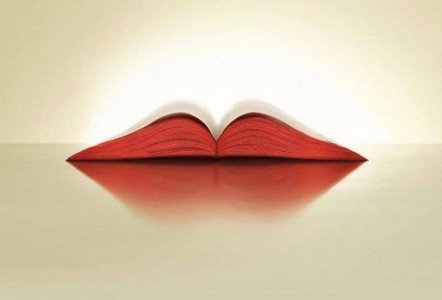في الستينيات، و'ما أدراك ما الستينيّات!'، حسب التعبير الاستنكاري لرئيس مصر الإخواني محمد مرسي، كان بمستطاع طالب الثانويّة العامّة القادم إلى مصر، بمصروفه البسيط، أن يعرج على شارع 'النبي دانيال' بالاسكندريّة (الذي يعادل في قيمته الثقافيّة ودوره سور الأزبكيّة في القاهرة، ويُذكِّر بشارع المتنبي الشهير في بغداد، وإن كان أصغر حجماً من الاثنين). وكان الطالب يعود من جولته محمّلاً بعدد كبير من الكتب، مقابل مبلغ ضئيل من المال. طالب الثانويّة العامّة الذي كنتُه في الستينيات، يدين لذلك الشّارع، بأنه أسهم منذ زمن بعيد في تشكيل وعيه وذائقته الأدبيّة والجماليّة. رغم أن المؤسسات الثقافيّة المصريّة الرسميّة، في زمن نّاصر الستينيات الذي يُغيظ الإخوان، لم تُقصِّر في توفير الكتب القيمة زهيدة الثمن، والدوريات المتخصصة، في الآداب والفكر والفنون التشكيليّة والسينما والمسرح.. وغيرها.
في زمن يرفع فيه الإخوان المسلمون يافطة أدرك الجميع أنها مُفرغة من المعنى، تردد عبارة 'المشروع الحضاري'، وخلال المئة يوم التي وعد فيها الرئيس وإخوانه بتحقيق ما لم يبلغه الأوائل، شهدت مصر عدداً من 'الإنجازات الثقافيّة والحضاريّة' التي ترسم الملامح الأولى لما سيكون عليه مشروعهم الحضاري 'العتيد'!
كان المشهد في شارع النبي دانيال يبشرنا بما سيؤول إليه حال الثقافة في زمن الإخوان. البلدوزرات المشحونة بالحقد تغزو الشارع الشهير الذي يجذب إليه القراء والمثقفين ومشاريع المثقفين، لتعمل فيه سحقاً وتدميراً. تتهاوى الأكشاك المتواضعة وتتراكم الكتب التي شهدت عمليّة إبادة بربريّة (ليس بعيداً عن المكان يقع بيت/ متحف الشّاعر اليوناني ـ السكندري 'قسطنطين كافافي'، الذي خدعنا عندما طمأننا بأن البرابرة لن يأتوا إلى المدينة التي انتظرت قدومهم)!
لولا غياب النار، لشكّل المشهد صورة موازيّة لمشاهد أخرى رأيناها في فيلم '451 فهرنهيت' للمخرج الفرنسي فرانسوا تروفو، الذي يتحدث عن الدرجة التي تحترق فيها الكتب، في ظلّ نظام شموليّ يناصب الكتاب عداءً سافراً ويجعل منه وقوداً مجانياً لنيران السُّلطة الغبيّة. وربما يستعيد المشاهد الأخيرة لفيلم يوسف شاهين 'المصير'، حيث أقامت سّلطات الجهل دائرة النار في السّاحة العامّة لقرطبة بهدف إحراق كتب ابن رشد، ولكن الكتب تحدّت النيران وتسرّبت نسخة منها إلى مصر.. التي حفظتها من مصير أراده لها جهلة التاريخ، وهي ما زالت تجلس بأبهتها على رفوف المكتبات في كل مكان.
في الستينيات، وما أدراك ما الستينيات، دخل طالب الثانوية العامّة سينما مترو في الاسكندريّة لمشاهدة فيلم مايكل أنجلو أنطونيوني 'إنفجار' Up-Blow ، ربما طمعاً في رؤية جنسٍ مكشوف على الشّاشة. غير أن ما لفته هو تنويه الرقيبة الشهيرة في حينها، إعتدال ممتاز، إلى القيمة الفنيّة للفيلم ومخرجه. وعليه، وتقديراً لوعي المشاهد وذائقته، أضاف التنويه، فإن الرقابة لن تلجأ إلى بتر أيّ مشهد من الشريط تحت أيّة دعاوى أخلاقيّة.
من تلك الإشارة البسيطة، تعلّم الفتى، طالب الثانويّة العامّة، درساً لن ينساه حول الجنس ولغة الجسد في الفن. أمّا الآن، في زمن الإخوان ومشروعهم الحضاري، فإن جسد فنانة عربيّة مصريّة (بغضّ النظر عن تقييمنا الفني لها) استبيح بانحطاط على ألسنة من يدّعون أنهم حماة الدين والفضيلة، بلغة تفصح عن كبت وشهوات مريضة، وبأسلوب مكشوف ولسان عارٍ من الذوق، ما كان لمقصّ اعتدال ممتاز المتنوِّر أن يسكت عن بذاءاته وتجاوزاته الأخلاقيّة!
في الستينيات، وما أدراك ما الستينيات. كان آخر منصب حكومي شغله نجيب محفوظ، هو رئيس الهيئة العامّة للسينما. وفي ظلّ المشروع الحضاري الإخواني، من يدلنا على اسم رئيس هذه الهيئة؟! بل من يدلنا أين هي السينما أصلاً، وإلى أيّ منحدر تسير!؟
في الستينيات، وما أدراك ما الستينيات، كان ثمّة حركة تشكيليّة مصريّة تعيش أوجهها، وانتشرت الغاليريهات وكليات الفنون والمراكز الثقافيّة المختلفة، وبلغت قوافل الثقافة المتنقِّلة أقاصي الريف المصري (وهي التجربة التي تحدّث عنها التشكيلي عز الدين نجيب في كتابه 'الصّامتون'). أمّا الآن، وفي ظلّ المشروع الحضاري الموهوم، فقد أعدت سلطة الإخوان ما استطاعت من قوّة ومن رباط الخيل، لتشنّ حملة شعواء على رسومات 'الغرافيتي' التي رسمها شباب الثورة على الحيطان في شارع محمد محمود، وعملت على طمس وجوه شهداء الثورة المعلّقة هناك، في محاولة لإزالتها عن جدران القلب والضمير. فلا ثورة الآن، بعد أن بلغ الإخوان مآربهم وقضوا وطرهم.. ولا من يثورون!
وليس بعيداً عن المكان والزمان، وفي التكوين الأيدولوجي الفاشي، كان مشهد العار الآخر في غزّة، حيث سلطة حماس، التي هي جزء لا يتجزأ من الجماعة، تعيد مشهد النبي دانيال بحذافيره. البلدوزرات تشنّ هجوماً كاسحاً مدمِّراً، فتزيل المنتدى الثقافي (جاليري الاتحاد)، متنفّس المثقفين والمبدعين في المدينة، وتمعن فيه تحطيماً وتجريفاً.
مشهد تتماهى فيه سُلطة حماس مع سلطات الاحتلال. وإمعاناً في التماهي، تزيل مع المبنى أشجار الزيتون.. والورد.. وكلّ ما يسهم في تشكيل الوعي والذائقة.. وجماليات المكان!
في زمن يرفع فيه الإخوان المسلمون يافطة أدرك الجميع أنها مُفرغة من المعنى، تردد عبارة 'المشروع الحضاري'، وخلال المئة يوم التي وعد فيها الرئيس وإخوانه بتحقيق ما لم يبلغه الأوائل، شهدت مصر عدداً من 'الإنجازات الثقافيّة والحضاريّة' التي ترسم الملامح الأولى لما سيكون عليه مشروعهم الحضاري 'العتيد'!
كان المشهد في شارع النبي دانيال يبشرنا بما سيؤول إليه حال الثقافة في زمن الإخوان. البلدوزرات المشحونة بالحقد تغزو الشارع الشهير الذي يجذب إليه القراء والمثقفين ومشاريع المثقفين، لتعمل فيه سحقاً وتدميراً. تتهاوى الأكشاك المتواضعة وتتراكم الكتب التي شهدت عمليّة إبادة بربريّة (ليس بعيداً عن المكان يقع بيت/ متحف الشّاعر اليوناني ـ السكندري 'قسطنطين كافافي'، الذي خدعنا عندما طمأننا بأن البرابرة لن يأتوا إلى المدينة التي انتظرت قدومهم)!
لولا غياب النار، لشكّل المشهد صورة موازيّة لمشاهد أخرى رأيناها في فيلم '451 فهرنهيت' للمخرج الفرنسي فرانسوا تروفو، الذي يتحدث عن الدرجة التي تحترق فيها الكتب، في ظلّ نظام شموليّ يناصب الكتاب عداءً سافراً ويجعل منه وقوداً مجانياً لنيران السُّلطة الغبيّة. وربما يستعيد المشاهد الأخيرة لفيلم يوسف شاهين 'المصير'، حيث أقامت سّلطات الجهل دائرة النار في السّاحة العامّة لقرطبة بهدف إحراق كتب ابن رشد، ولكن الكتب تحدّت النيران وتسرّبت نسخة منها إلى مصر.. التي حفظتها من مصير أراده لها جهلة التاريخ، وهي ما زالت تجلس بأبهتها على رفوف المكتبات في كل مكان.
في الستينيات، وما أدراك ما الستينيات، دخل طالب الثانوية العامّة سينما مترو في الاسكندريّة لمشاهدة فيلم مايكل أنجلو أنطونيوني 'إنفجار' Up-Blow ، ربما طمعاً في رؤية جنسٍ مكشوف على الشّاشة. غير أن ما لفته هو تنويه الرقيبة الشهيرة في حينها، إعتدال ممتاز، إلى القيمة الفنيّة للفيلم ومخرجه. وعليه، وتقديراً لوعي المشاهد وذائقته، أضاف التنويه، فإن الرقابة لن تلجأ إلى بتر أيّ مشهد من الشريط تحت أيّة دعاوى أخلاقيّة.
من تلك الإشارة البسيطة، تعلّم الفتى، طالب الثانويّة العامّة، درساً لن ينساه حول الجنس ولغة الجسد في الفن. أمّا الآن، في زمن الإخوان ومشروعهم الحضاري، فإن جسد فنانة عربيّة مصريّة (بغضّ النظر عن تقييمنا الفني لها) استبيح بانحطاط على ألسنة من يدّعون أنهم حماة الدين والفضيلة، بلغة تفصح عن كبت وشهوات مريضة، وبأسلوب مكشوف ولسان عارٍ من الذوق، ما كان لمقصّ اعتدال ممتاز المتنوِّر أن يسكت عن بذاءاته وتجاوزاته الأخلاقيّة!
في الستينيات، وما أدراك ما الستينيات. كان آخر منصب حكومي شغله نجيب محفوظ، هو رئيس الهيئة العامّة للسينما. وفي ظلّ المشروع الحضاري الإخواني، من يدلنا على اسم رئيس هذه الهيئة؟! بل من يدلنا أين هي السينما أصلاً، وإلى أيّ منحدر تسير!؟
في الستينيات، وما أدراك ما الستينيات، كان ثمّة حركة تشكيليّة مصريّة تعيش أوجهها، وانتشرت الغاليريهات وكليات الفنون والمراكز الثقافيّة المختلفة، وبلغت قوافل الثقافة المتنقِّلة أقاصي الريف المصري (وهي التجربة التي تحدّث عنها التشكيلي عز الدين نجيب في كتابه 'الصّامتون'). أمّا الآن، وفي ظلّ المشروع الحضاري الموهوم، فقد أعدت سلطة الإخوان ما استطاعت من قوّة ومن رباط الخيل، لتشنّ حملة شعواء على رسومات 'الغرافيتي' التي رسمها شباب الثورة على الحيطان في شارع محمد محمود، وعملت على طمس وجوه شهداء الثورة المعلّقة هناك، في محاولة لإزالتها عن جدران القلب والضمير. فلا ثورة الآن، بعد أن بلغ الإخوان مآربهم وقضوا وطرهم.. ولا من يثورون!
وليس بعيداً عن المكان والزمان، وفي التكوين الأيدولوجي الفاشي، كان مشهد العار الآخر في غزّة، حيث سلطة حماس، التي هي جزء لا يتجزأ من الجماعة، تعيد مشهد النبي دانيال بحذافيره. البلدوزرات تشنّ هجوماً كاسحاً مدمِّراً، فتزيل المنتدى الثقافي (جاليري الاتحاد)، متنفّس المثقفين والمبدعين في المدينة، وتمعن فيه تحطيماً وتجريفاً.
مشهد تتماهى فيه سُلطة حماس مع سلطات الاحتلال. وإمعاناً في التماهي، تزيل مع المبنى أشجار الزيتون.. والورد.. وكلّ ما يسهم في تشكيل الوعي والذائقة.. وجماليات المكان!