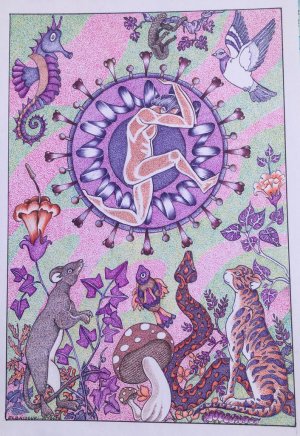(1)
المرّة الأخيرة التي شغلت فيها ذهني فكرة الموت، كانت في المقبرة، عند دفن صديقنا جبران. وحتى في المقبرة، سرعان ما تخلصت من الفكرة ما إن وصلت بوابة المقبرة، ورميت صدقة في كفّ أوّل متسوّلة. أمّا الآن، وأنا أغادر البيت، فلا سبيل للتخلص منها. الموت مرسوم على خشب الباب الذي فتحتُ، وأنا أخفي يدي في كمّي حتى لا تلامس أصابعي المقبض. على السلَّم، أنزل مهرولًا؛ مخافة أن تُفتح أبواب الشقق. في الزنقة، أبتعد عن العربات التي تمر، والجدران التي تبدو قريبة جدًّا. أسرع الخطو بلا سبب، مبتعدًا عن القطط والكلاب التي تتمطّى في تكاسل. أعبر إلى الرصيف الآخر حتى لا ألتقي بجاري القادم من قاع الزنقة؛ لأنه قد يلقي علي التحية، وأردُّ على تحيته، ويسألني عن العائلة، وأسأله عن العائلة، وكلّ الأسئلة التي لا تضر ولا تنفع. ثم إنه قد يكون حاملًا للموت، وهو – بدوره – لا يرى في هروبي أي حرج، لأنه يعتقد أنني أحمل البلاء نفسه. وكان سيفعل الشيء نفسه لو لم أسبقه وأعبر إلى الضفة الأخرى، ناجيًا بجلدي، وناجيًا بجلده. في الساحة، تحاشيت الاختلاط بالناس. الجائحة ضربتنا جميعًا. على وجوههم كمامات مسودة من كثرة الأيدي التي تداولتها. لقد أخذوها من ذويهم أو انتزعوها من جيرانهم، وسيردونها إليهم عندما يعودون إلى البيت. بالكمامة أو بدونها، كلٌّ يحمل نصيبه من التهديد. بقيت أنصت من بعيد. أسمع ما يتداوله البائعون والمشترون عن المصيبة. يطرحون السؤال نفسه: من أين جاءنا هذا العجب؟ الجواب حاضر في أذهانهم، حتى قبل أن يطرحوه… أمّا الصيدلي فيقول: إن خفاشًا هرب من أحد المختبرات الصينية وهو الذي وزَّع الوباء على سكّان العالم. أعود متحاشيًا الاقتراب من البشر، متحاشيًا الاقتراب من كلّ شيء: من التراب، والماء، والهواء.
(2)
في نفسي غضب مستعر، فحتى وأنا أتحاشى الاختلاط بهم أو الاقتراب منهم، أفكر منذ الآن، عندما أعود إلى البيت، بأن علي أن أغسل يدي بالماء والصابون ثلاثين ثانية على الأقل، وأنشر ثيابي في السطح حتى تتهوّى. هذه فكرة تبعث على الارتياح، لن أعود بحاجة إلى أن أعانق كلّ شخص أقابله، ويربّت بدوره على كتفي، ويضغط على أصابعي، ثم أطبع على وجهه أربع بوسات. انتهى ذلك العهد يا ولدي. في السابق، كانت بوسة واحدة كافية. أمّا الآن فلا تكفي اثنتين ولا حتى ثلاث بوسات. علاش؟ كما لو أن الواحد مجبر على أن يثبت، في كلّ مرّة، صدق مشاعره وحسن نواياه. ارتحت وأنا أجد نفسي في السطح مرّة أخرى. نجوتُ. أَطلُّ من هذا العلو، وأنا أفكر في كلّ هذه الأمور الجديدة علي. لن أسلّم على أحد، ثم هل أنا بحاجة إلى كلّ تلك الأسئلة التي سيلقيها علي جاري حول صحّتي وصحَّة أولادي؟ انتهى ذلك العهد يا ولدي. تصوّر، كلمة (السلام) وحدها، لم تعد كافية، وهي على أيّة حال لم تكن ذات مصداقية في يوم من الأيام؛ لأنك لا تعرف لِم تطلب السلام من واحد لا تريد أن تتحارب معه. بدل أن تشهر مديتك، تقول له: السلام عليكم. فكرتي هي أنك عندما تلقي السلام فإنك تفكر في الحرب، إنما تؤجلها إلى ما بعد. والآخر عندما يرد السلام فليقول لك إنه هو الآخر ترك مديته في البيت. هذه هي فكرتي. وما لنا على هذا الشي؟ حتى ذلك الإحساس الذي يسمّونه الشفقة، أو الحنان الذي كان يجتاحني بين الفينة والأخرى، لم يعد يغريني. منذ الآن، لن أفتح بابًا لشيخ أو عليل أو امرأة مسنّة. سأسير مرتابًا من كلّ شخص، ومن كلّ شيء. لن أمسك مقبضًا أو أضغط على زر. ارتخت عضلاتي المشدودة، نزعت ثيابي ونشرتها على حبل الغسيل.
(3)
أُطلّ من السطح، ليس بالإحساس السابق، اليومي نفسه؛ إحساس شخص يطل من أعلى سطحه فحسب. أنظر، الآن، إلى الخارج بنوع من الريبة، كما لو تكون المرّة الأولى. كما لو تقول: أطل على عالم لا أعرفه، وهل عرفته في يوم من الأيام؟ أنشغل بالتفكير في أشياء أخرى. أفكر في كلّ هذا الوقت الذي ما يزال أمامي. أنتبه، بنوع من الاستغراب، إلى أن هناك شيئًا اسمه الوقت، وعلي أن أنشغل به قليلًا، وأرى كيف يمر؛ ولهذه الغاية علي – أولًا – أن أمتنع عن مشاهدة التليفزيون، سأكون وصلت إلى نتيجة حسنة إن أمضيت بعض الوقت، دون التفكير في التليفزيون، كما أفعل، الآن، وأنا أطل على الدنيا بشكلٍ مخالف لعاداتي القديمة، وأتعامل مع الوقت، ليس من خلال عقارب الساعة، إنما من خلال النبضات المحيطة التي تمضي دون أن تمضي: اليمامة المتربّعة على عمود الالتقاط الهوائي، أو الحمامة التي تبدأ هديلها في وقت ما من الظهيرة، أو هذا الحلزون المنكمش في أصيص الأزهار.
(4)
أتصوَّر أنني نجوت، وأنا أعود إلى البيت وأغلق الباب، وأنا أخفي يدي في كمّي حتى لا تلامس أصابعي المقبض، وأتصوّر أنني لم أنجُ تمامًا، رغم كلّ الاحتياطات. أعدُّ الوجوه التي اقتربت منها إلى هذا الحد أو ذاك، والحركات التي قمت بها منذ أن غادرت البيت، المقابض التي لمست يدي، من مقبض الباب حتى مقبض باب الحافلة أو الترام أو البنك أو التاكسي. لم أنتبه، من قبل، إلى كلّ هذا العدد من المقابض: مقبض باب البيت وباب العمارة وباب السيارة وأبواب البقالة والصيدلية والبنك، والأزرار التي ضغطت عليها. أزرار الهواتف، وأزرار الأبواب والشبابيك الأوتوماتيكية، والأوراق المالية والمطبوعات والأكياس والفواتير. لن أعرف، أبدًا، عدد الأبواب التي فتحت يدي لأنها كثيرة، كثيرة بشكلٍ مدوّخ، ولا الجدران التي لمست، ولا القذارات التي وطئت قدماي، والنقود التي عددت قبل أن أخرجها أو أدخلها إلى جيبي. أنهض وأغسل يدي للمرّة الثالثة، ثم أتصوّر أنني مهما فعلت فلن أنجو من البشر.
(5)
رؤية الحلزون، وكلّ الأفكار حول عبوره النهار، دون مجهود، أضحكتني. ماذا يفعل الحلزون بوقته؟ يطل من قوقعته، ويعبر العشرة أمتار التي هي طول السطح، ويكون نهاره قد انقضى. هل أستطيع أن أفعل مثله، إن أنا تدرّبت جيّدًا، وتعلمت كيف أقضي يومًا كاملًا في إنجاز هذا المشروع الهائل؛ عبور السطح من هذا الجدار إلى ذاك الجدار؟ رحت أذرع الغرفة، وأعد خطواتي وأنا أقهقه. ولم أعد أنظر- مرتابًا- إلى البشر. هدأت، كأنما أفرغت على رأسي سطل ماء. لم أكن لأتصور أن الاقتراب من الموت سيهزني إلى هذا الحد، كما حدث لي قبل قليل، وأنا في الساحة، وأتحاشى التحديق في الوجوه، معتقدًا أن هذا كافٍ لأنجو. بالعكس، الوجوه كانت زاهية، وقد تألقت عليها فكرة الموت، كما لو تقول إنها تأنْسنتْ. نعم، والأجساد تتحرَّك أكثر حيوية من الأيام التي سبقت. كلّ هذا لم أنتبه إليه في حينه، وأنا أنتبه إليه، الآن، بتركيز أكبر. كنّا نسير، في تلك اللحظات الاستثنائية. لأوّل مرّة نسير معًا، ترشدنا الفكرة نفسها، اليد في اليد، على السفينة نفسها، نحو الموت. لأوّل مرّة، وأنا بينهم، متذكّرًا كلّ الميتات التي أفلتنا منها. كلّ الآخرين الذين ماتوا بالمجّان، الذي سقطت عليه سلحفاة رماها طفل من نافذة غرفته وهو يلعب، والذي وقع في حفرة تركها عامل البلدية فاغرة فاها ريثما يشرب قهوته. والتي اختنقت بعنبة أو بجرعة ماء، أو بقبلة. كلّ الميتات مضحكة إلّا هذه التي جمعتنا لأوّل مرّة. مستمرّ في قهقهتي، وأنا أذرع الغرفة. قد أحتاج إلى وقت أطول للتفكير في كلّ هذه الأمور الجديدة علي. وأفكر أنني مهما فعلت فلن أنجو من الناس أبدًا. لم أعد قلقًا. هواء السطح أنعشني، وطرد الأفكار السوداء التي اجتاحتني وأنا أغادر البيت. قد نموت قبل أن نصل إلى بيوتنا، وقد نبقى على قيد الحياة. اليقين الوحيد هو الطريق الباقية. كيفما كان الحال، وكيفما كان طولها فسنعبرها معًا. لا داعي للقلق. فكرة الموت تشدني إلى الحياة أكثر من أي وقت آخر. أرى من هذا العلو، ونشيد المساء يملأ رأسي، أننا نسير نحو الحياة. شعور بالقلق يقودنا. نعم، إنما هو قلق بسبب الطريق التي نعبر، متسائلين عن طولها ونوعيتها. نقيس حياتنا على ضوء وعورتها. هذا كلّ ما هنالك. لأوّل مرّة، أرى المستقبل بعين متفائلة. هل سيكفينا الوقت؟
(6)
أفكر في حكاية الخفاش التي سمعت عند الصيدلي. أين هو هذا الطائر المسكين؟ لقد فرَّ ناجيًا بجلده من بين أصابع العلماء. إنه يطل علينا من داخل مغارته، متأسفًا، ويرى أننا حيوانات نشبهه. حيوانات مثله، نموت في مختبرات الأسلحة الفتاكة والأدوية الكيماوية. أين اختفى الخفاش؟ لا وجود لخفاش يا ولدي. الخفافيش هي المختبرات العملاقة التي تزرع الدمار على كلّ أرض تقع عليها. إنها الشركات العابرة للقارات، والبنوك التي تقتل البشر بدون حاجة إلى وباء؛ لأنها هي الوباء. إنها سجون الديكتاتوريات من كلّ نوع. وهذه الجائحات ستبقى، كما ستبقى الرأسمالية العمياء تهددنا إلى الأبد. لكن الخبر الجديد الذي جاء به الخفاش، يا ولدي، هو انتعاش الأنظمة المستبدة التي بدأت تظهر، على قشرتها، الكثير من الشروخ. هذه فرصة لم تكن تحلم بها لترمّم الصدع. لتتغوّل وتجتاحنا من جديد. ها هي هذه الأنظمة المستبدة، بعد أن ظهرت ثقوب معيبة على وجهها، تعود لتشدِّد الرقابة على البلاد والعباد. المراقبة، والتوقيف، والتفتيش، والغرامة، وحبس الضحية بدل المجرم، والإسراع في سَنّ قوانين طوارئ جديدة توسع صلاحيات الاستبداد، وتزيد من صفاقته وشراسته. لا أدري كيف غدر بي فكري، وتوغل بي في هذه الدهاليز الأكثر سوداوية. نهضت وغسلت يدي للمرّة الرابعة. أعود إلى الجلوس، وأفكر بأنني لست حلزونًا، وأشعل التلفاز لأمحو بعض الساعات من حياتي.
المرّة الأخيرة التي شغلت فيها ذهني فكرة الموت، كانت في المقبرة، عند دفن صديقنا جبران. وحتى في المقبرة، سرعان ما تخلصت من الفكرة ما إن وصلت بوابة المقبرة، ورميت صدقة في كفّ أوّل متسوّلة. أمّا الآن، وأنا أغادر البيت، فلا سبيل للتخلص منها. الموت مرسوم على خشب الباب الذي فتحتُ، وأنا أخفي يدي في كمّي حتى لا تلامس أصابعي المقبض. على السلَّم، أنزل مهرولًا؛ مخافة أن تُفتح أبواب الشقق. في الزنقة، أبتعد عن العربات التي تمر، والجدران التي تبدو قريبة جدًّا. أسرع الخطو بلا سبب، مبتعدًا عن القطط والكلاب التي تتمطّى في تكاسل. أعبر إلى الرصيف الآخر حتى لا ألتقي بجاري القادم من قاع الزنقة؛ لأنه قد يلقي علي التحية، وأردُّ على تحيته، ويسألني عن العائلة، وأسأله عن العائلة، وكلّ الأسئلة التي لا تضر ولا تنفع. ثم إنه قد يكون حاملًا للموت، وهو – بدوره – لا يرى في هروبي أي حرج، لأنه يعتقد أنني أحمل البلاء نفسه. وكان سيفعل الشيء نفسه لو لم أسبقه وأعبر إلى الضفة الأخرى، ناجيًا بجلدي، وناجيًا بجلده. في الساحة، تحاشيت الاختلاط بالناس. الجائحة ضربتنا جميعًا. على وجوههم كمامات مسودة من كثرة الأيدي التي تداولتها. لقد أخذوها من ذويهم أو انتزعوها من جيرانهم، وسيردونها إليهم عندما يعودون إلى البيت. بالكمامة أو بدونها، كلٌّ يحمل نصيبه من التهديد. بقيت أنصت من بعيد. أسمع ما يتداوله البائعون والمشترون عن المصيبة. يطرحون السؤال نفسه: من أين جاءنا هذا العجب؟ الجواب حاضر في أذهانهم، حتى قبل أن يطرحوه… أمّا الصيدلي فيقول: إن خفاشًا هرب من أحد المختبرات الصينية وهو الذي وزَّع الوباء على سكّان العالم. أعود متحاشيًا الاقتراب من البشر، متحاشيًا الاقتراب من كلّ شيء: من التراب، والماء، والهواء.
(2)
في نفسي غضب مستعر، فحتى وأنا أتحاشى الاختلاط بهم أو الاقتراب منهم، أفكر منذ الآن، عندما أعود إلى البيت، بأن علي أن أغسل يدي بالماء والصابون ثلاثين ثانية على الأقل، وأنشر ثيابي في السطح حتى تتهوّى. هذه فكرة تبعث على الارتياح، لن أعود بحاجة إلى أن أعانق كلّ شخص أقابله، ويربّت بدوره على كتفي، ويضغط على أصابعي، ثم أطبع على وجهه أربع بوسات. انتهى ذلك العهد يا ولدي. في السابق، كانت بوسة واحدة كافية. أمّا الآن فلا تكفي اثنتين ولا حتى ثلاث بوسات. علاش؟ كما لو أن الواحد مجبر على أن يثبت، في كلّ مرّة، صدق مشاعره وحسن نواياه. ارتحت وأنا أجد نفسي في السطح مرّة أخرى. نجوتُ. أَطلُّ من هذا العلو، وأنا أفكر في كلّ هذه الأمور الجديدة علي. لن أسلّم على أحد، ثم هل أنا بحاجة إلى كلّ تلك الأسئلة التي سيلقيها علي جاري حول صحّتي وصحَّة أولادي؟ انتهى ذلك العهد يا ولدي. تصوّر، كلمة (السلام) وحدها، لم تعد كافية، وهي على أيّة حال لم تكن ذات مصداقية في يوم من الأيام؛ لأنك لا تعرف لِم تطلب السلام من واحد لا تريد أن تتحارب معه. بدل أن تشهر مديتك، تقول له: السلام عليكم. فكرتي هي أنك عندما تلقي السلام فإنك تفكر في الحرب، إنما تؤجلها إلى ما بعد. والآخر عندما يرد السلام فليقول لك إنه هو الآخر ترك مديته في البيت. هذه هي فكرتي. وما لنا على هذا الشي؟ حتى ذلك الإحساس الذي يسمّونه الشفقة، أو الحنان الذي كان يجتاحني بين الفينة والأخرى، لم يعد يغريني. منذ الآن، لن أفتح بابًا لشيخ أو عليل أو امرأة مسنّة. سأسير مرتابًا من كلّ شخص، ومن كلّ شيء. لن أمسك مقبضًا أو أضغط على زر. ارتخت عضلاتي المشدودة، نزعت ثيابي ونشرتها على حبل الغسيل.
(3)
أُطلّ من السطح، ليس بالإحساس السابق، اليومي نفسه؛ إحساس شخص يطل من أعلى سطحه فحسب. أنظر، الآن، إلى الخارج بنوع من الريبة، كما لو تكون المرّة الأولى. كما لو تقول: أطل على عالم لا أعرفه، وهل عرفته في يوم من الأيام؟ أنشغل بالتفكير في أشياء أخرى. أفكر في كلّ هذا الوقت الذي ما يزال أمامي. أنتبه، بنوع من الاستغراب، إلى أن هناك شيئًا اسمه الوقت، وعلي أن أنشغل به قليلًا، وأرى كيف يمر؛ ولهذه الغاية علي – أولًا – أن أمتنع عن مشاهدة التليفزيون، سأكون وصلت إلى نتيجة حسنة إن أمضيت بعض الوقت، دون التفكير في التليفزيون، كما أفعل، الآن، وأنا أطل على الدنيا بشكلٍ مخالف لعاداتي القديمة، وأتعامل مع الوقت، ليس من خلال عقارب الساعة، إنما من خلال النبضات المحيطة التي تمضي دون أن تمضي: اليمامة المتربّعة على عمود الالتقاط الهوائي، أو الحمامة التي تبدأ هديلها في وقت ما من الظهيرة، أو هذا الحلزون المنكمش في أصيص الأزهار.
(4)
أتصوَّر أنني نجوت، وأنا أعود إلى البيت وأغلق الباب، وأنا أخفي يدي في كمّي حتى لا تلامس أصابعي المقبض، وأتصوّر أنني لم أنجُ تمامًا، رغم كلّ الاحتياطات. أعدُّ الوجوه التي اقتربت منها إلى هذا الحد أو ذاك، والحركات التي قمت بها منذ أن غادرت البيت، المقابض التي لمست يدي، من مقبض الباب حتى مقبض باب الحافلة أو الترام أو البنك أو التاكسي. لم أنتبه، من قبل، إلى كلّ هذا العدد من المقابض: مقبض باب البيت وباب العمارة وباب السيارة وأبواب البقالة والصيدلية والبنك، والأزرار التي ضغطت عليها. أزرار الهواتف، وأزرار الأبواب والشبابيك الأوتوماتيكية، والأوراق المالية والمطبوعات والأكياس والفواتير. لن أعرف، أبدًا، عدد الأبواب التي فتحت يدي لأنها كثيرة، كثيرة بشكلٍ مدوّخ، ولا الجدران التي لمست، ولا القذارات التي وطئت قدماي، والنقود التي عددت قبل أن أخرجها أو أدخلها إلى جيبي. أنهض وأغسل يدي للمرّة الثالثة، ثم أتصوّر أنني مهما فعلت فلن أنجو من البشر.
(5)
رؤية الحلزون، وكلّ الأفكار حول عبوره النهار، دون مجهود، أضحكتني. ماذا يفعل الحلزون بوقته؟ يطل من قوقعته، ويعبر العشرة أمتار التي هي طول السطح، ويكون نهاره قد انقضى. هل أستطيع أن أفعل مثله، إن أنا تدرّبت جيّدًا، وتعلمت كيف أقضي يومًا كاملًا في إنجاز هذا المشروع الهائل؛ عبور السطح من هذا الجدار إلى ذاك الجدار؟ رحت أذرع الغرفة، وأعد خطواتي وأنا أقهقه. ولم أعد أنظر- مرتابًا- إلى البشر. هدأت، كأنما أفرغت على رأسي سطل ماء. لم أكن لأتصور أن الاقتراب من الموت سيهزني إلى هذا الحد، كما حدث لي قبل قليل، وأنا في الساحة، وأتحاشى التحديق في الوجوه، معتقدًا أن هذا كافٍ لأنجو. بالعكس، الوجوه كانت زاهية، وقد تألقت عليها فكرة الموت، كما لو تقول إنها تأنْسنتْ. نعم، والأجساد تتحرَّك أكثر حيوية من الأيام التي سبقت. كلّ هذا لم أنتبه إليه في حينه، وأنا أنتبه إليه، الآن، بتركيز أكبر. كنّا نسير، في تلك اللحظات الاستثنائية. لأوّل مرّة نسير معًا، ترشدنا الفكرة نفسها، اليد في اليد، على السفينة نفسها، نحو الموت. لأوّل مرّة، وأنا بينهم، متذكّرًا كلّ الميتات التي أفلتنا منها. كلّ الآخرين الذين ماتوا بالمجّان، الذي سقطت عليه سلحفاة رماها طفل من نافذة غرفته وهو يلعب، والذي وقع في حفرة تركها عامل البلدية فاغرة فاها ريثما يشرب قهوته. والتي اختنقت بعنبة أو بجرعة ماء، أو بقبلة. كلّ الميتات مضحكة إلّا هذه التي جمعتنا لأوّل مرّة. مستمرّ في قهقهتي، وأنا أذرع الغرفة. قد أحتاج إلى وقت أطول للتفكير في كلّ هذه الأمور الجديدة علي. وأفكر أنني مهما فعلت فلن أنجو من الناس أبدًا. لم أعد قلقًا. هواء السطح أنعشني، وطرد الأفكار السوداء التي اجتاحتني وأنا أغادر البيت. قد نموت قبل أن نصل إلى بيوتنا، وقد نبقى على قيد الحياة. اليقين الوحيد هو الطريق الباقية. كيفما كان الحال، وكيفما كان طولها فسنعبرها معًا. لا داعي للقلق. فكرة الموت تشدني إلى الحياة أكثر من أي وقت آخر. أرى من هذا العلو، ونشيد المساء يملأ رأسي، أننا نسير نحو الحياة. شعور بالقلق يقودنا. نعم، إنما هو قلق بسبب الطريق التي نعبر، متسائلين عن طولها ونوعيتها. نقيس حياتنا على ضوء وعورتها. هذا كلّ ما هنالك. لأوّل مرّة، أرى المستقبل بعين متفائلة. هل سيكفينا الوقت؟
(6)
أفكر في حكاية الخفاش التي سمعت عند الصيدلي. أين هو هذا الطائر المسكين؟ لقد فرَّ ناجيًا بجلده من بين أصابع العلماء. إنه يطل علينا من داخل مغارته، متأسفًا، ويرى أننا حيوانات نشبهه. حيوانات مثله، نموت في مختبرات الأسلحة الفتاكة والأدوية الكيماوية. أين اختفى الخفاش؟ لا وجود لخفاش يا ولدي. الخفافيش هي المختبرات العملاقة التي تزرع الدمار على كلّ أرض تقع عليها. إنها الشركات العابرة للقارات، والبنوك التي تقتل البشر بدون حاجة إلى وباء؛ لأنها هي الوباء. إنها سجون الديكتاتوريات من كلّ نوع. وهذه الجائحات ستبقى، كما ستبقى الرأسمالية العمياء تهددنا إلى الأبد. لكن الخبر الجديد الذي جاء به الخفاش، يا ولدي، هو انتعاش الأنظمة المستبدة التي بدأت تظهر، على قشرتها، الكثير من الشروخ. هذه فرصة لم تكن تحلم بها لترمّم الصدع. لتتغوّل وتجتاحنا من جديد. ها هي هذه الأنظمة المستبدة، بعد أن ظهرت ثقوب معيبة على وجهها، تعود لتشدِّد الرقابة على البلاد والعباد. المراقبة، والتوقيف، والتفتيش، والغرامة، وحبس الضحية بدل المجرم، والإسراع في سَنّ قوانين طوارئ جديدة توسع صلاحيات الاستبداد، وتزيد من صفاقته وشراسته. لا أدري كيف غدر بي فكري، وتوغل بي في هذه الدهاليز الأكثر سوداوية. نهضت وغسلت يدي للمرّة الرابعة. أعود إلى الجلوس، وأفكر بأنني لست حلزونًا، وأشعل التلفاز لأمحو بعض الساعات من حياتي.