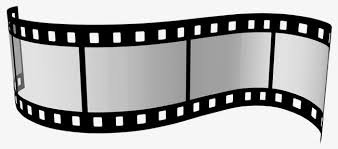ترى سوزان سونتاج في التصوير الفوتوغرافي محاولة "استيلاء" على الزمن؛ استعادة الماضي من وجهة نظر ثقافية وانثربولوجية. إنها بذلك وثيقة تمثّل قوة الأرشيف التاريخي، وسلطة المؤسسة التي تتخذ الصورة برهاناً أو دليلاً على اقتراف فعل جُرميّ. وإزاء هذه الخطورة "الجنائية" للصورة، تحاول سونتاج استخلاص متعةٍ ما من التقاط صورة لاجتماع عائلي، او سفرة سياحية؛ بل أن الصورة في كثير من الأحيان لصيقة بهذه اللحظة النادرة التي لن تتكرر، لأن التقاطها كان بمحض الصدفة، لا بمراقبة العين المتسلّطة، وإرادة الأرشيف. إنها تحرير الإرث المقيّد في سجل الزمن، وتوزيعه بعدالة على أصحابه الأبرياء.
إنّ المتعة الثانية المقابلة لآليّة الاستيلاء والاستئثار بودائع الماضي، تتأسَّس من استعادة الطاقة الكامنة في الأصل التصويري بكاميرات ما قبل الثورة التكنولوجية؛ التظهير البطئ ل"نكتف" الفلم الخام في غرفة التصوير/التحميض، والتحكم بدرجة التباين بين الظل والضوء. وهذه عملية ليست فنية خالصة، إذا فكرنا بالتقاطها في مناخ ثقافوي/سوسيولوجي، تتساوى فيه حظوظ الأشخاص المصوَّرين مع حظوظ أدباء من مختلف الأجيال، بكفاءة الآلة الآخذة (الكاميرا) لذلك الزمان. وبقدر ما يتعلق الدليل الجُرمي بالأشخاص المصوَّرين في صورتَي (البجّاري) الملتقطتين بكاميرا الهاتف النقال، قبل أيام قليلة، فإن مفهوم "الاستيلاء" على أرشيف الزمن، سيقرّب اللقطتين الحاضرتين من صور جماعية التُقِطت منتصف القرن الماضي لأدباء عراقيين وعرب، من جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأخرى من جيل الضياع الستّيني (جيل مقهى المعقدين ببغداد)، جنباً الى جنب مع مجموعة منتصف الليل من كتاب الرواية الجديدة الفرنسية (كما يظهر هؤلاء وأولئك في صور شهيرة).
تُلِحُّ المقارنة أكثر فأكثر، كلما تلاعب المصوِّرون بحساسية الصورة الملتقَطة بتقانات الكاميرات الحديثة، وأزمعوا تحقيق المتعة من انشاء سجل صُوَريّ تُلغى فيه حدود الزمن، وقوة المراقبة على متعة تصويرية، متخلّية عن صرامة السجل الجنائي. والصورتان المنشورتان هنا بكاميرا هاتف نقال لأحد رواد مكتبة شهريار، ومقهى أدباء البصرة، في يوم الجمعة، تبرهن على صحة هذه المقاربة/ المقارنة بين مفهومين لسلطة الزمن في التقاط صورة فوتوغرافية، تذكارية، عفوية، هاربة من السجل الجنائي.
إنّ المتعة الثانية المقابلة لآليّة الاستيلاء والاستئثار بودائع الماضي، تتأسَّس من استعادة الطاقة الكامنة في الأصل التصويري بكاميرات ما قبل الثورة التكنولوجية؛ التظهير البطئ ل"نكتف" الفلم الخام في غرفة التصوير/التحميض، والتحكم بدرجة التباين بين الظل والضوء. وهذه عملية ليست فنية خالصة، إذا فكرنا بالتقاطها في مناخ ثقافوي/سوسيولوجي، تتساوى فيه حظوظ الأشخاص المصوَّرين مع حظوظ أدباء من مختلف الأجيال، بكفاءة الآلة الآخذة (الكاميرا) لذلك الزمان. وبقدر ما يتعلق الدليل الجُرمي بالأشخاص المصوَّرين في صورتَي (البجّاري) الملتقطتين بكاميرا الهاتف النقال، قبل أيام قليلة، فإن مفهوم "الاستيلاء" على أرشيف الزمن، سيقرّب اللقطتين الحاضرتين من صور جماعية التُقِطت منتصف القرن الماضي لأدباء عراقيين وعرب، من جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأخرى من جيل الضياع الستّيني (جيل مقهى المعقدين ببغداد)، جنباً الى جنب مع مجموعة منتصف الليل من كتاب الرواية الجديدة الفرنسية (كما يظهر هؤلاء وأولئك في صور شهيرة).
تُلِحُّ المقارنة أكثر فأكثر، كلما تلاعب المصوِّرون بحساسية الصورة الملتقَطة بتقانات الكاميرات الحديثة، وأزمعوا تحقيق المتعة من انشاء سجل صُوَريّ تُلغى فيه حدود الزمن، وقوة المراقبة على متعة تصويرية، متخلّية عن صرامة السجل الجنائي. والصورتان المنشورتان هنا بكاميرا هاتف نقال لأحد رواد مكتبة شهريار، ومقهى أدباء البصرة، في يوم الجمعة، تبرهن على صحة هذه المقاربة/ المقارنة بين مفهومين لسلطة الزمن في التقاط صورة فوتوغرافية، تذكارية، عفوية، هاربة من السجل الجنائي.