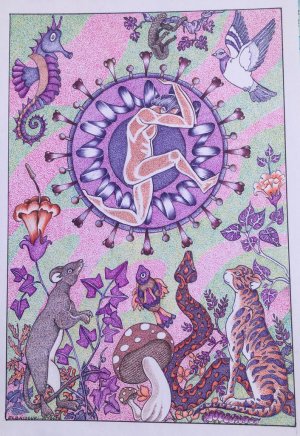لم أكن أتخيل لحظة أنه في اليوم الذي سأكملُ فيه الستين عامًا الأولى من عمري، سيكون فيروس كورونا الوغد يرعى في جسدي منذ عشرة أيام، كما لم أتوقع يومًا أن يتعرض جسمي لهذه الحالة من الإنهاك التام التي تفقدني السيطرة على حواسي وأعضائي مثلما حدث هذا الأسبوع.
ورغم أنني تلقيت اللقاح الصيني سينوفارم هنا في دبي، وهذا أمر ينبغي أن نقدم فيه الشكر الجزيل لدولة الإمارات لأنها وفرت للملايين اللقاح بالمجان، أقول.. ورغم ذلك، إلا أنني ظللت حريصًا على ارتداء الكمامة وملتزمًا بتعليمات التباعد الاجتماعي، ومع ذلك لا أعرف كيف تسلل هذا المجرم الخفي إلى جسدي في غفلة مني، إذ شعرت بتعب وسعال قبل عشرة أيام، ولما اشتد التعب توجهت نحو المستشفى، فكانت المسحة ثم الخبر المؤلم، وعلى الفور طلبت من ابنيّ، عمر وباسم، التوجه فورًا لعمل اختبار كورونا، وكانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل، ورغم أنني أعيش وحيدًا منذ نحو ثلاث سنوات ولا أرى أولادي إلا سويعات قليلة كل أسبوع، وتلك قصة مؤلمة أخرى، إلا أنني خشيت عليهما من الخطر الوشيك. ثم أبلغت زملائي وأصدقائي في العمل، فتوجهوا جميعًا لإجراء الاختبارات اللازمة، وكانت كلها مبشرة، فلم يتعرض أي من زملائي لسوء بسبب كورونا.
لكن من سوء الطالع، فإن ابني الأصغر باسم (خمسة عشر عامًا ونصف العام) قد أصيب أيضا بكورونا، بينما نجا عمر صاحب العشرين عامًا منها، وعلى الفور انتقل الصغير للإقامة معي بعيدًا عن شقيقه ووالدته.
لا أخفي عليك لم أكن قلقا من مصير موجع ينتظرني، أو أنني سأغادر هذه الدنيا مع المغادرين، فأنا رجل أومن بقدرة العلم على تقديم الحلول الناجزة إلى حد بعيد، وقد تلقيت اللقاح بالفعل، فلم الخوف إذن من هذا المجرم المستتر رغم يقيني التام بأن الموت قد يكون أقرب إلينا من حبل الوريد؟ ومع ذلك بدأت أراقب المعركة الدائرة داخل أوردتي وشراييني بين قاتل محترف لا يعرف الرحمة وجسد مدجج بسلاح اللقاح يعشق الحياة ويرفض الموت. وفي الوقت نفسه كنت أرصد بقلق بالغ وبدقة شديدة أثر كورونا على باسم، وقد لاحظت أنه لا يكابد أية أوجاع مزعجة، وأنه بصحة جيدة لا يعكر صفوها سوى بعض السعال الخفيف مع آلام بسيطة في الحلق، رغم أنه لم يتلقَ اللقاح لأنه لم يكمل ثمانية عشرة عامًا بعد، وتذكرت قول المختصين بأن عافية الشباب تحميهم من مكائد السفاح المجهول.
أما أنا فقد تلقيت أول هزيمة ماحقة عندما خسرت حاسة الشم تمامًا، فلم أعد أشم أي شيء، لا الكمون ولا الفلفل ولا البرتقال ولا الجوافة ولا الديتول ولا البرفان الفرنسي، وبدأت أجرّب حاسة التذوق، فلاحظت أنها حاضرة وإن بشكل باهت. ثم تابعت مراحل الهزيمة الموجعة الثانية المتمثلة في الإنهاك التام، إذ خذلني جسدي وفقد إيقاعه المعتاد فأضحى هشا محرومًا من التماسك، فلم أعد أقوى على الوقوف، وإذا توجهت نحو المطبخ لأعد لنفسي كوب شاي اعتراني التعب الشديد، ورضخت للتمدد أمام شاشة التليفزيون، فلا أستطيع القراءة أو الكتابة، فالعقل مشوش تمامًا، والتركيز تبدد، وفرحت لأنني أنهيت مقالي الأسبوعي في الوفد قبل تفاقم أزمتي مع كورونا. وهكذا تابعت بنصف تركيز نشرات الأخبار والأفلام المصرية، وبنصف التركيز الآخر شاهدت برامج الحيوان التي أعشقها، ولما ترهق الشاشة عينيّ، ألوذ بالغناء والموسيقى، فأنصت إلى أم كلثوم وعبدالوهاب أو بيتهوفن وفاجنر وموزارت. ورغم حرصي الشديد على تناول الأدوية أنا وابني، إلا أن النتائج الإيجابية مازالت بعيدة جدًا. صحيح أنني لم أواجه أية مشكلة مع التنفس، ولم يختنق صدري، ولم يتعطل تدفق الأكسجين في الجسم، إلا أن الصداع مزلزل، والوهن يدفع مياه الحياة إلى التسرب من الجسد.
منذ اقتحم كورونا السافل كوكبنا قبل أكثر من عام وأنا أتناول يوميًا الزنك وفيتامين سي تفاديًا لغدر قاتل غير مرئي أودي بحياة نحو ثلاثة ملايين إنسان وأصاب عشرات الملايين غيرهم، ولما غزاني هذا المتوحش قبل أيام أضفت لهما فيتامين (دي 5000) بناء على تعليمات الطبيب. وسقطت فريسة لهاجس غامض يؤكد لي إذا استعدت حاسة الشم فاعلم أنها بشارة القضاء على هذا الفيروس الحقير، فكنت كل ساعة أتوجه إلى المطبخ لأجرب أنفي مع الكمون، لأعود منكسر الخاطر خاسف البال، واكتشفت أن المرء بدون حاسم الشم مثل بيت بلا نوافذ، لا ينعم بلذة التواصل مع الأشياء والكائنات!
كنت سعيدًا جدًا لأن ابني يقيم معي بعد حرمان قاسٍ مفاجئ استمر نحو ثلاث سنوات، لكني كنت حزينا أكثر لأنه مصاب بكورونا، وبدأت أحاوره بعمق حول دراسته وأفكاره وطموحاته وأصدقائه، وفرحت جدًا لأنني استعدت حرارة العيش معًا في بيت واحد، فأنا كائن (بيتوتي) كما يقولون، ولم أكن أتخيل لحظة أنني سأكمل الستين وأنا أعيش وحيدًا. وهكذا مضيت أتناقش مع باسم فيما سنأكل واقترح عليه المطاعم المختلفة التي سنطلب منها الوجبات الجاهزة، فأنا للأسف نسيت مذاق الطعام المنزلي منذ أجبرتني ظروف بغيضة شريرة على الإقامة بمفردي وأنا على مشارف عامي الثامن والخمسين، وقد فاجأني باسم بلائحة طعام متنوعة، فمرة طلب كباب وكفتة ومرة طلب السمك المقلي والجمبري المشوي ومرة طلب فطائر بالتونة وهكذا، كل يوم له مطلب مختلف من مطعم مختلف، خاصة وأن تعليمات الأطباء أكدت بأننا يجب أن نتغذي جيدًا مع تناول العصائر والفواكه طوال اليوم لتعزيز قوة المناعة في جسدينا.
لكن أجمل ما في هذه التجربة المُرّة تمثل في حنان باسم، إذ لاحظ أنني أتعذب إذا تحركت وأن قدميّ ثقيلتان على الأرض لا أملك (رفاهية) رفعهما للسير ولو لعدة خطوات، فطلب مني ألا أقوم من سريري، وبدأ هو يعد لي الشاي أو يغسل الصحون عقب تناول الطعام أو يأتيني بالماء والأدوية أو يضع الغسيل في الغسالة ثم يتولى نشره وهكذا، وكنت أشفق عليه من هذه الأعمال المنزلية التي لم يتعود عليها، فحاولت قدر طاقتي ألا أرهقه، فكنت استغل فترة نومه، وأتولى القيام بهذه الأعمال على حسب القدرة.
اندلعت المعركة المحتدمة إذن بين مجرم غدّار خفي وجسد هزيل لكنه معزز بالأمل، وظلت دائرة بين كر وفر لمدة أسبوع أو يزيد، فساعات ينتصر الفيروس ويطرحني أرضا ويجردني من كل قوة بدنية أو طاقة نفسية، وساعات أهزمه وأسترد عافيتي بشكل معقول، وهكذا يمضي اليوم بين إقدام وإحجام، بين خمول وعنفوان، بين عجز وحيوية، وفي اللحظة التي رحل فيها الصديق العزيز الغالي الدكتور شاكر عبدالحميد ليلة الخميس 18 مارس، كنت أخوض أشرس صراع مع كورونا المرعب، فقد تمكن مني تمامًا، فسطا على حواسي كلها ونزع عني أي صلابة جسدية، وسخر من طاقاتي المتعددة وهي منطرحة أمامه بلا حول ولا قوة حتى غلبني النوم، ولما صحوت في الثالثة فجرًا مهدود الحيل، فوجئت بخبر غياب الصديق الدكتور شاكر عبدالحميد بسبب كورونا فطفرت من عينيّ الدموع، وحزنت جدًا لأنه لم يتسن له أخذ اللقاح.
لم أشأ أن أخبر أيًا من أهلي أو أصدقائي في القاهرة بأن الفيروس الملعون قد تسلل إلى جسدي حتى لا أقلق أحدًا، وحاولت قدر طاقتي الرد على الرسائل المعتادة للأحبة والأهل عبر الواتساب بهدوء وترحاب، كذلك تعاملت مع فيسبوك وتويتر بما تيسر من ردود وتعليقات فرضتها الضرورات الاجتماعية والمجاملات المنطقية وقدراتي الصحية، وقلت في نفسي: (سأدوّن تجربتي النادرة مع هذا البغيض عندما يتحقق لي النصر في النهاية).
ومساء أول أمس، وبينما أحاول باستماتة التملص من خبث هذا القاتل الماكر، تلاطمت في جمجمتي الأسئلة: رغم أنني تحصنت باللقاح، إلا أن الفيروس الجبار كاد يفتك بجسدي فتكا، فكيف كان عذاب الذين حرموا من اللقاح؟ وكيف تحمّل أصدقاؤنا الراحلون أوجاع الأيام والساعات الأخيرة قبل أن يجود كل واحد منهم بآخر شهيق؟ بل كيف ينام مسؤولو وزارة الصحة في بلادنا دون أن يعملوا على توفير اللقاح بأقصى سرعة لجميع الناس في مصر؟
واليوم 21 مارس أكمل عامي الستين بروح شاب وقلب وثاب، وأغلب الظن أن بشائر النصر على الفيروس النذل تلوح في الأفق، فجسدي أكثر توازنا وأعضائي أكثر انسجامًا، وقد استرددت حاسة الشم بنسبة ثلاثين في المائة تقريبًا، ومع ذلك سنظل أنا وابني ملتزمين في البيت حتى السبت القادم تنفيذا لتعليمات الأطباء هنا في دبي، وبعدها سنجري الاختبارات اللازمة وأتمنى وأتوقع أنها ستشي بالتخلص تمامًا من آثار هذا الكابوس والنصر العظيم على ذاك المجرم الجبان، لننطلق بعدها نحو دروب الحياة مفعمين بالأمل في اقتناص السعادة وقطف زهور الفرح وورود السرور إيذانا ببدء الستين عامًا الثانية من عمري… وكل عام وأنتم طيبون.
ورغم أنني تلقيت اللقاح الصيني سينوفارم هنا في دبي، وهذا أمر ينبغي أن نقدم فيه الشكر الجزيل لدولة الإمارات لأنها وفرت للملايين اللقاح بالمجان، أقول.. ورغم ذلك، إلا أنني ظللت حريصًا على ارتداء الكمامة وملتزمًا بتعليمات التباعد الاجتماعي، ومع ذلك لا أعرف كيف تسلل هذا المجرم الخفي إلى جسدي في غفلة مني، إذ شعرت بتعب وسعال قبل عشرة أيام، ولما اشتد التعب توجهت نحو المستشفى، فكانت المسحة ثم الخبر المؤلم، وعلى الفور طلبت من ابنيّ، عمر وباسم، التوجه فورًا لعمل اختبار كورونا، وكانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل، ورغم أنني أعيش وحيدًا منذ نحو ثلاث سنوات ولا أرى أولادي إلا سويعات قليلة كل أسبوع، وتلك قصة مؤلمة أخرى، إلا أنني خشيت عليهما من الخطر الوشيك. ثم أبلغت زملائي وأصدقائي في العمل، فتوجهوا جميعًا لإجراء الاختبارات اللازمة، وكانت كلها مبشرة، فلم يتعرض أي من زملائي لسوء بسبب كورونا.
لكن من سوء الطالع، فإن ابني الأصغر باسم (خمسة عشر عامًا ونصف العام) قد أصيب أيضا بكورونا، بينما نجا عمر صاحب العشرين عامًا منها، وعلى الفور انتقل الصغير للإقامة معي بعيدًا عن شقيقه ووالدته.
لا أخفي عليك لم أكن قلقا من مصير موجع ينتظرني، أو أنني سأغادر هذه الدنيا مع المغادرين، فأنا رجل أومن بقدرة العلم على تقديم الحلول الناجزة إلى حد بعيد، وقد تلقيت اللقاح بالفعل، فلم الخوف إذن من هذا المجرم المستتر رغم يقيني التام بأن الموت قد يكون أقرب إلينا من حبل الوريد؟ ومع ذلك بدأت أراقب المعركة الدائرة داخل أوردتي وشراييني بين قاتل محترف لا يعرف الرحمة وجسد مدجج بسلاح اللقاح يعشق الحياة ويرفض الموت. وفي الوقت نفسه كنت أرصد بقلق بالغ وبدقة شديدة أثر كورونا على باسم، وقد لاحظت أنه لا يكابد أية أوجاع مزعجة، وأنه بصحة جيدة لا يعكر صفوها سوى بعض السعال الخفيف مع آلام بسيطة في الحلق، رغم أنه لم يتلقَ اللقاح لأنه لم يكمل ثمانية عشرة عامًا بعد، وتذكرت قول المختصين بأن عافية الشباب تحميهم من مكائد السفاح المجهول.
أما أنا فقد تلقيت أول هزيمة ماحقة عندما خسرت حاسة الشم تمامًا، فلم أعد أشم أي شيء، لا الكمون ولا الفلفل ولا البرتقال ولا الجوافة ولا الديتول ولا البرفان الفرنسي، وبدأت أجرّب حاسة التذوق، فلاحظت أنها حاضرة وإن بشكل باهت. ثم تابعت مراحل الهزيمة الموجعة الثانية المتمثلة في الإنهاك التام، إذ خذلني جسدي وفقد إيقاعه المعتاد فأضحى هشا محرومًا من التماسك، فلم أعد أقوى على الوقوف، وإذا توجهت نحو المطبخ لأعد لنفسي كوب شاي اعتراني التعب الشديد، ورضخت للتمدد أمام شاشة التليفزيون، فلا أستطيع القراءة أو الكتابة، فالعقل مشوش تمامًا، والتركيز تبدد، وفرحت لأنني أنهيت مقالي الأسبوعي في الوفد قبل تفاقم أزمتي مع كورونا. وهكذا تابعت بنصف تركيز نشرات الأخبار والأفلام المصرية، وبنصف التركيز الآخر شاهدت برامج الحيوان التي أعشقها، ولما ترهق الشاشة عينيّ، ألوذ بالغناء والموسيقى، فأنصت إلى أم كلثوم وعبدالوهاب أو بيتهوفن وفاجنر وموزارت. ورغم حرصي الشديد على تناول الأدوية أنا وابني، إلا أن النتائج الإيجابية مازالت بعيدة جدًا. صحيح أنني لم أواجه أية مشكلة مع التنفس، ولم يختنق صدري، ولم يتعطل تدفق الأكسجين في الجسم، إلا أن الصداع مزلزل، والوهن يدفع مياه الحياة إلى التسرب من الجسد.
منذ اقتحم كورونا السافل كوكبنا قبل أكثر من عام وأنا أتناول يوميًا الزنك وفيتامين سي تفاديًا لغدر قاتل غير مرئي أودي بحياة نحو ثلاثة ملايين إنسان وأصاب عشرات الملايين غيرهم، ولما غزاني هذا المتوحش قبل أيام أضفت لهما فيتامين (دي 5000) بناء على تعليمات الطبيب. وسقطت فريسة لهاجس غامض يؤكد لي إذا استعدت حاسة الشم فاعلم أنها بشارة القضاء على هذا الفيروس الحقير، فكنت كل ساعة أتوجه إلى المطبخ لأجرب أنفي مع الكمون، لأعود منكسر الخاطر خاسف البال، واكتشفت أن المرء بدون حاسم الشم مثل بيت بلا نوافذ، لا ينعم بلذة التواصل مع الأشياء والكائنات!
كنت سعيدًا جدًا لأن ابني يقيم معي بعد حرمان قاسٍ مفاجئ استمر نحو ثلاث سنوات، لكني كنت حزينا أكثر لأنه مصاب بكورونا، وبدأت أحاوره بعمق حول دراسته وأفكاره وطموحاته وأصدقائه، وفرحت جدًا لأنني استعدت حرارة العيش معًا في بيت واحد، فأنا كائن (بيتوتي) كما يقولون، ولم أكن أتخيل لحظة أنني سأكمل الستين وأنا أعيش وحيدًا. وهكذا مضيت أتناقش مع باسم فيما سنأكل واقترح عليه المطاعم المختلفة التي سنطلب منها الوجبات الجاهزة، فأنا للأسف نسيت مذاق الطعام المنزلي منذ أجبرتني ظروف بغيضة شريرة على الإقامة بمفردي وأنا على مشارف عامي الثامن والخمسين، وقد فاجأني باسم بلائحة طعام متنوعة، فمرة طلب كباب وكفتة ومرة طلب السمك المقلي والجمبري المشوي ومرة طلب فطائر بالتونة وهكذا، كل يوم له مطلب مختلف من مطعم مختلف، خاصة وأن تعليمات الأطباء أكدت بأننا يجب أن نتغذي جيدًا مع تناول العصائر والفواكه طوال اليوم لتعزيز قوة المناعة في جسدينا.
لكن أجمل ما في هذه التجربة المُرّة تمثل في حنان باسم، إذ لاحظ أنني أتعذب إذا تحركت وأن قدميّ ثقيلتان على الأرض لا أملك (رفاهية) رفعهما للسير ولو لعدة خطوات، فطلب مني ألا أقوم من سريري، وبدأ هو يعد لي الشاي أو يغسل الصحون عقب تناول الطعام أو يأتيني بالماء والأدوية أو يضع الغسيل في الغسالة ثم يتولى نشره وهكذا، وكنت أشفق عليه من هذه الأعمال المنزلية التي لم يتعود عليها، فحاولت قدر طاقتي ألا أرهقه، فكنت استغل فترة نومه، وأتولى القيام بهذه الأعمال على حسب القدرة.
اندلعت المعركة المحتدمة إذن بين مجرم غدّار خفي وجسد هزيل لكنه معزز بالأمل، وظلت دائرة بين كر وفر لمدة أسبوع أو يزيد، فساعات ينتصر الفيروس ويطرحني أرضا ويجردني من كل قوة بدنية أو طاقة نفسية، وساعات أهزمه وأسترد عافيتي بشكل معقول، وهكذا يمضي اليوم بين إقدام وإحجام، بين خمول وعنفوان، بين عجز وحيوية، وفي اللحظة التي رحل فيها الصديق العزيز الغالي الدكتور شاكر عبدالحميد ليلة الخميس 18 مارس، كنت أخوض أشرس صراع مع كورونا المرعب، فقد تمكن مني تمامًا، فسطا على حواسي كلها ونزع عني أي صلابة جسدية، وسخر من طاقاتي المتعددة وهي منطرحة أمامه بلا حول ولا قوة حتى غلبني النوم، ولما صحوت في الثالثة فجرًا مهدود الحيل، فوجئت بخبر غياب الصديق الدكتور شاكر عبدالحميد بسبب كورونا فطفرت من عينيّ الدموع، وحزنت جدًا لأنه لم يتسن له أخذ اللقاح.
لم أشأ أن أخبر أيًا من أهلي أو أصدقائي في القاهرة بأن الفيروس الملعون قد تسلل إلى جسدي حتى لا أقلق أحدًا، وحاولت قدر طاقتي الرد على الرسائل المعتادة للأحبة والأهل عبر الواتساب بهدوء وترحاب، كذلك تعاملت مع فيسبوك وتويتر بما تيسر من ردود وتعليقات فرضتها الضرورات الاجتماعية والمجاملات المنطقية وقدراتي الصحية، وقلت في نفسي: (سأدوّن تجربتي النادرة مع هذا البغيض عندما يتحقق لي النصر في النهاية).
ومساء أول أمس، وبينما أحاول باستماتة التملص من خبث هذا القاتل الماكر، تلاطمت في جمجمتي الأسئلة: رغم أنني تحصنت باللقاح، إلا أن الفيروس الجبار كاد يفتك بجسدي فتكا، فكيف كان عذاب الذين حرموا من اللقاح؟ وكيف تحمّل أصدقاؤنا الراحلون أوجاع الأيام والساعات الأخيرة قبل أن يجود كل واحد منهم بآخر شهيق؟ بل كيف ينام مسؤولو وزارة الصحة في بلادنا دون أن يعملوا على توفير اللقاح بأقصى سرعة لجميع الناس في مصر؟
واليوم 21 مارس أكمل عامي الستين بروح شاب وقلب وثاب، وأغلب الظن أن بشائر النصر على الفيروس النذل تلوح في الأفق، فجسدي أكثر توازنا وأعضائي أكثر انسجامًا، وقد استرددت حاسة الشم بنسبة ثلاثين في المائة تقريبًا، ومع ذلك سنظل أنا وابني ملتزمين في البيت حتى السبت القادم تنفيذا لتعليمات الأطباء هنا في دبي، وبعدها سنجري الاختبارات اللازمة وأتمنى وأتوقع أنها ستشي بالتخلص تمامًا من آثار هذا الكابوس والنصر العظيم على ذاك المجرم الجبان، لننطلق بعدها نحو دروب الحياة مفعمين بالأمل في اقتناص السعادة وقطف زهور الفرح وورود السرور إيذانا ببدء الستين عامًا الثانية من عمري… وكل عام وأنتم طيبون.