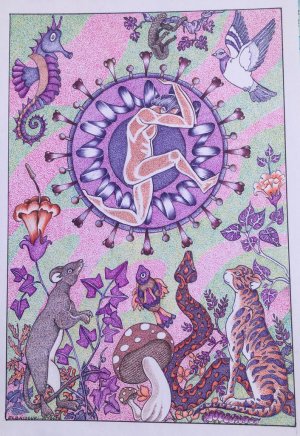هناك ما يعرف بمجموعة السوائل، وهي بضعة كتب (سبعة) لعالم الاجتماع البولندي "زيجمونت باومن"، ومن ضمنها كتاب "الخوف السائل"، وهو يتكلم عن عدم تحقيق الحداثة لوعودها في القضاء على خوف الإنسان، بل صار الخوف هو سمة العصر البارزة على أكثر من صعيد شخصي واجتماعي وسياسي ووجودي... وها هي الفكرة تتجلى على نحو تطبيقي مرعب بعد موت صاحب هذا الكتاب بسنوات، أثناء ظهور هذه الجائحة الكونية وانفلات خيوطها الغامضة في وجه البشرية المصدوم والمكلوم. صرنا جميعاً بشراً محكومين بالتكيف مع هذه اللعنة التي أصابتنا، وكانت مفاجِئةً ومباغتة مما أثّر على طرائق عيشنا وطبيعة يومياتنا وبرامجنا في قضاء الوقت واستغلاله سواءً أكانت هذه البرامج مخططة مدبرة أم فوضويةً مشتتةً.
صرنا، إذن، أفراداً ومجتمعاتٍ ومؤسساتٍ، نعيش وضعاً استثنائيا بكل المقاييس. ليس ثمة قطاع لم يتأثر بتبعات هذه اللعنة المنتشرة والناشرة رعباً وأضراراً على كل فرد وعلى عصب كل مكان. وربما كانت الثقافة وقطاعها المؤسسي الحكومي والأهلي، الأدبي والفكري والفني والثقافي خاصة، أكثر تأثراً بهذا الوضع المضطرب المتذبذب غير المستقر، لأسباب تتعلق بنظرة فاترة وقاصرة ومبتسرة وسطحية من الأفراد والمجتمعات والحكومات إلى هذا القطاع المهم والمؤثر، حيث يعتبرونه من بين القطاعات غير المنتجة، لأن لهم مفاهيمهم الخاصة للثقافة ولمعنى أن يكون هذا القطاع منتجاً أو غير منتج. فكل ما يدرُّ أرباحاً وفوائد عاجلة سهلة المنال ويحقق أهدافه على مدى زمني قصير الأجل يصبح قطاعاً منتجاً بنظرهم، غير أن الثقافة لا تتسم بهذه السرعة والسهولة في قطف النتائج وحصادها حيث تكون ثمارها بعيدة المدى والآجال في تربية الأذواق والأفهام والعقول والنفوس حضارياً وإنسانياً واجتماعياً وعلى كلّ صعيد، مما يجنب الأمم والشعوب مخاطر الانزلاق إلى مهاوي الإرهاب والتطرف والحروب الأهلية العبثية المدمرة المُكلفة. أتذكر بعد تراجع اشتداد أيام الإغلاق، وبعد خفوت حالة الرعب المستعرة في كل الوجوه الآدمية وفي كل مكان، ذهبتُ إلى المكتبة العامة لإرجاع كتب كنت قد استعرتها، وكانت أغلب المرافق الحيوية من مطاعم ومقاهٍ ومجمعات تجارية ومحلات بيع السلع الاستهلاكية وسواها قد تم استئناف العمل بها في البحرين(ربما باستثناء دور السينما وصالونات الحلاقة ومقاهي تدخين الشيشة والقاعات الرياضية)، وإذا بحارس مبنى المكتبة ينبهني إلى أن زيارات المراجعين والمرتادين للمكتبة ما يزال ممنوعاً. سألت من بعيد أمينات المكتبة في مكتب الاستقبال، ملتمساً استثناءً للمرة الأخيرة إلى أن تسمح القوانين ويحلّ موسم الانفراج، وكان الجواب حاسماً جازماً بمنع التردد على المكتبات العامة واستعارات المصادر أو حتى إرجاعها. قلت وقد اختلطت في نفسي وجوه الجدّ والهزل: فعلاً، لا تنتقل الفيروسات إلا هنا في المكتبات وقاعات الثقافة، أما هناك في المطاعم والمجمعات التجارية وأماكن الترفيه والشراء الاستهلاكي فلا أبداً، فهي حصينة منيعة لا يأتيها الفيروس من بين يديها ولا من خلفها.
على الجانب الآخر، ثمة ظواهر مضيئة خلقتها أو كشفتها الأزمة، بصفتها نقمة يكمن في أحشاء بواطنها النِعمُ والإضاءاتُ المثمرة والكاشفة. هذا السيل المنهمر من الفعاليات الثقافية الذي امتلأ به الفضاء الافتراضي كشف عن الجانب الإنساني المضي لهذه "الحداثة السائلة" إذا استعرنا مصطلح "باومن" في المنحى الإيجابي. وكأنَّ الآلة اشتغلت بالضد من منطقها، حيث دائما ما كنا نصمها بالتوحش والتبلد واللاإنسانية، حتى اكتشفنا مؤخراً بُعداً إنسانياً حميماً. اكتشفنا أخيراً أن الآلة ليست دائماً حديداً متوحشاً يعزز عدم التواصل الإنساني ويُفقدنا مشاعرنا الجياشة. تكنولوجيات ورقميات وبرامج وتطبيقات ووسائط لم نكن نعرف عنها شيئاً، وإذا بنا كمثقفين ناشطين نبحر ونتعمق في فضائها الإنساني والثقافي اللامتناهي، وإذا بمؤسساتنا الثقافية الرسمية والأهلية تستثمرها استثماراً جيدا في التواصل الثقافي وفي إقامة البرامج والفعاليات والمؤتمرات والملتقيات على أكثر من جانب وأكثر من موضوع، حتى صرنا نحلم باستعادة حالة الجدل الفكري والحوار الفلسفي والأدبي والنقدي المستمر والخلاق والمهم لكل الأمم التي تسعى لتتبوأ مكانة مرموقة وتساهم في البناء الحضاري وانتاجاته الإنسانية المتلاحقة على الصُعد العلمية والأدبية والفنية والفكرية والثقافية. حتى أصبح بعضُنا يتساءل بتهكم: ماذا سنفعل بكل هذا الكم الهائل ممن أصبحوا إعلاميين ومسيّرين ومدونين ووعاظاً ومذيعين وغيرهم، بعد أن ينجلي غبار الجائحة الكثيف؟! لكني أتصور أنه من الضروري لنا، كناشطين ثقافيين نعيش هذا العصر الرقمي، أن نستثمر إمكانات الوسائط التكنولوجية الرقمية وطاقاتها الهائلة حتى بعد انجلاء الأزمة الكونية. لم نكن بحاجة إلى جائحة كبيرة لتتكشف أمامنا الأبعاد الإنسانية العميقة لهذه الساحة الغريبة. أقصد أن مساحات جميلة بانتظار مخيلتنا وعقولنا وبصيرتنا لو كُنا نُحسن النظر إلى الأشياء ونُكيّفها لصالح تعزيز البُعد الإنساني فيها وفينا.
في ما يخص أثر الجائحة عليّ شخصياً أزعم أنه لا تغيير جوهريا في منحى حياتي، لكن إن شئت الدقة والتمحيص فإن فائض الوقت المتاح للقراءة والكتابة أصبح نسبياً أكثر من الفترة التي سبقتها. كانت دور النشر العربية وربما الأجنبية أيضا، ومحلات الكتب والمواقع الإلكترونية المتخصصة ببيع الكتب قد أشارت في أكثر من استطلاع واستبيان ومقابلة مؤخراً إلى زيادة الطلب على شراء الكتب من خلال الشحن والتوصيل إلى المنازل. هذا مؤشر واضح يدلّ على أن فوائض الوقت التي كنا نبددها في المجمعات وأماكن الترفيه والاستهلاك من الممكن أن تصير طوع أيدينا الآن في زمن الحجر المنزلي والتباعد المفروض علينا. هل سنعود إلى أنفسنا ونسألها عن كمية الساعات المخصصة للقراءة، وهل سيعود الكتاب جزءاً أساسياً في حياتنا اليومية حتى لو انقضت أيام العزلة القاسية وجاءت أيام الطمأنينة والرخاء؟ هل كنا في حاجة إلى جائحة أصلاً لنكتشف كم المتعة والغبطة والأريحية التي تتيحها لأرواحنا عادة القراءة؟
في نظري، لا أمل في حياة دون كتب واحتدام أفكار وموسيقى ومسارح وسينما ومعارض وفعاليات تُطرح من خلالها الأسئلة والقضايا والموضوعات الهامة. ما ينجينا من زمن الخوف هو ما يمكن أن يُحيي في دواخلنا المخيلة والعقل والحدس والإلهام وشهوة الحلم. سنكون في أتون أزمات نفسية يكتنفها الذعر والارتياب وفوبيات لها أول وليس لها آخِر، تتوازى وتستتبع هذه الأزمة الوبائية الطاحنة، إن لم نعالج نفوسنا بالدخول في حيوات ثقافية وفنية تتواصل مع الذات والآخر. إن مشكلتنا في العمق ثقافية أكثر من أي شيء آخر. الثقافة بمعناها العميق وليس كما يُراد لها أن تكون من قبل بعض الأطراف التي تتخذها استثماراً لتشغيلها في مآرب أخرى بعيدة كلَّ البعد عن أهدافها وجوهرها. الثقافة ليست مسألة إكسسوارية ترفية. المعرفة قوة لكل إنسان يدبّ على وجه هذه الأرض مهما كان نوع اشتغاله وعمله. النجار القارئ أفضل من نجار لا يقرأ. وسائق التاكسي الذي يقرأ أفضل بالتأكيد من زميله الذي لا يقرأ. والشاعر الذي يقرأ أفضل بمليون مرة من شاعر لا يقرأ. بل حتى الأزمات السياسية والاجتماعية يمكن أن تكون أسبابها قلة أو انعدام القراءة إذا نظرنا إليها بأبعادها الشاملة. السياسي الذي يقرأ جيداً خير بألف مرة من سياسي لا يقرأ، ولا يفكر حتى وإن قرأ، لأنه لم يقرأ بروحه وجسده وكيانه كله، أي أنه في الحقيقة لم يقرأ.
ببساطة لو كنا قُراء حقيقيين، هل صرنا حطباً لنيران حروب تأكل حيواتنا وثرواتنا في كل لحظة؟ لو كنا نقرأ فعلاً، هل ستكون حالتنا العامة فيها من الجهل والحرمان والأمراض والظلام والبؤس والقبح والموت أكثر مما فيها من العلم والضوء والحياة والجمال؟
صرنا، إذن، أفراداً ومجتمعاتٍ ومؤسساتٍ، نعيش وضعاً استثنائيا بكل المقاييس. ليس ثمة قطاع لم يتأثر بتبعات هذه اللعنة المنتشرة والناشرة رعباً وأضراراً على كل فرد وعلى عصب كل مكان. وربما كانت الثقافة وقطاعها المؤسسي الحكومي والأهلي، الأدبي والفكري والفني والثقافي خاصة، أكثر تأثراً بهذا الوضع المضطرب المتذبذب غير المستقر، لأسباب تتعلق بنظرة فاترة وقاصرة ومبتسرة وسطحية من الأفراد والمجتمعات والحكومات إلى هذا القطاع المهم والمؤثر، حيث يعتبرونه من بين القطاعات غير المنتجة، لأن لهم مفاهيمهم الخاصة للثقافة ولمعنى أن يكون هذا القطاع منتجاً أو غير منتج. فكل ما يدرُّ أرباحاً وفوائد عاجلة سهلة المنال ويحقق أهدافه على مدى زمني قصير الأجل يصبح قطاعاً منتجاً بنظرهم، غير أن الثقافة لا تتسم بهذه السرعة والسهولة في قطف النتائج وحصادها حيث تكون ثمارها بعيدة المدى والآجال في تربية الأذواق والأفهام والعقول والنفوس حضارياً وإنسانياً واجتماعياً وعلى كلّ صعيد، مما يجنب الأمم والشعوب مخاطر الانزلاق إلى مهاوي الإرهاب والتطرف والحروب الأهلية العبثية المدمرة المُكلفة. أتذكر بعد تراجع اشتداد أيام الإغلاق، وبعد خفوت حالة الرعب المستعرة في كل الوجوه الآدمية وفي كل مكان، ذهبتُ إلى المكتبة العامة لإرجاع كتب كنت قد استعرتها، وكانت أغلب المرافق الحيوية من مطاعم ومقاهٍ ومجمعات تجارية ومحلات بيع السلع الاستهلاكية وسواها قد تم استئناف العمل بها في البحرين(ربما باستثناء دور السينما وصالونات الحلاقة ومقاهي تدخين الشيشة والقاعات الرياضية)، وإذا بحارس مبنى المكتبة ينبهني إلى أن زيارات المراجعين والمرتادين للمكتبة ما يزال ممنوعاً. سألت من بعيد أمينات المكتبة في مكتب الاستقبال، ملتمساً استثناءً للمرة الأخيرة إلى أن تسمح القوانين ويحلّ موسم الانفراج، وكان الجواب حاسماً جازماً بمنع التردد على المكتبات العامة واستعارات المصادر أو حتى إرجاعها. قلت وقد اختلطت في نفسي وجوه الجدّ والهزل: فعلاً، لا تنتقل الفيروسات إلا هنا في المكتبات وقاعات الثقافة، أما هناك في المطاعم والمجمعات التجارية وأماكن الترفيه والشراء الاستهلاكي فلا أبداً، فهي حصينة منيعة لا يأتيها الفيروس من بين يديها ولا من خلفها.
على الجانب الآخر، ثمة ظواهر مضيئة خلقتها أو كشفتها الأزمة، بصفتها نقمة يكمن في أحشاء بواطنها النِعمُ والإضاءاتُ المثمرة والكاشفة. هذا السيل المنهمر من الفعاليات الثقافية الذي امتلأ به الفضاء الافتراضي كشف عن الجانب الإنساني المضي لهذه "الحداثة السائلة" إذا استعرنا مصطلح "باومن" في المنحى الإيجابي. وكأنَّ الآلة اشتغلت بالضد من منطقها، حيث دائما ما كنا نصمها بالتوحش والتبلد واللاإنسانية، حتى اكتشفنا مؤخراً بُعداً إنسانياً حميماً. اكتشفنا أخيراً أن الآلة ليست دائماً حديداً متوحشاً يعزز عدم التواصل الإنساني ويُفقدنا مشاعرنا الجياشة. تكنولوجيات ورقميات وبرامج وتطبيقات ووسائط لم نكن نعرف عنها شيئاً، وإذا بنا كمثقفين ناشطين نبحر ونتعمق في فضائها الإنساني والثقافي اللامتناهي، وإذا بمؤسساتنا الثقافية الرسمية والأهلية تستثمرها استثماراً جيدا في التواصل الثقافي وفي إقامة البرامج والفعاليات والمؤتمرات والملتقيات على أكثر من جانب وأكثر من موضوع، حتى صرنا نحلم باستعادة حالة الجدل الفكري والحوار الفلسفي والأدبي والنقدي المستمر والخلاق والمهم لكل الأمم التي تسعى لتتبوأ مكانة مرموقة وتساهم في البناء الحضاري وانتاجاته الإنسانية المتلاحقة على الصُعد العلمية والأدبية والفنية والفكرية والثقافية. حتى أصبح بعضُنا يتساءل بتهكم: ماذا سنفعل بكل هذا الكم الهائل ممن أصبحوا إعلاميين ومسيّرين ومدونين ووعاظاً ومذيعين وغيرهم، بعد أن ينجلي غبار الجائحة الكثيف؟! لكني أتصور أنه من الضروري لنا، كناشطين ثقافيين نعيش هذا العصر الرقمي، أن نستثمر إمكانات الوسائط التكنولوجية الرقمية وطاقاتها الهائلة حتى بعد انجلاء الأزمة الكونية. لم نكن بحاجة إلى جائحة كبيرة لتتكشف أمامنا الأبعاد الإنسانية العميقة لهذه الساحة الغريبة. أقصد أن مساحات جميلة بانتظار مخيلتنا وعقولنا وبصيرتنا لو كُنا نُحسن النظر إلى الأشياء ونُكيّفها لصالح تعزيز البُعد الإنساني فيها وفينا.
في ما يخص أثر الجائحة عليّ شخصياً أزعم أنه لا تغيير جوهريا في منحى حياتي، لكن إن شئت الدقة والتمحيص فإن فائض الوقت المتاح للقراءة والكتابة أصبح نسبياً أكثر من الفترة التي سبقتها. كانت دور النشر العربية وربما الأجنبية أيضا، ومحلات الكتب والمواقع الإلكترونية المتخصصة ببيع الكتب قد أشارت في أكثر من استطلاع واستبيان ومقابلة مؤخراً إلى زيادة الطلب على شراء الكتب من خلال الشحن والتوصيل إلى المنازل. هذا مؤشر واضح يدلّ على أن فوائض الوقت التي كنا نبددها في المجمعات وأماكن الترفيه والاستهلاك من الممكن أن تصير طوع أيدينا الآن في زمن الحجر المنزلي والتباعد المفروض علينا. هل سنعود إلى أنفسنا ونسألها عن كمية الساعات المخصصة للقراءة، وهل سيعود الكتاب جزءاً أساسياً في حياتنا اليومية حتى لو انقضت أيام العزلة القاسية وجاءت أيام الطمأنينة والرخاء؟ هل كنا في حاجة إلى جائحة أصلاً لنكتشف كم المتعة والغبطة والأريحية التي تتيحها لأرواحنا عادة القراءة؟
في نظري، لا أمل في حياة دون كتب واحتدام أفكار وموسيقى ومسارح وسينما ومعارض وفعاليات تُطرح من خلالها الأسئلة والقضايا والموضوعات الهامة. ما ينجينا من زمن الخوف هو ما يمكن أن يُحيي في دواخلنا المخيلة والعقل والحدس والإلهام وشهوة الحلم. سنكون في أتون أزمات نفسية يكتنفها الذعر والارتياب وفوبيات لها أول وليس لها آخِر، تتوازى وتستتبع هذه الأزمة الوبائية الطاحنة، إن لم نعالج نفوسنا بالدخول في حيوات ثقافية وفنية تتواصل مع الذات والآخر. إن مشكلتنا في العمق ثقافية أكثر من أي شيء آخر. الثقافة بمعناها العميق وليس كما يُراد لها أن تكون من قبل بعض الأطراف التي تتخذها استثماراً لتشغيلها في مآرب أخرى بعيدة كلَّ البعد عن أهدافها وجوهرها. الثقافة ليست مسألة إكسسوارية ترفية. المعرفة قوة لكل إنسان يدبّ على وجه هذه الأرض مهما كان نوع اشتغاله وعمله. النجار القارئ أفضل من نجار لا يقرأ. وسائق التاكسي الذي يقرأ أفضل بالتأكيد من زميله الذي لا يقرأ. والشاعر الذي يقرأ أفضل بمليون مرة من شاعر لا يقرأ. بل حتى الأزمات السياسية والاجتماعية يمكن أن تكون أسبابها قلة أو انعدام القراءة إذا نظرنا إليها بأبعادها الشاملة. السياسي الذي يقرأ جيداً خير بألف مرة من سياسي لا يقرأ، ولا يفكر حتى وإن قرأ، لأنه لم يقرأ بروحه وجسده وكيانه كله، أي أنه في الحقيقة لم يقرأ.
ببساطة لو كنا قُراء حقيقيين، هل صرنا حطباً لنيران حروب تأكل حيواتنا وثرواتنا في كل لحظة؟ لو كنا نقرأ فعلاً، هل ستكون حالتنا العامة فيها من الجهل والحرمان والأمراض والظلام والبؤس والقبح والموت أكثر مما فيها من العلم والضوء والحياة والجمال؟