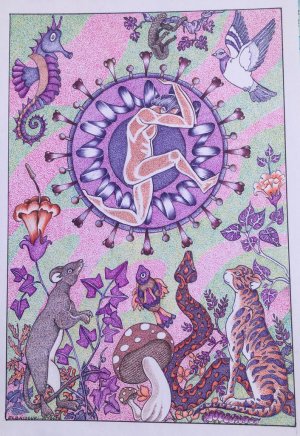قد لا تترك لنا الكوارث غير الدّمار والتّقهقر والانهيار، لكنّها قد تقدّم لنا في بعض الأحيان فرصة ثمينة لأجل إنجاز طفرات مهمّة في الحياة والنّمو والتّطور والتّاريخ. في كلّ الأحوال يتحدّد المآل انطلاقا من الحالة الثّقافيّة والوضع النّفسي للشّعوب، وتحديداً انطلاقا من تأويل النّاس للكارثة. لذلك طبيعي أن تكون الكوارث مجالا لصراع التّأويلات.
ماذا أقصد بهذا الكلام؟
ضمن شروط الوضع البشريّ هناك معادلة أساسيّة يجب استحضارها على الدّوام، مفادها أنّ العلاقة بين السّبب والنّتيجة ليست علاقة ميكانيكيةّ ومباشرة، كما أنّها ليست علاقة انعكاس شرطي وفق تصوّر بعض المدارس الكلاسيكيّة في حقل العلوم الإنسانيّة، بل هي أكثر تعقيدا من ذلك كلّه. إذ بين الحدث ونتائج الحدث يتدخّل عنصر حاسم وهو عنصر التّأويل، والّذي هو بمثابة رهان ثقافي في آخر المطاف. هنا يكمن الرّهان الأساسي على المثقّفين والفنّانين الإعلاميين التّنويريين في كلّ الظّروف، بل حتّى في أسوأ الظّروف، وهو رهان ليس بالهيّن، كما لا يمكن الاستهانة به.
هل لعب المثقّفون عندنا دورهم المنتظر لأجل حسم صراع التّأويلات الجاري حول جائحة كورونا؟ هذا السّؤال يبقى مفتوحا، وهو مجال آخر للقول والتّقييم والنّقاش.
في كلّ الأحوال، يظلّ تأويلنا للكارثة بمثابة العامل الحاسم في تحديد مآلات ما بعد الكارثة. الأمثلة كثيرة، من بينها مثلا، إذا فهمنا أنّ جائحة كورونا في أصلها عبارة عن فيروس تطوّر بنحو مفاجئ، وتفشى بشكل سريع، لكنّه يظلّ فيروسا طبيعيا كذلك، ويحتاج بالتّالي إلى طبّ وأدوية وعلم ومختبرات، فالمسار سيكون في النّهاية هو دعم قطاعات الصّحة والتّعليم والبحث العلميّ؛ أمّا إذا تصوّرنا أنّها مؤامرة أجنبيّة أو أنّها من بين الأخطار الّتي لا يمكن أن تأتي إلاّ من الخارج فالمسار في النّهاية سيكون هو دعم قطاعات الأمن والدّفاع والجمارك؛ غير أنّنا إذا تخيّلنا أنّها غضب من عند الله فستكون المسارات معلومة بالضّرورة، ولنا الخيار في الأخير.
مهما يكن فلا يمكن للتّأويلات الّتي تخضع لها الكارثة أن تكون متساوية من حيث القيمة والفائدة والجدوى. بل هناك دائما تأويلات تكون جيدة أو متفاوتة الجودة، مقابل تأويلات تكون سيّئة أو متفاوتة السّوء. لكن هل هناك من مقياس للحكم على جودة التّأويلات؟ بالفعل هناك مقياس واضح ومقنع وفعّال: التّأويلات الجيدّة هي الّتي تساهم في تحقيق نتائج تُحسن من قدرتنا على مقاومة كارثة مماثلة في المستقبل. ومن دون شكّ فإنّ مثل هذا الهدف سيكون قابلا للتّحقّق، وقابلا للقياس كذلك.
كيف ندعم التّأويلات الجيّدة والأكثر جودة؟ وكيف نتفادى التّأويلات السيّئة والأكثر سوءا؟
ثمّة مبدأ عام يمكن اعتماده، ويمكن صياغته على النّحو التّالي: حين تكون الرّوح العامّة معافاة يكون التّأويل العامّ معافى كذلك، والعكس صحيح. مثلا، لا يمكن للأرواح الخائفة أن تنتج سوى تأويلات غيبيّة تشلّ القدرة على التّفكير، كما لا يمكن للأرواح الحزينة أن تنتج سوى تأويلات سوداويّة تشلّ القدرة على الحياة، كما أنّ الأرواح الغاضبة لا يمكن أن تنتج سوى تأويلات حاقدة تشلّ القدرة على العيش المشترك، وهكذا دواليك.
تلك هي أمراض الرّوح باقتضاب، والّتي يسمّيها سبينوزا بالأهواء الحزينة، ويسمّيها نيتشه بغرائز الانحطاط، ويسمّيها فرويد بدوافع التّدمير، والّتي تفرز بعض المظاهر الاجتماعيّة والسّلوكيّة الّتي تهدّد النّمو والأمن والتّنمية، ضمن ما يشكّل الرّوح العامّة لبعض المجتمعات، من بينها ما نراه في سياق مواجهة الظّروف العصيبة، من أنّ المرء قد يرى في كلّ أزمة دليلاً على الإفلاس، وفي كلّ فشل دليلا على النّهاية، وفي كلّ كارثة علامة على بداية أهوال القيامة. وطالما الأمر كذلك فإنّ علاج أمراض الرّوح لا يقلّ أهميّة عن علاج أمراض الجسد والنّفس، حتّى في زمن الجائحات والأوبئة، وفي سائر الكوارث الأخرى.
علاج الرّوح، وظيفة من إذاً؟
إنّه وظيفة الحكماء باعتبارهم أطبّاء الحضارة، والفلاسفة باعتبارهم ممرضين. وهذا النّمط من تقسيم الأدوار قد أعود إلى توضيحه لاحقا. لكن ما دور المعالجين النّفسانيين؟ إنّهم يتكفّلون بالأفراد حصراً، وهم أطباء بالمعنى المهنيّ للكلمة.
في مواجهة وجود محكوم بالهشاشة، والنّقص، والخيبة، فإنّ خير الدّواء هو الحكمة. الحكمة أوّلا ودائما. صحيح أنّنا لا نستطيع الاقتصار عليها، لكنّ الأصحّ أيضا أنّنا لا نستطيع الاستغناء عنها. ولذلك جاء في الخطاب القرآنيّ، “من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا”.
سعيد ناشيد
ماذا أقصد بهذا الكلام؟
ضمن شروط الوضع البشريّ هناك معادلة أساسيّة يجب استحضارها على الدّوام، مفادها أنّ العلاقة بين السّبب والنّتيجة ليست علاقة ميكانيكيةّ ومباشرة، كما أنّها ليست علاقة انعكاس شرطي وفق تصوّر بعض المدارس الكلاسيكيّة في حقل العلوم الإنسانيّة، بل هي أكثر تعقيدا من ذلك كلّه. إذ بين الحدث ونتائج الحدث يتدخّل عنصر حاسم وهو عنصر التّأويل، والّذي هو بمثابة رهان ثقافي في آخر المطاف. هنا يكمن الرّهان الأساسي على المثقّفين والفنّانين الإعلاميين التّنويريين في كلّ الظّروف، بل حتّى في أسوأ الظّروف، وهو رهان ليس بالهيّن، كما لا يمكن الاستهانة به.
هل لعب المثقّفون عندنا دورهم المنتظر لأجل حسم صراع التّأويلات الجاري حول جائحة كورونا؟ هذا السّؤال يبقى مفتوحا، وهو مجال آخر للقول والتّقييم والنّقاش.
في كلّ الأحوال، يظلّ تأويلنا للكارثة بمثابة العامل الحاسم في تحديد مآلات ما بعد الكارثة. الأمثلة كثيرة، من بينها مثلا، إذا فهمنا أنّ جائحة كورونا في أصلها عبارة عن فيروس تطوّر بنحو مفاجئ، وتفشى بشكل سريع، لكنّه يظلّ فيروسا طبيعيا كذلك، ويحتاج بالتّالي إلى طبّ وأدوية وعلم ومختبرات، فالمسار سيكون في النّهاية هو دعم قطاعات الصّحة والتّعليم والبحث العلميّ؛ أمّا إذا تصوّرنا أنّها مؤامرة أجنبيّة أو أنّها من بين الأخطار الّتي لا يمكن أن تأتي إلاّ من الخارج فالمسار في النّهاية سيكون هو دعم قطاعات الأمن والدّفاع والجمارك؛ غير أنّنا إذا تخيّلنا أنّها غضب من عند الله فستكون المسارات معلومة بالضّرورة، ولنا الخيار في الأخير.
مهما يكن فلا يمكن للتّأويلات الّتي تخضع لها الكارثة أن تكون متساوية من حيث القيمة والفائدة والجدوى. بل هناك دائما تأويلات تكون جيدة أو متفاوتة الجودة، مقابل تأويلات تكون سيّئة أو متفاوتة السّوء. لكن هل هناك من مقياس للحكم على جودة التّأويلات؟ بالفعل هناك مقياس واضح ومقنع وفعّال: التّأويلات الجيدّة هي الّتي تساهم في تحقيق نتائج تُحسن من قدرتنا على مقاومة كارثة مماثلة في المستقبل. ومن دون شكّ فإنّ مثل هذا الهدف سيكون قابلا للتّحقّق، وقابلا للقياس كذلك.
كيف ندعم التّأويلات الجيّدة والأكثر جودة؟ وكيف نتفادى التّأويلات السيّئة والأكثر سوءا؟
ثمّة مبدأ عام يمكن اعتماده، ويمكن صياغته على النّحو التّالي: حين تكون الرّوح العامّة معافاة يكون التّأويل العامّ معافى كذلك، والعكس صحيح. مثلا، لا يمكن للأرواح الخائفة أن تنتج سوى تأويلات غيبيّة تشلّ القدرة على التّفكير، كما لا يمكن للأرواح الحزينة أن تنتج سوى تأويلات سوداويّة تشلّ القدرة على الحياة، كما أنّ الأرواح الغاضبة لا يمكن أن تنتج سوى تأويلات حاقدة تشلّ القدرة على العيش المشترك، وهكذا دواليك.
تلك هي أمراض الرّوح باقتضاب، والّتي يسمّيها سبينوزا بالأهواء الحزينة، ويسمّيها نيتشه بغرائز الانحطاط، ويسمّيها فرويد بدوافع التّدمير، والّتي تفرز بعض المظاهر الاجتماعيّة والسّلوكيّة الّتي تهدّد النّمو والأمن والتّنمية، ضمن ما يشكّل الرّوح العامّة لبعض المجتمعات، من بينها ما نراه في سياق مواجهة الظّروف العصيبة، من أنّ المرء قد يرى في كلّ أزمة دليلاً على الإفلاس، وفي كلّ فشل دليلا على النّهاية، وفي كلّ كارثة علامة على بداية أهوال القيامة. وطالما الأمر كذلك فإنّ علاج أمراض الرّوح لا يقلّ أهميّة عن علاج أمراض الجسد والنّفس، حتّى في زمن الجائحات والأوبئة، وفي سائر الكوارث الأخرى.
علاج الرّوح، وظيفة من إذاً؟
إنّه وظيفة الحكماء باعتبارهم أطبّاء الحضارة، والفلاسفة باعتبارهم ممرضين. وهذا النّمط من تقسيم الأدوار قد أعود إلى توضيحه لاحقا. لكن ما دور المعالجين النّفسانيين؟ إنّهم يتكفّلون بالأفراد حصراً، وهم أطباء بالمعنى المهنيّ للكلمة.
في مواجهة وجود محكوم بالهشاشة، والنّقص، والخيبة، فإنّ خير الدّواء هو الحكمة. الحكمة أوّلا ودائما. صحيح أنّنا لا نستطيع الاقتصار عليها، لكنّ الأصحّ أيضا أنّنا لا نستطيع الاستغناء عنها. ولذلك جاء في الخطاب القرآنيّ، “من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا”.
سعيد ناشيد