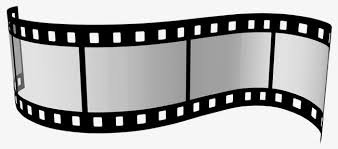صديقي العزيز سامي مهدي.....
في بداية الأسبوع الماضي.. وإذ كان أصدقاؤنا يملأون سهرتنا الموصلية الحميمة ضجيجاً.. كنت أتأمل صمتك.. فأستعيد علاقة تكاد تمتد الي ثلاثة عقود من الزمن.
أليس كذلك؟ إذ كان لقائي الأول بك عام 1963 في صحيفة الجماهير.. أعرف أنك ما عدت تتذكر ذلك اللقاء العابر.. وما ينبغي لك ان تتذكره.. إذ كنت غير معني بما جئت أنا من أجله.. وما قادني إليك إلا غياب الأستاذ العزيز كريم شنتاف.
يومها كنت مكلفا بتقديم طلب لإصدار صحيفة الطلائع في مدينة الحلة.. وإذ توجهت آنذاك الي المرحوم حميد خلخال وكان وزيراً للشؤون الاجتماعية أخبرني رحمه الله بأن أتصل بكريم شنتاف وأنت مكلف بتيسير المهمة التي كنت قد جئت من أجلها.
لم أكن أعرف بغداد.. فكان دليلي الي صحيفة الجماهير صديقي المزمن سلام علي السلطان.. ولأنك وكما عرفت بعد حين تسد فراغ الغائبين قد اقتحمنا عليك لحظات تناول فطورك في قاعة التحرير.. أو هكذا يخيل لي الآن، إذ لم أر قبل ذلك اليوم مبني صحفيا أو زرت مطبعة.. ومع هذا فقد كلفت بإصدار صحيفة.. يا للبراءة!!
وكنت أظن ان ما جئت من أجله لابد ان يعرفه كل العاملين في صحيفة الجماهير.. ولأنك أبديت عدم معرفتك بالأمر.. اتهمتك في سري وفي علني بكل ما يمكن ان يصدر عن طيبة مطلقة..
كان ذلك لقائي الأول بك.. وكان ذلك انطباعي الأول عنك. ثم كان لقاؤك الثاني.. وأظن أنك تحسبه اللقاء الأول. وليكن ذلك.. وكان المكان مقهي البرلمان أما تاريخه ففي بدايات عام 1964. وكنا نعاني معا من آثار الردة التشرينية.. والذي قادني الي ذلك اللقاء صديقنا مالك المطلبي وقد يكون خالد علي مصطفي.. المهم اننا التقينا وما فاجأني في ذلك اللقاء.. ثم في اللقاءات التي جاءت بعده هو مستوي الحوار الذي كان يدور بينكم ومحوره الشعر.. ورغم متعة الاكتشاف فإن سؤالا ظل يلاحقني دون أن أتعجل الاجابة عليه.. والسؤال هو.. هل يستبدل أصحابي مشروعهم الشعري بمشروعهم النضالي.. واعترف انني لم أكن قادرا علي وعي تكامل المشروعين أو وحدتهما.. ولم أكن بعيدا عن الوعي الشائع وهو وعي موروث منذ ان كانت القبيلة تستكمل كينونتها بالشاعر وبالشعر.
أي.. وهذا ما كنت أراه.. ان الشاعر والشعر من مستلزمات القبيلةالسياسية.. أما ان يكون الشاعر بديلا عنها.. فذلك من شيم الذين خلعتهم قبائلهم.. وهذا ما لم أكن أرتضيه للذين أحبهم.. لم أكن قارئا خاملاً.. غير أني لم أتوفر علي فرصة وضع قراءاتي علي محك الحوار.. فإقامتي في الحلة وهي كما تعلم أيها الصديق العزيز.. مدينتي التي ولدت ونشأت فيها.. اعطتني مساحة واسعة للقراءة والحلم والتأمل وحرمتني من محيط يطالبني بإجابات عن إشكاليات الشعر.. أو يحاول فرض إجاباته عليّ.. لقد سبق لي أن كتبت عن هذا الجانب من علاقتي بالشعر.. واكتشفت لاحقاً أن ذلك بعض ما منحني القدرة علي مقاومة اغراءات المحيط الشعري والانصياع لاشتراطات الجماعات الشعرية وتقاليدها.. وكنت في ظروف المحيط الذي أشرت إليه مضطراً لأن أكتشف الأشياء بنفسي.. أسئلة والإجابات.. الرفض والقبول.. المواقف وأضدادها.
هل تستغرب إذا قلت لك ان أفكاري كانت أكثر تنظيماً وكنت أكثر قدرة علي التعبير عنها.. في الفن التشكيلي مثلاً لأنني كنت غير بعيد عن وسط في مدينة الحلة يثير نقاشاً حول قضايا الفن التشكيلي..
ومما يثير ألمي ان فناناً تشكيلياً مهماً هو المرحوم داود سلمان الخلف كان قد درس الرسم في معهد البوزار بباريس.. وعين مدرساً للرسم في متوسطة الحلة عام 1954 واستمرت اقامته في الحلة الي أن توفي فيها ومعظم الرسامين المعروفين الآن هم من طلبته.. ولا أجد من يذكره أو يتذكر دوره وهو الذي طرح أولي قضايا التجديد في وسط لا يتجاوز فهمه للرسم في حدود النقل أو التكبير بالمربعات!! ولا أبالغ إذا قلت ان معرفتي آنذاك بحرفيات السينما والتعبير عنها.. تتجاوز قدرتي علي التعبير عن الشعر وقضاياه، لقد كانت الحلة مدينة سينما.. ففي أوائل الخمسينات وربما في أواخر الأربعينات كان فيها ثلاث دور سينما للعروض الشتوية وداران أو ثلاث دور للعروض الصيفية.. قد تستغرب الأجيال الجديدة حين تعرف بوجود دور سينما للعروض الصيفية.. وفي الهواء الطلق!! وشاهدت في دور العرض تلك أهم أفلام الأربعينات والخمسينات.. ومنذ أواسط الخمسينات بدأ اهتمامي بالمسرح، وطالما حرصت علي مشاهدة العروض المسرحية التي تقدم في بغداد فلم تكن الحلة آنذاك ومثلما هي الآن كذلك..تعرف العروض المسرحية باستثناء بعض العروض المدرسية التي كان لموليير حصة الأسد والفيل فيها.. وقادتني تلك العروض الي نقاشات مع الأصدقاء الذين كنت أرافقهم الي بغداد لمشاهدة ما يعرض من مسرحيات فيها.
كان الشعر يستهويني منذ صباي المبكر.. وأيام التقينا كنت قد قرأت ليس ما يكفي لمعرفة جيدة بالشعر العربي.. قديمه ومعاصره وحديثه.. بل بما يمنحني القدرة علي اتخاذ موقف مما كنت قد قرأت.. غير ان الموقف الذي أشير إليه ظل يعتمد علي نوع من البصيرة التي تأتي باستبطان النص وطول التأمل فيه.. فلم أكن أحفل كثيراً بأحكام المدارس النقدية ولم أتوفر علي صبر يؤهلني للانغمار في تعقيداتها أو الانصياع لأوامرها والرضا بنواهيها.. فهي تطفل علي جماليات الإبداع وتدخل فج في طقوسه الساحرة.. أو هكذا كنت أراها..
قد يتبادر الي ذهنك ما يدفعك الي القول.. هذا وعيك الراهن.. أو لافتراض هذا.. حتي أتيح لنفسي حقيقة انه تعبير الراهن عن وعي كان قائماً.. وإذ أعود الي لقاءاتي الأولي بالوسط الثقافي في بغداد.. أستذكر ما كان يراودني من إحساس بمعرفة تحققت بالقراءة والتأمل غير أنها لا تمتلك القدرة علي الحوار مع الآخر فتعوضه بالحوار مع الذات.. وقد أتاح لي ذلك نوعاً عميقاً من أنواع التأمل وحالة مفتوحة علي أفق اكتشاف الأشياء.. ثم منحني القوة علي رفض الأنماط الشائعة ومواجهة ثقافة الإشاعة والإشاعة الثقافية.. ورأيت في الكثير مما كنت استمع اليه من القول الثقافي إنشاء خاوياً وادعاءات فارغة مصادرهما الاستلاب وفقر الوعي واهتزاز المعرفة.
لم أكن منغلقاً.. ووجدت القليل المفيد من ذلك القول الثقافي أبواباً مشرعة علي حلم كان يراودني.. أن أكتب قصيدتي علي مسافة من قصائد الآخرين.. لا أذهب بها الي حيث تذهب قصائدهم ولا أحرمها من متعة الاقتراب منها.. أو مغامرة الوصول الي أبعد ينابيعها.. ومن هناك تفارقها الي يقينها الخاص.
ها أنذا وبعد ثلاثين عاماً.. أستعيد رؤيتي الشعرية التي جئت بها اليكم من ضفاف الحلم وفراديس الصمت الجميل..
جنون بجماليات اللغة العربية ودأب علي البحث عن خصوصية أسلوبية وتجريب علي شتي جبهات الفعل الشعري.. ومع كل هذا الحلم الطموح لم أكن قد كتبت قصيدتي بعد!! والتي كتبتها لم توفر لي يقين الوصول الي ضفاف الحلم الطموح.. ولم تكن هذه الرؤية محاصرة بوعي نظري يعيقها عن تجاوز نقص الخبرة أو عدم استكمال الأداة القاصرة عن انتاج النص.. بل كانت مفتوحة علي مدي تشكله توصلات وحالات تضاد.. تبدأ من اعجاب لا حدود له ببكارة القصيدة الجاهلية.. واستثناء للمعلقات.. استغراق في لغة جرير وتعاطف مع العذريين ومشاركة الفتيان القرشيين عمر بن أبي ربيعة والعرجي بهجتهما.. أما المتنبي فقد كنت أراه أطول قامة شعرية بين الذين أحببتهم من الشعراء.. ولا أمتلك تبريراً وما أزال..
إحساس بالسيد حيدر الحلي ووقفة عند علي الشرقي.. وإدراك لحيوية الياس أبي شبكة وجماليات علي محمود طه ورعشة في حضرة قاموس محمود حسن اسماعيل ونشوة لا تطول في لقاءات عابرة مع المهجرين.
ضيق بشعراء عصر النهضة يدفعني الي رفقة الجيل الذي تلاهم الجواهري وبدوي الجبل والأخطل الصغير.. حتي سليمان العيسي.. لكن حضور الجواهري يسد الطريق علي سواه من مجايليه..
قناعة تترسخ بأن مستقبل شعرنا في الذي بدأته حركة التجديد.. حيث تتراجع نازك الملائكة عن مجال أسئلتي ويتقدم السياب وخليل الحاوي.. ويظل البياتي في المابين..
لم أسقط في شرك ابتزاز دعاوي التجديد في نصوص مجلة شعر.. ولم تقتحم نماذجها أسراري.. أما أدونيس.. فأعترف أنكم وراء حضوره في محيط اهتماماتي فأدخلته في جغرافية تأملاتي.. بانتظار ما أصل اليه من اكتشاف تضاريس مجاله الشعري..
أخي العزيز..
لا أدري إن كنت وجدتني قد وفقت في رسم صورة تتوفر علي كثير من الدقة والصدق عن رؤيتي الشعرية آنذاك.. أما أنا.. فأكاد أقول.. نعم.
تمر الأعوام.. فتسقط قناعات وتترسخ أخري.. وتهتز مسلمات وتخترم بعضها أسئلة جديدة..
تحياتي.. واسلم أخاً كريماً ومبدعاً حقيقياً..
بغداد في17/4/1992
حميد سعيد
***********
- رسالة من سامي مهدي
أخي الحبيب أبا مصعب
تحياتي ومحبتي
لا أدري ما إذا كنت قد عدت إلى عمّان، أم أنك ماتزال في عجمان، ثم أنك لم تخبرني ما إذا التقيت بمحسن الموسوي، مرة أخرى وأبلغته بما طلبته، أم أنك لم تلتق به.
ماذا تفعل هذه الأيام، ألديك جديد تكتبه أو كتبته؟
لدي ملاحظة لا أتردد في قولها لك، لأنك تدرك نبل قصدي، الملاحظة هي: أكتب موضوعك من زوايا نظر أخرى لكي تتجنب تكرار المعاني والصور، فقد لاحظت بعض التكرار بين بستان قريش والتي قبلها، آمل أن أكون مخطئاً، آمل أن تكون قراءة بستان قريش في مرتين متباعدتين هي التي أوحت لي بهذا، ومع ذلك ضع هذه الملاحظة الأخوية في حسبانك.
إنني أكاد أعاني من نضوبٍ هذه الأيام، فليس عندي من جديد أكتبه، ولذا أتلهى بكتابة أشياء أخرى، مقالات وغيرها، أقول: أتلهى، وأنا أعني ما أقول، وكل ما أنشر من شعر هو مما كتبته خلال السنوات الأربع الماضية.
أعاني أيضاً من نسيان فظيع للشؤون القريبة، بينما تنشط ذاكرتي في شؤون الطفولة والشباب، أظنها الشيخوخة يا صاحبي.
وبعد، وددت أن أخبرك بأنني نشرت مقالة جديدة في الدستور الثقافي يوم الجمعة الماضية (13/4/2007)
آمل، إن كنت قد عدت إلى عمان، قد اطلعت عليها واحتفظت لي بنسخة منها.
أرجو المعذرة إن كنت قد أثقلت عليك بطلباتي.
أم نوار تسلم عليك كثيراً، وتطلب مني في كل مرّة أن أبلغك سلامها.
هذا، ودم بخير وعافية.
أخوك المحب
سامي مهدي، 22/4/2027، بغداد
****
صديقي العزيز الشاعر حميد سعيد
تأخرت في الرد على رسالتك المؤرخة في 1/5/1992 وأنت أعلم بالسبب.
دعني اعتمد على ذاكرتك حول لقاءاتنا المبكرة، فالمهم عندي أننا التقينا، وكان ذلك بداية صداقة امتدت إلى ما يقرب من ثلاثة عقود، وهي صداقة يندر أن تجد مثلها، على الرغم من أننا لم نلتق لقاءات منفردة طويلة كما يحدث عادة بين الأصدقاء. هل انتبهت إلى ذلك؟ اللقاءات المنفردة الطويلة تتيح للأصدقاء تفاهماً أعمق حتى وإن اختلفوا. ولكننا، على ما يبدو، قد تفاهمنا من دونها، وأحس كل منا بالآخر من خلال كتاباته ومواقفه وهمومه ومثله الأخلاقية.
إذن، سأعتمد على ذاكرتك حول لقاءاتنا المبكرة، وسأقبل منك ما تؤرخه لها.
وإذا كنت قد قلت في رسالتك انك لم تكن تحب الجلوس في مقهى البلدية، فليس ذلك بسبب عتمتها فقط، بل لأنك لا تحب الجلوس في المقاهي على ما يبدو، فأنا لا أتذكر أنك أطلت الجلوس في مقهى ما، ليس مثلنا في الأقل، وهو عكس ما اعتدت عليه وأحببته، لقد اكتسبت عادة الجلوس في المقاهي منذ شبابي المبكر، وعمقت هذه العادة ظروف النضال السري، أيام كانت المقاهي »مقرا« يلتقي فيها البعثيون، ويتصلون بسواهم من روادها، ويراقبون من خلالها حركة المجتمع.
إن هذه العادة مازالت محببة لدي، ومازلت أمارسها كلما سنحت لي الظروف، ولا أظنك ستعجب إذا ما حدثتك عن مقهى باريسية كنت أتردد عليها أثناء اقامتي في باريس، إنها مقهى »لاتريوم« الواقعة في »سان جرمان دويريه« ذلك الشارع الباريسي الشهير.
كنت أتردد على هذه المقهى أيام العطل الأسبوعية، وأيام الأعياد الرسمية والدينية في فرنسا(بالاضافة إلى أيام أعيادنا الوطنية) وما أكثرها. وقد كتبت فيها كثيراً من قصائد »الأسئلة« و»الزوال«. ولي فيها ذكريات جميلة كثيرا ما استرجعها وأحن إليها،. وما من مرة سافرت فيها إلى باريس بعد رحيلي عنها في 30 يونيو 1980 إلا وعدت إلى تلك المقهي مفعما بالشوق واتخذت منها مرتكزا للحركة اليومية في المدينة ومحطة راحة واسترخاء. وعلى الرغم من أن صديقي النادل »كريستيان« قد تركها إلى حيث لا أدري، فإن بعض من بقي فيها حتى مايو 1990 كان مايزال يتذكر ذلك الوجه القادم من الشرق الأوسط، ويتحدث الفرنسية بلكنة عربية، وجهى، خالد علي مصطفى، صديقنا الأثير، يعرف تلك المقهى، فقد أخذته إليها غير مرة حين حل ضيفا عليّ في باريس.
قل لي: ألم تحدثني أنت عن مقهى مدريدية تدعى »خيخون«؟!
لقد أخذتني الذكريات، وهذه علامات الشيخوخة كما يقال! فلنعد إذن إلى مقهى البلدية.
الأيام التي كنا نرتاد فيها »البلدية« كانت أياماً مهمة، بل حاسمة. كانت أيام مخاض وولادة، وربما كان بعضنا، أو كلنا، يثرثر، أو يستعرض، أو يدعي، ولكن هذا كله كان جزءا من عملية »هدم« ضرورية لمفهومات أدبية سائدة وتأسيس مفهومات أدبية جديدة، هي المفهومات التي أرساها جيلنا، والتي صرنا ننتمي إليها، وصارت تنتمي إلينا، شئا ذلك أم أبينا.
إنها موجودة فينا. في ما نكتبه من نصوص شعرية ونثرية، رغم التفاوت والاختلاف.
ولذا فإنني أحترم كل الذي كنا نقوله في تلك الأيام، ولا أتعالى عليه، مهما كانت قيمته الحقيقية!
ليس معنى ذلك أنني لا أميز بين الغث والسمين، بل معناه أنني أقدر الظرف الذي قيل فيه الغث فأتفهمه وأفهم دوافعه وأعرف آفاقه.
من ذلك ما يتعلق بشعر المرحوم بدر شاكر الشياب، فقد قال فيه الستينيون الشيء الكثير، ولكنني لم أرض عن كثير مما قالوه، حتى انني هاجمت مرة الشاعر فاضل العزاوي بسببه، لقد بنيت لي، على ما أحسب، موقفا خاصا نتيجة دراسة معمقة، كما أوضحت في رسالتي السابقة، وليس نتيجة اشتراطات وتوصيفات خارجية.
عد معي إلى قصائد السياب »الحديثة« (ودعك من قصائده العمودية الصرف، أو الشبيهة بالعمودية كالمومس العمياء وحفار القبور والأسلحة والأطفال) تجد في أغلبها روح الخطاب الكلاسيكي ونبرته وايقاعه، وقد كان من الضروري، لنا جميعا، أن ننتبه إلى هذا ونعيه، لكي نكتب قصيدة أخرى، مختلفة، أقرب إلى الحداثة ومفهوماتها. بل لقد كان من الضروري أن نتحدث عن ذلك بصوت عالٍ متعال، لكي نعرف مواطىء أقدامنا.
على أن نقد تجربة السياب لا يعني شطبها من تاريخ حركة الحداثة، وليس في وسع أحد أن يشطبها حتى لو أراد. إنه يعني، كما أفهم، وضعها في حجمها الطبيعي، وتحديد دورها التاريخي، لكي لا تتحول إلى »صنم« يعبد، ولكي لا يتحول السياب إلى »نموذج« ينبغي الاقتداء به، أو تقليده، ولكي لا يكون قياس الابداع على قياسه، فليس أخطر على مستقبل الشعر من »النمذجة« فيقال هذا بز السياب وهذا لم يبزه، وهذا اقترب من البياتي وهذا لم يقترب…الخ..
إنني أنطلق في ذلك من فهم صحيح، على ما أحسب، وواع، لمفهوم »القطيعة«، ذلك المفهوم الذي شوهه أدونيس وأشاع فهما خاطئا له، بعد أن حمله حمولة أيديولوجية، وأعطاه مساحة تاريخية أكبر بكثير جدا مما يجب في كتابه »الثابت والمتحول«، وظل هذا الفهم شائعا حتى اليوم بين »المأخوذين« من قراء الكتب المترجمة و»فلاسفتها«!
أنت ترى أنني لم أقل شيئا عن الشاعر فاضل العزاوي حتى الآن، إنني أفعل ذلك لأنني أخشى الاساءة لرجل جمعتني وإياه زمالة أدبية وصحفية امتدت سنوات طويلة، وإن فرقتنا السياسة.
ولكن لابد للمرء من أن يقول في النهاية شيئا للتاريخ.
أحسب أن فاضل العزاوي كان يعتمد »الاثارة« و»الاستفزاز« و»المكابرة« ويعتبرها سبيلا ناجعا لتحقيق »أهدافه« الأدبية.
بل كانت تلك »سياسة« يعتمدها في تقديم أفكاره وآرائه، ظنا منه بأنها أجدى طريقة لتسفيه آراء من يخالفونه، ويبدو لي أنه كان يريحه أن يجد من يرد عليه، لكي يرد عليه هو الآخر، ويتمادى في الرد تسفيها وسخرية، ولذا كان يقع في »التصنع« أحيانا وفي »التهريج« أحياناً أخرى.
كان فاضل العزاوي متأثرا بحركة شعراء »البيتس Beat« الأريكان شعراً وسلوكاً، ومع ذلك كان »صوتا ضروريا« في حركة جيلنا، وكان على أية حال، رجلا موهوبا وحاذقا.
ً
**********
.
في بداية الأسبوع الماضي.. وإذ كان أصدقاؤنا يملأون سهرتنا الموصلية الحميمة ضجيجاً.. كنت أتأمل صمتك.. فأستعيد علاقة تكاد تمتد الي ثلاثة عقود من الزمن.
أليس كذلك؟ إذ كان لقائي الأول بك عام 1963 في صحيفة الجماهير.. أعرف أنك ما عدت تتذكر ذلك اللقاء العابر.. وما ينبغي لك ان تتذكره.. إذ كنت غير معني بما جئت أنا من أجله.. وما قادني إليك إلا غياب الأستاذ العزيز كريم شنتاف.
يومها كنت مكلفا بتقديم طلب لإصدار صحيفة الطلائع في مدينة الحلة.. وإذ توجهت آنذاك الي المرحوم حميد خلخال وكان وزيراً للشؤون الاجتماعية أخبرني رحمه الله بأن أتصل بكريم شنتاف وأنت مكلف بتيسير المهمة التي كنت قد جئت من أجلها.
لم أكن أعرف بغداد.. فكان دليلي الي صحيفة الجماهير صديقي المزمن سلام علي السلطان.. ولأنك وكما عرفت بعد حين تسد فراغ الغائبين قد اقتحمنا عليك لحظات تناول فطورك في قاعة التحرير.. أو هكذا يخيل لي الآن، إذ لم أر قبل ذلك اليوم مبني صحفيا أو زرت مطبعة.. ومع هذا فقد كلفت بإصدار صحيفة.. يا للبراءة!!
وكنت أظن ان ما جئت من أجله لابد ان يعرفه كل العاملين في صحيفة الجماهير.. ولأنك أبديت عدم معرفتك بالأمر.. اتهمتك في سري وفي علني بكل ما يمكن ان يصدر عن طيبة مطلقة..
كان ذلك لقائي الأول بك.. وكان ذلك انطباعي الأول عنك. ثم كان لقاؤك الثاني.. وأظن أنك تحسبه اللقاء الأول. وليكن ذلك.. وكان المكان مقهي البرلمان أما تاريخه ففي بدايات عام 1964. وكنا نعاني معا من آثار الردة التشرينية.. والذي قادني الي ذلك اللقاء صديقنا مالك المطلبي وقد يكون خالد علي مصطفي.. المهم اننا التقينا وما فاجأني في ذلك اللقاء.. ثم في اللقاءات التي جاءت بعده هو مستوي الحوار الذي كان يدور بينكم ومحوره الشعر.. ورغم متعة الاكتشاف فإن سؤالا ظل يلاحقني دون أن أتعجل الاجابة عليه.. والسؤال هو.. هل يستبدل أصحابي مشروعهم الشعري بمشروعهم النضالي.. واعترف انني لم أكن قادرا علي وعي تكامل المشروعين أو وحدتهما.. ولم أكن بعيدا عن الوعي الشائع وهو وعي موروث منذ ان كانت القبيلة تستكمل كينونتها بالشاعر وبالشعر.
أي.. وهذا ما كنت أراه.. ان الشاعر والشعر من مستلزمات القبيلةالسياسية.. أما ان يكون الشاعر بديلا عنها.. فذلك من شيم الذين خلعتهم قبائلهم.. وهذا ما لم أكن أرتضيه للذين أحبهم.. لم أكن قارئا خاملاً.. غير أني لم أتوفر علي فرصة وضع قراءاتي علي محك الحوار.. فإقامتي في الحلة وهي كما تعلم أيها الصديق العزيز.. مدينتي التي ولدت ونشأت فيها.. اعطتني مساحة واسعة للقراءة والحلم والتأمل وحرمتني من محيط يطالبني بإجابات عن إشكاليات الشعر.. أو يحاول فرض إجاباته عليّ.. لقد سبق لي أن كتبت عن هذا الجانب من علاقتي بالشعر.. واكتشفت لاحقاً أن ذلك بعض ما منحني القدرة علي مقاومة اغراءات المحيط الشعري والانصياع لاشتراطات الجماعات الشعرية وتقاليدها.. وكنت في ظروف المحيط الذي أشرت إليه مضطراً لأن أكتشف الأشياء بنفسي.. أسئلة والإجابات.. الرفض والقبول.. المواقف وأضدادها.
هل تستغرب إذا قلت لك ان أفكاري كانت أكثر تنظيماً وكنت أكثر قدرة علي التعبير عنها.. في الفن التشكيلي مثلاً لأنني كنت غير بعيد عن وسط في مدينة الحلة يثير نقاشاً حول قضايا الفن التشكيلي..
ومما يثير ألمي ان فناناً تشكيلياً مهماً هو المرحوم داود سلمان الخلف كان قد درس الرسم في معهد البوزار بباريس.. وعين مدرساً للرسم في متوسطة الحلة عام 1954 واستمرت اقامته في الحلة الي أن توفي فيها ومعظم الرسامين المعروفين الآن هم من طلبته.. ولا أجد من يذكره أو يتذكر دوره وهو الذي طرح أولي قضايا التجديد في وسط لا يتجاوز فهمه للرسم في حدود النقل أو التكبير بالمربعات!! ولا أبالغ إذا قلت ان معرفتي آنذاك بحرفيات السينما والتعبير عنها.. تتجاوز قدرتي علي التعبير عن الشعر وقضاياه، لقد كانت الحلة مدينة سينما.. ففي أوائل الخمسينات وربما في أواخر الأربعينات كان فيها ثلاث دور سينما للعروض الشتوية وداران أو ثلاث دور للعروض الصيفية.. قد تستغرب الأجيال الجديدة حين تعرف بوجود دور سينما للعروض الصيفية.. وفي الهواء الطلق!! وشاهدت في دور العرض تلك أهم أفلام الأربعينات والخمسينات.. ومنذ أواسط الخمسينات بدأ اهتمامي بالمسرح، وطالما حرصت علي مشاهدة العروض المسرحية التي تقدم في بغداد فلم تكن الحلة آنذاك ومثلما هي الآن كذلك..تعرف العروض المسرحية باستثناء بعض العروض المدرسية التي كان لموليير حصة الأسد والفيل فيها.. وقادتني تلك العروض الي نقاشات مع الأصدقاء الذين كنت أرافقهم الي بغداد لمشاهدة ما يعرض من مسرحيات فيها.
كان الشعر يستهويني منذ صباي المبكر.. وأيام التقينا كنت قد قرأت ليس ما يكفي لمعرفة جيدة بالشعر العربي.. قديمه ومعاصره وحديثه.. بل بما يمنحني القدرة علي اتخاذ موقف مما كنت قد قرأت.. غير ان الموقف الذي أشير إليه ظل يعتمد علي نوع من البصيرة التي تأتي باستبطان النص وطول التأمل فيه.. فلم أكن أحفل كثيراً بأحكام المدارس النقدية ولم أتوفر علي صبر يؤهلني للانغمار في تعقيداتها أو الانصياع لأوامرها والرضا بنواهيها.. فهي تطفل علي جماليات الإبداع وتدخل فج في طقوسه الساحرة.. أو هكذا كنت أراها..
قد يتبادر الي ذهنك ما يدفعك الي القول.. هذا وعيك الراهن.. أو لافتراض هذا.. حتي أتيح لنفسي حقيقة انه تعبير الراهن عن وعي كان قائماً.. وإذ أعود الي لقاءاتي الأولي بالوسط الثقافي في بغداد.. أستذكر ما كان يراودني من إحساس بمعرفة تحققت بالقراءة والتأمل غير أنها لا تمتلك القدرة علي الحوار مع الآخر فتعوضه بالحوار مع الذات.. وقد أتاح لي ذلك نوعاً عميقاً من أنواع التأمل وحالة مفتوحة علي أفق اكتشاف الأشياء.. ثم منحني القوة علي رفض الأنماط الشائعة ومواجهة ثقافة الإشاعة والإشاعة الثقافية.. ورأيت في الكثير مما كنت استمع اليه من القول الثقافي إنشاء خاوياً وادعاءات فارغة مصادرهما الاستلاب وفقر الوعي واهتزاز المعرفة.
لم أكن منغلقاً.. ووجدت القليل المفيد من ذلك القول الثقافي أبواباً مشرعة علي حلم كان يراودني.. أن أكتب قصيدتي علي مسافة من قصائد الآخرين.. لا أذهب بها الي حيث تذهب قصائدهم ولا أحرمها من متعة الاقتراب منها.. أو مغامرة الوصول الي أبعد ينابيعها.. ومن هناك تفارقها الي يقينها الخاص.
ها أنذا وبعد ثلاثين عاماً.. أستعيد رؤيتي الشعرية التي جئت بها اليكم من ضفاف الحلم وفراديس الصمت الجميل..
جنون بجماليات اللغة العربية ودأب علي البحث عن خصوصية أسلوبية وتجريب علي شتي جبهات الفعل الشعري.. ومع كل هذا الحلم الطموح لم أكن قد كتبت قصيدتي بعد!! والتي كتبتها لم توفر لي يقين الوصول الي ضفاف الحلم الطموح.. ولم تكن هذه الرؤية محاصرة بوعي نظري يعيقها عن تجاوز نقص الخبرة أو عدم استكمال الأداة القاصرة عن انتاج النص.. بل كانت مفتوحة علي مدي تشكله توصلات وحالات تضاد.. تبدأ من اعجاب لا حدود له ببكارة القصيدة الجاهلية.. واستثناء للمعلقات.. استغراق في لغة جرير وتعاطف مع العذريين ومشاركة الفتيان القرشيين عمر بن أبي ربيعة والعرجي بهجتهما.. أما المتنبي فقد كنت أراه أطول قامة شعرية بين الذين أحببتهم من الشعراء.. ولا أمتلك تبريراً وما أزال..
إحساس بالسيد حيدر الحلي ووقفة عند علي الشرقي.. وإدراك لحيوية الياس أبي شبكة وجماليات علي محمود طه ورعشة في حضرة قاموس محمود حسن اسماعيل ونشوة لا تطول في لقاءات عابرة مع المهجرين.
ضيق بشعراء عصر النهضة يدفعني الي رفقة الجيل الذي تلاهم الجواهري وبدوي الجبل والأخطل الصغير.. حتي سليمان العيسي.. لكن حضور الجواهري يسد الطريق علي سواه من مجايليه..
قناعة تترسخ بأن مستقبل شعرنا في الذي بدأته حركة التجديد.. حيث تتراجع نازك الملائكة عن مجال أسئلتي ويتقدم السياب وخليل الحاوي.. ويظل البياتي في المابين..
لم أسقط في شرك ابتزاز دعاوي التجديد في نصوص مجلة شعر.. ولم تقتحم نماذجها أسراري.. أما أدونيس.. فأعترف أنكم وراء حضوره في محيط اهتماماتي فأدخلته في جغرافية تأملاتي.. بانتظار ما أصل اليه من اكتشاف تضاريس مجاله الشعري..
أخي العزيز..
لا أدري إن كنت وجدتني قد وفقت في رسم صورة تتوفر علي كثير من الدقة والصدق عن رؤيتي الشعرية آنذاك.. أما أنا.. فأكاد أقول.. نعم.
تمر الأعوام.. فتسقط قناعات وتترسخ أخري.. وتهتز مسلمات وتخترم بعضها أسئلة جديدة..
تحياتي.. واسلم أخاً كريماً ومبدعاً حقيقياً..
بغداد في17/4/1992
حميد سعيد
***********
- رسالة من سامي مهدي
أخي الحبيب أبا مصعب
تحياتي ومحبتي
لا أدري ما إذا كنت قد عدت إلى عمّان، أم أنك ماتزال في عجمان، ثم أنك لم تخبرني ما إذا التقيت بمحسن الموسوي، مرة أخرى وأبلغته بما طلبته، أم أنك لم تلتق به.
ماذا تفعل هذه الأيام، ألديك جديد تكتبه أو كتبته؟
لدي ملاحظة لا أتردد في قولها لك، لأنك تدرك نبل قصدي، الملاحظة هي: أكتب موضوعك من زوايا نظر أخرى لكي تتجنب تكرار المعاني والصور، فقد لاحظت بعض التكرار بين بستان قريش والتي قبلها، آمل أن أكون مخطئاً، آمل أن تكون قراءة بستان قريش في مرتين متباعدتين هي التي أوحت لي بهذا، ومع ذلك ضع هذه الملاحظة الأخوية في حسبانك.
إنني أكاد أعاني من نضوبٍ هذه الأيام، فليس عندي من جديد أكتبه، ولذا أتلهى بكتابة أشياء أخرى، مقالات وغيرها، أقول: أتلهى، وأنا أعني ما أقول، وكل ما أنشر من شعر هو مما كتبته خلال السنوات الأربع الماضية.
أعاني أيضاً من نسيان فظيع للشؤون القريبة، بينما تنشط ذاكرتي في شؤون الطفولة والشباب، أظنها الشيخوخة يا صاحبي.
وبعد، وددت أن أخبرك بأنني نشرت مقالة جديدة في الدستور الثقافي يوم الجمعة الماضية (13/4/2007)
آمل، إن كنت قد عدت إلى عمان، قد اطلعت عليها واحتفظت لي بنسخة منها.
أرجو المعذرة إن كنت قد أثقلت عليك بطلباتي.
أم نوار تسلم عليك كثيراً، وتطلب مني في كل مرّة أن أبلغك سلامها.
هذا، ودم بخير وعافية.
أخوك المحب
سامي مهدي، 22/4/2027، بغداد
****
صديقي العزيز الشاعر حميد سعيد
تأخرت في الرد على رسالتك المؤرخة في 1/5/1992 وأنت أعلم بالسبب.
دعني اعتمد على ذاكرتك حول لقاءاتنا المبكرة، فالمهم عندي أننا التقينا، وكان ذلك بداية صداقة امتدت إلى ما يقرب من ثلاثة عقود، وهي صداقة يندر أن تجد مثلها، على الرغم من أننا لم نلتق لقاءات منفردة طويلة كما يحدث عادة بين الأصدقاء. هل انتبهت إلى ذلك؟ اللقاءات المنفردة الطويلة تتيح للأصدقاء تفاهماً أعمق حتى وإن اختلفوا. ولكننا، على ما يبدو، قد تفاهمنا من دونها، وأحس كل منا بالآخر من خلال كتاباته ومواقفه وهمومه ومثله الأخلاقية.
إذن، سأعتمد على ذاكرتك حول لقاءاتنا المبكرة، وسأقبل منك ما تؤرخه لها.
وإذا كنت قد قلت في رسالتك انك لم تكن تحب الجلوس في مقهى البلدية، فليس ذلك بسبب عتمتها فقط، بل لأنك لا تحب الجلوس في المقاهي على ما يبدو، فأنا لا أتذكر أنك أطلت الجلوس في مقهى ما، ليس مثلنا في الأقل، وهو عكس ما اعتدت عليه وأحببته، لقد اكتسبت عادة الجلوس في المقاهي منذ شبابي المبكر، وعمقت هذه العادة ظروف النضال السري، أيام كانت المقاهي »مقرا« يلتقي فيها البعثيون، ويتصلون بسواهم من روادها، ويراقبون من خلالها حركة المجتمع.
إن هذه العادة مازالت محببة لدي، ومازلت أمارسها كلما سنحت لي الظروف، ولا أظنك ستعجب إذا ما حدثتك عن مقهى باريسية كنت أتردد عليها أثناء اقامتي في باريس، إنها مقهى »لاتريوم« الواقعة في »سان جرمان دويريه« ذلك الشارع الباريسي الشهير.
كنت أتردد على هذه المقهى أيام العطل الأسبوعية، وأيام الأعياد الرسمية والدينية في فرنسا(بالاضافة إلى أيام أعيادنا الوطنية) وما أكثرها. وقد كتبت فيها كثيراً من قصائد »الأسئلة« و»الزوال«. ولي فيها ذكريات جميلة كثيرا ما استرجعها وأحن إليها،. وما من مرة سافرت فيها إلى باريس بعد رحيلي عنها في 30 يونيو 1980 إلا وعدت إلى تلك المقهي مفعما بالشوق واتخذت منها مرتكزا للحركة اليومية في المدينة ومحطة راحة واسترخاء. وعلى الرغم من أن صديقي النادل »كريستيان« قد تركها إلى حيث لا أدري، فإن بعض من بقي فيها حتى مايو 1990 كان مايزال يتذكر ذلك الوجه القادم من الشرق الأوسط، ويتحدث الفرنسية بلكنة عربية، وجهى، خالد علي مصطفى، صديقنا الأثير، يعرف تلك المقهى، فقد أخذته إليها غير مرة حين حل ضيفا عليّ في باريس.
قل لي: ألم تحدثني أنت عن مقهى مدريدية تدعى »خيخون«؟!
لقد أخذتني الذكريات، وهذه علامات الشيخوخة كما يقال! فلنعد إذن إلى مقهى البلدية.
الأيام التي كنا نرتاد فيها »البلدية« كانت أياماً مهمة، بل حاسمة. كانت أيام مخاض وولادة، وربما كان بعضنا، أو كلنا، يثرثر، أو يستعرض، أو يدعي، ولكن هذا كله كان جزءا من عملية »هدم« ضرورية لمفهومات أدبية سائدة وتأسيس مفهومات أدبية جديدة، هي المفهومات التي أرساها جيلنا، والتي صرنا ننتمي إليها، وصارت تنتمي إلينا، شئا ذلك أم أبينا.
إنها موجودة فينا. في ما نكتبه من نصوص شعرية ونثرية، رغم التفاوت والاختلاف.
ولذا فإنني أحترم كل الذي كنا نقوله في تلك الأيام، ولا أتعالى عليه، مهما كانت قيمته الحقيقية!
ليس معنى ذلك أنني لا أميز بين الغث والسمين، بل معناه أنني أقدر الظرف الذي قيل فيه الغث فأتفهمه وأفهم دوافعه وأعرف آفاقه.
من ذلك ما يتعلق بشعر المرحوم بدر شاكر الشياب، فقد قال فيه الستينيون الشيء الكثير، ولكنني لم أرض عن كثير مما قالوه، حتى انني هاجمت مرة الشاعر فاضل العزاوي بسببه، لقد بنيت لي، على ما أحسب، موقفا خاصا نتيجة دراسة معمقة، كما أوضحت في رسالتي السابقة، وليس نتيجة اشتراطات وتوصيفات خارجية.
عد معي إلى قصائد السياب »الحديثة« (ودعك من قصائده العمودية الصرف، أو الشبيهة بالعمودية كالمومس العمياء وحفار القبور والأسلحة والأطفال) تجد في أغلبها روح الخطاب الكلاسيكي ونبرته وايقاعه، وقد كان من الضروري، لنا جميعا، أن ننتبه إلى هذا ونعيه، لكي نكتب قصيدة أخرى، مختلفة، أقرب إلى الحداثة ومفهوماتها. بل لقد كان من الضروري أن نتحدث عن ذلك بصوت عالٍ متعال، لكي نعرف مواطىء أقدامنا.
على أن نقد تجربة السياب لا يعني شطبها من تاريخ حركة الحداثة، وليس في وسع أحد أن يشطبها حتى لو أراد. إنه يعني، كما أفهم، وضعها في حجمها الطبيعي، وتحديد دورها التاريخي، لكي لا تتحول إلى »صنم« يعبد، ولكي لا يتحول السياب إلى »نموذج« ينبغي الاقتداء به، أو تقليده، ولكي لا يكون قياس الابداع على قياسه، فليس أخطر على مستقبل الشعر من »النمذجة« فيقال هذا بز السياب وهذا لم يبزه، وهذا اقترب من البياتي وهذا لم يقترب…الخ..
إنني أنطلق في ذلك من فهم صحيح، على ما أحسب، وواع، لمفهوم »القطيعة«، ذلك المفهوم الذي شوهه أدونيس وأشاع فهما خاطئا له، بعد أن حمله حمولة أيديولوجية، وأعطاه مساحة تاريخية أكبر بكثير جدا مما يجب في كتابه »الثابت والمتحول«، وظل هذا الفهم شائعا حتى اليوم بين »المأخوذين« من قراء الكتب المترجمة و»فلاسفتها«!
أنت ترى أنني لم أقل شيئا عن الشاعر فاضل العزاوي حتى الآن، إنني أفعل ذلك لأنني أخشى الاساءة لرجل جمعتني وإياه زمالة أدبية وصحفية امتدت سنوات طويلة، وإن فرقتنا السياسة.
ولكن لابد للمرء من أن يقول في النهاية شيئا للتاريخ.
أحسب أن فاضل العزاوي كان يعتمد »الاثارة« و»الاستفزاز« و»المكابرة« ويعتبرها سبيلا ناجعا لتحقيق »أهدافه« الأدبية.
بل كانت تلك »سياسة« يعتمدها في تقديم أفكاره وآرائه، ظنا منه بأنها أجدى طريقة لتسفيه آراء من يخالفونه، ويبدو لي أنه كان يريحه أن يجد من يرد عليه، لكي يرد عليه هو الآخر، ويتمادى في الرد تسفيها وسخرية، ولذا كان يقع في »التصنع« أحيانا وفي »التهريج« أحياناً أخرى.
كان فاضل العزاوي متأثرا بحركة شعراء »البيتس Beat« الأريكان شعراً وسلوكاً، ومع ذلك كان »صوتا ضروريا« في حركة جيلنا، وكان على أية حال، رجلا موهوبا وحاذقا.
ً
**********
.