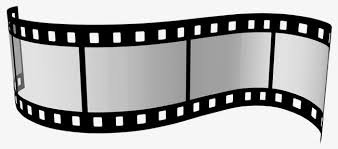للصورة مكانتها الملتبسة في النصوص الفلسفية. وربما كان مرجع هذا الالتباس؛ موقف الفلاسفة منها. حيث تراوح بين الرفض التام لها بوصفها مرادفًا للوهم والخداع وبين الدفاع عنها بوصفها تجليًّا للحقيقة والوجود. ومنذ أفلاطون وحتى وقتنا الراهن، لم يكف الفلاسفة عن التأمل حول مفهوم الصورة، وقد تمت مناقشته في سياقات عديدة، فهو حاضر في كل نقاش يدور حول نظرية المعرفة، وهو حاضر أيضًا في التصورات الانطولوجية للعالم–عالم الصور وعالم الأشياء. وهو حاضر بصورة مضمرة في العلوم الطبيعية– خاصة الرياضيات البحتة التي يمكن النظر إلى نسقها على أنه صورة رمزية لأشياء العالم. كما أنه بطبيعة الحال حاضر في كافة الفنون من الصورة في الرسم وحتى الصورة الشعرية في الأدب. وعالم الصور عالم إبداعي، مرتبط بالخيال عمومًا، لا يكتفي فيه الوعي بإدراك العالم، بل يعيد إنتاجه وخلقه، ويحوله من عالم مصمت إلى عالم حي، من صورة مطابقة إلى صورة مبدعة. وفي النهاية لا توجد صورة محاكية للعالم كما هو، كل صورة هي إعادة إنتاج وتحريف للشيء الواقعي، وحتى الإدراك الحسي يتضمن نوعًا من الإبداع عن طريق قلب الصورة في العين الطبيعية، وهو نفس ما يحدث في آلة التصوير أيضًا، بل إن الصورة المرآوية لا تعكس الأشياء كما هي في الواقع، بل تعيد إنتاجها وفقًا لطبيعة سطحها العاكس.
والواقع أن السينما قد حققت تقدمًا ثوريًّا في مجال الصورة المتحركة. وقد ضاعف هذا التقدم من جماهيرية السينما لدرجة جعلت الفيلسوف الألماني فالتر بنيامين يصفها بأنها "الفن الوحيد الممكن في المستقبل". ومع ذلك لم تكن علاقة الفلسفة بالسينما خصبة أو مثمرة كما هو الحال في علاقتها بباقي الفنون، ربما لأن السينما فن وليد لا يتجاوز عمره قرنًا وبضع سنين، أو ربما لأنها فن شعبي جماهيري لا يخاطب النخبة ومن ثم يفقد صفة مهمة من صفات الفنون التي تقاربها الفلسفة بما أنها هي الأخرى نخبوية. أو ربما أخيرًا لأنها، كما ذهب البعض انطلاقًا من موقف أفلاطوني رافض للصورة، تنتج الأوهام والخيالات والنسخ المشوهة، أي أنها أداة تضليل لا تنتج موضوعات من بين الموضوعات الواقعية، بل أشباه موضوعات. هذا فضلاً عن وجود من يشكك في الأصل في جدوى هذه المقاربة، وقد نقل عن الناقد السينمائي روجر إبرت R. Ibert قوله "لا علاقة للتأمل النظري للأفلام بالفيلم السينمائي نفسه"، وكان تعليقًا موجهًا لما يراه توجهًا في الدوائر التنظيرية للفيلم المعاصر نحو تطبيق لغة "ساحرة وسرية" يصعب تتبعها، وتبدو بلا صلة مع تجربة المشاهدة السينمائية. كل هذا قد أدى إلى غياب، أو على الأقل تعطيل، التأمل النظري الفلسفي للسينما. وكما يقول جاكينتو لاجيرا "لنعترف بأن اللقاء الذي لم يتحقق بين الاستطيقا والنظرية السينمائية راجع إلى الغياب شبه التام لتأمل الفلاسفة حول السينما".
هذا النتاج الفلسفي الزهيد حول هذا الفن الذي وصفه فريدريك جيمسون بـ"الفاعل المركزي الرئيسي في القرن العشرين" يمكننا أن نميز فيه بين موقفين؛ الأول، اتخذ منها موقفًا سلبيًّا ناقدًا. والثاني، سعى لفهمها والبحث عما هو مشترك بينها وبين الفلسفة.
الإيهام السينماتوجرافي
برغم قلة المقاربات الفلسفية للسينما إلا أنها جاءت مبكرة للغاية، فبعد أول عرض سينمائي قام به الأخوان لوميير في العام 1895 نشر هنري برجسون في العام 1907 كتابه التطور المبدع وخصص الفصل الأخير منه لمناقشة ما أطلق عليه الإيهام السينماتوجرافي، فآلة العرض السينمائي وفقًا لبرجسون تقدم لنا حركة كاذبة عبر تحريك الصور بسرعة 24 صورة، وهي بذلك مثال جيد للحركة الكمية، حركة العلم. وفي مقابل تلك الحركة توجد الحركة الكيفية. فالعالم كله متحرك وفي حالة من الصيرورة المستمرة. وهذه الحركة هي الحركة الحقيقية التي يتم إدراكها عبر العيان أو الحدس.
النظرية النقدية
قدمت النظرية النقدية نقدًا للسينما في سياق أوسع من نقدهم لما أطلقوا عليه صناعة الثقافة. وتشير المحادثات المتبادلة بين أدورنو وبنيامين (من أعلام مدرسة فرانكفورت) إلى تبني الأول موقفًا نقديًّا رافضًا لفن السينما، فهي تعمل على تقليص الفاعلية النقدية للمتلقي لأن المشاهد يكون همه الأول متابعة سيل الصور المتدفق على الشاشة، وليس ثمة فرصة أمامه لاتخاذ موقف نقدي منها، كما أن السينما تعمل من خلال مفهوم الصدمة الحسية وحشد كل ما هو غرائبي وغير مألوف للتلاعب بوعي المشاهد وهي بهذا تقع دائمًا في الكليشيه.، أي الصورة النمطية التي يعاد تكرارها باستمرار. أما بنيامين فهو يتفق مع مجمل ما ذهب إليه أدورنو لكنه يرى أن هناك وظيفة إيجابية للسينما تتمثل في أن الكاميرا تستطيع القيام بما لا يستطيع الإدراك الطبيعي القيام به مثل اللقطات المقربة والحركة السريعة والبطيئة.. إلخ. بالإضافة لذلك يرى بنيامين أن السينما إذا ارتبطت بمشروع حضاري ثوري، فقد يكون لها تأثير كبير على الوعي الجمعي، بما لها من إمكانيات تتفوق بها على كافة الفنون الأخرى.
الظاهراتية
كانت السينما حاضرة في النص الظاهرياتي وخصوصًا لدى ميرلوبونتي وآجل وأيفر. وقد تركزت محاولاتهم في مقارنة آلية عمل الكاميرا بالإدراك البشري من أجل إثبات فكرتهم عن تجاوز ثنائية الذات والموضوع، فشعاع الكاميرا الذي يسقط على الأشياء فيكشفها ويسجلها يشبه الوعي البشري الذي لا يعمل إلا وسط الأشياء، فكل وعي هو وعي بشيء ما. ومن جهة أخرى تكشف السينما عن الوجود الإنساني في العالم وعلاقته بالآخرين، السينما تعيد إيجاد العالم من جديد وتقدمه لنا بصورة غير معهودة وفائقة.
جيل دولوز
كانت دراسة الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز عن السينما هي الأكثر نضجًا واستيعابًا لهذا الفن. فقد حاول أن يؤسس لعلاقة تجمع الفلسفة بالسينما دون أي وصاية من الأولى على الثانية. فالفيلم لا يمكن إخضاعه للرؤى الفلسفية والمفاهيم النظرية، بل يبدع فلسفته الخاصة به. ومنطقة التقاطع بين الفلسفة والسينما هي تلك الأرضية المشتركة التي تجتمع المعارف كلها عليها، إنها صورة الفكر السابقة على عملية التشكل، فالفكرة قد تكون واحدة قبل عملية التشكل ثم ما تلبس أن تتخذ شكلاً لغويًّا فيكون الناتج أدبًا أو خطوطًا وألوانًا فتصبح رسمًا أو صورة متحركة فتغدو فيلما. هذا هو المشترك الذي يسمح بوجود علاقة متوازنة بين كافة المجالات المعرفية.
كيف يفكر الفيلم؟
كثير من الدراسات التي تتخذ من الفلسفة نهجًا لدراسة السينما تتبنى مقاربة تبدو مغرية من ناحية الشكل لكنها لا تؤسس لعلاقة يمكن البناء عليها مستقبلاً لتطوير هذه المنطقة البينية المهمة من الدراسات الإنسانية. وتتمثل تلك المقاربة في محاولة تطبيق بعض المفاهيم الفلسفية على الأفلام (العود الأبدي في أفلام نولان، النظرة المحدقة في أفلام هيتشكوك، أفلاطون في سلسلة أفلام المصفوفة، إلخ) أو قراءة عمل سينمائي من خلال أحد الفلاسفة (كانط- بيرجمان، نيتشه- نولان، فوكو- هيتشكوك، إلخ). غير أن هذا النهج في التعامل مع العمل السينمائي يختزله في جانب واحد فقط هو الحوار أو الحبكة (فكرة الفيلم). وهذا الجانب ليس هو الجانب الأهم داخل العمل لأن للفيلم لغته البصرية الخاصة التي لا يمكن اختزالها في مجرد فكرة. بمعنى أن فكرة الفيلم قد تكون تقليدية أو سبق تقديمها لكنها تظهر داخل الفيلم بلغة فنية جديدة ومدهشة، وهذه اللغة هي لغة الصورة التي هي امتياز السينما.
وبدلاً من محاولة البحث عن فيلسوف ما داخل العمل السينمائي أو لي بعض الأفكار السينمائية كيما تتوافق والفلسفة، ربما كان الأجدر هو التساؤل عن الكيفية التي يفكر بها الفيلم في العالم، وهنا قد يوصلنا الفيلم للفلسفة أو أي حقل معرفي آخر ليحدث هذا التلاقي المثمر. فالفيلم يفكر بذاته ولا يحتاج الفلسفة ولا الفلاسفة لحمله على التفكير. لهذا فلربما كان المدخل السليم لتأسيس علاقة متكافئة بين الفلسفة والسينما هو محاولة الإجابة عن سؤال كيف يفكر الفيلم؟ وكيف يؤثر؟ كيف يفكر فيلم هيتشكوك النافذة الخلفية Rear Window في النظرة والمراقبة؟ كيف يفكر فيلم المصفوفة Matrix في علاقة الواقع بالوهم؟ كيف يفكر فيلم نادي القتال Fight Club في الذات والاضطراب النفسي؟ كيف تفكر سينما شاهين في الأنا وعلاقتها بالآخر؟ كيف تؤثر أفلام روبرت بريسون في إداكنا للأماكن ونقاط التواصل بين الأفراد عن طريق اللمس؟ كيف يؤثر تصور كريستوفر نولان للزمن في إدراكنا له؟ كيف تؤثر أفلام بيرجمان في تصورنا لعلاقتنا مع الآخرين؟ إلخ.
 www.facebook.com
www.facebook.com
والواقع أن السينما قد حققت تقدمًا ثوريًّا في مجال الصورة المتحركة. وقد ضاعف هذا التقدم من جماهيرية السينما لدرجة جعلت الفيلسوف الألماني فالتر بنيامين يصفها بأنها "الفن الوحيد الممكن في المستقبل". ومع ذلك لم تكن علاقة الفلسفة بالسينما خصبة أو مثمرة كما هو الحال في علاقتها بباقي الفنون، ربما لأن السينما فن وليد لا يتجاوز عمره قرنًا وبضع سنين، أو ربما لأنها فن شعبي جماهيري لا يخاطب النخبة ومن ثم يفقد صفة مهمة من صفات الفنون التي تقاربها الفلسفة بما أنها هي الأخرى نخبوية. أو ربما أخيرًا لأنها، كما ذهب البعض انطلاقًا من موقف أفلاطوني رافض للصورة، تنتج الأوهام والخيالات والنسخ المشوهة، أي أنها أداة تضليل لا تنتج موضوعات من بين الموضوعات الواقعية، بل أشباه موضوعات. هذا فضلاً عن وجود من يشكك في الأصل في جدوى هذه المقاربة، وقد نقل عن الناقد السينمائي روجر إبرت R. Ibert قوله "لا علاقة للتأمل النظري للأفلام بالفيلم السينمائي نفسه"، وكان تعليقًا موجهًا لما يراه توجهًا في الدوائر التنظيرية للفيلم المعاصر نحو تطبيق لغة "ساحرة وسرية" يصعب تتبعها، وتبدو بلا صلة مع تجربة المشاهدة السينمائية. كل هذا قد أدى إلى غياب، أو على الأقل تعطيل، التأمل النظري الفلسفي للسينما. وكما يقول جاكينتو لاجيرا "لنعترف بأن اللقاء الذي لم يتحقق بين الاستطيقا والنظرية السينمائية راجع إلى الغياب شبه التام لتأمل الفلاسفة حول السينما".
هذا النتاج الفلسفي الزهيد حول هذا الفن الذي وصفه فريدريك جيمسون بـ"الفاعل المركزي الرئيسي في القرن العشرين" يمكننا أن نميز فيه بين موقفين؛ الأول، اتخذ منها موقفًا سلبيًّا ناقدًا. والثاني، سعى لفهمها والبحث عما هو مشترك بينها وبين الفلسفة.
الإيهام السينماتوجرافي
برغم قلة المقاربات الفلسفية للسينما إلا أنها جاءت مبكرة للغاية، فبعد أول عرض سينمائي قام به الأخوان لوميير في العام 1895 نشر هنري برجسون في العام 1907 كتابه التطور المبدع وخصص الفصل الأخير منه لمناقشة ما أطلق عليه الإيهام السينماتوجرافي، فآلة العرض السينمائي وفقًا لبرجسون تقدم لنا حركة كاذبة عبر تحريك الصور بسرعة 24 صورة، وهي بذلك مثال جيد للحركة الكمية، حركة العلم. وفي مقابل تلك الحركة توجد الحركة الكيفية. فالعالم كله متحرك وفي حالة من الصيرورة المستمرة. وهذه الحركة هي الحركة الحقيقية التي يتم إدراكها عبر العيان أو الحدس.
النظرية النقدية
قدمت النظرية النقدية نقدًا للسينما في سياق أوسع من نقدهم لما أطلقوا عليه صناعة الثقافة. وتشير المحادثات المتبادلة بين أدورنو وبنيامين (من أعلام مدرسة فرانكفورت) إلى تبني الأول موقفًا نقديًّا رافضًا لفن السينما، فهي تعمل على تقليص الفاعلية النقدية للمتلقي لأن المشاهد يكون همه الأول متابعة سيل الصور المتدفق على الشاشة، وليس ثمة فرصة أمامه لاتخاذ موقف نقدي منها، كما أن السينما تعمل من خلال مفهوم الصدمة الحسية وحشد كل ما هو غرائبي وغير مألوف للتلاعب بوعي المشاهد وهي بهذا تقع دائمًا في الكليشيه.، أي الصورة النمطية التي يعاد تكرارها باستمرار. أما بنيامين فهو يتفق مع مجمل ما ذهب إليه أدورنو لكنه يرى أن هناك وظيفة إيجابية للسينما تتمثل في أن الكاميرا تستطيع القيام بما لا يستطيع الإدراك الطبيعي القيام به مثل اللقطات المقربة والحركة السريعة والبطيئة.. إلخ. بالإضافة لذلك يرى بنيامين أن السينما إذا ارتبطت بمشروع حضاري ثوري، فقد يكون لها تأثير كبير على الوعي الجمعي، بما لها من إمكانيات تتفوق بها على كافة الفنون الأخرى.
الظاهراتية
كانت السينما حاضرة في النص الظاهرياتي وخصوصًا لدى ميرلوبونتي وآجل وأيفر. وقد تركزت محاولاتهم في مقارنة آلية عمل الكاميرا بالإدراك البشري من أجل إثبات فكرتهم عن تجاوز ثنائية الذات والموضوع، فشعاع الكاميرا الذي يسقط على الأشياء فيكشفها ويسجلها يشبه الوعي البشري الذي لا يعمل إلا وسط الأشياء، فكل وعي هو وعي بشيء ما. ومن جهة أخرى تكشف السينما عن الوجود الإنساني في العالم وعلاقته بالآخرين، السينما تعيد إيجاد العالم من جديد وتقدمه لنا بصورة غير معهودة وفائقة.
جيل دولوز
كانت دراسة الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز عن السينما هي الأكثر نضجًا واستيعابًا لهذا الفن. فقد حاول أن يؤسس لعلاقة تجمع الفلسفة بالسينما دون أي وصاية من الأولى على الثانية. فالفيلم لا يمكن إخضاعه للرؤى الفلسفية والمفاهيم النظرية، بل يبدع فلسفته الخاصة به. ومنطقة التقاطع بين الفلسفة والسينما هي تلك الأرضية المشتركة التي تجتمع المعارف كلها عليها، إنها صورة الفكر السابقة على عملية التشكل، فالفكرة قد تكون واحدة قبل عملية التشكل ثم ما تلبس أن تتخذ شكلاً لغويًّا فيكون الناتج أدبًا أو خطوطًا وألوانًا فتصبح رسمًا أو صورة متحركة فتغدو فيلما. هذا هو المشترك الذي يسمح بوجود علاقة متوازنة بين كافة المجالات المعرفية.
كيف يفكر الفيلم؟
كثير من الدراسات التي تتخذ من الفلسفة نهجًا لدراسة السينما تتبنى مقاربة تبدو مغرية من ناحية الشكل لكنها لا تؤسس لعلاقة يمكن البناء عليها مستقبلاً لتطوير هذه المنطقة البينية المهمة من الدراسات الإنسانية. وتتمثل تلك المقاربة في محاولة تطبيق بعض المفاهيم الفلسفية على الأفلام (العود الأبدي في أفلام نولان، النظرة المحدقة في أفلام هيتشكوك، أفلاطون في سلسلة أفلام المصفوفة، إلخ) أو قراءة عمل سينمائي من خلال أحد الفلاسفة (كانط- بيرجمان، نيتشه- نولان، فوكو- هيتشكوك، إلخ). غير أن هذا النهج في التعامل مع العمل السينمائي يختزله في جانب واحد فقط هو الحوار أو الحبكة (فكرة الفيلم). وهذا الجانب ليس هو الجانب الأهم داخل العمل لأن للفيلم لغته البصرية الخاصة التي لا يمكن اختزالها في مجرد فكرة. بمعنى أن فكرة الفيلم قد تكون تقليدية أو سبق تقديمها لكنها تظهر داخل الفيلم بلغة فنية جديدة ومدهشة، وهذه اللغة هي لغة الصورة التي هي امتياز السينما.
وبدلاً من محاولة البحث عن فيلسوف ما داخل العمل السينمائي أو لي بعض الأفكار السينمائية كيما تتوافق والفلسفة، ربما كان الأجدر هو التساؤل عن الكيفية التي يفكر بها الفيلم في العالم، وهنا قد يوصلنا الفيلم للفلسفة أو أي حقل معرفي آخر ليحدث هذا التلاقي المثمر. فالفيلم يفكر بذاته ولا يحتاج الفلسفة ولا الفلاسفة لحمله على التفكير. لهذا فلربما كان المدخل السليم لتأسيس علاقة متكافئة بين الفلسفة والسينما هو محاولة الإجابة عن سؤال كيف يفكر الفيلم؟ وكيف يؤثر؟ كيف يفكر فيلم هيتشكوك النافذة الخلفية Rear Window في النظرة والمراقبة؟ كيف يفكر فيلم المصفوفة Matrix في علاقة الواقع بالوهم؟ كيف يفكر فيلم نادي القتال Fight Club في الذات والاضطراب النفسي؟ كيف تفكر سينما شاهين في الأنا وعلاقتها بالآخر؟ كيف تؤثر أفلام روبرت بريسون في إداكنا للأماكن ونقاط التواصل بين الأفراد عن طريق اللمس؟ كيف يؤثر تصور كريستوفر نولان للزمن في إدراكنا له؟ كيف تؤثر أفلام بيرجمان في تصورنا لعلاقتنا مع الآخرين؟ إلخ.
Bei Facebook anmelden
Melde dich bei Facebook an, um dich mit deinen Freunden, deiner Familie und Personen, die du kennst, zu verbinden und Inhalte zu teilen.
 www.facebook.com
www.facebook.com