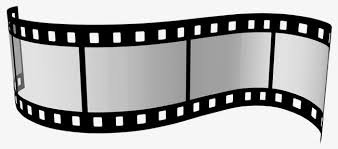"الفن يتكون من صنع الصور، وصنع الصور هو خلق البدائل."
" سنبدأ من سؤال خالد وهو: هل المرئي له قلب؟ هل هناك مركز أساس المرئي؟ هل هناك حقيقة مرئية، سرية للصور؟ على السؤال المطروح على هذا النحو، كان هناك، كما نعلم، ردان هائلان. الأول هو أن المرئي ليس له قلب، وأنه ليس له حقيقة - هذه هي النسخة التي تقول إن سر المرئي هو أنه مجرد ظل، ومظهر خادع، ومضلّل، وعبث، ومستهجن. هذه النسخة الفلسفية التي، منذ أفلاطون، تدين الصورة سيكون لها مصير هائل في تاريخ الصور. لدينا رد هائل آخر، وهو الرد المسيحي. كان لها أيضًا مصير هائل في تاريخ الصور. يتم تقديمه في سلسلة التناقضات التي من خلالها، في أربعة مئة، يدرك القديس برناردين سيينا البشارة على أنها المكان الذي يأتي فيه الله إلى الإنسان، وهو غير قابل للنقاش في الشكل، وغير مرئي في الرؤية. في هذا الإصدار، الله هو اسم مؤسسة المرئي. يصبح غير المرئي أساس المرئي وحقيقة ومصيره. ومن هنا جاءت فكرة الشخص المرئي المأهول الذي يحركه الروح، وأن كل ما هو مرئي له معنى، وأن كل ما يُرى يمكن قوله. هناك كلمة أخيرة للمرئي. ومن هنا جاءت فكرة العصور الوسطى عن العالم كمعبد، وكتاب قابل للفك. من الآن فصاعدًا، كل صورة لها معنى، أي أنها تعني دائمًا شيئًا آخر غير ما تقوله وتعرضه الرسالة، التي تقول إن ما يخص الغرب هو "استيلاء الفكر المسيحي على العاطفة التي حولت مسألة التعبير عن الخطاب إلى وضعه في قلب الصورة. أصبح العاطفة هي القصة التي تروي كيف أصبحت الصورة غير المرئية مرئية، وكيف تم حفظ الصورة الساقطة، وكيف ساهمت تضحية الجسد في مجيء الجسد المفدي. "ولكن في البشارة، يكون دخول غير المرئي إلى المرئي هو مرتبطة بهذا التناقض الآخر وفقًا لبرناردين، وهو عبارة عن دخول الخلود إلى الزمن. من أجل التأكيد على أن حساب التجسد المسيحي ليس فقط هو حساب دخول إله غير مرئي وخالد إلى الرؤى وفي التاريخ، ولكن أيضًا أن التاريخ نفسه يأتي مع التاريخ ويدخله. الصورة "التي تعطي الجسد للكلمة". في هذا، تصبح القصة قصة وعد بالفداء، وفداء الصورة بالصورة، وأمل العودة إلى صورتنا المفقودة. هذا هو الإعلان بحسب القديس بولس: ستأتي الصورة وقت القيامة. ان السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو: ما الجديد في القرن العشرين؟ هل يوجد في القصة العظيمة للصور الملتقطة بين الأشباح والروح شيء جديد تحت السماء الحديثة؟ هل هناك طريق آخر بين الصورة الفارغة والصورة المأهولة؟ أفترض نعم. أن هناك شيئًا جديدًا في القرن العشرين تحت شمس المرئي، أن صورة جديدة قادمة أمام المشهد تهرب، والتي تتعارض كثيرًا مع فكرة الفراغ المرئي كما هو الحال مع فكرة ذات مغزى مرئية. يبدو أن المعنى يأتي لمعارضة الغياب. المرئي سيكون له الغياب كأساسه وحقيقته. لن نتعامل بعد الآن مع خادع مرئي، ولا مع ثقل مرئي مع غير المرئي، ولكن مع وجود مرئي يشدده الغياب، دعنا نقول: شيء غير موجود. لا ينبغي أن نتحدث بعد الآن عن غير المرئي، حتى الذي لا أساس له، ولكن ببساطة عما وراء أو أسفل المرئي والذي سيكون فقط سبب أو سبب المرئي. في الأسفل سيثبت هناك: أن هناك سببًا للظهور، ولم يعد هناك معنى. والقرن العشرين سيكشف هذا، ويمكننا أن نقول ذلك بمصطلحات تحليلية أكثر من خلال الدفاع عن هذه الفكرة اللاكانية القائلة بأن سر الصورة هو الإخصاء - فالصورة تأتي كالحجاب، وليس من شيء ما، بل نقص. ما يجب فهمه ليس أن الإخصاء ليس له صورة، بل أنه سيكون عكس الصورة - الإخصاء على عكس التجسد. لذلك كان لدينا نسخة من صورة فارغة، لا تغلف شيئًا، صورة خاطئة - هناك، كما قيل في ملفات العدد المجهول، "الحقيقة في مكان آخر". مع المسيحية، اخترعنا صورة حقيقية، يسكنها غير المرئي، وهذا شيء موجود. هناك غير المرئي والمرئي هو الوصول إليه. الحقيقة هي هذه المرة خلف الصورة، السر وراء الباب، كما نرى في مكان آخر في هذه الإعلانات الإيطالية حيث، ترك أنظارنا تتخطى الشخصيات الموجودة في المشهد، تصطدم بباب مغلق، يقع بالضبط بين الملاك والملاك. بِكر. بين الصورة الممتدة بلا شيء والصورة الممتدة من قبل شيء موجود، أعتقد أن القرن العشرين يواجه شيئًا آخر، ويوضح طريقًا ثالثًا، جديدًا ومتناقضًا، وهو الصورة، المرئي الذي يسكنه شيء ما غير موجود. الظاهر يشدد بنقص - صور كبيرة مع نقص. الصورة كنوع من الحمل العصبي؛ لكن هذا الشيء بدون صورة واضحة بغيابها هو ما يمكن أن نطلق عليه الشيء. أقول لنفسي أن هذا يمكن أن يسمح لنا بأخذ وجهات نظر من زوايا مختلفة حول تاريخ التمثيل. هناك، في الحداثة، فكرة التمثيل التي تجعل المرئي نفسه مرئيًا. إنه بمعنى ما ورد في صيغة بول كلي المعروفة: "الفن لا يعيد إنتاج ما هو مرئي، بل يجعله مرئيًا. هذه هي الطريقة التي نعيد بها إلى قلب التمثيل بُعدًا مرجعيًا ذاتيًا حيث يظهر المرئي نفسه على أنه مرئي، أي تمثيل تكمن كلمته النهائية في تسطيح مستوى التمثيل. في ترتيب المستجدات، يمكن أن نسميها الحداثة الأولى. لها تاريخ في تاريخ فن القرن العشرين.
لكن هل لدينا في التسطيح الكلمة النهائية للتمثيل؟ لذلك أقترح أن ينشأ سؤال آخر، عن التمثيل الممتد بفعل نقص في الرؤية، لن تكون الكلمة النهائية له هي غير المرئية، بل النقص. تمثيل ينفتح على جمالية سلبية. فن تأسس على وجود شيء مستحيل رؤيته. سيكون هذا حداثة أخرى. وهذه الحداثة تأتي في الفن، تنبثق من التاريخ. وتتيح الوصول، إنها مكان ما لا يمكن رؤيته ". بالطبع ، يمكن رفض "ما لا يمكن رؤيته" بطرق مختلفة: إظهار ما لم نرَه من قبل ، وما لن نراه أبدًا ، وما نراه دون معرفة أننا نراه ، وما لا يمكننا تحمل رؤيته ، وما لا يمكننا رؤيته هيكليًا الآن ، إذا قلنا أن سر الصورة هو الإخصاء ، وإذا سمح الفن بالوصول إلى هذا النقص ، فإن هذا يفتح اتجاهين من شأنه أن يحدد جانبين من تاريخ الفن: إما حجاب واحد ، أو عرض واحد ؛ إما أن نخفيها ، أو نخفيها (وهي طريقة لإتاحة الوصول من خلال تعيين باب السر) ، أو نعطي حق الوصول إلى النقص الذي لا يمكننا رؤيته من خلال إظهاره. قال ، يمكننا الحصول على فكرة كيف نخفي النقص. هذه، إذا صح التعبير، وظيفة ما نسميه الرسم الشراعي. بمعنى ما، سيكون هذا هو دور الجمال. لأن الجمال منظم مثل ولادة فينوس من قبل بوتيتشيلي. ولادة الجمال هي ما يخفي عنا حقيقة هذه الولادة، أي بالتحديد الإخصاء، الذي حدث هنا للأب، في القصة الأسطورية، الذي نتج عن صب أعضائه التناسلية في البحر رغوة بيضاء صغيرة أتت منها فينوس أفروديت. لا يوجد جمال لا يتم عرضه على خلفية من الرعب، ولا توجد صورة ليست ستارة تُسدل على نقص. لكن إذا رأينا كيف نختبئ، فإن السؤال يبدو أكثر حساسية لمعرفة كيف نظهر. يمكن توضيح ذلك من خلال ما يقوله لاكان في أخلاقيات التحليل النفسي بخصوص الشيء: "هذا الشيء، الذي تمثل جميع الأشكال التي أنشأها الإنسان في سجل التعالي، دائمًا بفراغ، وبالتحديد في هذا لا يمكنه يتم تمثيلها بشيء آخر، أو بالأحرى لا يمكن تمثيلها إلا بشيء آخر. "هنا لدينا جوهر مشكلة جادة في الفن: إذا كانت المشكلة ستمنحنا إمكانية الوصول إلى الشيء الذي لا يمكننا رؤيته، فهذا يعني أن إظهار الشيء سيؤدي دائمًا إلى نقل الشيء. وتجدر الإشارة إلى أن تصريح لاكان ، الذي يتتبع إحداثيات ما يجب أن يسمى منطق المرئي ، أقرب ما يمكن إلى ما يقوله فرويد في نصه الصغير لعام 1922 على رأس ميدوسا ، حول حقيقة أن الشكل جورجون مع كل ثعابينه على رأسه هو واحد ، إنها شخصية إخصاء الأم ، وهذا يعني بالضبط ليس فقط أن الشيء يتم تمثيله بشيء آخر ، ليس فقط أنه لا يمكن تمثيله بشيء آخر ، ولكن لا يزال ذلك يتم تمثيله دائمًا بنقيضه: النقص بالمضاعف أو ، كما يمكنني أن أقول في اللاتينية ، بواسطة النسخة، وفرة - الوفرة ، قرن الوفرة ، إنه في الحقيقة مجرد إظهار للفراغ الذي إنه ممتلئ ، وهو مصنوع منه. يمكن للمرء أن يقول أن النقص ممثل في النسخة، وأن النسخة هي وجه غياب صور تغمرنا: أي إخصاء للصورة، وما هو حقيقي بدون صورة يمكن أن تكون النسخة الحالية من الصور هي الوجه؟ مع هذا السؤال الفرعي: ألا يقود هذا "بشكل طبيعي" الفن اليوم إلى جانب فقدان الشهية، وأكل العدم في الصورة؟
في منطق المرئي هذا حيث وضع لاكان علاقة الفراغ بتمثيله، يمكننا تحديد موقع إحدى البيانات التي تبدو لي أساسية للتفكير في فن القرن العشرين ومعه: كل صورة هي تبديل. وهي في الأساس أطروحة جومبريتش العظيم: "الفن يتكون من صنع الصور، وصنع الصور هو خلق البدائل. "أطروحة إرنست جومبريتش هذه هي أيضًا، كما لو كانت مصادفة، أطروحة جان لوك جودار، حيث يعود باستمرار، في تاريخه (قصص) للسينما، مثل الشعار:" بدائل السينما. سنعود إلى هذا، ومن هنا، هذا السؤال: ماذا سيكون شكله بدون بدائل؟ نلاحظ أيضًا أن لاكان لا يفترض حقًا هذا لأن فراغ الشيء، كما يقول، "لا يمكن تمثيله إلا بشيء آخر". لكن، على وجه التحديد، يبدو أن السؤال الكامل للفن المعاصر موجود هناك: في قدرته على إتاحة الوصول إلى ما لا يمكننا رؤيته، بدون بدائل وبدون تبديل (لاستخدام مصطلح المنظرة الأمريكية العظيمة روزاليند كراوس). وهذا يعني بشكل متساوٍ بدون رمز وبدون تشابه وبدون صورة. تمثيل غير رمزي وغير وهمي، والذي من شأنه التحايل على بنية اللغة، وهو تمثيل يمكنني اعتباره حيًا. لكن مع ذلك، تفتح فكرة التمثيل بدون استبدال، في سجل المرئي والصور، نوعًا من سؤال مالارمي ، الذي يمكن أن يسأله مالارمي نفسه عن اللغة ، لغة من شأنها أن تمس مباشرة الواقع ، الذي سيكون ، كما يكتب ، "في حد ذاته ، ماديًا ، الحقيقة". نعرف إجابته: إنها آية، بما "يكافئ عيب اللغات" والتي من شأنها أن تمس الواقع مباشرة. الآية التي لا تحل محل، لا تنقل الآية على أنها كلمة نهاية للغات، والآية على أنها حقيقة. إنه أحد الأسئلة الجوهرية التي نشأت للفن، في عصر حداثته، عصر الحقيقة. ومع ذلك، ما يجب التأكيد عليه هو أن السؤال المطروح ليس فلسفيًا ولكنه فني بشكل مناسب لأنه لم يكن سؤالًا، في القرن العشرين، كما في عبارة سيزان، "قول الحقيقة"؛ ساد فن القرن العشرين الاهتمام بإظهار الحقيقة. الذي يفترض سماع استجواب حول طبيعة الحقيقة ذاتها من حيث ترتيبها، أو الحقيقة كما يقال، أو ما يظهر. لإظهار الحقيقة، وهذا يعني إظهار النقص. في هذا الطيف تتكشف الحداثة الأخرى لفن القرن العشرين، والتي يمكن بالتالي نسجها في طرق متغيرة بلا حدود لإظهار النقص "الذي لا يمكن رؤيته". يبدو لي أن هذا الرسم الرسمي للأسئلة مرتبط بمحتوى هذا ملموس وتاريخي. وهكذا يمكن تنظيم تاريخ الفن من انحراف "ما لا يمكن رؤيته"، بافتراض أن "ما لا يمكن رؤيته" قد غيّر اسمه. كما لو أن مختلف عصور الفن تتخللها العديد من المستحيلات. كان من الممكن أن يُطلق عليه اسم الله أو، كما هو الحال بالنسبة للبرتي، الريح أو العاصفة أو الصوت أو الروح البشرية - إنه يعطي فكرة مجال فني محدد على أساس المستحيل، والذي يتوقف عليه هدف، تصويب. سيتكون تاريخ الفن بأكمله من ردود الفن لإظهار ما لا يمكن رؤيته، ولإعطاء صورة لما هو خارج، أي فن الاستبدال، والتبديل، وبالتالي الحجاب. في هذا الصدد، ما يجعل الفاصل الحديث هو إظهار ما لا يمكن رؤيته، بدون صورة وبدون كلمة، ولكن بدون تبديل. سوف ننتقل من التمثيل، من النقل إلى العرض، وهذا يعني أن الفن اختزل إلى فعل. أعتقد أيضًا أنه يمكن تمييز المنطق في تاريخ فن القرن العشرين، وهو المنطق الخاص بالمرور من التمثيل إلى الفعل. يبدو أن فن نهاية القرن العشرين يقترب باستمرار، من خلال مسارات متعددة - الرسم وليس استبعاد - بعد الفعل. الفن كمرور خاطف، لكن دعنا نصل إلى هذا: يمكن للمرء أن يقول إن اسمًا من المستحيل رؤيته في القرن العشرين، مما يجعل القلب غائبًا عن الصور، سر المرئي، هذه هي غرف الغاز. سيكون هذا هو الاسم الأكثر ملاءمة للافتقار الذي ظهر للقرن العشرين. واقع نشأ في التاريخ، خارج الفن، ولكنه، بمجرد وجوده، من خلال حقيقة أنه قد حدث، يفرض نفسه على الفن كشيء لا يمكنه الابتعاد عنه، إلا بالتخلي عما يؤسسه ويوجهه، أو لمنح حق الوصول إلى ما لا يمكن رؤيته. وبمعنى ما، فإن جملة أدورنو حول استحالة الفن بعد أوشفيتز هي فقط الإجابة، المتسرعة جدًا، على ما يجعل الفن التشكيك حقيقيًا، والذي لا يستطيع الهروب منه. يمكنه فقط الرد أو الهروب. نتيجة لذلك، يمكن للمرء أن يجادل في أن فن ما بعد عام 1945 يتكون من جميع الاستجابات اللانهائية التي تم إحضارها إلى الواقع، لهذا الثقب المرئي من القرن العشرين، والذي يسمى غرف الغاز (التي ما زلنا ليس لدينا صورة حتى الآن، على الرغم من تحريفات جورج ديدي هوبرمان حول صور معرض مذكرات المعسكرات الذي أقيم في باريس1.
إن طريقة وضع قلب مسألة المرئي والصور في الحل النهائي هي ما يدافع عنه أيضًا، بمعنى واحد، بمعنى واحد فقط، من قال إن "السينما بدائل"، جان لوك غودار. إذا استدعيتها هنا، فلن أعطي مكانتها لفن القرن العشرين الذي كان السينما، ولكن لأن السينما بالتحديد هي فن القرن العشرين. كتب غودار فيه ما كان، كما أعتقد، تحدي الفنون في القرن العشرين. كانت السينما بلا شك، لأنها كانت فنًا ناشئًا، ما يمكن أن أسميه الفن الحساس. ومع ذلك، أريد أيضًا أن أبين في جودار، الذي لديه رؤية حادة لمخاطر الصور في القرن العشرين، إلى أي مدى لم يكن رده على وجه التحديد استجابة للفن الحديث. بالنسبة له، في الواقع، تاريخ السينما في القرن العشرين يجد حقيقته في اكتشاف معسكرات الموت. بمعنى آخر، سيكون هناك بعد أدورني لفن السينما في جودار، والذي يفترض أن السينما أصبحت "مستحيلة بعد أوشفيتز". لكن إذا قلت عن جودار إنه دعم أطروحات حقيقة الصور هذه "بمعنى واحد" فقط، فذلك لأنه بالنسبة له، إذا أصبحت السينما "مستحيلة" بعد أوشفيتز، فليس ذلك بسبب عدم إمكانية تصوير الرعب، من الناحية البنيوية. غير قابل للتمثيل: هو، على العكس من ذلك، لأنه لم يتم تصويره. لذلك، بمعنى ما دائمًا، وإذا أشرت إلى المقولات التي حددتها في البداية، إذا دافع جودار عن أن ما هو مرئي وصور القرن العشرين ممتدة من قبل معسكرات الموت، فهذا ليس موجودًا على الإطلاق في فكرة نقص البصر البنيوي، لكن حقيقة الصور هي خطيئة ضد الصورة. بالنسبة له، حقيقة المرئي ليست شيئًا غير موجود؛ حقيقة الصور هي الخطيئة، إنها خطأ عدم إظهار الصور. وهذا يعني أننا وجدنا أنفسنا، مع جودار، في فكرة أن كل شيء مرئي، وأن كل ما هو مرئي مرئيا، وأن كل ما هو مرئي مرئيا، وبالتالي فإن ما هو غير مرئي هو مجرد خطأ فيما يتعلق الصورة. حقيقة الصور هي جريمة تم ارتكابها ضد الصورة وتم ارتكابها من قبل أولئك الذين هم على وجه التحديد سادة الصور، وبالتالي سادة العالم (هوليوود أمريكا). في هذا الصدد، فإن الافتراض القائل بأنه سيكون هناك شيء غير قابل للتمثيل يشكل بالنسبة لغودار هجومًا على الصورة التعويضية. كتب جاك رانسيير في مجلة دفاتر السينما: "إذا لم تكن هناك صور للمخيمات، فإن فضيلة الصورة هي التي ستكون موضع تساؤل: فضل وجودها في كل مكان وإظهار كل شيء للجميع. هذه الفضيلة لا علاقة لها بطاعة الآلة على التكاثر. الصورة المعنية هنا شيء آخر غير التكاثر. إنها علامة الحقيقة، الوجه على حجاب فيرونيك، وجه الكلمة، ابن الله المخلص، بصمة النموذج الأولي". فضيلة السينما حسب جودار ليست فضيلة الكاميرا التي تقرر، إنها فضيلة الشاشة، حجاب ممتد حتى يطبع العالم عليه. لهذا السبب كان على السينما تصوير محتشد أوشفيتز." لكن السينما فشلت في المهمة التي فرضتها عليها صلاحياتها وهي تصوير رعب المخيمات. لكنها كانت تفتقر أيضًا، بالنسبة إلى جودار، إلى معرفة صلاحياتها: لم يكن قادرًا على التعرف على ما سبق أن أظهره في خياله: على سبيل المثال، في البحث عن الأرانب أو رقصة الموت في قواعد اللعبة أو في الغارات المعادية للسامية ومعسكر اعتقال الدكتاتور. إلا أنه لم يتوقع رينوار ولا شابلن ما سيحدث: لم يستطيعوا، ولم يستطع أحد. في الحقيقة، كل شيء يحدث لجودار كما لو كانت الصورة، من ناحية، واحدة من تلك الشخصيات من العهد القديم تعلن الجديد، وكأن تصوير المعسكرات بعد ذلك يمكن أن يكون وسيلة لإنقاذ ما تم التضحية بها في المخيمات. هناك رؤية لغرف الغاز مثل تلك الخاصة بالعاطفة، لفداء محتمل من خلال شغف الصورة الذي من شأنه أن يحفظ الصورة لا تسقط بل مقتولة. كانت الصورة بسبب القيامة. بهذا المعنى، عندما يقول جودار أن هناك بالتأكيد صورًا لغرف الغاز في مكان ما، فأنا لا أعتقد حقًا أنه يبحث عن دليل - حتى لو دخل في منطق الإثبات الكارثي - ولكن هذا يشهد على الإيمان المسيحي العادل، الذي يدعم الأيقونة، أن الخطيئة ضد الصورة يمكن تخليصها بالصورة وفيها. إذا كانت هناك عقدة مسيحية بين التاريخ والتمثيل، إذا كان صنع التاريخ هو التقاط صورة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما يحدث للتاريخ في مواجهة حقيقة خارج التمثيل، وهي حقيقة لا تؤرخ، لاستخدام البرتي المصطلح في لوحة، حقيقة لا ترسم صورة. وهذا يعطي مصلحتها لمشكلة تصوير المحرقة، لأنها تفترض أن وضع الصور هو تحويل المحرقة إلى التاريخ، أي جعلها إيجابية: يمكننا إخبارها ووصفها - نحن يمكن أن ترسم صورة لها. وبهذا المعنى، فإن صنع صورة قصة يعني أن نقول وداعًا لها، فهذا يعني التأكيد، كما أعتقد، كما أعتقد آلان فينكيلكراوت يقول سراً في كتابه صوت يأتي من الشاطئ الآخر: "نحن لسنا أكثر تميزًا بالمخيمات. فيما يتعلق بغرف الغاز، يؤكد كلود لانزمان أن أي تمثيل، أي صورة للجريمة هو بديل، وبالتالي تليين، وبالتالي خيانة، ونسيان أيضًا. في هذا، السؤال الذي يطرحه فيلم مثل فيلم بينيه، الحياة جميلة، ليس ما إذا كان بإمكاننا الضحك على كل شيء (سؤال غبي: أننا قرأنا رقصة جنكيز كوهن بواسطة رومان جاري!)، لكن إذا لم نكن كذلك. هناك، أمام فيلم، بإدخال المحرقة في الصورة، يدخلها في التاريخ، ولكن في تاريخ هو بالتالي تاريخ الشغف بالصورة. من هناك، أليس عمل صور المحرقة بالضرورة هو تنصير المحرقة؟ علاوة على ذلك، وبنفس المعنى، فإن إدخال المحرقة في الصور يؤدي إلى إدخال الحقيقة في لعبة الاستبدالات والتشابهات، والتي تفترض أن نتيجة أو شرط دخول المحرقة في الصور وفي التاريخ، هي أيضًا من الجيد أن أتطرق إلى ما هو تفرده، وما يوجد في هذه الحقيقة غير قابل للاختزال لأي شيء آخر. أيضًا، نرى عددًا معينًا من المصطلحات يتم وضعها في سلسلة مثل الصورة أو القصة أو الإيجابية أو حتى المعنى، بقدر ما يكون تكوين الصورة هو إعطاء معنى. ما الذي قد تعارضه سلسلة أخرى: ذاكرة معارضة للتاريخ، وموضوعات تعارض معرفة ماهية التاريخ، وسلبية معارضة لإضفاء الطابع التاريخي على الإيجابية، وموضوع معارض للصورة. السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو معرفة ما الذي ينقل ذاكرة ما لا ينتقل إلى صورة القصة، وما الذي يجعل هذه الحقيقة تتجاوز التمثيل للموضوعات، وما الذي يعطي الوجود للسلبية. الجواب: هذه هي الأعمال، وأود أن أضعها على هذا النحو: العمل، كشيء، هو بصمة الواقع. هذه الطريقة في أخذ الشيء أولاً تمثل نقطة. إن مفهوم البصمة هو ما يفسر أساسًا السؤال الأول: كيفية تمثيل شيء ما ونقله عن طريق التحايل على البنية الدالّة والصورة، بدون استعارة، وبدون رمز أو تشابه، بشكل مباشر. لن يكون الفن بديلاً عن العالم. لكننا نرى السؤال الذي يلوح في الأفق، لأن فكرة البصمة تفترض إيجابية أولية تترك بصماتها في أجوف وسلبية. عندما يتعلق الأمر بالهولوكوست، يصبح السؤال هو نقل السلبية دون نقلها. البصمة هي الجواب. ولكن بعد ذلك، كيف نجعل بصمة السلبية، وكيف تحل المشكلة، التي يقف أمامها لاكان، من الفراغ الذي لا يمكن تمثيله إلا بشيء آخر؟ بعد كل شيء، المشكلة ببساطة هي بصمة الثقب. كيف يمكن تضييق مسألة "تمثيل" المحرقة من عملين مثل " أوراق جميلة أنثوية" لدوشامب و" يلقي من الفضاء " تحت مقعدي لبروس نعمان، وهما عملين صغيرين لا شيء على الإطلاق وهما في الواقع، بدون خطاب، رد الفن على السؤال الذي يبدو أساسيًا لفن القرن العشرين. هذه الأعمال، في حد ذاتها، هي بصمة الغياب، والافتقار، والفتحة، أي أن عمليتها الخاصة تتكون من الافتقار إلى النقص أو الفراغ، فهي تصنع من الوجود السلبي. إن فكرة الإيجابيات للافتقار أو الغياب هي في صميم فكرة الشيء في التحليل النفسي، يبدو لي في قلب فن القرن العشرين. ما أريد أن أؤكد عليه هو أن مسألة ما لا يمكن تمثيله لا تستلزم بأي حال من الأحوال التفكير في نهاية التمثيل. إذا تحدثنا عن غرف الغاز غير القابلة للتمثيل والإبادة، فهذا يعني أنه لا توجد صورة، ولن تكون هناك قصة متروكة لها لأن الحقيقة تتجاوز كل ما يقال وكل شيء مرئي. ولكن إذا لم يحدث شيء في المحرقة باستثناء "رعب العدم" (لاكو لابارث)، فهذا لا يتبع فناء التمثيل، أي أن أي تمثيل، مهما كانت طريقة سماعه، سيكون عفا عليه الزمن. الغياب أو النقص أو الاختفاء - لاستخدام عنوان رواية بيريك، الذي لم تكن كل هذه الأسئلة بالنسبة له سوى أجنبية - لا تفلت من منطق التمثيل. يستعيد التمثيل معناه الأساسي: ليس استنساخًا، يخضع بحد ذاته لحدود "وجهة نظر"، بل إيماءة تجلب الحضور، عرضًا. ما يمكنني أن أضيفه هو أن الموضوع الذي أتحدث عنه، كإيجابية للنقص، هو الشيء ذاته الذي يعرِّفه التحليل النفسي كموضوع. كل هذا يحفز التفكير فيما هو مرئي وحقيقة الصور لأنه، كما يشير رانسيير في الخارج، بالنسبة إلى جودار، فإن الصورة مطبوع عليها الوجود. فيما نجده هنا فكرة أن الصورة يتم تضييقها بواسطة شيء ما. لكن التعامل مع الصورة على أنها بصمة الوجود، فكرة أن السينما هي "أيقونات الحضور" (رانسيير)، إذا كان هذا يتعارض مع الخيال الوهمي، فهو بالتالي من أعتبره كذلك. راهبة. وهذا يعني أن هناك طريقة أخرى، بمعنى ما، هي الطريقة الحديثة على هذا النحو، وبالتحديد ما يسميه رانسيير "الوهم المزعوم" والذي يتألف من "احتفال بشري بحت بحيلة "، وهي حيلة تظهر على أنها حيلة. ستكون فكرة مالارميان عن خيال غير مرتبط بالرمز والتشابه والتجسد، وبالتالي غير مقيد بهذا المعنى من كل التدين. يمكننا الاحتفاظ بالأحرف الأولى منه: فن في. سيكون فن القرن العشرين فنًا لم يعد يُظهر بصمة الوجود، بل بصمة الغياب، التي من شأنها أن تُظهر غياب ما وراء - وهو ليس هو نفسه الغياب من الخارج، فقط تسطيح الطائرة، ولكن الذي يعطي الغياب باعتباره الحقيقة الإيجابية وسبب التمثيل. من هناك، علاوة على ذلك، يمكن للمرء أن يؤكد أن فكرة الفن كفئة وحدوية وجدت تماسكها فقط من افتراض غير مرئي كان المرئي هو التجسد؛ الصور المرئية المتعددة باعتبارها تجسيدًا للحضور والحضور الفريد؛ إن هذا الوجود الفريد، وهذا المعنى الديني للمرئي وللصور هو الذي أعطى تماسكه، إن لم يكن تناسقه، لفكرة الفن الواحد، مما يسمح على سبيل المثال بالحديث عن الرسم. لكن، إذا كان فن القرن العشرين، كما أعتقد، فنًا، فإنه يعرض إلحادًا للصورة، يفترض مسبقًا تحطيم الوحدة، فإن هذا الفن يتدفق بالكامل إلى أعمال لا تساوي أكثر من واحد من خلال واحد، كل منها يظهر ما يمكن أن يظهره فقط، من خلال إظهار نفسه، ولا شيء آخر غير ذلك. هذا ما يجعلنا ننتقل، كما هو الحال مع لاكان، من سؤال فلسفي أو تاريخي من نوع "ما هي اللوحة؟ لهذا الآخر: "ما هي اللوحة؟" ". يرتبط الإلحاد في فن القرن العشرين بارتداد ارتداد الفن إلى العمل الفردي، إلى هذا الفهم شبه الأحادي للعمل حيث يحتوي كل عمل على كل الفن. أيضًا، عندما نقول الفن، فإن اسم الفن هو اسم واحد، وبالتالي من المفارقات أن مجموعة غير واحدة وغير محدودة وغير متجانسة، تتكون من تفردات والتي نسميها "أعمال"، أو بالأحرى هذا الهيكل من الإلحاد (لا يوجد تاريخ لمثل هذا الإلحاد)، يشكل التجريد لحظة أساسية في هذا الفن الواقعي. في هذا، لذلك، نحن في عكس رأي جان كلير الذي يقول: "إن ظهور التجريد [...] لم يكن له النتيجة الوحيدة المتمثلة في صنع العمل، ولم يكن ثقب الباب المميز مفتوحًا على العالم، بل كان غير شفاف وتتداخل الشاشة المسطحة بين النظرة والواقع، مما يكرس فقدان الإحساس بالمكان، أو قمع أو استرخاء النقاط المرجعية التي أمرت بقبضتنا على العالم، أي إفقار العقل. كل من يعتقد أن وورينجر كان أول صرخة إنذار في القرن (في التجريد والتعاطف، 1907)، لديه، في فكر ذي رؤية، يُرى تمامًا في صعود التجريد أعراض "القلق الروحي أمام الفضاء"، "رهاب الخلاء الروحي"، و"الشعور بالضيق في الحضارة" الذي كان سيبتلع القرن العشرين بأكمله، يعتقد هذا المرء هراء. وأيضًا، الشخص الذي يدين التجريد بنبرة الواعظ النبوي، والمذنب بـ "التعهد بالابتعاد عن المرئي"، يعبر عن تركيز جاف من الهراء. وليس من الظاهر أن التجريد قد تعهد بالابتعاد. هذا هو دين المعنى. ينجز الفن التجريدي انفصال الصورة والمعنى. يمكن للمرء أن يقول إن الفن التجريدي يقدم لنا الإخصاء مباشرة، في حقيقة أنه يتعلق بصور بدون معنى تمثيلي، ومع ازدراء وضع عناوين لها لا يمكن إلا أن تخفي هذه اللوحات تضعنا في اختبار إخصاء المعنى. من ذوي الخبرة في أن الفن التجريدي يجعل الأيقونات مستحيلة (فهو لا يمنع تطور أيقونات الفن التجريدي، بل هو مجرد هذيان، على عكس أيقونية ولادة الفن من جديد). حتى ذلك الحين، كان تاريخ الرسم هو تاريخ الكتل غير القابلة للتجزئة، تلك الوحدات الموحدة للصورة والمعنى تسمى اللوحات. ما يجعل حدث التجريد هو أنه استند إلى تدمير هذه الكتلة، على الفصل بين الصورة والمعنى. الذي يحمله من يرعد ضد التجريد يهدف في الحقيقة إلى شيء آخر غير "فقدان المعنى". من المكانية ". مرتبًا في المظهر تحت راية الدفاع عن الواقع، الشخص الذي رعد ضد فن مسؤول عن ضمور الحواس - الواقع، اللون، المكاني، المادة ... - يأسف لشيء آخر: تحت فقدان الحواس، فقدان الإحساس - ببساطة المعنى. إذا كان ما يميز الحداثة في الرسم هو الانفصال عن المعنى، فإن فقدان المعنى بالتحديد هو الذي يدين الرسم الحديث في عيون الشخص الذي يكتب: فقط لأنها كانت رمز الآلام. ومع ذلك، مع فان دونجن ، لم يعد الأمر أكثر من صبغة حمراء ، جُردت من ممتلكاتها لأنها ذات معنى أعطاه شكلاً. ومن يفكر الآن في الرغبة في رسم زهرة، كما فعل دورر أو توماسو دا مودينا في وقتهما، يمكنه فقط مواجهة شيء، جرد من الأساطير أو الحكايات أو المعتقدات أو الرموز، والذي لفت انتباهنا بالأمس وحماستنا، تقف في نوع من التعقيم الدلالي المطلق. ما هي النية التي يجب أن تُعطى لفعل التمثيل، إن لم يكن الأكثر بؤسًا؟ "
بؤس التمثيل: إنه عيب بلا معنى. اتهام بالعمل على تجفيف المعنى الذي كان سيبتلع القرن بأكمله. صحراء المعنى التي نكون قد فقدنا فيها أنفسنا. من يتحدث على ما يبدو عن الرسم، عن العالم وعن المرئي، لا يتحدث في الحقيقة عن الرسم ولا عن العالم ولا عن المرئي، بل عن شيء ما وراء الرسم، العالم والمرئي. ببساطة وراء. على عكس ما يطلقه اللامبالاة على التجريد من قبل الشخص الذي تظاهر بأنه وقفة يقظة للواقع، لم يكن حزنًا على فقدان العالم المرئي، بل فقدان هذه العوالم الأخرى. أعطنا اشارة. صور، لم يعد لديك روح؟ وهكذا، فإن لوحة هذا القرن متهمة بشكل ماكر ولكن جوهري بإخلاء عالمنا من السكان وتنظيم حظر على المعنى. الشخص الذي يدعي، أرسطو قليلاً، باختصارإأن المعنى، مثل الروح، يعطي الشكل، يأسف لفقدان الشكل في الرسم، وفقدان المعنى في هذا العالم. بعد أن فقد الإحساس بالمعنى والشعور بكل اعتقاد، كان الفن اليوم قد غرق في خراب الأشكال: مؤمن بشكل سيئ، ورسم بشكل سيء، كما يقول المثل. بالإضافة إلى كونه مؤلمًا، فإن هذا الفن لا يزال يسبب الخراب الروحي للمشاهدين: رسم سيء، سيئ الاعتقاد، قول مأثور آخر، معتبرين أن ما نراه دائمًا يعني شيئًا آخر غير ما نراه: إنه جوهر التدين. كان الفن الحديث في الاتجاه المعاكس: فهو فن كتابة وليس فن روح، فن أخذه حرفياً. يمكننا أن نقول عن فن القرن ما قاله رامبو: "إنه يعني ما يقوله حرفياً وبكل معنى. في الأساس، أود أن أقول إن فن القرن العشرين حقق نوعًا من الكشف الأسمى: فمن ناحية، حقق ما جعل الفن منافسًا للفلسفة لأفلاطون، أي الاعتراف به كمظهر؛ إن تسطيح اللوحة، بعيدًا عن كونه مقدمة لشاشة غير شفافة تقطع العالم، يميل إلى إظهار نفسه كمظهر يقول إنه مظهر. الفن الحديث، هناك، يتميز بالاهتمام بالحقيقة. لكنه فعل أكثر من ذلك. من خلال إظهار نفسه كمظهر، يُظهر الفن أن العالم، ما نسميه الواقع، هو مظهر. فقط، بدلاً من توليد فكرة أنه سيكون هناك شيء ما وراء المظاهر، فكرة دينية، يميل الفن إلى إظهار أن هناك مظاهر فقط، حقيقة فقط، أن هذه الحقيقة التي يأسف لها جان كلير لأننا كنا قد فقدنا الإحساس بها، إنه ليس سوى استعراض للظواهر، وبالتالي، بدلاً من صرفنا عنها، فإن الفن على العكس يعيدنا إلى قلب الواقع. سيكون من الضروري تصور أن الهوس بأحدث لوحة يمر عبر ونسج القرن العشرين بأكمله ليس هاجسًا بنهاية للفن، أو إغلاق زمني، أو تاريخ مكتمل، ولكنه كشف نهائي للجانب السفلي من المظاهر: اللوحة الأخيرة هي في الحقيقة اللوحة الموجودة أدناه. من حيث السُمك، في سمك المستوى، استخدام كلمة داميش، سمك مستوى التمثيل، في سُمك مستوى الصور، في المظاهر، يجب وضع "اللوحة الأخيرة". ". هذه هي طريقة فيلاسكيز لجبل الفن. طريق مينيناس. ولهذا السبب أيضًا - أعتقد - أن هناك شيئًا لا يمكن تجاوزه في الفن، وهو الرسم. لهذا السبب - أعتقد - لن ننتهي من الرسم. أنا لا أقول أن الرسم على هذا النحو، من الناحية الفنية، هو الفن الوحيد الممكن وأن كل شيء آخر سيتم رفضه، أعتقد أننا لن ننتهي أبدًا من الفن مع اللوحة، التي أظهرت لنا اللوحة بالتحديد بنية. كل فن يدور حول اللوحة. من اللوحة ما يظهر هيكل المرئي. تمامًا حول: في الأمام، الفوق، من الداخل، من الخلف. في الأساس، عندما نقول إن اللوحة ستصبح شيئًا في القرن العشرين، فإننا نقول بالضبط: هذا هو الشيء الذي ندور حوله. في الواقع، في القرن العشرين، رجعنا إلى فكرة ألبرتيين بأن اللوحة عبارة عن نافذة. لكن بدلاً من أن يكون هذا وهمًا، أخذ فن القرن العشرين الأمر على محمل الجد. يمكننا أن نعتبر فن القرن العشرين فنًا شهد مسارين محتملين، مسارين حدّدهما مفهوم الرسم ذاته. يمكن للمرء أن يعتبر شاهداً على هذا الفصل وهذا التعبير عن المسارين عملاً لروثكو. خذ هذه الفكرة القائلة بأن اللوحات، في سلسلة 1958 من مبنى سيجرام ، تشبه الستائر المتساقطة. نرى أن سطح اللوحة لا يفي بحافة اللوحة. ما نراه هو نافذة مغلقة، مسرح سقط عليه الستارة. إذن، أحد أمرين: إما أن نصنع مسرحنا أمام الستارة، وأن نرسم الستائر، أي نظهر أن كل شيء مرسوم على السطح هو ستارة تُعترف بأنها ستارة؛ أو نظهر ما هو تحت، خلف الستارة، وهذا هو طريق الواقعية في الفن. لكننا ندرك على الفور أن الأمر لا يتعلق بمعارضة المسارين باعتبار أن أحدهما جيد والآخر سيئ، أحدهما صحيح والآخر خاطئ، لأنهما يمثلان جانبًا من الحقيقة: الرسم كما يفعل روثكو ، هو إظهار المظهر. الذي يقول إنه مظهر؛ في هذا، هذه اللوحة هي لوحة الحقيقة، فهي تهدف إلى الواقع. إما أن نعرض ما هو تحت الستارة، ثم نعرض الأشياء، أو نقوم بفن الأرض، أو نلمس الجسد في العروض، نتدخل في العالم على العالم. لكن هل الظهور وراء ستار روثكو يلبي أخيرًا طلب جان كلير الذي يأسف لفقدان الواقع في الفن؟ مُطْلَقاً! لأن إظهار الجانب السفلي من المظاهر، والتوقف عن تحجبها، وعدم نقلها، سيظهر دائمًا، بشكل أو بآخر، أنه لا يوجد شيء خلف المظاهر. لا شيء سوى رغبة الإنسان في أن يكون هناك شيء ما، رغبة إنسانية صحيحة تنبع من مجرد حقيقة أن هناك ستائر وكويز. ما تظهره مينيناس، بخلاف مشكلة الملك والملكة، هما شيئان أو ثلاثة أشياء: إنها لوحة مقلوبة وهي طريقة فيلاس أو روث (فيلاس "حجاب" بالإسبانية): يقر بأنه سطح شاشة تعترف بأنها شاشة. ثم يظهر أيضًا ما هو أمام اللوحة، والمشاهد الذي تم القبض عليه في الجهاز، والمشاهد الذي شاهده اللوحة. الشيء الثالث الذي يظهره هو الشخصية الموجودة في الخلفية، الشخصية الأبعد في خلفية اللوحة، الفيلاسكويز الآخر الذي يبدو أنه يغادر والذي، بالصدفة، هو الشخص الذي يقع على ذراعه نقطة تلاشي اللوحة. اللوحة - وهي بالتالي مركز البناء. وهذه الذراع بالتحديد ماذا تفعل؟ يسحب ستارة أو يدفعها للخلف. لا يعد فيلاسكيز الآخر مسارًا بالإضافة إلى المسارين الآخرين، فهو الذي يوضح أن هناك مسارين، مسار الطائرة وهذا، على وجه التحديد، للخلفية، لما وراءه. الطائرة التي تُظهر أنها طائرة وأن الخلفية تظهر أنه لا يوجد شيء خلف الطائرة (في هذا، أعتقد أنه لكونها لوحة ميتافيزيقية، فإن مينيناس بواسطة فيلاسكيز هي لوحة ملحدة). لكن ما أريد التأكيد عليه هو أن المسارين، وهما ما أسميه الحداثتين، ليسا متعارضين لأنهما في جانب الحقيقة: إظهار مظهر يقول إنه مظهر ويظهر أنه لا يوجد شيء وراء المظهر. الطريقة الوحيدة المستبعدة تمامًا من الفن الحديث هي بالتحديد تلك الخاصة بفن المعنى، والذي يعني دائمًا شيئًا آخر: فن المظاهر الذي من شأنه أن يقود المرء إلى الاعتقاد بأن هناك شيئًا وراء المظاهر، أن القرنفل لا يعني زهرة ولكن معنى يتجاوزها، العاطفة. ما تستبعده الحداثة هو الوهم بمعنى الوهم الذي لا يقول إنه وهم. لأنك لا يمكن أن تكون مخطئا. لا أدعي أن الفن الحديث كان سيُبطل الوهم على هذا النحو، باسم حقيقة بلا حجاب في النهاية. هذا هراء ديني: لأنه لا حقيقة وراء الحجاب، الحقيقة الوحيدة هي أن هناك حجابًا، وخلف الحجاب لا يوجد شيء يمكن رؤيته. أعتقد أنك ترى كيف يمكن للاعتذار القديم لـ زيوكس وباراسيوس أن يكون نقطة الحقيقة في فن القرن العشرين. إلا أن الاعتذار يدل على أن وراء الحجاب لا شيء - إلا الرغبة في رؤية ما وراء الحجاب. تأخذ الحداثة الاعتذار بشكل أساسي، لكنها تظهر من ناحية أن الحجاب وهم، وأن الحجاب يخفي أنه لا يوجد شيء. وهذا يعني أن فن القرن العشرين يظهر الحقيقة المخفية في اعتذار زوكسيس وباراسيوس. وفجأة، تحذر مما هو وراءك، والفن المرئي والمرئي هو حجاب يحجب هذا الشيء الذي لا يمكن رؤيته، وفي الوقت نفسه، له فضيلة الإشارة إلى أنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته خلفه. يمكن لـ روثكو أن يمارس الإيمان بالصورة المسطحة التي "تكشف الحقيقة"، وفي سلسلة مبنى سيجرام، هذه لوحات قماشية لها ظهر وعمق والتي، كما يشير إيف ديبلسينير، تعلن تحت الستار الساقط: الانتباه، هنا، الحد الأخير، هو الجدول الأخير بمعنى الذي تحدثت عنه من قبل؛ الشاشة الأخيرة قبل أي شيء، وهذا يعني أيضًا الحد الأخير قبل الرعب. لا يمكنني قبول أن روثكو ترك الشخصية بعد الحرب في عام 1948 مقابل لا شيء - وبالتالي، في نظري، بدلاً من ترك الواقع، على العكس من ذلك يغرق فيه. روثكو، وهو يهودي، هو بوتيتشيلي وفقًا للمعسكرات: من خلال رسم الحجاب، يرفع الحجاب عند ولادة الجمال بعد الرعب مباشرة وقبله مباشرة. ينجز روثكو بأكبر قدر ممكن مشروع فنه لإتاحة الوصول إلى ما لا يمكن رؤيته، ويقترب قدر الإمكان من الحقيقة، إلى الحقيقة التي لا يمكن رؤيتها. بهذا المعنى، فإن لوحة روثكو هي الشكل الأكثر دقة لرسومات تاريخ القرن العشرين. إن اختراع الحداثة الأخرى ليس التسطيح، بل العمق، ولكن ليس العمق الخادع، أي عمق الطائرة، عمق بلا وهم. إلى جانب ذلك، أود أن أقول إن فن القرن العشرين هو فن بلا وهم أو خيبة أمل. بصرف النظر عن القليل من القصاصات والأشخاص المهملين، لم يكن هناك فنانين أيديولوجيين عظماء في القرن العشرين، بينما، حتى ذلك الحين، كان الرسم مكانًا رائعًا لنشر الكاثوليكية. في القرن العشرين، لا يمكن القول إن الفن كان عامل أيديولوجيات عظيمة. ربما كان مكان الخلاف والنقد. أعتقد أن تسطيح الخطة هو السبب. لا يمكن خلق الاعتقاد على مستوى مسطح. لن يكون فن القرن العشرين مكانًا للنضال أو التنديد بل مكانًا لخيبة الأمل أو فن خيبة الأمل، فن المرئي حيث ستلتقي الرؤية بخيبة الأمل. آمل أن نفهم بشكل أفضل يمكنني أن أقول فيه ذلك فن القرن العشرين، حتى لو لم يكن معنيا به، حتى لو جاء قبل الحقائق التاريخية، مشغولا أو مشغولا دون أن تريده المحرقة. باختصار، المحرقة هي الاسم الذي يمكن أن نطلقه على ما يكمن وراء كل ما هو مرئي، على وجه التحديد لأنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته. ستة ملايين شخص بدون صور وستة ملايين اسم وستة ملايين شخص مكفوفين لأنهم لم يروا شيئًا. هناك فجوة واضحة في قلب القرن العشرين، حيث لم يتوقف النازيون أبدًا عن إخفاء جريمتهم عن الجميع، حتى الضحايا، بل محوها عن أعين الجميع، لإزالة كل آثارها. إنه اسم المستحيل، نقص الرؤية في القرن العشرين ... سيكون هناك، في فن القرن العشرين، حداثتان مجتمعتان، فن التخطيط وفن الظهر - خطة. يمكننا تصنيف هاتين الطريقتين، طريقة الخطة وخلفية اسمين من الفنانين. يمكنني الجمع بين هذين المسارين من خلال معارضة الحداثتين في عمل دانيال بورين من عام 1978، لوحة الأشكال، وفي نصب تذكاري لجوشن غيرز مؤرخ في عام 1986. يوضح بورين أن المظهر ليس سوى تصنيف طبقات، سماكة للطائرات. إنه أذكى في هذا من فونتانا، الذي يقسم لوحاته كما لو كان ليصدق أنه وراء، أخيرًا، هناك حياة حقيقية، الشيء الحقيقي. أما بالنسبة لجيرتس، فإنه يذهب إلى الجانب الآخر من الطائرة، من النافذة، إلى الجانب الآخر من المظاهر، على الجانب الآخر من مستوى الصورة. وما يجده في الجانب الآخر شيئان: لا شيء يمكن رؤيته، ثم ما يشغل مكان هذا العدم الذي يراه، وهو نظرة المتفرج. نحن ندرك أن الأمرين متداخلين تمامًا. في لوحة فيلاسكيز، الثانية فيلاسكيز في الخلفية (المرفقة بخدمة الملك، لم يكن مرتبطًا بعائلة دييغو)، الشكل الأسود في زاوية الباب الخلفي، فيلاسكيز الأخرى هي المتفرج الذي يغادر ويغادر بسبب لقد رأى كل شيء، وهذا يعني أنه رأى أنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته (مما يجعله جيدًا بما يكفي لتمثيل المحلل والمرور من باب محلله بعد جلسته الأخيرة). غيرز ليس مؤيدًا للفن بدون عمل، فهو يظهر فقط أن العمل بأكمله في نظر المتفرج. إنه ليس فنًا بدون عمل على الإطلاق، إنه فن يكون عمله نظرة المتفرج. جيرز هو فيلاسكيز في الخلفية، ولهذا السبب أعتبره فنانًا رائدًا (هذا ما سأسميه اللامركزية للفن أو فن التحول، كما سنرى لاحقًا). من الضروري إلقاء نظرة جيدة. بشكل عام، لا يبدو المرء على ما يرام. لا نرى شيئاً فنقول: غياب العمل. مُطْلَقاً! الأمر هو أننا لا ننظر إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه: لا نرى أن العمل الحقيقي، نحن من نبحث: أين يوجد العمل بحق الجحيم؟
جيرز هو النمط الذي، في فيلم لاس مينيناس لفيلاسكويز، يُظهر المشاهد أمام اللوحة الذي ينظر: اللعنة عليها، ولكن أين اللوحة؟ في هذا، غيرز هو فيلاسكيز في القلب، فيلاسكيز الأخرى. أعمال غيرز هي أجهزة لإخراج المشاهد كعمل، باعتباره العمل الفني الوحيد. لكنه ليس تلاعبًا (وهو ما كان سيحدث إذا كان الأمر يتعلق بمحاصرة المتفرج وإضحاك الفنان وأصدقائه، كما في الكاميرا الخفية)، بل على العكس من ذلك جهاز لإظهار المتفرج أنه موجود. قلب العمل، أن نظره هو العمل، إنه جهاز يظهر فيه المتفرج لنفسه على أنه قلب العمل. في هذا، أود أن أقول إن غيرز ينجز ويؤتي ثمار فكرة دوشامب: "المشاهد هو الذي يصنع الصورة. هذه المرة، المشاهد هو الشيء المركزي، الشيء الذي نحدق فيه في الصورة الكبيرة للعالم. نحن نتعامل هنا مع فن تصويري يمتد إلى أبعاد العالم، وحيث تكون الذات، والمتفرج، ونظرته التي تدخل كعمل في اللوحة. هذا هو بالضبط ما كتبه غيرز بجوار نصبه التذكاري لمناهضة الفاشية في هاربورغ، وهو ما يعنيه من الناحية السياسية، أي هذه الجملة: "لأنه لا يمكن لأحد أن يقف في مكاننا ضد الفاشية"، وهي الجملة التي تظهر بجانب عمود ضخم، بدلاً من الوقوف، وغرق ببطء واختفى تحت الأرض منذ عام 1992. أود أن أقول إن جوهر هذا العمل يتألف من فعل اللامركزية. ومع ذلك، أعتقد أن جوهر فن هذا القرن هو على وجه التحديد تحقيق اللامركزية. ازدواج اللامع تجاه الذات والموضوع، وإطار هذا هو العالم. النصب هو المركز. ليس فقط، في أغلب الأحيان، يتم تشييده في قلب المدن وفي وسط الساحات، ولكن أينما تم وضعه، فهو في حد ذاته مركزًا. دعونا نضيف أن النصب التذكاري يستجيب لفيزياء المركز: فهو لا يدور حوله في الفضاء العام فحسب، بل إنه يتمتع بقوة جذب، ولديه قوة جاذبية، وجمع، وضم، فهو مجموعة. أخيرًا، لديه أيضًا، إذا جاز لي القول، بنية بدنية مركزية: فهو طويل القامة وقوي ومستقيم (العمود الرأسي هو سمة طبيعية تقريبًا للنصب التذكاري). من الواضح أن النصب التذكاري الذي أتحدث عنه تم بناؤه قليلاً خارج المركز، تقريبًا في الضواحي، بجوار سوبر ماركت وقريب جدًا من مدخل المترو، في ألمانيا، في هاربورغ، إحدى ضواحي هامبورغ. لكن على الرغم من ذلك، فهي تقدم بنية أثرية حقيقية، وعمودًا قويًا يبلغ ارتفاعه 12 مترًا، مع مقطع مربع بطول متر واحد على جانب ومغطى بالكامل بالرصاص. هذا كل شيئ. إنه نصب تذكاري أرفع حدًا موجودًا، بدون أي ملحقات زخرفية، بدون حتى أي شيء مكتوب عليه؛ إنه نصب خام، النموذج الأساسي لأي نصب تذكاري. إذن هنا عمل يسمى "نصب هاربورغ التذكاري ضد الفاشية". أصفه هنا لأنه تم افتتاحه رسميًا في 10 أكتوبر 1986 بحضور المؤلفين، يوخن جيرز وإستير شاليف-جيرز - يتساءل المرء لماذا كان عليهما العمل معًا من أجل مثل هذا النصب التذكاري الموجز. أحدد التاريخ لأنه، منذ ذلك الحين، حدث تحول طفيف. في الواقع، ابتكر الفنانون خدعة صغيرة، تكاد تكون مزحة: إنها أن العمود يتفكك. وهذا يعني أنه تم تركيبه على آلية جعلته يغرق تدريجياً في الأرض. إذن، سنتمترًا بالسنتيمتر، بعد سبع سنوات، في 10 نوفمبر 1993، اختفى النصب تمامًا. لذلك، فهو مبدئيًا، جماليًا، بصريًا، شكلًا بعيدًا عن أي تمثيل، متمرد على أي تخيل. النصب التذكاري هنا يحرر نفسه من أي معنى بعدم تمثيله لشيء. إنها ليست مجرد فكرة مجردة: إن هندستها المعمارية تبقيها في إهمال شديد، فهي لا تمثل شيئًا ولا تقول شيئًا - حتى قياساتها لا تعني شيئًا: ارتفاع اثني عشر مترًا هو فقط متوسط ارتفاع المباني من الزاوية، ومترًا جانبًا، هو بعد مناسب. يعرض العمود المستقيم نوعًا من إخصاء المعنى. هذا هو النصب التذكاري لشيء. أو بالأحرى، في عام 1986، في البداية، تم اختصاره إلى اسمه. إنه رمز خالي من العيوب - سنرى أنه في الحقيقة معلق، في انتظار المعنى. بعد ذلك، بنى المؤلفون نصبًا تذكاريًا، لكنهم أدخلوا فيه عاملًا زمنيًا، فقد صمموا نوعًا من النصب التذكاري سريع الزوال، سريع الزوال بصريًا، والذي يتعارض مع فكرة النصب الذي يميل إلى الأبدية. أو الأفضل من ذلك، مع النصب، قاموا ببناء اختفائه. جاء العمود المخصي بالمعنى ليكشف عن إخصائه المرئي. وهو ما يتعارض هنا مرة أخرى مع المبدأ الضخم، وهو ليس فقط العمودي ولكن أيضًا العمودي القائم (خلال المناقشات في مجلس بلدية هامبورغ، قدمنا موافقتنا على مثل هذا النصب التذكاري، ولكن من خلال طلب ذلك من فضلك على العكس من ذلك)، أخرجه من الأرض، مثل الكراث). في الحقيقة، بنى الفنانون ثلاثة أشياء: عمود، خرابه واختفائه. مع هذه "الأقل" سينشأ "المزيد" من المعنى. وهذا يعني أن الرمز الفارغ من البداية سيتحول إلى سطح فارغ. وهذا من تسجيل العلامة. هذا لأن المؤلفين قد صمموا أن يضع المتفرجون اسمهم على العمود باستخدام قلم يتم توفيره لهم. يؤدي هذا إلى تشغيل آخر ميزة مادية للعمود، والتي يجب تغطيتها بالرصاص، والتي لا تعد شيئًا آخر هنا سوى معدن يمكن نقشه بسهولة. يقول غيرز إنه تولى الرصاص، وهو صفيحة بسمك سنتيمتر، بسبب قابليتها للاختراق: أثر في الرصاص يجعل أثرًا مرئيًا وملموسًا. طرس التدخلات هو المزيد من العنف الجسدي والبلاستيكي والعنف أيضًا. مع هذا المداخلة من المتفرجين، لدينا الآن كل العناصر التي ينهار منها النصب ويكشف عن نفسه في اختفائه. دعونا نصر على حقيقة أن الأمر لم يكن مجرد مسألة توقيع على العمود بقلم حبر، بل تتعلق بنقش اسمه بقلم. لذلك كان وضع توقيعه على النصب أمرين؛ لم يكن الأمر يتعلق فقط بترك أثره، بل كان لوضع بصمته، بصمة الذات، في اسمه، وبعد ذلك، كان من المفترض أن يتم اقتحام العمود في موضوعه، في سلامته، لعمل رسومات على الجدران حقًا تأثرت، ولا رجعة فيه. ومع ذلك، نُقِشت على العمود، تتابعات من الآثار شكلت تراكبات من الثقوب: التوقيع، ثم خدش التوقيع، ثم طلقات البندقية فوقه. في النهاية، من بين آلاف الأسماء التي تم نقشها، لم يبقَ أي منها على حاله: كلهم كانوا مخدوشين، دون استثناء، تم رسم الجرافيتي أنفسهم. والعمود الغارق الآن يتتبع كل شيء، الأسماء وتدميرها. لذلك، في وقت لاحق، يمكننا القول إن العمل الفارغ، العمل الضئيل في البداية كان أيضًا عملًا بدون مؤلف. من خلال نقش اسمه في العمل، أصبح كل شخص مؤلفًا مشاركًا للعمل. أصبح عمل البداية الصامت والمجهول عمل الأسماء ومحو الأسماء. اقترح جيرز مجموعة نصب تذكاري - عمل أصبح مستخدموه مؤلفين حقيقيين. في الواقع، لدينا هنا عمل يظهر مؤلفوه بعد وقت قصير من ولادة العمل، وهو عمل هو نفسه من يخلق مؤلفيه. ولكن فجأة، أيضًا، كلما زادت التوقيعات، كلما تدهورت القطعة. وهذا يعني أنه من خلال التوقيع عليه، أصبح المؤلف أيضًا مؤلفًا لتدمير النصب التذكاري. وتم العمل في هدمه. لكن التعقيد لم ينته عند هذا الحد. من خلال التوقيع على العمود، أصبح الناس أيضًا مؤلفي اختفاء العمل. هذا لأنه كان من المفترض أن يغرق العمود عندما تمتلئ الجوانب الأربعة عند سفح العمود بالتوقيعات؛ فكلما زاد عدد الأشخاص الذين وقعوا، سارعوا في اختفائه. من خلال نقش العمود، أصبح المتفرجون هم المؤلفون والسادة الحقيقيون للنصب التذكاري الذي دمروه وتسببوا في اختفائه. سادة النصب، كانوا حفاري القبور. لكن أسمائهم وآثارهم هي التي دفنت وأبدت. تأثير آخر للتوقيعات هو اختفاء العمود، في عام 1993 كان السطح المسطح عند مستوى الأرض. وهذا يعني، فجأة، طواعية أو بدون إدراك، يمكن للناس الآن السير عليها. بعيدًا عن فكرة المكان المقدس، فهذا يعني بالضبط، في الواقع، حيث كان العمود يقف، فإن الأشخاص هم الذين يأتون إلى مكان النصب التذكاري. أصبح المتفرجون، المؤلفون بالفعل وأساتذة النصب التذكاري، هم أنفسهم الآن، جسديًا، هو النصب التذكاري. كل ما تبقى من النصب الذي اختفى هو المتفرجون واقفون ويبحثون عن الشيء. وهكذا أصبح العمود قاعدة بسيطة، قاعدة المتفرجين الباحثين عن نصب تذكاري. إنها عملية انعكاس: حيث تم توجيه نظرة المتفرج نحو العمود، ولم يعد يراها، ويجد نفسه في المركز يدقق حوله بحثًا عن النصب المفقود ضد الفاشية. في هذه اللحظة، ظهر هو نفسه كنصب حي ضد الفاشية. يشكل هذا النصب الغارق تشويشًا للموضوع. كما يقول بومبي، في سيرتوريوس لكرنيليوس، أن روما لم تعد موجودة في روما، هنا لم يعد العمل في العمل، إنه حيث أنا؛ كل شيء في العارض. هذه سمة من سمات حداثة العمل ما بعد دوشامب. نحن في صميم الموضوع، لقد تمت المناورة بكل شيء هنا لإظهار أن النصب الحقيقي هو الموضوعات اليقظة. أحد آثار هذا النصب غير المرئي هو أنه يلزمنا، ولو للحظة، بفتح أعيننا. لأنه، كما هو مذكور في الدليل بجانب العمود، "لا شيء يمكن أن ينهض في مكاننا ضد الفاشية". ولا شيء يمكن أن نتذكره بالنسبة لنا أيضًا - وهذا بالضبط ما تفعله الآثار. هنا، على العكس من ذلك، يجبر الناس على النظر، وعلى وجه التحديد أولئك الذين ربما، في الماضي، نظروا بعيدًا. تأثير حقيقي آخر للنصب التذكاري هو أن اختفاء العمود يؤدي في المقابل إلى معنى أعتبره نقيًا، بمعنى مالارمي، سمة مادية ستكون في حد ذاتها الحقيقة، بعيدًا عن أي استعارة، علامة لا يمكن الاستدلال عليها؛ أو هذا النصب التذكاري ضد الفاشية، هذا العمود المتلاشي، في نوع من البوبوبيا الصامتة، يقول للسكان: "لم تروا أي شيء في ذلك الوقت، حسنًا، لن تروني أيضًا. يصبح إخفاء العمود باختصار التمثيل الدقيق والدقيق للعيون المغلقة للسكان الألمان أمام النازيين (أقول "السكان" وليس "الناس"، فضيحة عمل مؤخرًا لهانس هاك في البوندستاغ، في برلين، تبين مدى أهمية اختيار الكلمات). عيون مغلقة ممثلة بعمود غير مرئي، يجب أن نعترف بأن جيرز، بعيدًا عن المفاهيمي الذي نراه عمومًا، هو فنان واقعي. إذا كان الأمر يتعلق بتضخم النسيان، والصمت، والعمى، وتضخم غياب الذات، وجبن النظرات التي نحولها أو نخفضها؛ إذن، العمود الذي يغرق ويصبح غير مرئي هو نصب واقعي شديد، لأن هذا هو ما يظهره النصب المختفي، وفقًا لما سيكون قانون الانتقام الجمالي: العين بالعين - العمود غير المرئي للعين السفلية، اختفى النصب التذكاري واختفى الموضوع: نحن هناك بفن حقيقي. لا يزال هناك شيء واحد أخير: لقد قلت في البداية أن كل نصب يقوم بوظيفة التجميع وهي وظيفة الدال الرئيسي. يعمل نصب غيرز على ديناميت هذه الوظيفة للنصب التذكاري، ومن خلال جمع التوقيعات عليه، فإنه ينتج على العكس من ذلك تأثيرًا لتقسيم المجموعة وسحقها. هذا العمود ليس دعوة للتوحيد ورفع القوات ضد الفاشية: إنه في حد ذاته سلاح حاد، إنه نداء الأسماء. التواقيع هي وسيلة للتراجع عن إخفاء الهوية الجماعية التي تشكل الآثار (الآثار تشكل مجموعة، فإنها تؤدي مهمة التذكر وتجعلها مجهولة - الارتفاع، والحقيقة، كونها نصب تذكاري للجندي المجهول، اختراع فرنسي، ولكن أيضًا أجاز أول مذبحة جماعية كانت حرب عام 1914). في هذا، يعد نصب جيرز التذكاري مناهضًا للفاشية حيث يقول أحدهم أن مثل هذا الدواء مضاد للاكتئاب: إذا قرأ أحد ذلك على الملصق، فهذا لا يعني أن هذا المنتج يحتج على الاكتئاب، ولكن من المفترض أن يكون له خصائص حقيقية ضد الاكتئاب الشرير. حسنًا، يبدو لي أن نصب هاربورغ له فضائل حقيقية ضد الطاعون البني. لكن بمعنى أنه لا يعيق النازيين الجدد فحسب، بل يخلق أيضًا مشكلة للسكان بشكل عام، وهذا لسبب عميق: هذا النصب الغارق يمنع الناس من التواصل معًا، حتى من أجل السبب الجيد. إنه نصب يحرم عزاء الذكرى، التنفيس الاجتماعي؛ من خلال جعل نفسه غير مرئي، فإنه يمنعنا من إغلاق أعيننا معًا عن الماضي، ويمنعنا من إغلاق كتاب تاريخ النازية. كان القرن العشرين قرن الجماهير (نص فرويد، علم نفس الحشد، الذي تُرجم بشكل كارثي على أنه "علم النفس الجماعي"، هو نص أساسي من القرن العشرين). قرن من الحشود، يمكن للمرء أن يقول الكثير من القرن العشرين كما كان قرن الآثار. هذا هو سبب أهمية نصب جيرز، لأنه يعمل بشكل عكسي، فهو يمنع السكان الألمان من أن يصبحوا الشعب الألماني. إنه عمل مناهض للناس ومناهض للحشود. يمكن للمرء أن يسرد جميع الانعكاسات التي تجعل من نصب هاربورغ التذكاري ضد الفاشية الجانب الآخر من النصب التذكاري. ولكن في النهاية، ما يشار إليه هنا هو أنه في الفن بعد أوشفيتز، تم تحقيق التحول من الجماليات إلى الأخلاق. وأن جعل العمل على أنه المكافئ المطلق لفعل يتكون من إشراك المتفرجين فيما يرونه، في الواقع، إذا كان ذلك لا يضمن شيئًا، هو بلا شك ما يتطلب دعمًا وثيقًا لنقل ما لا نفضله. تذكر القرن العشرين، وهو حقيقة هذا القرن."
الهوامش والاحالات
[1] انظر مقالتي، "في المعتقدات الفوتوغرافية"، الزمنة الحديثة، رقم 613، 2001.
جيرارد واكمان، نشرت في مجلة المعارف والعيادة 2003/2 (رقم 3)، الصفحات 57 إلى 71
الرابط
https://www.cairn.info/revue-savoirs-et-cliniques-2003-2-page-57.htm
" سنبدأ من سؤال خالد وهو: هل المرئي له قلب؟ هل هناك مركز أساس المرئي؟ هل هناك حقيقة مرئية، سرية للصور؟ على السؤال المطروح على هذا النحو، كان هناك، كما نعلم، ردان هائلان. الأول هو أن المرئي ليس له قلب، وأنه ليس له حقيقة - هذه هي النسخة التي تقول إن سر المرئي هو أنه مجرد ظل، ومظهر خادع، ومضلّل، وعبث، ومستهجن. هذه النسخة الفلسفية التي، منذ أفلاطون، تدين الصورة سيكون لها مصير هائل في تاريخ الصور. لدينا رد هائل آخر، وهو الرد المسيحي. كان لها أيضًا مصير هائل في تاريخ الصور. يتم تقديمه في سلسلة التناقضات التي من خلالها، في أربعة مئة، يدرك القديس برناردين سيينا البشارة على أنها المكان الذي يأتي فيه الله إلى الإنسان، وهو غير قابل للنقاش في الشكل، وغير مرئي في الرؤية. في هذا الإصدار، الله هو اسم مؤسسة المرئي. يصبح غير المرئي أساس المرئي وحقيقة ومصيره. ومن هنا جاءت فكرة الشخص المرئي المأهول الذي يحركه الروح، وأن كل ما هو مرئي له معنى، وأن كل ما يُرى يمكن قوله. هناك كلمة أخيرة للمرئي. ومن هنا جاءت فكرة العصور الوسطى عن العالم كمعبد، وكتاب قابل للفك. من الآن فصاعدًا، كل صورة لها معنى، أي أنها تعني دائمًا شيئًا آخر غير ما تقوله وتعرضه الرسالة، التي تقول إن ما يخص الغرب هو "استيلاء الفكر المسيحي على العاطفة التي حولت مسألة التعبير عن الخطاب إلى وضعه في قلب الصورة. أصبح العاطفة هي القصة التي تروي كيف أصبحت الصورة غير المرئية مرئية، وكيف تم حفظ الصورة الساقطة، وكيف ساهمت تضحية الجسد في مجيء الجسد المفدي. "ولكن في البشارة، يكون دخول غير المرئي إلى المرئي هو مرتبطة بهذا التناقض الآخر وفقًا لبرناردين، وهو عبارة عن دخول الخلود إلى الزمن. من أجل التأكيد على أن حساب التجسد المسيحي ليس فقط هو حساب دخول إله غير مرئي وخالد إلى الرؤى وفي التاريخ، ولكن أيضًا أن التاريخ نفسه يأتي مع التاريخ ويدخله. الصورة "التي تعطي الجسد للكلمة". في هذا، تصبح القصة قصة وعد بالفداء، وفداء الصورة بالصورة، وأمل العودة إلى صورتنا المفقودة. هذا هو الإعلان بحسب القديس بولس: ستأتي الصورة وقت القيامة. ان السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو: ما الجديد في القرن العشرين؟ هل يوجد في القصة العظيمة للصور الملتقطة بين الأشباح والروح شيء جديد تحت السماء الحديثة؟ هل هناك طريق آخر بين الصورة الفارغة والصورة المأهولة؟ أفترض نعم. أن هناك شيئًا جديدًا في القرن العشرين تحت شمس المرئي، أن صورة جديدة قادمة أمام المشهد تهرب، والتي تتعارض كثيرًا مع فكرة الفراغ المرئي كما هو الحال مع فكرة ذات مغزى مرئية. يبدو أن المعنى يأتي لمعارضة الغياب. المرئي سيكون له الغياب كأساسه وحقيقته. لن نتعامل بعد الآن مع خادع مرئي، ولا مع ثقل مرئي مع غير المرئي، ولكن مع وجود مرئي يشدده الغياب، دعنا نقول: شيء غير موجود. لا ينبغي أن نتحدث بعد الآن عن غير المرئي، حتى الذي لا أساس له، ولكن ببساطة عما وراء أو أسفل المرئي والذي سيكون فقط سبب أو سبب المرئي. في الأسفل سيثبت هناك: أن هناك سببًا للظهور، ولم يعد هناك معنى. والقرن العشرين سيكشف هذا، ويمكننا أن نقول ذلك بمصطلحات تحليلية أكثر من خلال الدفاع عن هذه الفكرة اللاكانية القائلة بأن سر الصورة هو الإخصاء - فالصورة تأتي كالحجاب، وليس من شيء ما، بل نقص. ما يجب فهمه ليس أن الإخصاء ليس له صورة، بل أنه سيكون عكس الصورة - الإخصاء على عكس التجسد. لذلك كان لدينا نسخة من صورة فارغة، لا تغلف شيئًا، صورة خاطئة - هناك، كما قيل في ملفات العدد المجهول، "الحقيقة في مكان آخر". مع المسيحية، اخترعنا صورة حقيقية، يسكنها غير المرئي، وهذا شيء موجود. هناك غير المرئي والمرئي هو الوصول إليه. الحقيقة هي هذه المرة خلف الصورة، السر وراء الباب، كما نرى في مكان آخر في هذه الإعلانات الإيطالية حيث، ترك أنظارنا تتخطى الشخصيات الموجودة في المشهد، تصطدم بباب مغلق، يقع بالضبط بين الملاك والملاك. بِكر. بين الصورة الممتدة بلا شيء والصورة الممتدة من قبل شيء موجود، أعتقد أن القرن العشرين يواجه شيئًا آخر، ويوضح طريقًا ثالثًا، جديدًا ومتناقضًا، وهو الصورة، المرئي الذي يسكنه شيء ما غير موجود. الظاهر يشدد بنقص - صور كبيرة مع نقص. الصورة كنوع من الحمل العصبي؛ لكن هذا الشيء بدون صورة واضحة بغيابها هو ما يمكن أن نطلق عليه الشيء. أقول لنفسي أن هذا يمكن أن يسمح لنا بأخذ وجهات نظر من زوايا مختلفة حول تاريخ التمثيل. هناك، في الحداثة، فكرة التمثيل التي تجعل المرئي نفسه مرئيًا. إنه بمعنى ما ورد في صيغة بول كلي المعروفة: "الفن لا يعيد إنتاج ما هو مرئي، بل يجعله مرئيًا. هذه هي الطريقة التي نعيد بها إلى قلب التمثيل بُعدًا مرجعيًا ذاتيًا حيث يظهر المرئي نفسه على أنه مرئي، أي تمثيل تكمن كلمته النهائية في تسطيح مستوى التمثيل. في ترتيب المستجدات، يمكن أن نسميها الحداثة الأولى. لها تاريخ في تاريخ فن القرن العشرين.
لكن هل لدينا في التسطيح الكلمة النهائية للتمثيل؟ لذلك أقترح أن ينشأ سؤال آخر، عن التمثيل الممتد بفعل نقص في الرؤية، لن تكون الكلمة النهائية له هي غير المرئية، بل النقص. تمثيل ينفتح على جمالية سلبية. فن تأسس على وجود شيء مستحيل رؤيته. سيكون هذا حداثة أخرى. وهذه الحداثة تأتي في الفن، تنبثق من التاريخ. وتتيح الوصول، إنها مكان ما لا يمكن رؤيته ". بالطبع ، يمكن رفض "ما لا يمكن رؤيته" بطرق مختلفة: إظهار ما لم نرَه من قبل ، وما لن نراه أبدًا ، وما نراه دون معرفة أننا نراه ، وما لا يمكننا تحمل رؤيته ، وما لا يمكننا رؤيته هيكليًا الآن ، إذا قلنا أن سر الصورة هو الإخصاء ، وإذا سمح الفن بالوصول إلى هذا النقص ، فإن هذا يفتح اتجاهين من شأنه أن يحدد جانبين من تاريخ الفن: إما حجاب واحد ، أو عرض واحد ؛ إما أن نخفيها ، أو نخفيها (وهي طريقة لإتاحة الوصول من خلال تعيين باب السر) ، أو نعطي حق الوصول إلى النقص الذي لا يمكننا رؤيته من خلال إظهاره. قال ، يمكننا الحصول على فكرة كيف نخفي النقص. هذه، إذا صح التعبير، وظيفة ما نسميه الرسم الشراعي. بمعنى ما، سيكون هذا هو دور الجمال. لأن الجمال منظم مثل ولادة فينوس من قبل بوتيتشيلي. ولادة الجمال هي ما يخفي عنا حقيقة هذه الولادة، أي بالتحديد الإخصاء، الذي حدث هنا للأب، في القصة الأسطورية، الذي نتج عن صب أعضائه التناسلية في البحر رغوة بيضاء صغيرة أتت منها فينوس أفروديت. لا يوجد جمال لا يتم عرضه على خلفية من الرعب، ولا توجد صورة ليست ستارة تُسدل على نقص. لكن إذا رأينا كيف نختبئ، فإن السؤال يبدو أكثر حساسية لمعرفة كيف نظهر. يمكن توضيح ذلك من خلال ما يقوله لاكان في أخلاقيات التحليل النفسي بخصوص الشيء: "هذا الشيء، الذي تمثل جميع الأشكال التي أنشأها الإنسان في سجل التعالي، دائمًا بفراغ، وبالتحديد في هذا لا يمكنه يتم تمثيلها بشيء آخر، أو بالأحرى لا يمكن تمثيلها إلا بشيء آخر. "هنا لدينا جوهر مشكلة جادة في الفن: إذا كانت المشكلة ستمنحنا إمكانية الوصول إلى الشيء الذي لا يمكننا رؤيته، فهذا يعني أن إظهار الشيء سيؤدي دائمًا إلى نقل الشيء. وتجدر الإشارة إلى أن تصريح لاكان ، الذي يتتبع إحداثيات ما يجب أن يسمى منطق المرئي ، أقرب ما يمكن إلى ما يقوله فرويد في نصه الصغير لعام 1922 على رأس ميدوسا ، حول حقيقة أن الشكل جورجون مع كل ثعابينه على رأسه هو واحد ، إنها شخصية إخصاء الأم ، وهذا يعني بالضبط ليس فقط أن الشيء يتم تمثيله بشيء آخر ، ليس فقط أنه لا يمكن تمثيله بشيء آخر ، ولكن لا يزال ذلك يتم تمثيله دائمًا بنقيضه: النقص بالمضاعف أو ، كما يمكنني أن أقول في اللاتينية ، بواسطة النسخة، وفرة - الوفرة ، قرن الوفرة ، إنه في الحقيقة مجرد إظهار للفراغ الذي إنه ممتلئ ، وهو مصنوع منه. يمكن للمرء أن يقول أن النقص ممثل في النسخة، وأن النسخة هي وجه غياب صور تغمرنا: أي إخصاء للصورة، وما هو حقيقي بدون صورة يمكن أن تكون النسخة الحالية من الصور هي الوجه؟ مع هذا السؤال الفرعي: ألا يقود هذا "بشكل طبيعي" الفن اليوم إلى جانب فقدان الشهية، وأكل العدم في الصورة؟
في منطق المرئي هذا حيث وضع لاكان علاقة الفراغ بتمثيله، يمكننا تحديد موقع إحدى البيانات التي تبدو لي أساسية للتفكير في فن القرن العشرين ومعه: كل صورة هي تبديل. وهي في الأساس أطروحة جومبريتش العظيم: "الفن يتكون من صنع الصور، وصنع الصور هو خلق البدائل. "أطروحة إرنست جومبريتش هذه هي أيضًا، كما لو كانت مصادفة، أطروحة جان لوك جودار، حيث يعود باستمرار، في تاريخه (قصص) للسينما، مثل الشعار:" بدائل السينما. سنعود إلى هذا، ومن هنا، هذا السؤال: ماذا سيكون شكله بدون بدائل؟ نلاحظ أيضًا أن لاكان لا يفترض حقًا هذا لأن فراغ الشيء، كما يقول، "لا يمكن تمثيله إلا بشيء آخر". لكن، على وجه التحديد، يبدو أن السؤال الكامل للفن المعاصر موجود هناك: في قدرته على إتاحة الوصول إلى ما لا يمكننا رؤيته، بدون بدائل وبدون تبديل (لاستخدام مصطلح المنظرة الأمريكية العظيمة روزاليند كراوس). وهذا يعني بشكل متساوٍ بدون رمز وبدون تشابه وبدون صورة. تمثيل غير رمزي وغير وهمي، والذي من شأنه التحايل على بنية اللغة، وهو تمثيل يمكنني اعتباره حيًا. لكن مع ذلك، تفتح فكرة التمثيل بدون استبدال، في سجل المرئي والصور، نوعًا من سؤال مالارمي ، الذي يمكن أن يسأله مالارمي نفسه عن اللغة ، لغة من شأنها أن تمس مباشرة الواقع ، الذي سيكون ، كما يكتب ، "في حد ذاته ، ماديًا ، الحقيقة". نعرف إجابته: إنها آية، بما "يكافئ عيب اللغات" والتي من شأنها أن تمس الواقع مباشرة. الآية التي لا تحل محل، لا تنقل الآية على أنها كلمة نهاية للغات، والآية على أنها حقيقة. إنه أحد الأسئلة الجوهرية التي نشأت للفن، في عصر حداثته، عصر الحقيقة. ومع ذلك، ما يجب التأكيد عليه هو أن السؤال المطروح ليس فلسفيًا ولكنه فني بشكل مناسب لأنه لم يكن سؤالًا، في القرن العشرين، كما في عبارة سيزان، "قول الحقيقة"؛ ساد فن القرن العشرين الاهتمام بإظهار الحقيقة. الذي يفترض سماع استجواب حول طبيعة الحقيقة ذاتها من حيث ترتيبها، أو الحقيقة كما يقال، أو ما يظهر. لإظهار الحقيقة، وهذا يعني إظهار النقص. في هذا الطيف تتكشف الحداثة الأخرى لفن القرن العشرين، والتي يمكن بالتالي نسجها في طرق متغيرة بلا حدود لإظهار النقص "الذي لا يمكن رؤيته". يبدو لي أن هذا الرسم الرسمي للأسئلة مرتبط بمحتوى هذا ملموس وتاريخي. وهكذا يمكن تنظيم تاريخ الفن من انحراف "ما لا يمكن رؤيته"، بافتراض أن "ما لا يمكن رؤيته" قد غيّر اسمه. كما لو أن مختلف عصور الفن تتخللها العديد من المستحيلات. كان من الممكن أن يُطلق عليه اسم الله أو، كما هو الحال بالنسبة للبرتي، الريح أو العاصفة أو الصوت أو الروح البشرية - إنه يعطي فكرة مجال فني محدد على أساس المستحيل، والذي يتوقف عليه هدف، تصويب. سيتكون تاريخ الفن بأكمله من ردود الفن لإظهار ما لا يمكن رؤيته، ولإعطاء صورة لما هو خارج، أي فن الاستبدال، والتبديل، وبالتالي الحجاب. في هذا الصدد، ما يجعل الفاصل الحديث هو إظهار ما لا يمكن رؤيته، بدون صورة وبدون كلمة، ولكن بدون تبديل. سوف ننتقل من التمثيل، من النقل إلى العرض، وهذا يعني أن الفن اختزل إلى فعل. أعتقد أيضًا أنه يمكن تمييز المنطق في تاريخ فن القرن العشرين، وهو المنطق الخاص بالمرور من التمثيل إلى الفعل. يبدو أن فن نهاية القرن العشرين يقترب باستمرار، من خلال مسارات متعددة - الرسم وليس استبعاد - بعد الفعل. الفن كمرور خاطف، لكن دعنا نصل إلى هذا: يمكن للمرء أن يقول إن اسمًا من المستحيل رؤيته في القرن العشرين، مما يجعل القلب غائبًا عن الصور، سر المرئي، هذه هي غرف الغاز. سيكون هذا هو الاسم الأكثر ملاءمة للافتقار الذي ظهر للقرن العشرين. واقع نشأ في التاريخ، خارج الفن، ولكنه، بمجرد وجوده، من خلال حقيقة أنه قد حدث، يفرض نفسه على الفن كشيء لا يمكنه الابتعاد عنه، إلا بالتخلي عما يؤسسه ويوجهه، أو لمنح حق الوصول إلى ما لا يمكن رؤيته. وبمعنى ما، فإن جملة أدورنو حول استحالة الفن بعد أوشفيتز هي فقط الإجابة، المتسرعة جدًا، على ما يجعل الفن التشكيك حقيقيًا، والذي لا يستطيع الهروب منه. يمكنه فقط الرد أو الهروب. نتيجة لذلك، يمكن للمرء أن يجادل في أن فن ما بعد عام 1945 يتكون من جميع الاستجابات اللانهائية التي تم إحضارها إلى الواقع، لهذا الثقب المرئي من القرن العشرين، والذي يسمى غرف الغاز (التي ما زلنا ليس لدينا صورة حتى الآن، على الرغم من تحريفات جورج ديدي هوبرمان حول صور معرض مذكرات المعسكرات الذي أقيم في باريس1.
إن طريقة وضع قلب مسألة المرئي والصور في الحل النهائي هي ما يدافع عنه أيضًا، بمعنى واحد، بمعنى واحد فقط، من قال إن "السينما بدائل"، جان لوك غودار. إذا استدعيتها هنا، فلن أعطي مكانتها لفن القرن العشرين الذي كان السينما، ولكن لأن السينما بالتحديد هي فن القرن العشرين. كتب غودار فيه ما كان، كما أعتقد، تحدي الفنون في القرن العشرين. كانت السينما بلا شك، لأنها كانت فنًا ناشئًا، ما يمكن أن أسميه الفن الحساس. ومع ذلك، أريد أيضًا أن أبين في جودار، الذي لديه رؤية حادة لمخاطر الصور في القرن العشرين، إلى أي مدى لم يكن رده على وجه التحديد استجابة للفن الحديث. بالنسبة له، في الواقع، تاريخ السينما في القرن العشرين يجد حقيقته في اكتشاف معسكرات الموت. بمعنى آخر، سيكون هناك بعد أدورني لفن السينما في جودار، والذي يفترض أن السينما أصبحت "مستحيلة بعد أوشفيتز". لكن إذا قلت عن جودار إنه دعم أطروحات حقيقة الصور هذه "بمعنى واحد" فقط، فذلك لأنه بالنسبة له، إذا أصبحت السينما "مستحيلة" بعد أوشفيتز، فليس ذلك بسبب عدم إمكانية تصوير الرعب، من الناحية البنيوية. غير قابل للتمثيل: هو، على العكس من ذلك، لأنه لم يتم تصويره. لذلك، بمعنى ما دائمًا، وإذا أشرت إلى المقولات التي حددتها في البداية، إذا دافع جودار عن أن ما هو مرئي وصور القرن العشرين ممتدة من قبل معسكرات الموت، فهذا ليس موجودًا على الإطلاق في فكرة نقص البصر البنيوي، لكن حقيقة الصور هي خطيئة ضد الصورة. بالنسبة له، حقيقة المرئي ليست شيئًا غير موجود؛ حقيقة الصور هي الخطيئة، إنها خطأ عدم إظهار الصور. وهذا يعني أننا وجدنا أنفسنا، مع جودار، في فكرة أن كل شيء مرئي، وأن كل ما هو مرئي مرئيا، وأن كل ما هو مرئي مرئيا، وبالتالي فإن ما هو غير مرئي هو مجرد خطأ فيما يتعلق الصورة. حقيقة الصور هي جريمة تم ارتكابها ضد الصورة وتم ارتكابها من قبل أولئك الذين هم على وجه التحديد سادة الصور، وبالتالي سادة العالم (هوليوود أمريكا). في هذا الصدد، فإن الافتراض القائل بأنه سيكون هناك شيء غير قابل للتمثيل يشكل بالنسبة لغودار هجومًا على الصورة التعويضية. كتب جاك رانسيير في مجلة دفاتر السينما: "إذا لم تكن هناك صور للمخيمات، فإن فضيلة الصورة هي التي ستكون موضع تساؤل: فضل وجودها في كل مكان وإظهار كل شيء للجميع. هذه الفضيلة لا علاقة لها بطاعة الآلة على التكاثر. الصورة المعنية هنا شيء آخر غير التكاثر. إنها علامة الحقيقة، الوجه على حجاب فيرونيك، وجه الكلمة، ابن الله المخلص، بصمة النموذج الأولي". فضيلة السينما حسب جودار ليست فضيلة الكاميرا التي تقرر، إنها فضيلة الشاشة، حجاب ممتد حتى يطبع العالم عليه. لهذا السبب كان على السينما تصوير محتشد أوشفيتز." لكن السينما فشلت في المهمة التي فرضتها عليها صلاحياتها وهي تصوير رعب المخيمات. لكنها كانت تفتقر أيضًا، بالنسبة إلى جودار، إلى معرفة صلاحياتها: لم يكن قادرًا على التعرف على ما سبق أن أظهره في خياله: على سبيل المثال، في البحث عن الأرانب أو رقصة الموت في قواعد اللعبة أو في الغارات المعادية للسامية ومعسكر اعتقال الدكتاتور. إلا أنه لم يتوقع رينوار ولا شابلن ما سيحدث: لم يستطيعوا، ولم يستطع أحد. في الحقيقة، كل شيء يحدث لجودار كما لو كانت الصورة، من ناحية، واحدة من تلك الشخصيات من العهد القديم تعلن الجديد، وكأن تصوير المعسكرات بعد ذلك يمكن أن يكون وسيلة لإنقاذ ما تم التضحية بها في المخيمات. هناك رؤية لغرف الغاز مثل تلك الخاصة بالعاطفة، لفداء محتمل من خلال شغف الصورة الذي من شأنه أن يحفظ الصورة لا تسقط بل مقتولة. كانت الصورة بسبب القيامة. بهذا المعنى، عندما يقول جودار أن هناك بالتأكيد صورًا لغرف الغاز في مكان ما، فأنا لا أعتقد حقًا أنه يبحث عن دليل - حتى لو دخل في منطق الإثبات الكارثي - ولكن هذا يشهد على الإيمان المسيحي العادل، الذي يدعم الأيقونة، أن الخطيئة ضد الصورة يمكن تخليصها بالصورة وفيها. إذا كانت هناك عقدة مسيحية بين التاريخ والتمثيل، إذا كان صنع التاريخ هو التقاط صورة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما يحدث للتاريخ في مواجهة حقيقة خارج التمثيل، وهي حقيقة لا تؤرخ، لاستخدام البرتي المصطلح في لوحة، حقيقة لا ترسم صورة. وهذا يعطي مصلحتها لمشكلة تصوير المحرقة، لأنها تفترض أن وضع الصور هو تحويل المحرقة إلى التاريخ، أي جعلها إيجابية: يمكننا إخبارها ووصفها - نحن يمكن أن ترسم صورة لها. وبهذا المعنى، فإن صنع صورة قصة يعني أن نقول وداعًا لها، فهذا يعني التأكيد، كما أعتقد، كما أعتقد آلان فينكيلكراوت يقول سراً في كتابه صوت يأتي من الشاطئ الآخر: "نحن لسنا أكثر تميزًا بالمخيمات. فيما يتعلق بغرف الغاز، يؤكد كلود لانزمان أن أي تمثيل، أي صورة للجريمة هو بديل، وبالتالي تليين، وبالتالي خيانة، ونسيان أيضًا. في هذا، السؤال الذي يطرحه فيلم مثل فيلم بينيه، الحياة جميلة، ليس ما إذا كان بإمكاننا الضحك على كل شيء (سؤال غبي: أننا قرأنا رقصة جنكيز كوهن بواسطة رومان جاري!)، لكن إذا لم نكن كذلك. هناك، أمام فيلم، بإدخال المحرقة في الصورة، يدخلها في التاريخ، ولكن في تاريخ هو بالتالي تاريخ الشغف بالصورة. من هناك، أليس عمل صور المحرقة بالضرورة هو تنصير المحرقة؟ علاوة على ذلك، وبنفس المعنى، فإن إدخال المحرقة في الصور يؤدي إلى إدخال الحقيقة في لعبة الاستبدالات والتشابهات، والتي تفترض أن نتيجة أو شرط دخول المحرقة في الصور وفي التاريخ، هي أيضًا من الجيد أن أتطرق إلى ما هو تفرده، وما يوجد في هذه الحقيقة غير قابل للاختزال لأي شيء آخر. أيضًا، نرى عددًا معينًا من المصطلحات يتم وضعها في سلسلة مثل الصورة أو القصة أو الإيجابية أو حتى المعنى، بقدر ما يكون تكوين الصورة هو إعطاء معنى. ما الذي قد تعارضه سلسلة أخرى: ذاكرة معارضة للتاريخ، وموضوعات تعارض معرفة ماهية التاريخ، وسلبية معارضة لإضفاء الطابع التاريخي على الإيجابية، وموضوع معارض للصورة. السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو معرفة ما الذي ينقل ذاكرة ما لا ينتقل إلى صورة القصة، وما الذي يجعل هذه الحقيقة تتجاوز التمثيل للموضوعات، وما الذي يعطي الوجود للسلبية. الجواب: هذه هي الأعمال، وأود أن أضعها على هذا النحو: العمل، كشيء، هو بصمة الواقع. هذه الطريقة في أخذ الشيء أولاً تمثل نقطة. إن مفهوم البصمة هو ما يفسر أساسًا السؤال الأول: كيفية تمثيل شيء ما ونقله عن طريق التحايل على البنية الدالّة والصورة، بدون استعارة، وبدون رمز أو تشابه، بشكل مباشر. لن يكون الفن بديلاً عن العالم. لكننا نرى السؤال الذي يلوح في الأفق، لأن فكرة البصمة تفترض إيجابية أولية تترك بصماتها في أجوف وسلبية. عندما يتعلق الأمر بالهولوكوست، يصبح السؤال هو نقل السلبية دون نقلها. البصمة هي الجواب. ولكن بعد ذلك، كيف نجعل بصمة السلبية، وكيف تحل المشكلة، التي يقف أمامها لاكان، من الفراغ الذي لا يمكن تمثيله إلا بشيء آخر؟ بعد كل شيء، المشكلة ببساطة هي بصمة الثقب. كيف يمكن تضييق مسألة "تمثيل" المحرقة من عملين مثل " أوراق جميلة أنثوية" لدوشامب و" يلقي من الفضاء " تحت مقعدي لبروس نعمان، وهما عملين صغيرين لا شيء على الإطلاق وهما في الواقع، بدون خطاب، رد الفن على السؤال الذي يبدو أساسيًا لفن القرن العشرين. هذه الأعمال، في حد ذاتها، هي بصمة الغياب، والافتقار، والفتحة، أي أن عمليتها الخاصة تتكون من الافتقار إلى النقص أو الفراغ، فهي تصنع من الوجود السلبي. إن فكرة الإيجابيات للافتقار أو الغياب هي في صميم فكرة الشيء في التحليل النفسي، يبدو لي في قلب فن القرن العشرين. ما أريد أن أؤكد عليه هو أن مسألة ما لا يمكن تمثيله لا تستلزم بأي حال من الأحوال التفكير في نهاية التمثيل. إذا تحدثنا عن غرف الغاز غير القابلة للتمثيل والإبادة، فهذا يعني أنه لا توجد صورة، ولن تكون هناك قصة متروكة لها لأن الحقيقة تتجاوز كل ما يقال وكل شيء مرئي. ولكن إذا لم يحدث شيء في المحرقة باستثناء "رعب العدم" (لاكو لابارث)، فهذا لا يتبع فناء التمثيل، أي أن أي تمثيل، مهما كانت طريقة سماعه، سيكون عفا عليه الزمن. الغياب أو النقص أو الاختفاء - لاستخدام عنوان رواية بيريك، الذي لم تكن كل هذه الأسئلة بالنسبة له سوى أجنبية - لا تفلت من منطق التمثيل. يستعيد التمثيل معناه الأساسي: ليس استنساخًا، يخضع بحد ذاته لحدود "وجهة نظر"، بل إيماءة تجلب الحضور، عرضًا. ما يمكنني أن أضيفه هو أن الموضوع الذي أتحدث عنه، كإيجابية للنقص، هو الشيء ذاته الذي يعرِّفه التحليل النفسي كموضوع. كل هذا يحفز التفكير فيما هو مرئي وحقيقة الصور لأنه، كما يشير رانسيير في الخارج، بالنسبة إلى جودار، فإن الصورة مطبوع عليها الوجود. فيما نجده هنا فكرة أن الصورة يتم تضييقها بواسطة شيء ما. لكن التعامل مع الصورة على أنها بصمة الوجود، فكرة أن السينما هي "أيقونات الحضور" (رانسيير)، إذا كان هذا يتعارض مع الخيال الوهمي، فهو بالتالي من أعتبره كذلك. راهبة. وهذا يعني أن هناك طريقة أخرى، بمعنى ما، هي الطريقة الحديثة على هذا النحو، وبالتحديد ما يسميه رانسيير "الوهم المزعوم" والذي يتألف من "احتفال بشري بحت بحيلة "، وهي حيلة تظهر على أنها حيلة. ستكون فكرة مالارميان عن خيال غير مرتبط بالرمز والتشابه والتجسد، وبالتالي غير مقيد بهذا المعنى من كل التدين. يمكننا الاحتفاظ بالأحرف الأولى منه: فن في. سيكون فن القرن العشرين فنًا لم يعد يُظهر بصمة الوجود، بل بصمة الغياب، التي من شأنها أن تُظهر غياب ما وراء - وهو ليس هو نفسه الغياب من الخارج، فقط تسطيح الطائرة، ولكن الذي يعطي الغياب باعتباره الحقيقة الإيجابية وسبب التمثيل. من هناك، علاوة على ذلك، يمكن للمرء أن يؤكد أن فكرة الفن كفئة وحدوية وجدت تماسكها فقط من افتراض غير مرئي كان المرئي هو التجسد؛ الصور المرئية المتعددة باعتبارها تجسيدًا للحضور والحضور الفريد؛ إن هذا الوجود الفريد، وهذا المعنى الديني للمرئي وللصور هو الذي أعطى تماسكه، إن لم يكن تناسقه، لفكرة الفن الواحد، مما يسمح على سبيل المثال بالحديث عن الرسم. لكن، إذا كان فن القرن العشرين، كما أعتقد، فنًا، فإنه يعرض إلحادًا للصورة، يفترض مسبقًا تحطيم الوحدة، فإن هذا الفن يتدفق بالكامل إلى أعمال لا تساوي أكثر من واحد من خلال واحد، كل منها يظهر ما يمكن أن يظهره فقط، من خلال إظهار نفسه، ولا شيء آخر غير ذلك. هذا ما يجعلنا ننتقل، كما هو الحال مع لاكان، من سؤال فلسفي أو تاريخي من نوع "ما هي اللوحة؟ لهذا الآخر: "ما هي اللوحة؟" ". يرتبط الإلحاد في فن القرن العشرين بارتداد ارتداد الفن إلى العمل الفردي، إلى هذا الفهم شبه الأحادي للعمل حيث يحتوي كل عمل على كل الفن. أيضًا، عندما نقول الفن، فإن اسم الفن هو اسم واحد، وبالتالي من المفارقات أن مجموعة غير واحدة وغير محدودة وغير متجانسة، تتكون من تفردات والتي نسميها "أعمال"، أو بالأحرى هذا الهيكل من الإلحاد (لا يوجد تاريخ لمثل هذا الإلحاد)، يشكل التجريد لحظة أساسية في هذا الفن الواقعي. في هذا، لذلك، نحن في عكس رأي جان كلير الذي يقول: "إن ظهور التجريد [...] لم يكن له النتيجة الوحيدة المتمثلة في صنع العمل، ولم يكن ثقب الباب المميز مفتوحًا على العالم، بل كان غير شفاف وتتداخل الشاشة المسطحة بين النظرة والواقع، مما يكرس فقدان الإحساس بالمكان، أو قمع أو استرخاء النقاط المرجعية التي أمرت بقبضتنا على العالم، أي إفقار العقل. كل من يعتقد أن وورينجر كان أول صرخة إنذار في القرن (في التجريد والتعاطف، 1907)، لديه، في فكر ذي رؤية، يُرى تمامًا في صعود التجريد أعراض "القلق الروحي أمام الفضاء"، "رهاب الخلاء الروحي"، و"الشعور بالضيق في الحضارة" الذي كان سيبتلع القرن العشرين بأكمله، يعتقد هذا المرء هراء. وأيضًا، الشخص الذي يدين التجريد بنبرة الواعظ النبوي، والمذنب بـ "التعهد بالابتعاد عن المرئي"، يعبر عن تركيز جاف من الهراء. وليس من الظاهر أن التجريد قد تعهد بالابتعاد. هذا هو دين المعنى. ينجز الفن التجريدي انفصال الصورة والمعنى. يمكن للمرء أن يقول إن الفن التجريدي يقدم لنا الإخصاء مباشرة، في حقيقة أنه يتعلق بصور بدون معنى تمثيلي، ومع ازدراء وضع عناوين لها لا يمكن إلا أن تخفي هذه اللوحات تضعنا في اختبار إخصاء المعنى. من ذوي الخبرة في أن الفن التجريدي يجعل الأيقونات مستحيلة (فهو لا يمنع تطور أيقونات الفن التجريدي، بل هو مجرد هذيان، على عكس أيقونية ولادة الفن من جديد). حتى ذلك الحين، كان تاريخ الرسم هو تاريخ الكتل غير القابلة للتجزئة، تلك الوحدات الموحدة للصورة والمعنى تسمى اللوحات. ما يجعل حدث التجريد هو أنه استند إلى تدمير هذه الكتلة، على الفصل بين الصورة والمعنى. الذي يحمله من يرعد ضد التجريد يهدف في الحقيقة إلى شيء آخر غير "فقدان المعنى". من المكانية ". مرتبًا في المظهر تحت راية الدفاع عن الواقع، الشخص الذي رعد ضد فن مسؤول عن ضمور الحواس - الواقع، اللون، المكاني، المادة ... - يأسف لشيء آخر: تحت فقدان الحواس، فقدان الإحساس - ببساطة المعنى. إذا كان ما يميز الحداثة في الرسم هو الانفصال عن المعنى، فإن فقدان المعنى بالتحديد هو الذي يدين الرسم الحديث في عيون الشخص الذي يكتب: فقط لأنها كانت رمز الآلام. ومع ذلك، مع فان دونجن ، لم يعد الأمر أكثر من صبغة حمراء ، جُردت من ممتلكاتها لأنها ذات معنى أعطاه شكلاً. ومن يفكر الآن في الرغبة في رسم زهرة، كما فعل دورر أو توماسو دا مودينا في وقتهما، يمكنه فقط مواجهة شيء، جرد من الأساطير أو الحكايات أو المعتقدات أو الرموز، والذي لفت انتباهنا بالأمس وحماستنا، تقف في نوع من التعقيم الدلالي المطلق. ما هي النية التي يجب أن تُعطى لفعل التمثيل، إن لم يكن الأكثر بؤسًا؟ "
بؤس التمثيل: إنه عيب بلا معنى. اتهام بالعمل على تجفيف المعنى الذي كان سيبتلع القرن بأكمله. صحراء المعنى التي نكون قد فقدنا فيها أنفسنا. من يتحدث على ما يبدو عن الرسم، عن العالم وعن المرئي، لا يتحدث في الحقيقة عن الرسم ولا عن العالم ولا عن المرئي، بل عن شيء ما وراء الرسم، العالم والمرئي. ببساطة وراء. على عكس ما يطلقه اللامبالاة على التجريد من قبل الشخص الذي تظاهر بأنه وقفة يقظة للواقع، لم يكن حزنًا على فقدان العالم المرئي، بل فقدان هذه العوالم الأخرى. أعطنا اشارة. صور، لم يعد لديك روح؟ وهكذا، فإن لوحة هذا القرن متهمة بشكل ماكر ولكن جوهري بإخلاء عالمنا من السكان وتنظيم حظر على المعنى. الشخص الذي يدعي، أرسطو قليلاً، باختصارإأن المعنى، مثل الروح، يعطي الشكل، يأسف لفقدان الشكل في الرسم، وفقدان المعنى في هذا العالم. بعد أن فقد الإحساس بالمعنى والشعور بكل اعتقاد، كان الفن اليوم قد غرق في خراب الأشكال: مؤمن بشكل سيئ، ورسم بشكل سيء، كما يقول المثل. بالإضافة إلى كونه مؤلمًا، فإن هذا الفن لا يزال يسبب الخراب الروحي للمشاهدين: رسم سيء، سيئ الاعتقاد، قول مأثور آخر، معتبرين أن ما نراه دائمًا يعني شيئًا آخر غير ما نراه: إنه جوهر التدين. كان الفن الحديث في الاتجاه المعاكس: فهو فن كتابة وليس فن روح، فن أخذه حرفياً. يمكننا أن نقول عن فن القرن ما قاله رامبو: "إنه يعني ما يقوله حرفياً وبكل معنى. في الأساس، أود أن أقول إن فن القرن العشرين حقق نوعًا من الكشف الأسمى: فمن ناحية، حقق ما جعل الفن منافسًا للفلسفة لأفلاطون، أي الاعتراف به كمظهر؛ إن تسطيح اللوحة، بعيدًا عن كونه مقدمة لشاشة غير شفافة تقطع العالم، يميل إلى إظهار نفسه كمظهر يقول إنه مظهر. الفن الحديث، هناك، يتميز بالاهتمام بالحقيقة. لكنه فعل أكثر من ذلك. من خلال إظهار نفسه كمظهر، يُظهر الفن أن العالم، ما نسميه الواقع، هو مظهر. فقط، بدلاً من توليد فكرة أنه سيكون هناك شيء ما وراء المظاهر، فكرة دينية، يميل الفن إلى إظهار أن هناك مظاهر فقط، حقيقة فقط، أن هذه الحقيقة التي يأسف لها جان كلير لأننا كنا قد فقدنا الإحساس بها، إنه ليس سوى استعراض للظواهر، وبالتالي، بدلاً من صرفنا عنها، فإن الفن على العكس يعيدنا إلى قلب الواقع. سيكون من الضروري تصور أن الهوس بأحدث لوحة يمر عبر ونسج القرن العشرين بأكمله ليس هاجسًا بنهاية للفن، أو إغلاق زمني، أو تاريخ مكتمل، ولكنه كشف نهائي للجانب السفلي من المظاهر: اللوحة الأخيرة هي في الحقيقة اللوحة الموجودة أدناه. من حيث السُمك، في سمك المستوى، استخدام كلمة داميش، سمك مستوى التمثيل، في سُمك مستوى الصور، في المظاهر، يجب وضع "اللوحة الأخيرة". ". هذه هي طريقة فيلاسكيز لجبل الفن. طريق مينيناس. ولهذا السبب أيضًا - أعتقد - أن هناك شيئًا لا يمكن تجاوزه في الفن، وهو الرسم. لهذا السبب - أعتقد - لن ننتهي من الرسم. أنا لا أقول أن الرسم على هذا النحو، من الناحية الفنية، هو الفن الوحيد الممكن وأن كل شيء آخر سيتم رفضه، أعتقد أننا لن ننتهي أبدًا من الفن مع اللوحة، التي أظهرت لنا اللوحة بالتحديد بنية. كل فن يدور حول اللوحة. من اللوحة ما يظهر هيكل المرئي. تمامًا حول: في الأمام، الفوق، من الداخل، من الخلف. في الأساس، عندما نقول إن اللوحة ستصبح شيئًا في القرن العشرين، فإننا نقول بالضبط: هذا هو الشيء الذي ندور حوله. في الواقع، في القرن العشرين، رجعنا إلى فكرة ألبرتيين بأن اللوحة عبارة عن نافذة. لكن بدلاً من أن يكون هذا وهمًا، أخذ فن القرن العشرين الأمر على محمل الجد. يمكننا أن نعتبر فن القرن العشرين فنًا شهد مسارين محتملين، مسارين حدّدهما مفهوم الرسم ذاته. يمكن للمرء أن يعتبر شاهداً على هذا الفصل وهذا التعبير عن المسارين عملاً لروثكو. خذ هذه الفكرة القائلة بأن اللوحات، في سلسلة 1958 من مبنى سيجرام ، تشبه الستائر المتساقطة. نرى أن سطح اللوحة لا يفي بحافة اللوحة. ما نراه هو نافذة مغلقة، مسرح سقط عليه الستارة. إذن، أحد أمرين: إما أن نصنع مسرحنا أمام الستارة، وأن نرسم الستائر، أي نظهر أن كل شيء مرسوم على السطح هو ستارة تُعترف بأنها ستارة؛ أو نظهر ما هو تحت، خلف الستارة، وهذا هو طريق الواقعية في الفن. لكننا ندرك على الفور أن الأمر لا يتعلق بمعارضة المسارين باعتبار أن أحدهما جيد والآخر سيئ، أحدهما صحيح والآخر خاطئ، لأنهما يمثلان جانبًا من الحقيقة: الرسم كما يفعل روثكو ، هو إظهار المظهر. الذي يقول إنه مظهر؛ في هذا، هذه اللوحة هي لوحة الحقيقة، فهي تهدف إلى الواقع. إما أن نعرض ما هو تحت الستارة، ثم نعرض الأشياء، أو نقوم بفن الأرض، أو نلمس الجسد في العروض، نتدخل في العالم على العالم. لكن هل الظهور وراء ستار روثكو يلبي أخيرًا طلب جان كلير الذي يأسف لفقدان الواقع في الفن؟ مُطْلَقاً! لأن إظهار الجانب السفلي من المظاهر، والتوقف عن تحجبها، وعدم نقلها، سيظهر دائمًا، بشكل أو بآخر، أنه لا يوجد شيء خلف المظاهر. لا شيء سوى رغبة الإنسان في أن يكون هناك شيء ما، رغبة إنسانية صحيحة تنبع من مجرد حقيقة أن هناك ستائر وكويز. ما تظهره مينيناس، بخلاف مشكلة الملك والملكة، هما شيئان أو ثلاثة أشياء: إنها لوحة مقلوبة وهي طريقة فيلاس أو روث (فيلاس "حجاب" بالإسبانية): يقر بأنه سطح شاشة تعترف بأنها شاشة. ثم يظهر أيضًا ما هو أمام اللوحة، والمشاهد الذي تم القبض عليه في الجهاز، والمشاهد الذي شاهده اللوحة. الشيء الثالث الذي يظهره هو الشخصية الموجودة في الخلفية، الشخصية الأبعد في خلفية اللوحة، الفيلاسكويز الآخر الذي يبدو أنه يغادر والذي، بالصدفة، هو الشخص الذي يقع على ذراعه نقطة تلاشي اللوحة. اللوحة - وهي بالتالي مركز البناء. وهذه الذراع بالتحديد ماذا تفعل؟ يسحب ستارة أو يدفعها للخلف. لا يعد فيلاسكيز الآخر مسارًا بالإضافة إلى المسارين الآخرين، فهو الذي يوضح أن هناك مسارين، مسار الطائرة وهذا، على وجه التحديد، للخلفية، لما وراءه. الطائرة التي تُظهر أنها طائرة وأن الخلفية تظهر أنه لا يوجد شيء خلف الطائرة (في هذا، أعتقد أنه لكونها لوحة ميتافيزيقية، فإن مينيناس بواسطة فيلاسكيز هي لوحة ملحدة). لكن ما أريد التأكيد عليه هو أن المسارين، وهما ما أسميه الحداثتين، ليسا متعارضين لأنهما في جانب الحقيقة: إظهار مظهر يقول إنه مظهر ويظهر أنه لا يوجد شيء وراء المظهر. الطريقة الوحيدة المستبعدة تمامًا من الفن الحديث هي بالتحديد تلك الخاصة بفن المعنى، والذي يعني دائمًا شيئًا آخر: فن المظاهر الذي من شأنه أن يقود المرء إلى الاعتقاد بأن هناك شيئًا وراء المظاهر، أن القرنفل لا يعني زهرة ولكن معنى يتجاوزها، العاطفة. ما تستبعده الحداثة هو الوهم بمعنى الوهم الذي لا يقول إنه وهم. لأنك لا يمكن أن تكون مخطئا. لا أدعي أن الفن الحديث كان سيُبطل الوهم على هذا النحو، باسم حقيقة بلا حجاب في النهاية. هذا هراء ديني: لأنه لا حقيقة وراء الحجاب، الحقيقة الوحيدة هي أن هناك حجابًا، وخلف الحجاب لا يوجد شيء يمكن رؤيته. أعتقد أنك ترى كيف يمكن للاعتذار القديم لـ زيوكس وباراسيوس أن يكون نقطة الحقيقة في فن القرن العشرين. إلا أن الاعتذار يدل على أن وراء الحجاب لا شيء - إلا الرغبة في رؤية ما وراء الحجاب. تأخذ الحداثة الاعتذار بشكل أساسي، لكنها تظهر من ناحية أن الحجاب وهم، وأن الحجاب يخفي أنه لا يوجد شيء. وهذا يعني أن فن القرن العشرين يظهر الحقيقة المخفية في اعتذار زوكسيس وباراسيوس. وفجأة، تحذر مما هو وراءك، والفن المرئي والمرئي هو حجاب يحجب هذا الشيء الذي لا يمكن رؤيته، وفي الوقت نفسه، له فضيلة الإشارة إلى أنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته خلفه. يمكن لـ روثكو أن يمارس الإيمان بالصورة المسطحة التي "تكشف الحقيقة"، وفي سلسلة مبنى سيجرام، هذه لوحات قماشية لها ظهر وعمق والتي، كما يشير إيف ديبلسينير، تعلن تحت الستار الساقط: الانتباه، هنا، الحد الأخير، هو الجدول الأخير بمعنى الذي تحدثت عنه من قبل؛ الشاشة الأخيرة قبل أي شيء، وهذا يعني أيضًا الحد الأخير قبل الرعب. لا يمكنني قبول أن روثكو ترك الشخصية بعد الحرب في عام 1948 مقابل لا شيء - وبالتالي، في نظري، بدلاً من ترك الواقع، على العكس من ذلك يغرق فيه. روثكو، وهو يهودي، هو بوتيتشيلي وفقًا للمعسكرات: من خلال رسم الحجاب، يرفع الحجاب عند ولادة الجمال بعد الرعب مباشرة وقبله مباشرة. ينجز روثكو بأكبر قدر ممكن مشروع فنه لإتاحة الوصول إلى ما لا يمكن رؤيته، ويقترب قدر الإمكان من الحقيقة، إلى الحقيقة التي لا يمكن رؤيتها. بهذا المعنى، فإن لوحة روثكو هي الشكل الأكثر دقة لرسومات تاريخ القرن العشرين. إن اختراع الحداثة الأخرى ليس التسطيح، بل العمق، ولكن ليس العمق الخادع، أي عمق الطائرة، عمق بلا وهم. إلى جانب ذلك، أود أن أقول إن فن القرن العشرين هو فن بلا وهم أو خيبة أمل. بصرف النظر عن القليل من القصاصات والأشخاص المهملين، لم يكن هناك فنانين أيديولوجيين عظماء في القرن العشرين، بينما، حتى ذلك الحين، كان الرسم مكانًا رائعًا لنشر الكاثوليكية. في القرن العشرين، لا يمكن القول إن الفن كان عامل أيديولوجيات عظيمة. ربما كان مكان الخلاف والنقد. أعتقد أن تسطيح الخطة هو السبب. لا يمكن خلق الاعتقاد على مستوى مسطح. لن يكون فن القرن العشرين مكانًا للنضال أو التنديد بل مكانًا لخيبة الأمل أو فن خيبة الأمل، فن المرئي حيث ستلتقي الرؤية بخيبة الأمل. آمل أن نفهم بشكل أفضل يمكنني أن أقول فيه ذلك فن القرن العشرين، حتى لو لم يكن معنيا به، حتى لو جاء قبل الحقائق التاريخية، مشغولا أو مشغولا دون أن تريده المحرقة. باختصار، المحرقة هي الاسم الذي يمكن أن نطلقه على ما يكمن وراء كل ما هو مرئي، على وجه التحديد لأنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته. ستة ملايين شخص بدون صور وستة ملايين اسم وستة ملايين شخص مكفوفين لأنهم لم يروا شيئًا. هناك فجوة واضحة في قلب القرن العشرين، حيث لم يتوقف النازيون أبدًا عن إخفاء جريمتهم عن الجميع، حتى الضحايا، بل محوها عن أعين الجميع، لإزالة كل آثارها. إنه اسم المستحيل، نقص الرؤية في القرن العشرين ... سيكون هناك، في فن القرن العشرين، حداثتان مجتمعتان، فن التخطيط وفن الظهر - خطة. يمكننا تصنيف هاتين الطريقتين، طريقة الخطة وخلفية اسمين من الفنانين. يمكنني الجمع بين هذين المسارين من خلال معارضة الحداثتين في عمل دانيال بورين من عام 1978، لوحة الأشكال، وفي نصب تذكاري لجوشن غيرز مؤرخ في عام 1986. يوضح بورين أن المظهر ليس سوى تصنيف طبقات، سماكة للطائرات. إنه أذكى في هذا من فونتانا، الذي يقسم لوحاته كما لو كان ليصدق أنه وراء، أخيرًا، هناك حياة حقيقية، الشيء الحقيقي. أما بالنسبة لجيرتس، فإنه يذهب إلى الجانب الآخر من الطائرة، من النافذة، إلى الجانب الآخر من المظاهر، على الجانب الآخر من مستوى الصورة. وما يجده في الجانب الآخر شيئان: لا شيء يمكن رؤيته، ثم ما يشغل مكان هذا العدم الذي يراه، وهو نظرة المتفرج. نحن ندرك أن الأمرين متداخلين تمامًا. في لوحة فيلاسكيز، الثانية فيلاسكيز في الخلفية (المرفقة بخدمة الملك، لم يكن مرتبطًا بعائلة دييغو)، الشكل الأسود في زاوية الباب الخلفي، فيلاسكيز الأخرى هي المتفرج الذي يغادر ويغادر بسبب لقد رأى كل شيء، وهذا يعني أنه رأى أنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته (مما يجعله جيدًا بما يكفي لتمثيل المحلل والمرور من باب محلله بعد جلسته الأخيرة). غيرز ليس مؤيدًا للفن بدون عمل، فهو يظهر فقط أن العمل بأكمله في نظر المتفرج. إنه ليس فنًا بدون عمل على الإطلاق، إنه فن يكون عمله نظرة المتفرج. جيرز هو فيلاسكيز في الخلفية، ولهذا السبب أعتبره فنانًا رائدًا (هذا ما سأسميه اللامركزية للفن أو فن التحول، كما سنرى لاحقًا). من الضروري إلقاء نظرة جيدة. بشكل عام، لا يبدو المرء على ما يرام. لا نرى شيئاً فنقول: غياب العمل. مُطْلَقاً! الأمر هو أننا لا ننظر إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه: لا نرى أن العمل الحقيقي، نحن من نبحث: أين يوجد العمل بحق الجحيم؟
جيرز هو النمط الذي، في فيلم لاس مينيناس لفيلاسكويز، يُظهر المشاهد أمام اللوحة الذي ينظر: اللعنة عليها، ولكن أين اللوحة؟ في هذا، غيرز هو فيلاسكيز في القلب، فيلاسكيز الأخرى. أعمال غيرز هي أجهزة لإخراج المشاهد كعمل، باعتباره العمل الفني الوحيد. لكنه ليس تلاعبًا (وهو ما كان سيحدث إذا كان الأمر يتعلق بمحاصرة المتفرج وإضحاك الفنان وأصدقائه، كما في الكاميرا الخفية)، بل على العكس من ذلك جهاز لإظهار المتفرج أنه موجود. قلب العمل، أن نظره هو العمل، إنه جهاز يظهر فيه المتفرج لنفسه على أنه قلب العمل. في هذا، أود أن أقول إن غيرز ينجز ويؤتي ثمار فكرة دوشامب: "المشاهد هو الذي يصنع الصورة. هذه المرة، المشاهد هو الشيء المركزي، الشيء الذي نحدق فيه في الصورة الكبيرة للعالم. نحن نتعامل هنا مع فن تصويري يمتد إلى أبعاد العالم، وحيث تكون الذات، والمتفرج، ونظرته التي تدخل كعمل في اللوحة. هذا هو بالضبط ما كتبه غيرز بجوار نصبه التذكاري لمناهضة الفاشية في هاربورغ، وهو ما يعنيه من الناحية السياسية، أي هذه الجملة: "لأنه لا يمكن لأحد أن يقف في مكاننا ضد الفاشية"، وهي الجملة التي تظهر بجانب عمود ضخم، بدلاً من الوقوف، وغرق ببطء واختفى تحت الأرض منذ عام 1992. أود أن أقول إن جوهر هذا العمل يتألف من فعل اللامركزية. ومع ذلك، أعتقد أن جوهر فن هذا القرن هو على وجه التحديد تحقيق اللامركزية. ازدواج اللامع تجاه الذات والموضوع، وإطار هذا هو العالم. النصب هو المركز. ليس فقط، في أغلب الأحيان، يتم تشييده في قلب المدن وفي وسط الساحات، ولكن أينما تم وضعه، فهو في حد ذاته مركزًا. دعونا نضيف أن النصب التذكاري يستجيب لفيزياء المركز: فهو لا يدور حوله في الفضاء العام فحسب، بل إنه يتمتع بقوة جذب، ولديه قوة جاذبية، وجمع، وضم، فهو مجموعة. أخيرًا، لديه أيضًا، إذا جاز لي القول، بنية بدنية مركزية: فهو طويل القامة وقوي ومستقيم (العمود الرأسي هو سمة طبيعية تقريبًا للنصب التذكاري). من الواضح أن النصب التذكاري الذي أتحدث عنه تم بناؤه قليلاً خارج المركز، تقريبًا في الضواحي، بجوار سوبر ماركت وقريب جدًا من مدخل المترو، في ألمانيا، في هاربورغ، إحدى ضواحي هامبورغ. لكن على الرغم من ذلك، فهي تقدم بنية أثرية حقيقية، وعمودًا قويًا يبلغ ارتفاعه 12 مترًا، مع مقطع مربع بطول متر واحد على جانب ومغطى بالكامل بالرصاص. هذا كل شيئ. إنه نصب تذكاري أرفع حدًا موجودًا، بدون أي ملحقات زخرفية، بدون حتى أي شيء مكتوب عليه؛ إنه نصب خام، النموذج الأساسي لأي نصب تذكاري. إذن هنا عمل يسمى "نصب هاربورغ التذكاري ضد الفاشية". أصفه هنا لأنه تم افتتاحه رسميًا في 10 أكتوبر 1986 بحضور المؤلفين، يوخن جيرز وإستير شاليف-جيرز - يتساءل المرء لماذا كان عليهما العمل معًا من أجل مثل هذا النصب التذكاري الموجز. أحدد التاريخ لأنه، منذ ذلك الحين، حدث تحول طفيف. في الواقع، ابتكر الفنانون خدعة صغيرة، تكاد تكون مزحة: إنها أن العمود يتفكك. وهذا يعني أنه تم تركيبه على آلية جعلته يغرق تدريجياً في الأرض. إذن، سنتمترًا بالسنتيمتر، بعد سبع سنوات، في 10 نوفمبر 1993، اختفى النصب تمامًا. لذلك، فهو مبدئيًا، جماليًا، بصريًا، شكلًا بعيدًا عن أي تمثيل، متمرد على أي تخيل. النصب التذكاري هنا يحرر نفسه من أي معنى بعدم تمثيله لشيء. إنها ليست مجرد فكرة مجردة: إن هندستها المعمارية تبقيها في إهمال شديد، فهي لا تمثل شيئًا ولا تقول شيئًا - حتى قياساتها لا تعني شيئًا: ارتفاع اثني عشر مترًا هو فقط متوسط ارتفاع المباني من الزاوية، ومترًا جانبًا، هو بعد مناسب. يعرض العمود المستقيم نوعًا من إخصاء المعنى. هذا هو النصب التذكاري لشيء. أو بالأحرى، في عام 1986، في البداية، تم اختصاره إلى اسمه. إنه رمز خالي من العيوب - سنرى أنه في الحقيقة معلق، في انتظار المعنى. بعد ذلك، بنى المؤلفون نصبًا تذكاريًا، لكنهم أدخلوا فيه عاملًا زمنيًا، فقد صمموا نوعًا من النصب التذكاري سريع الزوال، سريع الزوال بصريًا، والذي يتعارض مع فكرة النصب الذي يميل إلى الأبدية. أو الأفضل من ذلك، مع النصب، قاموا ببناء اختفائه. جاء العمود المخصي بالمعنى ليكشف عن إخصائه المرئي. وهو ما يتعارض هنا مرة أخرى مع المبدأ الضخم، وهو ليس فقط العمودي ولكن أيضًا العمودي القائم (خلال المناقشات في مجلس بلدية هامبورغ، قدمنا موافقتنا على مثل هذا النصب التذكاري، ولكن من خلال طلب ذلك من فضلك على العكس من ذلك)، أخرجه من الأرض، مثل الكراث). في الحقيقة، بنى الفنانون ثلاثة أشياء: عمود، خرابه واختفائه. مع هذه "الأقل" سينشأ "المزيد" من المعنى. وهذا يعني أن الرمز الفارغ من البداية سيتحول إلى سطح فارغ. وهذا من تسجيل العلامة. هذا لأن المؤلفين قد صمموا أن يضع المتفرجون اسمهم على العمود باستخدام قلم يتم توفيره لهم. يؤدي هذا إلى تشغيل آخر ميزة مادية للعمود، والتي يجب تغطيتها بالرصاص، والتي لا تعد شيئًا آخر هنا سوى معدن يمكن نقشه بسهولة. يقول غيرز إنه تولى الرصاص، وهو صفيحة بسمك سنتيمتر، بسبب قابليتها للاختراق: أثر في الرصاص يجعل أثرًا مرئيًا وملموسًا. طرس التدخلات هو المزيد من العنف الجسدي والبلاستيكي والعنف أيضًا. مع هذا المداخلة من المتفرجين، لدينا الآن كل العناصر التي ينهار منها النصب ويكشف عن نفسه في اختفائه. دعونا نصر على حقيقة أن الأمر لم يكن مجرد مسألة توقيع على العمود بقلم حبر، بل تتعلق بنقش اسمه بقلم. لذلك كان وضع توقيعه على النصب أمرين؛ لم يكن الأمر يتعلق فقط بترك أثره، بل كان لوضع بصمته، بصمة الذات، في اسمه، وبعد ذلك، كان من المفترض أن يتم اقتحام العمود في موضوعه، في سلامته، لعمل رسومات على الجدران حقًا تأثرت، ولا رجعة فيه. ومع ذلك، نُقِشت على العمود، تتابعات من الآثار شكلت تراكبات من الثقوب: التوقيع، ثم خدش التوقيع، ثم طلقات البندقية فوقه. في النهاية، من بين آلاف الأسماء التي تم نقشها، لم يبقَ أي منها على حاله: كلهم كانوا مخدوشين، دون استثناء، تم رسم الجرافيتي أنفسهم. والعمود الغارق الآن يتتبع كل شيء، الأسماء وتدميرها. لذلك، في وقت لاحق، يمكننا القول إن العمل الفارغ، العمل الضئيل في البداية كان أيضًا عملًا بدون مؤلف. من خلال نقش اسمه في العمل، أصبح كل شخص مؤلفًا مشاركًا للعمل. أصبح عمل البداية الصامت والمجهول عمل الأسماء ومحو الأسماء. اقترح جيرز مجموعة نصب تذكاري - عمل أصبح مستخدموه مؤلفين حقيقيين. في الواقع، لدينا هنا عمل يظهر مؤلفوه بعد وقت قصير من ولادة العمل، وهو عمل هو نفسه من يخلق مؤلفيه. ولكن فجأة، أيضًا، كلما زادت التوقيعات، كلما تدهورت القطعة. وهذا يعني أنه من خلال التوقيع عليه، أصبح المؤلف أيضًا مؤلفًا لتدمير النصب التذكاري. وتم العمل في هدمه. لكن التعقيد لم ينته عند هذا الحد. من خلال التوقيع على العمود، أصبح الناس أيضًا مؤلفي اختفاء العمل. هذا لأنه كان من المفترض أن يغرق العمود عندما تمتلئ الجوانب الأربعة عند سفح العمود بالتوقيعات؛ فكلما زاد عدد الأشخاص الذين وقعوا، سارعوا في اختفائه. من خلال نقش العمود، أصبح المتفرجون هم المؤلفون والسادة الحقيقيون للنصب التذكاري الذي دمروه وتسببوا في اختفائه. سادة النصب، كانوا حفاري القبور. لكن أسمائهم وآثارهم هي التي دفنت وأبدت. تأثير آخر للتوقيعات هو اختفاء العمود، في عام 1993 كان السطح المسطح عند مستوى الأرض. وهذا يعني، فجأة، طواعية أو بدون إدراك، يمكن للناس الآن السير عليها. بعيدًا عن فكرة المكان المقدس، فهذا يعني بالضبط، في الواقع، حيث كان العمود يقف، فإن الأشخاص هم الذين يأتون إلى مكان النصب التذكاري. أصبح المتفرجون، المؤلفون بالفعل وأساتذة النصب التذكاري، هم أنفسهم الآن، جسديًا، هو النصب التذكاري. كل ما تبقى من النصب الذي اختفى هو المتفرجون واقفون ويبحثون عن الشيء. وهكذا أصبح العمود قاعدة بسيطة، قاعدة المتفرجين الباحثين عن نصب تذكاري. إنها عملية انعكاس: حيث تم توجيه نظرة المتفرج نحو العمود، ولم يعد يراها، ويجد نفسه في المركز يدقق حوله بحثًا عن النصب المفقود ضد الفاشية. في هذه اللحظة، ظهر هو نفسه كنصب حي ضد الفاشية. يشكل هذا النصب الغارق تشويشًا للموضوع. كما يقول بومبي، في سيرتوريوس لكرنيليوس، أن روما لم تعد موجودة في روما، هنا لم يعد العمل في العمل، إنه حيث أنا؛ كل شيء في العارض. هذه سمة من سمات حداثة العمل ما بعد دوشامب. نحن في صميم الموضوع، لقد تمت المناورة بكل شيء هنا لإظهار أن النصب الحقيقي هو الموضوعات اليقظة. أحد آثار هذا النصب غير المرئي هو أنه يلزمنا، ولو للحظة، بفتح أعيننا. لأنه، كما هو مذكور في الدليل بجانب العمود، "لا شيء يمكن أن ينهض في مكاننا ضد الفاشية". ولا شيء يمكن أن نتذكره بالنسبة لنا أيضًا - وهذا بالضبط ما تفعله الآثار. هنا، على العكس من ذلك، يجبر الناس على النظر، وعلى وجه التحديد أولئك الذين ربما، في الماضي، نظروا بعيدًا. تأثير حقيقي آخر للنصب التذكاري هو أن اختفاء العمود يؤدي في المقابل إلى معنى أعتبره نقيًا، بمعنى مالارمي، سمة مادية ستكون في حد ذاتها الحقيقة، بعيدًا عن أي استعارة، علامة لا يمكن الاستدلال عليها؛ أو هذا النصب التذكاري ضد الفاشية، هذا العمود المتلاشي، في نوع من البوبوبيا الصامتة، يقول للسكان: "لم تروا أي شيء في ذلك الوقت، حسنًا، لن تروني أيضًا. يصبح إخفاء العمود باختصار التمثيل الدقيق والدقيق للعيون المغلقة للسكان الألمان أمام النازيين (أقول "السكان" وليس "الناس"، فضيحة عمل مؤخرًا لهانس هاك في البوندستاغ، في برلين، تبين مدى أهمية اختيار الكلمات). عيون مغلقة ممثلة بعمود غير مرئي، يجب أن نعترف بأن جيرز، بعيدًا عن المفاهيمي الذي نراه عمومًا، هو فنان واقعي. إذا كان الأمر يتعلق بتضخم النسيان، والصمت، والعمى، وتضخم غياب الذات، وجبن النظرات التي نحولها أو نخفضها؛ إذن، العمود الذي يغرق ويصبح غير مرئي هو نصب واقعي شديد، لأن هذا هو ما يظهره النصب المختفي، وفقًا لما سيكون قانون الانتقام الجمالي: العين بالعين - العمود غير المرئي للعين السفلية، اختفى النصب التذكاري واختفى الموضوع: نحن هناك بفن حقيقي. لا يزال هناك شيء واحد أخير: لقد قلت في البداية أن كل نصب يقوم بوظيفة التجميع وهي وظيفة الدال الرئيسي. يعمل نصب غيرز على ديناميت هذه الوظيفة للنصب التذكاري، ومن خلال جمع التوقيعات عليه، فإنه ينتج على العكس من ذلك تأثيرًا لتقسيم المجموعة وسحقها. هذا العمود ليس دعوة للتوحيد ورفع القوات ضد الفاشية: إنه في حد ذاته سلاح حاد، إنه نداء الأسماء. التواقيع هي وسيلة للتراجع عن إخفاء الهوية الجماعية التي تشكل الآثار (الآثار تشكل مجموعة، فإنها تؤدي مهمة التذكر وتجعلها مجهولة - الارتفاع، والحقيقة، كونها نصب تذكاري للجندي المجهول، اختراع فرنسي، ولكن أيضًا أجاز أول مذبحة جماعية كانت حرب عام 1914). في هذا، يعد نصب جيرز التذكاري مناهضًا للفاشية حيث يقول أحدهم أن مثل هذا الدواء مضاد للاكتئاب: إذا قرأ أحد ذلك على الملصق، فهذا لا يعني أن هذا المنتج يحتج على الاكتئاب، ولكن من المفترض أن يكون له خصائص حقيقية ضد الاكتئاب الشرير. حسنًا، يبدو لي أن نصب هاربورغ له فضائل حقيقية ضد الطاعون البني. لكن بمعنى أنه لا يعيق النازيين الجدد فحسب، بل يخلق أيضًا مشكلة للسكان بشكل عام، وهذا لسبب عميق: هذا النصب الغارق يمنع الناس من التواصل معًا، حتى من أجل السبب الجيد. إنه نصب يحرم عزاء الذكرى، التنفيس الاجتماعي؛ من خلال جعل نفسه غير مرئي، فإنه يمنعنا من إغلاق أعيننا معًا عن الماضي، ويمنعنا من إغلاق كتاب تاريخ النازية. كان القرن العشرين قرن الجماهير (نص فرويد، علم نفس الحشد، الذي تُرجم بشكل كارثي على أنه "علم النفس الجماعي"، هو نص أساسي من القرن العشرين). قرن من الحشود، يمكن للمرء أن يقول الكثير من القرن العشرين كما كان قرن الآثار. هذا هو سبب أهمية نصب جيرز، لأنه يعمل بشكل عكسي، فهو يمنع السكان الألمان من أن يصبحوا الشعب الألماني. إنه عمل مناهض للناس ومناهض للحشود. يمكن للمرء أن يسرد جميع الانعكاسات التي تجعل من نصب هاربورغ التذكاري ضد الفاشية الجانب الآخر من النصب التذكاري. ولكن في النهاية، ما يشار إليه هنا هو أنه في الفن بعد أوشفيتز، تم تحقيق التحول من الجماليات إلى الأخلاق. وأن جعل العمل على أنه المكافئ المطلق لفعل يتكون من إشراك المتفرجين فيما يرونه، في الواقع، إذا كان ذلك لا يضمن شيئًا، هو بلا شك ما يتطلب دعمًا وثيقًا لنقل ما لا نفضله. تذكر القرن العشرين، وهو حقيقة هذا القرن."
الهوامش والاحالات
[1] انظر مقالتي، "في المعتقدات الفوتوغرافية"، الزمنة الحديثة، رقم 613، 2001.
جيرارد واكمان، نشرت في مجلة المعارف والعيادة 2003/2 (رقم 3)، الصفحات 57 إلى 71
الرابط
https://www.cairn.info/revue-savoirs-et-cliniques-2003-2-page-57.htm