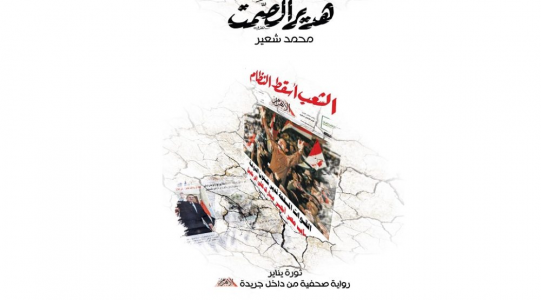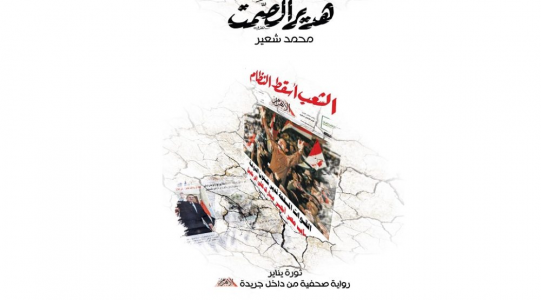لم يتخلف الإبداع منذ اللحظات الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير، عن مواكبة الأحداث. فانهمرت القصائد، واليوميات التي تسجل الحدث، حتى الرواية، لم تتخلف عن مسايرة الركب المنطلق، رغم ما تحتاجه من فترة تأمل ودراسة الأوضاع. غير أن السمة العامة لكل ذلك، كان الأمل، وكانت الفرحة، لكل المراحل العمرية، حتى أولئك الذين أُطلق عليهم “حزب الكنبة”، كان وجدانهم ومشاعرهم تعيش مع الشباب الذين لم يخشوا، وأصروا على المواجهة.
ومن بين تلك الأعمال التي راقبت وترقبت، ما يحدث يحدوها الأمل، تلك الرؤية الصحفية من داخل جريدة الأهرام العريقة والحاملة لذلك العنوان المكثف والمعبر، والمشحون بكل تلك المعاني، والمقتحم لجوهر ما يحدث “هدير الصمت”، ذلك العنوان الذى تخيره الكاتب الصحفى محمد شعير، والذى ينهيه بذلك الأمل الذى ولدته تلك الثورة { ورغم كل ما يجرى.. فقد ضحكنا جميعا.. ضحكنا بشدة.. لم نكن سعداء بالطبع.. لكننا أيضا لم نكن حزانى تماما، وقد كنا ندرك أننا تغيرنا.. لم نعد كما كنا.. لم نعد نحن.. ولن نعود}[1]. وهى النهاية التي يمكن منها أن ننطلق لقراءة عمله الروائى الأول “الخطة 51”[2]، بعد أن هدأ الشارع، وسكنت الأصوات.. وكمنت النفوس، ولم يعد أمامها إلا تأمل تلك الرحلة التي صاحبها الأمل. ورافقها الرجاء، فكان حتما تدارس التبعات، وما أدت إليه.. كيف كنا، وإلام صرنا. لنتبين أن كل تلك المراحل، كان انعكاسها نفسيا بالدرجة الأولى. فكان أول نجاحات الكاتب، أن اعتمدت الرواية على التأثير النفسى، والذى اتضح من غلبة منولوج السارد، وأن الأحداث، وما يجرى على السطح، ما هو إلا تعبير عما يعتمل داخل نفس السارد، ورؤيته، وهو ما يعتبر ثانى نجاحاته، فى التأكيد على اختلاف الرؤى، وأنه لا يملك وحده الحقيقة، وإنما كل هذا، مصبوغ برؤيته هو، وهو ما لا يمنع من وجود وجهات أخرى. وهو الانعكاس الضمنى الذى يعكس ما قُوبلت به ثورة يناير، عبر مراحلها العديدة، من تباين وجهات النظر.
اختار الكاتب –كصيغة شكلية- شكل مباراة كرة القدم.. كلعبة شعبية.. يتفاعل فيها اللاعبون، من الطرفين.. والحكام. والجمهور. وهو ما يتناسب مع شكل الموضوع المتناول، ثورة يناير، والتى يمكن تحديدها بوضوح، رغم أن الكاتب لم يُشر إليها مباشرة بطول الرواية، لكنه منحنا – كقراء- تلك الإشارات الذكية التي تدعونا لربط الأحداث والوقائع.
اول هذه الإشارات، بعد أن أصيب الابن “مالك” وهو الاسم الدال على ملكية القرار، وملكية القيادة، لا فى الثورة وحدها. وقد كان حلم هذا الابن، وحلم أبيه أيضا أن يصبح لاعبا مشهورا. غير أنه أصيب فى مباراة كان يلعب فيها ضمن فريق الأشبال ممثلا لحى المعادى، إصابة كان الخوف من تفاقمها، وتأثيرها على مستقبله، وكان ذلك الساعة 11 مساء يوم 11 فبراير. ذلك التاريخ الذى انحفر فى الذاكرة بالتهليل والفرح لإعلان مبارك ترك الحكم. فكان تهليل الأب وابنه، وفرحهما، لا بنتيجة الأشعة التي منحتهم الطمأنينة والأمل –فى الظاهر- وفى –الباطن- الفرح والتهليل بتلك اللحظة الفارقة التي أحدثت موجات التهليل بطول البلاد وعرضها، وذلك من خلال ترديد أغنية مدحت صالح: “الحلم دا حلمنا.. والحب من حقنا.. مين اللى يمنع طير إنه يطير فى السما؟””. ولتصبح تلك هى “ضربة البداية”. على أن “مالك” ليس فقط هو المستقبل، وهو ممثل الشباب الذين تقدموا الثورة، ومشعلى جذوتها. وإنما كان هو ابن الماضى، فالأب والجد وجد الأب.. كانوا جميعا مولعين بالمباريات، ويحرصون على حضورها بالملاعب. لينفتح الملعب بإتساع الوطن بجرافيته، وبتاريخه، إلا انه فى كل تلك المراحل كانوا من الجمهور.. ليأتى مالك، ويسعى لأن يكون لاعبا.. أى مؤثرا، وليس مجرد متفرج. وهى الأحلام التي داعبت، ليس الابن فقط، وإنما الجيل السابق له.
وإذا كان الكاتب قد اتخذ مجال الكرة – للتعبير الشكلى- حيث وفق كثيرا فى استخدام التعبيرات والاصطلاحات الكورية كعناوين للفصول، متقنا اختيار الأحدث للتمثيل، وترجمة المصطلح، فإنه يقودنا إلى أنه – أيضا- اتخذ من الشكل مضمونا، تجلى فى الجانب التقنى. حيث تم تقسيم ذات السارد إلى طرفين متقابلين- وكأنهما فريقين متقابلين-.. العقل والنفس. {يلعب عقلى مع نفسى مباراة خاصة، مباراة غير ودية، يحاول العقل أن يهزم النفس وآلامها، عبر إقناعها بأن كل شئ على ما يرام…. ولكن يواصل العقل هجماته المنتظمة، بينما تتواصل فى المقابل الهجمات المرتدة السريعة للنفس وآلامها…. وتستمر المباراة هكذا، سجالا بين الفريقين: العقل والنفس لتنتهى دائما بنتيجة (صفر/ صفر)ص12.
وقسم شخصيات الرواية إلى طرفين متقابلين- أيضا- فأحد الطرفين اعتمد على العقل، والآخر اعتمد على النفس، فتباينت الرؤى بينهما، وهو ما يعكس اختلاف الرؤية حول القضية الأساسية.. ثورة يناير. وكان الاختلاف الأكبر والظاهر فى تلك القضية هو عامل العمر- وفق ما كانت عليه (الجماهير) فى تلك الفترة. وهو ما قسم الكاتب شخصياته على نفس الأساس، فكانت هناك مجموعتان : السارد أكرم، وصديقته نورا.. الأكبر فى السن، أو الجيل الأسبق، وينتميان للعقل والحكمة فى موازنة الأمور، حيث أمسكت –هذه المجموعة- العصا من المتنصف. وهو ما يختلف عن الشباب الثائر الغاضب دون مواربة.
يقول أكرم لابنه الذى يزحف نحو القبول كلاعب فى أحد الأندية، وهو أمل الأب والابن معا (وسط كل أوجاعى، أصبحت تتقدم بى.. تقودنى على درب تحقيق حلمك.. وحلمى.. لعلى أشهد أى حلم لى يكتمل فى عمرى}ص184. كما يضاف إلى هذا الجيل صديق الأب، ريئس تحرير البرامج الإذاعية “أحمد سمك”.
والقسم الثانى الأصغر فى السن، أو مجموعة الشباب ويمثله.. الأخ الأصغر للسارد سيف، القريب من سن الإبن مالك. والذى اشترك لأول مرة فى ثورة يناير. والإبن مالك، والصحفية شيرين. حيث تحول الأخ سيف إلى الانعزالية وهجر السياسة، بعد طول ما عاناه من إحباطات فى الماضى، ويأس فى الحاضر مما يراه فى كتابات أخيه (الاعب فى المنتصف)، ونورا التي يعلم علاقتها بالجزب. فلم يحضر حفل افتتاح معرض “نورا” وأيضا لم يحضر حفل توقيع كتاب أخيه. فيحدثه السارد، كاشفا عن شخصيته {اعلم يا أخى أنك منشغل.. أنك بعيد.. وطالما كنت دوما بعيد.. لا عن أخيك فقط.. إنما عن الدنيا كلها.. عن البشر والبلد……. أنا أخبرك.. أنت ترى أن معرض نورا ليس سوى نفاق للحزب.. ولعلك ترانى أيضا فى كتاباتى منافقا.. لماذا؟ فقط لأن موضوع المعرض هو المعركة.. مع أنها معركة الوطن بأكمله.. لا معركة حزب أو سلطة أو مؤسسة…… لكنك ترى أن كل ما يجرى حولك باطل.. زائف.. ساقط.. لماذا؟ أنا أخبرك.. إنها الهّبْة المباركة التي لم تعد ترى غيرها، هبَّة الشباب التي شاركتَ فيها ولم تنجح….. هل المطلوب أن نظل نهجم ونهدم؟! }ص80. ثم يضيف السارد لتوضيح وتقريب الرؤية { سيف لم تكن له علاقة بالسياسة قبل تلك الهبة الوحيدة التي شاركَ فيها منذ سنوات دون غيرها من مثيلاتها}ص80. ويدور النقاش بين الأخين.. لنتبين منه مدى ما وصل إليه “سيف” من إحباط أدى به إلى الانغماس فى العمل وفقط، والانصراف عن كل ما يتعلق بالحزب.
ويتواصل الحوار، لنتبين أبعاد شخصية كل من الأخين، فيواصل السارد/ أكرم {الخطة البديلة.. أقصد إن عدم النجاح فى طريق معين مش معناه أبدا إن البديل يبقى خروج الجمهور من الملعب فى نُص المباراة.. ليه كل واحد ما يحاولش بنفسه إنه يحقق النجاح من خلال شغله وإبداعه؟ وتبقى دى معركته حتى لو كان المفروض زى ما بتقول يبقى فيه معارك تانية كثيرة……يا سيف أنت أخويا وحبيبى.. ونفسى لو أقدر انتزع بإيدى كل ذرة إحباط من جواك} ص82. إذن فالمواءمة هى شخصية السارد، والإحباط هو شخصية أخيه.
ويدور الحديث بين السارد وابنه “مالك” حول ادعاء اللاعب العرقلة فى منطقة الجزاء، وأن المدرب هو من يطلب منه ذلك، ليكشف عن رؤية هذا الجيل للأجيال السابقة، وأنهم ليسوا إلا نبت ما سبق زرعه من فساد، ولما عاب الأب عليه ذلك رد عليه {عن أى قيم تحدثنى؟! هذه أخلاقكم ردت إليكم، هذا نظامكم الذى أورثتمونا إياه وقد ورثناه.. هذا ما جنته علينا أجيالكم ولم نجن على أحد}ص134. ولحرص الكاتب على ألا يفارق القول طبيعة شخصية الابن، وسنه.. يكشف أن ذلك ما توارد لذهنه هو {لعلى أنا من قررت أن أفهم هذا دون أن يقوله}. ثم ينفتح المشهد، لنتعرف على نفس الفساد – تقريبا- فى ملعب الصحافة، الذى يعيشه السارد، والعمل بمجاله.
والصحفية شيرين.. التي تعانى وتضطر للعمل بما لا يتوافق وشخصيتها وطموحها. ففي حوار بين السارد وبينها، تبدى له رأيها فى كتابه، فتقول: {صدقنى يا أكرم، المسألة دلوقت ما بقتش انحيازات وأيديولوجيات وأفكار معلبة زى ما بتقول. المسألة إن الصورة ضبابية فى كل حاجة.. ولما بنحاول نفهم ونسأل كإعلام يعنى ما حدش بيقول حاجة.. ويمكن كمان السؤال نفسه يتحسب عليك.. كأن مش مسموح لأى مخلوق إنه يفكر حتى مجرد تفكير علشان يفهم.. إنت فى المجال وعارف..}ص87.
كما تُكمل فى جانب آخر، لتكشف عن تلك المعاناة التي يعانيها الشباب المتحمس، والساعى لتغيير النمط، وبما يكشف عن كيفية تسيير الأمور، حيث يحدثها السارد عما اتبعه فى كتابه “طريق الأشواك” { توازن إيه بس يا اكرم؟! إنت هتجننى؟!.. ده مكتب الأمن هو اللى اتصل يبلغنى إنى حاقدم وأدير الجلسة الافتتاحية فى مؤتمر الحزب الجاى عن الإعلام!.. وزارة الأمن اللى بتبلغنى مش وزارة الفنون بتاعتنا ولا الحزب.. حاتجنن!}ص88. و ويكمل السارد توضيح الصورة الكاريكاتورية التي يريد الحزب، ويريد المسؤلون أن يكون عليه الإعلام، فيصف حركتها المعبرة عن كلماتها { فراحت تلهو مقلدة صور تماثيل قدماء المصريين رافعة كفيها مفتوحتين بمحاذاة كتفيها، وهى تميل برأسها يمينا ويسارا وتقول “أنا حلوة أهو.. أنا كويسة أهو.. أنا مع وزارة الأمن.. ومع الحزب.. ومع وزارة الفنون.. والجنون}ص89. ويسألها أكرم: وإنت هتعملى إيه يا هانم؟ حتقدمى المؤتمر؟ {ردت سريعا “طبعا يا باشا ثم انقلب كل هذا إلى تنهيدة حملت مع زفيرها الساخن عبارة أخيرة.. هنعمل إيه بس؟! أهو شغل وخلاص}.
وتمضى رحلة الثورة، على ارض الواقع، متقلبة بين الأمل، واليأس، بما يعكسه الكاتب من أحداث –داخل الملعب، وفى العنوان الموفق “هجمة مرتدة” وكأنه بداية الشك، والخوف تدب فى النفوس. فنرى تلك التفرقة بين البشر، وكأن ثورة لم تقم. فحين عودة “مالك” إلى الملاعب بعد الشفاء. وفى مباراة “خارج الديار” كان مقررا أن يلعب فريق “مركز شباب المعادى”، وفريق نادى “هليوبولس” { هذه هى المرة الأولى التي أدخل فيها ملعبا – لمشاهدة مباراة لمالك- يكون فيه مدرجات للجمهور بالمعنى الحقيقى. المدرجات والإنشاءات و”التراك” حول الملعب، والجماهير بما ترتديه من “براندات” وما تضعه من “برفانات” كلها علامات دالة على عراقة النادى الكبير، الذى يضم بين أعضائه عددا من قيادات وكوادر الحزب. وعلامات دالة أيضا على حجم الضغط على الفريق الضيف، فريقنا}ص41. وهو ما يستدعى التساؤل الاستنكارى للإبن حين سأل أباه {هو الحزب فين؟ قلت سريعا” فى العاصمة..ليه؟” رد قائلا يااااه يعنى مش فى مصر الجديدة؟}ص163. وكأن الكاتب يرمى إلى ما هو أبعد.
وإذا كانت ثورة يناير، قد قامت بالأساس احتجاجا على تصرفات الشرطة، فى يوم عيدهم، الذى يمثل بطولات للشرطة في عهد وصف بالعهد البائد، فحين أحرز مالك الهدف الأول، وتسبب فى ضربة جزاء.. وفى المدرجات جلس رجل عالى الصوت شوشر على مشجعى مركزشباب المعادى، وبعد المباراة وبابتسامة ود قال : على فكرة.. عمركم ما كنتم حتغلبونى””…. وعاد ليفسر: “قصدى فى الصوت يعنى.. أنا ضابط”…. ضحكنا جميعا}ص45.
واثناء عودة الأب مصطحبا ابنه من أحد التدريبات.. أدار الأب مؤشر الراديو {تحولتُ إلى قائمة القنوات الفضائية، وفجأة تسمر الريموت كنترول فى يدى. خاصة بعد أن اتضح أن الأغنية تمجد إنجازات الحزب. عنئذ وجدت مالك يسألنى بشكل مباغت : إيه ده؟! همَّ عارفين الكلام ده؟ بيعجبهم يعنى؟.. وأضاف مفسرا” الحزب يعنى”}ص28.
كما يظهر “الكارت الأحمر” فى إيقاف المذيعة اللامعة شيرين عن العمل {حيث أن شيرين نوهت فى البرنامج عن خبر نشره موقع إليكتروني أجنبى حول صدور قرار رسمى فى دولة الأرجنتين بإيقاف بعض شركات تسمين الأبقار هناك – أعلنت أسماؤها- لاكتشاف استخدام أعلاف غير صحية أو آمنة، وقالت على الهواء أنه من المعروف أننا نستورد اللحوم من الأرجنتين، لذا فمن الضرورى أن يتأكد المسؤولون عندنا من أن التعاملات التي تمت لم تكن مع إحدى الشركات المخالفة..}ص106. وهو الموقف الذى تعرضت معه للتحقيق، ثم الإيقاف.
وفى حوار بين السارد وشيرين، تقول {ما أسهل أن تقول كل ما تراه بأعلى صوت، لكنه يظل حبيس غرفتك المظلمة. يتردد صداع فى أرجائها.، حتى يملأها ويملأك، وإن خرج صوتك إلى النور بشكل أو بآخر فلن يترك أثرا إلا لدى من هم معك، فى ذات فريقك، فيقتنع بك من هم أصلا مقتنعون، ويبتعد عنك-أكثر- من هم مبتعدون}ص105. حيث تكشف كلمة (أكثر) مدى التباعد، والانقسام بين طرفى المعادلة، والذى، بالعل، كان قائما.
ثم يعلو منولوج السارد { مشهد حصول شيرين الحداد على “الكارت الأحمر وخروجها أمامى مطرودة من الملعب، جاء مصحوبا – فى عقلى ونفسى- بهدف فى مرماى أنا. إذ وضعتنى أمام ذاتى بالواجهة. يقول الناس عنى إننى ألعب- فى كتاباتى- بإسلوب “دفاعى”، ولا يشغلنى هذا. فأنا لا أكتب إلا ما يُرضى ضميرى، لكننى الآن لم يعد يرضينى كل هذا القدر من “إغلاق المساحات” لذا لابد من إعادة توجيه الاعبين، لابد من الهجوم.. ولكن كيف؟ تلك هى المسألة!.. إيه يا عم أكرم ؟! ما أنت عارف.. عارف ؟! هل حقا أنا أعرف؟! هل أرى ؟! هل أسمع؟.. ومع ذلك لا أتكلم؟ هل أنا مجرد “رقاص”؟!}ص109.
ثم تأتى الدعوة إلى الهجوم من جديد، عندما اقتحمت جماعة اللحى الطويلة والجلاليب القصيرة الحكم فى البلاد، وللتعبير عن أحد مراحل التقلبات التي انتابت المرحلة، لتعبر عنها الرواية، باستخدام اللاعب رقم 51 {لم اشاهد ابنى عصبيا مثلما كان ذلك اليوم، كان يحاول أن يطارد حلما بدا منذ الدقائق الأولى أنه صار سرابا، يلتحم بقوة فى الكرات المشتركة، يحاول اقتناص أى شئ دون جدوى، إلا فى مرة واحدة راوغ فيها وحشا ضاريا بدت لحيته الكثة وحدها خير معبر عن فجيعة “التسنين فى الكورة لدينا}ص202. ويحصل مالك الشرقاوى على كارت أحمر.. ليعلق الأب {وها هو يخرج من الملعب مطرودا.. مصابا.. خاسرا.. ذليلا.. عدنا إلى حيث بدأنا.. لم نتقدم خطوة.. لم يتغير شئ}ص203. حيث يشير الاستدلال على إستئثار تلك الطائفة بكل شئ، دون باقى أفراد اللاعبين، والجمهور.
ثم تأتى السيول فى العشر دقائق الأخيرة من المبارة. فبعد أن كان قد أُعلن عن إنشاء مجموعة قنوات إعلامية، تتضمن قناة إخبارية تحت اسم “الحقيقة”، يديرها خالد الأنصارى- كواجهة لمن خلفه من أقطاب الحزب-.، طُلب لتقديم برنامج فيها الفناة التشكيلية “نورا” وورئيس التحرير الإذاعى “أحمد سمك”، وأسندت مسئولية تجهيز رسومات الاستديوهات، والتصاميم الهندسية للمهندس المعمارى “سيف”. تحمس الجميع حتى كادوا يتفرغون للعمل الجديد. وقبيل إفتتاح التشغيل الفعلى لقناة “الحقيقة”.. غابت الحقيقة.. حيث تم إلغاء المشروع، لينهار الجميع ويصيبهم بالإحباط التام، فتتفرق بهم السبل.. كل فى طريق.، فقد إختفت شيرين عن الأنظار، وأصبحت عودتها شبه مستحيلة. وسافر سيف للعمل بدبى وهجر مكتبه الهندسى، حتى أنه طلب من أخيه بيع شقته الخاصة به فى البيت الذى ورثوه عن أبيهم.. دخول أحمد سمك المصحة فى حالة بائسة ” وهو يرى كل أحلامه تذوب، تتبخر، تتلاشى”… ثم فوجئ الجميع بظهوره يعمل فى قناة الحرية، وهى إحدى القنوات المعادية تبث من لندن. واختلف السارد خلافا حادا مع “نورا” حبه الأكبر، بعد ما تصوره عن إشتراك نورا فى المؤامرات، والوصولية.{أأنتى تفعلين بى هذا يا “نوريتى”؟ّ توهميننى بالنقاء والصدق بينما تدبرين أمرك بليل مع الحزب؟ تتركيننى وتذهبين لغيرى لأجل المصلحة والشهرة فحسب؟!}ص189.
وليصرح السارد فى النهاية { ما أعرفه أننا صرنا كخيوط العنكبوت، يحركونها كما يشاءون بأيديهم. فتمتد ذات صباح لتبنى بيتا من أمل، اسمه قناة “الحقيقة” ثم تنهار بليل فجأة بكل سهولة، وتعود لتقيم عماد قصر من الأحلام لمالك فى الكورة}ص196.
ثم يأتى تحرك اللاعب الأصلى فى الملاعب، اللاعب رقم 51 “مالك أكرم الشرقاوى”. حيث يغادر الملاعب المحلية، ويسافر إلى ألمانيا للعب فى أحد الأندية درجة ثانية. إلى جانب إعتزال كل من السارد، ونورا، العمل، والتفرغ لحياتهما الويعة بالأسكندرية، لينعما بالهدوء، والابتعاد عن ملاعب السياسة، التي لم يعد لهم –جميعا- دور فيها.
غير أن الكاتب لم يشأ أن تكون رؤيته بهذا التجرد الحياتى الواقعى الجاف، ولكنه طعم شخصة السارد بالعديد من المواقف الرومانسية، بالحب المشتعل، بينه ونورا، ليمر ذلك الحب، كما الحب دائما، بما يعكر الصفو، من إختلاف الرؤى أحيانا، والغيرة أخرى.. لكنها، تنتهى بالزواج بينهما، بعد المصارحة والعتاب والعفو، وكأن الكاتب يقفل دائرة التساؤل فى البداية، حين أشار إلى وقوعه فى الحيرة بين العقل والنفس، ليصل السارد فى النهاية إلى مرحلة التوافق:
{عندما أنهت نورا كلماتها قمت إليها.. ضممتها إلى صدرى.. قبلتها وقبلتنى قبلتها برغم خطئها.. وقبلتنى برغم تخوينى وظنى.. ارتضى العقل وثارت النفس مؤيدة.. وصلا معا إلى نقطة التوازن}ص215. وكان المباراة بين العقل والنفس قد انتهت بالتعادل (صفر/ صفر). وكأن شيئا لم يكن، ولا ثورة قد قامت.
التقنية الروائية
دائما ما يكون بالعمل الأول بعض المآخذ، مثل رغبة الكاتب فى أن يقول كل شئ، وأن يخشى على قارئه من أن يفوته ما أراده. وهو ما يمكن أن نأخذه على “”الخطة 51″، حيث استفاض الكاتب فى عمليات الوصف و الاستفاضة فى الحديث عن دور الصديق “أحمد سمك” بعد عمله فى قناة الحرية المعادية.. وكذلك عمليات التنظير التي يتدخل فيها منولوج السارد، وكأنه الكورس فى الملاحم القديمة. رغم أنها تكشف البعد الإنسانى فى الشخصية، وتُخرجه عن النمطية، أو الرمز المجرد. فضلا عن الفصل الأخير “مباراة جديدة”، والتى لو تم حذفه، ما أثر ذلك فى رسالة الرواية. والذى استرسل فيه للمزيد عن تجربة كتابة الرواية، وبداية حلم بمباراة جديدة.
وقد حاول شعير، ان يتملص من تلك المآخذ بإعترافه {لكنى لست أديبا، بل صحفى جذبته السياسة وألاعيبها}. مؤكدا ذلك عبر ظهور الوظيفة، العملية، فى الوظيفة الروائية، لا فى الإسلوب السلس، الخالى من الزخرف، فقط، وإنما أيضا، فى القدرة على الإشارة التي توحى، دون أن ثصرح مثل الإشارة دائما إلى “العاصمة” وتجنب ذكر “الإدارية” رغم أنه يعنيها مثل.. أمام زحام الكورنيش {ما كل هذا الزحام؟! أكاد أختنق.. قفز إلى عقلى ما قرأته صدفة فى أحد الكتب المدرسية لمالك حول الخطة التاريخية لتفكيك زحام القاهرة القديمة، والتى تم بموجبها نقل الهيئات الحكومية إلى منطقة “العاصمة” كدت أصرخ فى الطريق.. لم يتفكك شئ.. نحن من نتفكك إلى حد التلاشى فى هذا الزحام}ص105. وكذلك الإشارة إلى الحكومة ب”الحزب”.
كذلك توضيح ما عنيه من روايته، مستعيرا عنها بكتابه الذى احتفل بتوقيعه “طريق الأشواك”، وحديث الوزير السابق “هشام علام” عنه {الحقيقة إن أهم ما لفت نظرى فى كتاب “طريق الأشواك” للأستاذ أكرم.. هو الأشواك نفسها.. مش الطريق.. يعنى إيه؟ يعنى الكاتب كان شجاع فى البحث عن مواضيع الأشواك الموجودة فى طريقنا الحالى…… والطريق قائم على محاولة تلمس الموضوعية وعدم الانحياز.. والتوازن بين القبول والرفض.. التأييد والمعارضة}ص206.
ثم يواصل أستاذ التاريخ {إحنا اساتذة التاريخ بنقول إن التاريخ يبدأ عندما تنتهى السياسة……. يعنى كتاب طريق الأشواك يوضع مع الكتب الأخرى للمقارنة بين الروايات المختلفة للحدث الواحد وتحليلها بهدف بناء رؤية كلية للحقبة التاريخية}. والذى يكشف فيه عن فلسفة السارد، والذى يمثل الصحفى خاصة، والإعلامى عامة، حين يمسك بالعصا من المنتصف، خاصة فى الأوقات التي تغيب فيها الحرية، وهو ما عبر عنه أكرم بنفسه بعد كتابة المقال عن شيرين الحداد، التي استبعدت عن الميكرفون، وبينما هو يعرف كل تفاصيل الحكاية، دون ذكر أسباب غيابها، علا المنولوج {هذا فقط ما كتبته.. وبهذا أجبت بذاتى عن تساؤلاتى.. كيف تقول ما تريده بشرط أن تضمن وصوله؟ كيف تبنى هجمة منظمة وتصل إلى المرمى من خلال خطة دفاعية فى الأساس؟! والأهم هو : كيف أثبت لذاتى أنى لست مجرد “رقاص”؟!}ص119.
فهى تكشف أيضا عن نظرية النسبية، والتى تتيح إختلاف الرؤى، ولا تقطع برأى أوحد، كرد على ما تبنته الجهة التي استلمت البلاد فى المرحلة التي تلت فعلها الثورى، والذى تكشف فى العلاقة بين الأخين أكرم وسيف، حين تبادلا المواقف، لتغير الظروف والرؤى، بعد أن كتب أكرم مقالا دفاعا عن شيرين، دون أن يصرح بذلك، وبعد أن كان أخوه “سيف” قد انتهى من إعداد صورة أستديو القناة المزمع إنشاؤها- “قناة الحقيقة”-، لصاحبها خالد الأنصارى يقول أكرم {يا للمفارقات.. هأنذا وأخى نتبادل الفخر بالنجاح فى اتجاهين مختلفين، وكل منهما مختلف عن الاتجاه الأصلى لصاحبه: سيف الذى يهاجم الحزب وسياساته يفخر بعمل فى قناة يرى أن الحزب يقف فى الخفاء وراءها. وأنا من أدافع عن الحزب فى كثير من خطواته، أفخر بمقال أرى أنه ضد الحزب لا معه.. أكان كلا منا يحاول التبرأ أمام الآمن شئ ما؟ لا أعرف}ص126.
و كذلك بعد لقاء السارد وشيرين بنقابة الصحفيين، ومواجتها له بصراحة، ودعته لترك الأمر للشباب، ودعها وتركها تنصرف، ليعلو المنولوج من جديد، حيث تغير الرؤية، وفقا للحالة النفسية التي يكون عليها الشخص{بدت لى مؤخرتها لأول مرة كبيرة، بما لا يتناسب مع باقى جسدها، وبما يُعيق حركتها أو يبطئها.. كيف رأيتها من قبل فرنسية القوام وإن يكن بمقاييس مصرية؟! هل كانت كذلك ثم تثاقلت أم أنها لم تكن أصلا؟ هل رأيتها من قبل بدقة أم لعلى لا أرى الآن جيدا}ص170.
كما أنه مما يحسب للكاتب، رغم هذه البداية، قدرته على رسم الشخصيات، والتى لم تتوقف عند كونها رموز. فإذا كانت شخصية السارد، هى الشخصية المحورية، فقد دعمها، بالتاريخ، الذى يمنح المنطقية، والبشرية لها. فهو يعمل صحفيا، وله رؤية محددة، سواء إتفقنا معها أو إختلفنا، فإن والده كان له دور كبير فى تكوين تلك الشخصية، حيث يقول عنه {أبى فؤاد الشرقاوى، المفتش فى وزارة التربية والتعليم سابقا، المعلم الأول فى حياتى. الرجل الذى خط طريقا ألزمنى-برغبتى- بالمسير فيه، فَنَبَتْتْ فى الدرب على مهل، وبتؤدة بذرة شخصيتى}ص23. كما تردد ذكر الأب كثيرا، بما يؤكد دوره فى حياته على المستوى الإنسانى، وما يؤكد تواصل الأجيال، الذى به قسم الكاتب الشخصيات إليها، ليؤكد أن ما من عمل ينبت شيطانيا، ومنه يحدد أن ما مر ليس إلا مباراة، وخسارتها لا يعنى توقف الحياة، ولكن على الأجيال القادمة ان تستعد للمباراة القادمة، بشرط أن تستمر الملاعب مفتوحة {استراتيجيتى للفوز بالبطولة تقوم بشكل أساسى على ضرورة أن يظل الملعب السياسى مفتوحا دوما، حتى وإن تكن الأجواء غائمة، أو المباريات قليلة، أو طرق اللعب عقيمة، لكن هذا فى كل الأحوال أفضل من الماضى}ص17، وحيث تبر هنا كيف يلعب الكاتب كى يظل سارده فى مأمن.
و كشف الكاتب عن شخصية “نورا” في اللقاء الذى تم بينهما للمكاشفة والمصافحة، حين استرجت حياتها منذ الصغر، وكيف كان والدها، وهى صغيرة، يساهم فى عمليات محاربة الإرهاب، وكيف كان أصدقاؤه يموتون كل يوم، إلى أن غادر هو الآخر، تاركا إياها صغيرة، تفتقر إلى الحماية، وهو ما تربى فى أعماقها، حتى صرحت للسارد لتبرر تعاملها مع الحزب {العلاقة مع الحزب كانت مسألة جبر لا اختيار..كنت أريد أن أكون أنا.. ولم يكن هذا ممكنا بعيدا عن الحزب.. لكننى لم أكن خائنة}ص212. فقد بحثتْ عن الحماية والسند، التي لم تكن لتجده إلا بمساندة الحزب، حيث تكون قصة “شيرين” هى النموذج والمثل.
وإذا كانت الرواية قد خلت من الحدث التصاعدى – التقليدى- فإنها إعتمدت على الإحساس التصاعدى، حيث تدرج إحساس السارد وتقلب بين الفرحة بالأمل،، والإحباط باليأس. السعادة فى الجب.. ثم إنسحاب الحب، مع كل من نورا. وشيرين… مع الفرحة بأمل التغيير، ثم اليأس لبقاء الحال على ما هو عليه.. وهو ما عبر عنه السارد فى قوله {تعبير “الذكرى السنوية” لايعنى أننى قررت أن أنعى طريقى لكننى.. جَرَحتْ الأشواك عقلى ونفسى}ص197. وكل ذلك ساعد على الحيوية فى السرد، ساعدها، اللغة الصحفية السلسة، والخالية من الزخارف، مما ساهم فى تقريب الأحداث – لقربها الحياتى من حياة القارئ- وتقريب الشخصيات – رغم جنوحها نحو الرمزية- ليشعر بها القارئ وكأنها أشخاص ممن قابلهم فى مكان ما، أو فى مناسبة ما.. من الحياة.
ثم يأتى العنوان “الخطة 51″ فقد عرفنا أنه إذا كان كبار اللاعبين ومشاهير اللعبة، يحملون الأرقام المميزة، ولا يأتى من بينها الرقم 51، الذى لم يجد مالك غيره، كلاعب ناشئ، يبحث عن الفرصة، حتى لو كانت بالرقم 51. فأصبح الرقم يميز الشخص، رغم أنه ال”مالك” ورغم أنه {“هو الأسبق والأبقى.. هو الأهم}. على إعتباره هو الشباب، وهو المستقبل، إلا أننا لم نجد له “خطة”. الأمر الذى قد يتيح لنا رؤية الرواية الممتعة تحت مسمى، ينبع من مسيرة الرواية، وليكن “الرحلة.. 51” فقد عشنا معه رحلة الشباب.. رحلة الأمل واليأس، رحلة إنكسار الحلم. أو أن يصبح كتاب السارد نفسه “طريق الشوك” والذى نراه أكثر من مناسب لتلك الرحلة.
الشعرية الروائية
لم يعد جديدا القول بأن الشعر، ليس هو الكلام الموزون المقفى، كما كانت أبسط تعريفاته، والذى يقف بها عند (النظم) دون الشاعرية، حيث تكمن الشاعرية فى استخدام الأساليب الجمالية التي يصل بها المبدع إلا صياغة خطابه. وهو ما عبر عنه اللغوى والناقد الروسى “جاكبسون” (1896 – 1982) فى تعريف الشعرية، بأنها الوقوف على الأسس الأدبية للخطاب، بمعنى أنها إكتشاف المنهج الذى سار عليه الخطاب الأدبى. وهو ما يمكن القول عليه بأنه التقنية التي سار عليها المبدع، كى يصبح عمله، إبداعا شاعريا.
فإذا ما تأملنا رواية “الخطة 51” والتى تقوم على السرد (الواقعى)، لرؤية فترة زمنية محددة، وهو الأمر الذى يؤكد أن الرواية قد اقتنصت دور الشعر الذى كان يُعرف بأنه ديوان العرب، فها هى الرواية، ليس فقط إقتناص هذا الدور، وإنما –أيضا- استخدمت أدواته، والتى يأتى فى مقدمتها، سيادة سرد الرواية على المنولوج، فنجد أن السارد يتدخل –كثيرا- بالحدث الداخلى، إما معلقا، أو مستدعيا، أو متوقعا، وكأنه يلعب دور الكورس فى الملاحم الإغريقية القديمة. أى ان حديث النفس، أو البوح (الداخلى) صار جزءا رئيسا من الخطاب الأدبى. وهو الوظيفة الأولية للشعر، الغنائى منه تحديا. فضلا عن الفجوات، التي تعمد الكاتب أن يتركها للقارئ، والتى تدعوه لاسنباطها بنفسه. مثل تلك الإشارات كال(العصمة….) و (الحزب..) وغيرها. بالإضافة إلى التورية فى عملية وصف ملعب “هليوبولس” وما يمكن أن يتركه فى النفس من شحنات نفسية، تتسع دائرتها لتشمل ما هو خارج نطاق الملاعب. كما لا يمكن أن نهمل التحولات النفسية لكل شخوص الرواية، من الفرحة والأمل، إلى القنوط واليأس، وبما آل إليه السارد نفسه وصديقته وحبيبته نورا، الذين تحولا من الفعل والحركة، إلى الاستسلام والدعة، والاكتفاء بالمشاهدة والذى معه يمكن أن نقول أنها رواية نفسية أكثر منها تاريخية، أو سياسية – برغم أن صفة السياسية صفة سيادية -، حيث تؤكد الانعكاس النفسى للفترة على البشر، وما الشعر إلا إنعكاس لأحاسيس ومشاعر، يعيشها الشاعر متفاعلا مع ما ومن حوله. وغيرها من مظاهر الشعرية التي قد لا يراها القارئ غير المدقق، والنظر للرواية فقط، على أنها شهادة على واقع معيش.
ولا يمكن إلا القول بأن الرحلة التي اصطحبنا فيها الكاتب محمد شعير، بين دهاليز فترة من أهم فترات التاريخ المصرى، الحاملة للكثير من التساؤلات، والكثير من التقلبات، والذى نستطيع معها –بكل إطمئنان- القول بأن ضربة البداية فى مسيرة الكاتب محمد شعير فى عالم الرواية، كانت بداية قوية، عرفت طريقها إلى شباك الخصم، فكان الهدف الأول، حتى وإن كان الحكم قد إحتسبها “تسلل” أو هدف أبيض، كما تقول لغة الكورة، وإصرار الحكم على أن تنتهى بتالعادل، دون أهداف، فقد تركت لنا عبرة ودرسا يصلح على المستوى الفردى، كما يصلح على المستوى الجمعى، وهى {أن الوصاية هى كبرى الخطايا فى التربية والسياسة، لكن يا عزيزتى.. محبتنا أمر فطرى.. نَفسى لادخل فيه للعقل. أما فى السياسة فلا مجال لمحبة أو كره، بل الأمر للعقل}ص215. فهل نملك العقل الذى يستوعب؟!.
…………………..
[1] – محمد شعير – هدير الصمت –رواية صحفية من داخل جريدة الأهرام – 2013.
[2] – محمد شعير- الخطة 51 – الطبعة الثانية – حابى للنشر والتوزيع يناير 2022.

ومن بين تلك الأعمال التي راقبت وترقبت، ما يحدث يحدوها الأمل، تلك الرؤية الصحفية من داخل جريدة الأهرام العريقة والحاملة لذلك العنوان المكثف والمعبر، والمشحون بكل تلك المعاني، والمقتحم لجوهر ما يحدث “هدير الصمت”، ذلك العنوان الذى تخيره الكاتب الصحفى محمد شعير، والذى ينهيه بذلك الأمل الذى ولدته تلك الثورة { ورغم كل ما يجرى.. فقد ضحكنا جميعا.. ضحكنا بشدة.. لم نكن سعداء بالطبع.. لكننا أيضا لم نكن حزانى تماما، وقد كنا ندرك أننا تغيرنا.. لم نعد كما كنا.. لم نعد نحن.. ولن نعود}[1]. وهى النهاية التي يمكن منها أن ننطلق لقراءة عمله الروائى الأول “الخطة 51”[2]، بعد أن هدأ الشارع، وسكنت الأصوات.. وكمنت النفوس، ولم يعد أمامها إلا تأمل تلك الرحلة التي صاحبها الأمل. ورافقها الرجاء، فكان حتما تدارس التبعات، وما أدت إليه.. كيف كنا، وإلام صرنا. لنتبين أن كل تلك المراحل، كان انعكاسها نفسيا بالدرجة الأولى. فكان أول نجاحات الكاتب، أن اعتمدت الرواية على التأثير النفسى، والذى اتضح من غلبة منولوج السارد، وأن الأحداث، وما يجرى على السطح، ما هو إلا تعبير عما يعتمل داخل نفس السارد، ورؤيته، وهو ما يعتبر ثانى نجاحاته، فى التأكيد على اختلاف الرؤى، وأنه لا يملك وحده الحقيقة، وإنما كل هذا، مصبوغ برؤيته هو، وهو ما لا يمنع من وجود وجهات أخرى. وهو الانعكاس الضمنى الذى يعكس ما قُوبلت به ثورة يناير، عبر مراحلها العديدة، من تباين وجهات النظر.
اختار الكاتب –كصيغة شكلية- شكل مباراة كرة القدم.. كلعبة شعبية.. يتفاعل فيها اللاعبون، من الطرفين.. والحكام. والجمهور. وهو ما يتناسب مع شكل الموضوع المتناول، ثورة يناير، والتى يمكن تحديدها بوضوح، رغم أن الكاتب لم يُشر إليها مباشرة بطول الرواية، لكنه منحنا – كقراء- تلك الإشارات الذكية التي تدعونا لربط الأحداث والوقائع.
اول هذه الإشارات، بعد أن أصيب الابن “مالك” وهو الاسم الدال على ملكية القرار، وملكية القيادة، لا فى الثورة وحدها. وقد كان حلم هذا الابن، وحلم أبيه أيضا أن يصبح لاعبا مشهورا. غير أنه أصيب فى مباراة كان يلعب فيها ضمن فريق الأشبال ممثلا لحى المعادى، إصابة كان الخوف من تفاقمها، وتأثيرها على مستقبله، وكان ذلك الساعة 11 مساء يوم 11 فبراير. ذلك التاريخ الذى انحفر فى الذاكرة بالتهليل والفرح لإعلان مبارك ترك الحكم. فكان تهليل الأب وابنه، وفرحهما، لا بنتيجة الأشعة التي منحتهم الطمأنينة والأمل –فى الظاهر- وفى –الباطن- الفرح والتهليل بتلك اللحظة الفارقة التي أحدثت موجات التهليل بطول البلاد وعرضها، وذلك من خلال ترديد أغنية مدحت صالح: “الحلم دا حلمنا.. والحب من حقنا.. مين اللى يمنع طير إنه يطير فى السما؟””. ولتصبح تلك هى “ضربة البداية”. على أن “مالك” ليس فقط هو المستقبل، وهو ممثل الشباب الذين تقدموا الثورة، ومشعلى جذوتها. وإنما كان هو ابن الماضى، فالأب والجد وجد الأب.. كانوا جميعا مولعين بالمباريات، ويحرصون على حضورها بالملاعب. لينفتح الملعب بإتساع الوطن بجرافيته، وبتاريخه، إلا انه فى كل تلك المراحل كانوا من الجمهور.. ليأتى مالك، ويسعى لأن يكون لاعبا.. أى مؤثرا، وليس مجرد متفرج. وهى الأحلام التي داعبت، ليس الابن فقط، وإنما الجيل السابق له.
وإذا كان الكاتب قد اتخذ مجال الكرة – للتعبير الشكلى- حيث وفق كثيرا فى استخدام التعبيرات والاصطلاحات الكورية كعناوين للفصول، متقنا اختيار الأحدث للتمثيل، وترجمة المصطلح، فإنه يقودنا إلى أنه – أيضا- اتخذ من الشكل مضمونا، تجلى فى الجانب التقنى. حيث تم تقسيم ذات السارد إلى طرفين متقابلين- وكأنهما فريقين متقابلين-.. العقل والنفس. {يلعب عقلى مع نفسى مباراة خاصة، مباراة غير ودية، يحاول العقل أن يهزم النفس وآلامها، عبر إقناعها بأن كل شئ على ما يرام…. ولكن يواصل العقل هجماته المنتظمة، بينما تتواصل فى المقابل الهجمات المرتدة السريعة للنفس وآلامها…. وتستمر المباراة هكذا، سجالا بين الفريقين: العقل والنفس لتنتهى دائما بنتيجة (صفر/ صفر)ص12.
وقسم شخصيات الرواية إلى طرفين متقابلين- أيضا- فأحد الطرفين اعتمد على العقل، والآخر اعتمد على النفس، فتباينت الرؤى بينهما، وهو ما يعكس اختلاف الرؤية حول القضية الأساسية.. ثورة يناير. وكان الاختلاف الأكبر والظاهر فى تلك القضية هو عامل العمر- وفق ما كانت عليه (الجماهير) فى تلك الفترة. وهو ما قسم الكاتب شخصياته على نفس الأساس، فكانت هناك مجموعتان : السارد أكرم، وصديقته نورا.. الأكبر فى السن، أو الجيل الأسبق، وينتميان للعقل والحكمة فى موازنة الأمور، حيث أمسكت –هذه المجموعة- العصا من المتنصف. وهو ما يختلف عن الشباب الثائر الغاضب دون مواربة.
يقول أكرم لابنه الذى يزحف نحو القبول كلاعب فى أحد الأندية، وهو أمل الأب والابن معا (وسط كل أوجاعى، أصبحت تتقدم بى.. تقودنى على درب تحقيق حلمك.. وحلمى.. لعلى أشهد أى حلم لى يكتمل فى عمرى}ص184. كما يضاف إلى هذا الجيل صديق الأب، ريئس تحرير البرامج الإذاعية “أحمد سمك”.
والقسم الثانى الأصغر فى السن، أو مجموعة الشباب ويمثله.. الأخ الأصغر للسارد سيف، القريب من سن الإبن مالك. والذى اشترك لأول مرة فى ثورة يناير. والإبن مالك، والصحفية شيرين. حيث تحول الأخ سيف إلى الانعزالية وهجر السياسة، بعد طول ما عاناه من إحباطات فى الماضى، ويأس فى الحاضر مما يراه فى كتابات أخيه (الاعب فى المنتصف)، ونورا التي يعلم علاقتها بالجزب. فلم يحضر حفل افتتاح معرض “نورا” وأيضا لم يحضر حفل توقيع كتاب أخيه. فيحدثه السارد، كاشفا عن شخصيته {اعلم يا أخى أنك منشغل.. أنك بعيد.. وطالما كنت دوما بعيد.. لا عن أخيك فقط.. إنما عن الدنيا كلها.. عن البشر والبلد……. أنا أخبرك.. أنت ترى أن معرض نورا ليس سوى نفاق للحزب.. ولعلك ترانى أيضا فى كتاباتى منافقا.. لماذا؟ فقط لأن موضوع المعرض هو المعركة.. مع أنها معركة الوطن بأكمله.. لا معركة حزب أو سلطة أو مؤسسة…… لكنك ترى أن كل ما يجرى حولك باطل.. زائف.. ساقط.. لماذا؟ أنا أخبرك.. إنها الهّبْة المباركة التي لم تعد ترى غيرها، هبَّة الشباب التي شاركتَ فيها ولم تنجح….. هل المطلوب أن نظل نهجم ونهدم؟! }ص80. ثم يضيف السارد لتوضيح وتقريب الرؤية { سيف لم تكن له علاقة بالسياسة قبل تلك الهبة الوحيدة التي شاركَ فيها منذ سنوات دون غيرها من مثيلاتها}ص80. ويدور النقاش بين الأخين.. لنتبين منه مدى ما وصل إليه “سيف” من إحباط أدى به إلى الانغماس فى العمل وفقط، والانصراف عن كل ما يتعلق بالحزب.
ويتواصل الحوار، لنتبين أبعاد شخصية كل من الأخين، فيواصل السارد/ أكرم {الخطة البديلة.. أقصد إن عدم النجاح فى طريق معين مش معناه أبدا إن البديل يبقى خروج الجمهور من الملعب فى نُص المباراة.. ليه كل واحد ما يحاولش بنفسه إنه يحقق النجاح من خلال شغله وإبداعه؟ وتبقى دى معركته حتى لو كان المفروض زى ما بتقول يبقى فيه معارك تانية كثيرة……يا سيف أنت أخويا وحبيبى.. ونفسى لو أقدر انتزع بإيدى كل ذرة إحباط من جواك} ص82. إذن فالمواءمة هى شخصية السارد، والإحباط هو شخصية أخيه.
ويدور الحديث بين السارد وابنه “مالك” حول ادعاء اللاعب العرقلة فى منطقة الجزاء، وأن المدرب هو من يطلب منه ذلك، ليكشف عن رؤية هذا الجيل للأجيال السابقة، وأنهم ليسوا إلا نبت ما سبق زرعه من فساد، ولما عاب الأب عليه ذلك رد عليه {عن أى قيم تحدثنى؟! هذه أخلاقكم ردت إليكم، هذا نظامكم الذى أورثتمونا إياه وقد ورثناه.. هذا ما جنته علينا أجيالكم ولم نجن على أحد}ص134. ولحرص الكاتب على ألا يفارق القول طبيعة شخصية الابن، وسنه.. يكشف أن ذلك ما توارد لذهنه هو {لعلى أنا من قررت أن أفهم هذا دون أن يقوله}. ثم ينفتح المشهد، لنتعرف على نفس الفساد – تقريبا- فى ملعب الصحافة، الذى يعيشه السارد، والعمل بمجاله.
والصحفية شيرين.. التي تعانى وتضطر للعمل بما لا يتوافق وشخصيتها وطموحها. ففي حوار بين السارد وبينها، تبدى له رأيها فى كتابه، فتقول: {صدقنى يا أكرم، المسألة دلوقت ما بقتش انحيازات وأيديولوجيات وأفكار معلبة زى ما بتقول. المسألة إن الصورة ضبابية فى كل حاجة.. ولما بنحاول نفهم ونسأل كإعلام يعنى ما حدش بيقول حاجة.. ويمكن كمان السؤال نفسه يتحسب عليك.. كأن مش مسموح لأى مخلوق إنه يفكر حتى مجرد تفكير علشان يفهم.. إنت فى المجال وعارف..}ص87.
كما تُكمل فى جانب آخر، لتكشف عن تلك المعاناة التي يعانيها الشباب المتحمس، والساعى لتغيير النمط، وبما يكشف عن كيفية تسيير الأمور، حيث يحدثها السارد عما اتبعه فى كتابه “طريق الأشواك” { توازن إيه بس يا اكرم؟! إنت هتجننى؟!.. ده مكتب الأمن هو اللى اتصل يبلغنى إنى حاقدم وأدير الجلسة الافتتاحية فى مؤتمر الحزب الجاى عن الإعلام!.. وزارة الأمن اللى بتبلغنى مش وزارة الفنون بتاعتنا ولا الحزب.. حاتجنن!}ص88. و ويكمل السارد توضيح الصورة الكاريكاتورية التي يريد الحزب، ويريد المسؤلون أن يكون عليه الإعلام، فيصف حركتها المعبرة عن كلماتها { فراحت تلهو مقلدة صور تماثيل قدماء المصريين رافعة كفيها مفتوحتين بمحاذاة كتفيها، وهى تميل برأسها يمينا ويسارا وتقول “أنا حلوة أهو.. أنا كويسة أهو.. أنا مع وزارة الأمن.. ومع الحزب.. ومع وزارة الفنون.. والجنون}ص89. ويسألها أكرم: وإنت هتعملى إيه يا هانم؟ حتقدمى المؤتمر؟ {ردت سريعا “طبعا يا باشا ثم انقلب كل هذا إلى تنهيدة حملت مع زفيرها الساخن عبارة أخيرة.. هنعمل إيه بس؟! أهو شغل وخلاص}.
وتمضى رحلة الثورة، على ارض الواقع، متقلبة بين الأمل، واليأس، بما يعكسه الكاتب من أحداث –داخل الملعب، وفى العنوان الموفق “هجمة مرتدة” وكأنه بداية الشك، والخوف تدب فى النفوس. فنرى تلك التفرقة بين البشر، وكأن ثورة لم تقم. فحين عودة “مالك” إلى الملاعب بعد الشفاء. وفى مباراة “خارج الديار” كان مقررا أن يلعب فريق “مركز شباب المعادى”، وفريق نادى “هليوبولس” { هذه هى المرة الأولى التي أدخل فيها ملعبا – لمشاهدة مباراة لمالك- يكون فيه مدرجات للجمهور بالمعنى الحقيقى. المدرجات والإنشاءات و”التراك” حول الملعب، والجماهير بما ترتديه من “براندات” وما تضعه من “برفانات” كلها علامات دالة على عراقة النادى الكبير، الذى يضم بين أعضائه عددا من قيادات وكوادر الحزب. وعلامات دالة أيضا على حجم الضغط على الفريق الضيف، فريقنا}ص41. وهو ما يستدعى التساؤل الاستنكارى للإبن حين سأل أباه {هو الحزب فين؟ قلت سريعا” فى العاصمة..ليه؟” رد قائلا يااااه يعنى مش فى مصر الجديدة؟}ص163. وكأن الكاتب يرمى إلى ما هو أبعد.
وإذا كانت ثورة يناير، قد قامت بالأساس احتجاجا على تصرفات الشرطة، فى يوم عيدهم، الذى يمثل بطولات للشرطة في عهد وصف بالعهد البائد، فحين أحرز مالك الهدف الأول، وتسبب فى ضربة جزاء.. وفى المدرجات جلس رجل عالى الصوت شوشر على مشجعى مركزشباب المعادى، وبعد المباراة وبابتسامة ود قال : على فكرة.. عمركم ما كنتم حتغلبونى””…. وعاد ليفسر: “قصدى فى الصوت يعنى.. أنا ضابط”…. ضحكنا جميعا}ص45.
واثناء عودة الأب مصطحبا ابنه من أحد التدريبات.. أدار الأب مؤشر الراديو {تحولتُ إلى قائمة القنوات الفضائية، وفجأة تسمر الريموت كنترول فى يدى. خاصة بعد أن اتضح أن الأغنية تمجد إنجازات الحزب. عنئذ وجدت مالك يسألنى بشكل مباغت : إيه ده؟! همَّ عارفين الكلام ده؟ بيعجبهم يعنى؟.. وأضاف مفسرا” الحزب يعنى”}ص28.
كما يظهر “الكارت الأحمر” فى إيقاف المذيعة اللامعة شيرين عن العمل {حيث أن شيرين نوهت فى البرنامج عن خبر نشره موقع إليكتروني أجنبى حول صدور قرار رسمى فى دولة الأرجنتين بإيقاف بعض شركات تسمين الأبقار هناك – أعلنت أسماؤها- لاكتشاف استخدام أعلاف غير صحية أو آمنة، وقالت على الهواء أنه من المعروف أننا نستورد اللحوم من الأرجنتين، لذا فمن الضرورى أن يتأكد المسؤولون عندنا من أن التعاملات التي تمت لم تكن مع إحدى الشركات المخالفة..}ص106. وهو الموقف الذى تعرضت معه للتحقيق، ثم الإيقاف.
وفى حوار بين السارد وشيرين، تقول {ما أسهل أن تقول كل ما تراه بأعلى صوت، لكنه يظل حبيس غرفتك المظلمة. يتردد صداع فى أرجائها.، حتى يملأها ويملأك، وإن خرج صوتك إلى النور بشكل أو بآخر فلن يترك أثرا إلا لدى من هم معك، فى ذات فريقك، فيقتنع بك من هم أصلا مقتنعون، ويبتعد عنك-أكثر- من هم مبتعدون}ص105. حيث تكشف كلمة (أكثر) مدى التباعد، والانقسام بين طرفى المعادلة، والذى، بالعل، كان قائما.
ثم يعلو منولوج السارد { مشهد حصول شيرين الحداد على “الكارت الأحمر وخروجها أمامى مطرودة من الملعب، جاء مصحوبا – فى عقلى ونفسى- بهدف فى مرماى أنا. إذ وضعتنى أمام ذاتى بالواجهة. يقول الناس عنى إننى ألعب- فى كتاباتى- بإسلوب “دفاعى”، ولا يشغلنى هذا. فأنا لا أكتب إلا ما يُرضى ضميرى، لكننى الآن لم يعد يرضينى كل هذا القدر من “إغلاق المساحات” لذا لابد من إعادة توجيه الاعبين، لابد من الهجوم.. ولكن كيف؟ تلك هى المسألة!.. إيه يا عم أكرم ؟! ما أنت عارف.. عارف ؟! هل حقا أنا أعرف؟! هل أرى ؟! هل أسمع؟.. ومع ذلك لا أتكلم؟ هل أنا مجرد “رقاص”؟!}ص109.
ثم تأتى الدعوة إلى الهجوم من جديد، عندما اقتحمت جماعة اللحى الطويلة والجلاليب القصيرة الحكم فى البلاد، وللتعبير عن أحد مراحل التقلبات التي انتابت المرحلة، لتعبر عنها الرواية، باستخدام اللاعب رقم 51 {لم اشاهد ابنى عصبيا مثلما كان ذلك اليوم، كان يحاول أن يطارد حلما بدا منذ الدقائق الأولى أنه صار سرابا، يلتحم بقوة فى الكرات المشتركة، يحاول اقتناص أى شئ دون جدوى، إلا فى مرة واحدة راوغ فيها وحشا ضاريا بدت لحيته الكثة وحدها خير معبر عن فجيعة “التسنين فى الكورة لدينا}ص202. ويحصل مالك الشرقاوى على كارت أحمر.. ليعلق الأب {وها هو يخرج من الملعب مطرودا.. مصابا.. خاسرا.. ذليلا.. عدنا إلى حيث بدأنا.. لم نتقدم خطوة.. لم يتغير شئ}ص203. حيث يشير الاستدلال على إستئثار تلك الطائفة بكل شئ، دون باقى أفراد اللاعبين، والجمهور.
ثم تأتى السيول فى العشر دقائق الأخيرة من المبارة. فبعد أن كان قد أُعلن عن إنشاء مجموعة قنوات إعلامية، تتضمن قناة إخبارية تحت اسم “الحقيقة”، يديرها خالد الأنصارى- كواجهة لمن خلفه من أقطاب الحزب-.، طُلب لتقديم برنامج فيها الفناة التشكيلية “نورا” وورئيس التحرير الإذاعى “أحمد سمك”، وأسندت مسئولية تجهيز رسومات الاستديوهات، والتصاميم الهندسية للمهندس المعمارى “سيف”. تحمس الجميع حتى كادوا يتفرغون للعمل الجديد. وقبيل إفتتاح التشغيل الفعلى لقناة “الحقيقة”.. غابت الحقيقة.. حيث تم إلغاء المشروع، لينهار الجميع ويصيبهم بالإحباط التام، فتتفرق بهم السبل.. كل فى طريق.، فقد إختفت شيرين عن الأنظار، وأصبحت عودتها شبه مستحيلة. وسافر سيف للعمل بدبى وهجر مكتبه الهندسى، حتى أنه طلب من أخيه بيع شقته الخاصة به فى البيت الذى ورثوه عن أبيهم.. دخول أحمد سمك المصحة فى حالة بائسة ” وهو يرى كل أحلامه تذوب، تتبخر، تتلاشى”… ثم فوجئ الجميع بظهوره يعمل فى قناة الحرية، وهى إحدى القنوات المعادية تبث من لندن. واختلف السارد خلافا حادا مع “نورا” حبه الأكبر، بعد ما تصوره عن إشتراك نورا فى المؤامرات، والوصولية.{أأنتى تفعلين بى هذا يا “نوريتى”؟ّ توهميننى بالنقاء والصدق بينما تدبرين أمرك بليل مع الحزب؟ تتركيننى وتذهبين لغيرى لأجل المصلحة والشهرة فحسب؟!}ص189.
وليصرح السارد فى النهاية { ما أعرفه أننا صرنا كخيوط العنكبوت، يحركونها كما يشاءون بأيديهم. فتمتد ذات صباح لتبنى بيتا من أمل، اسمه قناة “الحقيقة” ثم تنهار بليل فجأة بكل سهولة، وتعود لتقيم عماد قصر من الأحلام لمالك فى الكورة}ص196.
ثم يأتى تحرك اللاعب الأصلى فى الملاعب، اللاعب رقم 51 “مالك أكرم الشرقاوى”. حيث يغادر الملاعب المحلية، ويسافر إلى ألمانيا للعب فى أحد الأندية درجة ثانية. إلى جانب إعتزال كل من السارد، ونورا، العمل، والتفرغ لحياتهما الويعة بالأسكندرية، لينعما بالهدوء، والابتعاد عن ملاعب السياسة، التي لم يعد لهم –جميعا- دور فيها.
غير أن الكاتب لم يشأ أن تكون رؤيته بهذا التجرد الحياتى الواقعى الجاف، ولكنه طعم شخصة السارد بالعديد من المواقف الرومانسية، بالحب المشتعل، بينه ونورا، ليمر ذلك الحب، كما الحب دائما، بما يعكر الصفو، من إختلاف الرؤى أحيانا، والغيرة أخرى.. لكنها، تنتهى بالزواج بينهما، بعد المصارحة والعتاب والعفو، وكأن الكاتب يقفل دائرة التساؤل فى البداية، حين أشار إلى وقوعه فى الحيرة بين العقل والنفس، ليصل السارد فى النهاية إلى مرحلة التوافق:
{عندما أنهت نورا كلماتها قمت إليها.. ضممتها إلى صدرى.. قبلتها وقبلتنى قبلتها برغم خطئها.. وقبلتنى برغم تخوينى وظنى.. ارتضى العقل وثارت النفس مؤيدة.. وصلا معا إلى نقطة التوازن}ص215. وكان المباراة بين العقل والنفس قد انتهت بالتعادل (صفر/ صفر). وكأن شيئا لم يكن، ولا ثورة قد قامت.
التقنية الروائية
دائما ما يكون بالعمل الأول بعض المآخذ، مثل رغبة الكاتب فى أن يقول كل شئ، وأن يخشى على قارئه من أن يفوته ما أراده. وهو ما يمكن أن نأخذه على “”الخطة 51″، حيث استفاض الكاتب فى عمليات الوصف و الاستفاضة فى الحديث عن دور الصديق “أحمد سمك” بعد عمله فى قناة الحرية المعادية.. وكذلك عمليات التنظير التي يتدخل فيها منولوج السارد، وكأنه الكورس فى الملاحم القديمة. رغم أنها تكشف البعد الإنسانى فى الشخصية، وتُخرجه عن النمطية، أو الرمز المجرد. فضلا عن الفصل الأخير “مباراة جديدة”، والتى لو تم حذفه، ما أثر ذلك فى رسالة الرواية. والذى استرسل فيه للمزيد عن تجربة كتابة الرواية، وبداية حلم بمباراة جديدة.
وقد حاول شعير، ان يتملص من تلك المآخذ بإعترافه {لكنى لست أديبا، بل صحفى جذبته السياسة وألاعيبها}. مؤكدا ذلك عبر ظهور الوظيفة، العملية، فى الوظيفة الروائية، لا فى الإسلوب السلس، الخالى من الزخرف، فقط، وإنما أيضا، فى القدرة على الإشارة التي توحى، دون أن ثصرح مثل الإشارة دائما إلى “العاصمة” وتجنب ذكر “الإدارية” رغم أنه يعنيها مثل.. أمام زحام الكورنيش {ما كل هذا الزحام؟! أكاد أختنق.. قفز إلى عقلى ما قرأته صدفة فى أحد الكتب المدرسية لمالك حول الخطة التاريخية لتفكيك زحام القاهرة القديمة، والتى تم بموجبها نقل الهيئات الحكومية إلى منطقة “العاصمة” كدت أصرخ فى الطريق.. لم يتفكك شئ.. نحن من نتفكك إلى حد التلاشى فى هذا الزحام}ص105. وكذلك الإشارة إلى الحكومة ب”الحزب”.
كذلك توضيح ما عنيه من روايته، مستعيرا عنها بكتابه الذى احتفل بتوقيعه “طريق الأشواك”، وحديث الوزير السابق “هشام علام” عنه {الحقيقة إن أهم ما لفت نظرى فى كتاب “طريق الأشواك” للأستاذ أكرم.. هو الأشواك نفسها.. مش الطريق.. يعنى إيه؟ يعنى الكاتب كان شجاع فى البحث عن مواضيع الأشواك الموجودة فى طريقنا الحالى…… والطريق قائم على محاولة تلمس الموضوعية وعدم الانحياز.. والتوازن بين القبول والرفض.. التأييد والمعارضة}ص206.
ثم يواصل أستاذ التاريخ {إحنا اساتذة التاريخ بنقول إن التاريخ يبدأ عندما تنتهى السياسة……. يعنى كتاب طريق الأشواك يوضع مع الكتب الأخرى للمقارنة بين الروايات المختلفة للحدث الواحد وتحليلها بهدف بناء رؤية كلية للحقبة التاريخية}. والذى يكشف فيه عن فلسفة السارد، والذى يمثل الصحفى خاصة، والإعلامى عامة، حين يمسك بالعصا من المنتصف، خاصة فى الأوقات التي تغيب فيها الحرية، وهو ما عبر عنه أكرم بنفسه بعد كتابة المقال عن شيرين الحداد، التي استبعدت عن الميكرفون، وبينما هو يعرف كل تفاصيل الحكاية، دون ذكر أسباب غيابها، علا المنولوج {هذا فقط ما كتبته.. وبهذا أجبت بذاتى عن تساؤلاتى.. كيف تقول ما تريده بشرط أن تضمن وصوله؟ كيف تبنى هجمة منظمة وتصل إلى المرمى من خلال خطة دفاعية فى الأساس؟! والأهم هو : كيف أثبت لذاتى أنى لست مجرد “رقاص”؟!}ص119.
فهى تكشف أيضا عن نظرية النسبية، والتى تتيح إختلاف الرؤى، ولا تقطع برأى أوحد، كرد على ما تبنته الجهة التي استلمت البلاد فى المرحلة التي تلت فعلها الثورى، والذى تكشف فى العلاقة بين الأخين أكرم وسيف، حين تبادلا المواقف، لتغير الظروف والرؤى، بعد أن كتب أكرم مقالا دفاعا عن شيرين، دون أن يصرح بذلك، وبعد أن كان أخوه “سيف” قد انتهى من إعداد صورة أستديو القناة المزمع إنشاؤها- “قناة الحقيقة”-، لصاحبها خالد الأنصارى يقول أكرم {يا للمفارقات.. هأنذا وأخى نتبادل الفخر بالنجاح فى اتجاهين مختلفين، وكل منهما مختلف عن الاتجاه الأصلى لصاحبه: سيف الذى يهاجم الحزب وسياساته يفخر بعمل فى قناة يرى أن الحزب يقف فى الخفاء وراءها. وأنا من أدافع عن الحزب فى كثير من خطواته، أفخر بمقال أرى أنه ضد الحزب لا معه.. أكان كلا منا يحاول التبرأ أمام الآمن شئ ما؟ لا أعرف}ص126.
و كذلك بعد لقاء السارد وشيرين بنقابة الصحفيين، ومواجتها له بصراحة، ودعته لترك الأمر للشباب، ودعها وتركها تنصرف، ليعلو المنولوج من جديد، حيث تغير الرؤية، وفقا للحالة النفسية التي يكون عليها الشخص{بدت لى مؤخرتها لأول مرة كبيرة، بما لا يتناسب مع باقى جسدها، وبما يُعيق حركتها أو يبطئها.. كيف رأيتها من قبل فرنسية القوام وإن يكن بمقاييس مصرية؟! هل كانت كذلك ثم تثاقلت أم أنها لم تكن أصلا؟ هل رأيتها من قبل بدقة أم لعلى لا أرى الآن جيدا}ص170.
كما أنه مما يحسب للكاتب، رغم هذه البداية، قدرته على رسم الشخصيات، والتى لم تتوقف عند كونها رموز. فإذا كانت شخصية السارد، هى الشخصية المحورية، فقد دعمها، بالتاريخ، الذى يمنح المنطقية، والبشرية لها. فهو يعمل صحفيا، وله رؤية محددة، سواء إتفقنا معها أو إختلفنا، فإن والده كان له دور كبير فى تكوين تلك الشخصية، حيث يقول عنه {أبى فؤاد الشرقاوى، المفتش فى وزارة التربية والتعليم سابقا، المعلم الأول فى حياتى. الرجل الذى خط طريقا ألزمنى-برغبتى- بالمسير فيه، فَنَبَتْتْ فى الدرب على مهل، وبتؤدة بذرة شخصيتى}ص23. كما تردد ذكر الأب كثيرا، بما يؤكد دوره فى حياته على المستوى الإنسانى، وما يؤكد تواصل الأجيال، الذى به قسم الكاتب الشخصيات إليها، ليؤكد أن ما من عمل ينبت شيطانيا، ومنه يحدد أن ما مر ليس إلا مباراة، وخسارتها لا يعنى توقف الحياة، ولكن على الأجيال القادمة ان تستعد للمباراة القادمة، بشرط أن تستمر الملاعب مفتوحة {استراتيجيتى للفوز بالبطولة تقوم بشكل أساسى على ضرورة أن يظل الملعب السياسى مفتوحا دوما، حتى وإن تكن الأجواء غائمة، أو المباريات قليلة، أو طرق اللعب عقيمة، لكن هذا فى كل الأحوال أفضل من الماضى}ص17، وحيث تبر هنا كيف يلعب الكاتب كى يظل سارده فى مأمن.
و كشف الكاتب عن شخصية “نورا” في اللقاء الذى تم بينهما للمكاشفة والمصافحة، حين استرجت حياتها منذ الصغر، وكيف كان والدها، وهى صغيرة، يساهم فى عمليات محاربة الإرهاب، وكيف كان أصدقاؤه يموتون كل يوم، إلى أن غادر هو الآخر، تاركا إياها صغيرة، تفتقر إلى الحماية، وهو ما تربى فى أعماقها، حتى صرحت للسارد لتبرر تعاملها مع الحزب {العلاقة مع الحزب كانت مسألة جبر لا اختيار..كنت أريد أن أكون أنا.. ولم يكن هذا ممكنا بعيدا عن الحزب.. لكننى لم أكن خائنة}ص212. فقد بحثتْ عن الحماية والسند، التي لم تكن لتجده إلا بمساندة الحزب، حيث تكون قصة “شيرين” هى النموذج والمثل.
وإذا كانت الرواية قد خلت من الحدث التصاعدى – التقليدى- فإنها إعتمدت على الإحساس التصاعدى، حيث تدرج إحساس السارد وتقلب بين الفرحة بالأمل،، والإحباط باليأس. السعادة فى الجب.. ثم إنسحاب الحب، مع كل من نورا. وشيرين… مع الفرحة بأمل التغيير، ثم اليأس لبقاء الحال على ما هو عليه.. وهو ما عبر عنه السارد فى قوله {تعبير “الذكرى السنوية” لايعنى أننى قررت أن أنعى طريقى لكننى.. جَرَحتْ الأشواك عقلى ونفسى}ص197. وكل ذلك ساعد على الحيوية فى السرد، ساعدها، اللغة الصحفية السلسة، والخالية من الزخارف، مما ساهم فى تقريب الأحداث – لقربها الحياتى من حياة القارئ- وتقريب الشخصيات – رغم جنوحها نحو الرمزية- ليشعر بها القارئ وكأنها أشخاص ممن قابلهم فى مكان ما، أو فى مناسبة ما.. من الحياة.
ثم يأتى العنوان “الخطة 51″ فقد عرفنا أنه إذا كان كبار اللاعبين ومشاهير اللعبة، يحملون الأرقام المميزة، ولا يأتى من بينها الرقم 51، الذى لم يجد مالك غيره، كلاعب ناشئ، يبحث عن الفرصة، حتى لو كانت بالرقم 51. فأصبح الرقم يميز الشخص، رغم أنه ال”مالك” ورغم أنه {“هو الأسبق والأبقى.. هو الأهم}. على إعتباره هو الشباب، وهو المستقبل، إلا أننا لم نجد له “خطة”. الأمر الذى قد يتيح لنا رؤية الرواية الممتعة تحت مسمى، ينبع من مسيرة الرواية، وليكن “الرحلة.. 51” فقد عشنا معه رحلة الشباب.. رحلة الأمل واليأس، رحلة إنكسار الحلم. أو أن يصبح كتاب السارد نفسه “طريق الشوك” والذى نراه أكثر من مناسب لتلك الرحلة.
الشعرية الروائية
لم يعد جديدا القول بأن الشعر، ليس هو الكلام الموزون المقفى، كما كانت أبسط تعريفاته، والذى يقف بها عند (النظم) دون الشاعرية، حيث تكمن الشاعرية فى استخدام الأساليب الجمالية التي يصل بها المبدع إلا صياغة خطابه. وهو ما عبر عنه اللغوى والناقد الروسى “جاكبسون” (1896 – 1982) فى تعريف الشعرية، بأنها الوقوف على الأسس الأدبية للخطاب، بمعنى أنها إكتشاف المنهج الذى سار عليه الخطاب الأدبى. وهو ما يمكن القول عليه بأنه التقنية التي سار عليها المبدع، كى يصبح عمله، إبداعا شاعريا.
فإذا ما تأملنا رواية “الخطة 51” والتى تقوم على السرد (الواقعى)، لرؤية فترة زمنية محددة، وهو الأمر الذى يؤكد أن الرواية قد اقتنصت دور الشعر الذى كان يُعرف بأنه ديوان العرب، فها هى الرواية، ليس فقط إقتناص هذا الدور، وإنما –أيضا- استخدمت أدواته، والتى يأتى فى مقدمتها، سيادة سرد الرواية على المنولوج، فنجد أن السارد يتدخل –كثيرا- بالحدث الداخلى، إما معلقا، أو مستدعيا، أو متوقعا، وكأنه يلعب دور الكورس فى الملاحم الإغريقية القديمة. أى ان حديث النفس، أو البوح (الداخلى) صار جزءا رئيسا من الخطاب الأدبى. وهو الوظيفة الأولية للشعر، الغنائى منه تحديا. فضلا عن الفجوات، التي تعمد الكاتب أن يتركها للقارئ، والتى تدعوه لاسنباطها بنفسه. مثل تلك الإشارات كال(العصمة….) و (الحزب..) وغيرها. بالإضافة إلى التورية فى عملية وصف ملعب “هليوبولس” وما يمكن أن يتركه فى النفس من شحنات نفسية، تتسع دائرتها لتشمل ما هو خارج نطاق الملاعب. كما لا يمكن أن نهمل التحولات النفسية لكل شخوص الرواية، من الفرحة والأمل، إلى القنوط واليأس، وبما آل إليه السارد نفسه وصديقته وحبيبته نورا، الذين تحولا من الفعل والحركة، إلى الاستسلام والدعة، والاكتفاء بالمشاهدة والذى معه يمكن أن نقول أنها رواية نفسية أكثر منها تاريخية، أو سياسية – برغم أن صفة السياسية صفة سيادية -، حيث تؤكد الانعكاس النفسى للفترة على البشر، وما الشعر إلا إنعكاس لأحاسيس ومشاعر، يعيشها الشاعر متفاعلا مع ما ومن حوله. وغيرها من مظاهر الشعرية التي قد لا يراها القارئ غير المدقق، والنظر للرواية فقط، على أنها شهادة على واقع معيش.
ولا يمكن إلا القول بأن الرحلة التي اصطحبنا فيها الكاتب محمد شعير، بين دهاليز فترة من أهم فترات التاريخ المصرى، الحاملة للكثير من التساؤلات، والكثير من التقلبات، والذى نستطيع معها –بكل إطمئنان- القول بأن ضربة البداية فى مسيرة الكاتب محمد شعير فى عالم الرواية، كانت بداية قوية، عرفت طريقها إلى شباك الخصم، فكان الهدف الأول، حتى وإن كان الحكم قد إحتسبها “تسلل” أو هدف أبيض، كما تقول لغة الكورة، وإصرار الحكم على أن تنتهى بتالعادل، دون أهداف، فقد تركت لنا عبرة ودرسا يصلح على المستوى الفردى، كما يصلح على المستوى الجمعى، وهى {أن الوصاية هى كبرى الخطايا فى التربية والسياسة، لكن يا عزيزتى.. محبتنا أمر فطرى.. نَفسى لادخل فيه للعقل. أما فى السياسة فلا مجال لمحبة أو كره، بل الأمر للعقل}ص215. فهل نملك العقل الذى يستوعب؟!.
…………………..
[1] – محمد شعير – هدير الصمت –رواية صحفية من داخل جريدة الأهرام – 2013.
[2] – محمد شعير- الخطة 51 – الطبعة الثانية – حابى للنشر والتوزيع يناير 2022.