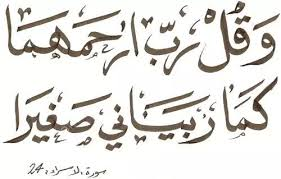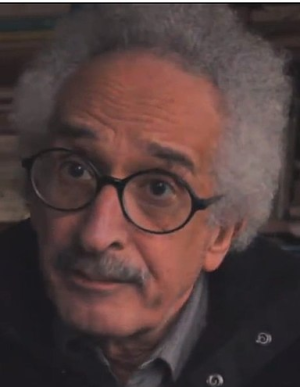في رسالة كافكا إلى أبيه: « أبي الحبيب.. لقد سألتني مؤخراً: لماذا أزعم أنني أخاف منك؟ وكالعادة لم أدر بماذا أجيبك. تارة بسبب الخوف الذي يعتريني أمامك، وتارة لأن الكثير من التفاصيل متعلقة بحيثيات ذلك الخوف، بحيث لا يكون بوسعي لملمة شتاتها في الحديث معك ولو جزئياً. وإنني إذ أحاول هنا أن أجيبك خطياً، فإن كل ما أقوم به لن يكون سوى محاولة مبتورة، وذلك لأن الخوف وتبعاته يصدانني عنك حتى في الكتابة، ولأن جسامة الموضوع تتعدى نطاق ذاكرتي وإدراكي «.
أمام اللجوء أو الهروب إلى الأم الحاضنة والحنونة وملاذ « التواطؤات « الجميلة، كيف يستحضر مبدعونا المغاربة صورة الأب، وهل تختلف نظرتهم إلى هذه السلطة الرمزية التي ارتبطت بالصرامة والتحكم؟ كيف دبروا هذه العلاقة التي تلتبس فيها العواطف بين خوف واحترام، بين حب أو كره، بين تقديس وقتل؟
«كل الرجال يرغبون في موت أبيهم
دوستوفسكي
«لا نستطيع أن نحمل جثة أبينا إلى أي مكان نذهب إليه..»
غيوم أبولينير
عشت في البيت مع أسرة صغيرة مكونة من شقيق وشقيقة يكبراني سناً، بالإضافة إلى أمي وأبي الذي كان موزعاً بين بيتين وأسرتين. فلم يكن يزورنا إلا لماماً، كأيام الجمع والأعياد، وخلال المناسبات الهامة، وخاصة عند تنظيم الانتخابات، بحكم أنه كان رئيساً للمجلس القروي الذي ينتظم فيه ممثلون عن القرى والمداشر المجاورة، مثلما كان يشرف على تنفيذ ما تصدره القيادة من قرارات وتدابير، كالحث على تسجيل الأطفال بمدرسة القرية، وملاحقة الممتنعين عن ذلك من آباء في بداية الستينيات، عندما كانت المدرسة ما تزال (بدعة) من بقايا الاستعمار – في اعتقادهم – تعطل التحاق الأبناء بكتاتيب القرآن أو بالحقول لمساعدة آبائهم في أعمال الزراعة، وكتسجيل الأسر المعوزة في لوائح الاستفادة من المساعدات الغذائية التي تخصصها لهم الحكومة من الإعانات الواردة من الخارج. كان أبي مشغولا جدا؛ لذلك لم أعرف من شخصيته سوى هذا الجانب الرسمي الذي ساهم كثيراً في إضعاف العلاقة الحميمية التي ينبغي أن تربط بين الأب وابنه. وكانت عاطفة أبي – على وجه الدقة – مختفية في صرامته وحرصه على أن يتعلم أبناؤه.
وكان أبي يمتلك هيبة تنخلع لها قلوب الكبار قبل الصغار. ورث السلطة والهيبة عن والده الذي كان قائدا في الخمسينات. وأضاف إليها من خصوصياته التدبيرية ما جعله محط احترام الشيوخ والأعيان. لذلك كان يغيب كثيرا عن البيت في اجتماعات المجلس، وفي حضور المناسبات الوطنية، وفي البيت الثاني الذي تعيش فيه زوجته الأولى. وكنت أحبذ هذا الغياب وأجد فيه حرية تسمح لي بالانطلاق والمرح مع أترابي، خصوصا عندما أعود في إجازات الصيف الطويلة إلى القرية إذ كنت أدرس بالمدينة. فأمضي النهارات الحارة سابحا في نهر (ورغة) الكبير، وأجزاء طويلة من الليل في قراءات الروايات والكتب التي أشتريها من المدينة، وقد تمكنت في مدةقصيرة، أواسط السبعينيات، من قراءة كتب جبران كلها، والمنفلوطي، وجرجي زيدان، ونجيب محفوظ، وإحسان عبد القدوس، وروايات أخرى بالفرنسية. لقد تولى الكُتاب والأدباء تربيتي عوضا عن أبي الغائب في مشاغله الدائمة، فيما تكلفت أمي بإعطائي محبتها وحنانها وتعاطفها في محنتي مع أبي.
كانت عودة أبي إلى الدوار، أيام الجمعة، جحيما لا يطاق، فما إن يترجل عن بغلته الرعناء، حتى يحاسبني حسابا عسيرا على ما تناهى إلى سمعه من شغبي وتفريطي وإفراطي، ثم يأمرنيبحمل الفأس ومرافقته إلى الحقل لأقضي معه الساعات الطوال في تدبر أعمال السقي والحفر والغرس، في طقوس لا تخلو من تأنيب وتوبيخ. (نسخة مصغرة من الحساب والعقاب الذي تحدثت عنه الأديان السماوية).
لا أدري أين قرأت هذه القولة بعد أن صرت رجلا، وتمنيت لو عاش قائلها طفولتي: «إن غضب الأب من ابنه يعد أكثر شفقة وحنانا من الحب الذي يكنه الابن لأبيه..» لا أشكك في صدقية القولة، ولو فتحت قلب أبي في طفولتي لوجدته ينبض بكل حب لي ولبقية إخوتي، لكن أنى لنا أن نقنع رهافة مشاعر الطفولة بغلظة معنى هذه القولة! ما كان غائبا عن أبي رغم كاريزميتههو فن التواصل مع الطفل والطفولة، وهذه سمة مسحوبة على معظم الآباء من مجايليه.
وليت الأمر كان يقف عند معاملتي أنا ابنه بفضاضة وعنف،فما إن يهدأ من محاسبتي حتى يشتعل جحيم آخر بينه وبين أمي. فهي تتهمه بالغياب وإهمال أحوال البيت، وهو يتهمها بسوء تربية الأبناء وتدليلهم أكثر من الحد المسموح به. وغالبا ما كانت المعركة تنتهي بغضبةشرسةمن أبي، تكون سببا في مغادرته البيت والرجوع إلى البيت الثاني، حيث زوجته الأولى التي كانت أكثر صبرا وتحملا. أما أنا فلم أكن أخفي فرحي بهذا الفرج الذي أسمعه في اصطفاق الباب، وفي الكلمات النابية التي تخرج من فمه، وهو يجرُّ بغلته العنيدة، كي يغيب أسبوعا آخر قبل أن يحل يوم الجمعة المشؤوم. وكنتُ في فسحة الحرية،هاته، أعود إلى تفقد أحوال شخصيات الروايات التي كنت أقرأها بالتزامن، فأطمئن على علاقة أرمانوسة المصرية بحبيبها، وأشفق على يتيم المنفلوطي، وأدعو لرشدي نجيب محفوظ بالشفاء العاجل.
كنت في غياب أبي أجد اللذة التي وجدها (جاك بريفر)، عندما عبَّرعن سعادته بعيدا عن «الأب» في معارضة جميلة للنص المقدس:
« أبانا الذي في السماوات
امكث هناك
ولنبق ـ نحن ـ هنا فوق الأرض
التي تبدو أحيانا جميلة «
هل كان أبي قاسيا إلى هذه الدرجة؟ مؤكد أنه لم يكن أباً عاطفياً، لذلك لا أدخر أية ذكرى تجعلني أطمئن إلى كوني قد تمتعت بالحنان الأبوي إلا في أواخر أيام هذا الأب، عندما أصيب بالمرض الخبيث في أوائل عام 1981، فعدل المرض كثيرا من سلوكه وطباعه، وأنا الذي كنت موقنا من أن أية قوة، مهما علت، لن تنال من جبروته. أذكر بألم يوم رافقتأبي إلى الطبيب بمدينة فاس ليأخذ له صورا بالأشعة، فهالني أن أرى هيكلا عظميا يتحرك باتجاه آلة السكانير. كانت صدمة كبرى أن أرى تاريخا من القوة والعنف ينهار في لحظة واحدة، واعترتني حالة إشفاق كبير ورغبة في البكاء عندما انفردتُ بالطبيب الذي بدا مقطبا وهو يقول لي:
ينبغي أن تأخذوه إلى الدار البيضاء.
هل حالته صعبة، يا دكتور؟
نعم، إن المرض اللعين قد تمكن منه، والأمر يدعو إلى الاستعجال لبدء العلاج بالأشعة.
كم سيعيش يا دكتور؟
الله أعلم، وإن كنت أخمن بأن حالته المتقدمة في المرض لن تمهله أكثر من خمس سنوات. أرجوك لا تذكر له هذا الأمر.
لم يَصْدُق تخمين الطبيب، فقد تفاقمت حالته بعد أيام قليلة، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى الأورام بالدار البيضاء، حيث قضى شهورا من العذاب، وكان طوال المدة يطلب نقله إلى بيته بالقرية، حتى يضمن أن يدفن جثمانه هناك في التراب الذي أحبه ودافع عنه، وحتى يضمن ارتباط أبنائه وبناته بأرضهم بعد موته. كان يقول: على الأقل ستزورون قبري هناك.
مات أبيذات ربيع، ولم أتمكن من حضورجنازته، فقد كنت منشغلا بإعداد بحث الليسانس للطبع والاستعداد للامتحانات النهائية بالكلية، وكان بحثي في موضوع (البطولة في الشعر الجاهلي). فصدَّرت بحثه بعبارة الإهداء التالي:
(إلى أبي الذي علمني أصول البطولة…)
لم تسعفني وسائل النقل في أن ألحق طقوس الجنازة، فوصلتفي أواخر النهار، وأثناء مروري بالطريق التي تفصل بين محطة الوصول وبين البيت، لمحت كومةً من التراب الطري بين القبور، فحدست أن جثمان أبي يرقد تحتها، وقد تخلص من جحيم الداء اللعين. وما هي إلا لحظة حتى تلقفتني الأيدي والأذرع والأصوات المنتحبة في مدخل البيت، وكانت أستار الظلام تهزم ما تبقى من شمس يوم ربيعي مزدهر من عام 1982.
لقد أبعدني أبي إلى المدينة مطروداً من القرية (جنتي) بسبب المدرسة، وصار هو رجلاً صالحاً لأنه عرف الشيطان وأحابيله ومكره، وطوَّع امرأتيه بشظف العيش وقسوته، ومات.. ولا شك أنه عاد إلى الجنة من جديد غانماً كاسباً، ليجد فيها التفاح تفاحاً، لا لغماً ملتبساً بالخطيئة ولا أثر للثعابين في جذوع أشجاره. أما أنا، فقد تركني في متاهة بين الدروب الضيقة والأبواب القديمة المجروحة، لا أكاد أجد فيها المخرج حتى أفاجأ بمتاهة جديدة، ولا أكاد أتبين وجه الحقيقة حتى ينفتح أمامي كتاب الأسئلة، ولا أكاد أظفر ببهجة الإيمان، حتى تطاردني الشياطين قافزة من الواجهات والمقاهي ومخادع الهاتف والمكتبات وهي تصيح في وجهي:
عد إلى الأشجار المحظورة، فثمة من يتربص بقطعها!
هكذا كان.. إلى أن تأكد أبي من فشل المِعْول في يدي، فنزعه مني بقوة، والماء يجري بيني وبينه تائهاً عن هدفه في أحواض الأشجار، صارخا في وجهي:
– لو كان أجدادك يعبثون بالماء هكذا، لما ظللتك هذه الأشجار! اهبط المدينة فثمة قنواتٌ تُحْكِمُ القبض على الماء، وصنابير تعلمك الاحتياط في العطش، ولا تنس أن تُحْكِم القبض على الكتب، فمتنها ألطف من مقابض المعاول، وعلمُها أوسع من عطشك!
الكاتب : عبد السلام المُساوي
بتاريخ : 05/07/2019
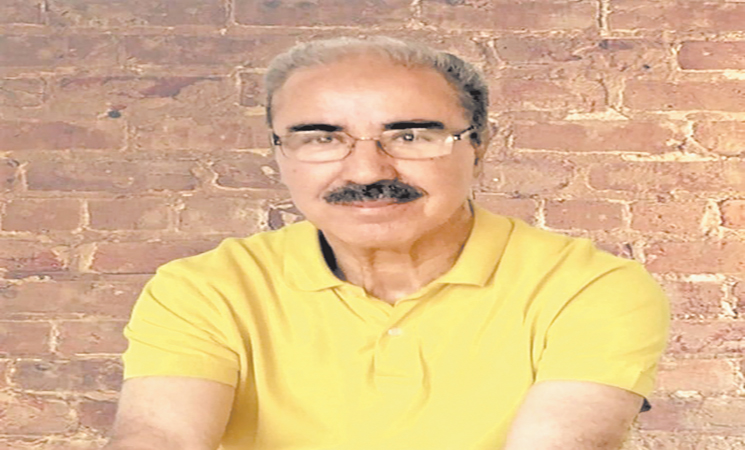
أمام اللجوء أو الهروب إلى الأم الحاضنة والحنونة وملاذ « التواطؤات « الجميلة، كيف يستحضر مبدعونا المغاربة صورة الأب، وهل تختلف نظرتهم إلى هذه السلطة الرمزية التي ارتبطت بالصرامة والتحكم؟ كيف دبروا هذه العلاقة التي تلتبس فيها العواطف بين خوف واحترام، بين حب أو كره، بين تقديس وقتل؟
«كل الرجال يرغبون في موت أبيهم
دوستوفسكي
«لا نستطيع أن نحمل جثة أبينا إلى أي مكان نذهب إليه..»
غيوم أبولينير
عشت في البيت مع أسرة صغيرة مكونة من شقيق وشقيقة يكبراني سناً، بالإضافة إلى أمي وأبي الذي كان موزعاً بين بيتين وأسرتين. فلم يكن يزورنا إلا لماماً، كأيام الجمع والأعياد، وخلال المناسبات الهامة، وخاصة عند تنظيم الانتخابات، بحكم أنه كان رئيساً للمجلس القروي الذي ينتظم فيه ممثلون عن القرى والمداشر المجاورة، مثلما كان يشرف على تنفيذ ما تصدره القيادة من قرارات وتدابير، كالحث على تسجيل الأطفال بمدرسة القرية، وملاحقة الممتنعين عن ذلك من آباء في بداية الستينيات، عندما كانت المدرسة ما تزال (بدعة) من بقايا الاستعمار – في اعتقادهم – تعطل التحاق الأبناء بكتاتيب القرآن أو بالحقول لمساعدة آبائهم في أعمال الزراعة، وكتسجيل الأسر المعوزة في لوائح الاستفادة من المساعدات الغذائية التي تخصصها لهم الحكومة من الإعانات الواردة من الخارج. كان أبي مشغولا جدا؛ لذلك لم أعرف من شخصيته سوى هذا الجانب الرسمي الذي ساهم كثيراً في إضعاف العلاقة الحميمية التي ينبغي أن تربط بين الأب وابنه. وكانت عاطفة أبي – على وجه الدقة – مختفية في صرامته وحرصه على أن يتعلم أبناؤه.
وكان أبي يمتلك هيبة تنخلع لها قلوب الكبار قبل الصغار. ورث السلطة والهيبة عن والده الذي كان قائدا في الخمسينات. وأضاف إليها من خصوصياته التدبيرية ما جعله محط احترام الشيوخ والأعيان. لذلك كان يغيب كثيرا عن البيت في اجتماعات المجلس، وفي حضور المناسبات الوطنية، وفي البيت الثاني الذي تعيش فيه زوجته الأولى. وكنت أحبذ هذا الغياب وأجد فيه حرية تسمح لي بالانطلاق والمرح مع أترابي، خصوصا عندما أعود في إجازات الصيف الطويلة إلى القرية إذ كنت أدرس بالمدينة. فأمضي النهارات الحارة سابحا في نهر (ورغة) الكبير، وأجزاء طويلة من الليل في قراءات الروايات والكتب التي أشتريها من المدينة، وقد تمكنت في مدةقصيرة، أواسط السبعينيات، من قراءة كتب جبران كلها، والمنفلوطي، وجرجي زيدان، ونجيب محفوظ، وإحسان عبد القدوس، وروايات أخرى بالفرنسية. لقد تولى الكُتاب والأدباء تربيتي عوضا عن أبي الغائب في مشاغله الدائمة، فيما تكلفت أمي بإعطائي محبتها وحنانها وتعاطفها في محنتي مع أبي.
كانت عودة أبي إلى الدوار، أيام الجمعة، جحيما لا يطاق، فما إن يترجل عن بغلته الرعناء، حتى يحاسبني حسابا عسيرا على ما تناهى إلى سمعه من شغبي وتفريطي وإفراطي، ثم يأمرنيبحمل الفأس ومرافقته إلى الحقل لأقضي معه الساعات الطوال في تدبر أعمال السقي والحفر والغرس، في طقوس لا تخلو من تأنيب وتوبيخ. (نسخة مصغرة من الحساب والعقاب الذي تحدثت عنه الأديان السماوية).
لا أدري أين قرأت هذه القولة بعد أن صرت رجلا، وتمنيت لو عاش قائلها طفولتي: «إن غضب الأب من ابنه يعد أكثر شفقة وحنانا من الحب الذي يكنه الابن لأبيه..» لا أشكك في صدقية القولة، ولو فتحت قلب أبي في طفولتي لوجدته ينبض بكل حب لي ولبقية إخوتي، لكن أنى لنا أن نقنع رهافة مشاعر الطفولة بغلظة معنى هذه القولة! ما كان غائبا عن أبي رغم كاريزميتههو فن التواصل مع الطفل والطفولة، وهذه سمة مسحوبة على معظم الآباء من مجايليه.
وليت الأمر كان يقف عند معاملتي أنا ابنه بفضاضة وعنف،فما إن يهدأ من محاسبتي حتى يشتعل جحيم آخر بينه وبين أمي. فهي تتهمه بالغياب وإهمال أحوال البيت، وهو يتهمها بسوء تربية الأبناء وتدليلهم أكثر من الحد المسموح به. وغالبا ما كانت المعركة تنتهي بغضبةشرسةمن أبي، تكون سببا في مغادرته البيت والرجوع إلى البيت الثاني، حيث زوجته الأولى التي كانت أكثر صبرا وتحملا. أما أنا فلم أكن أخفي فرحي بهذا الفرج الذي أسمعه في اصطفاق الباب، وفي الكلمات النابية التي تخرج من فمه، وهو يجرُّ بغلته العنيدة، كي يغيب أسبوعا آخر قبل أن يحل يوم الجمعة المشؤوم. وكنتُ في فسحة الحرية،هاته، أعود إلى تفقد أحوال شخصيات الروايات التي كنت أقرأها بالتزامن، فأطمئن على علاقة أرمانوسة المصرية بحبيبها، وأشفق على يتيم المنفلوطي، وأدعو لرشدي نجيب محفوظ بالشفاء العاجل.
كنت في غياب أبي أجد اللذة التي وجدها (جاك بريفر)، عندما عبَّرعن سعادته بعيدا عن «الأب» في معارضة جميلة للنص المقدس:
« أبانا الذي في السماوات
امكث هناك
ولنبق ـ نحن ـ هنا فوق الأرض
التي تبدو أحيانا جميلة «
هل كان أبي قاسيا إلى هذه الدرجة؟ مؤكد أنه لم يكن أباً عاطفياً، لذلك لا أدخر أية ذكرى تجعلني أطمئن إلى كوني قد تمتعت بالحنان الأبوي إلا في أواخر أيام هذا الأب، عندما أصيب بالمرض الخبيث في أوائل عام 1981، فعدل المرض كثيرا من سلوكه وطباعه، وأنا الذي كنت موقنا من أن أية قوة، مهما علت، لن تنال من جبروته. أذكر بألم يوم رافقتأبي إلى الطبيب بمدينة فاس ليأخذ له صورا بالأشعة، فهالني أن أرى هيكلا عظميا يتحرك باتجاه آلة السكانير. كانت صدمة كبرى أن أرى تاريخا من القوة والعنف ينهار في لحظة واحدة، واعترتني حالة إشفاق كبير ورغبة في البكاء عندما انفردتُ بالطبيب الذي بدا مقطبا وهو يقول لي:
ينبغي أن تأخذوه إلى الدار البيضاء.
هل حالته صعبة، يا دكتور؟
نعم، إن المرض اللعين قد تمكن منه، والأمر يدعو إلى الاستعجال لبدء العلاج بالأشعة.
كم سيعيش يا دكتور؟
الله أعلم، وإن كنت أخمن بأن حالته المتقدمة في المرض لن تمهله أكثر من خمس سنوات. أرجوك لا تذكر له هذا الأمر.
لم يَصْدُق تخمين الطبيب، فقد تفاقمت حالته بعد أيام قليلة، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى الأورام بالدار البيضاء، حيث قضى شهورا من العذاب، وكان طوال المدة يطلب نقله إلى بيته بالقرية، حتى يضمن أن يدفن جثمانه هناك في التراب الذي أحبه ودافع عنه، وحتى يضمن ارتباط أبنائه وبناته بأرضهم بعد موته. كان يقول: على الأقل ستزورون قبري هناك.
مات أبيذات ربيع، ولم أتمكن من حضورجنازته، فقد كنت منشغلا بإعداد بحث الليسانس للطبع والاستعداد للامتحانات النهائية بالكلية، وكان بحثي في موضوع (البطولة في الشعر الجاهلي). فصدَّرت بحثه بعبارة الإهداء التالي:
(إلى أبي الذي علمني أصول البطولة…)
لم تسعفني وسائل النقل في أن ألحق طقوس الجنازة، فوصلتفي أواخر النهار، وأثناء مروري بالطريق التي تفصل بين محطة الوصول وبين البيت، لمحت كومةً من التراب الطري بين القبور، فحدست أن جثمان أبي يرقد تحتها، وقد تخلص من جحيم الداء اللعين. وما هي إلا لحظة حتى تلقفتني الأيدي والأذرع والأصوات المنتحبة في مدخل البيت، وكانت أستار الظلام تهزم ما تبقى من شمس يوم ربيعي مزدهر من عام 1982.
لقد أبعدني أبي إلى المدينة مطروداً من القرية (جنتي) بسبب المدرسة، وصار هو رجلاً صالحاً لأنه عرف الشيطان وأحابيله ومكره، وطوَّع امرأتيه بشظف العيش وقسوته، ومات.. ولا شك أنه عاد إلى الجنة من جديد غانماً كاسباً، ليجد فيها التفاح تفاحاً، لا لغماً ملتبساً بالخطيئة ولا أثر للثعابين في جذوع أشجاره. أما أنا، فقد تركني في متاهة بين الدروب الضيقة والأبواب القديمة المجروحة، لا أكاد أجد فيها المخرج حتى أفاجأ بمتاهة جديدة، ولا أكاد أتبين وجه الحقيقة حتى ينفتح أمامي كتاب الأسئلة، ولا أكاد أظفر ببهجة الإيمان، حتى تطاردني الشياطين قافزة من الواجهات والمقاهي ومخادع الهاتف والمكتبات وهي تصيح في وجهي:
عد إلى الأشجار المحظورة، فثمة من يتربص بقطعها!
هكذا كان.. إلى أن تأكد أبي من فشل المِعْول في يدي، فنزعه مني بقوة، والماء يجري بيني وبينه تائهاً عن هدفه في أحواض الأشجار، صارخا في وجهي:
– لو كان أجدادك يعبثون بالماء هكذا، لما ظللتك هذه الأشجار! اهبط المدينة فثمة قنواتٌ تُحْكِمُ القبض على الماء، وصنابير تعلمك الاحتياط في العطش، ولا تنس أن تُحْكِم القبض على الكتب، فمتنها ألطف من مقابض المعاول، وعلمُها أوسع من عطشك!
الكاتب : عبد السلام المُساوي
بتاريخ : 05/07/2019
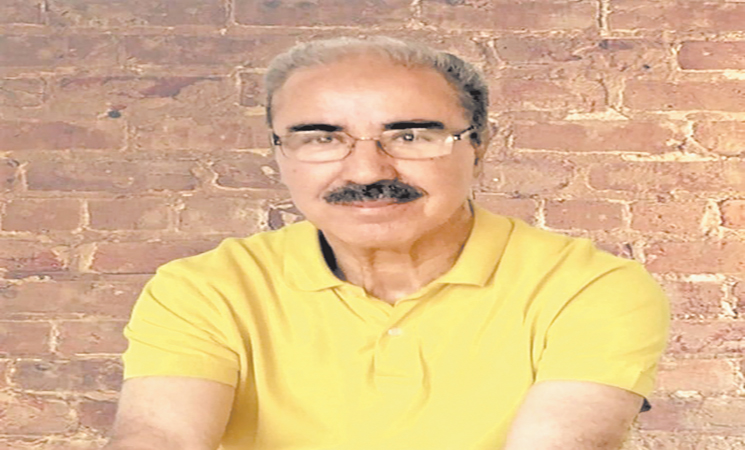
مبدعون في حضرة آبائهم 5 : عبد السلام الموساوي ، ان أبي يطارد طفولتي.. - AL ITIHAD
في رسالة كافكا إلى أبيه: « أبي الحبيب.. لقد سألتني مؤخراً: لماذا أزعم أنني أخاف منك؟ وكالعادة لم أدر بماذا
alittihad.info