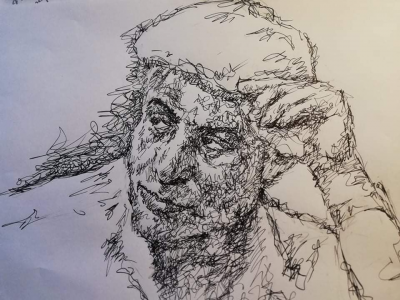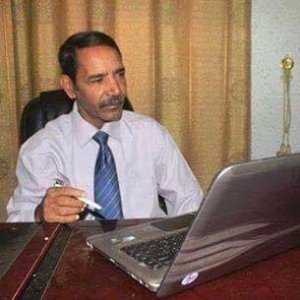1- تأمُّلات في واقع القصة القصيرة: قصتنا الفلسطينية مثالاً
عرفت الحركة الأدبية الفلسطينية القصة القصيرة منذ الربع الأول من القرن العشرين، فقد كانت أول مجموعة قصصية هي "مسارح الأذهان" (1924) لخليل بيدس. والطريف أن صاحبها الذي أصدر قبل أربع سنوات من إصدارها رواية، الطريف أنه صدرها بمقدمة عن الفن الروائي، لا عن فن القصة القصيرة، وثمة ما بين القصة القصيرة والرواية فوارق لا تخفى على الدارسين. هل اختلط الأمر على بيدس الذي لم يزد حجم روايته "الوارث" (1920) على مائة وعشرين صفحة؟ وهل "الوارث" أصلاً رواية أم أنها قصة طويلة؟
حتى العام 1948 صدرت مجموعات قصصية قليلة لا تزيد على عدد أصابع اليد، ولم يكن الكُتّاب، أيضاً، يزيدون على عدد أصابع اليد. "مسارح الأذهان" (1924) و"أول الشوط" (1937) و"قصص أخرى" (1944). بيدس والإيراني وعبد الحميد يس ونجاتي صدقي وعارف العزوني، والأخيران، حتى العام 1948 لم يصدرا أي مجموعة قصصية.
سيتوقف بيدس عن كتابة الرواية والقصة القصيرة، وسيموت في المنفى (1949)، فيما سيواصل صدقي والإيراني كتابة القصة القصيرة، وسيخلصان لها ولن يكتبا في أجناس أدبية أخرى كالشعر أو الرواية. وسيواصل، في المنفى، كتاب جدد كتابة القصة القصيرة: جبرا إبراهيم جبرا وسميرة عزام وغسان كنفاني. أصدر الأول مجموعة واحدة ثم طالب الكتّاب بالتحول عن كتابة القصة القصيرة إلى كتابة الرواية، وهذا ما فعله، فأصدر العديد من الروايات. لماذا تحول جبرا عن كتابة القصة القصيرة إلى الرواية؟ "القصة القصيرة فن سهل سريع، لا يستطيع استيعاب تجربته كما تستطيع الرواية ذلك" و"الرواية هي الفن الأصعب.. فأنا إذاً أطالب كتّابنا بالفن الأصعب".
لم تأخذ سميرة عزام برأي جبرا، فقد أخلصت لفن القصة القصيرة وأصدرت خمس مجموعات قصصية، وحاولت أن تكتب رواية غير أنها لم تكملها، واختلف عنها غسان كنفاني الذي بدأ قاصّاً يكتب القصة القصيرة، ثم تحول عن كتابتها ليكتب الرواية، وما أصدره في 60 ق 20، وما عكف على إنجازه في بداية 70 ق 20 ولم يُتمّه لاستشهاده، يقول لنا: إن غسان مال، مثل جبرا، إلى فن الرواية. هل زمننا هو زمن الرواية لا زمن القصة القصيرة؟ وهل الأمر يقتصر على الكتّاب الفلسطينيين؟
في العام 2011 ترجم السعودي ناصر الحجيلان كتاب (تشارلز ماي) القصة القصيرة: حقيقة الإبداع: نحو تقييم التطور التاريخي ودراسة الخصائص النوعية للقصة القصيرة" وفيه يثير المؤلف أسئلة عديدة حول واقع القصة القصيرة، وهي أسئلة لطالما أثيرت، أيضاً، من قبل، وتحديداً في النصف الأول من القرن العشرين، من ذلك مثلاً أنه في الأعوام 1909 و1913 و1917 صدرت ثلاثة كتب نظرية عن فن القصة القصيرة، وإثرها طالب عدد من القراء والنقاد بإنهاء هذا العمل، "فامتلأت الدوريات الجيدة بمقالات حول "انحطاط" القصة القصيرة و"تآكلها" و"خرفها". وقد أوجز (جيلبرت سيلدز) ردّات الفعل الأكثر تطرفاً في دورية "ذا ديال" عام 1922 حيث قال: "القصة الأميركية القصيرة على كل الأوجه هي العمل الفني الأضعف، والأسخف، الذي يعدم الدلالة في كل ما أنتج في هذه البلاد أو في أي بلاد أخرى" (ص 250).
هل كلام الناقد السابق كلام مبالغ فيه؟ وهل هو من أعداء القصة القصيرة؟
منذ ثلاثين عاماً وأنا أُتابع، كل عام، يوم الخميس، خبر إعلان اسم الفائز باسم جائزة (نوبل) للآداب، والجنس الأدبي الذي يكتب فيه. هل منحت، خلال هذه الأعوام، إلى كاتب قصة قصيرة؟ غالباً ما تمنح هذه الجائزة للرواية، وقليلاً ما تمنح للشعر، ونادراً، بل ونادراً جداً، ما تمنح للقصة القصيرة؟ لماذا؟ ألأن القصة القصيرة، قياساً إلى الشعر والرواية، فن حديث النشأة. تضرب جذور الشعر عميقاً في التاريخ، فيما تعود نشأة الرواية إلى خمسة قرون خلت، لا إلى قرن ونصف فقط، كما هو حال القصة القصيرة. أيعود الأمر إلى الانتشار والتوزيع وتلقّي القرّاء للأجناس الأدبية؟ كم تبيع الرواية؟ كم يبيع الشعر؟ كم تبيع القصة القصيرة؟ الرواية تبيع، إذا نجحت رواية، ملايين النسخ، وسرعان ما تترجم. الشعر لا يبيع، في أحسن الأحوال، بضعة آلاف نسخة، فكم تبيع القصة القصيرة، لأبرز كتّابها؟ مرة قرأت مقالاً لكاتب مصري يقول فيه: إن عدد كتّاب القصة القصيرة في مصر أكثر من عدد قرائها. وربما احتجنا إلى دراسة أدبية اجتماعية توضح لنا، هنا في فلسطين، عدد كتّاب القصة القصيرة، وعدد قرائها، وعدد النسخ التي تباع لأبرز كتّابها. سأجتهد قليلاً. أبرز شاعر فلسطيني هو محمود درويش، وأبرز روائيَّين فلسطينيين هما: غسان كنفاني وإميل حبيبي، وأبرز كاتبي قصة قصيرة في الضفة الغربية هما: محمود شقير وأكرم هنية؟ كم طبعة طبعت أعمال درويش، وكم طبعة طبعت روايات كنفاني وحبيبي، وكم طبعة طبعت أعمال شقير وهنية؟ وماذا عن تلقّي أشعار درويش وروايات كنفاني وحبيبي وقصص شقير وهنية نقدياً؟ ولا أُنكر أن قصص شقير وهنية لفتت أنظار النقاد، ولكنها قياساً إلى أشعار درويش وروايات كنفاني وحبيبي، لكنها ـ أعني الدراسات النقدية ـ تظلّ متواضعة.
أعود إلى نصيحة جبرا وتجربته "إن القصة القصيرة فن سهل إذا قُورن بالعمل الأكبر الرواية.. فأنا إذاً أطالب كتّابنا بالفن الأصعب". هل القصة القصيرة فن سهل والفن الأصعب هو الرواية؟ هل انطلق جبرا في حكمه من خلال تجربة شخصية أم من خلال قراءاته لتنظيرات كتّاب فن القصة القصيرة في الغرب، التنظيرات التي أشرت إليها آنفاً؟
أيّاً كان الأمر فإن نظرةً على مشهدنا القصصي الفلسطيني تقول لنا إن أكثر أدبائنا لبُّوا طلب جبرا، حتى وإن لم يكونوا قرأوه. ثمة عدد لا بأس به من كتّاب القصة القصيرة تحولوا إلى كتابة الرواية وهجروا القصة نهائياً، وثمة عدد لا بأس به ممن أخلصوا لفن القصة القصيرة لجأوا في العقد الأخير إلى كتابة عمل روائي، ولهذا دلالاته لا شك.
حبيبي وجبرا ويحيى يخلف وعزت الغزاوي هجروا عالم القصة القصيرة إلى عالم الرواية كلياً. هل يختلف عنهم، أيضاً، توفيق فياض؟
رشاد أبو شاور وليانة بدر وغريب عسقلاني ومحمد أيوب لم يتوقفوا عن كتابة القصة القصيرة، ولكنهم أصدروا أكثر من رواية، ومثلهم حنا إبراهيم، أيضاً.
محمود شقير ومحمد علي طه وأكرم هنية عُرفوا كتّاب قصة قصيرة بالدرجة الأولى، والأوّلان مالا إلى كتابة الرواية، فأصدرا عملاً روائياً. ولذلك دلالاته. وهناك مقولة تقول: إن زمننا هو زمن الرواية لا زمن الشعر، فهل هو زمن الرواية لا زمن القصة القصيرة، وللتأمُّلات بقيّة.
عادل الأسطة
2012-10-14
***
2- تأمّلات في واقع القصّة القصيرة (على هامش معرض الكتاب) هل أخلص كُتّاب القصّة القصيرة لها؟
إذا ما ألقى الدارس نظرةً على كُتّاب مجلة "الأفق الجديد" التي صدرت في 60 ق20 وتابع مسيرتهم ونهاياتهم فماذا يلاحظ؟ أبرز كُتّاب جيل "الأفق الجديد" هم خليل السواحري ومحمود شقير ويحيى يخلف وصبحي شحروري وفخري قعوار وماجد أبو شرار ونمر سرحان، وقد نضيف إليهم حكم بلعاوي. ولم يخلص للقصة القصيرة من الأسماء آنفة الذكر سوى اثنين شقير وقعوار، فما زالا يكتبان هذا الجنس الأدبي ولم ينصرفا عنه إلى مشاغل أخرى. أما الآخرون فما عادوا يكتبون القصة القصيرة، وإذا ما كتبوها كتبوها من وراء ظهرهم ولم يكتبوا نصوصاً تتميّز عن نصوصهم الأولى. كان خليل السواحري أصدر في نهاية 60 ق20 مجموعة متميزة هي "مقهى الباشورة"، وانقطع خمسة عشر عاماً عن كتابة القصة، ولما عاود كتابتها وأصدر "زائر المساء"، لم يضف جديداً، وحتى مجموعته التي أصدرها إثر عودته إلى الضفة، في بداية 90 ق20 لم تفق مجموعته الأولى. وكان يحيى يخلف أصدر في بدايات 70 ق20 مجموعتين قصصيتين هما "المهرة" و"نورما ورجل الثلج"، ثم انصرف عن كتابة القصة القصيرة إلى كتابة القصة الطويلة والرواية، فأصدر ما لا يقل عن ست روايات، وخلال كتابتها لم يكتب سوى قصص قصيرة لا تتجاوز عدد أصابع كف يد، ولم يصدرها في كتاب. ومع أن صبحي شحروري أصدر في 80 ق20 "المعطف القديم" وفي 90 ق20 "الداخل والخارج"، وفيما بعد مجموعة ثالثة، إلاّ أنه لم يلفت الأنظار كاتب قصة، كما لفتها ناقداً، وهكذا أشير إليه على أنه ناقد، لا على أنه كاتب قصة. أما ماجد أبو شرار الذي امتلك موهبة كتابة القصة، فقد انصرف عنها إلى عالم السياسة، وحين أصدر في نهاية 70 ق20 مجموعته "الخبز المر" جمع بين دفتيها ما كتبه على صفحات "الأفق الجديد". ولم يختلف حكم بلعاوي كثيراً عن شحروري وماجد. شغلته السياسة عن كتابة القصة، وإن عاد إليها بين حين وحين، ولم تثر مجموعاته أي صدى يُذكر. في 70 و80 ق20، في الضفة وقطاع غزة، لم تصدر سوى روايات قليلة، لكل من سحر خليفة وغريب عسقلاني. في تلك الفترة ازدهر الشعر وازدهرت القصة القصيرة، بل وصحبتهما حركة نقدية لا بأس بها. واصل محمود شقير كتابة القصة، وأصدر ـ رغم إبعاده ـ مجموعتين "خبز الآخرين" وأكثر قصصها كتبت قبل 1967، و"الولد الفلسطيني" (1977) واختلفت طريقته في الكتابة شكلاً وموضوعاً. وإلى جانب اسمه برز جيل جديد يكتب القصة: جمال بنورة وأكرم هنية وغريب عسقلاني وزكي العيلة ومحمد أيوب، وثمة أسماء أخرى أصدر أصحابها مجموعة أو مجموعتين ثم توقفوا عن الكتابة. ولئن واصل جمال بنورة إصدار العديد من المجموعات، ولئن فعل الشيء نفسه أكرم هنية، فأصدر حتى اللحظة ست مجموعات، فإن عسقلاني أخذ يميل إلى فن الرواية، أما العيلة وأيوب، فقد انصرفا إلى الدراسة الأكاديمية بالدرجة الأولى، وكتب أيوب الرواية، لا القصة القصيرة. وإذا كان شقير أخذ مؤخراً يكتب الرواية، وكان بنورة من قبل أصدر رواية، فإن أكرم هنية الذي شغلته السياسة، هو الوحيد الذي لم يكتب في غير جنس القصة القصيرة. ولو تأمّلنا في تجربة شقير على مدار خمسين عاماً وتتبعنا أعماله، فإننا سنلحظ أنه أخلص للقصة وحاول باستمرار أن يطور أدواته الكتابية. اجتهد وظلّ يجتهد، وحاول أن تكون كل مجموعة يصدرها مختلفة عن مجموعته السابقة، لكن هل حقق انتشاراً واسعاً كما حقق درويش انتشاراً في فن الشعر، وكما حقق حبيبي وكنفاني انتشاراً في باب الرواية؟ خيبة وصدمة: أعود إلى ما قرأته ذات نهار لناقد مصري عن تلقي القصة القصيرة: إن عدد كُتّاب القصة القصيرة، في مصر، يفوق عدد قرائها. وسأسند ما قاله ببعض تجربتي. أنا أدرّس الأدب الفلسطيني في الجامعة منذ ثلاثين عاماً، ولا أقتصر على الشعر أو الرواية. إنني أدرّس القصة القصيرة، أيضاً. غالباً ما أختار أعلاماً معروفين في هذا الجنس يمثلون بيئات مختلفة: زمانياً ومكانياً، وهكذا أدرّس نجاتي صدقي وسميرة عزام ومحمود درويش ومحمد علي طه أو توفيق فياض، وليانة بدر أو نجوى قعوار فرح وغريب عسقلاني وأكرم هنية. في بداية كل فصل دراسي، وأنا أوزع الخطة، أسأل الطلاب إن كانوا قرؤوا أي نص لأي من الأسماء الوارد ذكرها، والطلاب هم طلاب سنة رابعة تخصص أدب عربي، وغالباً، بل دائماً، ما أصدم، لأن أياً من الطلاب لا يعرف شيئاً عن الكتّاب ولم يقرأ لهم ـ للكتّاب. وذات فصل كنت أدرّس قصة يحيى يخلف "تلك المرأة الوردة"، وكان يومها وزيراً للثقافة، ودهشت من أنهم لم يسمعوا به، لا وزيراً ولا كاتباً. هل يمكن أن نسهم نحن أساتذة الجامعات بإنعاش فن القصة القصيرة وبعثه وازدهاره؟ أظن ذلك، وأعود إلى كتاب "القصة القصيرة: حقيقة الإبداع: نحو تقييم التطور التاريخي ودراسة الخصائص النوعية للقصة القصيرة" (2011) للمؤلف (د. تشارلز ماي). يذهب المؤلف إلى أن تأثير مدرسة النقد الجديد على أساتذة الجامعات جعلتهم يركزون انتباههم على تفسير القصص القصيرة المفردة بدلاً من الاهتمام بالسمات النمطية للشكل. (ص261). يذكر المؤلف هذا تحت عنوان فرعي هو "آثار قصر الشكل"، وأما أنا فأرى أن آثار قصر الشكل يمكن أن تنعكس، في مجتمعنا الذي لا يقرأ؛ إيجاباً. فلو كلف أستاذ جامعي طلابه قراءةَ رواية من مائتي صفحة، لشعر بالخيبة، لأنه سيلحظ أن أكثر الطلاب سيعتمدون على ملخّصات لها، أما إذا كلفهم قراءة قصة قصيرة وشدد على ضرورة القراءة، فإنهم سيلبون له طلبه، وسيقرؤون. وهكذا يمكن أن يسهم أساتذة الجامعات في ازدهار القصة القصيرة. التلقّي النقدي للقصة القصيرة: في 70 و80 و90 ق20 حظيت قصتنا القصيرة باهتمام نقدي لافت. أنجز محمود عباسي رسالة دكتوراه عنوانها "تطور القصة العربية في إسرائيل" وأنجزت رسالة ماجستير عنوانها "القصة القصيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة" (1982) وكتب صبحي شحروري مراجعات نقدية لافتة، ومثله نبيه القاسم، ثم محمود غنايم الذي أصدر كتابه المهم "المدار الصعب: رحلة القصة الفلسطينية في إسرائيل"، وأعد بعض طلاب الدراسات العليا رسائل ماجستير في أدب غير قاص (حنا إبراهيم، أكرم هنية، محمود شقير، ودرست قصص يخلف مع رواياته). هل واصل نقاد القصة القصيرة الاهتمام بها أم أنهم التفتوا إلى أجناس أدبية أخرى هي الشعر والرواية؟ أصدر شحروري كتابين في نقد الشعر، ودرس القاسم و(منيف) روائياً، وأخذت تصدر عشرات المجموعات القصصية لشباب دون الالتفات إلى أكثرها. وربما احتاج المرء إلى جردة حسابية لعدد الكتّاب الذين أصدروا مجموعة أو اثنتين ثم توقفوا عن مواصلة الكتابة، ربما لعدم الاهتمام بهم.
2012-10-23
عادل الأسطة
***
3- ^تأمُّلات في حركة القصة القصيرة
هل يدق آخر مسمار في نعش القصة القصيرة؟
في 80 ق20، وربما أسبق من ذلك بسنة أو اثنتين، قرأت مقالا تحت العنوان التالي: هل يدق آخر مسمار في نعش الشعر، وحجة صاحب المقال أن أبرز الشعراء، في باريس، قد لا يبيع ألف نسخة من ديوان شعره. وسيظل السؤال يراودني وأنا أتحدث عن الشعر، وإن كنت ألاحظ بعض الاستثناءات، فثمة شعراء قليلون تجاوزت مبيعات دواوينهم المليون نسخة.
في ندوة معرض الكتاب في رام الله (16/10/2012) سألت الناشر فتحي البس عن نفاد المجموعات القصصية التي يطبعها، وكانت إلى جانبي القاصة الأردنية بسمة النسور، فأجابني أنه طبع لبسمة أربع مجموعات منذ نهاية 80 ق20 وبدايات 90 ق20، وهي الآن توشك أن تنفد نسخها، ولم يتحدث عن طبعة ثانية.
وأنا أُمعن النظر في المجموعات القصصية لبعض كتّابنا ألحظ أن أكثرهم لم تطبع مجموعته أو مجموعاته أكثر من طبعة، وألحظ، أيضاً، أن هناك كتاباً وكاتبات أصدروا المجموعة الأولى، فكانت الأولى والأخيرة.
وكما ذكرت فمنهم من انشغل بأجناس أدبية أخرى أو تحول إليها، ومنهم من اكتفى بإصدار العمل الأول: فاطمة خليل حمد، وإلهام أبو غزالة، وماجد أبو شرار، ومحمد أبو النصر، وأحمد زيدان و... و... و... عز الدين القلق وجبرا ابراهيم جبرا ومحمد كمال جبر وعزت الغزاوي. وفي 70 ق20 أصدر القاص فضل الريماوي مجموعته الأولى "بياع السوس"، وكان يشارك في الحياة الأدبية مشاركة فعالة، وقد هجر الكتابة إلى التجارة، لا إلى الرواية مثل جبرا والغزاوي.
وأعود إلى السؤال: هل يدق آخر مسمار في نعش القصة القصيرة؟ ثمة أشكال أدبية عديدة ازدهرت ثم سادت ثم تلاشت. الحكاية والمقامة مثالان بارزان. هل ارتبطا بأشكال اجتماعية معينة فلما زالت زالت الحكاية والمقامة معهما، فالأخيرتان إفراز لشكل اجتماعي ما؟
هنا نتذكر رأي (جورج لوكاش) في اجتماعية الأشكال الأدبية: "لا تنشأ الأساليب الجديدة أو طرق القص الحديث أبداً من خلال جدل باطني للأشكال الفنية، حتى عندما تكون دائماً مرتبطة بالأشكال والأساليب القديمة، وينشأ كل أسلوب جديد مع الضرورة الاجتماعية التاريخية من الحياة، ويكون هذا نتيجة ضرورة للتطور الاجتماعي".
نشأت القصة القصيرة في ن2 من ق19، وكانت نشأتها ضرورية، فقد ازدهرت الصحف والمجلات، وازدهر التعليم والقراءة ولم يكن هناك منافس للكتّاب كما هي الحال في أيامنا. وتطورت الحياة وتغيرت وما عاد الكتاب وسيلة التثقيف الوحيدة، فهل ما ألم بالحكاية والمقامة ألم بالقصة القصيرة؟
في 70 ق20 في الضفة، بل وفي فلسطين المحتلة العام 1948، لم تكن هناك دور نشر تغامر بطباعة كتب، وكان على الكتاب أن ينشروا نتاجهم، ابتداءً في الصحف والمجلات وهكذا ازدهر الشعر وازدهرت القصة القصيرة، وحين جازفت دور النشر المحلية بطباعة كتب أخذت تطبع لأسماء معروفة. وربما تذكرنا ما رواه نجيب محفوظ في كتاب "نجيب محفوظ.. يتذكر" الذي أعده جمال الغيطاني.
حين سئل محفوظ عن قصصه القصيرة، وعن كونها مشاريع روايات، قال: إنها في الأصل روايات اختصرت إلى قصص قصيرة، وكثيرون لا يعرفون هذا. ويوضح محفوظ سبب اختصار رواياته إلى قصص قصيرة. كان يومها كاتباً ناشئاً، ولم تغامر دور النشر بنشر أية رواية له، لأنها قد تفلس، وهكذا اقترح عليه بعض الناشرين أن يختصر رواياته وينشرها في المجلات، وهذا ما كان.
والآن غدا الناشرون ينشرون الروايات، ويترددون في نشر المجموعات الشعرية والقصصية، إلا إذا كان صاحبها اسماً معروفاً. وكلنا يعرف أن هناك جوائز قيمة عربية للشعر وللرواية، مثل جائزة "البابطين" وجائزة "بوكر"، فهل ثمة جائزة على مستوى الوطن العربي للقصة القصيرة.
شعراء روائيون.. شعراء كتاب قصة قصيرة:
لعل من يتابع الأدب الفلسطيني منذ 40 ق20 يلحظ جنوح بعض الشعراء لكتابة الرواية (محمد العدناني وروايته "في السرير")، وسوف تتعزز هذه الظاهرة اللافتة بمرور السنوات: يوسف الخطيب وهارون هاشم رشيد وسميح القاسم وعلي الخليلي وأسعد الأسعد وغسان زقطان وزكريا محمد ومحمد القيسي، وقسم من هؤلاء أصدر أكثر من رواية، بل إن منهم من هجر الشعر كلياً إلى عالم الرواية مثل أسعد الأسعد. هل نقول الشيء نفسه عن إبراهيم نصر الله؟
وإذا ما تتبع الدارس تحول الشعراء إلى كتاب قصة قصيرة فهل يلحظ الشيء نفسه وبالمقدار نفسه؟
طبعاً هناك شعراء كتبوا القصة القصيرة وأصدروا مجموعة واحدة أو مجموعتين على أكثر تقدير، لكنهم لم يتميزوا في كتابة القصة ولم يهجروا عالم الشعر لأجلها، فقد ظلوا شعراء بالدرجة الأولى وأبرز هؤلاء فاروق مواسي والمتوكل طه.
قاصون جدد:
أعود إلى السؤال: هل ندق آخر مسمار في نعش القصة القصيرة يعتب عليّ بعض القاصين الجدد، مثل أحلام بشارات وأماني الجندي بأنني أقتصر في كتاباتي على أسماء محددة في عالم القصة القصيرة، وأنني لا ألتفت إلى الكتاب الجدد، وربما يكون هذا صحيحاً، لكنني أتساءل: هل قدم قاص جديد إضافات نوعية متميزة إلى ما قدمه شقير وهنية؟
مرة كتبت مقالاً عنوانه "محمود شقير وقصتنا القصيرة الفلسطينية" وأتيت في نهايته على القاص الشاب ـ في حينه ـ زياد خداش، وأوردت له قصة قصيرة جداً، لأربط بين "تجربته وتجربة شقير في هذا اللون، وحين أهداني أمين دراوشة مجموعتيه "الوادي أيضاً" (2001) و"الحاجة إلى البحر" (2007) تساءلت: هل أضاف جديداً إلى حركتنا القصصية؟
كان هاجس محمود درويش في الشعر، وهاجس أكرم هنية ومحمود شقير في القصة القصيرة، الإضافة النوعية، وربما تذكر المرء منهج (برونتير) التاريخي: ما هو موقع ما يكتب في لونه الأدبي؟ وحين أسأل قاصين جدداً إن كانوا قرؤوا، قبل أن يكتبوا، النتاج القصصي الفلسطيني، يعترف لي كثيرون بأنهم لم يفعلوا ذلك بعد ـ أعني: لم يمارسوا فعل قراءة السابق ليبنوا عليه. وربما هذا السبب، وأسباب أخرى، هي ما تجعلني أتردد في الكتابة عنهم: الانقطاع عن الكتابة لاحقاً والانصراف إلى جنس أدبي آخر، وأحياناً أقول: على الجيل الجديد أن يوجد معه نقاده، ولعلّني مخطئ، وأظن للتأمُّلات بقية!!
عادل الأسطة
2012-11-04
***
عرفت الحركة الأدبية الفلسطينية القصة القصيرة منذ الربع الأول من القرن العشرين، فقد كانت أول مجموعة قصصية هي "مسارح الأذهان" (1924) لخليل بيدس. والطريف أن صاحبها الذي أصدر قبل أربع سنوات من إصدارها رواية، الطريف أنه صدرها بمقدمة عن الفن الروائي، لا عن فن القصة القصيرة، وثمة ما بين القصة القصيرة والرواية فوارق لا تخفى على الدارسين. هل اختلط الأمر على بيدس الذي لم يزد حجم روايته "الوارث" (1920) على مائة وعشرين صفحة؟ وهل "الوارث" أصلاً رواية أم أنها قصة طويلة؟
حتى العام 1948 صدرت مجموعات قصصية قليلة لا تزيد على عدد أصابع اليد، ولم يكن الكُتّاب، أيضاً، يزيدون على عدد أصابع اليد. "مسارح الأذهان" (1924) و"أول الشوط" (1937) و"قصص أخرى" (1944). بيدس والإيراني وعبد الحميد يس ونجاتي صدقي وعارف العزوني، والأخيران، حتى العام 1948 لم يصدرا أي مجموعة قصصية.
سيتوقف بيدس عن كتابة الرواية والقصة القصيرة، وسيموت في المنفى (1949)، فيما سيواصل صدقي والإيراني كتابة القصة القصيرة، وسيخلصان لها ولن يكتبا في أجناس أدبية أخرى كالشعر أو الرواية. وسيواصل، في المنفى، كتاب جدد كتابة القصة القصيرة: جبرا إبراهيم جبرا وسميرة عزام وغسان كنفاني. أصدر الأول مجموعة واحدة ثم طالب الكتّاب بالتحول عن كتابة القصة القصيرة إلى كتابة الرواية، وهذا ما فعله، فأصدر العديد من الروايات. لماذا تحول جبرا عن كتابة القصة القصيرة إلى الرواية؟ "القصة القصيرة فن سهل سريع، لا يستطيع استيعاب تجربته كما تستطيع الرواية ذلك" و"الرواية هي الفن الأصعب.. فأنا إذاً أطالب كتّابنا بالفن الأصعب".
لم تأخذ سميرة عزام برأي جبرا، فقد أخلصت لفن القصة القصيرة وأصدرت خمس مجموعات قصصية، وحاولت أن تكتب رواية غير أنها لم تكملها، واختلف عنها غسان كنفاني الذي بدأ قاصّاً يكتب القصة القصيرة، ثم تحول عن كتابتها ليكتب الرواية، وما أصدره في 60 ق 20، وما عكف على إنجازه في بداية 70 ق 20 ولم يُتمّه لاستشهاده، يقول لنا: إن غسان مال، مثل جبرا، إلى فن الرواية. هل زمننا هو زمن الرواية لا زمن القصة القصيرة؟ وهل الأمر يقتصر على الكتّاب الفلسطينيين؟
في العام 2011 ترجم السعودي ناصر الحجيلان كتاب (تشارلز ماي) القصة القصيرة: حقيقة الإبداع: نحو تقييم التطور التاريخي ودراسة الخصائص النوعية للقصة القصيرة" وفيه يثير المؤلف أسئلة عديدة حول واقع القصة القصيرة، وهي أسئلة لطالما أثيرت، أيضاً، من قبل، وتحديداً في النصف الأول من القرن العشرين، من ذلك مثلاً أنه في الأعوام 1909 و1913 و1917 صدرت ثلاثة كتب نظرية عن فن القصة القصيرة، وإثرها طالب عدد من القراء والنقاد بإنهاء هذا العمل، "فامتلأت الدوريات الجيدة بمقالات حول "انحطاط" القصة القصيرة و"تآكلها" و"خرفها". وقد أوجز (جيلبرت سيلدز) ردّات الفعل الأكثر تطرفاً في دورية "ذا ديال" عام 1922 حيث قال: "القصة الأميركية القصيرة على كل الأوجه هي العمل الفني الأضعف، والأسخف، الذي يعدم الدلالة في كل ما أنتج في هذه البلاد أو في أي بلاد أخرى" (ص 250).
هل كلام الناقد السابق كلام مبالغ فيه؟ وهل هو من أعداء القصة القصيرة؟
منذ ثلاثين عاماً وأنا أُتابع، كل عام، يوم الخميس، خبر إعلان اسم الفائز باسم جائزة (نوبل) للآداب، والجنس الأدبي الذي يكتب فيه. هل منحت، خلال هذه الأعوام، إلى كاتب قصة قصيرة؟ غالباً ما تمنح هذه الجائزة للرواية، وقليلاً ما تمنح للشعر، ونادراً، بل ونادراً جداً، ما تمنح للقصة القصيرة؟ لماذا؟ ألأن القصة القصيرة، قياساً إلى الشعر والرواية، فن حديث النشأة. تضرب جذور الشعر عميقاً في التاريخ، فيما تعود نشأة الرواية إلى خمسة قرون خلت، لا إلى قرن ونصف فقط، كما هو حال القصة القصيرة. أيعود الأمر إلى الانتشار والتوزيع وتلقّي القرّاء للأجناس الأدبية؟ كم تبيع الرواية؟ كم يبيع الشعر؟ كم تبيع القصة القصيرة؟ الرواية تبيع، إذا نجحت رواية، ملايين النسخ، وسرعان ما تترجم. الشعر لا يبيع، في أحسن الأحوال، بضعة آلاف نسخة، فكم تبيع القصة القصيرة، لأبرز كتّابها؟ مرة قرأت مقالاً لكاتب مصري يقول فيه: إن عدد كتّاب القصة القصيرة في مصر أكثر من عدد قرائها. وربما احتجنا إلى دراسة أدبية اجتماعية توضح لنا، هنا في فلسطين، عدد كتّاب القصة القصيرة، وعدد قرائها، وعدد النسخ التي تباع لأبرز كتّابها. سأجتهد قليلاً. أبرز شاعر فلسطيني هو محمود درويش، وأبرز روائيَّين فلسطينيين هما: غسان كنفاني وإميل حبيبي، وأبرز كاتبي قصة قصيرة في الضفة الغربية هما: محمود شقير وأكرم هنية؟ كم طبعة طبعت أعمال درويش، وكم طبعة طبعت روايات كنفاني وحبيبي، وكم طبعة طبعت أعمال شقير وهنية؟ وماذا عن تلقّي أشعار درويش وروايات كنفاني وحبيبي وقصص شقير وهنية نقدياً؟ ولا أُنكر أن قصص شقير وهنية لفتت أنظار النقاد، ولكنها قياساً إلى أشعار درويش وروايات كنفاني وحبيبي، لكنها ـ أعني الدراسات النقدية ـ تظلّ متواضعة.
أعود إلى نصيحة جبرا وتجربته "إن القصة القصيرة فن سهل إذا قُورن بالعمل الأكبر الرواية.. فأنا إذاً أطالب كتّابنا بالفن الأصعب". هل القصة القصيرة فن سهل والفن الأصعب هو الرواية؟ هل انطلق جبرا في حكمه من خلال تجربة شخصية أم من خلال قراءاته لتنظيرات كتّاب فن القصة القصيرة في الغرب، التنظيرات التي أشرت إليها آنفاً؟
أيّاً كان الأمر فإن نظرةً على مشهدنا القصصي الفلسطيني تقول لنا إن أكثر أدبائنا لبُّوا طلب جبرا، حتى وإن لم يكونوا قرأوه. ثمة عدد لا بأس به من كتّاب القصة القصيرة تحولوا إلى كتابة الرواية وهجروا القصة نهائياً، وثمة عدد لا بأس به ممن أخلصوا لفن القصة القصيرة لجأوا في العقد الأخير إلى كتابة عمل روائي، ولهذا دلالاته لا شك.
حبيبي وجبرا ويحيى يخلف وعزت الغزاوي هجروا عالم القصة القصيرة إلى عالم الرواية كلياً. هل يختلف عنهم، أيضاً، توفيق فياض؟
رشاد أبو شاور وليانة بدر وغريب عسقلاني ومحمد أيوب لم يتوقفوا عن كتابة القصة القصيرة، ولكنهم أصدروا أكثر من رواية، ومثلهم حنا إبراهيم، أيضاً.
محمود شقير ومحمد علي طه وأكرم هنية عُرفوا كتّاب قصة قصيرة بالدرجة الأولى، والأوّلان مالا إلى كتابة الرواية، فأصدرا عملاً روائياً. ولذلك دلالاته. وهناك مقولة تقول: إن زمننا هو زمن الرواية لا زمن الشعر، فهل هو زمن الرواية لا زمن القصة القصيرة، وللتأمُّلات بقيّة.
عادل الأسطة
2012-10-14
***
2- تأمّلات في واقع القصّة القصيرة (على هامش معرض الكتاب) هل أخلص كُتّاب القصّة القصيرة لها؟
إذا ما ألقى الدارس نظرةً على كُتّاب مجلة "الأفق الجديد" التي صدرت في 60 ق20 وتابع مسيرتهم ونهاياتهم فماذا يلاحظ؟ أبرز كُتّاب جيل "الأفق الجديد" هم خليل السواحري ومحمود شقير ويحيى يخلف وصبحي شحروري وفخري قعوار وماجد أبو شرار ونمر سرحان، وقد نضيف إليهم حكم بلعاوي. ولم يخلص للقصة القصيرة من الأسماء آنفة الذكر سوى اثنين شقير وقعوار، فما زالا يكتبان هذا الجنس الأدبي ولم ينصرفا عنه إلى مشاغل أخرى. أما الآخرون فما عادوا يكتبون القصة القصيرة، وإذا ما كتبوها كتبوها من وراء ظهرهم ولم يكتبوا نصوصاً تتميّز عن نصوصهم الأولى. كان خليل السواحري أصدر في نهاية 60 ق20 مجموعة متميزة هي "مقهى الباشورة"، وانقطع خمسة عشر عاماً عن كتابة القصة، ولما عاود كتابتها وأصدر "زائر المساء"، لم يضف جديداً، وحتى مجموعته التي أصدرها إثر عودته إلى الضفة، في بداية 90 ق20 لم تفق مجموعته الأولى. وكان يحيى يخلف أصدر في بدايات 70 ق20 مجموعتين قصصيتين هما "المهرة" و"نورما ورجل الثلج"، ثم انصرف عن كتابة القصة القصيرة إلى كتابة القصة الطويلة والرواية، فأصدر ما لا يقل عن ست روايات، وخلال كتابتها لم يكتب سوى قصص قصيرة لا تتجاوز عدد أصابع كف يد، ولم يصدرها في كتاب. ومع أن صبحي شحروري أصدر في 80 ق20 "المعطف القديم" وفي 90 ق20 "الداخل والخارج"، وفيما بعد مجموعة ثالثة، إلاّ أنه لم يلفت الأنظار كاتب قصة، كما لفتها ناقداً، وهكذا أشير إليه على أنه ناقد، لا على أنه كاتب قصة. أما ماجد أبو شرار الذي امتلك موهبة كتابة القصة، فقد انصرف عنها إلى عالم السياسة، وحين أصدر في نهاية 70 ق20 مجموعته "الخبز المر" جمع بين دفتيها ما كتبه على صفحات "الأفق الجديد". ولم يختلف حكم بلعاوي كثيراً عن شحروري وماجد. شغلته السياسة عن كتابة القصة، وإن عاد إليها بين حين وحين، ولم تثر مجموعاته أي صدى يُذكر. في 70 و80 ق20، في الضفة وقطاع غزة، لم تصدر سوى روايات قليلة، لكل من سحر خليفة وغريب عسقلاني. في تلك الفترة ازدهر الشعر وازدهرت القصة القصيرة، بل وصحبتهما حركة نقدية لا بأس بها. واصل محمود شقير كتابة القصة، وأصدر ـ رغم إبعاده ـ مجموعتين "خبز الآخرين" وأكثر قصصها كتبت قبل 1967، و"الولد الفلسطيني" (1977) واختلفت طريقته في الكتابة شكلاً وموضوعاً. وإلى جانب اسمه برز جيل جديد يكتب القصة: جمال بنورة وأكرم هنية وغريب عسقلاني وزكي العيلة ومحمد أيوب، وثمة أسماء أخرى أصدر أصحابها مجموعة أو مجموعتين ثم توقفوا عن الكتابة. ولئن واصل جمال بنورة إصدار العديد من المجموعات، ولئن فعل الشيء نفسه أكرم هنية، فأصدر حتى اللحظة ست مجموعات، فإن عسقلاني أخذ يميل إلى فن الرواية، أما العيلة وأيوب، فقد انصرفا إلى الدراسة الأكاديمية بالدرجة الأولى، وكتب أيوب الرواية، لا القصة القصيرة. وإذا كان شقير أخذ مؤخراً يكتب الرواية، وكان بنورة من قبل أصدر رواية، فإن أكرم هنية الذي شغلته السياسة، هو الوحيد الذي لم يكتب في غير جنس القصة القصيرة. ولو تأمّلنا في تجربة شقير على مدار خمسين عاماً وتتبعنا أعماله، فإننا سنلحظ أنه أخلص للقصة وحاول باستمرار أن يطور أدواته الكتابية. اجتهد وظلّ يجتهد، وحاول أن تكون كل مجموعة يصدرها مختلفة عن مجموعته السابقة، لكن هل حقق انتشاراً واسعاً كما حقق درويش انتشاراً في فن الشعر، وكما حقق حبيبي وكنفاني انتشاراً في باب الرواية؟ خيبة وصدمة: أعود إلى ما قرأته ذات نهار لناقد مصري عن تلقي القصة القصيرة: إن عدد كُتّاب القصة القصيرة، في مصر، يفوق عدد قرائها. وسأسند ما قاله ببعض تجربتي. أنا أدرّس الأدب الفلسطيني في الجامعة منذ ثلاثين عاماً، ولا أقتصر على الشعر أو الرواية. إنني أدرّس القصة القصيرة، أيضاً. غالباً ما أختار أعلاماً معروفين في هذا الجنس يمثلون بيئات مختلفة: زمانياً ومكانياً، وهكذا أدرّس نجاتي صدقي وسميرة عزام ومحمود درويش ومحمد علي طه أو توفيق فياض، وليانة بدر أو نجوى قعوار فرح وغريب عسقلاني وأكرم هنية. في بداية كل فصل دراسي، وأنا أوزع الخطة، أسأل الطلاب إن كانوا قرؤوا أي نص لأي من الأسماء الوارد ذكرها، والطلاب هم طلاب سنة رابعة تخصص أدب عربي، وغالباً، بل دائماً، ما أصدم، لأن أياً من الطلاب لا يعرف شيئاً عن الكتّاب ولم يقرأ لهم ـ للكتّاب. وذات فصل كنت أدرّس قصة يحيى يخلف "تلك المرأة الوردة"، وكان يومها وزيراً للثقافة، ودهشت من أنهم لم يسمعوا به، لا وزيراً ولا كاتباً. هل يمكن أن نسهم نحن أساتذة الجامعات بإنعاش فن القصة القصيرة وبعثه وازدهاره؟ أظن ذلك، وأعود إلى كتاب "القصة القصيرة: حقيقة الإبداع: نحو تقييم التطور التاريخي ودراسة الخصائص النوعية للقصة القصيرة" (2011) للمؤلف (د. تشارلز ماي). يذهب المؤلف إلى أن تأثير مدرسة النقد الجديد على أساتذة الجامعات جعلتهم يركزون انتباههم على تفسير القصص القصيرة المفردة بدلاً من الاهتمام بالسمات النمطية للشكل. (ص261). يذكر المؤلف هذا تحت عنوان فرعي هو "آثار قصر الشكل"، وأما أنا فأرى أن آثار قصر الشكل يمكن أن تنعكس، في مجتمعنا الذي لا يقرأ؛ إيجاباً. فلو كلف أستاذ جامعي طلابه قراءةَ رواية من مائتي صفحة، لشعر بالخيبة، لأنه سيلحظ أن أكثر الطلاب سيعتمدون على ملخّصات لها، أما إذا كلفهم قراءة قصة قصيرة وشدد على ضرورة القراءة، فإنهم سيلبون له طلبه، وسيقرؤون. وهكذا يمكن أن يسهم أساتذة الجامعات في ازدهار القصة القصيرة. التلقّي النقدي للقصة القصيرة: في 70 و80 و90 ق20 حظيت قصتنا القصيرة باهتمام نقدي لافت. أنجز محمود عباسي رسالة دكتوراه عنوانها "تطور القصة العربية في إسرائيل" وأنجزت رسالة ماجستير عنوانها "القصة القصيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة" (1982) وكتب صبحي شحروري مراجعات نقدية لافتة، ومثله نبيه القاسم، ثم محمود غنايم الذي أصدر كتابه المهم "المدار الصعب: رحلة القصة الفلسطينية في إسرائيل"، وأعد بعض طلاب الدراسات العليا رسائل ماجستير في أدب غير قاص (حنا إبراهيم، أكرم هنية، محمود شقير، ودرست قصص يخلف مع رواياته). هل واصل نقاد القصة القصيرة الاهتمام بها أم أنهم التفتوا إلى أجناس أدبية أخرى هي الشعر والرواية؟ أصدر شحروري كتابين في نقد الشعر، ودرس القاسم و(منيف) روائياً، وأخذت تصدر عشرات المجموعات القصصية لشباب دون الالتفات إلى أكثرها. وربما احتاج المرء إلى جردة حسابية لعدد الكتّاب الذين أصدروا مجموعة أو اثنتين ثم توقفوا عن مواصلة الكتابة، ربما لعدم الاهتمام بهم.
2012-10-23
عادل الأسطة
***
3- ^تأمُّلات في حركة القصة القصيرة
هل يدق آخر مسمار في نعش القصة القصيرة؟
في 80 ق20، وربما أسبق من ذلك بسنة أو اثنتين، قرأت مقالا تحت العنوان التالي: هل يدق آخر مسمار في نعش الشعر، وحجة صاحب المقال أن أبرز الشعراء، في باريس، قد لا يبيع ألف نسخة من ديوان شعره. وسيظل السؤال يراودني وأنا أتحدث عن الشعر، وإن كنت ألاحظ بعض الاستثناءات، فثمة شعراء قليلون تجاوزت مبيعات دواوينهم المليون نسخة.
في ندوة معرض الكتاب في رام الله (16/10/2012) سألت الناشر فتحي البس عن نفاد المجموعات القصصية التي يطبعها، وكانت إلى جانبي القاصة الأردنية بسمة النسور، فأجابني أنه طبع لبسمة أربع مجموعات منذ نهاية 80 ق20 وبدايات 90 ق20، وهي الآن توشك أن تنفد نسخها، ولم يتحدث عن طبعة ثانية.
وأنا أُمعن النظر في المجموعات القصصية لبعض كتّابنا ألحظ أن أكثرهم لم تطبع مجموعته أو مجموعاته أكثر من طبعة، وألحظ، أيضاً، أن هناك كتاباً وكاتبات أصدروا المجموعة الأولى، فكانت الأولى والأخيرة.
وكما ذكرت فمنهم من انشغل بأجناس أدبية أخرى أو تحول إليها، ومنهم من اكتفى بإصدار العمل الأول: فاطمة خليل حمد، وإلهام أبو غزالة، وماجد أبو شرار، ومحمد أبو النصر، وأحمد زيدان و... و... و... عز الدين القلق وجبرا ابراهيم جبرا ومحمد كمال جبر وعزت الغزاوي. وفي 70 ق20 أصدر القاص فضل الريماوي مجموعته الأولى "بياع السوس"، وكان يشارك في الحياة الأدبية مشاركة فعالة، وقد هجر الكتابة إلى التجارة، لا إلى الرواية مثل جبرا والغزاوي.
وأعود إلى السؤال: هل يدق آخر مسمار في نعش القصة القصيرة؟ ثمة أشكال أدبية عديدة ازدهرت ثم سادت ثم تلاشت. الحكاية والمقامة مثالان بارزان. هل ارتبطا بأشكال اجتماعية معينة فلما زالت زالت الحكاية والمقامة معهما، فالأخيرتان إفراز لشكل اجتماعي ما؟
هنا نتذكر رأي (جورج لوكاش) في اجتماعية الأشكال الأدبية: "لا تنشأ الأساليب الجديدة أو طرق القص الحديث أبداً من خلال جدل باطني للأشكال الفنية، حتى عندما تكون دائماً مرتبطة بالأشكال والأساليب القديمة، وينشأ كل أسلوب جديد مع الضرورة الاجتماعية التاريخية من الحياة، ويكون هذا نتيجة ضرورة للتطور الاجتماعي".
نشأت القصة القصيرة في ن2 من ق19، وكانت نشأتها ضرورية، فقد ازدهرت الصحف والمجلات، وازدهر التعليم والقراءة ولم يكن هناك منافس للكتّاب كما هي الحال في أيامنا. وتطورت الحياة وتغيرت وما عاد الكتاب وسيلة التثقيف الوحيدة، فهل ما ألم بالحكاية والمقامة ألم بالقصة القصيرة؟
في 70 ق20 في الضفة، بل وفي فلسطين المحتلة العام 1948، لم تكن هناك دور نشر تغامر بطباعة كتب، وكان على الكتاب أن ينشروا نتاجهم، ابتداءً في الصحف والمجلات وهكذا ازدهر الشعر وازدهرت القصة القصيرة، وحين جازفت دور النشر المحلية بطباعة كتب أخذت تطبع لأسماء معروفة. وربما تذكرنا ما رواه نجيب محفوظ في كتاب "نجيب محفوظ.. يتذكر" الذي أعده جمال الغيطاني.
حين سئل محفوظ عن قصصه القصيرة، وعن كونها مشاريع روايات، قال: إنها في الأصل روايات اختصرت إلى قصص قصيرة، وكثيرون لا يعرفون هذا. ويوضح محفوظ سبب اختصار رواياته إلى قصص قصيرة. كان يومها كاتباً ناشئاً، ولم تغامر دور النشر بنشر أية رواية له، لأنها قد تفلس، وهكذا اقترح عليه بعض الناشرين أن يختصر رواياته وينشرها في المجلات، وهذا ما كان.
والآن غدا الناشرون ينشرون الروايات، ويترددون في نشر المجموعات الشعرية والقصصية، إلا إذا كان صاحبها اسماً معروفاً. وكلنا يعرف أن هناك جوائز قيمة عربية للشعر وللرواية، مثل جائزة "البابطين" وجائزة "بوكر"، فهل ثمة جائزة على مستوى الوطن العربي للقصة القصيرة.
شعراء روائيون.. شعراء كتاب قصة قصيرة:
لعل من يتابع الأدب الفلسطيني منذ 40 ق20 يلحظ جنوح بعض الشعراء لكتابة الرواية (محمد العدناني وروايته "في السرير")، وسوف تتعزز هذه الظاهرة اللافتة بمرور السنوات: يوسف الخطيب وهارون هاشم رشيد وسميح القاسم وعلي الخليلي وأسعد الأسعد وغسان زقطان وزكريا محمد ومحمد القيسي، وقسم من هؤلاء أصدر أكثر من رواية، بل إن منهم من هجر الشعر كلياً إلى عالم الرواية مثل أسعد الأسعد. هل نقول الشيء نفسه عن إبراهيم نصر الله؟
وإذا ما تتبع الدارس تحول الشعراء إلى كتاب قصة قصيرة فهل يلحظ الشيء نفسه وبالمقدار نفسه؟
طبعاً هناك شعراء كتبوا القصة القصيرة وأصدروا مجموعة واحدة أو مجموعتين على أكثر تقدير، لكنهم لم يتميزوا في كتابة القصة ولم يهجروا عالم الشعر لأجلها، فقد ظلوا شعراء بالدرجة الأولى وأبرز هؤلاء فاروق مواسي والمتوكل طه.
قاصون جدد:
أعود إلى السؤال: هل ندق آخر مسمار في نعش القصة القصيرة يعتب عليّ بعض القاصين الجدد، مثل أحلام بشارات وأماني الجندي بأنني أقتصر في كتاباتي على أسماء محددة في عالم القصة القصيرة، وأنني لا ألتفت إلى الكتاب الجدد، وربما يكون هذا صحيحاً، لكنني أتساءل: هل قدم قاص جديد إضافات نوعية متميزة إلى ما قدمه شقير وهنية؟
مرة كتبت مقالاً عنوانه "محمود شقير وقصتنا القصيرة الفلسطينية" وأتيت في نهايته على القاص الشاب ـ في حينه ـ زياد خداش، وأوردت له قصة قصيرة جداً، لأربط بين "تجربته وتجربة شقير في هذا اللون، وحين أهداني أمين دراوشة مجموعتيه "الوادي أيضاً" (2001) و"الحاجة إلى البحر" (2007) تساءلت: هل أضاف جديداً إلى حركتنا القصصية؟
كان هاجس محمود درويش في الشعر، وهاجس أكرم هنية ومحمود شقير في القصة القصيرة، الإضافة النوعية، وربما تذكر المرء منهج (برونتير) التاريخي: ما هو موقع ما يكتب في لونه الأدبي؟ وحين أسأل قاصين جدداً إن كانوا قرؤوا، قبل أن يكتبوا، النتاج القصصي الفلسطيني، يعترف لي كثيرون بأنهم لم يفعلوا ذلك بعد ـ أعني: لم يمارسوا فعل قراءة السابق ليبنوا عليه. وربما هذا السبب، وأسباب أخرى، هي ما تجعلني أتردد في الكتابة عنهم: الانقطاع عن الكتابة لاحقاً والانصراف إلى جنس أدبي آخر، وأحياناً أقول: على الجيل الجديد أن يوجد معه نقاده، ولعلّني مخطئ، وأظن للتأمُّلات بقية!!
عادل الأسطة
2012-11-04
***