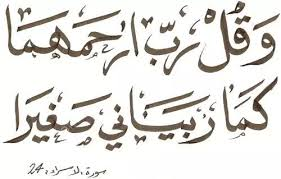الآن، وقد هدأ كل شئ الا من هذا اللهيب الذي لم يزدد داخلي الا تأججا، اصطدم بالحقيقة. حقيقة ان أمي توارت خلف شئ ما، و اقيم بينها وبين الوجود ستار سميك. ستار اتخيله متمركزا في مكان ما، ابحث عنه بإصرار و بداخلي قوة اتصورها قادرة على اختراقه، فأمد يدي، و أنتشل أمي ، وأعيد اليها الحياة.
أوالي بحثي. ينتابني العياء. وفي لحظة استرخاء، وحين أعي اني أدق بقوة الحد الفاصل بين التعقل و الجنون، أتمرد على التصنيفات و الاسماء. لا يهم بم سأسمى بقدر ما يهم ان استرد الحضن الذي كان يمنحني كل شئ. الدفء والاحلام. الامن والامل. أبواب كانت تنفتح. رحاب كانت تمتد. روعة لا توصف. و بنفسي كنت القي، مهزوما او ظافرا. سعيدا او مكلوما. ومع كل هبة نسيم او مسحة حنونة، وفي كل نفس دافئ او تمريرة لطيفة، كانت الجراح تندمل، و تعاود الروح زواجها بالجسد. والى الحياة قوية تعود.
انظر حوالي باحثا عن اشارة. وميض. بوابة يمتد خلفها ممر يفضي الى دهاليز الغيب حيث تقبع امي أسيرة. لا يتراءى لناظري غير الفراغ والصمت. استرجع تفاصيل اللحظة الرهيبة حين نفثت امي نفسها الاخير في ذلك الصباح الباكر. هل انتهت حقا ؟ هل صار كل ما كانت مجرد خيالات بعيدة ؟
تتأجج انتفاضة رفضي للحقيقة. يخمدها بسرعة ذلك الخصم العنيد الذي لا ادرك له شكلا ولا لونا. ابحث من جديد. تتراءى لي الحياة. هذا اللغز. هذه الإكذوبة التي تستمد سحرها و روعتها من قدرتها على خداع الجميع. أتساءل ماذا لو كانت الحياة جسدا؟ شريطا تلمسه الايادي ؟ أكيد ان كل الذين انهارت قلاعهم الخلفية وقحلت الحدائق التي كانت تصنع صمودهم و تبني شموخ ارواحهم كانوا سيهبون لنجدتي، و نوقف سويا انسكاب الحياة الى الامام. لكن ماذا يجدي الآن التمني وامي قد راحت و انتهت ؟
اولي وجهتي. انظر الى هناك حيث مسافات نسجت رحابها السنون، وتموجات صنعت التواءاتها العقود، وحيث يلوح في النهاية شط أسود. وقبالته تتعالى اعمدة دخان. سفينة قادمة. ربانها لم يكن في حاجة الى منظار لتلمس مساره. عيناه الصغيرتان كانتا قادرتان على تلمس مسالك العصور القادمة . و حرارة أنفاسه كانت تمد محركات السفينة بكل ما كانت في حاجة اليه من طاقة .
ركاب السفينة لم يعرفوا شيئا عن رحلتهم. الربان كان قد نذرهم لشئ آخر غير مواجهة القراصنة الذين تناثروا في كل مكان من مسار الرحلة. لم يعرفوا انهم في محطات كثيرة كادوا أن يصبحوا رقيقا. كما لم يسمح لهم برؤية الدماء التي نزفت منه حين اصابته سهام مسمومة. كان يفعل كل شئ ليجنب الركاب الاحساس بالخطر. وحين كان يطمئن، كان يلجأ لمقصورته. يُحكم خلفه اغلاق الباب. ينزع قناعه و يبكي.
نشيجه كان يعلو أحيانا حتى على أصوات المحركات و هدير الموج. و دموعه كانت تذرف بسخاء. وعند قدميه كانت تتجمع لتشكل بركا. وعلى صفحاتها كانت تلوح صور كثيرة .. ملامح وجوه توارت. عقد انفرط. اخوة تقاتلوا. أحقاد تأججت.أيتام لا حضن يدفئهم. دنيا شرسة جوعت ضعافها لتتخم جبابرتها. دساتير انقلبت فصولها حبالا التفت حول أعناق بؤساء طالبوا بحق العيش.
صور كانت ترعب الربان فيهرع لمغادرة المقصورة و يطوف السفينة متفقدا أعناق الركاب واحدا واحدا. وبعدها كان يعود للسطح. ينظر الى السماء باحثا عن علامة تنبئ بنهاية الطوفان .
بحث تحول الى تأمل شَغَلهُ عن كل شئ. وحين بارحه الشرود، كان هناك على الشط الاسود ملقى امام حطام سفينته. أي نوع من أنواع التنويم كان تحت تأثيره ؟ لم يهتم بالسؤال، لكن الذي شغله حقا كان معرفة مصير الركاب. جرى في كل الاتجاهات، أوصل صوته كل البقاع. وحين قرر شنق نفسه بسبب تقصيره، لم يجد نفسه في حاجة الى حبال. كان ما رآه كافيا كي يوقف نبض فؤاده. رأى ركاب سفينته، كل الركاب ماضين في رحلة معاكسة في يخوت تسطع منها الضياء و تشع منها الحياة. حاول ان يفعل شيئا، أن يشعرهم بوجوده، أن ينبههم الى مكانه، لكن الظلام كان مطبقا، فكر في ان يجري في اتجاه الشط. لكن ساقيه لم تتحملا ثقله، بدأ يصرخ. يصيح صيحات ابتلعها هدير الموج، و اتلفتها اصوات المحركات. بعدَها، قرفص امام حطام السفينة و راح يتابع الضياء وهي تختفي في عمق البحر .
لكن ها هو ذلك الربان الآن، هاهي أمي قد توغلت في مسار احتضارها الطويل او نفقِ انفصال الروح عن الجسد. من الذي اتخذ القرار الحاسم ؟ هل كانت الروح هي التي سعت الى نقائها متخلصة من جسد متعفن منهك، أم كان الجسد هو الذي رغب في اندثاره منتفضا ضد استمرارية الصمود و الاستسلام فيها لم يكونا ليعنيا له في النهاية سوى شيئا واحدا؟
هلوساتها لم تحمل اية اجابة، لكنها من عمق رحلتها احيانا كانت تعود. تستفيق. تتفحص الوجوه وتسأل.الازمنة لم يكن لها معنى ولا كان لأعمار المتحلقين حولها. وبين عمر يمشي قدما الى نهايته ورغبة في معاكسة المسار، كان رجاء يعلو. تتشبث بأشياء لم يكن لها تجسيد. وحين كانت تعي ان يديها لا تلويان على شئ، و أنها ماضية في انزلاقها الى التلاشي، كانت تتحصن من الموت في عمق طفولتها ....
استفاقت في المرة الأخيرة، تفحصت الوجوه، ركزت عينيها في عيني، روعتني نظرتها. كان فيها كل حرارة الوداع الأبدي. استمرت في حوارها الصامت. عتاب قاس رسمته في البداية وهي تضغط على مكان الداء. ثم أبلغتني في عجالة خلاصة درسها الأخير: "مهما تعش، مهما تكدح، مهما تحلم، فيوما ما، قريبا او بعيدا، ستدخل هذا النفق".
لكن بالرغم من ذلك فقد كان في عينيها رجاء و توسلات. وحين أدركت ان لا يداي ولا ايادي غيري قادرة على انتشالها من ما هي ماضية إليه، أدارت وجهها الى الشط الآخر و مضت.
صرخت غير مصدق انها انتهت الى الابد. حاولت ان افعل شيئا. ان اتمسك بها. ان اثنيها على الرحيل.ان اتعلق باذيالها كما كنت افعل صغيرا. ضغطت على يديها. أصغيت لانفاسها صرخت في اذنيها، انتصبت امامي الحقيقة بصرامتها و غلظة أفادت ان كل ما يتصل بالامومة صار شيئا من الماضي.
هو الموت إذا. لكنه لم يكن طائرا كاسرا اسود كما تخيلته دوما. و الحصانة التي كنت قد نسجتها بوجداني ووضعت في جوفها من أحببتهم لم تصمد.. انهارت وضرب الموت بقوة، و ارتفع نحيب النسوة بايقاع حاد يمزق الأفئدة و يعري حقيقة يعيش الانسان ليعاندها، لكنها في النهاية تخرسه ثم تلغيه.
رهبة لم يوازيها الا نشيد الموت الذي ردده الكبار بأصوات عادلت مفعول الموت نفسه. الموت الذي رسم ظلالا قاتمة على الوجوه، ونطقت به ملامح كل من هو على موعد للعبور الى الشط الآخر.
أوالي بحثي. ينتابني العياء. وفي لحظة استرخاء، وحين أعي اني أدق بقوة الحد الفاصل بين التعقل و الجنون، أتمرد على التصنيفات و الاسماء. لا يهم بم سأسمى بقدر ما يهم ان استرد الحضن الذي كان يمنحني كل شئ. الدفء والاحلام. الامن والامل. أبواب كانت تنفتح. رحاب كانت تمتد. روعة لا توصف. و بنفسي كنت القي، مهزوما او ظافرا. سعيدا او مكلوما. ومع كل هبة نسيم او مسحة حنونة، وفي كل نفس دافئ او تمريرة لطيفة، كانت الجراح تندمل، و تعاود الروح زواجها بالجسد. والى الحياة قوية تعود.
انظر حوالي باحثا عن اشارة. وميض. بوابة يمتد خلفها ممر يفضي الى دهاليز الغيب حيث تقبع امي أسيرة. لا يتراءى لناظري غير الفراغ والصمت. استرجع تفاصيل اللحظة الرهيبة حين نفثت امي نفسها الاخير في ذلك الصباح الباكر. هل انتهت حقا ؟ هل صار كل ما كانت مجرد خيالات بعيدة ؟
تتأجج انتفاضة رفضي للحقيقة. يخمدها بسرعة ذلك الخصم العنيد الذي لا ادرك له شكلا ولا لونا. ابحث من جديد. تتراءى لي الحياة. هذا اللغز. هذه الإكذوبة التي تستمد سحرها و روعتها من قدرتها على خداع الجميع. أتساءل ماذا لو كانت الحياة جسدا؟ شريطا تلمسه الايادي ؟ أكيد ان كل الذين انهارت قلاعهم الخلفية وقحلت الحدائق التي كانت تصنع صمودهم و تبني شموخ ارواحهم كانوا سيهبون لنجدتي، و نوقف سويا انسكاب الحياة الى الامام. لكن ماذا يجدي الآن التمني وامي قد راحت و انتهت ؟
اولي وجهتي. انظر الى هناك حيث مسافات نسجت رحابها السنون، وتموجات صنعت التواءاتها العقود، وحيث يلوح في النهاية شط أسود. وقبالته تتعالى اعمدة دخان. سفينة قادمة. ربانها لم يكن في حاجة الى منظار لتلمس مساره. عيناه الصغيرتان كانتا قادرتان على تلمس مسالك العصور القادمة . و حرارة أنفاسه كانت تمد محركات السفينة بكل ما كانت في حاجة اليه من طاقة .
ركاب السفينة لم يعرفوا شيئا عن رحلتهم. الربان كان قد نذرهم لشئ آخر غير مواجهة القراصنة الذين تناثروا في كل مكان من مسار الرحلة. لم يعرفوا انهم في محطات كثيرة كادوا أن يصبحوا رقيقا. كما لم يسمح لهم برؤية الدماء التي نزفت منه حين اصابته سهام مسمومة. كان يفعل كل شئ ليجنب الركاب الاحساس بالخطر. وحين كان يطمئن، كان يلجأ لمقصورته. يُحكم خلفه اغلاق الباب. ينزع قناعه و يبكي.
نشيجه كان يعلو أحيانا حتى على أصوات المحركات و هدير الموج. و دموعه كانت تذرف بسخاء. وعند قدميه كانت تتجمع لتشكل بركا. وعلى صفحاتها كانت تلوح صور كثيرة .. ملامح وجوه توارت. عقد انفرط. اخوة تقاتلوا. أحقاد تأججت.أيتام لا حضن يدفئهم. دنيا شرسة جوعت ضعافها لتتخم جبابرتها. دساتير انقلبت فصولها حبالا التفت حول أعناق بؤساء طالبوا بحق العيش.
صور كانت ترعب الربان فيهرع لمغادرة المقصورة و يطوف السفينة متفقدا أعناق الركاب واحدا واحدا. وبعدها كان يعود للسطح. ينظر الى السماء باحثا عن علامة تنبئ بنهاية الطوفان .
بحث تحول الى تأمل شَغَلهُ عن كل شئ. وحين بارحه الشرود، كان هناك على الشط الاسود ملقى امام حطام سفينته. أي نوع من أنواع التنويم كان تحت تأثيره ؟ لم يهتم بالسؤال، لكن الذي شغله حقا كان معرفة مصير الركاب. جرى في كل الاتجاهات، أوصل صوته كل البقاع. وحين قرر شنق نفسه بسبب تقصيره، لم يجد نفسه في حاجة الى حبال. كان ما رآه كافيا كي يوقف نبض فؤاده. رأى ركاب سفينته، كل الركاب ماضين في رحلة معاكسة في يخوت تسطع منها الضياء و تشع منها الحياة. حاول ان يفعل شيئا، أن يشعرهم بوجوده، أن ينبههم الى مكانه، لكن الظلام كان مطبقا، فكر في ان يجري في اتجاه الشط. لكن ساقيه لم تتحملا ثقله، بدأ يصرخ. يصيح صيحات ابتلعها هدير الموج، و اتلفتها اصوات المحركات. بعدَها، قرفص امام حطام السفينة و راح يتابع الضياء وهي تختفي في عمق البحر .
لكن ها هو ذلك الربان الآن، هاهي أمي قد توغلت في مسار احتضارها الطويل او نفقِ انفصال الروح عن الجسد. من الذي اتخذ القرار الحاسم ؟ هل كانت الروح هي التي سعت الى نقائها متخلصة من جسد متعفن منهك، أم كان الجسد هو الذي رغب في اندثاره منتفضا ضد استمرارية الصمود و الاستسلام فيها لم يكونا ليعنيا له في النهاية سوى شيئا واحدا؟
هلوساتها لم تحمل اية اجابة، لكنها من عمق رحلتها احيانا كانت تعود. تستفيق. تتفحص الوجوه وتسأل.الازمنة لم يكن لها معنى ولا كان لأعمار المتحلقين حولها. وبين عمر يمشي قدما الى نهايته ورغبة في معاكسة المسار، كان رجاء يعلو. تتشبث بأشياء لم يكن لها تجسيد. وحين كانت تعي ان يديها لا تلويان على شئ، و أنها ماضية في انزلاقها الى التلاشي، كانت تتحصن من الموت في عمق طفولتها ....
استفاقت في المرة الأخيرة، تفحصت الوجوه، ركزت عينيها في عيني، روعتني نظرتها. كان فيها كل حرارة الوداع الأبدي. استمرت في حوارها الصامت. عتاب قاس رسمته في البداية وهي تضغط على مكان الداء. ثم أبلغتني في عجالة خلاصة درسها الأخير: "مهما تعش، مهما تكدح، مهما تحلم، فيوما ما، قريبا او بعيدا، ستدخل هذا النفق".
لكن بالرغم من ذلك فقد كان في عينيها رجاء و توسلات. وحين أدركت ان لا يداي ولا ايادي غيري قادرة على انتشالها من ما هي ماضية إليه، أدارت وجهها الى الشط الآخر و مضت.
صرخت غير مصدق انها انتهت الى الابد. حاولت ان افعل شيئا. ان اتمسك بها. ان اثنيها على الرحيل.ان اتعلق باذيالها كما كنت افعل صغيرا. ضغطت على يديها. أصغيت لانفاسها صرخت في اذنيها، انتصبت امامي الحقيقة بصرامتها و غلظة أفادت ان كل ما يتصل بالامومة صار شيئا من الماضي.
هو الموت إذا. لكنه لم يكن طائرا كاسرا اسود كما تخيلته دوما. و الحصانة التي كنت قد نسجتها بوجداني ووضعت في جوفها من أحببتهم لم تصمد.. انهارت وضرب الموت بقوة، و ارتفع نحيب النسوة بايقاع حاد يمزق الأفئدة و يعري حقيقة يعيش الانسان ليعاندها، لكنها في النهاية تخرسه ثم تلغيه.
رهبة لم يوازيها الا نشيد الموت الذي ردده الكبار بأصوات عادلت مفعول الموت نفسه. الموت الذي رسم ظلالا قاتمة على الوجوه، ونطقت به ملامح كل من هو على موعد للعبور الى الشط الآخر.