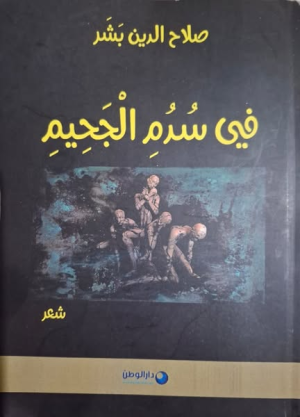عادة ما تكون المراحيض مناطق مكتظة بالبذاءة, مناطق غير مأهولة, نتقاسم أسرارها المحظورة جميعاً ولكن بصمت مطبق.
أحياناً يتضاءل مقدار هذا الصمت في عالم السرد الأدبي ويتحول الى مجرد لمسات لغوية مبتسرة وخاطفة, اذ يختصر الروائي الياباني (هاروكي موراكامي) كل شيء في جملة واحدة خاطفة في روايته (كافكا على الشاطئ):
"بعد طقوس النظافة هذه, دخل الى بيت الراحة وأهتم بالأمر المعتاد . . . أتم الأمر."
مرورٌ خاطِف, بضع كلمات أجترحها (موراكامي) على سطح الورقة النظيف مختزلاً كلَ شيء بعبارة "أتم الأم" . . . وكفى.
بينما ينغمس الروائي الأيرلندي (جيمس جويس) في سرد مكتضٍ بالتفاصيل في روايته (يوليسس) مصوراً تجربة (مستر بلوم) وهو يقضي حاجته في بيت الراحة ممسكاً بالصحيفة بين يديه:
"بهدوء راح يقرأ, كابحاً بطنه, العمود الأول و, مستسلماً لكنه مقاوم, شرع بقرأءة العمود الثاني. في نصف العمود, أنهارت مقاومته الأخيرة, فأفسح المجال لأمعائه أن تفرغ نفسها بهدوء, بينما هو يقرأ, قارئأ بصبر ذلك الأمساك الخفيف الذي أصابه أمس ذهب تماماً. آمل الا تكون كبيرة فتجلب لي البواسير ثانيةً. لا بالحجم المضبوط. كذا. آه! امساك. قرص من اللحاء المقدس. ربما كانت الدنيا هكذا. لم أتحرك أو أمسسه ولكن كان شيئاً سريعاً ودقيقاً. يطبعون أي شيء الآن. فصل الصحف السخيف. واصل القراءة وهو جالس بهدوء فوق خاصة رائحته المتصاعدة. صافية بالتأكيد. . . حدقَ بما كان قد قرأه وبينما شعر ببوله يتدفق بهدوء, حسد برفق المستر بوفوي . . ."
حاول عالم النفس الفرنسي (دومنيك لابورتيه ) في كتابه (تأريخ البراز) في عام 1978 دراسة تطور أنظمة الصرف الصحي في أوربا الغربية في محاولةٍ منه لمعرفة الكيفية التي ساهمَ بها هذا التطور في تشكيل مفاهيم الفردية المعاصرة. ويستكشف لابورتيه أحد أشكال هذه العلاقة بين أنظمة الصرف الصحي وفردية الانسان المعاصر عبر ما يدعوه (بالتطهير اللغوي). فهو يستهل كتابه المذكور بنصٍ للشاعر الفرنسي (بول أيلورد) في ديوانه الشعري (عاصمة الألم):
تتكلم اللغة وتسأل:
"لِمَ أنا حسناء؟
هذا لأن سيدي يُحَمِمُني."
يقترن مفهوم التطهير اللغوي عند (لابورتيه) بتحرير اللغة من عبئها, بطرح اللغة لكل ما هو زائد, أو لكل ما هو فائض عن حاجتها التواصلية, لكل ما يعيق جريانها وأنسيابها, بل يقترن التطهير اللغوي هنا باستفراغ اللغة لكل ما من شأنه أن يزيد من ترهلها دون أن يعمل على رفد معجمها الدلالي أو المفاهيمي بالمزيد من الوحدات اللغوية التي تُسهم في إغناء الأفق التواصلي لتلك اللغة.
يتحدث أحد الشعراء الفرنسيين عن ضرورة تجنب تدوين الأحرف الصامتة عند كتابة الفرنسية فهذه الأحرف لم تُوضع الا لحشو الأوراق. جمالية اللغة اذن تتماهى مع أستعارة الأستحمام اللغوي, فاللغة حسناء لأن سيدها ينزع عنها أدران الترهل والتزويق, جمالية اللغة تصبح عندئذ صنواً أخرا للأقتضاب لا للاسهاب والأطناب.
يبدو أن السرد لدى جويس هو الأخر يمارس نوعاً من الأستفراغ اللغوي في محاكاة أسلوبية ماكرة لأستفراغ البطن لدى (مستر بلوم) . . ربما تكون هذه هي المرة الأولى في الأدب المعاصر التي يتصدى فيها روائي بحجم (جويس) لوصف ما أعتاد الروائيون على تجنب وصفه. فالتبرز مشهد يومي يتجنب تناوله الكثير من الروائيين لأسباب تختلف من روائي لأخر . . فالمشهد برمته يعد تافها, مبتذلا, ناهيك عن القرف والخجل الذان تنطوي عليهما الطبيعة المادية للبراز وخصوصية الفرد المُتَبَرِز. كل ذلك لم يقف عائقاً أمام ذائقة (جويس) التي شكلت مفترق طرق لعالم السرد برمته, فروايته (يوليسس) تحتفي بكل ما هو مبتذل, بكل ما يشكل الأطار العام للحياة اليومية الرتيبة للأنسان العادي في القرن العشرين, ومن بين جميع التفاصيل التي تحفل بها هذه الرتابة اليومية لم يَفت (جويس) مشهد الجلوس في المرحاض.
وبالطبع لا يقتصر السرد في هذا المشهد على مجرد التصوير اللغوي المقتضب لتَبَرُز (مستر بلوم) فحسب بل ينسحب على خلق حالة من التماهي الرمزي الجريء بين عملية (التبرز) وعملية (القراءة) , فيستعيد (جويس) ثنائية (القارئ/ المستهلك) اذا ما أخذنا بنظر الأعتبار التورية البارعة لمفردة (العمود): فهي تكتنز دلالتين يتشبث أحدهما بالأخر دون فكاك, دلالة عمود (المقال) المطبوع في الصحيفة أزاء دلالة عمود (البراز) وهو يعلنً نهاية الأمساك الخفيف الذي أصاب (مستر بلوم) بالأمس. هذا التماهي لا يُجيز للقارئ أن يستهلك نصوص (يوليسس) سلبياً, بل يتوجب عليه أن يستحضر أو يُفعِل خزينه المعرفي الخاص به هو (ويطرحه) أزاء السياق المعرفي للنص المقروء حتى تكتسب القراءة الزخم اللازم لجعلها عملية بناء يُسهمُ فيها القارئ في أغناء الأحتمالات التأويلية المشرعة أمام لغة ذلك النص المقروء. أخلاقيا ليس بوسع القارئ طرح نفس المدخلات القرائية دون أي اضافة, دون أي استحضار فاعل لمرجعياته المعرفية الخاصة به. أن الأشتراط الأخلاقي لخصوصية الاضافة القرائية للنص هو نفس الأشتراط الأخلاقي الذي تقتضيه خصوصية الجلوس في المراحيض وغلق أبوابها بعيدا عن عيون أي مترصد, بل ما تقتضيه خصوصية وفرادة البراز الناجم عن كل فرد.
كما يخصص الروائي التشيكي (ميلان كونديرا) جزءا كاملا من روايته (خفة الكائن التي لا تحتمل) للحديث عن (البراز) ولكنه براز من نوعٍ أخر هذه المرة, براز يتحول الى قضية يموت في سبيلها المرء, فهو (براز ابن ستالين وهو في مخيم الأسر الألماني مع مجموعة من الضباط البريطانيين). ربما تكون لغة (كونديرا) أقل تجريبيةً من لغة جويس, وأشد وضوحاً, وأكثر أحتراماً لزمنية السرد التقليدي, الا أنها مقتضبة أيضا, لغة طهرها (كونديرا) تماماً, شذبها من أي أغصان زائدة, لغة مُستَفرَغة, جمل قصيرة تتقافز برشاقة على فضاء الورقة البيضاء.
"ابن ستالين قضى في سبيل البراز. ولكن الموت في سبيل البراز ليس موتاً مجرداً من المعنى. فالألمان الذين ضحوا بحياتهم من أجل توسيع أمبراطوريتهم أكثر بأتجاه الشرق, والروس الذين ماتوا لكي تمتد سلطة بلادهم أكثر صوب الغرب. أجل, كل هؤلاء ماتوا من اجل بلاهة, وموتهم مجرد من أي معنى ومن أي مغزى عام. أما موت ابن ستالين فكان بالمقابل, الموت الميتافيزيقي الوحيد وسط البلاهة العالمية للحرب."
لا يمتلك القارئ أمام نص (كونديرا) هذا الا ان يُسلم مقاليد عقله لمتعة الجدل السردي والفلسفي والتأريخي وهو يَسبرُ عنفوان البداهة اليومية (للبراز) أزاء ضِعة وبلاهة الحرب وأوهام السلطة المطلقة. بل ويستطرد في لغةٍ مطهرةٍ تماماً من أنفعالية أطلاق النعوت المعبئة بالأحكام المُسبقة فيقفز الى أستنتاج يستفز جميع الأُطر الذهنية التقليدية للقارئ حول (البراز):
" البراز أذن هو مسألة لاهوتية أكثر صعوبة من مسألة الشر."
هذه لعبة خطيرة لا يجيدها الا مَن يمتلك الجرأة على قلب الطاولة المفاهيمية التقليدية للقارئ رأساً على عَقِب, أكثر عاداتنا اليومية بذاءة تحولها لغة (كونديرا) الى قضية ميتافيزيقية يتمفصل حولها جميع اللاهوت المسيحي, بل تهدد قلب المُعتقد المسيحي القائم على الوهية المسيح (ابن الرب), وعلى تبني تعريف غير تقليدي للمقدس أزاء الدنيوي: فالمقدس هو (نفيٌ مطلقٌ للبراز) أزاء الدنيوي وهو (استهلاك فرويدي للبراز بصفته اثارة مفضية للذة). وبذا يصبح البراز حافة تفصل بين قطبي الوجود ببعده الميتافيزيقي من طرف وبعده الأرضي من طرف أخر.
كما تنتزع لغة كونديرا (البراز) من الأفق التقليدي للقضايا الاجتماعية والتابو الاخلاقي وتزجه في قلب الصراع الميتافيزيقي واللاهوتي الأصيل, والذي ينتهي حتما الى استثارة الكثير من الأسئلة المشروعة حول (الطريقة التي خُلِقنا بها):
"إذا كانت كلمة براز يُستعاض حالياً عنها في الكتب بنُقط, فهذا ليس لأسباب أخلاقية. يجب الا نذهب الى حد الأدعاء بأن البراز شيء منافٍ للأخلاق! فالخلاف مع البراز خلاف ميتافيزيقي. هناك أمرٌ من أمرين: إما أن البراز شيء مقبول (إذا لا تقفلوا على أنفسكم بالمفتاح وأنتم في المراحيض!), وإما ان الطريقة التي خُلِقنا بها تثير جدلاً."
يذكرنا عالم (كونديرا) الى حدٍ ما بعالم (نيتشه), فكلاهما محاطان بمجتمعات تعتمد آلية الرفض في خلق نسيج مجتمعي منسجم ويتلاشى فيه الأختلاف. وإن تواجد هذا الأختلاف في أي زاوية من زوايا هذا النسيج من الوجود (القَطِيعي) يُسارع هذا المجتمع من على فوره الى محاولة استيعابه, بل تَمثله, وتفكيكه, وان فَشِلَ في اذابة هذا الأختلاف وأحتوائه يعمد عندئذ الى تغليفه بغطاء سميك من الرفض والأستنكار ودمغه بعلامة التابو الحتمية! ان فشل المجتمعات الأنسانية في أحتواء قضية (البراز) على المستويين المجتمعي واللاهوتي وضع هذا البراز في خانة (الرفض, والبذاءة, والقرف) على المستوى الأخلاقي. وهذا ما يفسر شجاعة الجدل (الكونديري) في تذكير المجتمع بهروبه الجبان من مواجهة اشكالية (الحرج اللاهوتي أمام قضية البراز), فشرائح هذا المجتمع مرغمة على مواجهة أحتمالين: اما أن البراز أمرٌ طبيعي أخلاقيا, ويستتبع ذلك تحطيم سلسلة طويلة من المفاهيم والممارسات اليومية المتعلقة به, أو أنه أمرٌ غير مقبول أخلاقيا مما يثير حفيظة السيناريوهات اللاهوتية المطروحة لقضية (الخَلق).
وما فتئ (كونديرا) يدعو الى اعادة تصنيف قضية البراز, وسحب ملفته من الرف الأخلاقي ووضعها في رف القضايا الميتافيزيقية العويصة. والأصرار على نزع المشروعية الاخلاقية من البراز ما هو الا هروب من الأخفاقات اللاهوتية في التعاطي مع الكمالات المُفترضة للمقدس وما تقتضيه هذه الكمالات من نفي مطلق للبراز.
ويندرج جميع هذا الجدل السردي الممتع لدى (كونديرا) ضمن الثنائية المفاهيمية الأساسية التي تطرحها روايته: تلك هي ثنائية (الخفة والثقل). ثنائية التنصل اللاأخلاقي والتخفف (الذي لا يُحتَمَل) من عبئ (البراز) أزاء مشروعية الثقل الميتافيزيقي لهذا البراز بصفته قضية لاهوتية لا يجوز تجنب الخوض فيها و محاولة حلحلتها وفقاً لسياقات الوجود الميتافيزيقي للاله.
ويفاجئنا (لؤي حمزة عباس) بكتابة نصٍ سرديٍ كاملٍ عن المراحيض ويدعوه: (كتاب المراحيض).
غير أن السرد في هذا الكتاب بعيدٌ جداً عن (التطهير اللغوي) لدى (لابورتيه), فهو لا يعتمد لغةً مقتضبةً كما هي عليه الحال لدى (جويس وكونديرا), بل تنفرط فيه اللغة وتعوم في مستنقع راكد من الفائض المعجمي والدلالي. نعم, ربما تتحدث لغة (لؤي حمزة عباس) عن الاستفراغ لكنها أحيانا كثيرة تكون هي نفسها لغة مترهلة ومثقلة وعائمة . . .
" وتعيد للعبة, مرة أخرى, توازنها المرير بين مكانين من أماكن العسكر, ففي الوقت الذي يُنصِت فيه جندي المساء, في مراحيض المعسكر, مزروعاً وسط البركة لعواءات كائنات الليل, تتسمع, وحدك, في نتانة الأعضاء الشائهة, لصوت الشاعر مشغولاً بايقاع الفناء الفادح وهو يصدح في الصوتين."
إن (لؤي حمزة عباس) أبعد ما يكون عن أحتضان طست الماء بين ساقيه لينكب على غسل سرده من الفائض اللغوي, من الأسهاب والأطناب, فلغته مثقلةٌ بجملٍ يغطي رأسها الضباب , فلا تعلم شيئاً عن مرجعيات فاعلها, ثم تصفع هذه الجمل عيني القارئ بذيلٍ طويل ومرتخٍ من الانثيالات والنعوت المتراكبة بعضها فوق البعض الآخر . ."عواءات كائنات الليل . . . نتانة الأعضاء الشائهة . ."
وكلما توغلنا في غابة (لؤي حمزة عباس) السردية ضاقت علينا مواسير مراحيضه اللغوية. فهو يمارس نوعاً غريباً من التحميل, نوعاً من الحقن المتواصل لسوائل لزجة وكثيفة تثقل مواسير الصرف اللغوي لديه . . فيمضي في السرد, وينفرط عقد اللغة منجرفةً مع الفائض السردي للراوي:
"الشقوق الجبلية تحدثنا ببلاغة صخرية عن صراع الانسان, وهو يعيد أختبار حقائق وجودها كما أختبرها من قبل, تلمّس فيها كياناً محيطاً لا سبيل للأنفلات أو الخلاص منه, لكن عبر مواجهته يراكم جلال حقائقه, فيخبرنا العماء الجليدي بمقدرة الطبيعة وأستعدادها لشتى ضروب المواجهات, حيث تنهض الجبال كيانات من صخرٍ أجرد, هائل أصم, يختزن في أرتفاعه الشاهق لغة أبدية, يكون الأنسان فيها نقطة هائمة في أشتباك الحروف. تتواجه الجبال, في حوارها الصامت الجليل, فتبيح, من دون اشارة, هواجس جنود الربايا والمواقع لغابة الجليد. . . في مثل هذا الزمهرير تنفتح جغرافيا المراحيض انفتاحاً كبيراً, تندفع مثل موجة معتمة على ورق الخارطة, فتغرق خطوطها النحيلة, علاماتها, كلماتها الصغيرة, مساحاتها اللونية المختلفة, تلوثها بالركام الدافئ النتن . . ."
كل هذه اللغة محقونة ومكتظة في جملتين مختنقتين فحسب!
" الاحتكاك الذي تتناقله الرياح في المساحات الباردة كما تتناقل صرخات اللوعة الحادة لعشرات الجنود التائهين على القمم المرعبة وهم يوقتون حيواتهم على مراسيم الحروب, مناسيب فتوتها اللاهبة, اذ تسحب الكائن, بلا هدىً, نقطة حشرية هائمة على يباب الخارطة, لا ظل لها ولا غبار, وحدها الصرخات الكونية تشير لحضورها الخاطف على قمم الجليد, أو الصحارى المديدة, أو بين الغابات المتشابكة, وسنون الصخر, وعلى المياه, تطلقها طيور (الهامة) المجبولة من جمر وريش . . ."
هذا الأنفراط اللامسؤل في لغة السرد لدى (لؤي حمزة عباس) لا يستحظر في ذهن القارء سوى مفهوم المرحاض بصفته مقصورة مغلقة تتكثف فيها لغة الراوي وبدل أن تتطهر هذه اللغة من تراكيبها المصابة بالأسهال وتنظو عن نفسها أدران الزوائد التي يغص بها معجم السرد الممتد بلا نهاية منطقية, نجد أنها لغة تترهل بالتعويم المستمر لنحوها ودلالتها, فأبنيتها الجُملية موغِلةٌ بالأمتداد الى المالانهاية ومعجمها يغص بحلقات مفرغة من الوحدات الدلالية المفتوحة على سيناريوهات الحرب. القارئ أمام لغة سردية راكدة, لا تجري لكنها تدور وتدور في أحواض دلالية طافحة غير قابلة للتصريف, على العكس تماما من لغة (جويس وكونديرا) , فهي لغةٌ تكاد أن تكون صفرية, محسوبة بدقة, متطهرة من جميع أدران الفائض اللغوي فتجد جملها وسردها يتقافزان متخففان من كل شيء ما عدا الوضوح والأحكام.
ولا ينتهي الأمر بنص (لؤي حمزة عباس) عند هذه اللغة الطافحة فحسب, بل يتعداه الى ما هو أشد خطورة من مجرد أبنية نحوية أفعوانية وحلقات دلالية مدومة. ان البُنية المفاهيمية الأساسية التي تدعم عادةً مجمل البناء السردي للنص وتنتصب كسقالة بَنّاء ماهر تُسنِد الفيوضات اللغوية لنص السارد, هذه البُنية في أرتكازاتها المفاهيمية الأساسية مأخوذة الى حدٍ كبير (في نص لؤي حمزة عباس) من نفس الوسط المفاهيمي الذي أسسه (كونديرا) في روايته (خفة الكائن التي لا تحتمل).
فقضية البراز عند (لؤي حمزة عباس) هي الأخرى قضية ميتافيزيقية, يتمفصل عندها طرفي الوجود البشري بشقيه الميتافيزيقي (المتعالي) والأرضي (المتسافِل):
" منذ أن استل جبرائيل وسطاه من إست أدم, وأدم, حتى هذه الساعة, ولما لا يعد ولا يدرك من الساعات, يلتذ بما يخرج منه, لذاذة الراحة والمراح . . . وهو يزيد من أرتباطه بالأرض . . فيقوم وفي جسده شيء من خفة يُخلفُها الجهد والدفء والرائحة, وعذوبة غريبة توطد أحساساً مبهماً . . ., موحِداً بينه وبين أشد الكائنات نتانة, وبينه وبين صاحب الأصبع العتيق, فالعملية . . . تُحرِكُ ظل جبرائيل المحبوس في طين جسده الآدمي."
هذا بلا شك مجرد تنويع مفاهيمي أخر أستعارهُ (لؤي حمزة عباس) من رؤية (كونديرا) للبراز بصفته قضيةٌ ميتافيزيقية. فالأستفراغ بحد ذاته يستفز فينا (أحساساً مبهماً), يعمل على خلق ذاكرة توحيدية مزدوجة: واحدية الجسد بكل أعراضه الأرضية (الطينية) من جهة, وواحدية الظلال المقدسة الرازحة تحت ثقل هذا الطين المُتَبَرِز للجسد من جهةٍ أخرى. تلك هي مرةً أخرة ثنائية (كونديرا) الشهيرة ولكن بتنويع صوفي أخر أستحضره نص (لؤي حمزة عباس): تخفف الجسد (ترويحه بالعرف الصوفي) أزاء تثقيل الروح (تجسيدها) وهي في أسر الطين الآدمي الثقيل.
فلؤي حمزة عباس لا يشتغل مفاهيمياً على الاطلاق الا ضمن خبايا الثنائيات التي أبدعها (كونديرا) سلفاً في روايته المذكورة آنفاً, وأول هذه الثنائيات وأهمها واكثرها حضورا وتميزا ثنائية (الخفة والثقل) مقترنةً معجمياً بمفردة فارقة للغة (كونديرا) هي مفردة (الكائن) والتي تكررت الى حدٍ ما في نص (لؤي حمزة عباس) مقترنةً على الدوام بمفهومي الثقل والخفة:
"ربما كان من أعراف الحروب الكبيرة الطاحنة, أن يحمل الجندي أقراصاً وإبراً ومراهم, في محاولةٍ منه لمحاصرة الكائن فناءه, وللجسد حصاره المكين, إيقاع سطوته, فبعد كم من الأيام لن يكون بامكانه التجلد والرضوخ أمام ثقل ما خزن من ألم؟"
" . . . وهم يوقتون حيواتهم على مراسيم الحروب, مناسيب فتوتها اللاهبة, إذ تسحب الكائن, بلا هدىً . . ."
"هل يحرك المرحاض, بوصفه ملاذاً حسياً, شعورنا بالرضا والاطمئنان؟ وهل يقودنا, عبر الأندماج بما صُمِمَ له من وظائف, الى مصالحة ذواتنا وهي تتخفف مما حُمِلَت أجسادنا من أدران؟"
ولكن ما يُحسَب (للؤي حمزة عباس) هو تحقيقه لحالة أستثنائية من التماهي الأسلوبي بين الثيمة الرمزية للمراحيض الطافحة بالبراز أبداً واللغة الطافحة هي الأخرى بنحوها المحتشد وهو يكدس الجمل فوق بعضها البعض حتى أن ذاكرة القارئ لا تُسعِفه في تذكر بداية الجملة بمجرد بلوغه نهايتها بعد لأيٍ وعناء.
يقول لابورت في كتابه (تأريخ البراز): " ربما لا يجرؤ أحدٌ على الحديث عن البراز, ولكن منذ بدأ الخليقة لم يوجد موضوع أكثر منه – ولا حتى الجنس – جعلنا نتحدث عنه بهذا القدر".
تلك مفارقةٌ غريبة! أكثر الأشياء المسكوت عنها هي أكثر الأشياء التي نتحدث عنها. لا يمكن التعاطي مع مفارقة (لابورت) هذه الا عبر نوع من السحب المشفر لماهية البراز الرمزية. فنحن ربما نتجنب الخوض المباشر في الكثير من المحظورات لبذائتها الظاهرة وأولها (البراز), لكننا بالمقابل نخوض غمار الحديث في جميع القضايا التي تطفو على سطح خفيف نوعاً ما من القبح فيما تقبع كتلة القبح الكثيف في القاع بسلام دون أن يستفز صفوها أحد, فالبحيرة راكدة وأحاديثنا صبيانية تخدش سطحها فحسب. وحينما نتحدث عن السلطة, والنفوذ, والسيطرة, والفوضى, والجنس فأننا بشكل أو بأخر نستحضر جرعات مخففة من (البراز).
إن الفنان فحسب هو ما يجعلنا نحدق عن كثب في خفايا القبح والبذاءة بحثاً عن الجمال فللقبح جمالياته أيضاً. فمَنْ غيرَ (جويس) يجرؤ على مماحكة (فعل القراءة) عبر قرينة الجلوس في المرحاض والتبرز بعد امساك معوي طفيف؟ مَنْ غير (كونديرا) يجرؤ على مسك طرفي الوجود البشري المتناحرين ليحبكهما معاً في رباط واحدٍ لا أنفكاك له: رباط السماء والأرض, رباط الميتافيزيقيا والبراز؟ مَن غير (لؤي حمزة عباس) يجرؤ على إغراق جسد لغته بأحواض المراحيض بكل ما تختزنه من مقموعات وتواطؤات محظورة!
مَنْ؟
أحياناً يتضاءل مقدار هذا الصمت في عالم السرد الأدبي ويتحول الى مجرد لمسات لغوية مبتسرة وخاطفة, اذ يختصر الروائي الياباني (هاروكي موراكامي) كل شيء في جملة واحدة خاطفة في روايته (كافكا على الشاطئ):
"بعد طقوس النظافة هذه, دخل الى بيت الراحة وأهتم بالأمر المعتاد . . . أتم الأمر."
مرورٌ خاطِف, بضع كلمات أجترحها (موراكامي) على سطح الورقة النظيف مختزلاً كلَ شيء بعبارة "أتم الأم" . . . وكفى.
بينما ينغمس الروائي الأيرلندي (جيمس جويس) في سرد مكتضٍ بالتفاصيل في روايته (يوليسس) مصوراً تجربة (مستر بلوم) وهو يقضي حاجته في بيت الراحة ممسكاً بالصحيفة بين يديه:
"بهدوء راح يقرأ, كابحاً بطنه, العمود الأول و, مستسلماً لكنه مقاوم, شرع بقرأءة العمود الثاني. في نصف العمود, أنهارت مقاومته الأخيرة, فأفسح المجال لأمعائه أن تفرغ نفسها بهدوء, بينما هو يقرأ, قارئأ بصبر ذلك الأمساك الخفيف الذي أصابه أمس ذهب تماماً. آمل الا تكون كبيرة فتجلب لي البواسير ثانيةً. لا بالحجم المضبوط. كذا. آه! امساك. قرص من اللحاء المقدس. ربما كانت الدنيا هكذا. لم أتحرك أو أمسسه ولكن كان شيئاً سريعاً ودقيقاً. يطبعون أي شيء الآن. فصل الصحف السخيف. واصل القراءة وهو جالس بهدوء فوق خاصة رائحته المتصاعدة. صافية بالتأكيد. . . حدقَ بما كان قد قرأه وبينما شعر ببوله يتدفق بهدوء, حسد برفق المستر بوفوي . . ."
حاول عالم النفس الفرنسي (دومنيك لابورتيه ) في كتابه (تأريخ البراز) في عام 1978 دراسة تطور أنظمة الصرف الصحي في أوربا الغربية في محاولةٍ منه لمعرفة الكيفية التي ساهمَ بها هذا التطور في تشكيل مفاهيم الفردية المعاصرة. ويستكشف لابورتيه أحد أشكال هذه العلاقة بين أنظمة الصرف الصحي وفردية الانسان المعاصر عبر ما يدعوه (بالتطهير اللغوي). فهو يستهل كتابه المذكور بنصٍ للشاعر الفرنسي (بول أيلورد) في ديوانه الشعري (عاصمة الألم):
تتكلم اللغة وتسأل:
"لِمَ أنا حسناء؟
هذا لأن سيدي يُحَمِمُني."
يقترن مفهوم التطهير اللغوي عند (لابورتيه) بتحرير اللغة من عبئها, بطرح اللغة لكل ما هو زائد, أو لكل ما هو فائض عن حاجتها التواصلية, لكل ما يعيق جريانها وأنسيابها, بل يقترن التطهير اللغوي هنا باستفراغ اللغة لكل ما من شأنه أن يزيد من ترهلها دون أن يعمل على رفد معجمها الدلالي أو المفاهيمي بالمزيد من الوحدات اللغوية التي تُسهم في إغناء الأفق التواصلي لتلك اللغة.
يتحدث أحد الشعراء الفرنسيين عن ضرورة تجنب تدوين الأحرف الصامتة عند كتابة الفرنسية فهذه الأحرف لم تُوضع الا لحشو الأوراق. جمالية اللغة اذن تتماهى مع أستعارة الأستحمام اللغوي, فاللغة حسناء لأن سيدها ينزع عنها أدران الترهل والتزويق, جمالية اللغة تصبح عندئذ صنواً أخرا للأقتضاب لا للاسهاب والأطناب.
يبدو أن السرد لدى جويس هو الأخر يمارس نوعاً من الأستفراغ اللغوي في محاكاة أسلوبية ماكرة لأستفراغ البطن لدى (مستر بلوم) . . ربما تكون هذه هي المرة الأولى في الأدب المعاصر التي يتصدى فيها روائي بحجم (جويس) لوصف ما أعتاد الروائيون على تجنب وصفه. فالتبرز مشهد يومي يتجنب تناوله الكثير من الروائيين لأسباب تختلف من روائي لأخر . . فالمشهد برمته يعد تافها, مبتذلا, ناهيك عن القرف والخجل الذان تنطوي عليهما الطبيعة المادية للبراز وخصوصية الفرد المُتَبَرِز. كل ذلك لم يقف عائقاً أمام ذائقة (جويس) التي شكلت مفترق طرق لعالم السرد برمته, فروايته (يوليسس) تحتفي بكل ما هو مبتذل, بكل ما يشكل الأطار العام للحياة اليومية الرتيبة للأنسان العادي في القرن العشرين, ومن بين جميع التفاصيل التي تحفل بها هذه الرتابة اليومية لم يَفت (جويس) مشهد الجلوس في المرحاض.
وبالطبع لا يقتصر السرد في هذا المشهد على مجرد التصوير اللغوي المقتضب لتَبَرُز (مستر بلوم) فحسب بل ينسحب على خلق حالة من التماهي الرمزي الجريء بين عملية (التبرز) وعملية (القراءة) , فيستعيد (جويس) ثنائية (القارئ/ المستهلك) اذا ما أخذنا بنظر الأعتبار التورية البارعة لمفردة (العمود): فهي تكتنز دلالتين يتشبث أحدهما بالأخر دون فكاك, دلالة عمود (المقال) المطبوع في الصحيفة أزاء دلالة عمود (البراز) وهو يعلنً نهاية الأمساك الخفيف الذي أصاب (مستر بلوم) بالأمس. هذا التماهي لا يُجيز للقارئ أن يستهلك نصوص (يوليسس) سلبياً, بل يتوجب عليه أن يستحضر أو يُفعِل خزينه المعرفي الخاص به هو (ويطرحه) أزاء السياق المعرفي للنص المقروء حتى تكتسب القراءة الزخم اللازم لجعلها عملية بناء يُسهمُ فيها القارئ في أغناء الأحتمالات التأويلية المشرعة أمام لغة ذلك النص المقروء. أخلاقيا ليس بوسع القارئ طرح نفس المدخلات القرائية دون أي اضافة, دون أي استحضار فاعل لمرجعياته المعرفية الخاصة به. أن الأشتراط الأخلاقي لخصوصية الاضافة القرائية للنص هو نفس الأشتراط الأخلاقي الذي تقتضيه خصوصية الجلوس في المراحيض وغلق أبوابها بعيدا عن عيون أي مترصد, بل ما تقتضيه خصوصية وفرادة البراز الناجم عن كل فرد.
كما يخصص الروائي التشيكي (ميلان كونديرا) جزءا كاملا من روايته (خفة الكائن التي لا تحتمل) للحديث عن (البراز) ولكنه براز من نوعٍ أخر هذه المرة, براز يتحول الى قضية يموت في سبيلها المرء, فهو (براز ابن ستالين وهو في مخيم الأسر الألماني مع مجموعة من الضباط البريطانيين). ربما تكون لغة (كونديرا) أقل تجريبيةً من لغة جويس, وأشد وضوحاً, وأكثر أحتراماً لزمنية السرد التقليدي, الا أنها مقتضبة أيضا, لغة طهرها (كونديرا) تماماً, شذبها من أي أغصان زائدة, لغة مُستَفرَغة, جمل قصيرة تتقافز برشاقة على فضاء الورقة البيضاء.
"ابن ستالين قضى في سبيل البراز. ولكن الموت في سبيل البراز ليس موتاً مجرداً من المعنى. فالألمان الذين ضحوا بحياتهم من أجل توسيع أمبراطوريتهم أكثر بأتجاه الشرق, والروس الذين ماتوا لكي تمتد سلطة بلادهم أكثر صوب الغرب. أجل, كل هؤلاء ماتوا من اجل بلاهة, وموتهم مجرد من أي معنى ومن أي مغزى عام. أما موت ابن ستالين فكان بالمقابل, الموت الميتافيزيقي الوحيد وسط البلاهة العالمية للحرب."
لا يمتلك القارئ أمام نص (كونديرا) هذا الا ان يُسلم مقاليد عقله لمتعة الجدل السردي والفلسفي والتأريخي وهو يَسبرُ عنفوان البداهة اليومية (للبراز) أزاء ضِعة وبلاهة الحرب وأوهام السلطة المطلقة. بل ويستطرد في لغةٍ مطهرةٍ تماماً من أنفعالية أطلاق النعوت المعبئة بالأحكام المُسبقة فيقفز الى أستنتاج يستفز جميع الأُطر الذهنية التقليدية للقارئ حول (البراز):
" البراز أذن هو مسألة لاهوتية أكثر صعوبة من مسألة الشر."
هذه لعبة خطيرة لا يجيدها الا مَن يمتلك الجرأة على قلب الطاولة المفاهيمية التقليدية للقارئ رأساً على عَقِب, أكثر عاداتنا اليومية بذاءة تحولها لغة (كونديرا) الى قضية ميتافيزيقية يتمفصل حولها جميع اللاهوت المسيحي, بل تهدد قلب المُعتقد المسيحي القائم على الوهية المسيح (ابن الرب), وعلى تبني تعريف غير تقليدي للمقدس أزاء الدنيوي: فالمقدس هو (نفيٌ مطلقٌ للبراز) أزاء الدنيوي وهو (استهلاك فرويدي للبراز بصفته اثارة مفضية للذة). وبذا يصبح البراز حافة تفصل بين قطبي الوجود ببعده الميتافيزيقي من طرف وبعده الأرضي من طرف أخر.
كما تنتزع لغة كونديرا (البراز) من الأفق التقليدي للقضايا الاجتماعية والتابو الاخلاقي وتزجه في قلب الصراع الميتافيزيقي واللاهوتي الأصيل, والذي ينتهي حتما الى استثارة الكثير من الأسئلة المشروعة حول (الطريقة التي خُلِقنا بها):
"إذا كانت كلمة براز يُستعاض حالياً عنها في الكتب بنُقط, فهذا ليس لأسباب أخلاقية. يجب الا نذهب الى حد الأدعاء بأن البراز شيء منافٍ للأخلاق! فالخلاف مع البراز خلاف ميتافيزيقي. هناك أمرٌ من أمرين: إما أن البراز شيء مقبول (إذا لا تقفلوا على أنفسكم بالمفتاح وأنتم في المراحيض!), وإما ان الطريقة التي خُلِقنا بها تثير جدلاً."
يذكرنا عالم (كونديرا) الى حدٍ ما بعالم (نيتشه), فكلاهما محاطان بمجتمعات تعتمد آلية الرفض في خلق نسيج مجتمعي منسجم ويتلاشى فيه الأختلاف. وإن تواجد هذا الأختلاف في أي زاوية من زوايا هذا النسيج من الوجود (القَطِيعي) يُسارع هذا المجتمع من على فوره الى محاولة استيعابه, بل تَمثله, وتفكيكه, وان فَشِلَ في اذابة هذا الأختلاف وأحتوائه يعمد عندئذ الى تغليفه بغطاء سميك من الرفض والأستنكار ودمغه بعلامة التابو الحتمية! ان فشل المجتمعات الأنسانية في أحتواء قضية (البراز) على المستويين المجتمعي واللاهوتي وضع هذا البراز في خانة (الرفض, والبذاءة, والقرف) على المستوى الأخلاقي. وهذا ما يفسر شجاعة الجدل (الكونديري) في تذكير المجتمع بهروبه الجبان من مواجهة اشكالية (الحرج اللاهوتي أمام قضية البراز), فشرائح هذا المجتمع مرغمة على مواجهة أحتمالين: اما أن البراز أمرٌ طبيعي أخلاقيا, ويستتبع ذلك تحطيم سلسلة طويلة من المفاهيم والممارسات اليومية المتعلقة به, أو أنه أمرٌ غير مقبول أخلاقيا مما يثير حفيظة السيناريوهات اللاهوتية المطروحة لقضية (الخَلق).
وما فتئ (كونديرا) يدعو الى اعادة تصنيف قضية البراز, وسحب ملفته من الرف الأخلاقي ووضعها في رف القضايا الميتافيزيقية العويصة. والأصرار على نزع المشروعية الاخلاقية من البراز ما هو الا هروب من الأخفاقات اللاهوتية في التعاطي مع الكمالات المُفترضة للمقدس وما تقتضيه هذه الكمالات من نفي مطلق للبراز.
ويندرج جميع هذا الجدل السردي الممتع لدى (كونديرا) ضمن الثنائية المفاهيمية الأساسية التي تطرحها روايته: تلك هي ثنائية (الخفة والثقل). ثنائية التنصل اللاأخلاقي والتخفف (الذي لا يُحتَمَل) من عبئ (البراز) أزاء مشروعية الثقل الميتافيزيقي لهذا البراز بصفته قضية لاهوتية لا يجوز تجنب الخوض فيها و محاولة حلحلتها وفقاً لسياقات الوجود الميتافيزيقي للاله.
ويفاجئنا (لؤي حمزة عباس) بكتابة نصٍ سرديٍ كاملٍ عن المراحيض ويدعوه: (كتاب المراحيض).
غير أن السرد في هذا الكتاب بعيدٌ جداً عن (التطهير اللغوي) لدى (لابورتيه), فهو لا يعتمد لغةً مقتضبةً كما هي عليه الحال لدى (جويس وكونديرا), بل تنفرط فيه اللغة وتعوم في مستنقع راكد من الفائض المعجمي والدلالي. نعم, ربما تتحدث لغة (لؤي حمزة عباس) عن الاستفراغ لكنها أحيانا كثيرة تكون هي نفسها لغة مترهلة ومثقلة وعائمة . . .
" وتعيد للعبة, مرة أخرى, توازنها المرير بين مكانين من أماكن العسكر, ففي الوقت الذي يُنصِت فيه جندي المساء, في مراحيض المعسكر, مزروعاً وسط البركة لعواءات كائنات الليل, تتسمع, وحدك, في نتانة الأعضاء الشائهة, لصوت الشاعر مشغولاً بايقاع الفناء الفادح وهو يصدح في الصوتين."
إن (لؤي حمزة عباس) أبعد ما يكون عن أحتضان طست الماء بين ساقيه لينكب على غسل سرده من الفائض اللغوي, من الأسهاب والأطناب, فلغته مثقلةٌ بجملٍ يغطي رأسها الضباب , فلا تعلم شيئاً عن مرجعيات فاعلها, ثم تصفع هذه الجمل عيني القارئ بذيلٍ طويل ومرتخٍ من الانثيالات والنعوت المتراكبة بعضها فوق البعض الآخر . ."عواءات كائنات الليل . . . نتانة الأعضاء الشائهة . ."
وكلما توغلنا في غابة (لؤي حمزة عباس) السردية ضاقت علينا مواسير مراحيضه اللغوية. فهو يمارس نوعاً غريباً من التحميل, نوعاً من الحقن المتواصل لسوائل لزجة وكثيفة تثقل مواسير الصرف اللغوي لديه . . فيمضي في السرد, وينفرط عقد اللغة منجرفةً مع الفائض السردي للراوي:
"الشقوق الجبلية تحدثنا ببلاغة صخرية عن صراع الانسان, وهو يعيد أختبار حقائق وجودها كما أختبرها من قبل, تلمّس فيها كياناً محيطاً لا سبيل للأنفلات أو الخلاص منه, لكن عبر مواجهته يراكم جلال حقائقه, فيخبرنا العماء الجليدي بمقدرة الطبيعة وأستعدادها لشتى ضروب المواجهات, حيث تنهض الجبال كيانات من صخرٍ أجرد, هائل أصم, يختزن في أرتفاعه الشاهق لغة أبدية, يكون الأنسان فيها نقطة هائمة في أشتباك الحروف. تتواجه الجبال, في حوارها الصامت الجليل, فتبيح, من دون اشارة, هواجس جنود الربايا والمواقع لغابة الجليد. . . في مثل هذا الزمهرير تنفتح جغرافيا المراحيض انفتاحاً كبيراً, تندفع مثل موجة معتمة على ورق الخارطة, فتغرق خطوطها النحيلة, علاماتها, كلماتها الصغيرة, مساحاتها اللونية المختلفة, تلوثها بالركام الدافئ النتن . . ."
كل هذه اللغة محقونة ومكتظة في جملتين مختنقتين فحسب!
" الاحتكاك الذي تتناقله الرياح في المساحات الباردة كما تتناقل صرخات اللوعة الحادة لعشرات الجنود التائهين على القمم المرعبة وهم يوقتون حيواتهم على مراسيم الحروب, مناسيب فتوتها اللاهبة, اذ تسحب الكائن, بلا هدىً, نقطة حشرية هائمة على يباب الخارطة, لا ظل لها ولا غبار, وحدها الصرخات الكونية تشير لحضورها الخاطف على قمم الجليد, أو الصحارى المديدة, أو بين الغابات المتشابكة, وسنون الصخر, وعلى المياه, تطلقها طيور (الهامة) المجبولة من جمر وريش . . ."
هذا الأنفراط اللامسؤل في لغة السرد لدى (لؤي حمزة عباس) لا يستحظر في ذهن القارء سوى مفهوم المرحاض بصفته مقصورة مغلقة تتكثف فيها لغة الراوي وبدل أن تتطهر هذه اللغة من تراكيبها المصابة بالأسهال وتنظو عن نفسها أدران الزوائد التي يغص بها معجم السرد الممتد بلا نهاية منطقية, نجد أنها لغة تترهل بالتعويم المستمر لنحوها ودلالتها, فأبنيتها الجُملية موغِلةٌ بالأمتداد الى المالانهاية ومعجمها يغص بحلقات مفرغة من الوحدات الدلالية المفتوحة على سيناريوهات الحرب. القارئ أمام لغة سردية راكدة, لا تجري لكنها تدور وتدور في أحواض دلالية طافحة غير قابلة للتصريف, على العكس تماما من لغة (جويس وكونديرا) , فهي لغةٌ تكاد أن تكون صفرية, محسوبة بدقة, متطهرة من جميع أدران الفائض اللغوي فتجد جملها وسردها يتقافزان متخففان من كل شيء ما عدا الوضوح والأحكام.
ولا ينتهي الأمر بنص (لؤي حمزة عباس) عند هذه اللغة الطافحة فحسب, بل يتعداه الى ما هو أشد خطورة من مجرد أبنية نحوية أفعوانية وحلقات دلالية مدومة. ان البُنية المفاهيمية الأساسية التي تدعم عادةً مجمل البناء السردي للنص وتنتصب كسقالة بَنّاء ماهر تُسنِد الفيوضات اللغوية لنص السارد, هذه البُنية في أرتكازاتها المفاهيمية الأساسية مأخوذة الى حدٍ كبير (في نص لؤي حمزة عباس) من نفس الوسط المفاهيمي الذي أسسه (كونديرا) في روايته (خفة الكائن التي لا تحتمل).
فقضية البراز عند (لؤي حمزة عباس) هي الأخرى قضية ميتافيزيقية, يتمفصل عندها طرفي الوجود البشري بشقيه الميتافيزيقي (المتعالي) والأرضي (المتسافِل):
" منذ أن استل جبرائيل وسطاه من إست أدم, وأدم, حتى هذه الساعة, ولما لا يعد ولا يدرك من الساعات, يلتذ بما يخرج منه, لذاذة الراحة والمراح . . . وهو يزيد من أرتباطه بالأرض . . فيقوم وفي جسده شيء من خفة يُخلفُها الجهد والدفء والرائحة, وعذوبة غريبة توطد أحساساً مبهماً . . ., موحِداً بينه وبين أشد الكائنات نتانة, وبينه وبين صاحب الأصبع العتيق, فالعملية . . . تُحرِكُ ظل جبرائيل المحبوس في طين جسده الآدمي."
هذا بلا شك مجرد تنويع مفاهيمي أخر أستعارهُ (لؤي حمزة عباس) من رؤية (كونديرا) للبراز بصفته قضيةٌ ميتافيزيقية. فالأستفراغ بحد ذاته يستفز فينا (أحساساً مبهماً), يعمل على خلق ذاكرة توحيدية مزدوجة: واحدية الجسد بكل أعراضه الأرضية (الطينية) من جهة, وواحدية الظلال المقدسة الرازحة تحت ثقل هذا الطين المُتَبَرِز للجسد من جهةٍ أخرى. تلك هي مرةً أخرة ثنائية (كونديرا) الشهيرة ولكن بتنويع صوفي أخر أستحضره نص (لؤي حمزة عباس): تخفف الجسد (ترويحه بالعرف الصوفي) أزاء تثقيل الروح (تجسيدها) وهي في أسر الطين الآدمي الثقيل.
فلؤي حمزة عباس لا يشتغل مفاهيمياً على الاطلاق الا ضمن خبايا الثنائيات التي أبدعها (كونديرا) سلفاً في روايته المذكورة آنفاً, وأول هذه الثنائيات وأهمها واكثرها حضورا وتميزا ثنائية (الخفة والثقل) مقترنةً معجمياً بمفردة فارقة للغة (كونديرا) هي مفردة (الكائن) والتي تكررت الى حدٍ ما في نص (لؤي حمزة عباس) مقترنةً على الدوام بمفهومي الثقل والخفة:
"ربما كان من أعراف الحروب الكبيرة الطاحنة, أن يحمل الجندي أقراصاً وإبراً ومراهم, في محاولةٍ منه لمحاصرة الكائن فناءه, وللجسد حصاره المكين, إيقاع سطوته, فبعد كم من الأيام لن يكون بامكانه التجلد والرضوخ أمام ثقل ما خزن من ألم؟"
" . . . وهم يوقتون حيواتهم على مراسيم الحروب, مناسيب فتوتها اللاهبة, إذ تسحب الكائن, بلا هدىً . . ."
"هل يحرك المرحاض, بوصفه ملاذاً حسياً, شعورنا بالرضا والاطمئنان؟ وهل يقودنا, عبر الأندماج بما صُمِمَ له من وظائف, الى مصالحة ذواتنا وهي تتخفف مما حُمِلَت أجسادنا من أدران؟"
ولكن ما يُحسَب (للؤي حمزة عباس) هو تحقيقه لحالة أستثنائية من التماهي الأسلوبي بين الثيمة الرمزية للمراحيض الطافحة بالبراز أبداً واللغة الطافحة هي الأخرى بنحوها المحتشد وهو يكدس الجمل فوق بعضها البعض حتى أن ذاكرة القارئ لا تُسعِفه في تذكر بداية الجملة بمجرد بلوغه نهايتها بعد لأيٍ وعناء.
يقول لابورت في كتابه (تأريخ البراز): " ربما لا يجرؤ أحدٌ على الحديث عن البراز, ولكن منذ بدأ الخليقة لم يوجد موضوع أكثر منه – ولا حتى الجنس – جعلنا نتحدث عنه بهذا القدر".
تلك مفارقةٌ غريبة! أكثر الأشياء المسكوت عنها هي أكثر الأشياء التي نتحدث عنها. لا يمكن التعاطي مع مفارقة (لابورت) هذه الا عبر نوع من السحب المشفر لماهية البراز الرمزية. فنحن ربما نتجنب الخوض المباشر في الكثير من المحظورات لبذائتها الظاهرة وأولها (البراز), لكننا بالمقابل نخوض غمار الحديث في جميع القضايا التي تطفو على سطح خفيف نوعاً ما من القبح فيما تقبع كتلة القبح الكثيف في القاع بسلام دون أن يستفز صفوها أحد, فالبحيرة راكدة وأحاديثنا صبيانية تخدش سطحها فحسب. وحينما نتحدث عن السلطة, والنفوذ, والسيطرة, والفوضى, والجنس فأننا بشكل أو بأخر نستحضر جرعات مخففة من (البراز).
إن الفنان فحسب هو ما يجعلنا نحدق عن كثب في خفايا القبح والبذاءة بحثاً عن الجمال فللقبح جمالياته أيضاً. فمَنْ غيرَ (جويس) يجرؤ على مماحكة (فعل القراءة) عبر قرينة الجلوس في المرحاض والتبرز بعد امساك معوي طفيف؟ مَنْ غير (كونديرا) يجرؤ على مسك طرفي الوجود البشري المتناحرين ليحبكهما معاً في رباط واحدٍ لا أنفكاك له: رباط السماء والأرض, رباط الميتافيزيقيا والبراز؟ مَن غير (لؤي حمزة عباس) يجرؤ على إغراق جسد لغته بأحواض المراحيض بكل ما تختزنه من مقموعات وتواطؤات محظورة!
مَنْ؟