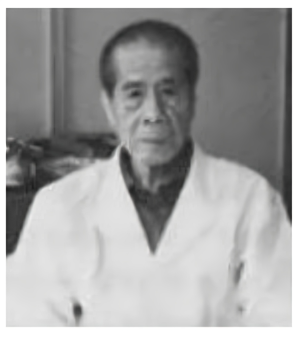كانت الشقة ساكنة كصفحة ماء تُخفي تحتها حَجرًا. بابٌ بلا كسر، نافذة مغلقة، مصباح في المطبخ ظلَّ مشتعلًا كعينٍ لا تنام. على الأرض رجل في الأربعين، على صدره زهرة سوداء اسمها الطعنة. لا صراخ سُجِّل، لا كاميرا تُراجَع، لا جار أقسَم أنه رأى. بدا وكأن القاتل جاء من بين الجدران وعاد إليها.
في الدقيقة الأولى من وصول الشرطة والنيابة، طوَّقوا المكان. الأقدام التي دخلت، دخلت بأغطية، والأيدي لامسَت بقفازات. كُلّف فردٌ واحد فقط بفتح الأبواب وملامسة المفاتيح. صُوِّر المشهد في لقطات شاملة ثم قريبة؛ وُضعت دلائل مرقَّمة قُرب كل أثر محتمل: كوب زجاجي على الرخام، محفظة جلدية سوداء على الطاولة، نقطة بُنِّية على مقبض الباب الداخلي، خدشٌ خفيف تحت ظفر اليد اليسرى للقتيل. كُلّ كيسٍ شفاف أُغلق بشريط لاصق ممهور برقم الدعوى.
الطب الشرعي جاء بثقل خبرته: طعنة نافذة بالقلب، زاويتها حادة، اتجاهها من اليمين إلى اليسار قليلًا، قوة يدٍ تعرف أين تذهب. لا آثار بعثرة، لا مقاومة صريحة، لكن تحت أظافر اليد اليسرى كشطٌ ميكروسكوبي كأنه احتكاك خاطف. درج النقود مغلق، المفاتيح في الجيب، الهاتف على الشاحن. لم يأتِ أحد ليسرق؛ جاء شخصٌ يعرف الرجل ويعرف الشقة.
المحفظة بدت وحيدة بين الأشياء. حين فُتحت بحضور النيابة، ليس بها سوى إيصالات أمانة على بياض، التوقيع عليها ليس للقتيل، قالها تقرير أبحاث التزييف. كانت أوراقًا نظيفة كفخ: ما تزال تؤدي وظيفتها حتى قبل أن تُكتب.
أخَذ فريق الأدلة القطن المعقم ومسَح حواف الكوب، فم الكوب، منطقة المقبض الداخلي. وُضعت المسحات في أنابيب محكمة، وأُرسلت إلى المعمل. أُخذت قصاصات دقيقة من تحت أظافر القتيل. كل شيء بموعدٍ وتوقيع.
الجيران قالوا جملة واحدة بأشكال مختلفة: “لم نسمع شيئًا.” وأحدهم حَلف أنَّ الرجل يعيش وحيدًا، وآخَر ذكرَ أن ضيوفه نادرون، وثالث استرجع صوت جِدال قبل أسبوعين توقف عند الدرج.
التحريات فتّشت في الديون، في الاتصالات الأخيرة، في الرسائل المحذوفة التي عاد بها المختص من ذاكرة الهاتف. دائرة الاشتباه اتسعت ثم ضاقت إلى أربعة: صديقٌ قديم، شريكٌ في مشروع صغير لم يكتمل، سمسار تعثرت بينهما صفقة، وجارٌ في البناية لم يُعرَف عنه سوى كثرة السؤال عن الرجل.
بأمر النيابة، أُخذت عينات مرجعية من الأربعة: مسحات فموية، وُضعت في مغلفات مستقلة، أُغلقت وخُتمت كأي حرز. في المعمل، أُجريت مضاعفة للحمض النووي، رُسمت بصمة وراثية لكل عينة، ثم جاء الجدول الذي لا يحب أحد أن يُقارَن به: تطابقت عينة واحدٍ منهم - ذلك الصديق القديم - مع الحمض النووي الموجود على مقبض الباب، ومع اللعاب على حافة الكوب، ومع أثرٍ جلدي تحت ظفر الضحية. ثلاث نقاط تشير إلى اسم واحد كأنها سهام تُساقط الأقنعة.
استُدعي. جلس قبالة المحقق، حاول أن يضع ابتسامة مُتعَبة. سأله عن آخر زيارة، ادَّعى أنها قبل شهر. ذُكرَت له آثار لعابه على الكوب، قال: "شربتُ معه قهوة قديمة". ذُكر له أثر الجلد تحت ظِفر الضحية، صمَت. ذُكرت إيصالات الأمانة التي كانت تُطارده بها الرسائل، ارتفع صدره وهبَط. حين قيل له إن الدَّين كبير، وأن الضحية طالبَه به قبل يومين، قال الجملة التي تُغيِّر كل شيء: "كنت سأعيدها… لكنه هو مَن استفزني".
اعترف. قال إنه جاء ليرضي الرجل ولو بأجل، انتهى الحديث حادًا، دفعه، سقطا لحظة، امتدت اليد إلى السكين المعلّقة على الحائط، طعنة واحدة، “لم تكن نية قتل” - هكذا قال - ثم فرّ. أما الثلاثة الآخرون فقد سماهم شركاءَه. في بيتٍ آخر من الأكاذيب: قال إنهم يعرفون، وإنهم ساعدوه من بعيد. لم يجد العلم أثرًا لهم في الشقة، لكن التحريات حملت أسماءهم إلى الملف كظلال.
جلسنا على المنصة بملفٍ ثقيل. في القفص أربعة: واحدٌ رأسه مُنكَّس، ثلاثة يتطلعون إلى المنصة وكأنهم يُجدفون بعيدًا عن تيار لا يرحم. القاعة مكتومة الصوت إلا من حفيف الورق. فتحتُ حرز المحفظة في مواجهتهم، وضعتها أمامي. لم تكن الأوراق في نظري مجرد أوراق؛ كانت خيطًا يربط الدافع بالمشهد.
سألتهم عن العلاقات، عن المواعيد، عن الرسائل، عن الأصوات في الليل. سألتُ الثلاثة الذين لا دليل عليهم سوى التحريات. أجابوا أنهم لا يعرفون إلا صداقة عابرة أو جيرةٍ سلامها على السلم. كان سؤالي بلا انفعال. أشرتُ لهم بالعودة إلى القفص، ولكني أطرقتُ لأفكر في أي شيء، وإذا بعبارة ينطق بها لساني دون تفكير أو إعداد مسبق، قلت وأنا أشيعهم بنظري إلى القفص: "صاحب المحفظة يأتي ليتسلمها".
وفي لحظةٍ لا يحكمها ميزان المنطق، عاد "الصديق" خُطوة إلى الخلف، حركة غريزية تفضح أكثر مما تُخفي. أدرك ما فعل، فتسمَّرت قدمه في الأرض، حدَّق في المنصة بعينين تريدان أن تبتلعا مكانهما. ارتجَّت القاعة بلفظٍ واحدٍ من فمٍٍ واحد: "الله أكبر". طرقتُ بالمطرقة مرتين، صمتٌ سريع بعد عاصفة قصيرة.
رُفعَت الجلسة للمداولة. في الغرفة الخلفية، قبل أن نجلس نحن القضاة، سألني أحد الزملاء متهللا: "ما الذي دعاك إلى هذه العبارة؟" قلتُ: "لا أدري… لساني قالها قبل أن أفكر". ربما لأن العدالة، حين تكتمل الخيوط، لا تحتاج إلا إلى دفعة صغيرة تُسقط آخر ورقة توت.
لكنني بَعدها تَذكرتُ، وقصَصتُ لهم القصة، وكيف تجودُ الذاكرة على الإنسان بما اختزنته في ظرف ما، مع حلول مثله دون أن يَمَد إلى استدعائها: كنا في العام 1988 وكنتُ وقتها معاونا للنيابة العامة بنيابة منوف بمحافظ المنوفية، ذات يوم انتُدبت لتمثيل النيابة العامة بمحكمة جنايات شبين الكوم.
كان رئيس الجلسة المستشار عبد الرحمن الفيل - رحمه الله - وكانت قضية قتل، المتهمون فيها كُثر، وجيء بحرز الفأس على المنصة، وعندما غادروا من أمامه في طريقهم إلى القفص، قال: صاحب الفأس يرجع ليأخذها، فارتدَّ للخلف أحدهم لا إراديا. ولكنها لم تحضرني البتَّة قبل نظر قضيتنا.
عدنا إلى القاعة، نطقتُ القرار: إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي... القرار صريح، لا يقفل الباب بل يفتحه على إجراءٍ تتطلبه العدالة حين توقف إنسانًا على الحافة. الصمت الذي بدأ مع أول قطرة دم عاد إلى القاعة، لكنه هذه المرة كان صمتًا يليق بالجُمل الكبرى.
في مذكراتي بعد الحكم، كتبتُ: "حين يصمت الشهود خوفًا… تتكلم الجثث عِلمًا". وأضفت جملة أهدأ: "والعلم لا يصدق إلا إذا حُفِظ طريقه من باب الشَقة إلى باب المعمل".
أما الثلاثة الآخرون فقد ظلوا هناك، في منطقة بين الظل والنور. التحريات - بكل قوتها على الورق -لم تجد لها توأمًا في أثرٍ مادي. لم نخرج عن عادتنا: الكلام بلا سندٍ يظل كلامًا. لم ندِنهم بدليل لا يقف على قدميه.
لم تكن العدالة أسرع من الريح، لكنها لا تنام. وإذا صمَت البشر، وإذا اختبأ الخوف في زوايا القلوب، وإذا بدت الجدران أعلى من أن تُختَرق، يظل هناك شاهدٌ لا ينطق، يطلب فقط أن يُحمَل كما ينبغي، وأن يُحكى كما وقع، ليقول بصمته ما لا يَقدر عليه صوت.
بعدها جلستُ أتدبر ما حدث، لم تكن الجملة التي قُلتها مخططًا لها، ولم أضعها كملاحظة في هامش الرول، ولكن الله أنطق لساني بها قبل أن تستوي فكرة ما حولها، في رأسي.
إنه تسخير إلهي، حين لا يجد القاضي كلامًا بعد أن يُتم مناقشته المهنية للمتهمين، وحين يُطرق بُرهة فتنبع من لسانه عبارة لم يُخطّط لها في أوراقه، ولم يُعدُّها في ذهنه. عندئذٍ، ليس لأحدٍ أن يجزم بشيء، إلا أن يقول: إن الله كان معنا فوق المنصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الله فوق المنصة.
في الدقيقة الأولى من وصول الشرطة والنيابة، طوَّقوا المكان. الأقدام التي دخلت، دخلت بأغطية، والأيدي لامسَت بقفازات. كُلّف فردٌ واحد فقط بفتح الأبواب وملامسة المفاتيح. صُوِّر المشهد في لقطات شاملة ثم قريبة؛ وُضعت دلائل مرقَّمة قُرب كل أثر محتمل: كوب زجاجي على الرخام، محفظة جلدية سوداء على الطاولة، نقطة بُنِّية على مقبض الباب الداخلي، خدشٌ خفيف تحت ظفر اليد اليسرى للقتيل. كُلّ كيسٍ شفاف أُغلق بشريط لاصق ممهور برقم الدعوى.
الطب الشرعي جاء بثقل خبرته: طعنة نافذة بالقلب، زاويتها حادة، اتجاهها من اليمين إلى اليسار قليلًا، قوة يدٍ تعرف أين تذهب. لا آثار بعثرة، لا مقاومة صريحة، لكن تحت أظافر اليد اليسرى كشطٌ ميكروسكوبي كأنه احتكاك خاطف. درج النقود مغلق، المفاتيح في الجيب، الهاتف على الشاحن. لم يأتِ أحد ليسرق؛ جاء شخصٌ يعرف الرجل ويعرف الشقة.
المحفظة بدت وحيدة بين الأشياء. حين فُتحت بحضور النيابة، ليس بها سوى إيصالات أمانة على بياض، التوقيع عليها ليس للقتيل، قالها تقرير أبحاث التزييف. كانت أوراقًا نظيفة كفخ: ما تزال تؤدي وظيفتها حتى قبل أن تُكتب.
أخَذ فريق الأدلة القطن المعقم ومسَح حواف الكوب، فم الكوب، منطقة المقبض الداخلي. وُضعت المسحات في أنابيب محكمة، وأُرسلت إلى المعمل. أُخذت قصاصات دقيقة من تحت أظافر القتيل. كل شيء بموعدٍ وتوقيع.
الجيران قالوا جملة واحدة بأشكال مختلفة: “لم نسمع شيئًا.” وأحدهم حَلف أنَّ الرجل يعيش وحيدًا، وآخَر ذكرَ أن ضيوفه نادرون، وثالث استرجع صوت جِدال قبل أسبوعين توقف عند الدرج.
التحريات فتّشت في الديون، في الاتصالات الأخيرة، في الرسائل المحذوفة التي عاد بها المختص من ذاكرة الهاتف. دائرة الاشتباه اتسعت ثم ضاقت إلى أربعة: صديقٌ قديم، شريكٌ في مشروع صغير لم يكتمل، سمسار تعثرت بينهما صفقة، وجارٌ في البناية لم يُعرَف عنه سوى كثرة السؤال عن الرجل.
بأمر النيابة، أُخذت عينات مرجعية من الأربعة: مسحات فموية، وُضعت في مغلفات مستقلة، أُغلقت وخُتمت كأي حرز. في المعمل، أُجريت مضاعفة للحمض النووي، رُسمت بصمة وراثية لكل عينة، ثم جاء الجدول الذي لا يحب أحد أن يُقارَن به: تطابقت عينة واحدٍ منهم - ذلك الصديق القديم - مع الحمض النووي الموجود على مقبض الباب، ومع اللعاب على حافة الكوب، ومع أثرٍ جلدي تحت ظفر الضحية. ثلاث نقاط تشير إلى اسم واحد كأنها سهام تُساقط الأقنعة.
استُدعي. جلس قبالة المحقق، حاول أن يضع ابتسامة مُتعَبة. سأله عن آخر زيارة، ادَّعى أنها قبل شهر. ذُكرَت له آثار لعابه على الكوب، قال: "شربتُ معه قهوة قديمة". ذُكر له أثر الجلد تحت ظِفر الضحية، صمَت. ذُكرت إيصالات الأمانة التي كانت تُطارده بها الرسائل، ارتفع صدره وهبَط. حين قيل له إن الدَّين كبير، وأن الضحية طالبَه به قبل يومين، قال الجملة التي تُغيِّر كل شيء: "كنت سأعيدها… لكنه هو مَن استفزني".
اعترف. قال إنه جاء ليرضي الرجل ولو بأجل، انتهى الحديث حادًا، دفعه، سقطا لحظة، امتدت اليد إلى السكين المعلّقة على الحائط، طعنة واحدة، “لم تكن نية قتل” - هكذا قال - ثم فرّ. أما الثلاثة الآخرون فقد سماهم شركاءَه. في بيتٍ آخر من الأكاذيب: قال إنهم يعرفون، وإنهم ساعدوه من بعيد. لم يجد العلم أثرًا لهم في الشقة، لكن التحريات حملت أسماءهم إلى الملف كظلال.
جلسنا على المنصة بملفٍ ثقيل. في القفص أربعة: واحدٌ رأسه مُنكَّس، ثلاثة يتطلعون إلى المنصة وكأنهم يُجدفون بعيدًا عن تيار لا يرحم. القاعة مكتومة الصوت إلا من حفيف الورق. فتحتُ حرز المحفظة في مواجهتهم، وضعتها أمامي. لم تكن الأوراق في نظري مجرد أوراق؛ كانت خيطًا يربط الدافع بالمشهد.
سألتهم عن العلاقات، عن المواعيد، عن الرسائل، عن الأصوات في الليل. سألتُ الثلاثة الذين لا دليل عليهم سوى التحريات. أجابوا أنهم لا يعرفون إلا صداقة عابرة أو جيرةٍ سلامها على السلم. كان سؤالي بلا انفعال. أشرتُ لهم بالعودة إلى القفص، ولكني أطرقتُ لأفكر في أي شيء، وإذا بعبارة ينطق بها لساني دون تفكير أو إعداد مسبق، قلت وأنا أشيعهم بنظري إلى القفص: "صاحب المحفظة يأتي ليتسلمها".
وفي لحظةٍ لا يحكمها ميزان المنطق، عاد "الصديق" خُطوة إلى الخلف، حركة غريزية تفضح أكثر مما تُخفي. أدرك ما فعل، فتسمَّرت قدمه في الأرض، حدَّق في المنصة بعينين تريدان أن تبتلعا مكانهما. ارتجَّت القاعة بلفظٍ واحدٍ من فمٍٍ واحد: "الله أكبر". طرقتُ بالمطرقة مرتين، صمتٌ سريع بعد عاصفة قصيرة.
رُفعَت الجلسة للمداولة. في الغرفة الخلفية، قبل أن نجلس نحن القضاة، سألني أحد الزملاء متهللا: "ما الذي دعاك إلى هذه العبارة؟" قلتُ: "لا أدري… لساني قالها قبل أن أفكر". ربما لأن العدالة، حين تكتمل الخيوط، لا تحتاج إلا إلى دفعة صغيرة تُسقط آخر ورقة توت.
لكنني بَعدها تَذكرتُ، وقصَصتُ لهم القصة، وكيف تجودُ الذاكرة على الإنسان بما اختزنته في ظرف ما، مع حلول مثله دون أن يَمَد إلى استدعائها: كنا في العام 1988 وكنتُ وقتها معاونا للنيابة العامة بنيابة منوف بمحافظ المنوفية، ذات يوم انتُدبت لتمثيل النيابة العامة بمحكمة جنايات شبين الكوم.
كان رئيس الجلسة المستشار عبد الرحمن الفيل - رحمه الله - وكانت قضية قتل، المتهمون فيها كُثر، وجيء بحرز الفأس على المنصة، وعندما غادروا من أمامه في طريقهم إلى القفص، قال: صاحب الفأس يرجع ليأخذها، فارتدَّ للخلف أحدهم لا إراديا. ولكنها لم تحضرني البتَّة قبل نظر قضيتنا.
عدنا إلى القاعة، نطقتُ القرار: إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي... القرار صريح، لا يقفل الباب بل يفتحه على إجراءٍ تتطلبه العدالة حين توقف إنسانًا على الحافة. الصمت الذي بدأ مع أول قطرة دم عاد إلى القاعة، لكنه هذه المرة كان صمتًا يليق بالجُمل الكبرى.
في مذكراتي بعد الحكم، كتبتُ: "حين يصمت الشهود خوفًا… تتكلم الجثث عِلمًا". وأضفت جملة أهدأ: "والعلم لا يصدق إلا إذا حُفِظ طريقه من باب الشَقة إلى باب المعمل".
أما الثلاثة الآخرون فقد ظلوا هناك، في منطقة بين الظل والنور. التحريات - بكل قوتها على الورق -لم تجد لها توأمًا في أثرٍ مادي. لم نخرج عن عادتنا: الكلام بلا سندٍ يظل كلامًا. لم ندِنهم بدليل لا يقف على قدميه.
لم تكن العدالة أسرع من الريح، لكنها لا تنام. وإذا صمَت البشر، وإذا اختبأ الخوف في زوايا القلوب، وإذا بدت الجدران أعلى من أن تُختَرق، يظل هناك شاهدٌ لا ينطق، يطلب فقط أن يُحمَل كما ينبغي، وأن يُحكى كما وقع، ليقول بصمته ما لا يَقدر عليه صوت.
بعدها جلستُ أتدبر ما حدث، لم تكن الجملة التي قُلتها مخططًا لها، ولم أضعها كملاحظة في هامش الرول، ولكن الله أنطق لساني بها قبل أن تستوي فكرة ما حولها، في رأسي.
إنه تسخير إلهي، حين لا يجد القاضي كلامًا بعد أن يُتم مناقشته المهنية للمتهمين، وحين يُطرق بُرهة فتنبع من لسانه عبارة لم يُخطّط لها في أوراقه، ولم يُعدُّها في ذهنه. عندئذٍ، ليس لأحدٍ أن يجزم بشيء، إلا أن يقول: إن الله كان معنا فوق المنصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الله فوق المنصة.