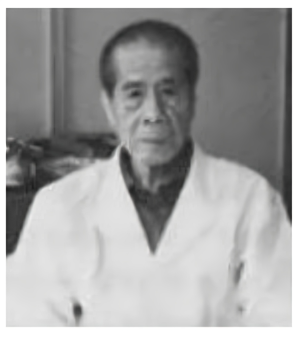في العام 2010 بمدينة حُدودية، كمينٌ مُترسِّخٌ في الأرض، كأنه جزء منها. أعينٌ لا تنام، وبنادقُ تلمَعُ في الشمس كأنها مَرايا للموت.
حواجز مرورية تَفرض على السائقين رَقصةً ثعبانية مُجبرة لا خيار فيها إلا البطء والخضوع.
تقدَّمَت سيارة نصفُ نقلٍ مُترنِّحة بحمولتها الخضراء، يعلوها البرسيم كغطاءٍ بريءٍ يُخفي ما تحته. وما أن اقتربت من الكمين، حتى التهمها الحصار من الجهات الأربع: جنودٌ كأنهم انبثقوا من الأرض، بأصواتٍ كالرعد وقفزاتٍ كالصواعق. في لحظة، صُوِّبت البنادق، وفُتحت الأبواب عُنوة.
هبطَ سائقٌ قرويٌّ مذهولٌ كمَن خرج لتوِّه من شاشة سينما، ومعه امرأة غزَّاوية، في الأربعين من عمرها، مكسوةٌ بالسواد لا بالخوف، تقفُ بثباتٍ لا تملك له وصفًا، كأنها جذع زيتونة لا تهزُّه الريح. ونزلً معها شابان من فوق البرسيم، قُيِّدوا جميعًا، سُحبوا كحكايةٍ من فم الريح، وسُلِّموا.
لكن القصة لم تبدأ بعد...
جنودٌ آخرون، أكثر مرونة وخبرة، يصعدون فوق البرسيم، يقذفونه أرضًا بحركاتٍ متسارعة، كأنهم يُمزقون سِتار مسرحٍ قبل العَرض. تظهر "الطبلية"، تُنتزع كأنها قِشرة كذب، وإذا بخمس بنادق آلية وصندوق ذخيرة، قُدِّر له أن يُدفَن حيًّا تحت عُشب أخضر لا ذنب له.
في تحقيقات النيابة العامة. لم تبكِ. لم تُنكر. في المحكمة رفعَت رأسها كما رفعَت بندقيتها في قلبها من قبل. بصوتٍ أجَش، صلب، خالٍ من الرعشة، قالت:
"هي أسلحتي، والذخيرة ذخيرتي. خبأتُها بنفسي تحت البرسيم، ولم يعلم أحد من مرافقِيَّ شيئًا. هؤلاء أبرياء، وخُدِعوا كما خُدِع العالم يوم سكتَ عن المذبحة."
سردَت قصتها كمن يسرد تاريخه بالدموع المكتومة. تحدَّثت عن بيتٍ اقتحمَه العدُو، عن ثلاث بناتٍ جُرِّدن من أثوابهن، عن ابنٍ ضُرب حتى سالت طفولته على الأسفلت، عن أسبوعين من العار المعتَّق في زنازين المحتل.
قدَّمت للنيابة مستندات، وصورًا من الصحف، وأدلة موثقة، تُظهر واقعة اقتحام بيتها. ثبت ما قالته، وتأكَّد.
القاعةُ ترتجف. جدرانها تلتقط أنفاسها بصعوبة. الصمتُ ثقيلٌ كالكلمات غير المنطوقة. داخل القفص، لا متهمين، بل رايات بشَرية تُرفرف بعناد. المحكمة أمام مأزق لم يُدرَّس في كليات الحقوق.
واجههُم القاضي بالتهمة، فما أنكر أحد. حتى أولئك الذين سعَت المرأة لتبرئتهم اعترفوا، ورفعوا رؤوسهم بفخر، قالوا: "بل نحن من جَلب لها السلاح والذخيرة، وساعدناها، نحن رجال، لا أقل منها غَيرة ولا شهامة".
حين جاء الدور على الدفاع ليتكلم، رفعَت المرأة يدها من القفص، واستأذنت بالكلام، تقدمت، ووقفت بثبات، وقالت:
"إن فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وقفت أمام أبي بكر الصدِّيق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدافع عن حقها في أرض فدك، ولم يمنعها أحد من أن تترافع عن نفسها، فدعوني أقول قولي".
ساد الصمتُ أرجاء القاعة، واشرَأبَّت الأعناق إليها، واسترسلت:
"دخل الغاصبون بَيتي كما داسُوا أرضي. ضربوا بناتي، وجرَّدونا من ملابسنا، حتى صِرنا كما ولدتنا أمهاتنا. دهسُوا طعامنا، وحطموا ما في الدار، وتركوا ذلك كله 'إنذارًا'.
خرجتُ من الأسر بعد أسبوعَين، لا أنسَى ما عِشته. غَلَت الدماء في عروقي، شعرتُ بالمذلة والعار، فقررتُ أن أثأر لكرامتي، لبَيتي، لأرضي، لعِرضي، لبناتي. اشتريتُ السلاح وخبأته وكنتُ عائدة به إلى وطني.
أصبحَت المحكمة في مأزق لم تَعرف مثله. الاعتراف ساطع. السلاح بين أيديهم. والنية مُعلنَة. فكيف تُبرِّئ من ثبتت عليه الجريمة؟ لكن الضمير كان أثقل من الورق، والوجدان أبلغ من القانون.
في المداولة، نظر القضاةُ بعضهم إلى بعض، بوجوهٍ يَسكنها الصمتُ وتُفصِحُ عن صراعٍ داخلي عنيف.
تكلمَ رئيس الجلسة، سأل زميله الأحدث رأيه، فصمَت. فسأل الأقدم منه، فمالت رموشه نحو الأرض، كأنهم جميعا يُصلُّون في صمت، لا يريدون قول ما يُثقِلُ أرواحهم.
لم يجد الرئيس بُدًا من أن يتكلم أولا، كمن قرَّر أن يطعن تقاليد المداولة بخِنجر الرحمة. قال بلا تردد: "سنقضي ببراءتهم. لا لسببٍ قانونيٍّ أستطيع صَوغه الآن، بل لسببٍ إنسانيٍّ تتلعثم أمامه القوانين."
نطقَ زميلاه في صوتٍ واحد: "ونحن معك." ثم عانقاه كما يُعانَق المُنتصر بعد معركةٍ روحية مريرة. وانحدرت الدموع في صمت من تحت الأجفان التي يظنُّها الناسُ من حَجَر.
أمسكَ القلم، الذي ارتعشت به أنامله لا من التردُّد، بل من فرَحٍ مَهيب، وكتَب:
"حكمَت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهمين مما نُسِبَ ىإليهم، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة." فانفجر الحضور بصوتٍ زَلزلَ الجدران: "الله أكبر!"
ثم كتب رئيس الجلسة في سِرِّه: لقد نطقنا بكلمة الحق، وما كان ذلك إلا بتوفيق من الله، الذي يُنطِقُ كل شيء، وهو على كل شيء قدير.
ثم كانت المفاجأة... النيابة العامة لم تطعن على الحكم!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) نساء في قفص الاتهام.
حواجز مرورية تَفرض على السائقين رَقصةً ثعبانية مُجبرة لا خيار فيها إلا البطء والخضوع.
تقدَّمَت سيارة نصفُ نقلٍ مُترنِّحة بحمولتها الخضراء، يعلوها البرسيم كغطاءٍ بريءٍ يُخفي ما تحته. وما أن اقتربت من الكمين، حتى التهمها الحصار من الجهات الأربع: جنودٌ كأنهم انبثقوا من الأرض، بأصواتٍ كالرعد وقفزاتٍ كالصواعق. في لحظة، صُوِّبت البنادق، وفُتحت الأبواب عُنوة.
هبطَ سائقٌ قرويٌّ مذهولٌ كمَن خرج لتوِّه من شاشة سينما، ومعه امرأة غزَّاوية، في الأربعين من عمرها، مكسوةٌ بالسواد لا بالخوف، تقفُ بثباتٍ لا تملك له وصفًا، كأنها جذع زيتونة لا تهزُّه الريح. ونزلً معها شابان من فوق البرسيم، قُيِّدوا جميعًا، سُحبوا كحكايةٍ من فم الريح، وسُلِّموا.
لكن القصة لم تبدأ بعد...
جنودٌ آخرون، أكثر مرونة وخبرة، يصعدون فوق البرسيم، يقذفونه أرضًا بحركاتٍ متسارعة، كأنهم يُمزقون سِتار مسرحٍ قبل العَرض. تظهر "الطبلية"، تُنتزع كأنها قِشرة كذب، وإذا بخمس بنادق آلية وصندوق ذخيرة، قُدِّر له أن يُدفَن حيًّا تحت عُشب أخضر لا ذنب له.
في تحقيقات النيابة العامة. لم تبكِ. لم تُنكر. في المحكمة رفعَت رأسها كما رفعَت بندقيتها في قلبها من قبل. بصوتٍ أجَش، صلب، خالٍ من الرعشة، قالت:
"هي أسلحتي، والذخيرة ذخيرتي. خبأتُها بنفسي تحت البرسيم، ولم يعلم أحد من مرافقِيَّ شيئًا. هؤلاء أبرياء، وخُدِعوا كما خُدِع العالم يوم سكتَ عن المذبحة."
سردَت قصتها كمن يسرد تاريخه بالدموع المكتومة. تحدَّثت عن بيتٍ اقتحمَه العدُو، عن ثلاث بناتٍ جُرِّدن من أثوابهن، عن ابنٍ ضُرب حتى سالت طفولته على الأسفلت، عن أسبوعين من العار المعتَّق في زنازين المحتل.
قدَّمت للنيابة مستندات، وصورًا من الصحف، وأدلة موثقة، تُظهر واقعة اقتحام بيتها. ثبت ما قالته، وتأكَّد.
القاعةُ ترتجف. جدرانها تلتقط أنفاسها بصعوبة. الصمتُ ثقيلٌ كالكلمات غير المنطوقة. داخل القفص، لا متهمين، بل رايات بشَرية تُرفرف بعناد. المحكمة أمام مأزق لم يُدرَّس في كليات الحقوق.
واجههُم القاضي بالتهمة، فما أنكر أحد. حتى أولئك الذين سعَت المرأة لتبرئتهم اعترفوا، ورفعوا رؤوسهم بفخر، قالوا: "بل نحن من جَلب لها السلاح والذخيرة، وساعدناها، نحن رجال، لا أقل منها غَيرة ولا شهامة".
حين جاء الدور على الدفاع ليتكلم، رفعَت المرأة يدها من القفص، واستأذنت بالكلام، تقدمت، ووقفت بثبات، وقالت:
"إن فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وقفت أمام أبي بكر الصدِّيق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدافع عن حقها في أرض فدك، ولم يمنعها أحد من أن تترافع عن نفسها، فدعوني أقول قولي".
ساد الصمتُ أرجاء القاعة، واشرَأبَّت الأعناق إليها، واسترسلت:
"دخل الغاصبون بَيتي كما داسُوا أرضي. ضربوا بناتي، وجرَّدونا من ملابسنا، حتى صِرنا كما ولدتنا أمهاتنا. دهسُوا طعامنا، وحطموا ما في الدار، وتركوا ذلك كله 'إنذارًا'.
خرجتُ من الأسر بعد أسبوعَين، لا أنسَى ما عِشته. غَلَت الدماء في عروقي، شعرتُ بالمذلة والعار، فقررتُ أن أثأر لكرامتي، لبَيتي، لأرضي، لعِرضي، لبناتي. اشتريتُ السلاح وخبأته وكنتُ عائدة به إلى وطني.
أصبحَت المحكمة في مأزق لم تَعرف مثله. الاعتراف ساطع. السلاح بين أيديهم. والنية مُعلنَة. فكيف تُبرِّئ من ثبتت عليه الجريمة؟ لكن الضمير كان أثقل من الورق، والوجدان أبلغ من القانون.
في المداولة، نظر القضاةُ بعضهم إلى بعض، بوجوهٍ يَسكنها الصمتُ وتُفصِحُ عن صراعٍ داخلي عنيف.
تكلمَ رئيس الجلسة، سأل زميله الأحدث رأيه، فصمَت. فسأل الأقدم منه، فمالت رموشه نحو الأرض، كأنهم جميعا يُصلُّون في صمت، لا يريدون قول ما يُثقِلُ أرواحهم.
لم يجد الرئيس بُدًا من أن يتكلم أولا، كمن قرَّر أن يطعن تقاليد المداولة بخِنجر الرحمة. قال بلا تردد: "سنقضي ببراءتهم. لا لسببٍ قانونيٍّ أستطيع صَوغه الآن، بل لسببٍ إنسانيٍّ تتلعثم أمامه القوانين."
نطقَ زميلاه في صوتٍ واحد: "ونحن معك." ثم عانقاه كما يُعانَق المُنتصر بعد معركةٍ روحية مريرة. وانحدرت الدموع في صمت من تحت الأجفان التي يظنُّها الناسُ من حَجَر.
أمسكَ القلم، الذي ارتعشت به أنامله لا من التردُّد، بل من فرَحٍ مَهيب، وكتَب:
"حكمَت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهمين مما نُسِبَ ىإليهم، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة." فانفجر الحضور بصوتٍ زَلزلَ الجدران: "الله أكبر!"
ثم كتب رئيس الجلسة في سِرِّه: لقد نطقنا بكلمة الحق، وما كان ذلك إلا بتوفيق من الله، الذي يُنطِقُ كل شيء، وهو على كل شيء قدير.
ثم كانت المفاجأة... النيابة العامة لم تطعن على الحكم!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) نساء في قفص الاتهام.