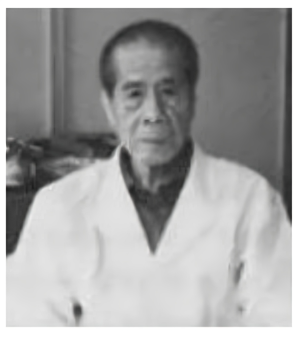لم تعد الجريمة مجرد خبر في صفحة الحوادث، بل مأساة إنسانية تتجاوز حدود الواقعة لتصيب ضمير المجتمع برمَّته، معلنة تسارع الأحداث، وتهاوى القيم أمام لحظة غضب.
حادثة إطلاق نار شهدتها إحدى القرى، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين والسبب خلاف على كلب من الكلاب التي يبتاعها الشباب. ليست مجرد قضية جنائية، بل جرس إنذار يدقّ في وجه مجتمع بدأ يعتاد مشاهد الدم، وكأنها مشهد يومي في مسلسل عبثي لا نهاية له.
ما الذي يدفع إنسانًا ليطلق النار على آخر دون أن يرتجف قلبه؟ كيف يتحول الإنسان من كائن عاقل إلى أداة قتل لمجرد أن تشتعل نيران الغضب أو الثأر في صدره؟
السؤال الأعمق: هل نحن ضحايا أفراد أم ضحايا بيئة كاملة؟ القاتل لم يُولد مجرمًا. إنه نتاج مجتمع يُبارك العنف، ويُشَرعن الانتقام تحت عناوين زائفة مثل "الكرامة" أو "الرجولة"، ويغرس في نفوس أبنائه أن التسامح ضعف، وأن كبح الغضب عيب لا يُغتفر.
في مثل هذه الحوادث، لا يُقتل شخص واحد فقط، بل تُغتال معها ثقة المجتمع، وتُرمَّل نساء، ويُيتَم أطفال، ويُصاب النسيج الاجتماعي كله بخدش غائر قد لا يُشفى. فالرصاصة ليست فعلًا لحظيًا، بل سلسلة ممتدة من الألم، تبدأ بالدماء ولا تنتهي عند حدود القبر. إنها مأساة تبدأ بلحظة وتدوم أثرًا في الذاكرة الجمعية لعقود.
في كثير من الأحيان، يُلقَّن الأبناء أن "حقك لا يعود إلا بيدك" بدلًا من أن نُربيهم على أن القانون هو السبيل الحقيقي للعدالة. ومع تكرار هذا النمط من العنف، تتضاءل هيبة المجتمع، ويتآكل الشعور بالأمان، ويفقد القانون معناه في الوعي الجمعي.
الفيلسوف أرسطو، حين تحدث عن الغضب، لم يُدنه بشكل مطلق، بل قال إن "المشكلة ليست في الشعور، بل في كيفية التعبير عنه: أن تغضب من الشخص المناسب، في الوقت المناسب، للسبب المناسب، وبالطريقة المناسبة".
لكن ما يحدث في مجتمعاتنا أن الغضب يتجاوز حدوده، ويتحوّل إلى حقد، ثم إلى رصاصة لا تقتل جسدًا فحسب، بل تصيب في مقتل ضمير المجتمع بأكمله.
الكرامة الحقيقية ليست في الرد على العنف بالعنف، بل في تجاوز الفعل، والسمو عنه، والاحتكام للعقل والعدالة. فالرصاصة الواحدة لا تُطلق على جسد، بل على مستقبل بأكمله، تترك خلفها أطفالًا بلا آباء، وأمهاتٍ بلا فلذات، وجيرانًا بلا ثقة، ومجتمعًا تتآكله الشكوك.
أخطر ما في الأمر، أن الحِس الإنساني قد يتبلَّد، فتمر الجريمة كأنها خبر طقس، نقرؤه ثم ننساه، ونعيش كأن الضحايا ليسوا منَّا. وهنا، يبدأ الخطر الحقيقي: التطبيع مع الدم، والاعتياد على الموت كحلّ.
وكلما زادت هذه الحوادث، ازداد معها التبلد، وتراجعت قدرة الناس على الغضب السليم أو الرفض الواعي.
حين تغيب العدالة أو تتأخر، يُفتح الباب للعنف ليملأ الفراغ. لكن الحل لا يكون أبدًا في أخذ القانون باليد، بل في معالجة جذور الخلل، من خلال: تعليم حقيقي للقيم الأخلاقية، لا شعارات جوفاء. تربية منزلية تبني إنسانًا مسؤولًا، لا ضحية جاهزة للانفجار. إعلام يعزز ثقافة التسامح والحكمة، لا يُمجّد العنف والانتقام. قانون عادل وسريع، يحفظ الحقوق بهيبة الدولة، لا بقسوتها.
لقد آن الأوان لأن نربَّي أبناءنا على أن الاعتذار لا يُنقص من الرجولة، وأن التسامح قوة لا يمتلكها إلا من امتلك نفسه. علينا أن نعيد للناس إيمانهم بأن القانون لا يزال قائمًا، وأن الحياة أغلى من أن تُختزل في لحظة غضب.
فكل رصاصة لا تقتل إنسانًا فقط، بل تطلق النار على حاضر وطن ومستقبله.
حادثة إطلاق نار شهدتها إحدى القرى، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين والسبب خلاف على كلب من الكلاب التي يبتاعها الشباب. ليست مجرد قضية جنائية، بل جرس إنذار يدقّ في وجه مجتمع بدأ يعتاد مشاهد الدم، وكأنها مشهد يومي في مسلسل عبثي لا نهاية له.
ما الذي يدفع إنسانًا ليطلق النار على آخر دون أن يرتجف قلبه؟ كيف يتحول الإنسان من كائن عاقل إلى أداة قتل لمجرد أن تشتعل نيران الغضب أو الثأر في صدره؟
السؤال الأعمق: هل نحن ضحايا أفراد أم ضحايا بيئة كاملة؟ القاتل لم يُولد مجرمًا. إنه نتاج مجتمع يُبارك العنف، ويُشَرعن الانتقام تحت عناوين زائفة مثل "الكرامة" أو "الرجولة"، ويغرس في نفوس أبنائه أن التسامح ضعف، وأن كبح الغضب عيب لا يُغتفر.
في مثل هذه الحوادث، لا يُقتل شخص واحد فقط، بل تُغتال معها ثقة المجتمع، وتُرمَّل نساء، ويُيتَم أطفال، ويُصاب النسيج الاجتماعي كله بخدش غائر قد لا يُشفى. فالرصاصة ليست فعلًا لحظيًا، بل سلسلة ممتدة من الألم، تبدأ بالدماء ولا تنتهي عند حدود القبر. إنها مأساة تبدأ بلحظة وتدوم أثرًا في الذاكرة الجمعية لعقود.
في كثير من الأحيان، يُلقَّن الأبناء أن "حقك لا يعود إلا بيدك" بدلًا من أن نُربيهم على أن القانون هو السبيل الحقيقي للعدالة. ومع تكرار هذا النمط من العنف، تتضاءل هيبة المجتمع، ويتآكل الشعور بالأمان، ويفقد القانون معناه في الوعي الجمعي.
الفيلسوف أرسطو، حين تحدث عن الغضب، لم يُدنه بشكل مطلق، بل قال إن "المشكلة ليست في الشعور، بل في كيفية التعبير عنه: أن تغضب من الشخص المناسب، في الوقت المناسب، للسبب المناسب، وبالطريقة المناسبة".
لكن ما يحدث في مجتمعاتنا أن الغضب يتجاوز حدوده، ويتحوّل إلى حقد، ثم إلى رصاصة لا تقتل جسدًا فحسب، بل تصيب في مقتل ضمير المجتمع بأكمله.
الكرامة الحقيقية ليست في الرد على العنف بالعنف، بل في تجاوز الفعل، والسمو عنه، والاحتكام للعقل والعدالة. فالرصاصة الواحدة لا تُطلق على جسد، بل على مستقبل بأكمله، تترك خلفها أطفالًا بلا آباء، وأمهاتٍ بلا فلذات، وجيرانًا بلا ثقة، ومجتمعًا تتآكله الشكوك.
أخطر ما في الأمر، أن الحِس الإنساني قد يتبلَّد، فتمر الجريمة كأنها خبر طقس، نقرؤه ثم ننساه، ونعيش كأن الضحايا ليسوا منَّا. وهنا، يبدأ الخطر الحقيقي: التطبيع مع الدم، والاعتياد على الموت كحلّ.
وكلما زادت هذه الحوادث، ازداد معها التبلد، وتراجعت قدرة الناس على الغضب السليم أو الرفض الواعي.
حين تغيب العدالة أو تتأخر، يُفتح الباب للعنف ليملأ الفراغ. لكن الحل لا يكون أبدًا في أخذ القانون باليد، بل في معالجة جذور الخلل، من خلال: تعليم حقيقي للقيم الأخلاقية، لا شعارات جوفاء. تربية منزلية تبني إنسانًا مسؤولًا، لا ضحية جاهزة للانفجار. إعلام يعزز ثقافة التسامح والحكمة، لا يُمجّد العنف والانتقام. قانون عادل وسريع، يحفظ الحقوق بهيبة الدولة، لا بقسوتها.
لقد آن الأوان لأن نربَّي أبناءنا على أن الاعتذار لا يُنقص من الرجولة، وأن التسامح قوة لا يمتلكها إلا من امتلك نفسه. علينا أن نعيد للناس إيمانهم بأن القانون لا يزال قائمًا، وأن الحياة أغلى من أن تُختزل في لحظة غضب.
فكل رصاصة لا تقتل إنسانًا فقط، بل تطلق النار على حاضر وطن ومستقبله.