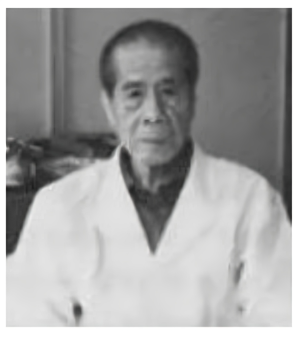كانت الحياة في تلك الدائرة تبدأ من خيطٍ يتدلّى بين عمودين من أعمدة الكهرباء، كوترٍ أوشك أن يتهتك من فرط التكرار. خيطٌ مشدود يحمل يافطةً باهتة، كأن يدًا غير مرئية علّقتها في جوف الليل، الخط العريضٍ يقول: "الحاج أبو شوق يهنّئ أهالي الدائرة الكرام بمناسبة..."
لم يعرف أحدٌ متى وُضعت، ولا مَن علَّقها، لكنها كانت دائمًا هناك، تطلّ في كل موسمٍ كما يطلّ القمر في ميعاده، شاهدةً على دورةٍ لا تنكسر من العطاء والاحتفاء.
في رمضان، تسبق موائده مدفع الإفطار؛ تتناثر الحقائب المملوءة بما لذّ وطاب في الأزقة قبل أن يُسأل، وفي العيد الكبير، تُذبَح الأضاحي على نفقته، وتُقسَّم اللحوم كما تُقسَّم المغانم في زمن الغزو القديم.
شيئًا فشيئًا، صار الرجل طيفًا يمرّ في الذاكرة كما يمرّ النسيم في ظهيرةٍ خانقة؛ لا يُرى، لكنه يُحسّ. وحين تساءل الناس عن هويته، جاءهم الجواب كأنه وحيٌ من الغيب: أغنى تُجّار الخردة في المدينة.
لكن هذا العام... بدا أن الطيف قرَّر أن يتجسَّد. اختفت يافطات التهنئة المألوفة، وظهرت أخرى جديدة، أكثر جرأةً ووضوحًا، كُتِب عليها بخطٍّ أكبر وأثقل: من أجلكم رشَّحتُ نفسي لانتخابات... وتحت العبارة، صورته مطبوعة بعناية، يجاورها رمزٌ أحمر قانٍ: الطربوش.
كان الاسم قد تسلّل إلى كل بيت، لا لفصاحته، بل لجرسه الذي يملأ الأذن بثقلٍ لا يُنسَى. وفي صباح التصويت، لاحظ رئيس اللجنة كيف تدفّق الناس نحو الاسم ذاته، وكيف أن الأميين الذين لم يخطّوا حرفًا في حياتهم صاروا يسألون بلهفةٍ طفولية: كيف نختار الحاج؟
لقد صار الرجل أيقونةَ البساطة، وورقةَ الأمل الأخيرة في دفتر الغلابة؛ الاسم الذي لا يُخطئه اللسان، والرمز الذي لا يُشير إلا إليه.
منتصف النهار، دوَّى صِخبٌ مفاجئ عند الباب. خطواتٌ صلبةٌ تشبه دقّ الطبول، وعدساتٌ تُضيء كوميض البرق. دخل رجلٌ قصير، كثّ الشارب، ضيّق العينين، ممتلئ البطن، يرتدي جلبابًا صوفيًّا في عزّ الصيف، وعلى رأسه طاقيةٌ مشدودة. خلفه رجالٌ طِوالٌ غِلاظ، كأنهم خرجوا من مشهدٍ سينمائي قديم. كان دخوله لوحةً ساخرةً تتحرّك، تجمع بين الهيبة والعبَث في آنٍ واحد.
جلس رئيس اللجنة يراقبه بعينٍ قاضٍٍ لا يُخفِي فضوله. تقدَّم الحاج نحو السِّجل، أمسك القلم كمن يمسك أداةً غريبة، وراح يخطّ اسمه بتأنٍّ شديد، يفصل بين الحروف كأن بينها خصومةً قديمة.
وبينما الصمت يملأ القاعة، دخلت امرأةٌ عجوز تسلمت بطاقة الانتخاب، توجهت صوب الصندوق ثم عادت بها تمسكها مقلوبة، وسألت ببراءةٍ عَفوية: "فين الطربوش يا أستاذ"؟ ضحك الحاج بصوتٍ ملأ المكان، وقال: "أنا الطربوش"!
ومع آخر ضوءٍ في المساء، نطق الصندوق. فوزٌ كاسحٌ لا جدال فيه. ارتفعت الهتافات، ورفرفت الأيادي بالدعاء، وتفتّحت في الغروب أزهارُ "الشكر" التي كانت بذورها "بونات" النهار.
وفي زاوية القاعة، بقيت صورة الطربوش تتدلّى من الحائط، تبتسم ببرودٍ ملوكي، كأنها تعرف أن اللعبة لم تنتهِ بعد.
لم يعرف أحدٌ متى وُضعت، ولا مَن علَّقها، لكنها كانت دائمًا هناك، تطلّ في كل موسمٍ كما يطلّ القمر في ميعاده، شاهدةً على دورةٍ لا تنكسر من العطاء والاحتفاء.
في رمضان، تسبق موائده مدفع الإفطار؛ تتناثر الحقائب المملوءة بما لذّ وطاب في الأزقة قبل أن يُسأل، وفي العيد الكبير، تُذبَح الأضاحي على نفقته، وتُقسَّم اللحوم كما تُقسَّم المغانم في زمن الغزو القديم.
شيئًا فشيئًا، صار الرجل طيفًا يمرّ في الذاكرة كما يمرّ النسيم في ظهيرةٍ خانقة؛ لا يُرى، لكنه يُحسّ. وحين تساءل الناس عن هويته، جاءهم الجواب كأنه وحيٌ من الغيب: أغنى تُجّار الخردة في المدينة.
لكن هذا العام... بدا أن الطيف قرَّر أن يتجسَّد. اختفت يافطات التهنئة المألوفة، وظهرت أخرى جديدة، أكثر جرأةً ووضوحًا، كُتِب عليها بخطٍّ أكبر وأثقل: من أجلكم رشَّحتُ نفسي لانتخابات... وتحت العبارة، صورته مطبوعة بعناية، يجاورها رمزٌ أحمر قانٍ: الطربوش.
كان الاسم قد تسلّل إلى كل بيت، لا لفصاحته، بل لجرسه الذي يملأ الأذن بثقلٍ لا يُنسَى. وفي صباح التصويت، لاحظ رئيس اللجنة كيف تدفّق الناس نحو الاسم ذاته، وكيف أن الأميين الذين لم يخطّوا حرفًا في حياتهم صاروا يسألون بلهفةٍ طفولية: كيف نختار الحاج؟
لقد صار الرجل أيقونةَ البساطة، وورقةَ الأمل الأخيرة في دفتر الغلابة؛ الاسم الذي لا يُخطئه اللسان، والرمز الذي لا يُشير إلا إليه.
منتصف النهار، دوَّى صِخبٌ مفاجئ عند الباب. خطواتٌ صلبةٌ تشبه دقّ الطبول، وعدساتٌ تُضيء كوميض البرق. دخل رجلٌ قصير، كثّ الشارب، ضيّق العينين، ممتلئ البطن، يرتدي جلبابًا صوفيًّا في عزّ الصيف، وعلى رأسه طاقيةٌ مشدودة. خلفه رجالٌ طِوالٌ غِلاظ، كأنهم خرجوا من مشهدٍ سينمائي قديم. كان دخوله لوحةً ساخرةً تتحرّك، تجمع بين الهيبة والعبَث في آنٍ واحد.
جلس رئيس اللجنة يراقبه بعينٍ قاضٍٍ لا يُخفِي فضوله. تقدَّم الحاج نحو السِّجل، أمسك القلم كمن يمسك أداةً غريبة، وراح يخطّ اسمه بتأنٍّ شديد، يفصل بين الحروف كأن بينها خصومةً قديمة.
وبينما الصمت يملأ القاعة، دخلت امرأةٌ عجوز تسلمت بطاقة الانتخاب، توجهت صوب الصندوق ثم عادت بها تمسكها مقلوبة، وسألت ببراءةٍ عَفوية: "فين الطربوش يا أستاذ"؟ ضحك الحاج بصوتٍ ملأ المكان، وقال: "أنا الطربوش"!
ومع آخر ضوءٍ في المساء، نطق الصندوق. فوزٌ كاسحٌ لا جدال فيه. ارتفعت الهتافات، ورفرفت الأيادي بالدعاء، وتفتّحت في الغروب أزهارُ "الشكر" التي كانت بذورها "بونات" النهار.
وفي زاوية القاعة، بقيت صورة الطربوش تتدلّى من الحائط، تبتسم ببرودٍ ملوكي، كأنها تعرف أن اللعبة لم تنتهِ بعد.