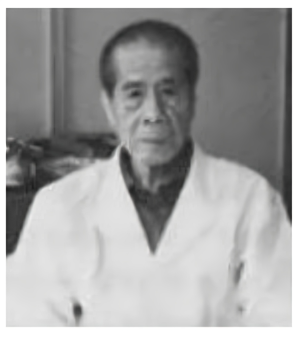ارتبطت فكرة البطولة في الوعي الجمعي بالدفاع عن الأرض والعقيدة غير أن التاريخ حين يُقرأ بعين العقل لا بعاطفة الشعارات، يكشف أن كثيرًا من الجرائم ارتُكبت باسم الوطن والدين، وأن القاتل كثيرًا ما تحوّل - بفعل التضليل - إلى "فدائي" أو "شهيد"، بينما هو في حقيقته مجرد أداة لتنظيم سريّ، أو رهينة لفكرة منحرفة.
في القانون القاتل مجرم وفي أدبيات بعض الجماعات القاتل فدائيّ. هذه المفارقة هي أصل الداء، حيث تُغلف الجريمة بغلاف القَداسة، ويُروَّج لها كأنها طاعة دينية أو بطولة وطنية.
كم كشفت التراث القضائي عن قضايا قُتِل فيها الأبرياء بدعوى "نُصرَة الدين" أو "خدمة الوطن"، بينما الحقيقة كانت انتقامًا سياسيًّا، أو تنفيذًا لأجندة جماعة، أو نتيجة تحريض مُمنهج.
لو كان القتل سبيلًا للنهضة، لكانت دماء الخصوم في أي بلد قد أنبتت تقدمًا واستقرارًا. لكن الحقيقة أن كل رصاصة طائشة، وكل عبوة ناسفة، لم تُنتج إلا الفوضى، وزعزعة الثقة، وتآكل هيبة الدولة.
ما الذي جناه الوطن من اغتيالات مثل النقراشي، وأحمد ماهر، والقاضي أحمد الخازندار؟ ألم نخسر رجال دولة وقضاء وعقل؟ ألم تنفتح أبواب العنف الممنهج بدلًا من أبواب الحوار؟
كثير من جرائم القتل السياسي كانت تحمل شعارات دينية أو وطنية، لكنها في حقيقتها خطط تنظيمية خالصة، لا علاقة لها بالإيمان ولا بالإخلاص الوطني.
لم تقف جريمة القتل باسم الدين أو الوطن عند حدود التاريخ المحلي، بل امتدت في عصرنا الراهن مع جماعاتٍ عابرةٍ للحدود كداعش والقاعدة، حيث اختُزل الإيمان في تفجير، والجهاد في ذبح، فصار الدين مطيّةً للسلطة، والوطن ساحةً للخراب.
تاريخنا الحديث ملئ بالأمثلة: بطرس غالي (1910) قُتل بدعوى "الخيانة"، بينما أظهرت الوثائق أن قاتله كان ضحية دعايات حزبية بلا وعي قانوني. النقراشي باشا (1948) قتله أحد الإخوان لأنه حلّ الجماعة والمفارقة المؤلمة أن النقراشي هو من كفل تعليم قاتله. القاضي أحمد الخازندار اغتيل لأنه حكم ضد متهمين ينتمون للجماعة نفسها. فرج فودة (1992) قتله شاب لا يقرأ ولا يكتب، لمجرد أنه "سمع" أنه كافر. السندي وفايز: قادة في تنظيم واحد، أحدهما أرسل للآخر صندوق حلوى مفخخ فقتل أسرته. هل بعد كل هذا يُقال إن القتل دفاعٌ عن الحق؟
رغم ما حدث، فإن القضاء المصري كان في كثير من هذه القضايا شاهد عدل، وضميرًا حيًّا. لم يكن قاسيًا ولا متعجلًا، بل بحث، وواجَه، وكشف التزييف وبعض الاعترافات بفساد "الجهاد المزعوم" جاءت من داخل الجماعات نفسها. منهم من وصف القتل بــ "العبادة"، ومنهم من حمّل الضحية مسؤولية موته، في منطق مقلوب لا يعرفه دين ولا عقل.
الخطورة الكبرى ليست في القتل، بل في تحويل القاتل إلى "رمز". حين يتحوّل حسين توفيق قاتل أمين عثمان إلى بطل سينمائي، كما حدث في رواية "في بَيتنا رجل"، فإن الوعي الجمعي يُصاب بالعمى، وتُزيف الذاكرة الوطنية.
الكلمة قد تقتل. الصورة قد تضلل. والفن، حين يُجمّل القاتل، يصبح شريكًا في الجريمة.
لسنا نحاكم أفرادًا، بل نحاكم الفكرة القاتلة. الفكرة التي تخلط بين الجريمة والبطولة، وبين الخيانة والفضيلة، وبين الحق والمصلحة التنظيمية.
إننا في أمسّ الحاجة إلى إعادة قراءة تاريخنا بعينٍ ناقدة، وكتابة الحاضر بضميرٍ حيّ، وتربية الأجيال على قداسة الكلمة لا قداسة الرصاص.
وليعلم كل من سوّلت له نفسه أن يغتال باسم الله أو الوطن، أن هناك قضاءً يُنصف، وشعبًا يُبصر، وذاكرةً لن تنسى.
في القانون القاتل مجرم وفي أدبيات بعض الجماعات القاتل فدائيّ. هذه المفارقة هي أصل الداء، حيث تُغلف الجريمة بغلاف القَداسة، ويُروَّج لها كأنها طاعة دينية أو بطولة وطنية.
كم كشفت التراث القضائي عن قضايا قُتِل فيها الأبرياء بدعوى "نُصرَة الدين" أو "خدمة الوطن"، بينما الحقيقة كانت انتقامًا سياسيًّا، أو تنفيذًا لأجندة جماعة، أو نتيجة تحريض مُمنهج.
لو كان القتل سبيلًا للنهضة، لكانت دماء الخصوم في أي بلد قد أنبتت تقدمًا واستقرارًا. لكن الحقيقة أن كل رصاصة طائشة، وكل عبوة ناسفة، لم تُنتج إلا الفوضى، وزعزعة الثقة، وتآكل هيبة الدولة.
ما الذي جناه الوطن من اغتيالات مثل النقراشي، وأحمد ماهر، والقاضي أحمد الخازندار؟ ألم نخسر رجال دولة وقضاء وعقل؟ ألم تنفتح أبواب العنف الممنهج بدلًا من أبواب الحوار؟
كثير من جرائم القتل السياسي كانت تحمل شعارات دينية أو وطنية، لكنها في حقيقتها خطط تنظيمية خالصة، لا علاقة لها بالإيمان ولا بالإخلاص الوطني.
لم تقف جريمة القتل باسم الدين أو الوطن عند حدود التاريخ المحلي، بل امتدت في عصرنا الراهن مع جماعاتٍ عابرةٍ للحدود كداعش والقاعدة، حيث اختُزل الإيمان في تفجير، والجهاد في ذبح، فصار الدين مطيّةً للسلطة، والوطن ساحةً للخراب.
تاريخنا الحديث ملئ بالأمثلة: بطرس غالي (1910) قُتل بدعوى "الخيانة"، بينما أظهرت الوثائق أن قاتله كان ضحية دعايات حزبية بلا وعي قانوني. النقراشي باشا (1948) قتله أحد الإخوان لأنه حلّ الجماعة والمفارقة المؤلمة أن النقراشي هو من كفل تعليم قاتله. القاضي أحمد الخازندار اغتيل لأنه حكم ضد متهمين ينتمون للجماعة نفسها. فرج فودة (1992) قتله شاب لا يقرأ ولا يكتب، لمجرد أنه "سمع" أنه كافر. السندي وفايز: قادة في تنظيم واحد، أحدهما أرسل للآخر صندوق حلوى مفخخ فقتل أسرته. هل بعد كل هذا يُقال إن القتل دفاعٌ عن الحق؟
رغم ما حدث، فإن القضاء المصري كان في كثير من هذه القضايا شاهد عدل، وضميرًا حيًّا. لم يكن قاسيًا ولا متعجلًا، بل بحث، وواجَه، وكشف التزييف وبعض الاعترافات بفساد "الجهاد المزعوم" جاءت من داخل الجماعات نفسها. منهم من وصف القتل بــ "العبادة"، ومنهم من حمّل الضحية مسؤولية موته، في منطق مقلوب لا يعرفه دين ولا عقل.
الخطورة الكبرى ليست في القتل، بل في تحويل القاتل إلى "رمز". حين يتحوّل حسين توفيق قاتل أمين عثمان إلى بطل سينمائي، كما حدث في رواية "في بَيتنا رجل"، فإن الوعي الجمعي يُصاب بالعمى، وتُزيف الذاكرة الوطنية.
الكلمة قد تقتل. الصورة قد تضلل. والفن، حين يُجمّل القاتل، يصبح شريكًا في الجريمة.
لسنا نحاكم أفرادًا، بل نحاكم الفكرة القاتلة. الفكرة التي تخلط بين الجريمة والبطولة، وبين الخيانة والفضيلة، وبين الحق والمصلحة التنظيمية.
إننا في أمسّ الحاجة إلى إعادة قراءة تاريخنا بعينٍ ناقدة، وكتابة الحاضر بضميرٍ حيّ، وتربية الأجيال على قداسة الكلمة لا قداسة الرصاص.
وليعلم كل من سوّلت له نفسه أن يغتال باسم الله أو الوطن، أن هناك قضاءً يُنصف، وشعبًا يُبصر، وذاكرةً لن تنسى.