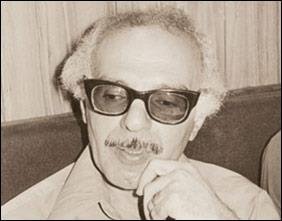المقدمة:
............
يُعدّ أدب الطفل المدرسي أحد أخطر الحقول الثّقافيّة تأثيرًا، لا لأنّه موجّه إلى فئة عمرية هشّة فحسب، بل لأنّه يمثّل اللّقاء الأوّل، وغالبًا الحاسم، بين الطفل واللّغة بوصفها جمالًا لا مجرّد أداة، وبين النّص بوصفه تجربة لا واجبًا ومن هنا، فإنّ أيّ نقاش حول طبيعة هذا الأدب لا يمكن اختزاله في مسائل تقنيّة أو تربويّة محضة، بل يتجاوزها إلى حدود سؤال أعمق يتعلّق بالسّلطة الثّقافية من يقرّر ما يقرأه الطفل؟ وبأيّ منطق يُصاغ هذا النّص؟ وهل يُنظر إلى أدب الطفل في الكتاب المدرسي بوصفه فنًّا حيًّا، أم وسيلة تعليمية مُقنّعة؟ إنّ هذا السؤال، في جوهره، ليس تنظيريًا، بل مصيري، لأنّ نتائجه تمتدّ إلى تشكيل الذّائقة، وبناء العلاقة مع القراءة، وصياغة الحسّ الجمالي لجيل كامل.
- ليس الخلاف في أدب الطفل المدرسي خلافًا حول الأهداف التّربوية المعلنة، بل هو خلاف حول من يملك حقّ صياغة الحسّ الجمالي للطفل: أهو الكاتب المبدع الذي يرى النّص ككائن حيّ، أم لجنة الصّياغة التي تتعامل معه بوصفه أداة تنفيذ لبرنامج توجيهي؟ فبين هذين المنهجين يتحدّد مصير النّص الأدبي في الكتاب المدرسي، ويتشكّل الذوق اللّغوي والجمالي لأجيال كاملة، غالبًا من دون وعي بحجم المسؤوليّة الثّقافية الملقاة على عاتق من يختار
النّصوص ويقرّر مصيرها.في التّجربة المدرسيّة العربيّة، فلا يُصنع النّص الأدبي في الغالب داخل أفق الإبداع، بل داخل منطق المطابقة مع الأهداف، حيث يُطلب من النّص أن يشرح قيمة، أو يخدم مهارة، أو يثبت قاعدة، قبل أن يُسمح له بأن يكون جميلًا أو مدهشًا. وهنا يحدث الانزياح الخطير، إذ يُفرَّغ الأدب من طبيعته الجمالية، ويُختزل في وظيفة تعليمية مباشرة، فيتحوّل الكاتب المبدع إن استُدعي إلى مجرّد مورّد مادة لغوية، أو يُستبعد كليًا لصالح نصوص
مصنَّعة داخل المكاتب، بلا روح ولا أثر.والخلل الحقيقي لا يكمن في وجود اللّجان في حدّ ذاته، فالتّخطيط البيداغوجي ضرورة لا غنى عنها، وإنّما يكمن في طبيعة من يشكّل هذه اللّجان ،وفي المعايير التي تحكم عملها. حين يتولى اختيار النّصوص أشخاص يملكون خبرة تربويّة صِرفة، من دون ذائقة أدبية راسخة أو وعي بفنّ الكتابة للطفل، يصبح النّص الأدبي ضحية سوء الفهم. فاللّجنة هنا لا تسأل هل هذا نص جيّد؟ بل تسأل فقط: هل يوافق المؤشّر؟ وهل يخدم الكفاءة؟ وهل يمكن تقطيعه إلى أسئلة وتمارين؟ وهكذا يُقصى الجمال لصالح القابليّة للاستهلاك
المدرسي ،ويزداد الخلل حين يُنظر إلى الطفل بوصفه متلقّيًا سلبيًا ينبغي تشكيله وفق نموذج جاهز، لا بوصفه كائنًا حساسًا يتكوّن ذوقه من خلال التعرّض المبكر لنصوص حيّة، عميقة، وصادقة. فالطفل الذي لا يلتقي في كتابه المدرسي بقصة حقيقية، أو نشيد يمتلك موسيقى داخلية، أو نصّ يفتح له أفق الخيال، سيبحث عن البديل في مكان آخر، وغالبًا ما يكون هذا البديل رقميًا، سريعًا، وفقيرًا لغويًا.
- إنّ غياب الذّوق الأدبي والفنّي عند بعض أعضاء لجان الصّياغة لا يؤدّي فقط إلى اختيار نصوص ضعيفة، بل يكرّس ذائقة عامة مشوّهة، تجعل الطفل يربط الأدب بالواجب، والقراءة بالامتحان، والنص بالملل. وهنا تتحوّل المدرسة، من حيث لا تدري، إلى أول جهة تنفّر الطفل من الأدب بدل أن تصادقه عليه.
والحلّ لا يكمن في إقصاء اللّجان ولا في تسليم الكتاب المدرسي كاملًا للكاتب، بل في إعادة التّوازن بين البيداغوجي والجمالي، عبر إشراك كتّاب حقيقيين، ونقّاد أدب طفل، ومختصّين في الذّائقة الفنّية، ضمن فرق العمل، بحيث يُختار النّص أولًا لكونه أدبًا، ثم يُبحث بعد ذلك عن أنسب الطرائق التّربويّة لتوظيفه، لا العكس، فالنّص الجيّد قادر بطبيعته على حمل القيّم والمهارات، أمّا النّص المصنوع على المقاس البيداغوجي الضيّق، فلا يحمل سوى هشاشته.
الخاتمة
- إنّ الرهان في أدب الطفل المدرسي لا يتعلّق بنجاح درس أو تحقيق كفاءة مرحلية، بل بتأسيس علاقة طويلة الأمد بين الطفل واللّغة، علاقة تقوم على المتعة والدهشة والصدق. وحين يُنتزع الأدب من روحه ليُحشر في قوالب إجرائية جامدة، فإنّ الخسارة لا تطال النّص وحده، بل تطال الطفل نفسه، الذي يُحرم من حقّه في لقاء الجمال مبكرًا. لذلك، فإنّ حماية أدب الطفل داخل الكتاب المدرسي ليست مسؤولية الكاتب وحده، ولا اللّجنة وحدها، بل هي مسؤولية ثقافيّة مشتركة، تتطلّب وعيًا بأنّ النص الأدبي ليس خادمًا للمنهاج، بل شريكًا في بناء الإنسان. وحين يُعاد الاعتبار لهذا الوعي، يمكن للكتاب المدرسي أن يستعيد وظيفته الأسمى: أن يكون بداية حبّ، لا بداية نفور، وبوّابة حلم، لا جدار تعليم.

............
يُعدّ أدب الطفل المدرسي أحد أخطر الحقول الثّقافيّة تأثيرًا، لا لأنّه موجّه إلى فئة عمرية هشّة فحسب، بل لأنّه يمثّل اللّقاء الأوّل، وغالبًا الحاسم، بين الطفل واللّغة بوصفها جمالًا لا مجرّد أداة، وبين النّص بوصفه تجربة لا واجبًا ومن هنا، فإنّ أيّ نقاش حول طبيعة هذا الأدب لا يمكن اختزاله في مسائل تقنيّة أو تربويّة محضة، بل يتجاوزها إلى حدود سؤال أعمق يتعلّق بالسّلطة الثّقافية من يقرّر ما يقرأه الطفل؟ وبأيّ منطق يُصاغ هذا النّص؟ وهل يُنظر إلى أدب الطفل في الكتاب المدرسي بوصفه فنًّا حيًّا، أم وسيلة تعليمية مُقنّعة؟ إنّ هذا السؤال، في جوهره، ليس تنظيريًا، بل مصيري، لأنّ نتائجه تمتدّ إلى تشكيل الذّائقة، وبناء العلاقة مع القراءة، وصياغة الحسّ الجمالي لجيل كامل.
- ليس الخلاف في أدب الطفل المدرسي خلافًا حول الأهداف التّربوية المعلنة، بل هو خلاف حول من يملك حقّ صياغة الحسّ الجمالي للطفل: أهو الكاتب المبدع الذي يرى النّص ككائن حيّ، أم لجنة الصّياغة التي تتعامل معه بوصفه أداة تنفيذ لبرنامج توجيهي؟ فبين هذين المنهجين يتحدّد مصير النّص الأدبي في الكتاب المدرسي، ويتشكّل الذوق اللّغوي والجمالي لأجيال كاملة، غالبًا من دون وعي بحجم المسؤوليّة الثّقافية الملقاة على عاتق من يختار
النّصوص ويقرّر مصيرها.في التّجربة المدرسيّة العربيّة، فلا يُصنع النّص الأدبي في الغالب داخل أفق الإبداع، بل داخل منطق المطابقة مع الأهداف، حيث يُطلب من النّص أن يشرح قيمة، أو يخدم مهارة، أو يثبت قاعدة، قبل أن يُسمح له بأن يكون جميلًا أو مدهشًا. وهنا يحدث الانزياح الخطير، إذ يُفرَّغ الأدب من طبيعته الجمالية، ويُختزل في وظيفة تعليمية مباشرة، فيتحوّل الكاتب المبدع إن استُدعي إلى مجرّد مورّد مادة لغوية، أو يُستبعد كليًا لصالح نصوص
مصنَّعة داخل المكاتب، بلا روح ولا أثر.والخلل الحقيقي لا يكمن في وجود اللّجان في حدّ ذاته، فالتّخطيط البيداغوجي ضرورة لا غنى عنها، وإنّما يكمن في طبيعة من يشكّل هذه اللّجان ،وفي المعايير التي تحكم عملها. حين يتولى اختيار النّصوص أشخاص يملكون خبرة تربويّة صِرفة، من دون ذائقة أدبية راسخة أو وعي بفنّ الكتابة للطفل، يصبح النّص الأدبي ضحية سوء الفهم. فاللّجنة هنا لا تسأل هل هذا نص جيّد؟ بل تسأل فقط: هل يوافق المؤشّر؟ وهل يخدم الكفاءة؟ وهل يمكن تقطيعه إلى أسئلة وتمارين؟ وهكذا يُقصى الجمال لصالح القابليّة للاستهلاك
المدرسي ،ويزداد الخلل حين يُنظر إلى الطفل بوصفه متلقّيًا سلبيًا ينبغي تشكيله وفق نموذج جاهز، لا بوصفه كائنًا حساسًا يتكوّن ذوقه من خلال التعرّض المبكر لنصوص حيّة، عميقة، وصادقة. فالطفل الذي لا يلتقي في كتابه المدرسي بقصة حقيقية، أو نشيد يمتلك موسيقى داخلية، أو نصّ يفتح له أفق الخيال، سيبحث عن البديل في مكان آخر، وغالبًا ما يكون هذا البديل رقميًا، سريعًا، وفقيرًا لغويًا.
- إنّ غياب الذّوق الأدبي والفنّي عند بعض أعضاء لجان الصّياغة لا يؤدّي فقط إلى اختيار نصوص ضعيفة، بل يكرّس ذائقة عامة مشوّهة، تجعل الطفل يربط الأدب بالواجب، والقراءة بالامتحان، والنص بالملل. وهنا تتحوّل المدرسة، من حيث لا تدري، إلى أول جهة تنفّر الطفل من الأدب بدل أن تصادقه عليه.
والحلّ لا يكمن في إقصاء اللّجان ولا في تسليم الكتاب المدرسي كاملًا للكاتب، بل في إعادة التّوازن بين البيداغوجي والجمالي، عبر إشراك كتّاب حقيقيين، ونقّاد أدب طفل، ومختصّين في الذّائقة الفنّية، ضمن فرق العمل، بحيث يُختار النّص أولًا لكونه أدبًا، ثم يُبحث بعد ذلك عن أنسب الطرائق التّربويّة لتوظيفه، لا العكس، فالنّص الجيّد قادر بطبيعته على حمل القيّم والمهارات، أمّا النّص المصنوع على المقاس البيداغوجي الضيّق، فلا يحمل سوى هشاشته.
الخاتمة
- إنّ الرهان في أدب الطفل المدرسي لا يتعلّق بنجاح درس أو تحقيق كفاءة مرحلية، بل بتأسيس علاقة طويلة الأمد بين الطفل واللّغة، علاقة تقوم على المتعة والدهشة والصدق. وحين يُنتزع الأدب من روحه ليُحشر في قوالب إجرائية جامدة، فإنّ الخسارة لا تطال النّص وحده، بل تطال الطفل نفسه، الذي يُحرم من حقّه في لقاء الجمال مبكرًا. لذلك، فإنّ حماية أدب الطفل داخل الكتاب المدرسي ليست مسؤولية الكاتب وحده، ولا اللّجنة وحدها، بل هي مسؤولية ثقافيّة مشتركة، تتطلّب وعيًا بأنّ النص الأدبي ليس خادمًا للمنهاج، بل شريكًا في بناء الإنسان. وحين يُعاد الاعتبار لهذا الوعي، يمكن للكتاب المدرسي أن يستعيد وظيفته الأسمى: أن يكون بداية حبّ، لا بداية نفور، وبوّابة حلم، لا جدار تعليم.